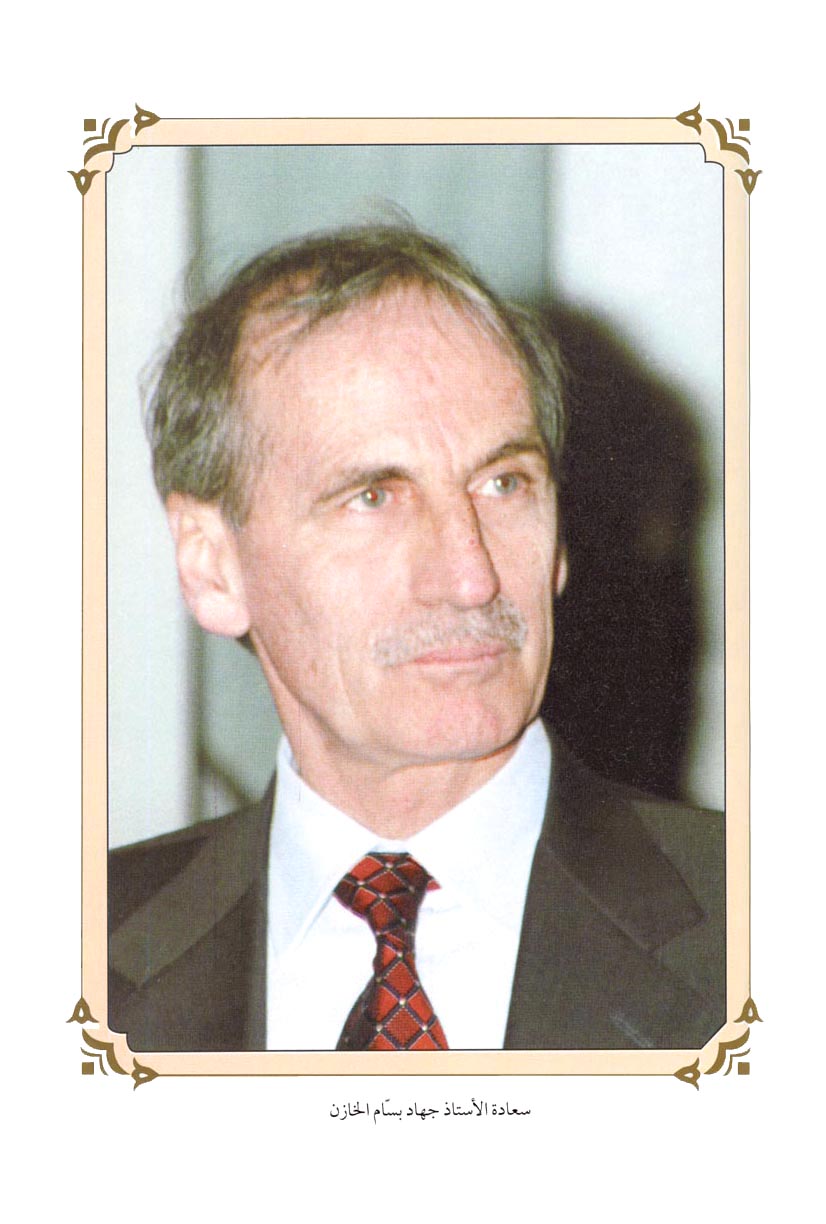| حقيبةٌ دبلوماسيةٌ وسيجار "كوبيّ" |
| يتنقل بين أصابعه وشفتيه.. وقلم |
| ذهبي مع بضع أوراق: ليصبح كاتباً |
| يتحدث عن فلسفة الدهاليز، ونظريةِ |
| تحديد النسل باستعمال المشانقِ والديناميت.. |
| مِسْبَحَةٌ من حَدَقات الضحايا، وَ"جُبَّةُ" |
| درويش: ليصبح "أوغسطين" الجديد، |
| يتحدث في اللاهوتِ، ويعرض صكوك |
| الغفران على الأرصفة المغسولة بدمِ ضحاياه! |
| سكّينٌ دمويٌ، واحتجازٌ لبضعة أيامٍ |
| في مخفر للشرطة.. بسبب مشاجرةٍ |
| في حانةٍ ليلية، أو مشاكسةٍ على |
| رصيفِ الصباح: ليصبح ثورياً |
| يحمل السوطَ والقنبلة الموقوتة |
| ضَدَّ مَنْ يُعلنُ العصيانَ على قانونه الجَدَلي |
| أو لا يؤمن بثورةٍ تشتعل في صالاتِ الليلِ |
| وتنطفئ على أرصفة الصباح..! |
| آهٍ يا وطني.. |
| إن الأقلام الذهبية والحقائبَ الدبلوماسيةَ – |
| وفلسفات الدهاليز والمشاجرات الليلية: |
| قد قَتَلَتْ منّا |
| أكثر مما قتلت الطلقاتُ المخاتلةُ |
| وحبالُ المشانق – |
| وحوادثُ الدهس المُنَسَّقَةِ! |
| فكيف لا يهرمُ الوطنُ الطفلُ |
| أو تشيخ الأنهار والخضرة – |
| إذا كان بعضنا ينتشي برائحة القيحِ |
| ويخشى عبيرَ البرتقال؟ |
| كيف لا تغادرُ الشمسُ نوافذَ الصباحِ – |
| إذا كنا نستورد كتبَ الفلسفةِ الصفراءَ.. |
| بينما فلسفتنا الخضراء |
| تبقى مُعَلَّقَةً على مشاجبِ الذكرى؟ |
| * * * |
| لقد علَّمَتْني العرباتُ التي أكلت نصْفَ عمري: |
| أن الذين يجلسون في المقاعد الأمامية |
| لا يبصرون غيرَ زجاجِ النوافذِ.. |
| لهذا: |
| أبحث عن مقعدٍ فارغ – |
| بينَ المقاعدِ الخلفيةِ في العربات.. |
| فأنا أريد أنْ أرى الجميعَ |
| وهم يسيرون نحو المدينةِ الفاضلةِ! |
| وحين يَتَرَجَّلون: |
| سأسيرُ خلفهم.. |
| فإذا سقط أحدٌ ما، |
| سأجعل من صدري "نقّالةً" |
| ومن ظهري "هودجاً".. |
| أمَّا إذا سقطتُ أنا – |
| فسأسقط بهدوءٍ.. دون ضجيج |
| من أجل أنْ تستمر القافلة.. |
| وعند ذلك: |
| سأغفو مطمئناً – |
| طالما ينعم الجميعُ بالدفءِ والمسرة! |
| * * * |
 شارع عبد المقصود خوجة
شارع عبد المقصود خوجة 00966-12-6982222 - تحويلة 250
00966-12-6982222 - تحويلة 250