|
(( كلمة المحتفى به الأستاذ عزيز ضياء ))
|
| بعد الكلمة الترحيبية التي ألقاها المحتفي الأستاذ عبد المقصود خوجه تحدث المحتفى به فقال: |
| - الحمد لله... |
| - لعل أول ما ينبغي أن أقدمه في هذا الحفل، هوشكري الجزيل والجم، والكبير، للابن، الأستاذ/ عبد المقصود محمد سعيد خوجه. وأنا أخلط بين الاسمين بينه وبين أبيه لأن أباه/ محمد سعيد كان صديقي، وكثيرًا ما أرى عبد المقصود فأذكره، ولعلي أذكر محمد سعيد أكثر مما أذكر عبد المقصود. رحم الله محمد سعيد فقد كان إنساناً، يملأ علينا حياتنا في تلك الفترة التي عشناها قبل الحرب العالمية الثانية، وعلى التحديد بعد أن أسَّس الملك عبد العزيز - يرحمه الله -، المملكة العربية السعودية. وكان محمد سعيد يقوم بإصدار جريدة "أم القرى"، أو كان يساعد الشيخ رشدي ملحس في إصدارها. وكلنا نعلم أنها جاءت في أعقاب جريدة "القبلة"، التي كانت تصدر في مكة، وكان يحررها الشيخ/ فؤاد الخطيب، بل وكان يحررها كذلك الملك حسين بنفسه، وكثيراً ما كنا نسمع أن الحسين لا يرضى عن مقالٍ ما، فيكتب مقالاً هو بقلمه بديلاً عن المقال الذي لا يرضى عنه، ثم ينشره وكثيرون يعلمون أن الكاتب هوالملك حسين - رحمهم الله جميعاً -. |
| - اليوم حين يحتفل بي الابن عبد المقصود يحرجني كثيراً، إلاَّ أنني أشعر دائماً أن ألقاب الأستاذية التي أفاض وأغدقها عليَّ الأستاذ/ حسين نجار، وجرت عادة الأستاذ عبد المجيد شبكشي أن يرددها في كل مناسبة، وفي كل لقاء، وهذه الألقاب لا أستحقها في الواقع، لأني أكرر ومنذ زمن طويل أنني لست أكثر من طالب علم. وليس هذا تواضعاً، ولا رغبة لمزيد من الثناء، بل هي الحقيقة. فإني ما أزال طالب علم، بل لعلّي في هذه الأيام أدهش كثيراً عندما أجد أنني قرأت كتاباً في زمنٍ ما، ثم آخذه بين يدي فأجد أنني قد نسيته، فأضطر إلى قراءته مرة ثانية. ومن هذه الزاوية يمكن أن أقول إني طالب علم بليد أيضاً، أوعلى جانب من البلادة كبير. وهذه البلادة تتقدم مع تقدم السن، ولهذا أرجوأن يعذرني الإِخوان إذا لم أستطع أن أفيَ الموضوع حقه. ومن هذه الناحية، فأنا أكرر وأريد أن يتكرَّس هذا في الأذهان، أني لست أكثر من طالب علم. |
| - ولست مغروراً بما يضفى عليَّ من ألقاب الكاتب الكبير. وعلى طريقة الأستاذ/ عبد المجيد... أستاذ الجيل إلى آخر هذه الألقاب التي أريد أن أقر أني أضيق بها كثيراً. ثم أضفى علي الأستاذ/ عبد المقصود كذلك صفات هي في الواقع ربما كان لها قيمة في تقدير كثيرين، ولا أستهتر بها، ولا أقول إنها لا قيمة لها عندي، ولكنها شيء مضى وانتهى. وتجربتي في الحياة تقول إني بعد أن تركت العمل في الدولة، ولأسباب ليس هذا مجال شرحها، سعدت أكثر، وعشت آفاقاً أكثر رحابة، وأكثر سعة، وأكثر تعاملاً مع الحياة، ومع الحضارة، ومع الثقافة. |
| - ولوأني ظللت موظفاً إلى أن أبلغ الستين مثلاً، لما كنت هذا الإِنسان الذي يسعد اليوم بتكريمه الإِخوة الأفاضل جميعاً، أحسب أن أترك مجال حديثي عن وظائف الدولة. ليس استهتاراً بها، أواستقلالاً بشأنها، إلاَّ أنها شيء مضى وانتهى. |
| - وما أزال أقول إني أكثر سعادة من ذي قبل، أيام كنت موظفاً. بعد ترك العمل الحكومي وجدت نفسي قادراً على أن أتفرَّغ للثقافة، والكتابة، وليس مما أضيق به أن أقول إني عشت من جهد القلم واقعاً حقيقياً وممارسة وحتى اليوم. أنا من الذين لا يتمتَّعون بما يتمتَّع به غيري من المتقاعدين، مما يسمّى راتب تقاعد، أو ما أشبه ذلك، وكذلك لست من أصحاب الأملاك، والعقار، والأراضي. ولم يتح لي كذلك في السنوات العشر الأخيرة أن أدخل مغامرة التعامل مع الأرض. ولهذا فإني ما زلت حتى هذه اللحظة أعيش مما أكتسبه بقلمي. وأحمد الله على هذا كثيراً. |
| - أريد أن أقف فأقول: لولا أن حاجتي إلى العيش وإلى نفقات هذا العيش اضطرّاني إلى التعامل مع القلم، لعلّي ما كنت أحقق شيئاً مما يظن الإِخوان أنه ذو قيمة في مجال الكلمة. ومع هذا لا بد أن أعترف أني تعشَّقت الكلمة والحرف منذ كنت في الرابعة عشرة من عمري. |
| - لتعشُّقي الحرف قصة تحدثت عنها كثيراً أو مراراً، يعرف عنها أو بعضها الأستاذ/ محمد حسين زيدان بالذات. كنت في مكة ولم تكن لي علاقة لا بالأدب، ولا بالشعر، وكنت مع زملاء في المدرسة، زعموا لنا أنها مدرسة طب، وهكذا ظننا خاطئين، واكتشفنا بعد وصولنا مكة، وبقائنا فيها بضعة أشهر، أنها مدرسة تمريض، وانحدرت مدرسة التمريض هذه إلى حد أننا أصبحنا مكلَّفين بأخذ درجة حرارة المرضى المصابين بالسل، والإِسهال، وأمراض أخرى معدية. وكانت النتيجة أني هربت من هذه المدرسة. وحكاية الهروب حكاية طريفة... سوف أتحدَّث عنها بعد أن أنتهي من الحديث عن بدايتي مع الكلمة. قبل أن أهرب كان يزورنا بعض الأصدقاء - ممن يكبرني سنّاً - فقد كنت صغير السن في تلك الأيام. ومن أولئك الأصدقاء، رجل يتعلَّق بالأدب والشعر، ولا أدري إن كان أحد يذكره. إنه الأستاذ أحمد سناري - يرحمه الله -، إنني أشك أن أحداً يذكره اليوم. |
| وينطلق صوت الأستاذ محمد حسين زيدان ليعلن معرفته بذلك الشخص قائلاً: |
| - "إنه صاحب مكتبة باب السلام". |
| ثم يعاود المحتفى به حديثه قائلاً: |
| - جاء الأستاذ/ أحمد سناري لزيارة الأخ والزميل أيامها، فؤاد وفا أخي طلعت وفا من رجال الشرطة، وكذلك فهمي الحساني - الله يرحمه - وأحضر معه كتاباً في يده اسمه: "العواصف والعواطف" لجبران خليل جبران. ولم أكن أيامها أدري، أو أعرف، جبران أو غير جبران وإنما الأستاذ/ أحمد السناري أحضر هذا الكتاب معه، وعندما خرج مع أصدقائه نسيَ الكتاب في الغرفة، فأخذته، وأخذت أقرأ منه شيئاً... فأعجبني الكلام ولأول مرة أعرف أن الكلمة لها سحر، وأنا غير قادر على السهر. كنت أنام مبكراً كما عوَّدونا في المدينة بعد صلاة العشاء، ولا بد أن نستسلم للفراش وننام. ولكن في تلك الليلة لم أنم بل سهرت مع جبران خليل جبران، أو مع هذا الكتاب إلى وقت متأخر من الليل، لا أزعم أنه الفجر، ولكن قبله بقليل، فتعشَّقت الكلمة منذ ذلك اليوم، وبدا لي أنه ليس من الصعب أن أكتب كما كتب جبران. وإن كان هذا يعني مجازفة كبيرة جداً. ولكني هكذا أحسست وأخذت أكتب فعلاً، وأكتب إلى صديقي في المدينة، وهوالأخ/ محمد نيازي، صديق، وزميل يعرفه الأستاذ/ زيدان، رسائل كلها حب وغرام، وأشياء من هذا القبيل. |
| ويعلِّق الأستاذ محمد حسين زيدان: |
| - كنت أقرؤها. |
| ويواصل الأستاذ عزيز ضياء حديث ذكرياته قائلاً: |
| - وكان يعجبني أن الرسائل التي كانت تأتيني من محمد نيازي - الله يذكره بالخير - أن فيها من الثناء لي والإِعجاب الكثير بما كتبت، ويبشِّرني أنه قرأ بعض هذه الرسائل على الإِخوة وأنهم كذلك معجبون بها. وأحب أن أنبِّه أني لم أكن أسرق كلام جبران وأضعه في الرسائل، إنما كنت أحاول أن أقلِّده، وهناك فرق كبير بين أن تسرق الكلمة كما هي، كما يفعل بعض الكتّاب، لا حاجة لذكر الأسماء، وبين أن تقلِّد أديباً في الأسلوب، وفي الأداء. وهوما أتبعه، وظللت على هذا فترة لا تقل عن السنة، أنا أكتب الرسائل إلى المدينة وتأتيني الردود. وأنا سعيد بأني استطعت أن أشعر الإِخوة الموجودين في المدينة من زملائي بأني أصبحت أقدر أن أكتب كلمة يحسّون بها، ويثنون عليها. |
| - ثم حدثت حادثة الهرب من مدرسة الصحة هذه بعد خناقة ومضاربة مع أحد الأطباء - الله يذكره بالخير إن كان حَيّاً وأن يتغمده برحمته، إن كان ميتاً -، هذا الدكتور كان عنيفاً جداً بالرغم من أنه قصير القامة، ضئيل الجسم، لكني كنت أضأل منه فكان هذا سبباً يجعله حريصاً على أن يتكبَّر عليَّ من دون إخواني كلهم. وكانوا قد كلَّفوني مسؤولية الإِشراف على قسم فيه حوالي عشرين أوثلاثين مريضاً كلهم مصابون بالسل. |
| - فأنا مكلَّف أن أحضر في الصباح قبل شروق الشمس، لأقيس درجة حرارة هؤلاء المسلولين، وأقوم بتسجيل درجة الحرارة في الورقة المعدة لذلك، محدداً الساعة التي تمَّ فيها قياس الحرارة. |
| - في الواقع إني أعترف: كنت أرتكب حماقة، وإهمالاً، وعدم مبالاة، فلا أقوم بالتأكد من درجات الحرارة، كنت أضع مقياس درجة الحرارة في فم المريض، ثم أضعه في فم المريض الذي يليه وأكتب درجة الحرارة التي اختارها. |
| - لاحظ الدكتور تصرُّفي هذا. فأصرَّ على أن يتخذ ضدي موقفاً يعاقبني فيه على سوء تصرفي، وأظن أن له حقاً في الواقع، لكنني تضايقت. |
| - لقد كنت مجرماً في هذه الحكاية، وأنا أعترف بذلك، ولكن... أيامها كنت شاباً يافعاً وكلهم مرضى بالسل، وعلمت أن جرثوم السل ينتقل في الهواء، والبنية الضعيفة تأخذه بسرعة. ولذلك وهرباً من مرضى السل بل من القسم كله قمت بارتكاب هذه الحماقة، بل الجريمة على الأصح، وعندما لاحظني الدكتور أصر على مجازاتي وأخذ يوغر صدر المدير عليَّ. وكان المسؤولون يطلبون منه أن يرفق بي لصغر سني، ورجعت أعمل معه لكنه شدَّد عليَّ الخناق، وأخذ يزداد شدة في مراقبتي. وكان يساعدني في عملي مساعد، يقوم بكنس الغرفة، ورأى هذا المساعد واسمه/ محمد الأسود المعاملة السيئة التي يعاملني بها الدكتور، فقال لي: أعتقد أن هذا الدكتور لا يريد أن يعفيك ولا يعفيني، بل يرغب أن ينكد عليك. قلت له: ما رأيك؟ قال: إذا حضر غداً فسوف أمسكه لك، وأنت عليك أن تعلمه درساً لا ينساه. |
| - في اليوم الثاني، جاء الدكتور بالفعل كعادته بعد حضوري بقليل، وقد كنت أحضر قبله. وكان من الضروري أن نسير وراءه عند تفقُّده للأقسام، فلما رآني، قال: أما تستحي؟ ألا تريد أن تترك عادتك؟ قلت له: لا تطوِّل لسانك يا دكتور. إني أنصحك، إنَّ ما تقوم به ضدي لن يعود عليك بالخير! فقال لي: ما الذي تعني بهذا؟ قلت له: أعني شيئاً كثيراً. قال: أتهددني؟ قلت له: نعم!. وفي هذه اللحظة أمسك محمد الأسود به وتولَّيت ضربه على الفور، خرجت من باب المستشفى، وتوجَّهت إلى وكيل لي اسمه الشيخ/ عبد العزيز - الله يرحمه - في الشامية واختبأت عنده، وكان للشيخ عبد العزيز زوجة تسكن معه في البيت. فأخبرته بالحكاية كلها كيت، وكيت وكيت. فقال لي: هذه مصيبة كبيرة، قلت له: فعلاً ولكن أريدك أن ترسلني إلى المدينة. قال: عليك أن تلتزم الصمت حتى نرى ماذا سيحدث؟ وفي صباح اليوم الثاني، سمعنا المنادي ينادي معلناً عن ضياعي أو ما في معناه، إذ كان المنادي في ذلك الوقت هووسيلة الإِعلان الوحيدة. |
| - استمر المنادي ينادي ثلاثة أيام متتالية. فعرفت أنني المطلوب، ففضلت البقاء في البيت خمسة وأربعين يوماً، لم أتجاوز باب الشارع. |
| - ثم أتيح لي السفر إلى المدينة وانتهت الحكاية. بعد سنة رجعت مكة مرة ثانية. وتقدمت للعمل في وظيفة مقيد أوراق في مديرية الصحة العامة بعد الإِعلان عنها، وكان السيد ضياء الدين بك زوج أمي قد نقل إلى صحة مكة ليعمل في وظيفة رئيس صيادلة في المستشفى. وما أدري أكانت مجاملة منهم له؟ أوكان الأمر حقيقة أن أكون أول الناجحين في الامتحان الذي أعد لاختيار من يشغل هذه الوظيفة، وكان عدد المتقدمين عشرين شخصاً، فعيَّنت مقيد أوراق في مديرية الصحة العامة، ويعتبر نجاحي والتحاقي بهذه الوظيفة، خطوة كبيرة جداً في حياتي، وهي أول وظيفة أشغلها في الدولة. |
| ويسأل أحد الحاضرين قائلاً: |
| - في أية سنة كان ذلك؟ |
| ويجيب الأستاذ عزيز ضياء على سؤال السائل بقوله: |
| - أعتقد أن ذلك تم في سنة سبع وأربعين بعد الثلاثمائة وألف من الهجرة. |
| - وكنت خلال هذه الفترة كلها لا أزال أحمل كتاب جبران خليل جبران في جيبي، أصطحبه في غدوتي وروحتي، وظللت أواصل كتابة رسائل الغرام إلى أصدقائي في المدينة. |
| - نسيت أن أقول لكم أني لما وصلت المدينة من مكة، بعد هروبي من المستشفى، استقبلت استقبالاً حافلاً من الأصدقاء الذين كانوا يتلقّون هذه الرسائل. وأتذكر منهم العم يوسف بصراوي - الله يرحمه - الذي أقام لي ما يشبه حفلة تكريم صغيرة. وقال فيها: إن هذا الرجل، أوهذا الشاب، أوهذا الإِنسان سيكون كاتباً، فقد تنبَّأ لي بشيء من هذا القبيل. ولا أدري كيف حصل على رسالة من الرسائل، وترك واحداً من أولاده، أظنه أنور - الله يرحمه - يقرأ هذه الرسالة، ومنهم أيضاً العم يوسف ديولي، أبا محمود ديولي، وكذلك العم أحمد الكابلي، وأبناءه حمزة كابلي وإخوانه وغيرهم. |
| - لنعد إلى حديث الذكريات لوصل ما انقطع منه. |
| - لقد انتهى الحديث بنا عندما رجعت إلى مكة، والتحقت موظفاً بمديرية الصحة بمسمى مقيِّد أوراق. كان مساعد مدير الصحة العام الدكتور حسني الطاهر - الله يرحمه – وهو أخو أو ابن محمد علي الطاهر، صاحب جريدة "الشورى" التي كانت تصدر في القاهرة. هذا الرجل كان أديباً وشاعراً وذوّاقة ويعرف اللغة الإِنجليزية بشكل ممتاز جداً. أظن أنه درسها في أكسفورد، تابعت كتابة الرسائل التي أستمدها من كتاب جبران خليل جبران وذلك بعد الانتهاء من عملي لأنني إذا أنهيت عملي بقيت بمديرية الصحة، حيث كانت البساتين في مكة قليلة، لنصل لمنطقة بها خضرة، يلزمنا الذهاب إلى المسفلة، وكانت المسفلة بالنسبة لنا بعيدة آنذاك، حيث كنا بأجياد ولا نزور المسفلة، إلاَّ مرة واحدة كل شهرين أوثلاثة أشهر، ولا يوجد في بركة ماجن غير زرع وخضار، ولكن مبنى مديرية الصحة به حديقة وفيها زهور، وبركة تجعلني أفضَّل البقاء، بعد انتهاء العمل حتى الليل، فكنت أغتنم هذه الفرصة، لأكتب هذه الرسائل. |
| - وذات يوم بُعيد المغرب وكنت منهمكاً في كتابة رسالة من تلك الرسائل، سمعت تصفيقاً حاداً من ورائي، فرأيت الدكتور حسني طاهر ولم أشعر به، ولم أسمع له صوتاً فقد كان يعتاد لبس نعال من المطاط لا تحدث صوتاً حتى لا يحس العاملون بالمستشفى، ليكتشف المهمل منهم، فقلت له: خيراً يا دكتور. قال: هل أنت كاتب هذا الكلام؟ فأجبته بالإِيجاب. قال: هذا غير معقول. قلت له: إن عندي غيره ومددت يدي إلى الدرج، وأخرجت منه بعض الأوراق وأعطيته إياها، قال: عجيب منذ متى وأنت تكتب؟ قلت: منذ سنتين تقريباً. ثم تناول الأوراق كلها وأخذ ينظر إليها، ثم أعادها إليَّ وقال: انظر هذه غلطة في النحو، وهذا تصريف خطأ. ينبغي لك لكي تكون كاتباً أن تطبع في ذهنك أن لا تخطئ لا نحواً ولا صرفاً، فشكرته على ذلك، وفرحت جداً بتقدير الدكتور، لأننا كنا ننظر إليه باحترام، فهو أولاً دكتور يفهم الإِنجليزية، وهو من جهة أخرى أديب، وشاعر في بعض الأحيان، فكان تقديره ذا أثر كبير جداً في نفسي - رحمه الله - ثم زارني بعد أسبوع تقريباً، وبصحبة دكتور في التكية المصرية اسمه مصطفى. |
| يتدخل هنا الأستاذ/ محمد حسين زيدان، فيقول: |
| - (مصطفى عبد الخالق). |
| فيثني الأستاذ عزيز على قوة ذاكرة الزيدان بقوله: |
| - ما شاء الله على ذاكرتك. نعم مصطفى عبد الخالق. |
| - لقد جاء الدكتور/ حسني الطاهر، والدكتور مصطفى عبد الخالق ومعهما رزمة كتب كلها للمنفلوطي، "النظرات"، "العبرات"، " مجدولين"، " الشاعر"، "في سبيل التاج"، "الفضيلة" ووضعها على المكتب، وكتباً أخرى عليها إهداء من الدكتورين مصطفى عبد الخالق وحسني الطاهر. لقد فرحت بالكتب كثيراً وقال لي الدكتوران لكي تصبح كاتباً جيداً، فلا بد من تحسين لغتك. وكتب المنفلوطي هذه فيها كثير من الألفاظ التي تحتاجها. والتي تستطيع أن تعبر بها عن نفسك التعبير الصحيح. فقرأت كتب المنفلوطي أكثر من سبع، أوثماني مرات. |
| - ولقد استفدت من المنفلوطي كثيراً وبالفعل استقامت عباراتي، وصرت أشعر بنفسي أني كاتب، ولا أجد ما يمنع جلوسي مع الدكتور. |
| - دعوني أحدِّثكم الآن عن حكاية اللغة الإِنجليزية، لقد قلت لكم: أنني بعد دراستي للمنفلوطي أصبحت أشعر بأن عباراتي استقامت، وفي هذه الفترة درست النحوعلى زميل ولكن... كبير السن يدعى/ محمد سعيد الكيالي - رحمة الله عليه - كان يعرف النحو كمعرفة سيبويه. |
| - وكان رجلاً ظريفاً جداً، ويحب أبا العلاء المعري كثيراً جداً. |
| - والعجيب أنه كان عالماً بالنحووالصرف بشكل عظيم، يعني يعتبر عالماً من العلماء، ولكنه لا يستطيع أن يكتب عبارة أكثر من سطرين، لقد رأيته يناقش أحد علماء النحوالمشهورين في شنقيط وقد أُعجب به إعجاباً بالغاً. وقال: هذا عالم في اللغة العربية والنحو والصرف. لكن الرجل إذا كتب لا يستطيع أن يكتب أكثر من سطرين، ثم يضيق صدره فيوكل إليَّ كتابة المذكرات الصادرة لمديرية الصحة. |
| - لم يكن عملي بالصحة مريحاً فقد كنت أتمنى الانتقال منه إلى غيره. فعندما أَعلنت الحكومة في جريدة "أم القرى" عن وظيفة مقيد أوراق، وكاتب آلة في مديرية الشرطة، قبل أن يطلق عليها مسمى الأمن العام. وكان مديرها مهدي بك الذي نقل من المدينة. |
| - ومهدي كان زوج ابنة العم يوسف بصراوي - الله يرحمه - الأمر الذي شجعني على تقديم أوراقي إلى مديرية الشرطة، لكن المسؤولين في الشرطة طلبوا مني أن أستقيل من الوظيفة التي كنت فيها لكي يضمنوا عدم معارضة الصحة. فتقدمت بطلب الاستقالة فرفضها بادئ ذي بدء، لكنه لما وجد إصراري أشَّر على طلبي بعبارة تقبل استقالته، وعلى الفور تقدمت إلى مديرية الشرطة. لشغل الوظيفة، وعقد امتحان لذلك ونجحت، وربما كان نجاحي في الامتحان مجاملة فقط. وعُينت مقيد أوراق في مديرية الشرطة العامة. |
| - قبل الاسترسال في سرد الذكريات، أريد أن أقول إن هذا الكلام قد سمعه الناس من قبل، وقد نشره السيد/ أيمن حبيب في "يوم الإِجازة". |
| ويعلق الأستاذ محمد حسين زيدان بقوله: |
| - لا بأس أن يعاد. |
| ويرد الأستاذ عزيز ضياء بقوله: |
| - ليس فيه ما يستحق الإِعجاب، ولكن هذا حسن ظن منكم بي فشكراً لكم. |
| - وتعالوا بنا نكمل الرحلة، كان مهدي بك رجلاً مخيفاً جداً. ومن خوف الناس منه كان البعض منهم لا يمر أمام الحميدية، وهومقر إدارة الشرطة، خشية أن يكون مهدي واقفاً في الشرفة العريضة أمام الباب، لأنه لا يطيق رؤية مهدي رغم أنه ليس عليه مأخذ، ولم تكن له سابقة مُشينة، لكنني لا بد أن أضيف أنه من الرجال الذين وطدوا الأمن في المملكة العربية السعودية، وعلى الأخص في مكة، وجدة، والمدينة. لقد وطد الأمن بجهد وسهر طويلين جداً، فلم يكن ينام الليل، بل كان يقوم بنفسه بأعمال الحراسة الدورية تقريباً، حرصاً منه على الأمن، وكان عدد الضباط الموجودين في تلك الأيام لا يزيد على خمسة ضباط هم: علي جميل - يرحمه الله - ومراد أفندي، وحمدي نظمي أفندي، وكان ضابطاً في الحرم، وإبراهيم الرشيد، وصالح باخطمة. خمسة فقط لا غير في مكة كلها من أولها إلى آخرها. |
| - وقد يتعجب المرء كيف يستطيع مدير الأمن العام وخمسة ضباط وما يزيد قليلاً على ثلاثمائة جندي أن يوطد الأمن في مكة، ومكة في الماضي تختلف عنها الآن. تخضع لنظام الحواري. إن الدخول في المشاكل وإثارة القلاقل فيما بين أبنائها بناء على أتفه الأسباب، وقد تصل إلى حد الاقتتال. |
| - وبعد مضي ستة أشهر أو يمكن سنة على التحاقي بالوظيفة كمقيد أوراق، احتاجت شرطة المدينة المنورة إلى كاتب ربط للتحقيق، فسألني مهدي بك قائلاً: هل ترغب في الذهاب إلى المدينة؟ فأجبته: كيف لا! وما ذلك عن رغبة، ولكن لأهرب من رؤيته، ومن صوته الذي يهدر باستمرار، والذي يخيف البلد كلها. ذهبت إلى المدينة والتقيت بالأساتذة عثمان حافظ، وعلي حافظ، والأستاذ/ محمد حسين زيدان، والسيد أمين مدني، وكانوا يفكرون في إصدار جريدة المدينة، والأستاذ/ ضياء الدين رجب أظن أنه كان مشاركاً لهم. وللتاريخ أقول: كان أول اجتماع للإِخوان الذي تم فيه مناقشة أوالتفكير في إصدار الجريدة كان في بيتي في المسيح، قريباً من بيت مأمون بري. |
| - وقد تداول الإِخوان الرأي حول إصدار جريدة "المدينة" وأنا مستغرب! كيف يمكن إصدار جريدة "المدينة" دون وجود مطبعة، ودون إذن حكومي بإصدار الجريدة. والجريدة الوحيدة التي كانت موجودة، أظنها صوت الحجاز، وربما أنها لم تبدأ بعد؟ |
| ويتدخل الأستاذ/ محمد حسين زيدان ليصحح الخبر، بقوله: |
| - بل بدأت. |
| ويؤيد الأستاذ عزيز قول الأستاذ/ الزيدان، بقوله: |
| - نعم تذكرت، لقد بدأت فقد كنت أكتب في صوت الحجاز. ثم توالت الجلسات لبحث الموضوع وقبل إتمامه سافرت من المدينة، وبعد سفري صدرت جريدة "المدينة" فعلاً بالجهد الذي تحدَّث عنه السيدان عثمان وعلي حافظ، والواقع أنهما بذلا جهداً كبيراً جباراً ليس فقط في سبيل إصدار الجريدة فقد يكون هذا سهلاً. لكن عملية طباعتها في المدينة، كانت خطوة عملاقة كبيرة جداً. |
| - ثم رجعت إلى مكة فقد طلب مهدي بك مني الرجوع إلى مكة ببرقية سريعة إلى العم يوسف بصراوي، قال له فيها: أرسل عزيزاً حالاً إلى مكة. وبمجرد مقابلتي له بعد وصولي مكة، قال لي: قررنا تعيينك ضابطاً، ثم كلف السيد يوسف جمال، بتدريبي مدة أسبوعين أوشهر، حاولت التهرب من العملية، والفكاك من الجندية بشتى الأعذار، لكنه هوّن عليَّ الأمر فقبلت، فكنت أتدرب مساءاً حتى استطعت أن أتقن حمل السلاح، وبعض العمليات العسكرية الضرورية. عند ذلك استصدر مهدي بك أمراً من الأمير فيصل بتعييني مفوضاً ثالثاً. ولم أكن أعلم ما يكمن وراء ذلك. لكنني لبست الزي العسكري وشعرت بأنني أصبحت إنساناً آخر. |
| - وللواقع أقول للشباب الذين سيواجهون الحياة، الزي العسكري وما يتبعه من إشارات الترقية تبعث في نفس الإِنسان إحساس بضرورة الانضباط، ولقد فرحت كثيراً عندما ارتديت ذلك اللباس العسكري، والذي يزيد الضابط انضباطاً تلك التحايا التي تؤدى له. ثم صرنا نركب الخيل أثناء تجوالنا وكان يتبعني ثلاثة خيالة ينفذون أوامري ويتقيدون بتعليماتي. لقد كان لعملي في الشرطة تأثير في نفسيتي ولعله صاحبني حتى اليوم. فأنا أزعم في نفسي وأزعم لأولادي ضياء وإخوته أنني منضبط جداً، وأتمنى أن يكون من حولي منضبطاً أيضاً، فأنا منضبط إلى حد أني أحياناً أضايقهم بهذا الانضباط. |
| - لكن لا أملك إلاَّ هذا. |
| - ومن الذكريات الجميلة التي لا زلت أذكرها عن عملي في الشرطة، ذكرى يوم العرض الذي أقيم بمكة المكرمة بجرول أمام القشله بعد حادثة المطاف التي قام بها اليمنيون، فقد قرر الملك عبد العزيز - رحمه الله -، إقامة عرض عسكري تشترك فيه الجياد التابعة للأمن العام، وكان يزيد عددها على خمسة عشر جواداً. وقد دعي لحضور العرض عدد كبير من الأجانب وقد أراد مهدي بك، والشيخ ابن سليمان من دعوة هؤلاء أن يظهروا لهم أن المملكة تملك قوة من العتاد، والفرسان قادرة على الدفاع عن الوطن. فأحضرت يوم العرض الأحصنة وكان عددها خمسة عشر حصاناً، وحضر الخيالة وكلهم من الضباط، وقد التقى الضباط بمهدي بك في اليوم السابق للعرض، وأفهمهم ما يجب أن يفعلوه خلال العرض. بحيث لا يدرك المشاهد أن عدد الأحصنة قليل، وذلك بطريقة تدور بها الأحصنة خلف مكان العرض وبينها مسافات معقولة، يتخيل المشاهد أنها أعداد كثيرة من الخيول متتابعة. |
| - وكان من الجياد التي أعدت للعرض، جواد شرس لا يستطيع أحد أن يمتطي ظهره. فاتفقنا معشر الضباط أن نتركه لكي يركب عليه مهدي، ومن جهة أخرى لنختبر مهدي بك. |
| - امتطى كل منا أحد الجياد وتركنا الجواد الشرس لمهدي بك. فلما حضر لم يكن أمامه سوى ركوبه، فامتطاه وتقدم الجميع وبقيت خلفه، دون أن يحس بي، وتأكدت أنه غير قادر على ترويض ذلك الجواد الشرس، وأنه لم يستطع أن يحسن الركوب عليه فتقدمت، ومنذ تلك اللحظة علمت أن مهدي بك لا يحسن ركوب الخيل، وازدادت ثقة مهدي بك بشخصيتي فطلب مني أن أتولى رئاسة المنطقة الثالثة بمكة، وكان يشغلها قبلي الشيخ/ صالح باخطمه - يرحمه الله - فقد كان رجلاً سمحاً، متساهلاً مع الشخصيات الكبيرة التي تتزعم المنطقة، وكانت المنطقة الثالثة من المناطق التي تكثر بها المضاربات، فبعد انقضاء أسبوع من تسلُّمي مهام رئاسة المنطقة وقعت حادثة شغب كبيرة في المنطقة، اشترك فيها عدد من الرؤوس الكبيرة في تلك المنطقة، فما كان مني إلاَّ أن طلبت من أحد العرفاء أن يصطحب معه عدداً من الجنود وأن يحضروا زعماء الشغب والمضاربة. فأحضروهم وكان أمراً مستغرباً! حضور هؤلاء الكبار. |
| - فقد كان الشيخ/ باخطمه في مثل هذه الحالات يقوم بسجن الصغار ويطلق سراح الكبار، ألقيت القبض على الكبار وجلدت الصغار، وأطلقتهم وظل الكبار في الحبس رهن التحقيق. صعب الأمر عليهم أن يبقوا في الغرفة فسألني أحدهم قائلاً: ما الذي تريده منا الآن؟ قال ذلك بأسلوب عنتريٍّ. قلت: سأرسلكم إلى الحميدية للتحقيق معكم. قال: كيف؟ قلت: عندي أمر بإرسال من يقوم بأعمال الشغب إلى هناك، قال: ومن أخبرك بأننا قمنا بمشاغبات؟ فأجبته: أخبرني رئيس الحرس بذلك، وقد أبصركم الجنود فعلاً والسكاكين في أيديكم، ولوأن واحداً منكم ضرب الآخر بالعصا التي بيده لقتله. |
| - ثم طلبت من أحد الجنود أخذهم لوضعهم في غرفة التوقيف واتصلت هاتفياً بمهدي بك وأعلمته بما حصل. طلب مهدي مني إبقاءهم عندي ساعة، أوساعتين ثم إرسالهم إليه. نفذت الأمر ثم قمت بإرسالهم إليه، فأخذ على كل واحد منهم تعهداً بعدم اللجوء إلى مثل هذه الأعمال مستقبلاً. في الواقع تأسفت لما حدث لكنها فورة الشباب، وسلطة الوظيفة التي جاءتني على حين غرة، ومن غير انتظار. ولو أني كلفت بهذه المهمة بعد عشر سنوات لتردَّدت كثيراً جداً في أن أرسل مشايخ كهؤلاء مخفورين إلى الحميدية، ومشياً على الأقدام. |
| - بعد هذه الحادثة، هدأت المنطقة، وتلاشت حوادث الشغب فيها إلى ما يقارب 70% عما كانت عليه. |
| - وفي تلك الأيام كنت أواصل الكتابة، كما صدر في تلك الفترة أيضاً كتاب "وحي الصحراء" الذي ألَّفه محمد سعيد خوجه (أبوعبد المقصود)، ومعالي الشيخ عبد الله بلخير، كما بدأنا خلال تلك الحقبة من الزمن نجتمع أنا وحمزة شحاته، وأحمد قنديل، وأحمد عباس - الله يرحمهم جميعاً -، وتكونت بذلك شلة اسمها شلة الأدب ومنهم حسين نظيف، كان سمكرياً، لكنه سمكري أديب يكتب عموداً بعنوان (من ثقب المجتمع)، وكنا عشاق أدب من الطراز الأول، نجتمع عند حسين نظيف في خلوته في باب زياده مع عدد كبير من أكابر القوم في ذلك الوقت، ومنهم محمد سعيد عمودي ومحمد سرور الصبان، وعبد الوهاب آشي، وفي هذه الخلوة تدور أبحاث عن الأدب والشعر، وعن السياسة، وعن الأوضاع، ويتزعم المناقشة محمد سرور الصبان، وكنا معشر الشباب نساهم بقولنا نعم أو لا. |
| - لكن كان محمد سرور - رحمة الله عليه - في تلك الأيام، وإلى أن مات زعامة وقيادة فعلاً. زعامة لا تنكر، له شخصية عجيبة جداً. لقد كان الرجل نحيف الجسم، لونه أسمر يميل إلى السواد لكنه مهاب وذو شخصية، إذا تحدث يحثك على أن تصغي إليه. |
| يعلِّق الأستاذ/ محمد حسين قائلاً: |
| - (كانت طبيعة الحياء فيه تحثك على الاستحياء منه). |
| ثم يواصل الأستاذ/ عزيز حديثه عن معالي الشيخ محمد سرور الصبان، قائلاً: |
| - إذا كان محمد سرور في مجلس، فهو رئيس المجلس، فهو الذي يتكلم، وهو الذي يبدأ الحديث ويدير الحوار. فعندما فكر أبوعبد المقصود والأستاذ عبد الله بلخير في تأليف كتاب وحي الصحراء فرحنا بالفكرة طبعاً، وبدأنا نجتمع في منزل محمد سعيد عبد المقصود، في شعب عامر. |
| - وكان الأستاذ عبد الله بلخير، ما يزال يخاف من الظلام، فكثيراً ما يحضر إلى مقر الشرطة، ويطلب مني أن أرافقه في الذهاب إلى منزل محمد سعيد خوجه وكنت على علم بخوفه من الظلام، وكان لنا صديق اسمه الشريف سيف بن ناصر يعرف كذلك خوف عبد الله من الظلام، فيختبئ أحدنا في السلالم، ونفاجئ الأخ عبد الله فيصرخ خائفاً وينطلق. |
| ويتدخل معالي الشيخ عبد الله بلخير قائلاً: |
| - وكيف يخاف من يكون رفيقه في الدرب ضابط ملء الدنيا؟ |
| فيجيب الأستاذ عزيز على ذلك بقوله: |
| - والله أنا قلت إنه يخاف من الظلام، والبيوت في تلك الفترة لم يكن بها مصابيح. ولقد أتاح منزل الأستاذ/ محمد سعيد عبد المقصود المضاء بالأتاريك، فرصة التقاء مجموعة من الشباب في الليل، هم: حمزة شحاته، أحمد قنديل، وعزيز ضياء، ومحمد سعيد عبد المقصود، وعبد الله بلخير، وأحمد خليفة النبهان. وفي تلك الفترة نشأت المشكلة التي لم تُعرف أسبابها حتى الآن بين حمزة شحاته ومحمد سرور الصبان. كل الذي أعرفه، أن محمد سرور أرسل إلى مؤلِّفَي "وحي الصحراء" مجموعة من القصائد لا أذكر عددها، وطلب نشرها في الكتاب. اعترض حمزة شحاته على إحداهن وهي فضلاهن من حيث الأسلوب والبلاغة وفيها يبرز حسّ الشاعر. زعم حمزة شحاته أنها ليست من شعر محمد سرور الصبان دون أن يبين الأسباب ودون أن يجزم بنسبها إلى شخص معلوم. |
| يتدخل الأستاذ محمد حسين زيدان قائلاً: |
| - القصيدة لحسين الصبان اشتريت بسبعة ريالات مجيدي. |
| يستمر الأستاذ عزيز ضياء في الحديث، قائلاً: |
| - أصرَّ حمزة على عدم نسبة القصيدة لمحمد سرور ويجب ألاَّ تقترن باسمه، إذا نشرت في كتاب "وحي الصحراء". وبالفعل لم ينشر لحمزة شحاته شعر في الكتاب. |
| ويثير الأستاذ محمد سعيد طيب سؤالاً سبق أن طرحه الأستاذ/ عبد المجيد شبكشي، وهو: |
| - لماذا لم يشتمل كتاب "وحي الصحراء" على نماذج من شعر كل من محمد حسن عواد، وحمزة شحاته؟ |
| يجيب الأستاذ/ عزيز قائلاً: |
| - أسباب عدم اشتراك العواد في الكتاب ترجع إلى أن محمد سعيد عبد المقصود حين كان يصدر جريدة "أم القرى"، كانت تربطه علاقة قوية بكل من يوسف ياسين، ورشدي ملحس، وفؤاد حمزة وكيل وزارة الخارجية آنذاك، وقد سبق للعواد إصدار كتاب "خواطر مصرحة" قبل أن يصدر كتاب "وحي الصحراء". وقد هاجم في كتابه "العلماء"، وحركة الجمود، ودعا إلى تطور الحياة، وتعليم المرأة، وما شابه ذلك مما يعتبر في تلك الأيام ثورة. كما هاجم ضعف اللغة العربية الكامن في أساليب الصنعة الممقوتة التي كانت سائدة إبان القرون السابقة التي تقع ما بعد المائة الرابعة من الهجرة. |
| - وقد كاد أن يسجن على ما احتواه كتابه المذكور. وقد صودر الكتاب ولم يتم توزيعه. |
| - ومن الذين طالبوا بمحاكمة محمد حسن عواد، وسجنه الأستاذ/ يوسف ياسين، والأستاذ رشدي ملحس، لأنهما كانا يريان أن العمل الذي قام به محمد حسن عواد، ليس تطرفاً ولكنه غير مقبول ظهوره في تلك الفترة لأن الدولة كانت ما تزال في طور التأسيس، ولذلك فقد شعر محمد سعيد عبد المقصود أنه سيكون موضع انتقاد من فؤاد حمزة، ورشدي ملحس ويوسف ياسين لو قام باستكتاب محمد حسن عواد. |
| - ولا ننسى أن إخواننا السوريين في ذلك الوقت كانوا مستشارين للملك عبد العزيز - يرحمه الله - فهم الذين يبدون الرأي، وهم الذين يتصرفون، وربما لهذا السبب قرَّر محمد سعيد عبد المقصود عدم اشتراك محمد حسن عواد. وقد يكون الأستاذ عبد الله بلخير أكثر علماً مني بذلك. |
| وهنا أدلى معالي الشيخ عبد الله بلخير بدلوه، وقال موضحاً بعض النقاط التي يجهلها الكثير: |
| - عندما بدأت مع صديقي محمد سعيد نفكر في إصدار الكتاب ووضعنا العواد في رأس قائمة الذين سوف نطالبهم بإرسال مشاركاتهم، وأرسلت دعوات خاصة مطبوعة لكل الأدباء والشعراء المعروفين بما فيهم محمد حسن عواد. لكن العواد كانت له مواقف كثيرة مع محمد سعيد عبد المقصود منها: ما أشار إليه الأستاذ عزيز ضياء في حديثه، ومنها قصيدة له نشرت في جريدة "البلاغ"، أثارت الشيخ رشيد رضا. وكان له في تلك الأيام المكانة الكبرى. كما أثارت محب الدين الخطيب الذي علَّق عليها في جريدة "الفجر". فاجتمعت المشاكل كلها في وقت واحد، وقد تألمت والأخ محمد سعيد تعصباً للعواد. لم نتألم لشيء أكثر مما تألمنا مما جاء في المقال الذي نشر في جريدة "الفجر" بقلم محب الدين الخطيب الذي خاطب فيه الملك عبد العزيز طالباً منه أن يضع حداً للشباب من أبناء مكة الذين يقومون بتصدير مثل هذه الأمور. |
| - لذلك أخذنا هذا بعين الاعتبار. ومن الصدف أن يأتي رشيد رضا للحج في تلك السنة، ويثير الموضوع، وأشار على المسؤولين بأنه ينبغي ألاَّ يصدر شيء من مهبط الوحي إلاّ بإذن، ومن هنا نشأت المراقبة على المطبوعات، ولم تكن في السابق دائرة للمراقبة. |
| - وعلى ضوء ذلك وضع العواد تحت المراقبة كما تعرفون. |
| يتدخل الأستاذ الزيدان بقوله: |
| - حتى أن مجيئه موظفاً إلى الشرطة كان تحت المراقبة. وليكون ملتزماً. |
| يتابع الشيخ عبد الله بلخير حديثه: |
| - ومن هنا يتضح أن الأخ محمد سعيد ليس له دخل في الموضوع. |
| يعترض الأستاذ الزيدان بقوله: |
| - كما قلت سابقاً إن فرصة حمزة شحاته في كسر ظهر العواد هو موقف العواد الضعيف. |
| يسأل الشيخ عبد الله بلخير قائلاً: |
| - ما هودخل حمزة شحاته في هذا الموضوع؟ |
| كما يسأل الأستاذ عزيز بقوله: |
| - وما هوالموقف الضعيف؟ |
| فيجيب الأستاذ الزيدان: |
| - إن الحكومة تكرهه! فحمزة كان صاحب منصب والعواد كان ضعيفاً. |
| وهنا يسأل الأستاذ عزيز أيضاً: |
| - هل تعني أن حمزة قد استغل موقف العواد من الدولة فكسر ظهره؟ |
| فيجيب الأستاذ الزيدان: |
| - هذا يقين لا شك فيه وقد حققت ذلك. |
| فينكر الأستاذ/ عزيز على الأستاذ محمد حسين زيدان مقولته برده: |
| - لا. إن حمزة أكبر من هذا يا أستاذ زيدان. |
| يؤكد الأستاذ زيدان بقوله: |
| - إنَّ العواد استغل. |
| ويؤكد الأستاذ عزيز رأيه المعارض بقوله: |
| - إن حمزة لا يستغل مواقف الضعف في إنسان أبداً. حمزة أكبر من ذلك والكل يعرف هذا في حمزة - رحمه الله -. |
| ويتقدم الأستاذ أمين بسؤال إلى الأستاذ عزيز قائلاً: |
| - حينما أصدر الدكتور الساسي كتابه "شعراء الحجاز في العصر الحديث" كتب مقدمة له حمزة شحاته، وفي هذه المقدمة نجد صفحة دارت حول المقدمة التي كتبها محمد سرور الصبان في كتاب "الشعراء الثلاثة". وقد وصف حمزة الشيخ محمد سرور الصبان في تلك الصفحة بقوله: الأستاذ الكبير الشاعر، وهو يعلم أنه كان ضمن المجموعة. فهل غيَّر حمزة موقفه من شاعرية محمد سرور الصبان؟ وهل اقتنع بأن محمد سرور هو صاحب القصيدة التي أنكرها سابقاً؟ |
| يرد الأستاذ عزيز قائلاً: |
| - موقف حمزة شحاته من القصيدة معروف فقد قال: إنها ليست لمحمد سرور. هذا موقف ثابت يعرفه الأستاذ بلخير كذلك. |
| السائل يكرر سؤاله قائلاً: |
| - المطلوب يا سيدي أن نعرف موقف حمزة شحاته عندما كتب المقدمة. |
| الأستاذ عزيز يرد بقوله: |
| - أنا لا أعتقد أنه وصف محمد سرور بأنه شاعر. |
| السائل يقول: |
| - بل المقدمة التي في الكتاب تثبت ذلك. |
| يتدخل الأستاذ الزيدان بقوله: |
| - هذا صحيح. |
| ويحاول الأستاذ عزيز أن يقول قولة فاصلة، فقال: |
| - إن المقدمة التي كتبها حمزة شحاته لكتاب الدكتور الساسي "شعراء الحجاز في العصر الحديث" أظن أنني قرأتها قبل بضعة أيام، ولا أتذكر أنني قرأت فيها كلمة الشاعر الكبير الأستاذ محمد سرور، على أنني أود أن أشير إلى الزوبعة التي ثارت بين حمزة وبين الدكتور الساسي، بصدد محمد سرور لأن حمزة شحاته تناول محمد سرور بما لا يليق ولا يرضى عنه محمد سرور. فالساسي حذف الجملة التي تمس محمد سرور من المقدمة. فاضطر حمزة أن يبرق برقية من القاهرة، يقول فيها: إن المقدمة التي تضمنها كتاب الساسي لم تكن كذلك. وظلَّت القضية مثار نزاع بينهما، إلى أن مات حمزة. |
| يعلِّق الأستاذ محمد حسين زيدان بقوله: |
| - أنا لا أعرف أحداً من أصدقاء محمد سرور، أكثر احتراماً للأستاذ محمد سرور في حضرته من حمزة شحاته. |
| - وإنني أشهد أنَّ حمزة كان كثير الاحترام لمحمد سرور، بينما هو كثير السبّ له، ولكنه لا يرضى أن يسبّه أحد. لأنه لا يرى أحداً أكفأ من حقه أن يسب محمد سرور الصبّان. |
| ويتدخَّل الشيخ/ عبد الله بلخير بقوله: |
| - نريد أن نتم الإِجابة على السؤال الذي أثير قبل قليل ونصّه: لماذا لم يشتمل كتاب "وحي الصحراء" على نماذج من شعر حمزة شحاته؟ |
| للإِجابة على هذا السؤال أقول: |
| - الواقع أنه بعد أن استلم الدعوة للمشاركة في محتويات مؤلفنا، وقد كنا نراه أبرز واحد في المجموعة لكنه رفض أن يتجاوب معنا للظروف التي كانت سائدة حينذاك. لم يكتب لنا رغم إلحاحنا عليه، وقد توجَّه محمد سعيد إلى بيت العتابي أحد أصدقائه ليقنعه في أن يرسل لنا شيئاً، فأجابه بالرفض. وكنا نحاول الحصول على شيء من إنتاجه حتى لا يظهر الكتاب دون أن يذكر فيه العواد، وهذا الواقع، فإذن العواد هو نفسه الجواب على السؤال المطروح لأنه واجه أمامه المشاكل والقصيدة والخواطر، وغيرها فرفض الاشتراك. |
| يعلِّق الأستاذ محمد حسين زيدان بقوله: |
| - أنا أشهد أن يوسف ياسين كان شديد الحملة على العواد فيما مضى، ولكنه كتب إلي عندما كنت رئيس تحرير "البلاد"، أن أعين العواد رئيساً للتحرير معي، أو مديراً للتحرير وأن أتحدث إلى العواد في ذلك. |
| ويضيف الأستاذ/ عزيز قائلاً: |
| - هذا لا يتنافى مع موقف يوسف ياسين في العواد. لأن المسألة ليست موقف الدولة بالذات في تلك الأيام بالنسبة لكتاب يعالج، مثل تلك المشاكل التي تعرض العواد لعلاجها. ثم تشعَّب الحديث بين الحاضرين، واختلطت الأصوات فما يكاد السامع يسمع شيئاً. |
| وهنا انطلق صوت أحد الحاضرين سائلاً: |
| - هل الأستاذ العواد أول من كتب أو دعا إلى تعليم المرأة؟ |
| فيرد الأستاذ عزيز بقوله: |
| - نعم أول من كتب يدعو لتعليمها. |
| ويعلِّق الأستاذ/ محمد زيدان بقوله: |
| - إنما أول من قام بتنظيم ذلك هي السيدة خوجه هانم، ويؤكِّد الأستاذ عزيز بقوله: المرأة كانت تتعلم في المدينة على يد السيدة خوجه هانم، ثم توجهت السيدة خوجه هانم إلى مكة. لكن العواد هو أول من كتب يدعو إلى تعليم المرأة، وأثار في كتاباته صوراً عديدة وعجيبة جداً. |
| يعلِّق معالي الشيخ عبد الله بلخير بقوله: |
| - الأستاذ أحمد السباعي كتب رسالة باسم بنت، وأنا عملت نشيداً أيضاً في وجوب تعليم الفتاة، فكل الناس كانت تراودهم هذه الخواطر. |
| - ثم طلب المستمعون أن يواصل الأستاذ عزيز الحديث عن ذكرياته. |
| فيرد الأستاذ عزيز قائلاً: |
| - وماذا أكمل فقد انتهى كل شيء؟ لقد انتهينا من كل ما يتعلق بموضوع (وحي الصحراء) ولوأردنا الدخول في نقاش النقاط الهامشية. لظللنا نتحدَّث أياماً وليالي دون الوصول إلى نهاية مقنعة. |
| - غير أن الدكتور عبد الله منّاع حاول استدراج الأستاذ عزيز للحديث عن جوانب أخرى من حياته الأدبية. |
| فسأل المحتفى به قائلاً: |
| كيف استطعت وأنت ضابط بالشرطة أن تجمع بين العمل في الشرطة وبين الكتابة في الصحافة؟ |
| فرد الأستاذ عزيز بقوله: |
| - دعني أعد بالذاكرة خطوة إلى الوراء. كان لسجن حمزة شحاته، وعبد الوهاب آشي، ومحمد حسن عواد، وعبد العزيز في الرياض أيام ثورة ابن رفادة ضجة كبيرة. ولما رجعوا بعد إطلاق سراحهم، - لم أكن في تلك الفترة على معرفة بحمزة شحاته -، شاءت الصدف أن أكون برفقة الشيخ باخطمه، فإذا به يشير إلى شاب طويل، أنيق، يضع الشال على كتفه بأناقة ويقول: هذا أبو عرب. فقلت له: من هو أبو عرب؟ فقال: إنه حمزة شحاته، منذ تلك اللحظة عرفت حمزة شحاته، ولما التقينا صافحته وسأله الشيخ باخطمه عن وجهة سيره، فقال: إنني ذاهب إلى الأخ عبد الوهاب، فقد خرج منذ يومين من السجن. وسهرنا عند عبد الوهاب حتى قرب الفجر، وخضنا في مواضيع كثيرة جداً منها الأدب، ومنها الشعر، وكانت تلك الليلة أوَّل معرفتي بحمزة شحاته - الله يرحمه -، ومن ذكرياتي الأولى مع الكتابة أذكر أنني نشرت في "وحي الصحراء" بعنوان: (نريد رجالاً)، مما دعا مهدي أن يستدعيني إلى الحميدية، ويسألني عن معنى (نريد رجالاً). فقلت له: هذا عنوان مقال كتبته. فطلب مني عدم الكتابة مرة ثانية، ولكننا لم نتوقف عن الكتابة، بعد تلك الليلة قويت عرى الصداقة بيننا، وبدأنا نجتمع أنا وحمزة وقنديل. وذلك قبل أن ينضم الأخ محمد عمر توفيق، لأنه كان لا يزال في ذلك الوقت مقيماً في المدينة. |
| - وعلى فكرة. فمحمد عمر توفيق أصغر مني سناً وأصغر من الأستاذ/ زيدان بكثير، وهو أصغر من السيد ياسين طه، وكان أول لقاء لي به عندما زرت المدينة المنورة واطَّلعت على مقال منشور في جريدة المدينة بتوقيع راصد، فأعجبني المقال! فسألت السيد علي حافظ عن كاتب المقال، وأثناء حديثي هذا مرَّ من أمامنا شاب صغير، فقال لي السيد علي حافظ: هذا هو راصد فتعرفت عليه في تلك اللحظة. |
| - وكان في صغره كثير الانطواء، غير منطلق اللسان، وعندما جاء مكة واشتغل في المطبعة مع الأخ محمد سعيد أصبحت الشلة تتكوَّن: منِّي ومن الأستاذ حمزة - الله يرحمه - وأحمد قنديل، ومحمد عمر توفيق. ثم انضمَّ إلينا بعد ذلك العريف وتبعه الزمخشري، والأستاذ زيدان، حينما جاء مكة كان مشغولاً بوظيفته فلا نراه إلاَّ لماماً، فهو من الناس الذين لم يشاركونا الحضور في مركزنا الواقع في المسفلة والذي نعتبره مركزاً أساسياً نجتمع به في العصر، إذا لم نكن مقيَّدين بعمل، ونحن أغلب الأحيان نمشي مشياً، وكانت وسيلة ركوبي من بيتي في زقاق الوزير بسوق الليل إلى المسفلة إلى قهوة خليل البخاري هي: أقدامي، وكنا نقضي الساعات الطوال هناك من العصر إلى صباح اليوم الثاني، بل ننام أحياناً، وقد اتخذنا جبلاً بالقرب من المقهى أطلقت عليه "الأولمب"، وقد شهد الأولمب الأهاجي التي دارت بين حمزة وقنديل من جهة، وبين العواد - الله يرحمه - من جهة ثانية وكان الساسي يحفظ جميع القصائد ولا أدري كيف يحفظ؟ |
| أحد الحضور يسأل الأستاذ عزيز عن أسباب تلك الأهاجي؟ |
| فيرد الأستاذ/ عزيز بقوله: |
| - والله لا أعرف حتى الآن أسبابها، ولا عنيت بالبحث عنها فقد كانت المهاجاة عنيفة جداً. وكان الأستاذ الساسي يتولى إلقاء القصائد بنفسه، فإذا انتهى من قصيدة حمزة شحاته مثلاً، أنشد قصيدة محمد حسن عواد أو العكس، وكان يهتم بكتابة تلك القصائد جداً، ويعنى في توجيه أنظار المتابعين لتلك المهاجاة. فلقد قام حقاً بدور كبير جداً ولهذا أرجو الناس الذين يعرفون المرحوم عبد السلام الساسي أن يطالبوا ذويه بطباعتها، ولقد رأيتها ذات مرة مكتوبة على الآلة الكاتبة عندهم. وهو الذي أراني إياها بنفسه. |
| الشيخ عبد الله بلخير يقول: |
| - في رأيي أنها موجودة عند عائلته، فقد حدَّثني بعض الأخوة، غير أنني لا أتذكر من هو، بأنهم طالبوا عائلته بتلك الأهاجي فأجابوهم بقولهم: إننا سوف نبحث عنها، فإن وجدناها أعطيناكم إياها. |
| بعض الحاضرين أشار إلى أن هذه الأهاجي ربما تكون محفوظة عند عبد الحميد مشخص. |
| فأجابه الأستاذ/ عزيز بقوله: |
| - لا أظن ذلك لأن عبد الحميد مشخص ما صار صديقاً لحمزة إلاَّ في مصر، فلم نره في المركز ولا أيام الأولمب. |
| ويتدخَّل الشيخ عبد الله بلخير بقوله: |
| - لكنه كان يتتبع آثاره لا سيما في العشرين السنة الأخيرة. |
| ويرد الأستاذ عزيز قائلاً: |
| - هذا صحيح، ولكن الأهاجي مدار البحث كانت قبل أكثر من ثلاثين سنة. |
| ويضيف الأستاذ الزيدان قائلاً: |
| - إن حمزة لم يعطِ لعبد الحميد مشخص شيئاً من ذلك. |
| ويؤكد الأستاذ عزيز ذلك بقوله: |
| - حقاً إنه لم يعطه شيئاً. |
| الأستاذ محمد سعيد طيب يشارك بقوله: |
| - إن السيدة نجاة ابنة الأستاذ العواد قالت إنها تحتفظ بالأهاجي الخاصة بوالدها، وعندما طلبناها لنشرها قالت إنها فُقدت ولم نعثر عليها. |
| ويعلِّل الأستاذ عزيز رفض السيدة نجاة بقوله: |
| - إن لها حقاً في عدم إظهار تلك الأهاجي ففيها إقذاع، وإن يكن ذلك الإِقذاع فيه بلاغة وفن. تذكرنا بأهاجي جرير والأخطل وفحول الشعراء الأقدمين، وبعض تلك الأهاجي قد تم نشرها بجريدة "صوت الحجاز". |
| ثم يوالي الأستاذ عزيز إجابته على سؤال الدكتور عبد الله مناع حول استطاعته التوفيق بين عمله كضابط في الشرطة وكاتب في الصحافة، فقال: |
| - على أنني أود أن أضيف إلى أنني رغم وظيفتي كضابط في الشرطة إلاَّ أنني لم أغفل القراءة. فقد كنت أمر على ضوء الفانوس الهندي داخل الكلَّة في زمن القيظ ليالي عديدة دون كلل أو ملل، وكنا نقرأ كل شيء دون تخصُّص لدرجة أننا كنا نقرأ كل كتاب يقع في أيدينا، ومن ذلك أننا قرأنا كتاباً صدر في علم السياسة للسيد محمد وفيق من ألف صفحة، لا علاقة له بميولنا، وقد شاركني في قراءته حمزة شحاته، سهرنا عدة ليالي وأيام. نداوم على قراءته من بعد الظهر إلى قرب العصر، ثم نعود ثانية في الليل، من بعد العشاء إلى الصباح. ولقد أفادنا في النهاية، رغم أننا قرأنا فيه أشياء لا لزوم لها في حياتنا اليومية أبداً، في تلك الأيام. ومن الأشياء المضحكة أننا شاهدنا فيلم الوردة البيضاء ولا أدري كيف حصلت على الأسطوانات الخاصة بالفيلم، وكان الاستماع أو مشاهدة الأفلام ممنوعاً في تلك الفترة، مما جعلنا نملأ مكبرات صوت الحاكي بالقطن المبلل. حتى لا يستطيع أحد أن يسمعه وما علينا إلاَّ أن نتصور الفرق بين ذلك الوقت وبين الاستريو والفيديو ونظائرهما مما نرى هذه الأيام. |
| يسأل أحد الحضور الأستاذ/ عزيز ضياء قائلاً: |
| - أرجوأن تحدِّثنا عن طريقة تعلمك اللغة الإِنجليزية وكيف بدأت؟ |
| فيجب الأستاذ عزيز قائلاً: |
| - إن الذي حبَّب إليَّ اللغة الإِنجليزية في الواقع هو رجل اسمه سعد الدين بشار كان جارنا، سمعته ذات يوم يتحدَّث إلى شخص هندي، يدعى يوسف علي، بلغة سحرني منه إخراج ألفاظها بطريقة تستحوذ على لب المستمع وتؤكد له أن المتحدِّث متقن للغة ومتمكن منها. |
| - فسألت سعد الدين أفندي قائلاً: ما هذه اللغة التي كنت تتحدَّث بها إلى السيد يوسف علي؟ فأجابني إنها اللغة الإِنجليزية. فسألته حينئذٍ هل يمكن أن تعلمني؟ فقال: سأعلِّمك لكن لو استطعت أن تعمل على أن ينضم أكثر من واحد لنستفيد، وبالفعل حاولت مع بعض الإِخوان المشتغلين بالتجارة حتى أقنعتهم على الانضمام معي في دراسة اللغة الإِنجليزية عند سعد الدين بشار. وبدأنا فعلاً نتعلم اللغة الإِنجليزية، واستمرت دراستنا تقريباً ثلاثة أشهر. |
| - وبعد انقضاء ثلاثة أشهر اعتذرنا لسعد الدين أفندي، قلت له: إنني أرغب أن تأتي إلى منزلي لتعلمني الإِنجليزية بدلاً من مجيئي إليك مقابل خمسة ريالات شهرياً، وبدأت الدراسة معه، ونظراً لتعشقي اللغة الإِنجليزية، فقد كنت أحفظ يومياً مائة كلمة ويختبرني فيها قراءة، وكتابة، وتهجياً ومعنى، غير أني سمعت مرة رجلاً يتحدث باللغة الإِنجليزية بطريقة تختلف تماماً عن لهجة سعد الدين أفندي ويوسف علي. |
| - جلست أفكر، وأسأل نفسي ماذا أفعل حتى أتقن اللغة الإِنجليزية؟ كان المذياع قد تم اختراعه في تلك الفترة وبدأ تسويقه. فكنت أستمع إلى الأخبار في البداية فلم أفهم شيئاً مما قيل، ولكن اللهجة أعجبتني، ومن ثم بدأت أحرص على أن أقوم مبكراً في ميعاد الإِذاعة، صباحاً أومساءاً أسمع الأخبار، وازداد تعلقي بها وعشقي لها. |
| - ووجدت أن خير وسيلة قد تمكنني من إتقان اللغة الإِنجليزية نطقاً وكتابة وقراءة، هي: أن أقوم بحفظ كلمتين أو ثلاث وترديدها بنفس اللهجة التي تحدث بها المذيع. وبالفعل فقد أدَّى هذا العمل دوره في تحسين لغتي، ثم سافرت بعد ذلك إلى الهند لأعمل مذيعاً مترجماً بإذاعة دلهي الجديدة، مما كان له الأثر في انطلاق لساني. |
| فيسأل أحد الحضور قائلاً: |
| - ما الذي دعاك إلى السفر إلى الهند؟ |
| يجيب الأستاذ/ عزيز بقوله: |
| - لقد قلت: إنها حكايات لن تنتهي، ولوأخذت أتحدث عنها لاستغرق ذلك مني وقتاً طويلاً. |
| - ولكن دعوني أذكر لكم الأسباب باختصار، تبدأ الحكاية بعد ترقيتي إلى مفوض ثان إثر النجاح الذي حققته في المنطقة التي كنت أعمل بها وما تبع ذلك من استتباب للأمن، في تلك الأيام تم افتتاح مدرسة تحضير البعثات فكنت أول من قدم طلب للالتحاق بها، وعند تقديم طلبي، سألت السيد/ إبراهيم نوري - الله يرحمه - ما هي المواد التي يتعلمها الطالب في هذه المدرسة؟ فأجابني: الجبر والحساب والإِنجليزي. فسألته سؤالاً آخر هو: وما عدد السنوات التي يجب أن يقضيها الطالب حتى التخرج؟ فقال: أربع سنين، قلت له: ألا يستطيع الإِنسان أن يؤدي الاختبار في مناهجها كلها في سنة واحدة، فقال: يظهر أنك مجنون. قلت له: هذا مجرد سؤال هل يمكن تحقيق ذلك أم لا؟ فقال لي: والله إذا كان هناك طالب مجتهد فهو يستطيع أن يحقق ما يريد، فقلت له: إذن أنا سأحقق ذلك. قال: وكيف؟ قلت له: لقد استقلت من الشرطة لكي أتمكن من دخول مدرسة البعثات، غير أني الآن قررت الذهاب إلى القاهرة لدراسة المرحلة الثانوية هناك ودخول الامتحان النهائي هذا العام على أساس نظام الطلاب المتقدمين من منازلهم. وبالفعل ذهبت إلى القاهرة والتحقت بمدرسة الخديوي إسماعيل. وأدَّيت الاختبار نهاية العام، ولكني لم أوفق فقد رسبت في مادة اللغة الإِنجليزية التي أحسب نفسي أنني أكثر إجادة لها من أية مادة أخرى. ثم عرفت بعد ذلك سبب رسوبي، فالمدرِّس الذي كان يقوم بتدريسي اللغة الإِنجليزية لم يرشدني إلى المواضيع الهامة، التي كثيراً ما تدور حولها الأسئلة، ولم يعطني نماذج لكثير من الأسئلة التي تضمنها الكتاب المقرر، وذلك خلاف ما كان يقوم به مدرس اللغة الفرنسية التي حققت فيها درجة متقدمة، ورسوبي هذا كان سبباً في إيجاد مشاكل صعبة، أحاطت بحياتي كانت نتيجتها قلة مواردي. |
| - ولكن الله لا يترك عبده، فما تضيق على المرء إلاَّ ويتبع الله بعد العسر يسراً، فقد قرأت أم ضياء في الأهرام إعلاناً مفاده أن السفارة الهندية تحتاج إلى مذيع يجيد الترجمة من الإِنجليزية إلى العربية وبالعكس. |
| - قالت لي: هل قرأت هذا الإِعلان؟ قلت لها: ما رأيك؟ قالت لي: بل أنت ما رأيك؟ قلت لها: نتوكل على الله، أليس ذهابنا إلى الهند أحسن من بقائنا؟ قالت: بلى لقد أصبتَ. وكتبت على الفور طلباً إلى السفارة الهندية. ومن العجيب أنني نجحت في الامتحان الذي أعدّ لذلك وتوجهنا إلى الهند هرباً، أو لجوءاً، أو طلباً للرزق كما قال الأستاذ الزيدان، وظللت أعمل هناك 22 شهراً، والعجيب أنه منذ اليوم الأول الذي دخلت فيه الإِذاعة في الهند، كلِّفت بإذاعة نشرة الأخبار بعد ترجمتها. ولقد لقيت مشقة في البداية في عملية الترجمة واستغرقت وقتاً طويلاً، ولكني استطعت التغلب على ذلك بالحضور المبكر قبل ميعاد النشرة بنصف ساعة تقريباً أتمكن خلاله من إعداد ترجمة الأخبار. وقد أنيطت بي مسؤولية ترجمة الأخبار وإذاعتها منذ وصولي حتى مغادرتي الهند وعودتي إلى المملكة بما في ذلك أيام الإِجازات والأعياد إذ لا يوجد شخص غيري يستطيع القيام بتلك المهمة. |
| - هذه هي القصة كاملة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والعجائز يكثر هرجهم، ولوتركتم لي المجال، لحدثتكم من الآن إلى ما بعد الغد. ولكني لا أحب أن يضيع وقتي في ذكريات لا تغني ولا تسمن من جوع. |
| يعلِّق الشيخ عبد الله بلخير بقوله: |
| - ولكنها أسفار يا أستاذ. |
|
|
|
|
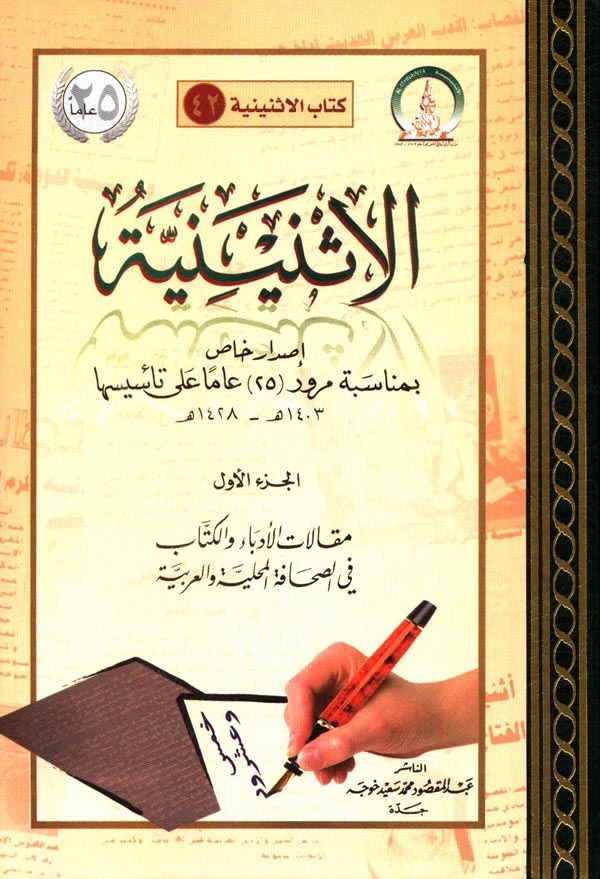
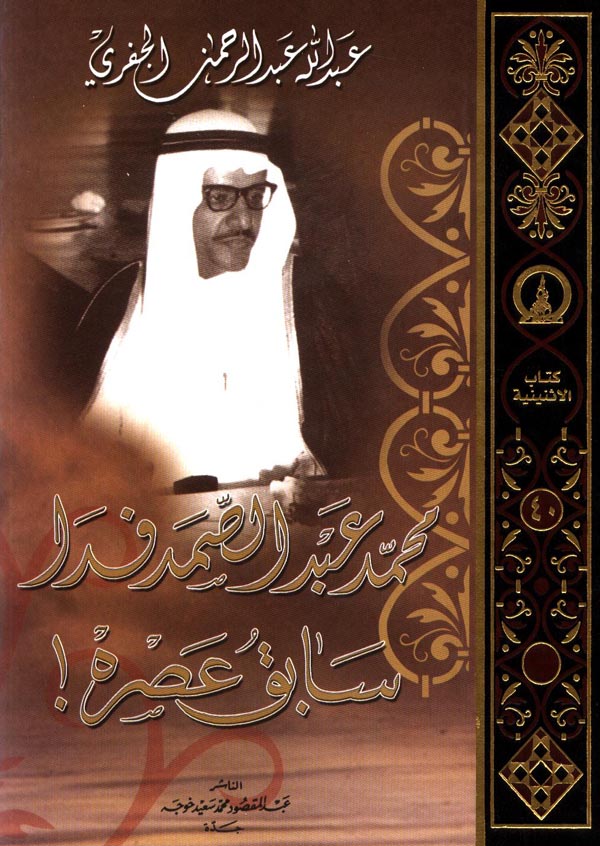
 شارع عبد المقصود خوجة
شارع عبد المقصود خوجة 00966-12-6982222 - تحويلة 250
00966-12-6982222 - تحويلة 250




