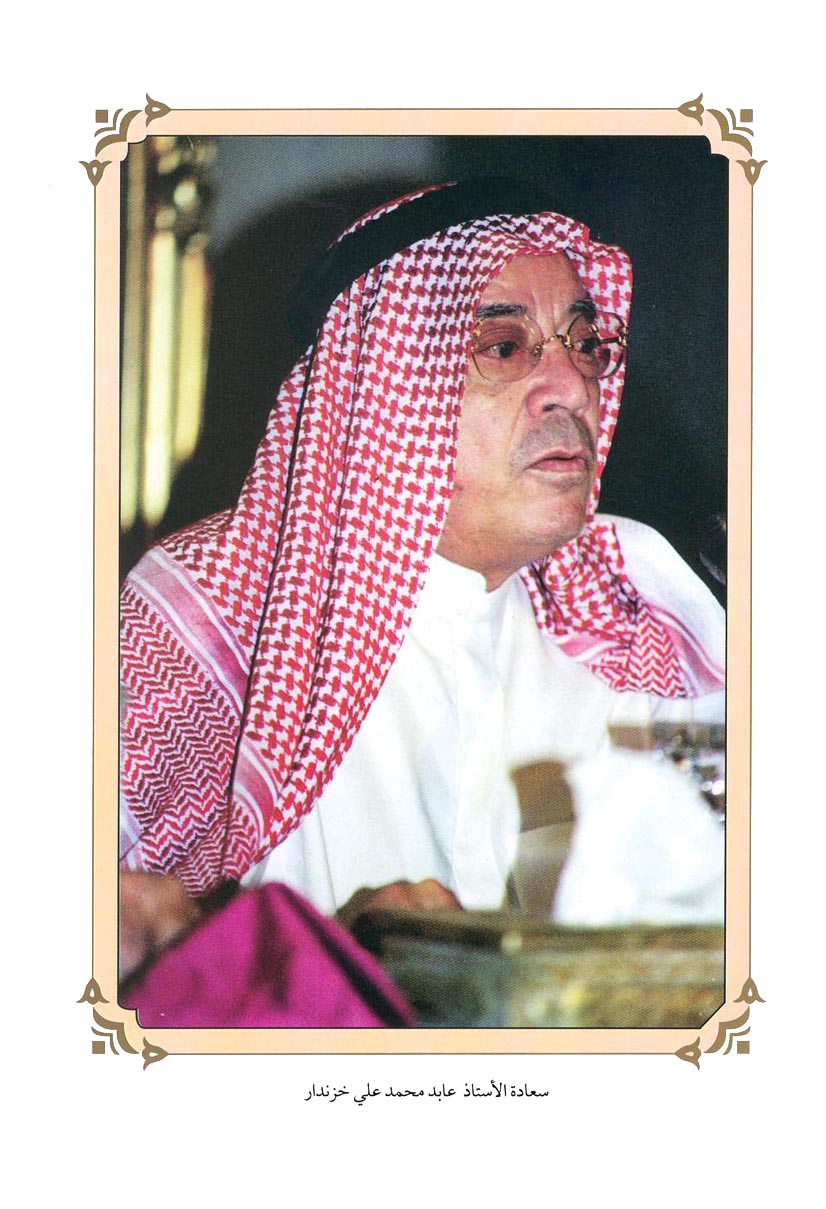| اللقاء بيني وبين زوجها.. |
| لم يكن احساسي بالغربة من ذلك النوع السطحي الذي يمكن أن يزيله ذلك الترحاب، أو الشعور الطيب الذي قابلني به زوجها الدكتور في أول لقاء.. وبعد أن فرغنا من تناول الفطور وقد حاول أن يحملني على الكلام ببعض الأسئلة عن الشام، وحلب، هل أحب الشام أكثر من حلب؟؟ أم أحب حماة؟؟؟ ولكني خيبت ظنه أو هي رغبته في التحبب إلى وإزالة ما لاشك أنه قد لاحظ من الانكماش عنه، أو هي الرهبة منه... اكتفيت بأن التفت إليها وكأني اطلب منها هي أن تتولى الإجابة.. نهض عن المائدة فنهضت هي معه، وقبل أن يتجه نحو الباب بادرت أنا بالنهوض عن الكرسي مسرعا إلى الغرفة التي قضيت ليلتي السوداء فيها.. ولا أدري بأي احساس اسرعت إلى النافذة، أرى عبرها الزقاق وكما هو الحال في زقاق القفل، كانت البيوت في زقاق الطوال تتقابل والمسافة بين البيتين المتقابلين لا تزيد عن مترين أو ثلاثة أمتار.. كان البيت المواجه خاليا اذ كانت جميع النوافذ فيه مغلقة وعلى بعضها الكثير من خُرء الحمام.. والقيت نظرة على ارض الزقاق، حيث يقع باب البيت.. كان هناك على مسافة من هذا الباب حصان أبيض يقف إلى جانبه عسكري يتحدث بالتركية إلى الرجل العجوز الذي قالت منكشة يوم زرنا الدكتور مع الخالة فاطمة وبدرية أنه زوج (باجي)، وهي الطاهية التي تجيد طهو الأكلات التركية ومنها (الصوبريك).. |
| وما هي إلا دقائق حتى خرج الدكتور في بزته العسكرية وعلى كتفيه شارات ذهبية عرفت مع الأيام أنها نجوم تحدد الرتبة كما تسمى التي يحملها الضباط في الجيش. |
| لا أخفي انبهاري لحظتها بالحصان الأبيض ثم بالدكتور وأنا اراه يمتطي صهوة الجواد بخفة ورشاقة وبراعة، ثم ينطلق إلى الشارع العام... لم أكن أعلم حتى ذلك اليوم أن من حق الضابط من رتبة معينة أن يعطي حصانا وسائسا لتأمين مواصلاته بين بيته ومحل عمله.. ولم أكن أعرف في الواقع أين يعمل الدكتور.. ولكني لم أشأ أن أظهر انبهاري أو هو اعجابي بما رأيت، فلم أحاول أن أسأل أمي شيئا عنه أو عن عمله.. ظللت في الغرفة أكاد لا أغادرها إلا إلى بيت الماء.. وانقضت فترة الصباح والضحى، دون أن تمر بي أمي مع أني كنت اتطلع إلى أن أراها للتخفيف من احساسي بالاغتراب والوحدة.. وتساءلت بيني وبين نفسي: أين هي يا ترى؟؟ وما الذي شغلها عني.. ولم اتردد في التسليم بأنها.. خلاص.. لم يعد يهمها من أمري شيء.. منذ الليل واحساسي بالحريق الذي ينهش أعماقي يتزايد اشتعالا، كلما جالت بذهني حقيقة أني أصبحت وحدي.. وأن هذه الأم هي أيضا قد أخذها مني هذا الرجل.. وجال بذهني أنها منذ اليوم قد أصبحت سعيدة وانتهت متاعبها ولم يكن معقولا في تلك السن، أن أعفيها من اللوم أو أن التمس لها العذر في موافقتها على الزواج.. ولكن مع ذلك وجدت نفسي أفكر في أبي.. وأرسم له في ذهني صورة لا أملك إلا أن أعترف اليوم بانها لم تكن مرضية بأية حال.. وحتى عندما رأيت ذلك الحلم في (تايبيه) وسمعت من ذلك المخلوق الواقف على الباب وخلفه فضاء ضبابي كلمة (زاهد) لم أشعر بشيء من فرحة أو ارتياح لرؤيته أو بالحنين إلى رؤيته مرة أخرى.. وكانت مفاجأة قرار ابني وزوجته تسمية الطفل الذي يرزقانه (زاهد) لا واقع لها إلا في غرابة العلاقة بين الحلم والواقع لا أعفي أمي من اللوم ولا التمس لها العذر في الزواج ولكن مع ذلك لست راضيا عن هذا الأب الذي تقول أمي أنها لم تتلق عنه أي خبر منذ غادر المدينة قبل الحرب أو قبل هجرة أهل المدينة إلى الشام وحتى اليوم الذي تم فيه طلاقها على مذهب الامام مالك ثم شهور العدة ثم الزواج.. ولا ادري لم ظللت حتى بعد أن شببت عن الطوق لا أتصور أنه مات ولم يعد يهمني في شيء ان كان قد مات أو مايزال على قيد الحياة.. |
| حبست نفسي في تلك الغرفة لا اغادرها بل ولا أتطلع إلى الخروج إلى الشارع حيث أجد الأطفال يلعبون فالعب معهم أو أجلس على طرف دكة دكان العم صادق.. كان هناك شيء آخر أدركت أني أرهبه ولا أدري كيف يكون تصرفي إزاءه.. وهو احتمال أن يسألني العم صادق أو حتى أحد الأولاد عن أمي.. هل تزوجت؟؟ ما أثقل هذه السؤال يطرحه عليَّ مخلوق؟؟ بماذا أجيب؟؟ فإذا خطر لأحدهم أن يخرج لسانة في وجهي ساخرا (من الولد الذي تزوجت أمه رجلا غير أبيه) ماذا أفعل؟؟ ومن يدري.. فقد يجتمع على بقية المجموعة من الأطفال ويأخذون في الصخب ورفع اصواتهم بالبذاءات الكثيرة التي كثيرا ما سمعتهم يرددونها وهم يتشاجرون. |
| ولا أدري كيف غلبني النعاس، في جلستي على طرف السرير، فاستغرقت في نوم عميق ايقظتني منه، تلك العجوز (الباجي).. فقد سمعتها تردد بالتركية كلمات التدليل أو الاشفاق اذ يبدو انها قد صعب عليها أن ترى نصفي الأعلى على السرير بينما نصفي السفلى متدليا على الأرض.. استيقظت واسرعت بالجلوس بحركة خائف أو متهيب فأخذت تربت كتفي وانحنت علي تحتضنني ثم قالت بعربية مكسرة: |
| ماما يقول أنت فين؟؟؟ |
| ثم مشت امامي وهي تقول: |
| تعال.. فيه ماما.. فيه مسافرين.. لازم انت تشوف. |
| وفهمت أن أمي أرسلتها لتجيء بي.. وان عندها (مسافرين).. والمسافرين في التركية هم الزائرات أو الضيوف. |
| مشيت خلفها، متثاقلا ومايزال النعاس في عيني.. ولكن وجود (ضيوف) اغراني بأن أغالب النعاس ولم يكن في ذهني تصور عن الضيوف الذين يمكن أن يزوروا أمي في هذا اليوم بالذات خطرت كلمحة خاطفة سرعان ما تلاشت صورة بدرية.. ولا أفهم كيف تذكرت على التو أنهم قالوا أنها (حامل). فخالجني احساس بالضيق بل ربما الاشمئزاز.. ولا اعرف لذلك تعليلا بل قد يحسن أن أعترف أني اعتنق حتى اليوم فكرة أن لاشيء يشوه جمال المرأة عندي مثل أن يقال عنها أو أن أراها (حاملا)... عندي أن الجمال فيه من معنى الملائكية وروحانيتها ما يجعله اسمى وأجل من أن يهبط إلى مستوى الحيوانية في بدائيتها الزاحفة في الاغوار. |
| وعندما دخلت غرفة (المسافرين) أو (الضيوف) لم أر بدرية بالطبع ولا الخالة فاطمة وانما رأيت سيدات لم يسبق ان رأيتهن قط... كلهن يتحدثن باللغة التركية.. ولكهن أقرب إلى الشيخوخة.. فما كدن يرينني، حتى هتفن:ـ |
| ما شاء الله... ما شاء الله. |
| وكانت الكلمتان، تعبيرا عن الاعجاب، يستعملها الاتراك بنفس المعنى في العربية ولكن ما بعدهما كان كلاما طويلا باللغة التركية، فيه الفاظ التدليل والتحبب.... كانت أمي تتابع مشيتي ورأيت نظراتها كأنها تتفرس في وجهي.. ثم قالت:ـ |
| ـ أنت كنت نايم؟؟ |
| ـ ايوه.. كنت نايم |
| ـ طيب.. هيا تعال سلم على خالاتك.. شوف هادى.. هانم.. عندها بنت قدك.. وهادى.. هانم.. عندها ولد.. قدك كمان.. وهادى.. خالتك.. هانم.. |
| وكانت قد نهضت وأخذت يدي في يدها وهي تقدمني إلى هذه الهانم وتلك دون أن أعرف شيئا عنهن إلا أنهن (هوانم).. وكلما وقفت عند احداهن، تمد لي يدها اليمنى، لأقبلها فإذا قبلتها تمديديها الاخرى وتلف ذراعها حولي، وتحتضنني.. وهي تردد كلمات التدليل والاعجاب أو التحبب والأرضاء. |
| وأخذت مجلسي على أحد المقاعد بجانب أمي.. وإذْ كان الحديث يدور بالتركية فلم استطع أن أفهم شيئا بالطبع... ولم يطل جلوسهن بعد ان دارت عليهن الباجي بفناجين القهوة التركي.. كانت احداهن تدخِّن بشراهة... لاحظت أنها دخنت سيجارتين، خلال شربها فنجان القهوة... ونهضْن.. تتقدمهن أمي بينما بقيت أنا في مجلسي، وفي نفسي أن غربتي تتأكد بهؤلاء ((الهوانم)) اللائي لا أعرف من هنّ، ولم يخطر لهن أن يتحدثن بالعربية كلمة واحدة... رجّحت أو خمّنت أنهن اقارب زوج أمي... وانبسطت أمام ذهني صورة لمستقبل حياتي مع هؤلاء، إذا قدر لهن أن يعشْن معنا، أو أن نعيش نحن معهن... أحسست كأن قلبي يغوص في صدري، إذ بدا لي أني حرمت من بيتنا في زقاق القفل، ومن الخالة فاطمة، وبدرية ثم خاتون الهندية، وبنات العم صادق، وغيرهن، من اللائي كن يملأن الحياة حولنا حين يزرننا أو حين نذهب نحن لزيارتهن، بعد العصر أو بعد الغروب... |
| وعادت أمي، بعد أن شيعّتهن إلى الباب... وكنت أنتظرها في الواقع، وفي نفسي أن استأذنها في الذهاب إلى بيتنا في زقاق القفل.. وقبل أن تجلس نهضت أقول:ـ. |
| :ـ أنا ابغا أروح بيتنا |
| وبدا على وجهها الأستغراب والدهشة وهي تقول:ـ |
| :ـ بيتنا؟؟؟؟؟ في زقاق القفل؟؟ |
| :ـ أيوه... اقعد مع دادة منكشة. |
| :ـ لكن ليه؟؟؟ ليه ما تبغا تقعد معانا هنا؟؟؟ ها دا دحّين بيتنا كمان. |
| :ـ يا فَقَم بيتنا هناك... بيتنا في زقاق القفل... |
| :ـ ايوه هاداك بيتنا صحيح... لكن هادا دحين بيتنا كمان. |
| :ـ يعني بيتين؟؟؟ |
| :ـ ايوه بيتين... هاداك ملكنا انا وانت... وهادا... |
| وتلعثمت... لحظات ثم قالت: |
| :ـ اسمع افهّمك.. اقعد. |
| ولكني لم أجلس... ووجدت نفسي مختنقا بزحمة البكاء وأنا أقول:ـ |
| :ـ انا فاهم يا فَقَم... فاهم هادا دحِّين بيتك انتي... مع الدكتور... لكن أنا.... أنا بيتي هناك.. في زقاق القفل.. انتي بنفسك بتقولي انّو ملكنا انتي وانا.. |
| وبدا عليها الأرتباك... وتغيّر وجهها، وأخذت تغالب الأنفعال والتوتر لتقول: |
| :ـ اسمع يا عزيز... الدكتور انت عارف اني اتجوّزته... وعشان كده أنا لازم اسكن معاه في بيته... يعني في هادا البيت... وانت |
| وقاطعتها، وكنت ماازال واقفا:ـ |
| :ـ انا ايه يا فغَّم؟؟ |
| :ـ انت؟؟؟ انت ولدي يا عزيز.... انت تعيش محل ما اعيش انا... هنا معايا في هدا البيت.. |
| :ـ طيب، ونسيِّب بيت زقاق القفل لدادة منكشة؟؟؟ |
| ولا أدري كيف طرأ على ذهني في هذه اللحظة، أنها قد استلمت أجرة الدكانين في زقاق الزرندي، ستة جنيه ((عُسْمنلي))... وكيف خطر لي أنها تستطيع الأنفاق علينا ـ أنا ومنكشة من هذه الجنيهات... فقلت بعفوية صادقة. |
| :ـ يا ففَّم... أنا ودادة منكشة نقعد في بيتنا في زقاق القفل... والجنيهات العُسْمنلي من أجرة الدكاكين تكفينا... وكمان أنا شفت عيال قدّي بيشتغلوا... شفتهم في سوق الخضرة... انا كمان أقدر أشتغل زيهّم... وأجيب فلوس تكفَيّنا انا ومنكشة. وانتي.... خلاص... خلّيكي قاعدة مع زوجك... |
| قلت هذا الكلام بعفويةٍ وبساطة، وكأن ما أقوله خالياً من أي غرض للاثارة... بل قلته وفي تقديري انّها سترحب به ولن تتردد في الموافقة عليه.. ولكن كانت المفاجأة الصاعقة أنهّا اندفعت من موقفها نحوي بسرعة انفعال عاصف، ووضعت يديها على كتفّي وهي تقول: |
| ؛ـ اسمع... اسمع الكلام اللي بأقول لك هوّه... وفَتح عينيك قد الريال... انت تعيش معايا انا محل ما اعيش... في هادا البيت تعيش معايا... في غير هادا البيت، تعيش معايا في جهنم الحمرا... تعيش معايا.. فاهم؟؟؟ فاهم؟؟؟ انت فاهم؟؟؟؟ |
| ورفعت يديها عن كتفي، وكانت نظرتي إلى الأرض... وقد ادركني رعب شديد، اذ لم يسبق قط، ان تصرفّت معي بهذا الأسلوب.. ولم أستطع أن أجيب بشيء... ظللت واقفا مطرقا برأسي إلى الأرض... وانتبهتُ فجأة إلى حركتها وهي تبتعد عني.. لتلقي بنفسها على الكنبة الطويلة وقد أحاطت جبهتها وعينيها بذراعها، ثم مالت على مسند الكنبة... أحسست أنها تبكي بحرارة وحرقة... لم أسمعها تنشج أو تُعول.. ولكن لا اشك في أنها كانت تبكي... لم ادر ما اذا افعل... ظللت واقفا وهي امامي لحظات مشحونة بالحيرة والأسى بل والأشفاق عليها... واستهولت كثيراً أن يكون كلامي قد أثر عليها وأثارها إلى هذا الحد... وأخيرا وجدت نفسي انحني عليها وأحيطها بذراعي.. وامطر رأسها بقبلات متلاحقة، وأنا أقول لها. |
| :ـ. خلاص... خلاص... اعيش معاكي.. محل ما تعيشي انت أعيش أنا معاكي... خلاص.. |
| * * * |
| ومرّت ايام بعد ذلك الموقف، كنت خلالها اتساءل: ترى إلى متى كتب عليّ أن أعيش هذه الغربة.. كان زوجها، الذي أصبحت اسميه ((عمّي)) كما اقترحت هي... رجلا دمث الأخلاق رقيق الحاشية... عفوي التعامل معي، ظل يبذل جهدا ظاهرا في التحبب اليّ.. ومحاولة اسقاط الكلفة بيني وبينه... كان يستدنيني من مجلسه، ويحيطني بذراعه، وكان يتكلم العربية دون لكنة أو خطأ في مخارج الحروف، ولكن بلهجة تختلف قليلا عن لهجة اهل المدينة... ولقد عرفت فيما بعد... أنه كان مع القوة العثمانية في اليمن... أرسلوه بعد التخرج من الكلية الطبية العسكرية في اسطمبول... صيدليا برتبة ملازم اول ((على كتفه نجمتان ذهبيتان))... ولم يكن قد تجاوز الخامسة والعشرين من عمره.. وقد ظل مع الجيش التركي في اليمن، في حواضرها الكبيرة، ومنها صنعاء، وتعز، وزبيد، وعايش أهلها، وأحبوه وأحبهم، إلى أن انفجرت الحرب العالمية وثار الشريف، على الأتراك، فنُقل مع الفرقة التي كانت في اليمن إلى المدينة، تحت قيادة فخري باشا... حيث ظل يترفع إلى رتبة ((بيكباشي))... ولا اعرف ماذا يقابلها من الرتب اليوم. |
| اما قصة بقائه في المدينة، فتتلخص في أنه اصيب بحمى التيفوس، وعندما اضطرت القوة التركية إلى الانسحاب من المدينة، كان هو، ومعه طبيبان وصيدليان آخران، مضطرين للبقاء هو بسبب مرضه، وهم لرعاية المرضى والجرحى من افراد القوة التي تعهّدت حكومة الشريف، بترحيلهم عندما يتماثلون للشفاء... في المستشفى الذي كانت تديره القيادة التركية، واسمه المستشفى العسكري... فعرضت عليهم أن يبقوا على عملهم وزادت كلا منهم رتبة، مع الأحتفاظ لهم بحق اللحاق بدولتهم في تركيا، عندما يشاؤون... |
| واني لأذكر اليوم، الكثير جدا من محاولاته المتواصلة لأسقاط الكلفة بيني وبينه... ومن ذلك، حكاياته عن أيامه في اليمن... عن المواقع والحروب التي خاض غمارها مع القوات التركية في حربها مع قوات الأمام يحيى،... عن الجبال الشاهقة التي كان عليهم ان يتسلقوها تحت وابل الرصاص، وفي مواجهة الهجوم عليهم بالخناجر والجناني... ثم عن حدائق اليمن وبساتينها، وأشجار البن، والهيل، والفواكه، إلى جانب المفاجآت في الليالي المظلمة من غارات اليمنيين، ليس بالبنادق والرصاص، وانما بالخناجر، يذبحون بها الجنود ذبحا كالأغنام أو يبقرون بطونهم، في صمت، لتسفر الغارة في الصباح عن العدد الكبير من الضحايا فيكون الرد هجوماً مضادا، في تلك الطرق الوعرة، وفي الوديان التي يدخلونها ليطبق عليهم اليمنيون، من الجبال... وقد ظل هذا حال الجيوش العثمانية في اليمن، طوال السبعين سنة انتهت بالحرب العالمية، التي انسحبت فيها تركيا من الأراضي العربية كلها، بما فيها اليمن، وعسير، وأخيرا الحجاز. |
| وما أكثر هداياه إلى كلّما عاد من العمل على حصانه الأبيض.. هدايا خاصة لي شخصيا، منها حلوى الشكوكولا... و ((الغُريِّبة))... والفواكه المستوردة من الشام، ومنها التين، والكمثري والتفاح.. وأقول (لي شخصيا)، لأنه ما يكاد يدخل دهليز البيت حتى يرفع صوته يناديني فاهرع إليه.. فيدفع اليَّ ما يحمله العسكري، في لفافة أو علبة، أو قرطاس.... ويضحك وهو يقول:ـ |
| :ـ هادا لك انت... لا تعطي ففَّم.. ولا باجي ولا أحد... |
| واضحك من جانبي... وارى كيف يطفح وجهه بشرا حين يراني اضحك... فيمسح رأسي بيده ثم يلتفت إلى أمي التي تكون قد جاءت ترحّب به يحييها، ويسألها عن حالها ثم يدخل. |
| اشهد اليوم... أن ما لقيت في الأسابيع أو الشهور الأولى من حياتي معها في هذا البيت من عطف زوجها وحنانه ورعايته، كان أكثر كثيرا حتى من عطفها وحنانها... واعترف اني رغم كل ذلك ظللت انطوي على الأحساس بالغربة... بالوحدة... ولابد أن أفسّر احساسي هذا باللؤم أو بشيء من هذا القبيل... اذ ماذا أكثر من أن يعاملني الرجل هذه المعاملة التي قد لا يجدها الأبناء من آبائهم... |
| والأعجب في هذا الاحساس الذي ظللت منطويا عليه، اني كنت لا أنسى أبدا أن هناك بيتي في زقاق القفل... وهناك الجنيهات العُسْمنلي... ثم أولئك الأطفال الذين يعملون ويأخذون أجرا على عملهم في سوق الخضرة... كان يخيّل الي، أني استطيع أن أعيش وحدي... حتى بدون رعاية الدادة منكشة... وأقول لنفسي: |
| :ـ ايوه... اقدر اشتغل... واجيب فلوس... بس لو أمي ترضى... |
| ففَّم |
| هي الأسم الذي تعوَّدت منذ بدأت الكلام أن أنادي به أمي، واسمها فاطمة. |
|
|
 شارع عبد المقصود خوجة
شارع عبد المقصود خوجة 00966-12-6982222 - تحويلة 250
00966-12-6982222 - تحويلة 250