| طفولتي التي بدأت |
| مع رياح الحرب العالمية الأولى |
| لا أكاد أبدا الجزء التالي من قصة (حياتي.... مع الجوع... والحب... والحرب)، حتى أجد نفسي، وطفولتي، التي بدأت مع رياح الحرب العالمية الأولى، في مواجهة ما أسميه اليوم (معركة)، كأنَّ كل الذي عشتُه إلى تلك الليلة التي انتقلت فيها مع أمّي إلى بيت زوجها، لم يكن، ((معركة))، تزاحمت فيها الأحداث، وتراكمت في كل يوم من أيامها المآسي والأحزان... والأرجح الذي ينبغي أن أسّلم به، هو أن كل ما عايشتُه من الفواجع والآلام، لم يكن معركتي أنا، وانما هو معركة أمّي رحمها الله، معركتها، وهي أمّ لطفل سافر أبوه عندما كان هو في الشهر التاسع من عمره، وحامل بطفل وضعته، وقد انقطعت أخبار الأب، منذ سافر... وجاءت أخبار الحرب، تتلاحق، فيتحدث عنها الناس في المدينة، ولكن دون أن يدركوا لها معنى، بل دون أن يَعوا أنها تلك التي أخذت تحصد في ميادينها مئات الألوف من الأرواح... سمّوها (سفر بَرْلِكْ)، وحتى اليوم لا أعرف معنى هذا الاسم على التحديد، رغم أني سمعته مئات المرات... كانوا يسمعون ـ على سبيل المثال ـ أسماء الدول التي دخلت هذه الحرب، ولكن ما أقل الذين يعرفوان شيئا واضحا عن هذه الدولة أو تلك... الدولة الوحيدة التي يعرفون عنها الكثير، الذي عايشوه هُمْ، كما عايشه قبلهم آباؤهم وربما أجدادُهم، هو (الدولة العثمانية)... التي يحفظون عن ظهر قلب أنها (الخلافة) وأن الخليفة هو (خادم الحرمين الشريفين) و (خاقانُ البرّين والبحرين... السلطان بن السلطان.... الخ.)... وأن هذا السلطان، أو هو (الخليفة)، أو (الباديشاه) موجود في (دار السعادة)... ودار السعادة هذه ـ في تلك الأيام ـ هي (استامبول)... وهي (القسطنطينية) التي يحفظون عن ظهر قلب أيضا أنها التي فتحها، وأزاح الكفّار عنها، السلطان (محمد الفاتح)، الذي يعلّقون في منازلهم صورته على جواده، وفي يده سيفه، وقد أشهره عاليا، يتقدم جحافل جيشه... وفي البحر... أجل في البحر، وليس في البر... لأنه فتح القسطنطينية بالهجوم عليها، وعلى أسوارها العريضة الشاهقة، من البحر.... أمّا الدول الأخرى التي دخلت هذه الحرب، فالقلة القليلة جدا من الذين يقرأون ويكتبون اللغة التركية، إلى جانب ما يحفظونه من القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة، والأدعية والأذكار، هم الذين يدركون أن في الدنيا دولا، منها الروس... والانجليز... والألمان، والبلغار، والروم ـ وهم اليونان أو الأغريق ـ ولكنه ما أقل ما تصوّروا أن (الدولة العلية العثمانية)، قد اشتبكت في حرب مع هذه الدولة أو تلك... وحتى إذا قيل لهم، أن الدولة العلية تلك، تحارب الروس، أو البلغار، أو الانجليز، فإن المسألة عندهم تافهةٌ لا يقيمون لها كبير وزن أو حساب، لأن الدولة لابد أن تنتصر والسبب، في منتهى البساطة، هو أنها (الدولة العلية)، التي ما أكثر ما اشتبكت في حروب مع (الكفّار)... وما أكثر ما انتصرت عليهم، فاسلموا بل وأصبحوا هم أيضا يحاربون في صفوف جيوش الدولة، التي تملأ البر كما تملأ البحر... والتي لم يسمعوا قط، أنها هزمت طوال مئات السنين... فما الذي يجعلهم يدركون أن هذا الذي سموه (سفر برلك) شيء مختلف عن الحروب الأخرى... وأنها حرب اشتركت فيها جميع دول العالم، وأن (الدولة العلية) تحارب هذه الدول جميعها، وحدها، وليس معها إلا (الألمان)... |
| بلى... كانت المعركة، معركة الأم، التي كان عليها، ليس فقط أن تربّي ولدها الذي عاش رغم اصابته بالتيفوس الذي اخترم حياة الألوف، بينما مات أخوه بالحصبة، وانما أن تقف إلى جانب أبيها ـ في شيخوخته، وهي تراه ينتزع لقمة العيش من براثن العوز والفاقة بالعمل الشاق، بعد مداهمة اللصوص، في تلك الليلة في حماة وقد ذهبوا بكل ما يملك الرجل العجوز الذي استطاع رغم ضعفه أن يتحدى كل العجز الذي يطوّق حياته وحياة أسرته في ديار الغربة، بالعمل في حفر الأختام... أن تقف إلى جانبه، ترعاه، وتخفف عن نفسه مشاعر الاحساس بالحزن والتفجّع والأسى، وهو يرى الموت يحصد الألوف حوله، فلا يدري ماذا سيكون مصيرها هي وهذا الطفل، إذا كان هو أيضا سيلحق بربّه في هذه الديار... وقد كان، فلحق بربّه ذات صباح، لتواجه هي وحدها مع هذا الطفل فواجع النهاية التي أرادها الله سبحانه، (للدولة العلية) بانتصار قوات الانجليز والعرب، وخروج الأتراك من أراضي الشام إلى الأبد، ثم خروجها هي ـ وحدها مع هذا الطفل ـ من حلب ومنها إلى المدينة، التي ما كادت القافلة تصل إلى ساحة محطة سكة الحديد فيها، حتى وفت بنذرها، بأن توضّأت، وصلت ركعتي الفجر، ثم لعقت تراب الأرض التي ظلت تحلم بالعودة إليها منذ خرج بها (البابور) مع الذين هجّرهم (الباشا) إلى الشام، وطوال تلك الأيام والليالي السود، في تلك الديار. |
| هذا الادراك للواقع حين يقرؤه القارىء اليوم، كان غائبا تماما عن ذهني، وعن مشاعري في تلك الليلة، التي تم فيها زواجها من الرجل، فوجدت نفسي ـ وللمرة الأولى ـ أنام وحدي على سرير في غرفة حسنة الأثاث، كانت تنام مع زوجها... ولن أنسى أبدا اللحظات الأولى، التي وجدتها تدخل معي هذه الغرفة، ويدها على كتفي، وتشرع في تدليلي بكلمات، حاولت أن تحبّب إليّ بها، النوم على هذا السرير، وأن تطمئنني، بأنها ليست بعيدة عني... ستسمع صوتي إذا بدا لي أن أناديها، ثم هو ذا ضوء ((اللمبة العلاّقي))، ينير الغرفة كلهّا، فليس من سبب للخوف... ثم حين كانت تساعدني على خلع الحذاء والجورب، والثوب (القَرَمْسود)، كنت أسمع أنفاسها، تتلاحق، مما أعرب أنه يعبّر عن انفعالها... وقد لاحظت، أنها تحرص على أن تتجنّب النظر إليّ... فلا ترفع وجهها نحوي بعد أن جلست على السرير... لا أدري، إن كنت في هذه اللحظات حانقا، أو حاقدا عليها أو غضبان منها، ولكن لا شك أبدا، في أني كنت أستكبر، وأستهول، أن يحدث ما حدث، لا أشك في أني كنت أجتاز ما أشبهّه اليوم بأخدود من اللهب الحارق الرهيب.... ولذلك فقد حاولت من جانبي أن أنظر إلى وجهها... إلى عينيها... فملأ قلبي احساس غامض بالرغبة الجارفة في أن أتشبّث بها، فلا أتركها تذهب عني... كانت عيناها محتنقتين في بياضهما احمرار، اختلط بالكحل... رجّحت انها تغالب دموعا ما أكثر ما كنت أراها تنذرف، كلّما احتوانا موقف، من تلك المواقف، التي ظللنا نتجرّع غصصها، طوال هذه السنين السبع التي عشناها معا في مواجهة المآسي والأحزان... |
| ولكنهّا، لم تبك... لم أر الدموع... وأني لأتساءل اليوم... كيف استطاعت أن تحبس دموعها في تلك اللحظات؟؟؟ لم أكن في السن التي يخالجني فيها سوء الظن بها فاعلّل لعدم بكائها بأنها (عروس) ينتظرها زوجها في الغرفة التي قالت أنها ليست بعيدة عني... وربّما لذلك.. ولاني لم أر الدموع المعتادة في مثل هذا الموقف، تخلّيت عن الرغبة في التشبث بها... والأعجب من ذلك أني أيضا لم أشعر بزحمة البكاء على فراقها، وهي تضجعني، ثم تنحني عليّ وتقبّلني في جبهتي... ثم تستدير وتخرج من الغرفة، وتغلق بابها برفق دون أن تنبس بكلمة. |
| لقد اكتشفت ـ مع الأيام ـ انها معركتي أنا... أذ خالجني احساس، بعد خروجها بأني منذ تلك اللحظة أصبحت مع نفسي... (ومع نفسي) هذه، كانت وماتزال حتى اليوم تعني حقيقة أصبحت أعيشها بكل ما تنطوي عليه من قسوة ووحشة وآلام... وهي (الغربة) أو (الاغتراب)... كل السنين التي عشتها مع أمي، في ديار الشام، رغم كل ما تفجّر فيها من آلام، أقلّها الجوع... ومنها موت الذين ماتوا من الأهل، ومنهم جدّي وخالتي.... بل موت أولئك الذين كانوا يتساقطون صرعي الجوع والمرض، على الأرصفة في شوارع حلب... ثم منها الرعب الساحق الذي كانت تنخلع له القلوب، مع دوي وانفجارات طلقات المدافع وزخّات الرصاص من الرشاشات طوال الليل... كل تلك السنين، مرت دون أن أشعر في يوم منها، ما شعرت به في اللحظة التي خرجت فيها أمّي من الغرفة إلى غرفتها مع زوجها... (مع نفسي)... لا تعني أقل من أني أصبحت فعلا... وحيدا... غريبا... ضائعا، في جوف المجهول الذي بدا لي كأنّه طريق يمتد إلى مالا نهاية... بل المجهول، الذي حدّدت معناه بوضوح، هذه الاستلقاءة على السرير، الغريب، الذي لم يسبق لي قط أن نمت على مثله... وفي هذه الغرفة، التي أطبقت عليّ جدرانها، وفي أحد هذه الجدران نافذة لا أدري على ماذا تطل من هذه الدنيا... بلى... (مع نفسي) فقط في سكون أكد لي أنّه أشد رهبة من أشد أصوات طلقات المدافع وزخّات الرصاص.. هناك على الجدار اللمبة العلاّقي... والمسافة بيني، وبين الباب الذي أغلقته أمّي عند خروجها لا تزيد عن مترين أو أقل... أستطيع أن أخرج... أن أتسلّل إلى الشارع... ومنه إلى بيتنا في (زقاق القفل)... ولا شك أني أعرف كيف أهتدي إلى الزقاق، فالمسافة بين الزقاقين قصيرة... ولكن... بيتنا...؟؟؟ أجل... بيتنا هو المكان الذي أستعيد فيه وجودي، والخلاص من غربتي في هذا البيت... بيت الرجل الذي تزوّجته أمّي... ولاشك أن مَنَكْشة ماتزال في ذلك البيت... وما كادت تلك العجوز، تخطر على بالي، حتى أحسست بيدي تتشنّج، وأصابعها تتوتر... أحسست برغتبي في خنقها... إلى أن تموت... بلى هي.. تلك اللعينة التي لعبت الدور الأكبر والأهم في إقناع ـ إن لم يكن إغراء ـ أمّي بفكرة الزواج. |
| ولكن... ماذا بعد؟؟؟ هل تنتهي غربتي بالعودة إلى بيتنا؟؟؟ ومع من؟؟؟ مع هذه العجوز... كلا... المسألة... أو هي المشكلة... أو هي الغربة التي أعيشها في هذه اللحظات ليست في المكان... وليست أني مستلق على السرير في هذه الغرفة... وانما هي في أن أمّي قد تركتني أنام وحيدا... وذهبت هي لتنام مع زوجها... واجهتني حقيقة أخرى عجيبة ورهيبة في نفس الوقت... وهي أني مخلوق... سافر أبوه، دون أن يظهر له أثر طوال سبع سنين... وها هي أمّه أيضا... أمّه التي ليس له غيرها، وكانت دائما تأخذه في حضنها، وإذا خرجت لابد أن تكون يده في يدها... أمه أيضا لم يعد لها وجود... كلا لم تمت... لم تسافر وانقطعت أخبارها كما انقطعت أخبار أبيه... ولكنها...؟؟؟ ماذا؟؟؟ ما الفرق بين أن تموت... وبين أن يأخذها منه رجل غريب... أصبح ـ كما ظلوا يقولون ـ زوجَها؟؟؟ |
| حاولت جاهدا أن أنام... ظللت أحملق في السقف... سقف الغرفة مختلف عن سقف الغرف في بيتنا... مبطّن بالخشب... فلا تظهر جذوع النخل التي يتكوّن منها السقف في أكثر بيوت المدينة... وحانت مني التفاتة عفوية إلى أحد جدران الغرفة، لأرى خزانة أو هو (دولاب) فيه رفوف على بعضها علب وزجاجات، (قوارير) منها زجاجة (الكينالاروش) التي كانت أول هدايا (الدكتور) مع حبات الكينا، عندما عاودت أمّي حمى الملاريا... ولكن سرعان ماتذكرت حبات الفاصوليا التي كانت وسيلتي إلى عد الأيام طوال الشهور، التي كنت أحلم خلالها بمفاجأة عودة أبي... فلا تتزوّج أمّي... ودون أن أشعر... أحسست بدموعي تنذرف، وتنحدر على وجهي ساخنة لاذعة... استسلمت للبكاء في صمت... وانقلبت في مضجعي بحيث دفنت وجهي في الوسادة... بكيت طويلا... بحيث كدت أجهش وأُعْول... ولكني تماسكت، وتركت الوسادة ترتوي بدموعها، لعلّي لم أذرف مثلها قط. من قبل. |
| * * * |
| تنّبهت على حركة في الغرفة... لأرى على ضوء النهار، أمّي تتجه إليّ متوجّسة كأنهّا تتوخّى أن لا توقظني... ولكن حين رأتني أنظر إليها أسرعت إليّ، وانحنت عليّ، وأحاطتني بذراعيها... ضمتني إلى صدرها... ورفعت وجهي إلى وجهها، وقالت: |
| :ـ. ما دام صحيت... هيّا قوم أغسل لك وجهك... والبس حوايجك، عشان تفطر معانا.. |
| وكلمة (معانا) هذه طّنت في كياني كله، إذ جعلتني أشعر لأول مرة أننا... ماذا؟؟؟ أننا مع هذا الرجل، الذي أصبح زوجها.. |
| وتساءلت بيني وبين نفسي... ماذا هو بالنسبة لي؟؟؟ كيف أناديه؟؟؟ جميع الرجال الذين مروا بنا، حتى اليوم، كنت أناديهم (عم..)... أو (عمّي)... |
| ووجدت في نفسي الجرأة على أن أسألها؟؟؟ |
| :ـ. مع مين يا أمي؟؟؟ |
| :ـ. معايا أنا و... |
| وتلعثمت... ثم التزمت الصمت.. وبعد لحظات قالت: |
| :ـ. يا عزيز... معايا أنا أمّك... وهوه (عمّك)... عمّك الدكتور.. |
| * * * |
| نهضت من الفراش مثقلا... وأخذت يدي في يدها، ومشينا معا... إلى (بيت الماء) حيث غسلت لي وجهي... ويديّ... ورجليّ أيضا... وعندما عادت إلى الغرفة، حرصت على أن تلبسني أحد الثياب الجديدة.. والحذاء.. وكان في ذلك الدولاب، ما بحثت عنه ووجدته.. وهو المشط الذي مشطت به شعري... ثم، قالت: |
| :ـ. هيّا... دحّين لمّا تشوفو... لازم تسلّم على يدّه... عشان هوّه زي أبوك.. والأولاد الصغار.. وحتى الكبار.. دايما يسلمو على يد الكبار.. |
| وتقدمتني ماشية... ومشيت خلفها بخطى متوجّسة، وفي نفسي احساس بأني مقدم على أمر مبعث الرهبة فيه، أنه لقاء مع هذا الرجل... الدكتور... الذي أصبح زوجها.. |
| * * * |
| عندما دخلنا ـ أمّي وأنا ـ كان جالسا على مقعد وثير... فما كاد يرانا حتى نهض واقفا... وامتلأت قسماته بابتسامة عفوية واسعة... وقال بلغة عربية سليمة: |
| :ـ. أهلا... أهلا وسهلا.. |
| وأمسكت أمّي بيدي.. وهي تتقدم إليه في موقفه... لاشك أني كنت أمشي بخطى مترددة.. إذ رأيته هو يتقدم نحوي... وينحني عليّ... ويأخذ وجهي بين يديه... ثم يقبلني، ويمسح وجنتيَّ ثم يمسح رأسي، وهو يقول: |
| :ـ. ها... انت مبسوط هنا؟؟؟ |
| لم أجب بشيء... ولكني أخذت يده وقبّلتها.. وفي نفسي.. أنّه أول رجل أقبل يده بعد جدي رحمه الله... وهو أول رجل، يقبّلني بهذه العفوية والحب ويشعرني بأكثر مما كنت أتوقع من العطف والحنان... |
| وحين التفتُّ إلى أمّي رأيت في عينيها دموعا... لا أشك في أنها دموع الفرح بأن اللقاء بيني وبين زوجها، كان على أفضل مما كانت تتوقع وتحب. |
|
|
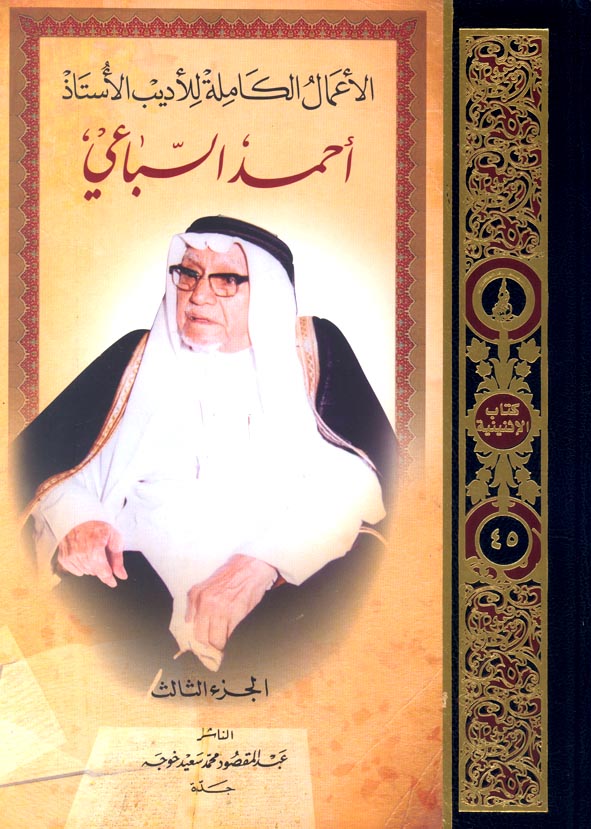

 شارع عبد المقصود خوجة
شارع عبد المقصود خوجة 00966-12-6982222 - تحويلة 250
00966-12-6982222 - تحويلة 250




