| المحاضرة (5) |
| وقد حللنا بعض الرذائل التي نسميها معائب عقلية أو طبْعية (كالبخل، والجبن والكبرياء، والأثرة) تحليلاً نخشى أن يؤخذ دليلاً على عقيدتنا في رجحانها على نقائضها، وليس لنا في الحقيقة غرض من هذا التحليل، والمقابلة إلا الإشارة إلى أن هذه الرذائل أو بعضها من سنن العقل والطبائع أو من فرائضهما. |
| ولنا رأي نخالف به الاصطلاح الشائع في الفضائل والرذائل خلاصته أنا لا نرى صفة من هذه الصفات التي جرينا في هذا الحديث على تسميتها فضائل ورذائل، ما هو خليق بهذه التسمية. |
| وإنما ندعوها محاسن ومعائب فردية يهبط بها العرف أو يعلو، على وفاق نصيب المتصف بها من القوة والضعف، أو على نصيبها من الشيوع والخمول، وأساسها الأنانية والمصلحة. |
| أما الفضائل التي نراها خليقة بهذه التسمية، فهي التي نزل بها القرآن ودعا إليها. تلك فضائل، لا يكون للمتصف بها، والمؤمن بقوانينها، نظر إلى مصلحة أو سمعة.. وإن كان شيء من ذلك فالمثوبة عند الله، والزلفى إليه. |
| فالكرم فيها إحسان إلى مستحقه، ينزل منزلة الحق المفروض له، وخروج من سلطان المادة وحدودها في سبيل الله. |
| والأمانة مبدأ يعامل الأمين به الناس، كأنه يعامل الله. |
| والصدق ميزان دقيق، لا يستقر فيه الغش والتدليس، ولا يستقر فيه الحقد والرياء. |
| والتواضع إنكار للذات وقوتها، في سبيل إيمانها بقوة الله. |
| والعفة سمو بالنفس لا تشيل بميزانه خالجة من خوالج الشيطان والهوى. فإذا انحرفت بها نزوة عارضة من نزواتها، لجأت إلى التفكير والتوبة والاعتراف، لتتطهر من إثمها. |
| وهكذا حتى تكون الفضيلة حياء من الله، تتجنب به مواطن حرماته فلا تأتيها؛ ولو أتاها الناس جميعاً. |
| * * * |
| وخير لنا أن نحجم عن تحليل بعض الرذائل (التي ندعوها رذائل روحية) واستجاباتها العصبية الظاهرة، فهي خليقة عندنا بأن تدعى أمراضاً نفسية، أو جسدية، أو عقلية، أو هي مزيج من ثلاثتها. |
| وإنا لنجد بعض المصابين بأدوائها أصح نظراً إلى الفضيلة، وأصدق في تقديرها، والإيمان العميق بها، من المتشددين فيها لأن ممارسة هذه الرذائل تنتهي بمن يمارسونها إلى ألوان من العناء، والمشقة والمضض، ترهقهم بأعبائها، فهم أصدق نزوعاً إلى التخلص منها، وإن كان الاندحار نصيبهم -في الأكثر- كلما نازعوا نفوسهم على الإفلات من قيودها وأغلالها. |
| فنزوعهم إلى الفضيلة، وظمؤهم المحرق إليها، أشبه بظمأ السجناء إلى الحرية، والقلق المضطرب إلى الراحة والطمأنينة، والمقاربة بين شعور الإنسان الطليق، وشعور الإنسان المكبوح، بجمال الحرية وفتنتها، تكشف لنا عن شعور المصابين بهذه الرذائل. |
| وهي عادة عرض أصحابها باليأس من الخلاص، فذاك حيث يتسمون بعدم المبالاة، والاستهتار الظاهر، وهما دلالة اليأس في الشفاء. |
| فلا غرو أن نرى في بعض المصابين بهذه العاهات النفسية التي نسميها رذائل؛ قبساً خاطفاً من الشعور بهدي الضمير، وصدق التأثر، والإحساس بالوخز والمرارة ولا نراه إلاّ نادراً في نفوس المتمسكين بالفضائل لا تمسك الإيمان الصادق بها، بل تمسك الخوف مما تجر إليه نقائضها وأضدادها، من فقدان أمل، أو مكانة.. وقد يكون تمسك من لا يحس من نفسه النزوع إلى هذه النقائض والأضداد. |
| ولو أن رجلاً ذابت في عينه ونفسه مغريات الرذيلة، وتزايلت فيه أسباب النزوع إلى متعاتها السانحة، فصدف عنها صدوف الواثق بعجزه أو بعجزها عن إثارة رغبته واشتهائه، لما كان خليقاً بأن تعد فضيلته فضيلة قوة وجهاد في منطق العقل السليم. |
| فما تكون الفضيلة جديرة بهذه التسمية، إذا كانت إيماناً، حتى تكون غلبة وانتصاراً وقوة وجهاداً لإغراء الرذيلة، وكبحاً لميل النفس المسعورة، وحنينها الملحّ إليها. |
| * * * |
| إن كثيراً من الفضائل لا يكون مطلباً خلقياً في البلاد التي تتسع فيها أسباب الكسب، وتتنوع وسائله، ويتكاثف فيها الاجتماع. فالناس في مثل هذه البيئة يتسامحون في طلابها، لأن ضرورات التكاثف وما تستلزمه، من الاتصال والاشتباك واتساع العلائق، تصرفهم عن التماس القوانين الأدبية، فيفهمون الحياة على حقيقتها الواقعة، وينشغلون عن النظرة الشعرية المثالية إليها. |
| فمتى تكلفت الأنظمة بحماية الحرمات الفردية، وبحماية الحرمات والحقوق، وقام الفرد بواجبه القانوني في صلاته المعينة الحدود بالناس، استوى في القمة، الحليم والأحمق، والعفيف والمستهتر، والكاذب والصادق، والشجاع والجبان، والأناني والإيثاري، ما دامت رذائل إنسان لا تتناول غيره بالأذى والإساءة. |
| وليس لنا أن نطمع في تحويل تيارات الحياة، فالحياة لا تخرج على قوانينها، ولا تتكيف على ما يطابق ميولنا، وإنما الإنسان يكيف حياته ومطالبه على وفاق ضروراتها. |
| فهل كان انحراف الناس بإيمانهم بالفضائل، إلى هذه الهمود ضرورة، اقتضاها سير الحياة العامة، وقوانينها؟ |
| إننا نعترف في ألم بهذه الحقيقة. |
| يقول الأستاذ العقاد: (ليس بحيِّ الضمير من لا يسمع صوت ضميره مرة، على أنه لو وُجد ذلك الرجل بين الناس، لكان كمن يعاملهم بصك يتقيد به من جانبه، ولكنهم هم من جانبهم لا يتقيدون به). |
| كم يلقى العقل، وتلقى النفس الشاعرة، في التسليم بهذه الحقيقة من مضض وألم؟. أترانا نريد من الضعفاء والموتورين، والعاجزين والفقراء.. أن يؤلفوا جيشاً أعزل لحماية الفضائل مما جرّت إليه هذه النظرة العامة؟ |
| أم تراه واجب الناشئين الحائرين؟ |
| أم واجب القوانين التي تعرف كيف تعاقب الرذائل، ولا تعرف كيف تناصر الفضائل وتثيبها وتشجعها؟ |
| أم أنه واجب الأقوياء والقادرين، وواجب قادة الأمة وسراتها المتسلطين على مجاري حياتها، والذين حذقوا فن القوة فيها؟ |
| إنما ننهض بالمبادىء والنزعات الطيبة، بالتشجيع والمناصرة والإقبال. |
| فهل يلقى الخلق الفاضل بيننا التشجيع والمناصرة؟ |
| كم يلقى الصادق، والصريح، والعادل، والأنوف، والصابر، والمستحي، والأمين، والرحيم من المشقات، ومن انزواء الناس عنهم ومن المقاومة الظاهرة والمستورة لخطواتهم؟؟ |
| وكم يلقى الكاذب اللبق، والماكر الختّال، والضارع الشره، والظالم القوي، والجريء الملحف، والطامع المتوقح، والخؤون، ومغلق الحس، من الارتياح إليهم، والاستجابة لفرائضهم، والإعجاب بهم، والرهبة منهم؟؟ |
| أفهذا لأن موازين المحاسن والمقابح قد اختلت قوانينها وتبدلت؟ |
| أم لأن تيارات القوة اختطت لسيرها مجرى أعوج غير مجراه الطبيعي؟ |
| أم لأن الفضائل أدوات زينة، وشارات تجمل، كل شأنها أن تستكمل بها، وبشواهدها المسرودة، معاني الترف والنعمة ومطالب الذوق الناعس، فما تصلها بحياة الإنسان، صلة بسلاحه، وعدته، وأفكاره، وعقائده؟؟ |
| أم لأن النفوس عرفتها حلية زائفة، وزخرفاً براقاً، ووهماً في ألفاظ فهي لا تنزل منها، ومن الألسنة، إلا منزلة الشعر الجميل، والخيال البهيج، تنطلق به مناسباته السانحة في مجالس الطرب والاسترخاء، ثم لا ورود له بعد انقضاء دواعيه، وزوال أسبابه؟ |
| أرأيتم كيف يتقلص نفوذ الفضائل في هذا الزمن العجيب الذي اتضحت فيه سبل الحياة وحقائقها، وقلت مساتير النفس وانكشفت مكنوناتها؟ |
| أرأيتم كيف تقلص في عصور عجيبة قبله، امتطت فيها الرذائل، غوارب الفضائل تقودها وتتخذ منها جُنة تُتقى بها المخاطر، وتُدفع قالة السوء، وتسخر الجموع وتُخمد الفورات..؟ |
| * * * |
| بين جزر هذا الحديث ومده، رأيتم الفضائل التي سميتها محاسن، سلعاً مزجاة يرتفع بها الميزان تارة ويهبط. |
| ورأيتموها تجارة يراد بها الغنم، وفخاخاً يصاد بها العاجز والغافل، وسلاحاً يغتال به الضعيف، ولهواً تستمد منه اللذة. |
| ورأيتم فضائل الدين التي بعث محمد صلى الله عليه وسلم ليتمم بها مكارم الأخلاق -تضحية لا ينظر من ورائها إلى غرور الدنيا، وأعراضها الزائلة.. تضحية لا تضمن للمقدم عليها متعة ولا فائدة.. إلا الزلفى إلى الله، ونِعْمَتْ تجارة لن تبور.. تلك محاسن، وهذه فضائل. |
| تلك فخاخ يصاد بها حطام الدنيا، أو تسحر أعين الناس. |
| وهذه وسائل ينال بها رضاء الله، وتُبتغى المثوبة عنده.. |
| تلك محاسن نزل بنا إيماننا بها إلى الحضيض، فكانت شارة ضعفنا. |
| وهذه فضائل أقامت مبدأ سامياً فتح القلوب والنفوس قبل أن يفتتح المدن والممالك، فما يعجزها والله أن تنهض بهذه الأمة المعروفة التي قعد بها ضعفها وقعدت بها محاسن ومعائب بنيها.. |
| فلنلتمسها، ولنمهد المجال لظهورها.. فهي أمل النجاة، وسبب النهوض وسبيل القوة والظفر. |
| إن كل فضيلة من فضائل القرآن تضرب المثل الأعلى الكامل للقوة وحريتها فآمنوا بها واطلبوها. |
| وكل فضيلة من فضائلنا تضرب مثلاً للضعف والتهافت والتمويه، فأعرضوا عنها، وانبذوها. |
| وليكن الكريم الوهاب محسناً أنوفاً يأبى أن يأخذ بما يعطي شيئاً. |
| وليكن محسناً بصيراً.. يفرق بين الحسنة الواجبة، والمحمدة الزائفة.. |
| وليكن الشجاع مجاهداً حراً، يغضب للحق، كما يغضب لنفسه، وليكن الصادق أميناً، يقول كلمته في القانون، قبل أن يقولها في المجرم. |
| وليكن المتواضع صادقاً لا طامعاً. |
| والصابر مختاراً لا مكرهاً.. |
| والإيثاري زاهداً، لا تاجراً.. |
| وبعد فهذه حقيقة الفضائل كما تعرفها القوة، لا كما يعرفها الاصطلاح، وما على كل فاضل إلا أن ينزع من فضائله نصيب نفسه الترابي فيها، فإذا هي فضائل القرآن التي تصنع للأفراد الصحائف الذهبية في التاريخ.. والتي تبني الأمم.. |
| ولعل معترضاً يقول: أفلا يقتضي هذا التحول المطلوب، أن تصاغ الحياة صياغة جديدة تنتزع من النفس الإنسانية، أنانيتها، وطبائعها، وتبدل غرائزها وميولها الراسخة؟ |
| ونجيب بأن أصحاب هذه الفضائل، كانوا من أوسع الناس أنانية، وأبعدهم طمعاً وأعمقهم خيالاً.. فما يضحي الفرد منهم بنفسه في سبيل مبدئه إلا وهو يعتقد أن الموت ختام الحياة الذي لا مفر من لقيانه، وأن خلود هذا المبدأ وانتصاره إنما هو خلود نفسه فيه. |
| وما يخرج من سلطان المادة، إلا وللدنيا عنده معنى من الجمال والحرية -ما تتمتع به النفس إلا إن لقيته بأكبر منه، من داخل نفسها وذات سرائرها. |
| وما يكبح نفسه عما يشينه في أدل صورها على حب الذات والذهاب بها في أبعد مذاهب الغلبة والسيطرة. |
| فهذه الفضائل ترمي إلى توسيع مدى القوة والأنانية وطبائع النفس، فتكبر فيها الحياة وتمتد حتى تكون مثلاً أعلى ما تقنع النفس دونه بشيء، ويصغر كل ما في الحياة مما دون هذا المثل، حتى تكون خَطْرَة من خطرات النفس الأناني، الأناني أغلى من ذلك الكل الذي تنزل عنه راضية لمن كانوا دونها أنانية وطمعاً. |
| وخليق بنا أن نرى الأمل في مثل هذه الفضائل ضرباً من الخيال، لولا أن معارض الحياة اليوم غنية بالشواهد عليها، في أمم لا تعرف أن وراء حدود الحياة الظاهرة، حياة ينتهي إليها الجهاد، وتستقر فيها الموازين، فكيف بمن يرون الحياة الأولى سبيلهم إلى الحياة الكاملة الصحيحة، ومجال سباقهم الذي يعرضون فيه قواهم وأعمالهم للفوز أو للخسران؟ |
| * * * |
| نحن بسبيل الحديث عن الفضائل، ولسنا بسبيل حصرها، وما نظنها من الخفاء بحيث يكون حصرها ضرورة لازمة.. |
| وللفضائل في رأينا جماع هو الحياء.. والرحمة.. والعدالة.. وقوام هذا الجماع الحياء.. |
| فالحياء قوة النفس، وحرية العقل، وميزان الضمير. |
| والرحمة عدالة النفس، وجمالها، وحسها. |
| والعدالة رحمة العقل وبصره وسلطانه. |
| وسنسهب في تحليل الحياء الذي هو قوام الفضائل، أو قوام جماعها إسهاباً نحرص ألا يقودنا إلى التماس العلاقة بين كل فضيلة من الفضائل وبينه حسبنا أن نجمل الإشارة إلى هذه العلاقة فنقول إن كل صفة فاضلة مردها إحدى ثلاث صفات من جماع الفضائل أولاً، ومردها الحياء أخيراً. |
| والصلة، هنا ليست صلة الجزء بكله، لكنها صلة الفكر المحس، والوجدان الشاعر، والضمير المبصر، ولقد أقول إن الرحمة جمال، فيأخذ السامع بغرابة هذا القول، لأنه عرف الرحمة معنى، أو شعوراً وعرف الجمال صورة، ولكنه متى عرف أن الصورة للجمال رمز لما وراءه من معانيه وخطراته، وأن الألفاظ إشارات مجملة إلى معان تنزل منزلة اللحم والدم ممن تجول المعاني وراء نفسه، أدرك أن جمال الرحمة هو الجمال في جملته وحقيقة معناه. |
| المعروف أن الحياء صفة طبعية مظهره الترفع الأدبي المتطرف عن الاستجابة لرغائب النفس، إذا شعرت بأن في هذه الاستجابة ما يشينها، ولو كان مباحاً يأتيه الناس. |
| والمعروف أيضاً أنها دلالة الحس المرهف، ووضوح الشعور بالنقص، أو ضعف الجهاز العصبي، هذا أو ما يقرب منه في الطب. |
| * * * |
| لا توجد بين الفضائل فضيلة، أو بين المزايا مزية، تعرضت لما تعرض له الحياء من الامتحان بسوء النظرة وقصرها، وبالتقدير المختل، والوزن الجزاف. |
| أقصى ما يبلغه من التقدير، أن يدعي شعوراً بالنقص، أو فرقاً من الشماتة والتقصير، في الرجل. |
| وأن يعتبر ضابط العفة، وصمام الأمن في أخلاق المرأة، ودوافعها الطبيعية، حتى بلغ سوء النظرة إليه أن يعتبره بعض الأساتذة المعدودين من المفكرين في مصر كمالاً للأنثى، وعيباً للرجال. |
| وأول ما ينزل إليه، أن يعد دليلاً على ضعف الجهاز العصبي. |
| أما آخر ما ينزل إليه، فأن يعتبر أول خطوات البله والعته، وفتور الحيوية حتى يختلط بالجبن والخور، وقصر الفكر، وفقدان الثقة بالنفس. |
| يتلقى بعضنا عن بعض هذه النظرة الفاشية في مجال الحياء، ونظرة أخرى مبهمة في مجال النشأة الأولى. |
| * * * |
| هذا صغير يلتهم الطعام في شره -استح |
| يصرخ من شيء يؤلمه -أو يبكي -استح |
| يتكشف عما يجب عندنا ستره -استح |
| يقلب الأثاث أو يكسر شيئاً -استح |
| يربت على ظهر كلب -استح |
| هذا في البيت. |
| في الزقاق: |
| يضرب الكلب -استح |
| يضرب رفيقه -استح |
| يغتصب شيئاً منه -استح |
| في الكُتَّاب في المدرسة: |
| يبتسم -استح |
| تفلت منه ضحكة أو حركة شاذة -استح |
| يضاحك زميله الكبير أو الصغير -استح |
| يقصّر في دروسه أو يغيظ الأستاذ -استح |
| يكذب أو يسب -استح |
| الصغير يريد بغريزته أن يشعر بوجوده، وبأهميته، ويحب الحركة لأنه ميال بفطرته إلى الحرية، وإلى الشعور بها. |
| يتناول كل شيء بعينه، فيحب أن يتناوله بيده، وأن يعرفه، وأن يختبره.. الكرسي، الصورة، الصحن، النار، القط. |
| يقلب الكرسي، يجذب الصورة، يكسر الصحن، يلمس النار، يجر ذيل القط، يخنقه. |
| هو معتاد ألا يشعر بنفسه إلا بهذه الحركات. ومعتاد ألا يثير الاهتمام به، فيمن حوله إلا بهذه الوسيلة. |
| إذا هدأ وسكن، لم يلتفت إليه أحد، فلا يكون أكثر من قطعة أثاث تأخذ حيزها المحدود في الغرفة. |
| إذا بكى أو صرخ، أو تحرك، اهتم به الناس. |
| ينشأ معه هذا الميل إذا كبر قليلاً، فيقابل بزواجر القانون المختزل في كلمة واحدة يندر أن تتغير (استح) في البيت، في الزقاق، في الكتَّاب. |
| إذاً اللعب، الحركة، البكاء، الضحك، التقصير في الدروس عيب ينافي الحياء. |
| هذه عقدة عصبية. |
| عندما يشب.. يرى سمر الكبار، وحديثهم، ومزاحهم، وحريتهم، فيميل إلى المشاركة فيه بحذر وانكماش. (يجلس في طرف المجلس).. زجر.. نظرات قاسية.. استحِ. |
| يغني وحده، كما يسمع الكبار يفعلون -استحِ. |
| إذاً التشبه بالكبار حرية محرمة.. تسع الكبار، ولا تسع الصغار. |
| هذا هو الحياء؟ |
| إنه غير عادل، وغير جميل، لا منطق فيه. |
| هذه عقدة عصبية. |
| يظلمه الكبير، أخوه، أخته، أستاذه، زميله. |
| يشتكي -يبكي -يعلن غيظه -يتحدث صادقاً منفعلاً. |
| كذاب -أكبر منك- استحِ. |
| إذاً الصغير عندما يقول الصدق، يكون كاذباً! |
| وإذاً الظلم من الكبير (القوي) لا ينافي الحياء. |
| يشعر بالمرارة، يتعلم الحقد، يتحسر على الحرية، يكره حكم الكبار (العدالة) ويسأل نفسه لماذا لا يستحي الكبار عندما يضحكون، ويغنون ويمرحون، ولماذا لا يصدقونه، ولماذا يظلمونه؟ |
| لا جواب: |
| هناك إنهم أكبر منه (أقوى). |
| إذاً لا يجب أن يستحي إلا الصغير (الضعيف). |
| الحياء قانون، ولكنه مفروض عليه وحده. |
| الحق للكبير دائماً، لأنه قوي، وليس للصغير.. لأنه ضعيف. |
| الصغير لا حق له. |
| الحرية -الجمال -الغناء -الضحك -الحق -للكبار دائماً لأنهم أقوياء. |
| عقدة عصبية.. |
| كنا نقول إن الشعور بالمؤثرات، والمفارقات، في حياة الإنسان القديم، لا يقتضي التسمية.. كذلك هو في حياة الصغير.. معنى وشعور وإدراك. |
| يكبر، وتكبر هذه العقد العصبية في دمه ونفسه.. كما تكبر عقد عصبية أخرى لها خطورتها على أعصابه، وعلى مستقبله الفكري والنفسي. نشأ عن الكبت وسوء التربية.. وانحطاط البيئة، واختزان مؤثراتها. |
| وقد تضيع هذه العقد من ذاكرته، ولكنها تبقى في واعيته الخفية، قوة لا شعورية مستورة، ولكنها موجودة تعمل في نفسه وأعصابه، عملها المخيف الهادىء. |
| في المدرسة.. |
| يتعلم أن الصدق والشجاعة، والكرم، والعفو، والعفة، والرحمة، والصبر، والحلم، وطائفة كبرى من أمثال هذه السجايا.. فضائل واجبة.. |
| وتضرب له الأمثلة، في كتب الدين والأخلاق، والتاريخ، والإنشاء والمطالعة، على هذه الفضائل، وعلى الخير والبر والتقوى. |
| إن كان ذكياً رأى أستاذه يكذب، ورأى أمه تكذب على أبيه، وأباه يكذب على أمه، ورأى أنه لا ينجو من العقاب المدرسي إلا بالكذب.. ورأى الأستاذ يخاف، ورآه بخيلاً، ورآه لا يرحم، ورآه ضيق الصدر، ورآه عفيفاً في الظاهر فقط.. |
| التلاميذ يعرفون أسرار أساتذتهم ويكتشفون هناتهم ونقائصهم أكثر مما يعرفها الرجال. |
| وإن كان ساذجاً انفعلت نفسه وأفكاره بما يتلقى.. فأخذ نفسه ببعض الفضائل أخذاً، حتى يرى نفسه شيئاً شاذاً لا ينطبق على ما حوله. |
| يتطلعان إلى الحياة، الأول في ذكاء وخبث، والثاني في خجل، وحيرة، وتردد وانكسار. |
| وينشط كلاهما بالتدريج، ولكن نشاطاً حيوانياً خطراً. |
| الكبار يتمتعون بحريتهم، وأفكارهم، وألسنتهم الطليقة، الشاب يقلدهم. |
| تتكشف له الحياة عما يمارسون.. يراهم يقولون شيئاً.. ويفعلون ضده.. يستحون في الظاهر، ولا يستحون في الباطن، يخافون القانون.. ولا يخافون ضمائرهم، وقوانينهم الأدبية (الفضائل). |
| هذه عقدة عصبية.. |
| يرى خطيباً يخطب ويتلعثم. |
| يقول في نفسه، هو لا يحسن الخطابة. |
| يسمع الناس يقولون.. يستحي! |
| يدخل إلى مجلس غاص فيرتعد، يعرق. |
| يبتسم الناس، ويسألون لماذا تستحي؟ |
| يسمعهم يقولون: فلان يستحي كالنساء. |
| يرى الذين لا يستحون يتصدرون المجالس، والذين يتوقحون، يسيطرون عليها ولو سيطرة ظاهرة، ويضحك الناس لهم تشجيعاً. |
| إذاً فالحياء ضعف، كلما قل تأثيره في النفس، كان الإنسان قوياً.. |
| هذه عقدة عصبية خطرة. |
| * * * |
|
|
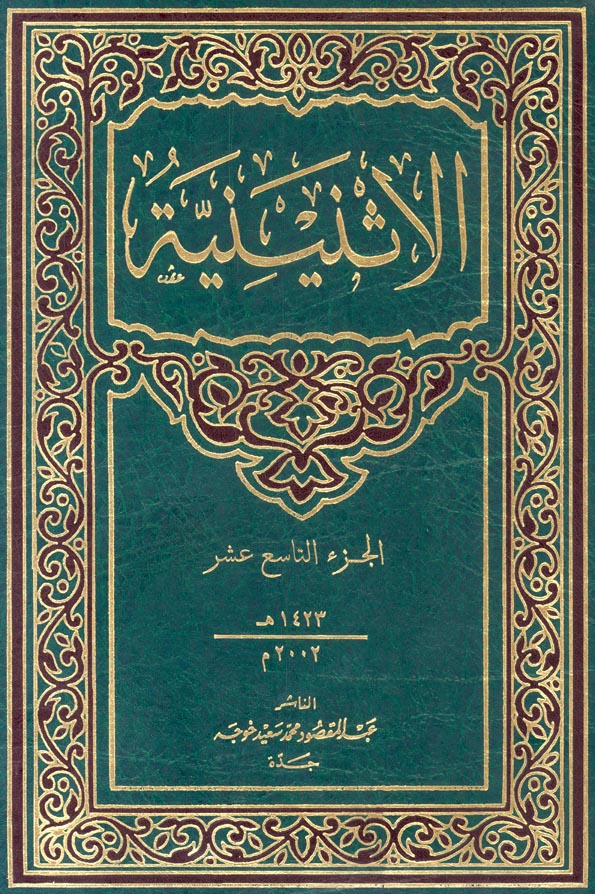
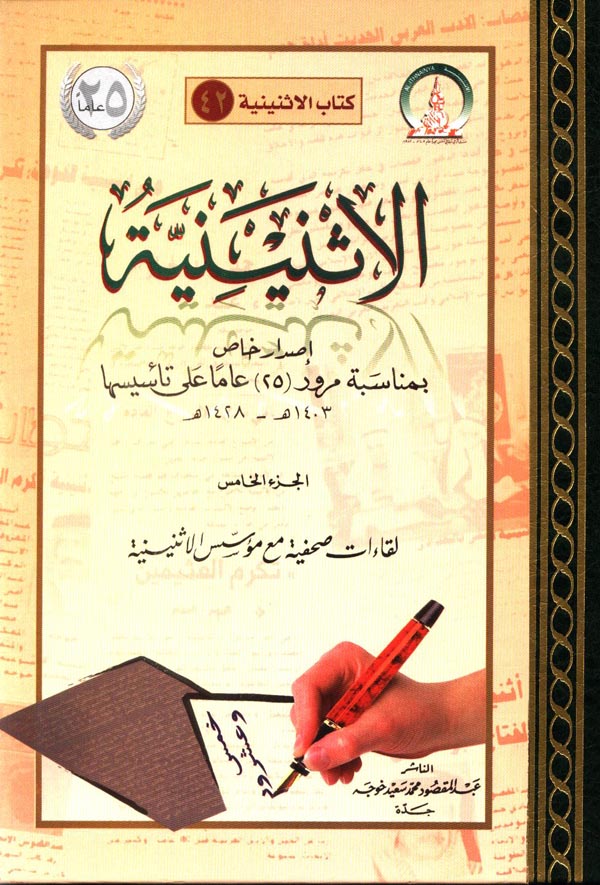
 شارع عبد المقصود خوجة
شارع عبد المقصود خوجة 00966-12-6982222 - تحويلة 250
00966-12-6982222 - تحويلة 250




