| هذا الكتاب |
|
بقلم: عبد المحسن حليت مسلم |
|
| هذه أول مرة أكتب فيها مقدمة لكتاب.. |
| ولا أنكر أنني خائف ومضطرب.. |
| كأنني أشبه ما أكون بشاب يلمس يد امرأة لأول مرة.. |
| أو طالب يدخل قاعة الامتحان لأول مرة.. |
| أو طبيب يمسك بالمشرط لأول مرة.. |
| وقد سألت نفسي أكثر من مرة.. لماذا؟ |
| ورغم أني لم أجد الإجابة إلا أنني أحسست أن خلع عباءة الشعر وارتداء عباءة النثر أمر صعب علي.. إن علاقتي بالشعر كعلاقة السحاب بالمطر.. وعلاقة الوردة بالأريج.. وأسماك السلمون بمياه الأنهار.. |
| فعباءة الشعر ملتصقة بجلدي ولو نزعتها فلسوف أنزع معها قطعة من جلدي.. لذلك فأنا لا أقابل الناس إلا بها، أما عباءة النثر فأستطيع أن أرتديها وأخلعها ألف مرة في اليوم ولكنني لا أقابل الناس بها لأنني لو فعلت فلسوف يسألونني عن اسمي واسم أبي واسم جدي. |
| قد يتصور البعض أن كتابة مقدمة ما، أمر هين، أما أنا فلا أراها كذلك.. خصوصاً حينما يكون الكتاب الذي بين يديك موغلاً في الروحانية، غائراً في الوجدان، ومحلقاً في أفق واسع من الشفافية والصفاء. |
| أول ما استوقفني في هذا الكتاب أنه كتاب خارج عن الصف.. سابح ضد التيار.. متمرد على المألوف!! |
| أريد أن أسأل القارئ.. |
| هل سبق لك أن قرأت كتاباً أكثره حديث عن البسطاء والفقراء؟ |
| هل سبق لك أن سمعت عن ((الزين)) أو ((ابن جبل)) أو ((ابن عيسى))؟ |
| هل سبق لك أن رأيت صورة أحدهم في صحيفة أو مجلة أو شاهدتهم على شاشة التلفزيون أو قرأت عن أحدهم خبراً يقول: سافر فلان أو وصل فلان أو قال فلان؟ |
| هل سبق لك أن رأيت أحدهم يدخل أو يخرج من باب كبار الشخصيات؟ |
| لقد جرت العادة أن تقصر الكتب على المشاهير أو شبه المشاهير من مؤرخين ومفكرين وشعراء.. الخ. ولكن أن يظهر كتاب معظمه حديث عن الفقراء والبسطاء، فهذا شيء لا نراه كثيراً. هذه هي أبرز سمات هذا الكتاب.. لقد كان خارجاً عن الصف لأن ((الزين)) و((ابن جبل)) و((ابن عيسى)) وغيرهم، لم يكونوا من علية القوم.. |
| كانوا دائماً يدخلون من ((باب السلام)) لا من باب ((كبار الشخصيات)).. |
| لم تكن تسعى إليهم أضواء الكاميرات بل كانوا هم يسعون إلى تلك الأضواء المنبعثة من القبر الشريف.. |
| لم يكونوا يطربون لـ ((موزارت)) ولا ((شتراوس)) ولا ((هايدن)) بل لعبد الستار بخاري وعبد الملك نعمان وحسين هاشم.. |
| وقبل الحديث عن هذا الكتاب، أود أن أحدد مسار المؤلف في معظم كتبه التي صدرت له: (ذكريات من الحصوة)، (حارة الأغوات)، (حارة المناخة) و (أشجان الشامية) وهي جميعها صور أدبية لبعض المواقع في المدينة المنورة ومكة المكرمة في عصور مختلفة، فالذي يقرأ كتبه هذه يذهب به الظن إلى أن هذا هو المحور الوحيد الذي تدور حوله اهتمامات المؤلف وكتاباته. صحيح أنه يرى أن من البر بهاتين البلدتين الطاهرتين أن يحاول أن يؤرخ لهما، وأن ينفض الغبار عن وجه تلك المواقع، وأن الوفاء يفرض عليه أن تكون مكة والمدينة هاجسه وهمه، ولا سيما أنه يرى انصرافاً شبه كلي وغياباً شبه مؤكد من قبل الكثير من الكتاب عن ربط أغصان اليوم بجذور الأمس لكي لا ينخر سوس النسيان جذع الذاكرة، فنحن معشر العرب أصبحنا نعرض ذاكرتنا للبيع في مزاد النسيان بأبخس الأثمان. |
| ومع تركيزه الشديد على هذا الجانب، إلا أن له كتباً أخرى تعكس ثقافته المنفتحة على أكثر من صعيد، فنجد كتابه ((نحن والآخر)) الذي يتناول في معظمه قضايا يدعو من خلالها لتأصيل الثقافة العربية والإسلامية موضحاً ذلك التهافت الذي نشهده على كل ما يرد من الغرب من فكر دون تمييز بين الجيد والرديء منه، إضافة إلى كتب أخرى مثل ((التآمر الصهيوني - الصليبي على الإِسلام))، و ((المدينة المنورة بين الأدب والتاريخ)). |
| ولكن هذا المؤلف الحاصل على شهادة الدكتوراه في ((الفلسفة)) من جامعة ((مانشستر)) ببريطانيا ((الصغرى))، يجد نفسه في ((حوائر)) المدينة ومكة مع البسطاء والفقراء، ولم تستطع شهادة ((الفلسفة)) يوماً ما أن تجعله يتعالى على ((حارة الأغوات)) ولم تمنعه من الحديث عن ((الشامية)) ولا الكتابة عن ((حارة المناخة))!! |
| وها هو اليوم، يلتفت - في هذا الكتاب - للحديث عن قوم لم يكونوا من علية القوم نسباً، ولكنهم كانوا من علية القوم ديناً وأخلاقاً وسلوكاً وقيماً. |
| أما ((الزين)) و ((ابن جبل)) و ((ابن عيسى)) فقد كانوا أصدقاءه بالأمس، وأقول بالأمس لأنهم جميعاً رحلوا إلى جوار بارئهم وبقيت ذكراهم تدق في ذاكرته التي لم تقفل نوافذها عنهم بعد رحيلهم. |
| ويؤكد المؤلف أنهم كانوا أصدقاءً جمعهم حب المعلم الأكبر والمخلوق الأطهر صلى الله عليه وسلم، ذلك الحبيب الذي تفنن العشاق في حبه بدءاً بأبي بكر وعلي رضي الله عنهما، ومروراً بباقي صحابته الذين كانوا في ((بدر)) و ((أحد)) يصدون بصدورهم عنه رمح قريش وسهامها، ووقوفاً عند الأنصار الذين خرجوا إلى مشارف المدينة يغنون له ((طلع البدر علينا)).. هؤلاء الأنصار الذين شاء الله يوماً أن يعاتبوا نبي الرحمة، فقدر الله أن يكون ذلك العتاب مناسبة كبيرة أعلن فيها سيد الخلق عن حبه الكبير الكبير الكبير لهم. |
| كان يوم العتاب، يوم حنين، وكان يوماً عظيماً، لا لأن الله نصر فيه رسوله وجنده فحسب، بل لأن ((المعلم)) محمداً صلى الله عليه وسلم كان يعطي فيه المسلمين ((الحق)) في أن يحاسبوه ويسائلوه ويعاتبوه، كان يعطيهم ذلك الحق وهو ((نبي)) لا ينطق عن الهوى، وكان بإمكانه أن يستخدم هذه الآية وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى (النجم: 3) سلاحاً في وجه كل من يريد أن ينتقده أو يحاسبه أو يعاتبه، ولكنه لم يفعل ذلك لأنه ((المعلم)) محمد صلى الله عليه وسلم. |
| وكان يوماً عظيماً أيضاً لأن الأنصار رأوا وسمعوا كم يحبهم محمد صلى الله عليه وسلم، وكم يذكر فضلهم وصنيعهم حين استقبلوه بأحضانهم بعد أن أثخنه قومه جراحاً وأذى. |
| في هذه الأبيات التي نظمها حسان بن ثابت، تكمن شكوى الأنصار وعتبهم: |
| وآتِ الرسولَ فقل يا خيرَ مؤتمنٍ |
| للمؤمنينَ إذا ما عُدّدَ البشرُ |
| علامَ تُدعى سُليمٌ وهي نازحةٌ |
| قدّامَ قومٍ هُمو آووا وهمْ نصروا |
| سَمَّاهمُ اللَّه أنصاراً بنصرهُمُ |
| دينَ الهُدى وعوانُ الحربِ تستعرُ |
| وسارعوا في سبيل اللَّهِ واعترفوا |
| للنائباتِ وما خاموا وما ضجروا |
|
| خلاصة القصة أنه بعد انتصار المسلمين في غزوة حنين، رأى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يوزع الغنائم على المؤلفة قلوبه والمحتاجين من المقاتلين، ولم يعط الأنصار شيئاً، وحين نظم حسان تلك الأبيات، وسمع ((سعد بن عبادة)) أن باقي الأنصار يشاركون حسان الرأي، ذهب إلى المعلم محمد صلى الله عليه وسلم ووقف أمامه وقال: |
|
((يا رسول الله.. إن هذا الحي من الأنصار قد وجدوا عليك في أنفسهم لما صنعت في هذا الفيء الذي أصبت، لقد قسمت في قومك وأعطيت عطايا عظاماً في قبائل العرب ولم يك في هذا الحي من الأنصار منها شيء)). |
| فسأله الرسول صلى الله عليه وسلم قائلاً: |
|
((وأين أنت من ذلك يا سعد؟)).. |
| فقال سعد: |
|
((ما أنا إلا من قومي))
|
| وعندها قال الرسول: |
|
((إذن فاجمع لي قومك)). |
| وفعل سعد، وجاء صلى الله عليه وسلم إلى الأنصار ورأى في عيونهم الحزن فقال لهم: |
|
((يا معشر الأنصار.. ما قالة بلغتني عنكم، وجدة وجدتموها علي في أنفسكم؟ ألم آتكم ضُلاَّلاً فهداكم الله؟.. وعالة فأغناكم الله؟.. وأعداء فألف الله بين قلوبكم؟ |
| وظل رنين السؤال يغوص في أفئدتهم إلى أن قالوا: |
|
((بلى.. الله ورسوله أمن وأفضل)). |
| وكرر نبي الرحمة السؤال: |
|
((ألا تجيبونني يا معشر الأنصار))؟ |
| فقالوا: ((بم نجيبك يا رسول الله.. لله ورسوله المن والفضل؟. |
| ويكاد الندم يعصف بكل واحد منهم، فقد وضع الرسول صلى الله عليه وسلم أمامهم حقيقة لا يستطيع أن يفر من أمامها عقل ولا منطق ولا وجدان، نعم كانوا ضُلالاً قبله، وعالة قبله، وأعداء فألف به الله بين قلوبهم.. |
| ولكن هذا العظيم محمداً صلى الله عليه وسلم لا ينسى اليد البيضاء التي آزرته، ولا القلوب التي احتضنته، ولا الصدور التي تلقت عنه الضرب والطعن منذ أن قدم إلى المدينة.. وبينما كانت رؤوسهم منكسة، وأفئدتهم دامية ندماً على ما قالوه للرسول، تأتي كلمات محمد صلى الله عليه وسلم لتجبر الكسور وتداوي القلوب الدامية وترفع لواء الوفاء والعرفان.. ويبدأ الرسول: |
|
((أما والله لو شئتم لقُلتم، فلصَدَقتْم وصُدقتم: |
| أتيتنا مكذباً فصدقناك، ومخذولاً فنصرناك، وعائلاً فآسيناك، وطريداً فآويناك..)). |
| وهنا بدأت منابع الدموع تستيقظ من شدة فرح الأنصار بما سمعوه من رسولهم، ولكي تنفجر المآقي ويهدر طوفان العبرات كان لا بد أن يسمعوا بقية ما لدى المعلم العظيم: |
|
((أوجدتم يا معشر الأنصار في أنفسكم في لَعاعةٍ من الدنيا تألفتُ بها قوماً ليسلموا، ووكلتكم إلى إسلامكم؟ |
| ألا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاة والبعير، وترجعون أنتم برسول الله إلى رحالكم؟ |
| وهنا سقطت آخر نقطة مقاومة في قلوب الأنصار، وبدأ طوفان الدمع يهدر، وتابع الرسول: ((فوالذي نفسي بيده، لولا الهجرة لكنت امرءاً من الأنصار.. ولو سلك الناس شعباً، لسلكت شعب الأنصار.. اللَّهم ارحم الأنصار.. وأبناء الأنصار.. وأبناء أبناء الأنصار)). |
| وبكى الأنصار بكاءً لم يعهدوه.. وتكلمت دموعهم، وصاحوا جميعاً بصوت واحد: |
|
((رضينا برسول الله قسماً وحظاً)).. |
| هذه إحدى صور الحب العظيمة لذلك النبي الذي قال عنه ربه وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ (القلم: 4)، وهناك صورة أخرى لهذا الحب، بل هي صورة فريدة لامرأة من بني الأشهل يقال إنها ((هند بنت عمرو بن حرام)) أخت الصحابي الجليل ((عبد الله بن عمرو بن حرام))، وزوجة ((عمرو بن الجموح))، ذلك الصحابي الذي قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم إنه سيد بني سلمة، وكان عبد الله بن حرام، وعمرو بن الجموح، صديقين حميمين، وكلاهما استشهد يوم أُحد، وحين كان المسلمون يدفنون شهداءهم، رآهما الرسول صلى الله عليه وسلم وقال ((اجعلوا عبد الله بن عمرو بن حرام وعمرو بن الجموح في قبر واحد فإنهما كانا في الدنيا متحابين متصافيين)). |
| وحين عاد المسلمون إلى المدينة من ((أُحد))، خرجت هذه السيدة تسأل عن المعركة، فقال لها أحدهم: |
|
((احتسبي الأجر في أبيك وأخيك وزوجك)).. |
| وكان أول سؤال تلفظت به: |
|
((وماذا فعل رسول الله))؟ |
| فقيل لها: |
|
((هو بحمد الله كما تحبين))
|
| فقالت: |
|
((أرونيه حتى أنظر إليه))
|
| وحين أتى الرسول صلى الله عليه وسلم قالت: |
|
((كل مصيبة فيما سواك تهون يا رسول الله))
|
| أي حب هذا.. وأي إيمان.. وأي فداء.. |
| ولكن هذا الحب لم ينقطع على مر القرون والدهور، فما زال محمد صلى الله عليه وسلم سيد البشر وأكبر محبوب وأعظم معشوق.. وليس هذا فحسب بل إن هناك قلوباً تآخت، ونفوساً تآلفت تحت مظلة حبه دون أدنى اعتبار للون أو لعرق أو لسان. |
| وهذا الحب هو الذي جمع قلوب هؤلاء الأربعة: المؤلف و((الزين)) و((ابن جبل)) و((ابن عيسى))، الذين نجد في ثنايا الكتاب أسماءهم وقصصهم كلما دقت أجراس الذكريات في ذهن المؤلف، هؤلاء وغيرهم من البسطاء، هم نجوم هذا الكتاب الذي نستشف من عنوانه (ذكريات من الحصوة)، إنه كتاب يشد الرحال إلى الماضي لينزل بين عبقه وجماله ونقائه. |
| أما الجزء الأول من الكتاب فهو عن المؤذنين في الحرمين، وفيه رحلة جميلة إلى تلك الأصوات التي كانت تستوقف الماشي وتفتح للخشوع في القلوب ألف باب وباب. |
| ومع أنني لم أدرك كثيراً من رموز الأذان كالريس عبد الستار بخاري والشيخ حسين بخاري، إلا أنني أتذكر - حينما كنت صغيراً - الأخوين عصام وعبد العزيز بخاري حينما كان صوتهما ينساب في كل المدينة، وحتى حين أكون خارجها، وأسمع صوت أحدهما، أشعر بيد خفية تنقلني إلى باب السلام، وتعيدني إلى سوق القَمّاشة وشارع العينية، وأعتقد أنهما قد خلقا تميزاً واضحاً للأذان في المدينة. |
| والمتأمل في هذه الحلقات عن الأذان والمؤذنين في الحرمين، يجد أن هذا الموضوع يجب أن يكون جزءاً مهماً من تاريخ البلدتين العظيمتين، ويجد أن المؤلف لم يقصر ارتباطه بهاتين البلدتين على حاراتهما وأماكنهما الموغلة في القدم، بل إنه يضع أمام الأجيال القادمة سفراً لمظهر من مظاهر التميز في مكة والمدينة، ويسجل في دفاتر الوفاء صفحات عن قوم رحل جلّهم عن هذه الدنيا ليبقى ذكرهم امتداداً لأصواتهم التي طالما بللت القلوب والآذان، وجعلت من المنابر قطعاً من المشاعر. |
| والكتاب، وإن كان في إطاره العام ينبش في ملفات الماضي القريب، إلا أن الإيقاع في الحديث عن الماضي، جاء إيقاعاً روحانياً وجدانياً، وحتى الصور الأدبية فيه لم تستطع أن تفلت من قبضة ذلك الإيقاع، ويتضح هذا في مجموعة ((أشواق الطريق)) و ((روابي قباء)). |
| ففي هاتين المجموعتين، وبالأخص ((أشواق الطريق))، نجد نبرة عالية جداً من التأمل والمناجاة لخالق هذا الكون سبحانه، واستهانة بالدنيا وبالذين يركضون خلف بريقه الذي ما انفك يأخذ مريديه إلى نهاية أهون ما فيها الندم وأشد ما فيها الهلاك. |
| وحديث المؤلف عن الماضي، تضمن أيضاً حديثاً عن أيام صباه حين يتذكر مكان نشأته والأماكن التي كان يتردد عليها ليطلعنا على مشاهداته في أسلوب لم يكن يريده أن يكون قصصيًّا، ولكنه كان كذلك. وكان يرمز إلى نفسه بكلمة ((الفتى))، ويرمز إلى والده - رحمه الله - بسيد الدار، أما سيد الدار هذا، فهو رجل أعرفه، ولا أدعي أنني أعرفه جيداً وذلك لفارق السن، ولكنني أعرفه ويعرف كل أهل المدينة أنه كان رجلاً ((عمرياً)) فقد كان في الحق كالرعد، وفي سلوكه كالسيف، كان صديقاً حميماً لوالدي - رحمه الله - وكان ((عمدة حارتنا)) في قباء، وكان نعم العمدة، وكان شعاره في عمله قول الرسول صلى الله عليه وسلم من ستر مسلماً ستره الله يوم القيامة. كان جل همه، في ذلك العمل، رضا الله، وبالرغم من كونه موظفاً، إلا أن اهتمامه ((بالناس)) كان يسبق اهتمامه بـ ((أي جهة أخرى)). |
| لم أشأ - في هذه المقدمة - أن أستعرض مع القارئ الكتاب، فذلك يتنافى مع ما أعلمه عن التقديم لأي عمل، ولكنني حاولت استجلاء هويته ولاسيما أنها هوية مختلفة لا نرى مثلها كثيراً في هذا الزمن. |
|
|

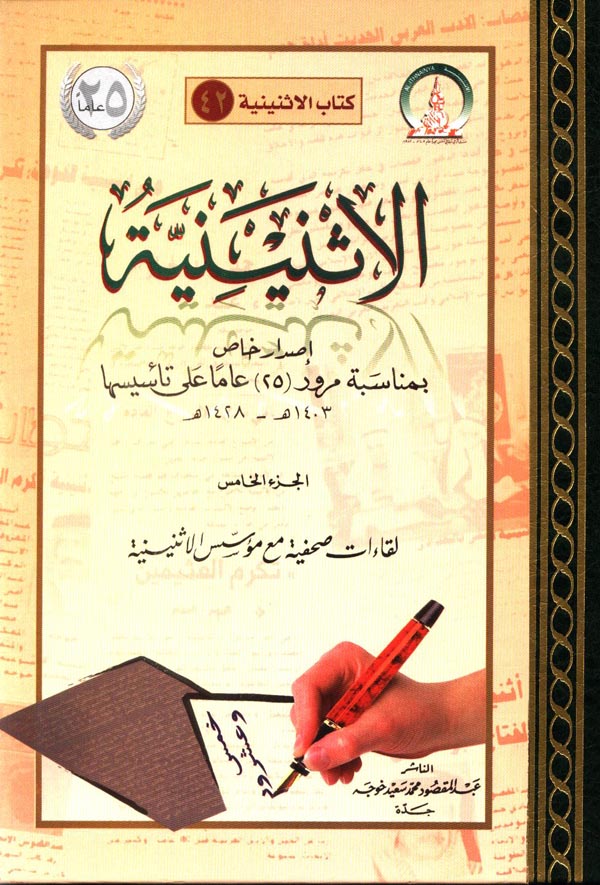
 شارع عبد المقصود خوجة
شارع عبد المقصود خوجة 00966-12-6982222 - تحويلة 250
00966-12-6982222 - تحويلة 250




