| -11- (الشخصية الخلقية) |
| وجدنا، ونحن نقرأ ذكريات عبد لله بلخير، بعض ملامح شخصيته وطبيعته الخلقية والاجتماعية والنفسية من تواضع وحياء، وانطباعات حسنة عن معارفه وأصدقائه، وتصرفات لائقة، وسلوك حميد.. في معاملاته، ورحلاته. وباختصار وجدنا كتابة، لنا أن نطلق عليها أدب السيرة الذاتية تضيء أحداثاً في حياته. |
| وإن أروع كتاب السيرة الذاتية هم الذين يعبرون عن مكنون شخصياتهم بصدق وبلا تكلف، ويتركون لأنفسهم الاسترسال العفوي يكشف بواطن وأعماق تلك الشخصيات، ويبرزون كل ما يخالجهم من خواطر، ويجسدون كل ما ينتابهم من مشاعر وأحاسيس.. كما دبت في النفس، وكما خطرت في الهاجس.. بلا ادعاء أو تفاخر، يرسمون شخصياتهم كما هي، وكما يحسونها.. لا كما يريدونها أن تكون. ويبوحون بمجريات الحوادث كما مروا بها وكما وقعت عليهم، والأحداث كما شاهدوها أو عانوها ويعترفون بمواقفهم حيالها في حالتي: الضعف والقوة، والإحجام والإقدام، والانكسار والانتصار، واليأس والأمل، والتشاؤم والتفاؤل. |
| على أن تلك الموازنة بين جملة هذه المفارقات لا تتأتى بدرجة واحدة، فقد يغلب جانب أو وجه على الآخر، وبخاصة الجانب أو الوجه المشرق الإيجابي حين تكون الشخصية متزنة مع ذاتها، ومع الواقع والمجتمع والحياة. فيغلب عليها الخط السعيد، أو الجهد الكبير الذي يمنح صاحبه طاقة قصوى يذلل بها الصعاب، ويتجاوز ويتخطى بها العراقيل، ويصل إلى شاطئ الأمان براحة وغبطة وسعادة. |
| عندها ستكون السيرة الذاتية لهذه الشخصية متوجة – في كثير من بوحها وسردها – بآيات ومعاني الإيجابية التي تؤول بصاحبها في كثير من الأحيان إلى النجاح والتوفيق والحظ السعيد. وقلما نجد في درب حياته معاني السلبية التي تعكرها إمارات الإخفاق والانكسار والفشل والألم والتشاؤم. |
| وعبد الله بلخير من هؤلاء المتفائلين الصادقين المتوازنين مع أنفسهم ومع الآخرين ومع الواقع ومع الحياة. وبخاصة مع العظام الذين يصنعون التاريخ والمعرفة والأدب والفكر بمواقفهم السياسية وأقلامهم الإبداعية. |
| وإن شخصيته لتتجلى لنا من خلال هذه السيرة الذاتية موشحة بأخلاق التواضع والحياء، ويحس بهما كلما استوجبت منه المواقف والمناسبات أن يورد شيئاً من نجاحه أو توفيقه أو تفوقه في مسيرة الحياة، ولا سيما في سيرته الشعرية والأدبية. منها مثلاً يوم أرسل إلى أمير البيان (شكيب أرسلان) في الطائف رسالة وقصيدة من مدرسته، يحييه بها ويبدي عاطفته نحو ذلك الوفد الذي جاء للإصلاح بين الملك عبد العزيز والإمام يحيى، ونحو أمير البيان. وقد أجابه برسالة لا تخلو من الشكر والتقدير والمحبة والإعجاب بشاعرية هذا الطالب الصغير. ووصف شعوره ساعة أرسل إليه مديره ليتسلم الرسالة، ولكم كانت لحظات غبطة وسرور تتيه بالمرء، وبالطلاب خصوصاً، زهواً وتفاخراً، ولكنه متزن مع نفسه دوماً، مسيطر على عواطفه وانفعالاته، فهو كعادته - كما يقول -: "لا أحب أن أتظاهر بأي انفعال من مثل هذا الموقف ولا بأي زهو في مثل هذا المقام". |
| ويظهر تواضعه وحياؤه حيث يتطلب منه المقام إيراد بعض الحقائق عن شخصيته، أو مواقفه التي يحتم عليه السرد والسياق ذكرها. |
| يقول في ذكرياته عن بداية معرفته بأمين الريحاني بعد تلك القصيدة التي مدح بها شكيب أرسلان وأعجبته وبخاصة هذا البيت: |
| يا صائداً مهج العباد بمكة |
| والصيد في البلد الحرام حرام |
|
| "إن القصيدة في حد ذاتها لم يكن فيها غير العاطفة الجياشة من تلميذ صغير نحو زعيم كبير.. وفيما أعتقد أن مفتاح كهربائيتها في عواطف أمير البيان لم يكن البيت السابق، والذي رسخ وحده في قلب الأمير فحفظه. وعندما غادر الطائف متوجهاً إلى مكة معتمراً سمعت بقدومه، وذهبت إلى الحرم أبحث عنه فإذا به في نهاية طوافه بالكعبة، حتى إذا ما انتهى مع أعضاء وفده ورجالات الدولة السعودية، دخلت بينهم مسلماً عليه معرفاً نفسي له، فاحتضنني بغبطة كبيرة كانت من أسعد أيام حياتي كلها، وهو يشجعني ويشكرني ويدعوني في اليوم التالي لتناول الغداء معه ومع الوفد في دار الضيافة السعودية بمكة". |
| أو كقوله في مكان آخر مستطرداً: "فلما دخلت في إحدى المرات على الأمير شكيب في مكتب (حسين العويني) مكتب دولة الرئيس فيما بعد – في بيروت، وصافحته كعادتي عندما يكون هناك، قدمني إلى الأستاذ أمين الريحاني بقول: هذا ابننا الشاعر وأردفها بما أستحيي أن أقوله الآن، ولكنه وديعة تاريخية، هو: (الشاعر الكبير) وكنت أعرف نفسي بأنني لست شاعراً كبيراً، وإنما الأمير يصدر في ذلك عن النفوس الكبيرة التي تشجع الشباب في مطلع حياتهم، وتحضهم على التطلع إلى العلا". |
| وفي حديثه عن الكشافة العراقية التي زارت الملك عبد العزيز، وقصيدته التي نظمها في تلك المناسبة، لا يريد أن يتفاخر بما أثارت هذه القصيدة من مشاعر وحماسة، فهو المتواضع، ولكن المقام يفرض عليه مثل هذا القول: "وليسمح لي القراء مرة أخرى معتذراً، عن الحديث عن نفسي أن أقول أن هذه القصيدة هي في نظري من القصائد ذات الحظوظ، والتي كان لها حظ كبير في الانتشار يومئذ.. فقد نشرتها الصحف، وحملتها البعثة العراقية عندما عادت إلى بغداد، وقررتها مديرية المعارف في العراق لطلاب المدارس والطالبات، فحفظوها وتغنوا بها" ويقوده الاستطراد دوماً، لأن الشيء بالشيء يذكر، ومن باب الطرف عمن لقيهم بعد تلك القصيدة من أصدقائه العراقيين الذين كانوا طلاباً في البعثة الكشفية أو من طلبة المدارس آنذاك، فيورد بعض المواقف المثيرة، ولكنها تثير خجله وحياءه. |
| لأنه يقول بداية: "ولا بأس أن أشير أيضاً بتواضع خجول إلى حادث جرى لي بعد ذلك طبعاً بنحو خمسة وأربعين عاماً عندما كنت في بيروت عام 1964، متقاعداً ومقيماً" ليفاجأ بضيف يقدمه له الأديب البيروتي (عز الدين بليق)، وهو (محمود شيت خطاب) أحد الكشافة. |
| ومن أخلاق أديبنا بلخير التي تظهر لنا في أحاديث ذكرياته انطباعاته الحسنة على معارفه وأصدقاء الأدب والفكر والسياسة عموماً آنذاك لما كانوا يتحلون به من قيم حميدة. فهو الذي يقول عنهم عقب كل مشهد نبيل منهم: "كانت أهداف الشاب العربي يومئذ صافية، ولهجاتهم صادقة، وقلوبهم مفعمة بالمحبة والإخاء والصدق". |
| وكذلك في إنصاف الرجال وتقديرهم، ووضعهم في الدرجة العالية مما يستحقونها، والإشادة بمآثرهم ومكانتهم العلمية أو الأدبية أو الدينية أو الفكرية أو الاجتماعية والسياسية وما أكثر هؤلاء الرجال. وتلك الشخصيات الفذة آنذاك. مما سنقرأ الكثير عنهم. لقد كان يحلم دوماً أن يظلوا في ذاكرة العرب والمسلمين. وأن يحيا ذكرهم. وتطبع وتقرأ مؤلفاتهم. كان يقول إثر الانتهاء من الكلام عن شكيب أرسلان: |
| "رحم الله الأمير المجاهد النبيل الجليل شكيب أرسلان، ووفق الله لجمع آثاره، وطبع مؤلفاته، وإحياء ذكره.. لتتعرف الأجيال الجديدة في الأمة العربية والإسلامية على مُثُله وأمثاله، عسى أن يكون لها من ذلك عظة وعبرة". |
| وتبدو فكرة الإنصاف عند أديبنا بلخير بشكل أوضح حين لا يجد الذكر الكافي في إنصاف الرجال العظام، ومنحهم حقهم من التقدير، ولذلك يتمنى من التاريخ بل من رجاله أن ينصفوا أمثال المجاهد أمين الحسيني وغيره. |
| فيقول نهاية عنه: "هكذا فالحديث عن الحاج أمين الحسيني يجدر بسواي أن يطيل فيه ما اختصرت والتاريخ إلى أن لم ينصفه، كما لم ينصف بلاده وقومه، ولا نعلم إذا كان في المستقبل أمل لإنصاف من غمط حقهم من رجالات العرب أم لا". |
| على أن أديبنا عبد الله بلخير منح هذا المجاهد بعض حقه في الإشادة والتقويم، وترجم لنا إحساسه وشعوره إزاء الزعماء والعلماء الذين افتقدهم العرب والإسلام ورحلوا، وقد شارك في تشييع جنائزهم، وقدر منازلهم. في مثل هذا الحكم للرجال الأفذاذ تتجلى فيه أصالته، وطيب معدنه، ونقاء سريرته، وحبه للعظام دوماً، إن لم يكن لكل الناس. |
| ولهذا يقول عن المجاهد أمين الحسيني وهو بصدد تعداد رجالات العرب وزعماء المسلمين الذين كانوا يحرصون على أداء الحج كل عام في تلك الأيام إذا واتتهم الفرصة للقيام بذلك: "سماحة الزعيم المجاهد الحاج أمين الحسيني المشهور بمفتي القدس، وهو زعيم الكفاح والصراع في سبيل تحرير فلسطين منذ أكثر من سبعين عاماً، حتى توفاه الله منذ بضع عشرة سنة في بيروت حيث دفن بها في مقابر الشهداء... وكنت واحداً من جماهير غفيرة شيعوا جنازته، ووقفوا على قبره، وتألموا لفقد العالم الإسلامي لرجل مثله. |
| وكان أديبنا بلخير قد أشاد بأحد هؤلاء الزعماء من تلك الشخصيات الإسلامية والسياسية والعربية الفذة، ممن وفد لحج في عام 1939م، وهو الزعيم اليمني أحمد محمد نعمان، وقد أورد كلمة – هذا الزعيم – الذي سيصبح صديقه فيما بعد وإلى اليوم – في حفلة الشباب في منى، واستشهاده بأبياته الأربعة - التي كررها قبل ذلك، وتكراره – كما قلنا – ليس عن ادعاء وتفاخر، وإنما المناسبة هي التي دوماً تفرض عليه ذلك... ويا لها من مناسبة تستحق الذكر، ويقدرها القارئ، لأن أديبنا بلخير يروي أحاديثه – كما عودنا – بلغة القلب، ولسان الوجدان وعفوية الخاطر، وصدق القول والتعبير... وهو قول يلتحم مع ذكرياته العذبة والسارة والجميلة مع شخصياته البارزين أمثال هذا الزعيم اليمني الذي رسم لنا صورة شائقة مثيرة محببة عنه، تظللها سمات الإنسان والقائد والسياسي والأديب. |
| ولنقرأ النص كاملاً، لأن فيه إضاءة لجوانب وزوايا عديدة من شخصية أديبنا بلخير التي نحاول أن نظهرها للقارئ في هذه السيرة الذاتية: |
| "وأتذكر أنه في حج عام 1939م قدم مع بعثة الأزهر من مصر صديقنا فيما بعد وإلى اليوم الزعيم اليمني المشهور دولة الرئيس أحمد محمد نعمان. وكان بين البارزين المدعوين إلى حفلة الشباب في منى ذلك العام، فتحمس كعادته، وكان يومئذ لا يزال في عنفوان حيويته وصولته وثورته.. وقد سمع زعماء العالم الإسلامي يتحدثون ويخطبون في ذلك الحفل، فوقف يلقي كلمة مطولة دعا فيها إلى الوحدة العربية، وأطال فيما دعا وتحمس فيما خطب حتى قال مستشهداً بما يدعو إليه... قال – كما قال الشاعر عبد الله بلخير-: |
| شبه الجزيرة موطني وبلادي |
| من حضرموت إلى ربى بغداد |
| أشدو بذكراها وأهتف باسمها |
| في كل جمع حافل أو ناد |
| منها خلقت وفي سبيل حياتها |
| سعيي وفي إسعادها إسعادي |
| كل له فيمن أحب صبابة |
| وصبابتي في أمتي وبلادي |
|
| وعفواً إذا أعدت الأبيات الأربعة مرة أخرى بعد أن ذكرتها في حلقات سابقة جاءت مناسبتها. وما قصدت الآن إلا أن أروي هذه الطرفة منسوبة إلى صاحبها الأستاذ النعمان أمد الله في حياته وهو يرويها في كل مناسبة نلتقي معه فيها أو بآخرين. |
| ولقد صفَّق الحاضرون في تلك الحفلة والندوة لخطاب الأستاذ النعمان الذي كان كعادته ساحراً فيما يقول وينشد، حتى إذا انتهى منها، وأقبل عليه من يهنئه على الكلمة، كما هنأوا غيره من خطباء الحفل. قمت أنا أشق طريقي إليه ماداً له يدي أحييه على كلمته. فقال لي: من الأخ؟ فقلت له: عبد الله بلخير، فذهل لما سمع! وقال لي: كنت أظنك، وقد رويت مطلع إحدى قصائدك من محفوظاتي، أنك شيخ كبير بلحية طويلة وعباءة فضفاضة وعصا طويلة تتوكأ عليها، وها إنك في عزة شبابك
(1)
، ترى أأنت الشاعر؟ فتبسمت وقلت: نعم. فقال لي: يا سبحان اللهّ!. |
| لقد ربطتنا منذ تلك اللحظة صداقة تراوح عمرها نحو نصف قرن تقريباً، التقينا خلاله مئات المرات، ولا نزال نجتمع في صيف كل عام في مدينة (جنيف) بعد أن تكون اجتماعاتنا في (جدة)، وأحاديثنا بالهاتف في كل صباح. وفي جنيف يجيئني الأستاذ من فندقه إلى الفندق المجاور له، فندق (دولابيه)، فنجلس الساعات الطويلة في ذكريات لا تنقطع، بل تتجدد إذا كنا في بلد واحد كل يوم. وهكذا فلي مع الأستاذ النعمان وكل من عرفه، ابتداء من الإمام يحيى، فالإمام أحمد، فالرئيس جمال عبد الناصر.. فأكثر رؤساء العرب وملوكهم من الذكريات المتجددة التي لا يمل سماعها، ولا ينضب معينها. وهو أستاذ سياسي ملون الثقافة، فيه ذكاء مفرط، وشمم متوارث، وهو في مناصبه الرفيعة، ومصائبه المتوالية المخيفة منذ نصف قرن، التي تحتوى على العجب العجاب والمضحك والمبكي. وأستطيع أن أتحدث عن هذا الصديق في مئات، إذا لم أقل ألوف الصفحات… كما يشاركني في إعجابي به، ودهشتي منه كل من عرفه وعرف عبقريته وفطنته ولماحيته ومكره، وشهامته، وهو صالح لكل شيء، وفي كل زمان ومكان، ثم هو بعد كل ذلك لما شئت إذا شاء وطرب. |
| الزعيم أحمد محمد نعمان دخل السجن وحمل الأغلال والقيود، ولبس العمامة، وتولى في المحاريب الإمامة، وانتصب وزيراً، فعضواً لرئاسة الجمهورية.. وكان مع كل هذا الأديب والمؤانس والسمير المبدع، والشديد واللين. فإذا اشتد لا يقدر عليه أحد، وإذا لان فهو كخطرات النسيم لا يمل سامعه كلامه، ولا يحب صاحبه أن يفارقه إلا إذا انتفض وتملص ثم قام خارجاً لا يلوي على شيء... فهناك الإعصار المدمدم الذي لا يقف أمامه واقف، حتى إذا هدأ فهناك الوداعة والرقة والعبقرية والشمم. ولي معه ذكريات طويلة، ولغيري معه ذكريات أطول، والحديث عنها مني ومنهم لا ينتهي، وله طرف وملح مع ملوك اليمن ومع كبار رجال الثورة في مصر، ورجال السياسة في العالم لا يستثنى منها أحد، المطرب والمعجب". |
| وكان يرغب أديبنا عبد الله بلخير دوماً أن يكون من يروي أخباره من الأحياء لو أنه يقرأ كلامه عنه، كي تتصل الأرواح ببعض وتتناجى القلوب المحبة عبر الأثير، وتتواسع المسافات، وتتجدد مشاعر الحب والوفاء على الدوام. |
| ولهذا فإنه ينهي نصه السابق بهذه العبارات: "تحياتي إليه والسلام عليه إذا ما قرأ ما ذكرته عنه وذكرني فيمن عنده، وهو – جزاه الله خيراً – كثيراً يفعل ذلك، مع من أحب، وأرجو أن أكون منهم". |
| كما تتجلى لنا شخصية أديبنا عبد الله بلخير المتميزة بمواقفها السامية من الأخلاق في كثير من أحاديث الذكريات والرحلات والسيرة الذاتية، وفي أساسياتها وجزئياتها، كبيرة أو صغيرة، في مواقفها وتصرفاتها، فهي السيرة المتوازنة اللائقة، ولقد مر بنا عنها الشيء الكثير في الشؤون العربية والإسلامية والوطنية وغيرها. ولكن نود هنا أن نقف عند رحلاته إلى دمشق، نجده مدفوعاً للرحلة ليكون سباقاً إلى صنع الخير والمكرمات، فتشده الأصول إلى جل المناسبات. |
| "وقررت السفر في العطلة الأسبوعية من بيروت إلى دمشق للبحث عن مقر ورئاسة البعثة الكشفية للسلام عليها، والترحيب بها باسم الشباب السعودي، وما قد تراءى لي بأنها قد تحتاج إلى بعض المعلومات". |
| فمن خلال قصة سفره، وركوبه الحافلة من المرجة إلى مقر نادي الكشاف العربي، وأسلوبه الشائق في معرفة أصول الحديث والمفارقات التي قد يتعرض لها الغريب والرحالة. سنجد أن أديبنا بلخير رحال معاصر وسندباد أصيل، يمخر عباب البحار في مركب وشراع، بشخصية عذبة رائعة، ونفس عربية مثيرة بأحاسيسها الوطنية والقومية.. فثمة اندفاع لتجسيد الأخوة العربية، هي من سمات شخصيته أينما كان، والأخلاق العربية من كرم وشهامة ومروءة ونخوة وغيرها من فضائل، مما نلمسها في كتاباته ورحلاته، وهي الأنفاس التي عودنا عليها كلما التقى بشباب عربي أينما حل، وأينما رحل.. فهو الرجل الذي يعرف واجبه الوطني والقومي. |
| ولقد سارت رحلات أديبنا بلخير – غير ذكرياته – سيراً طبيعياً.. طرقه ممهدة لم تعترضه صعوبات مكدرة صفو رحلاته، أرضه الصعبة الوعرة تصير من تحت قدميه هشة لينة رخوة مفروشة بنور الله وتوفيقه.. يصل إلى غايته بأمان وسلام. |
| لم نسمعه يشكو أو يتذمر، أو يتضايق من مجريات الرحيل ما لا بد منها، إذ تصادف المرء عادة مهما كان شأنه
(2)
، وإن مرت به بعض هذه المصادفات من سوء الآخرين أو تصرفاتهم الشائنة فإنه يشير إليها بلا إساءة لهم وبلا انفعال، كأن لم تكن. وإنها شخصية المتفائلين المتوازنين مع النفس كما قلنا، على أن أكبر منغص صادفه في رحلاته هو ذلك الموقف الذي اتخذه منه سفير مصر في عاصمة النرويج (أوسلو)، حين خيَّب أمله، وانطفأت في قلبه وقدة الأخوة وحرارة العاطفة العربية الأصيلة.. هو لم يقل ذلك، ولكننا أحسسنا أنه عانى من ذلك الجفاء الذي قوبل به رغم أنه قصده لمصلحة إسلامية ومهمة سامية تخص المسلمين هناك. |
| "وتوجهت في اليوم الثاني لوصولي إلى النرويج في سيارة أجرة لزيارة السفارة المصرية بالعاصمة (أوسلو)، حاملاً معي بطاقة التعريف من الصديق السفير (ناصر المنقور) في (استوكهولم)، ووصلت مبنى السفارة، ودخلت إلى قاعة الاستعلامات فيها، وكانت السفارة تتألف من دورين، الدور الثاني العالي وفيه مكتب السفير وموظفيه. فاستقبلتني السكرتيرة النرويجية تسأل عما أريد. فقلت لها: إنني سعودي أرجو أن أقابل السفير المصري، فاتصلت به هاتفياً فجاء الجواب أن تسألني عن الغرض من زيارتي له، فقلت لها: أتشرف بمعرفته والسلام عليه، فأخبرته بذلك، ثم قالت لي: انتظر، وأشارت إلى كرسي، ذهبت وجلست عليه، وبقيت مدة طويلة في الانتظار، حتى هممت بالاعتذار منها والانصراف، عندما رأت ذلك في ملامح وجهي اتصلت مرة أخرى بالسفير، ولا أعلم ماذا قالت: إلا أنها قد أشارت إلى السلم الحلزوني إلى الدور الثاني وهي تقول لي: تفضل. ووجدت على رأس السلم موظفاً مصرياً شاباً رحب بي باتزان، ثم أدخلني إلى غرفة وأشار إلى كرسي أمرني أن أجلس عليه، ففعلت، وقال لي: الحمد الله على السلامة، فشكرته، ولم أعلم هل هو السفير أم موظف من موظفيه، فذكرت له أنني أحمل بطاقة من سفيرنا في السويد لصديقه السفير في سفارتكم، ولا غرض لي إلا السلام عليه، وتبليغه سلام زميله السعودي والاستفسار عن بعض الأسئلة عمن يكون في هذه البلاد من الجاليات الإسلامية. |
| فأخذ مني البطاقة وقال لي: "والله ما فيش حد مسلم في هذه البلاد إلا الموظفين في هذه السفارة. أما السفير فهو مشغول في الوقت الحاضر" وكنت أستمع عبر الباب الموارب لأحاديث السفير مع من كان يتحدث معه فيما لا يدل على أنه عمل. فقلت له: هل تجمعات العمال في هذه البلاد مثل تجمعاتهم في بلاد السويد؟ فقال لي: تقصد إيه؟ قلت له: الغالب أن يكون بين العمالة أعداد من البلاد الإسلامية كتركيا ويوغوسلافيا وبعض بلدان الشمال الإفريقي أو العربي، فقد يكون لهؤلاء شبه نقابات أو نواد يعرفون بها. فقال لي: لا يوجد في النرويج شيء نعرفه من هذا القبيل، فتحركت في كرسي متأهباً للوقوف مستأذناً منه في العودة من حيث أتيت، فقام وودعني على باب مكتبه، وانحدرت في السلم خارجاً من الباب، باحثاً عن سيارة أجرة أعود بها من حيث أتيت. ولم يتسن لي في هذه المقابلة أن أعرف شيئاً مما أريد، وأسفت لتسلمي بطاقة الأستاذ السفير المنقور التي كنت أحملها، فقد كان في عدم رغبة السفير مقابلتي بعد كل ما ذكرت ما لم أكن أنتظره، خصوصاً وقد كانت ضحكاته وأحاديثه بصوت عال من غرفته تصل إلى مسامعي بأنه كان كلاماً أقل من عادي". |
| على أن أديبنا بلخير لا يعمم حكمه على الآخرين أمثال ذلك السفير، فهو يعرف أن الدنيا بخير، وأن الخيرين كثير والسيئين ندر. |
| لذلك يختم نصه السابق بقوله: "ويندر أن يكون بين إخواننا وأشقائنا المصريين في سفارتهم في كل مكان من العالم، كما شاهدت ولمست من لا يخف للترحيب بأي عربي يزور سفارة من سفاراته. وهذا شيء لا يحتاج إلى شهادة مني، فهم في ذروة الأخوة والضيافة والمجاملة والمساعدة"
(3)
. |
| وتتجلى لنا أخلاق عبد الله بلخير في علاقاته مع أصدقائه، وبخاصة أصدقاء العلم والمعرفة والأدب – سواء من كانوا في وطنه أو في الوطن العربي والعالم والإسلامي – وما أكثر هؤلاء الأصدقاء، وما أقوى رابطة الصداقة التي تربطه بهم جميعاً، ولكم روى لنا بداياتها مع أعلام وشخصيات فذة، لم يكن بعضها بهذا القدر من القيمة لولا هذا الكلام الذي نقرأة عنهم. ولقد مر بنا الكثير من النماذج الخالدة في عالم الصداقة والمودة والحب والمشاعر السامية التي تلتقي دوماً على الخير والبركة. |
| وإن في تلك الصداقة الكثير من المعلومات التي هي أشبه بالوثائق التي تؤكد أحلام وطموحات جيل الثلاثينيات وما عبده بقليل من هذا القرن، في عالمنا العربي والإسلامي. استطاع أديبنا، ومن خلال علاقاته بنماذج عديدة من أولئك الأعلام الفكرية والعلمية والأدبية والدينية، أن يصور الواقع العربي بكل تفاصيله ومفرداته السياسية والقومية والأدبية. |
| وإذا كانت أسماء أصدقائه العرب والمسلمين خارج وطنه كثيرة – كما رأينا – فإن أسماءهم الوطنية أكثر. ولهذا وردت أسماء لشخصيات أدبية سعودية لا تعد ولا تحصى لدرجة أنه كان يورد تعدادهم بالعشرات ممن تجمعه بهم صناعة الأدب ونظم الشعر، ولا يذكرهم إلا بالخير والقول الحسن. على أن بعض تلك الأسماء تكررت كثيراً وتبدى عنها علاقات طيبة ومخلصة تقوم على حب الأدب والمعرفة والفكر، ونخص منهم (محمد سعيد عبد المقصود) الذي كان رئيس تحرير جريدة (أم القرى) ومدير مطبعة الحكومة في مكة. وقد أورد اسمه في مجالات الأدب والحرص على نشره، وفي مواقف السمعة الحميدة، فعرفنا أنه كان يزوده بصحف العالم العربي، وأنهما يشتركان في مطالعتها، ومطالعة بعض الكتب العربية التي كان لها دوي إعلامي كبير آنذاك، وكلاهما يحب المطالعة بدرجة قصوى، ولقد وقفنا عند حب بلخير للمطالعة حالما يصل بيروت، وحب محمد سعيد عبد المقصود للمطالعة والكتب يوم ودع صديقه وحمله رغبته ووصيته بأن يرسل له من بيروت كتاب (ابن أبي ربيعة) بأجزائه الثلاثة. |
| على أن الصداقة بينهما، وهما بعيدان عن بعض، ترجمتها الرسائل، ومضامينها المصلحة الوطنية والأدبية وسمعة الجزيرة العربية. فكان أديبنا بلخير من حين لآخر يبعث برسائله إليه يطلب نتاجاً من أدباء السعودية كي ينشره في صحف لبنانية، أو في الدعوة إلى عقد مؤتمر لطلاب العرب بصفته رئيس جمعية الشباب العربي في بيروت، وفشلت المحاولات في المرسل والمرسل إليه، كما كانت بعض الرسائل الأخرى ذات صبغة إعلامية مثل إخباره بضيوف الكشافة السورية الذين سيصلون المملكة. |
| على أن ما تجدر الإشارة إليه في هذه العلاقة الحميمة هو مناسبتان ذكرهما لنا أديبنا بلخير: الأولى حول كتابهما (وحي الصحراء)، والثانية حين اشتركا بإعداد بلاغ عن محاولة مقتل الملك عبد العزيز، وفي المناسبتين يشتركان في عمل جليل. |
| فقد أورد قصة اختيار هيكل ليكون مقدم كتابهما، وذلك حين زار المملكة، لأهمية كتاب (وحي الصحراء) في الأدب السعودي وريادته في بلورة الأعمال الشعرية لمجموعة من الشباب السعودي، وفي إبراز باكورة إنتاجهم وإبداعهم الأدبي، نود أن نشير إلى ما رافق هذا الكتاب من أمور ومعلومات قبل طبعه وبعده، ليضاف إلى دور صاحبيه في نهضة الأدب وحركة الثقافة لهذه الجزيرة العربية الشامخة. |
| ولهذا فعلينا أن نقرأ النص التالي: "وعلى هذه المنزلة التي كنا نكنها للدكتور هيكل في قلوبنا اخترناه دون غيره ليتولى تقديم كتاب (وحي الصحراء) الذي ألفته مع زميلي محمد سعيد عبد المقصود منذ نصف قرن، وذلك الكتاب كما وصفناه صفوة الأدب العصري في الحجاز يومئذ، فرحب الدكتور باختياره لكتابة مقدمته، وكتبها بروح ودية أدبية صادقة مسهبة. ولقد حملت له نسخة من نسخ الكتاب فور نهاية طبعه في مطابع الحلبي بمصر، وتوجهت إليه في مكتب مجلة السياسة الأسبوعية بمصر، مسلماً ومهدياُ له الكتاب، ففرح باستلامها، ورحب بتلقي الحركة الأدبية التي أضاءت الجزيرة، وكان حديثه معي عن ذكريات حجه ومن تعرف بهم من الشباب يفيض بالمحبة والصدق والتشجيع. وأتذكر أنني قد حملت نسخة أخرى من ذلك الكتاب وتوجهت بها إلى خاله أحمد لطفي السيد، وكان الدكتور هيكل هو الذي أخذ لي موعد زيارتي تلفونياً، فتقبل الكتاب بمحبة وتشجيع، وكما قدمت أيضاً نسخاً أخرى هدية مني ومن زميلي محمد سعيد عبد المقصود يومئذ للدكتور فؤاد صروف في دار المقتطف، وللدكتور صروف الكبير وللأستاذ وديع فلسطين ولكبار أدباء مصر الآخرين.. وقد جر الكلام إلى هذا ذكر الدكتور محمد حسين هيكل وحبه وزيارته للحجاز". |
| أما المناسبة الثانية فقد ذكرها حين عرج على دار الحكومة خارجاً من ركب أهله في الحج وعند باب إبراهيم من أبواب الحرم المكي، ويرى صديقه (محمد سعيد عبد المقصود)، وسنجده دؤوباً، وله مواقفه وإيجازاته ومساهماته الوطنية، والاجتماعية والشخصية والأدبية. وهذا المشهد واحد من مئات المشاهد في الإنجاز والعمل والدأب. وإننا في تلك المناسبة لنجد فيه الكثير من الإثارة والحيوية.. فضلاً عن روح الإعلام والسبق الصحفي الذي يحاول الصحفيون أن يتحلوا به اليوم: |
| ".. ولم أكد أصل إلى ركن الحرم المكي المقابل لمطبعة الحكومة، واليوم يوم عيد، حتى لفت نظري عندما ألقيت نظرة بعيدة على المطبعة أن بابها كان مفتوحاً، واستغربت ذلك، فاليوم يوم عيد والناس مشغولون بأيام التشريق والحج، والمطبعة وإدارتها تحت إشراف مديرها صديقي الأستاذ محمد سعيد عبد المقصود، وهو الرجل الذي لا نكاد نتفارق معه إلا في ساعات قليلة من النهار أو الليل. |
| فتوجهت حالاً إلى باب المطبعة لأستجلي الأمر خوفاً أن تكون فتحت لأي سبب من الأسباب، نظراً لصداقتي معه. وأسرعت للذهاب إلى باب دار المطبعة، ولم أكد أتسلق درجاتها الأربع، وأشرف على بهو مطابعها الكبير حتى سمعت ضجة المطبعة الكبيرة، ورأيت صديقي محمد سعيد عبد المقصود بملابس إحرامه وهو يدير عجلة المطبعة، إذ أنها كانت من النوع القديم ومن مخلفات الدولة العثمانية، وقد أجهده التعب، وغسله العرق، فلم يكد يراني، وأنا مستغرب وجوده في مثل هذا الوقت حتى صاح بي: الحقني وساعدني في إدارة عجلة المطبعة، ووقفت مبهوتاً ممَّا سمعت ورأيت وأنا أقول له: ما هذا الذي تقوم به؟ فقال لي: ألم تعلم ما جرى اليوم؟ فتسمرت قدماي في مكانها وصحت به: وما الذي جرى؟ فقال لي: لقد نجا جلالة الملك عبد العزيز وسلمه الله من محاولة اعتداء أثيم على حياته أثناء طوافه بالكعبة، فصحت به مذعوراً: وكيف كان ذلك؟ قال لي: لا وقت عندي، فأنا أطبع الآن البلاغ الرسمي عن هذا الحادث الذي جاءني من ديوان الملك وهو ينتظره الآن مني، وقد كلمني الشيخ ياسين منذ برهة يقول لي: ابعث لنا الدفعة الأولى من البلاغ الرسمي لنفرقها على الناس في منى تطميناً لخواطرهم، وتبياناً لحقيقة ما جرى، ثم قال لي: وأنا لم أجد أحداً من موظفي المطبعة إلا واحداً استعنت به على جمع حروف البلاغ، وأرسلته الآن يبحث عن الآخرين، وتوليت بنفسي إدارة الطبع، وقد جاء بك الله لي الآن فخذ الدفعة الأولى من هذا البلاغ وتوجه به حالاً إلى الديوان الملكي في منى ريثما ننتهي نحن من البقية الباقية وألحقكم بها بعد ذلك إلى هناك. وتناولت ورقة مما طبع عليه ذلك البلاغ، وبدأت أقرأها في وجل وقلق، ومحمد سعيد يدير العجلة ويحدثني باختصار عما حصل في مساء البارحة. |
| وجاء هاتف من الشيخ يوسف ياسين في الديوان الملكي بمنى يسأل: ألم تنته المطبوعة؟ فقال محمد سعيد: هي الآن مع الأخ عبد الله بلخير، متوجهاً بها إليكم، وأنا بنفسي واقف على إنهاء المهمة". |
| ومما تجدر الإشارة إليه في نهاية هذا الكلام عن أخلاق أديبنا عبد الله بلخير هو أسلوب التعبير عن شخصياته وأصدقائه. فقد وردت في ذكرياته شخصيات سياسية ودينية وعلمية وفكرية وأدبية وشعرية: سعودية وعربية وإسلامية، ولا تعد ولا تحصى. ذكرنا بعضاً منها في هذه الدراسة، وقد ذكرها لنا في أحسن الذكر، ونعتها بأطيب الصفات، وأثنى عليها بما هي أهل للثناء، وأنصفهم حقهم، وأنزلهم منازلهم. |
| كل ذلك يدل على معدن أديبنا الأصيل، وأخلاقه العربية الفذة. فلم يخنه الوصف، ولم نر منه تعبيراً نابياً، أو إساءة لأحد منهم، سواء أكانوا أحياء أم أمواتاً، فكان يرجو الله طول العمر للحي، والرحمة للميت. ومعظم شخصياته ورجاله التقى واجتمع بهم، وبنى معهم علاقات حميمة – قامت على الصدق والحب – دامت وخلدت في ذاكرته وذكرياته، ودخلت رحاب التاريخ الأدبي والثقافي، والتحمت مع وقائعه، وأصبحت وثائق أدبية وفكرية لم يود أن يستقي منها معالم الحياة الثقافية والسياسية والتاريخية والأدبية لتلك الحقبة من تاريخ الأمة العربية. |
|
|
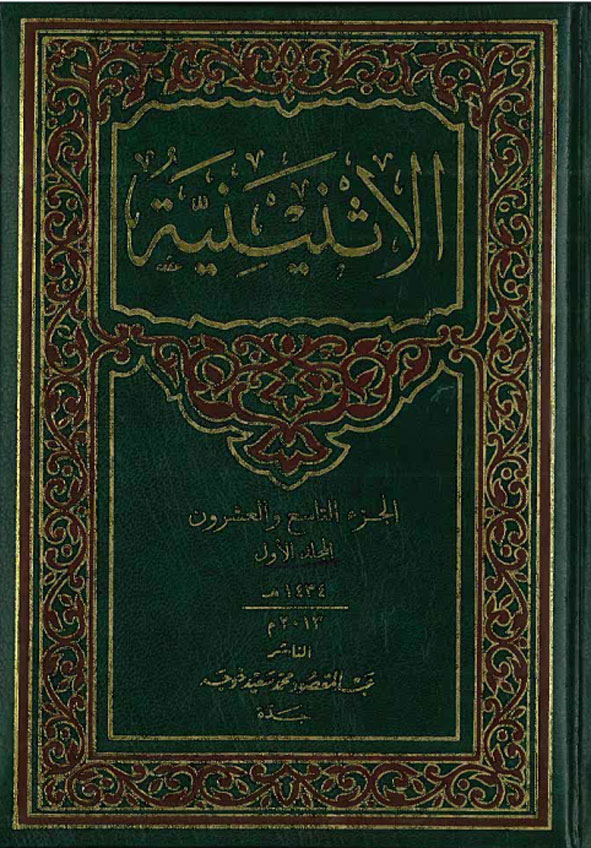
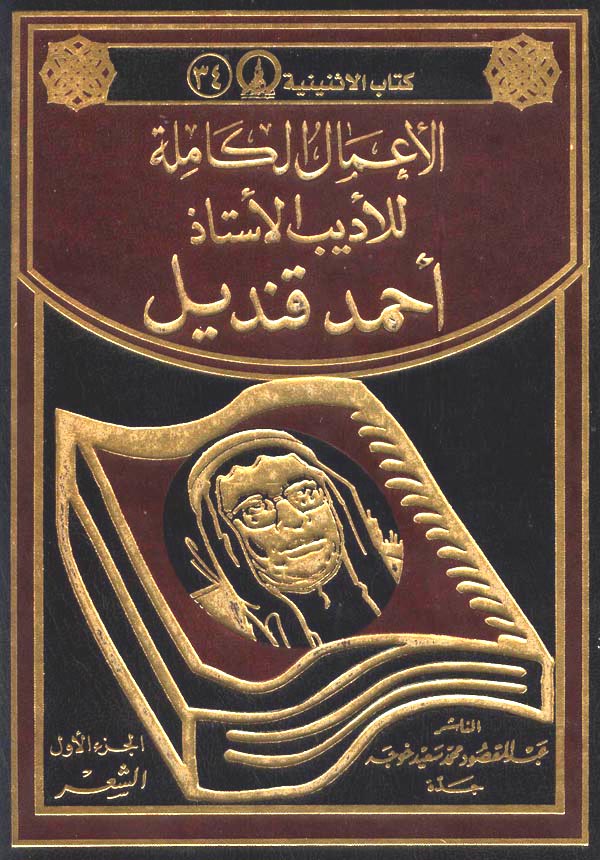
 شارع عبد المقصود خوجة
شارع عبد المقصود خوجة 00966-12-6982222 - تحويلة 250
00966-12-6982222 - تحويلة 250




