| عَبد العَزيز الرّفَاعي وَرحلَة التأليف |
| أصدر عبد العزيز الرفاعي خلال عام 1413هـ أي قبيل وفاته بأشهر كتيباً عنوانه "رحلتي مع التأليف" يحتوي على خمسين صفحة من القطع الصغير، شرح فيه رحلته مع التأليف بصدق من الألف إلى الياء، وكان هذا الكتاب ضمن سلسلة "من دفاتري" التي تصدرها "دار الرفاعي" ويحتل الرقم الثالث في السلسلة، إذ سبقه كتيبان الأول عنوانه "الرسول كأنك تراه" حديث أم معبد، وقد صدرت الطبعة الأولى منه عام 1403هـ وتبلغ صفحاته اثنتين وتسعين صفحة، أما الثاني فعنوانه "رحلتي مع الكلمات" ومجموع صفحاته أربع وثمانون صفحة، منها أربع وخمسون صفحة من تأليفه، ثم ملحق بقلم الأستاذ صالح محمد جمال - رحمه الله- شغل عشرات صفحات، فملحق آخر بقلم الأستاذ عبد الغني فدا وبتقديم المؤلف وشغل 20 صفحة، والكتيبات الثلاثة لا يختلف حجم أحدها عن الآخر. |
| لقد تطرق عبد العزيز الرفاعي إلى بداياته في القراءة، التي تعتبر الأساس الأول للكتابة، والقراءة أيضاَ مفتاح العلم، فمتى قرأ الإنسان علم، فإذا علم كتب، والكتابة هي الدرجة الأولى من درجات سلم التأليف، وهذا التسلسل أورده الله سبحانَه وتعالى في محكم كتابه إذ قال عز وجل من قائل في سورة "العلق": اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. |
| وإذا كان الكتاب هو حلْقة الوصلِ بين الإنسان والقراءة، فإنني أرى أنّ ذلك يكون شرطاً لازماً عندما يتقدم علم الإنسان ومعرفته بأصول الكتابة، لكنه يستطيع أن يقرأ قبل أن يفك الحرف. فالرسول صلى الله عليه وسلم قرأ وهو أمي، ونحن في صغرنا قرأنا في المرحلة التمهيدية أو السنة الأولى من المرحلة الابتدائية، دون علم تام بتهجي حروف الكلمات، وإنما قرأنا دروس تلك المرحلة تَلْقيناً ولكن الإنسان لا يستطيع أن يكتب دون أن يكون قد سبق له دراسة الحروف الأبجدية، كيف تُكتَبُ وكيف تربط بغيرها، فالكتابة بعد العلم، والقراءة هي الطريق الموصل إلى العلم. |
| ومتى تعلَّم الإنسان وكتب، فإنه يستطيع حينئذ أن يتخذ من الكتابة متنفّساً له، يجد فيه ما يبحث عنه وما يتمنى الحصول عليه ويهدي إليه بل يودعه كل أسراره ومخزونات فكره، وروائع شعره، وبدائع نثره، ثم يقدم ذلك لجيله وللأجيال اللاحقة هدية منتقاة، يرجو من ورائها بادئ ذي بدء تأدية الواجب الديني المكلف بأدائه، ثم تأدية الواجب الإنساني الذي يضع على عاتقه مسؤولية تعليم نفسه، وتعليم أبنائه، تعليماً نافعاً يفرقون به بين الخير والشر ويجعلون منه لبنات صُلْبة يقيمون عليها أعمدة أعلامهم، لتخفق كرامةً وعزةً ورفعةً تتحدث عن حاضرهم في عالم اليوم، وهنا ندرك قيمة الكتاب، ولا حاجة بنا إلى أن نسرد ما قيل في وصفه، أو ذكر فضائله، التي عدَّدها كثير من الكتّاب، فكتب الأدب مملوءة بها، وربما قرأها الكثيرون. لكنني أودُّ أن أعرّجَ على ما كتبه عبد العزيز الرفاعي عن الكتاب، في الصفحة الرابعة من كتيبه الموسوم بـ "رحلتي مع المكتبات". حيث وردت هذه العبارة لتبين للقارئ قيمة الكتاب عند الرفاعي - رحمه الله - "يكفي أن أقول: إن طريقَ الإنسان إلى المعرفة كانت تجارِبه وذاكرتُه. ولكن ذاكرته وحدها لم تكن كافية. كان عليه أن يبحث عن وسيلة يخلد فيها لأجياله المقبلة خلاصة تجاربِه، وأثمرت محاولاته المتعددة، اختراعه الكتابة، إنها أعظم مخترعاته، فلولاها لضاعت كل المخترعات الأخرى. |
| من أجل ذلك كان (الكتاب) هو المعرفة -إذن- الإنسان هو المعرفة، والمعرفة هي الكتاب، وما دام للكتاب كل هذه الأهمية فإن للحديث عنه وحوله فروعاً من الأهمية قد تكبر وقد تتضاءل، ولكنها كلها على مختلف درجاتها ترفد تاريخه". |
| ومن وجهة نظري فالكتاب ليس حروفاً وكلمات، وإنما هو نور أو ظلمات، فهو نور إذا كانت كلماته شموساً، وكانت حروفه نجوماً.. شموساً تطهر النفوس، وتُهذِّب النّهى وتصقل القلوبَ؛ تحرق بحرارتها شهواتِ النفس الجامحة وتدفئ في ليالي الشتاء أحلامَ القلوب الطامحة، ونجوماً تُضيء وتَهدي، وتحمل الخير إلى القارئ، وتَهدي وتنبض على السطور حبّاً وسلاماً، وتشع أمناً وبياناً، أولها قدوة لآخرها، وتاليها مقتف آثار من سبقه، فهي عقود منظومة. وقد يكون الكتاب ظلمات إذا فاحت كلماته بريح المزابل، واستحمت أحرفه في المياه الآسنة، يتأفف من الاقتراب منها كل لبيب، ويأنف مصاحبته كل أديب. |
| وعبد العزيز الرفاعي استطاع منذ عهد صباه أن يتعرف على الكتب النافعة، والكتب الضارة، وأن يفرق بين ما يرفع قيمة الإنسان ويحله المكان الأسمى، وبين ما يهوي به إلى الدرك الأسفل مذموماً مدحوراً، لذلك ظل ماسكاً زمام أمر نفسه، لم يسمح لها بالانطلاق وإذاعة ما كان ضنيناً به. |
| مرّتْ الأيام وتتابعت الشهور والأعوام حتى بلغ عمره سبعاً وأربعين سنة، والأربعون هي مرحلة اكتمال العقل والرشد، واجتياز مرحلتي المراهقة والشباب، وهما المرحلتان اللتان قد تحفلان بكثير من أسباب اللهو، وتحملان نفحات من الجِدَّةِ تشوبها أشياء من وثبات الشبابِ وزهْوِ الصِبا، لأن الإنسانَ إذا بلغ الأربعين من عمره، يستكمل قواه العقلية والجسدية، ويكون في مقدوره أن ينظر إلى الأشياء بمنظار مغاير تماماً لما كان ينظر به في زمن المراهقة والشباب، إذ يستيقظ الغافل من غفلته، ويؤوب التائه إلى رشده، ويقول المسلم عندئذ رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت عليّ وعلى والدي وأن أعمل صالحاً ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. |
| على أن عبد العزيز الرفاعي - رحمه الله - لم يعرف مسارح الصبا وزهوه، ولم يطرق أبواب المراهقة ومفاتنها وملاهيها، ولم يحزم حقائبه، ليشبع رغباته الشبابية من هنا وهناك، فقد شاء الله أن يصونه من أن يقع فريسة أو صيداً سهلاً لتلك المغريات القاتلة فقد امتحنه بضيق ذات اليد، ووقف الكفافُ سداً منيعاً يحميه من الانجراف في المنزلقات التي تهوي بمرتاديها إلى الهاوية، وإنما كان في ذلك دافع في أن يستزيد من طلب العلم ويحرص قدر الإمكان على التزود منه، من كل الموارد التي تُهَيأ له، بل نجده قبل أن يبلغ العشرين من عمره يحمل عبء تدريس طلاب مدرسته الابتدائية، التي تخرج فيها قبل ثلاث سنوات من عودته إليها معلماً. وفي نفس السنة يحاول أن يؤلف لطلابه كتاباً في الهندسة، لطلاب السنة الخامسة، الذين يقوم بتدريسهم تلك المادة، كما فكر بل صمّم على الأصح أن يقوم بتأليف كتاب في السيرة النبوية الشريفة، في سَرْد قصصيٍّ وبلغة سهلة ميسرة، لكنه لم يكمل أياً من الكتابين، وقد بين سبب ذلك في الصفحة الرابعة عشرة من كتيبه "رحلتي مع التأليف" حيث قال: "أما لماذا لم أتم هاتين المحاولتين؟ فقد كان ذلك لأنني لم أقض في التدريس أكثر من سنة دراسية واحدة، أو على التحديد ثمانية أشهر فقط، ثم أصررتُ على مغادرة التدريس إذ وجدته مرهقاً، وخيِّل إليّ أنّه لا يتسع لطموحي، فقد رأيت التدريس أيامها ضيق المجال، فغادرته إلى مديرية المعارف ذاتها محرراً في ديوانها.. وترتب على ذلك إهمال تينك المحاولتين". |
| ولنقف طويلاً أمام جملة واحدة في هذه العبارة التي بين فيها عبد العزيز الرفاعي سبب عدم إتمام تينك المحاولتين، تلك الجملة هي قوله "خيَّل إلي أنه لا يتسع لطموحي". فقد كان يطمح أن ينال مركزاً مرموقاً. والتدريس مهنة شاقة، واكتساب العيش منها في تلك السنين لا يكفي رغبات الطامحين، ولعله وجد في بيت أمير الشعراء أحمد شوقي حكمةً تُقويَّ من عزمه على ترك مهنة التدريس، لأن المعلم في نظر الكثيرين شمْعَةٌ تحترقُ لتضيءَ للآخرين، دون أن تنال حمداً ولا شكوراً، وهي وظيفة شريفة لا شك في ذلك، ولكنّها لا ترقى بصاحبها، ولا تحقق أمنيات الطامحين الذين امتدحهم أحمد شوقي بقوله: |
| شبابا قُنع لا خير فيهم |
| وبورك في الشباب الطامحينـا |
|
| والطموح مزية كل عاشق للتجديد في حياته، كاره للرتابة، ويهوى الحركة، ويمقت السكون، فالسكون مُمِلٌّ وقاتل للنفس، بل هو الموت ذاته، ولعل عبد العزيز الرفاعي، بل أجزم، أنه قرأ أدب الجاحظ إبان دراسته بالمعهد العملي السعودي، أو بعد ذلك حيث أشار إلى ذلك إشارة عامة إذ قال: "أما وقد انتقلت إلى المعهد العملي السعودي، وأصبح من بين مواد دراستنا، دراسة الأدب العربي في شتى عصوره وانطلقت إلى قراءات حرة متنوعة". ولعله خلال قراءته لأدب الجاحظ اطلع على رأيه في معلمي الصبيان وأنّه كان يعدهم من الحمقى. |
| وبعضهم يرى أنّ استمرار الشخص معلم صبيان لمدة عشرين عاماً ونيّف سبب من أسباب اختلال عقله، أو هو المرفأ الذي يبدأ منه رحلتَه مع الجنون، على أن هذا الرأي قد يصح أحياناً ولا يصح أحايين كثيرة ومهما يكن الأمر فإن عبد العزيز الرفاعي عندما ترك مهنة التعليم، والتحق بالديوان العام لوزارة المعارف، فقد طوى بذلك صفحة إصراره على تأليف كتيب في الهندسة للسنة الخامسة الابتدائية وعلى كتيب في السيرة النبوية للمرحلة الابتدائية، وله من الأعذار ما يشفع له: |
| منها أولاً ترك مهنة التدريس، وزوال الهدف الذي من أجله أزمع على إعداد كتيب في مادة الهندسة لطلاب السنة الخامسة بالمرحلة الابتدائية، ليتيسر لهم فهمه بسهولة، حتى يتمكن من أن يحصل على رضائهم ونجاحهم في المادة التي يقوم بتدريسها لهم وبالتالي نجاحه في مهمته التي أنيطت به، حتى يحصل على تقدير واحترام المسؤولين. |
| وثانيها ما يتعلق بالسيرة النبوية، وهو أنه وجد بين المراجع التي أعطيت له من مستودع مديرية المعارف رسالة لطيفة عن السيرة من تأليف السيد محمد طاهر الدباغ مدير المعارف في ذلك الوقت أطفأت شمعة الحماس في نفسه. |
| ولنقرأ ما كتبه بيده حول هذا الموضوع في كتيبه "رحلتي التأليف" ابتداء من السطر الأخير في الصفحة الثانية عشرة وحتى نهاية السطر الخامس من الصفحة الرابعة عشرة: "وفي السيرة النبوية اتجه عزمي أيضاً إلى وضع كتاب للصبيان، أقصُّ فيه قصةَ السيرة النبوية، في سرد قصصي، محاولاً استعمال لغة سهلة، وتعابير مشوَّقة، وكنت في هذه المحاولة أكثرَ تصميماً، وما زلت أذكر كيف كتبت رسالة إنسانية حبّرتُها تحبيراً، وذهبت بها إلى مديرية المعارف في مقرها في باب علي (الخاسكية) أمام بيت (باناجة) أمام الحرم الشريف، وقدمت الرسالة إلى مدير المعارف أيامها، وهو السيد محمد طاهر الدباغ، الرجل الذي أسس مدرسة تحضير البعثات، فوضع اللبنة الكبرى في الابتعاث. كانت الرسالة عرضاً للفكرة التي اعتزمتها، مع تزويدي بالمراجع اللازمة من مستودع مديرية المعارف، تحمس مدير المعارف - رحمه الله - فأشر على رسالتي لمراجعة مأمور المستودع، لإعطائي ما يتوفر لديه من المراجع منحة من المديرية، وهكذا حصلت على عدد من المراجع وبينها رسالة لطيفة من تأليف السيد محمد طاهر الدباغ نفسه عن السيرة النبوية لعله كتبها لطلاب المدارس أيضاً وأحسب أن مصدر حماسه، أنه رأى في شخصي المتواضع صورة لشبابه حينما وضع تلك الرسالة، لكنه أصدق مني عزماً وتصميماً، فقد طبع هو رسالته، ولم أطبع أنا رسالتي لأني لم أتمها". |
| ثالثاً أن عمله الجديد يتطلب منه أن يبذل المزيد من الجهد حتى يبرز فيه وينال تشجيع رؤسائه له وتهيئته لمراكز أعلى وهي أمور تستوجب منه أن يثقف نفسه، وأن يزيد من الإطلاع والمعرفـة، وأن يغض النظر عن التأليف بعد أن ترك المكان الذي عقد العزم على التأليف من أجله. |
| غير أن عبد العزيز الرفاعي - رحمه الله - لم يجدْ بعد سنتين قضاهما في الديوان العام، بمديرية المعارف، بغيَته أو بالأحرى أنه لمس عن كثَب عدم تمكنه من تحقيق طموحاته المتطلعة، في ظلّ مديرية المعارف، لأنها تعج بالموظفين المؤهلين، الأمر الذي قد يكون عائقاً لرغباته الجياشة، في بلوغ مآربه ومقاصده العلياء التي أخذ يخطط ويرسم لها منذ صغر سنه، أو منذ السنوات الأولى من حياته، منذ أن رأى أمه وأخته الكبرى وهما يربطان أذيال الليل بأكمام النهار، يجاهدان في سبيل توفير لقمة العيش له ولأخته وتوفير ملبسهما. لذلك عزم على ترك مديرية المعارف وأسرع بالالتحاق بشرطة العاصمة، غير أنه وجد أن العمل بالشرطة لا يختلف كثيراً عن العمل بمديرية المعارف، فتركه بعد أن أتم قرابة عام، وتهيأت له الفرصة بعد ذلك للعمل بالنيابة العامة، في الوقت الذي كان الأستاذ عبد القدوس الأنصاري يتولى رئاسةَ أحدِ الأقسامِ المهمة. |
| في تلك الفترة، كان قلم عبد العزيز الرفاعي، قد عرف طريقه إلى الصحافة، وقرأه المهتمون بها، وأعجبوا بما حملتْه مقالاته من أفكار نيّرة ومواضيع هامة، عولجت بشكلٍ يدعو إلى الإعجاب. |
|
|
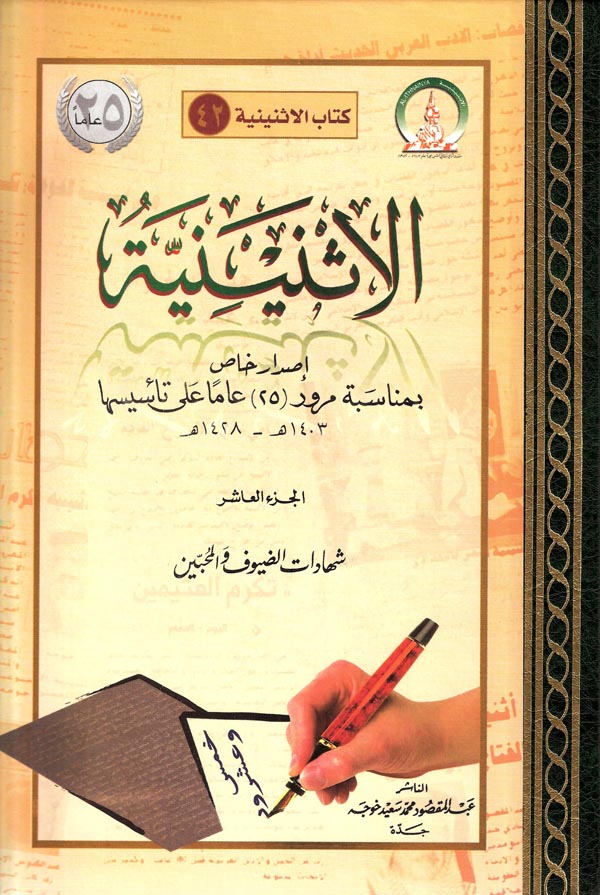

 شارع عبد المقصود خوجة
شارع عبد المقصود خوجة 00966-12-6982222 - تحويلة 250
00966-12-6982222 - تحويلة 250




