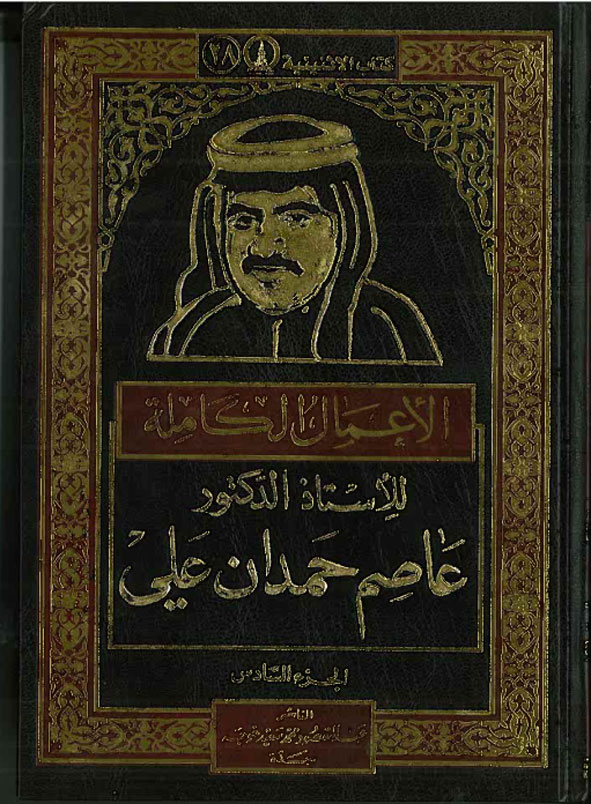|
((كلمة الدكتور معجب بن سعيد الزهراني))
|
| شكراً جزيلاً، الحقيقة أودّ أن لا أتحدث حتى لا أخرّب الصورة التي سمعتم عنها، لكنني سأتحدث، وسأبدأ بكلمة شكر مستحقة لصاحب هذا البيت الأندلسي شكلاً، وهذا البيت الأدبي الثقافي، شكلاً ومضموناً كما يقول القدماء. في الحقيقة، أزعم أن الأستاذ الشيخ عبد المقصود خوجه عندما أسس هذا التقليد الكريم لتكريم من يراه أهلاً لذاك، كان وسيبقى صاحب الفضل، لأن من يكرم الآخرين هو الكريم، لكن من يكرم في الآخرين الثقافة والأدب والمعرفة فهذا لعمري هو أسمى معاني الكرم، وبالتالي اسمحوا لي أن أوجه له تحية، وكلمة شكر شخصية، علماً بأن ما سأتطرق إليه في هذه العجالة، ربما يكشف وجهة نظري للتكريم. |
| خاطبني الأستاذ محمد الحسن هذا اليوم عصراً، فقلت له إنني سأتحدث خمس دقائق، لأنني كنت واثقاً تماماً أن من سيسبقني للحديث سيقولون الشيء الأجمل، والأفضل، لكنه قال معك نصف ساعة، ويشهد الله أنني وقعت في "حيص بيص"، ماذا أقول في نصف ساعة؟ ليس المقام مقام محاضرة، فأتحدث في موضوع معرفي أتقن الحديث فيه. لذا، قررت أن أستعين بالذاكرة، وبالتالي اسمحوا لي أن أتوقف عند بعض اللحظات، بعض الذكريات، وبعض الانطباعات، لا لأنها تكشف فيّ شخصية استثنائية، وإنما ربما تنطوي على معنى أرجو أن يصل إلى الآخرين، وسأبدأ من قرية الغرباء، واسمها يا صديقي قرية الغُرباء، ويقال إن جدنا الخامس قادم إما من المغرب، أو من اليمن، واسمه مُحِي الدين، ومحي الدين ليس شائعاً في الزهران حقيقة ولا في منطقة الباحة، وبالتالي فنحن غُرباء. |
| ماذا تعلمت من القرية؟ سألني أحد الصحفيين قبل سنوات من جريدة عكاظ، فقلت إن أجمل ما تعلمته من القرية محبة الطبيعة واحترام العمل، لأن مدرسة القرية كانت بعيدة نسبياً. قرية الغُرَباء هي واحدة من قرى وادي الصدر، والمدرسة بعيدة عنها نسبياً، وكنا نعبر كل يوم من بين الحقول ونسلم على الكثير من الأشجار، وحينما يهطل المطر كنا نتوقف كثيراً في الوادي ونحن ذاهبون إلى المدرسة، أو عائدون منها، لأن الماء نبي، لدينا مقولة في القرية، وفي المنطقة تقول: "الماء نبي". وكنا أيضاً نصاحب الفلاحين والفلاحات في الطريق ونحن ذاهبون ونحن عائدون، فكانت هذه المدرسة بيتاً من بيوت القرية، وتتحول أحيانا إلى مزرعة من مزارع القرية، لم تكن مؤسسة رسمية قمعية منفصلة عن الناس وعن المجتمع وعن الحياة اليومية، كما صارت عليه لاحقاً في الكثير من الحالات للأسف الشديد، لكن داخل هذه المدرسة من الأشياء التي لا أنساها، سألت ذات يوم أستاذاً فلسطينياً لا زلت أحفظ صورته واسمه شهر، لا أدري ما الذي دفعني إلى سؤاله، لو مشيت من هنا خلف هذا الجبل ثم ثم... أين نهاية العالم؟ إلى أين سأصل؟ فضحك وبدأ يشرح لي عن كروية الأرض وعن قضايا نظرية لم أستوعب الكثير منها، لكن بعد نحو أسبوعين أو ثلاثة يبدو أنه طلب من مدير المدرسة الكرة الأرضية فجلبها من الباحة أو من بلجُرَشي، ولا أنسى فرحتي حينما وضعها أمامي على منصة أو على طاولة وقال نفترض أنك الآن هنا، حين تمشي هكذا ترجع إلى المكان نفسه، فرحت لأن السؤال الذي كان يقلقني توقف، لكن أيضاً ربما كانت أول عبارة تولد في نفسي حلم هذه الرحلة التي تأخذ الإنسان بعيداً، بعيداً، بعيداً.. ثم تعيده ذات يوم إلى ذاته وبيته وموضع خطوته الأولى، سافرت بعدها بعد المتوسطة إلى الرياض، لم يكن هناك ثانويات منتشرة في منطقة الباحة حقيقية، وكان السكن في الرياض مع أخي الأكبر أهون علي من أذهب إلى بلجُرَشي أو إلى مكان آخر في منطقة الباحة، كانت المسافات الجبلية بعيدة، ولم يكن هناك سيارات بشكل منتظم. في الرياض الأخ الأكبر يعني الأب البديل كما يسمى، حسبت الرياض قريبة جداً وحينما سافرنا مضينا يوماً وليلة في طريق كشفت لي أشياء لم أكن أتصور أنها موجودة في العالم. لأول مرة، أرى الصحراء، هذا الفضاء الممتد بلا نهاية، وأنا ابن الجبل والوادي والشجرة فاستغربت، وتكررت التجربة لاحقاً حين رأيت البحر لأول مرة، لدينا مياه كثيرة، لكن الغدير يظل غديراً، لم أكن أتخيل أن هناك مياهاً بهذا الامتداد وهذا اللون وهذا الرقص أيضاً. وصلت الرياض في عز الصيف، ويشهد الله أنني حسبت أن الشمس سقطت على رؤوس البشر، في عز الظهر، وربما هذه الانطباعات الأولى خففت من بهجة اكتشاف أو دهشة اكتشاف المدينة أو السيارات والشارع والأضواء خصوصاً في الليل عندما تشتعل المدينة وكأن النجوم سقطت عليها دفعة واحدة، ولم تكن هناك الحقيقة تجارب غنية لابن القرية الذي ينتقل إلى المدينة، كان هناك توجس، ونوع من أنواع التوتر، خصوصاً وأن بعض المدن قاسية على الحجر والبشر والشجر، طبعاً لا أقصد الرياض، في الثانوية فوجئت بكتابين، الحقيقة لازال لهما أثر في تشكيل ما يمكن أن نسميه بالوعي المعرفي، الكتاب الأول هو الجغرافيا البشرية، وكان مليئاً بمعلومات وصور عن الشعوب وثقافات الشعوب ومواطن الشعوب، والكتاب الثاني هو عن نظريات علم النفس، قرأنا النظريات الأساسية كلها في علم النفس ونحن في الثانوية، وكانت هذه من الكتب أو من المواد التي أزعم أنها صنعت شرخاً حميداً في وعي محدود تشكّل في قرية صغيرة، ولكن لديه بعض الأسئلة التي تقلقه، تغيرت الأمور تماماً في الجامعة لأننا انتقلنا إلى كليه كانت قصراً، وقد ذكّرتني الأشجار والحديقة أول ما دخلت بكلية التربية في جامعة الرياض حينها، جامعة الملك سعود حالياً، وكانت كلية التربية تابعة لليونسكو وبالتالي أول من طبق نظام الساعات، المطاعم الأنيقة، والأنشطة الطلابية المنفتحة. الحقيقة أنها كانت كلية فرحة، وحين كنا نزور زملاءنا في كلية الآداب، نشعر أنهم في سجن بينما نحن في قصر، ومن غلاظة الشباب أحياناً هذا الشعور بالتفوق أو بالميزة، يجعلنا أكثر سعادة. لكن الشيء الثاني الذي لا أنساه في الجامعة هو أننا في نهاية كل أسبوع كنا نشاهد فيلماً سينمائياً يختاره المشرفون على السكن، أو مسرحية للطلاب يؤديها الطلاب وبالتالي تكون هي مائدة مساء الخميس، وحينما لا يأتي هذا ولا ذاك، كان لدينا حقيقة فرقتان شعبيتان من أحلى ما يكون، واسمحوا لي بأن أكسر صرامة اللغة ببعض الشعبية أو اللغة المحكية، كان لدينا مجموعة من مكة وأخرى من جدة، يتقنان ما نسميه أو ما يعرف لاحقاً بالموسيقى العارفة، أحدهم يعزف على قانون، والآخر على كمان، وأحدهم على العود وهو خالد هوساوي، التقيت به بعد فترة وقال إنه تاب، فحزنت كثيراً أن يتوب إنسان عن الفن. كان الجميع يحيون لنا أمسيات حتى المشرف أو المشرفون على السكن، وبعض الأساتذة يحضرون لأن الحقيقة كانت هذه المجموعة التي تتألف من خمسة أو ستة أشخاص، تؤدي الطرب الحجازي الراقي، وأحياناً يخرجون من هذا الطرب إلى تقليد كبار المطربين في العالم العربي، وحينما يتغيبون أو يعودون إلى مكة أو جدة، نفتقدهم. كما كان لدينا فرقة موسيقية من حائل، وكل واحد فيها يحمل دفاً وصوتاًَ جميلاً وسامريات، مرة تقدّم من حائل وأخرى من القصيم – نسيت التفاصيل – والحقيقة كانت الجامعة بيئة جامعية، تسهم في تفتح أذهان الطلاب، لأن الجامعات في الحقيقة لدينا مفهوم خاطئ اليوم عنها، إذ نعتقد أنها المكان الذي يتعلم فيه الإنسان بعض المعلومات، ويكتسب بعض المهارات، لكن الجامعة مختبر للفكر، ملتقى للتيارات والنظريات، فضاء لممارسة هذه الحريات الصغيرة المشروعة والأساسية في حياة الإنسان، افتقدت جامعاتنا للأسف الشديد لاحقاً كما سأشير إلى ذلك. في الجامعة بدأنا نقرأ الجاحظ وابن رشد والمتنبي، بنوع من أنواع الصرامة والحقيقة أنني من جيل سعد سعادة غامرة بأن درّسه شكري عياد، رمضان عبد التواب، عز الدين إسماعيل، منصور الحازمي، محمد الشامخ، حسن الشماع، وحتى بعض أساتذة التربية الإسلامية، رشاد سالم الّذي لا أنساه، هو أول من فتح ذهني على قراءة الغزالي وابن رشد، وكان مستشاراً يعلّم في جامعة لندن، ثم استعارته الجامعة، وبالتالي كانت البيئة كما نلاحظ تصقل وتفتح، وأهم من هذا وذاك أعتقد أنها تزرع في أمثالنا محبة التعلم، ومحبة المعرفة، وهذا ما يولّد ما يمكن أن نسميه بروح التحدي الذاتي، لأن واحدة من سمات الوعي، الذي بدأ يتطور أن كل ما ازددت معرفة، أدركت أن ما لم تعرفه بعد أهم وأكثر بكثير مما عرفته، هذا التوق والشوق المعرفي إن لم تغرسه المدرسة الابتدائية والمتوسطة والثانوية والجامعة، فبئس التعليم. لأن التعليم يتحول إلى النقيض تماماً لهذه الوظيفة العظيمة، يتحول إلى أن يخرّج شباباً في سن الرابعة عشر أو السادسة عشر وهم يعرفون الإجابات كلها عن الأسئلة، وأخطر ما تعانيه شعوب المنطقة العربية والإسلامية والعالم الثالث هو هذا التعليم المؤدلج، سأعود أيضاً إلى هذه القضية لاحقاً. |
| بعد الجامعة، كان هناك نوع من أنواع الاطمئنان أن الطالب المثالي والعميد المعيد الذي لقي الوظيفة سيبتعث، صديقي وأستاذي وأستاذنا جميعاً عبد الله مناع يتساءل ما الذي جعلنا نختار باريس، الحقيقة أن غواية الأدب والروايات والفكر التدويلي ربما الذي امتد من الطهطاوي إلى خمسينيات أو ستينيات القرن العشرين في مصر وفي بلاد الشام، وكان يضيء المنطقة العربية ككل، هي ربما الظاهرة التي دُرِسَت كثيراً ولكن أزعم أنها مازالت تستحق المزيد من الدراسة لأن حينما نعود إلى تلك الأجيال حقيقة، نجد أنها كانت تنافس في بعض الأحوال والمقامات ما هو موجود في أوروبا، كان حضور هذه الأجيال وإنتاجها وإنجازها من الرواد قوياً وعالي المقام. راسلت بعض الجامعات الأمريكية وجامعة السربون بفضل الأستاذ حسن ظاظا رحمه الله، وهو أيضاً من الذين سعدنا كثيراً بالتتلمذ على يديه، فجاءتني كما أذكر أنا والصديق أحمد أبودهمان رسالة قبول من جامعة كولومبيا في نيويورك من قسم الأدب المقارن، ويبدو أنها موقّعة باسم إدوارد سعيد لكني لم أكن أسمع شيئاً عنه، ولم أكن أعرف شيئاً عنه. وفي اليوم نفسه وصلت رسالة من السوربون، فما كان هناك أي مجال للحيرة، لماذا لأن السوربون في أذهاننا شيء عظيم، فقمت ببيع سيارة الأجرة-هذه ربما إضاءة تليق بالصديق قينان الغامدي - فقد كنت أمتلك سيارة أجرة لثلاث سنوات في الجامعة وبعد ما تخرجت من الجامعة لكي أسدد بعض الأقساط، بعتها وهي من نوع "مازدا صفراء"، مهترئة لكنها حميمة جداً، وكانت تخرب وأحاول إصلاحها وأنجح دائماً، أو بنسبة خمس وتسعين في المائة، بعد بيعها اشتريت بذلتين وجهاز اسطوانات، وتسجيلاً، وسافرنا من دون أن نعرف شيئاً عن اللغة الفرنسية أو الثقافة الفرنسية، إلا عبر الكتب، والكتب أكبر خديعة لأمثالنا يا عبد الله، حينما وصلنا كنا نعاني صعوبة تدبر أمور الفندق، وكيف نركب المترو، وكيف نطلب طعاماً في المساء، لأننا لم نسافر، وعشنا هذه الصدمات الثقافية اليومية، الطريف في الموضوع حينما نتذكرها لا تولد أي انعكاس سلبي في نفسياتنا، بالعكس كأنما مسألة طبيعية، لأن روح التحدي تنمو كلما زادت العوائق ولحسن الحظ أنه بعد أيام عدة في باريس بدأنا نتدبر أمورنا، أرسلت إلى مدينة اسمها (رويان)، وأرسل أحمد أبودهمان - صديقي العزيز – إلى شرق فرنسا في مدينة اسمها (بيزونصو)، وقد كانت تأتيني منه رسائل سوداء، رسائل حزينة كئيبة، وأنا مستمتع في مدينة صغيرة على المحيط الأطلسي، وعلى نهر (بوردو) عرفتها خلال يومين أو ثلاثة أصبحت أتمشى فيها براحة بال، من المعهد إلى السكن، والشاطئ الجميل، فهي مليئة بالحدائق ونسبة السكان فيها قليلة، لأنها مدينة سياحية، يبلغ عدد سكانها نحو خمس وعشرين ألف، وفي الصيف يصلون إلى نصف مليون، وبالتالي يطردون الطلاب، عشت فيها ثمانية أشهر، وكانت أيضاً تجربة معززة لمحبتي للطبيعة وألفتي بالكثير من الوجوه، لكن التجربة الأكبر والأهم بدأت في باريس حينما انتقلنا إليها في السنة الثانية، ليدرس كل واحد في تخصصه في جامعة السوربون، اكتشفنا منذ الأيام الأولى أن هناك سوربون، وسوربون، وسوربون، هناك عشرة سربونات، في السربون الأولى حينما ندخل قاعة المحاضرات لا بد من الوقوف حينما يدخل المحاضر ولا بد من التصفيق حينما ينتهي المحاضر، يعني جامعة عريقة وتقليدية جداً، بجوارها جامعة السوربون الرابعة لا بأس لكنها منضبطة تماماً في شؤونها، ثم أخذت بعض الحصص في باريس الثامنة، ولا أنسى حينما سألت عن أحد أشهر الفلاسفة الفرنسيين أريد أن أتابع دروسه، اسمه جيل ديلوز، فأعطيت رقم الصالة دخلت وخرجت، فسألت مرة ثانية عنه، قال هذا هو درس جيل ديروز، رجل أشعث أغبر، ورجله على الطاولة، ومجموعة من الطلاب ليسوا أقل منه أناقة، يشربون مشروبات وعصائر وبيرة ويدخنون، الحقيقة، في البداية انكسرت صورة الجامعة في ذهني وتشوهت، لكن يشهد الله أنني سعدت معهم نحو ستة شهور ودخلت في جوّهم، ولعله أثّر في العديد من أبحاثي اللاحقة، لأنه مجدد ومن الفلاسفة الثمانية والستين في فرنسا، ولديه أطروحات خاصة وكان مهتماً بالسينما، وأنا أعشق السينما، وقال عنه أستاذه وصديقه ميشيل فوكو، إن القرن القادم سيكون ديلوزياً، لا أدري هل ستتحقق هذه البشارة والنبوءة أم لا، لكن فعلاً هذه الجامعة اكتشفنا لاحقاً أنه غير معترف بها في المملكة العربية السعودية، وهربت منها خوفاً من العقاب، جامعة للعاقين، لجماعة ثماني وستين، للثورة الطلابية، للجيل الجديد الذي تمرد على المؤسسات الأسرية والسياسية والاجتماعية بعد أن خاضت أوروبا الحداثة والثورات الصناعية في حربين متتاليتين، وكأنما وضع الجميع في سلة التساؤلات والنقد والنقض وبدأ يبحث عن أفق جديد للحياة الإنسانية، أما في السوربون الثالثة التي كانت مشهورة بالدراسات الإنسانية لكنها جامعة رصينة، والحقيقة أريد أن أفتح قوساً هنا أشير إلى أن التأطير المنهجي ربما يتم داخل القاعات، لكن التعلم الحقيقي، والفكر الحقيقي هو خارج الجامعة، هناك سيل لا يتوقف من الندوات والأساتذة الزائرين، أنا شخصياً كطالب كان لدي الحق في أن استدعي أي كاتب عربي مشهور وآتي به إلى قسم الدراسات العليا لكي يحاضر لزملاء من إفريقيا، من أمريكا اللاتينية، من آسيا، كما يوجد سينما. وأعتقد أن أهم كيان ثقافي في فرنسا وربما في غيرها ولكن أتحدث عما أعرفه،كان المقهى، المقاهي حقيقة مكان التواصل الاجتماعي الأكثر حيوية لكنه ملتقى حيث نجلس في بعض المقاهي في الحي اللاتيني فنقابل كبار الكتاب، وكبار الأدباء، عرباً كانوا أم أفارقة أم فرنسيين، وهذا الجو المنفتح وهذا الجو الخصب الحقيقة هو الذي يعطي أهمية لما نسميه بالبعثة والشهادة، وكثير من الناس مع الأسف الشديد يذهبون لتحصيل الشهادة، والشهادة مطلب لمشروع وظيفة، لكنها لا تعني كل شيء وقد لا تعني شيئاً. |
| قلت قبل مدة إن مجتمعنا زاد فيه عدد الدكاترة وحملة الماجستير وقلّت فيه المعرفة، لماذا لأن الشهادة تعني نقطة التوقف، أبداً التعليم العالي في أوروبا وفي أمريكا وفي معظم دول العالم هو فعلاً نوع من أنواع – لو استخدمت استعارات مجازية-كأنما يعامل الطلاب والطالبات كمجموعة من الأحصنة والأفراس يطلق أمامهم المضمار مفتوحاً وكل يركض بحسب طاقته وقدراته، كان هناك نشاط جانبي ربما أتوقف عنده قليلاً لأنه أول ما عرفت أستاذنا الفاضل عبد الله مناع من خلاله، في بدايات بدايات وجودي في باريس وليس عندما كنت أستاذاً زائراً في السوربون، كنت أراسل وأقرأ صحيفة ((إقرأ)) في الصفحات الثقافية وأكتب أحياناً عن السينما وعن المسرح وعن اليونسكو وعن ندوات، وذات يوم عرض علي وظيفة أفضل، أن أكون مديراً لمكتب عكاظ في الشانزليزيه، وأن يعرض على طالب أن يكون مدير مكتب عكاظ في الشانزيليزيه، وبتواصل حميم مع الأستاذ إياد مدني، الذي هو من ألطف الناس، الذين سعدت حقيقة بمعرفتهم والتعامل معهم، ظل هذا الرجل بضعة أشهر يرسل شيك في نهاية كل شهر، مرة اتصلت عليه ولا أنسى ذلك، قلت يا أستاذ عبد الله رجاء لا ترسل المستحقات الشهرية لأنني نقلت إلى مكان آخر وأنا الآن مدير مكتب عكاظ، فقال لي كلمة نبيلة لا أنساها، "يا ابني، ساعد نفسك فأنت طالب تدرس في باريس والحياة هناك غالية". أيضاً في تلك المرحلة، وهذه كلمة ربما موجهة إلى بعض الشباب، غامرنا مجموعة من الزملاء أحدهم عراقي والآخر مصري وكان بيننا تونسي وأنا ومعنا أيضاً لبناني، قمنا بإصدار مجلة، تعنى بالدراسات الشرقية، وكانت تصدر باللغتين العربية والفرنسية، بدأنا نجمع مواداً رصينة ومواداً حوارية جيدة، وبعد ثلاثة أو أربعة أعداد فوجئنا برسائل من جامعات فرنسية أن هذه المجلة معترف بها كمجلة مُحَكَّمَة، وانظروا الآن التعقيدات التي تواجهها كلية أو جامعة لكي تنال شرف التحكيم من أناس أحياناً كثيرة لا يقرؤون، هذا درس لأنه مفتوح المجال، وفي أعدادها الأخيرة حينما تركت باريس كانت تصدر باللغة الانكليزية أيضاً، أي صدرت في ثلاث لغات. |
| أيضاً، شاركت لأول مرة في المهرجان الوطني للثقافة والفنون، وقد كنت طالباً في باريس، اتصل عليّ أستاذ الجميع الدكتور منصور الحازمي، وصديقنا العزيز فهد الحارثي وقالوا نريدك أن تشارك لأن هذا أول مهرجان لنا، كانت السنة الأولى متواضعة المسألة، أو المحاور الثقافية فيها، قالوا لدينا الآن نقلة نوعية في الجنادرية، ونريدك أن تشارك بشيء عن الرواية، فالمحور الأساسي كان يختصّ بها، فلم أعتذر، غامرت واستشرت صديقي العزيز رحمه الله الطيب صالح لأنني سعدت بجواره نحو سنتين في باريس، فشجعني، وذهبت إلى الرياض وشاركت بورقة، تعدّ الآن فيها نوع من السذاجة، لكنني حينما أعود إليها أجد نواة لمعظم أطروحاتي في الجانب النظري، تحدثت أو حاولت أن استثمر الحوارية التي تطرقت لها الزميلة الفاضلة الدكتورة بسمة قبل قليل، لأن عبد العزيز مشري -رحمه الله- حينما كتب رواياته وخصوصاً "الوسمية" وكانت روايته الأولى والأهم في اعتقادي، كان يزاوج بين اللهجات المحلية واللهجات الفصيحة وهناك نوع من أنواع الخلطة الأنيقة والجديدة على الرواية السعودية، التي بدأت من الحجاز رواية مدنية وحضرية، تطرح قضايا إصلاحية، ثم لاحقاً دخل فيها بعض الكتاب من بيئات أخرى، مثلاً أدخل إبراهيم الناصر بعض القضايا الاجتماعية، ثم عبد العزيز مشري في مرحلة معينة أقحم الريف، أو جلب الريف الجنوبي إلى الرواية وإلى فضاء الرواية في السعودية أو في المملكة، وبالتالي كانت من الأوراق التي إلى الآن أستمتع بالعودة إليها لأنها كانت تجربة وممارسة لاختبار نظرية معينة، طبعا حينما عدت إلى جامعة الملك سعود، عدت إلى جامعة أنكرتها وأوشكت أن تنكرني، لأن الجامعة التي عدنا إليها ليست هي نفسها التي تركناها، أول ما واجهني شخصياً من توترات لم أكن أتوقعها حينما قدمت الرسالة للفحص أو ما يعرف بتفحص الرسائل ليعد عنها تقرير، قال لي أحد الزملاء المعين حديثاً: " توقع كل شيء". قلت له: "ماذا أتوقع؟" رسالة دكتوراه من السوربون وفي مجلدين، قال: "نعم لو أحد هؤلاء الثلاثة تطرق إلى قضية من القضايا الحداثية، فربما لا تعيّن". ويشهد الله أني بقيت على قلق بضعة أشهر إلى أن كانت النتيجة لحسن الحظ كما أردتها، لأن المحكمين كانوا على ما يبدو عقلاء، ويحترمون المضمون المعرفي بعيداً عن هذه التصنيفات التي كانت في ذروتها، وأثرت فينا في الجامعة وفي مجالس القسم وفي علاقاتنا بالطلاب، فلا يمر أسبوع وإلا هناك قضية تثير التقزز، وتجعل كثير منا وخصوصاً من ذوي الحساسية الذهنية والعاطفية الهشة أو المرهفة لا أدري يصاب بالاحباط. |
| كنت انسحب حقيقة من مجلس القسم، ولا أشارك لأنني أشعر أن فيها نوعاً من أنواع المناقدات والمنافسات، لكننا عوضناها بجانب آخر، إذ كان هناك حضور ومشاركات في الندوات والمحاضرات، خارج المملكة أكثر من داخل المملكة، عوضناها أيضاً بنوع من أنواع الاستفزاز المعرفي للذات وللآخرين بسلسلة من البحوث، التي كانت تنشر تباعاً. فبعض الزملاء كان ينشر بحثين أو ثلاثة بحوث في السنة، وأيضاً عبر التدريس والتواصل اليومي مع هؤلاء الطلاب والطالبات، كان هذا الأمر شغفاً ومتعة حقيقة لأنه عندي كما أزعم علاقات قائمة على المحبة، فالأستاذ أو المعلم في الابتدائية أو في الروضة إن لم يستطع أن يحب ويحترم طلابه فهو معلم فاشل، حتى لو كان "أينشتاين"، هذه بالنسبة إليّ قناعة عميقة، لماذا أقولها لأن التدريس بطبيعته غث، فيه مجموعة من الشروط والمتطلبات والتوجيهات والتوصيات، لا بد أن تحفز الطالب إلى إنجازها، لكن حينما تأخذها من باب الاحترام والمحبة تنجح في الكثير من هذه الأمور، والنجاح الأهم هو أن تكسب محبة الآخرين واحترامهم. وهنا أفتح قوساً قصيراً لأشير إلى تلك الملاحظة الأنيقة من صديقي الأستاذ قينان، لقد أعطيت مادة اسمها علم الجمال وهي مادة نظرية، منذ أن عدت من فرنسا وإلى اليوم لازلت أدرّسها وأزعم أنها من المواد، التي أكسبتني كثيراً خلال هذه السنوات، أي خلال ربع قرن، لماذا لأنها مادة صعبة الحقيقة، مادة فلسفية، لكن فيها هذا العنصر الذي سريعاً ما كشف أن طلابنا وطالباتنا متعطشون إليه، لأنهم لا يدرسون شيئاً جدياً عن الفنون طوال المراحل السابقة، وحينما نبدأ في نقاش بعض القضايا، بأن الإنسان ربنا سبحانه وتعالى خلقه كائناً جمالياً، يستطيع أن يتذوق الفنون وأن يبدع، ثم ندخل في الآيات وأحاديث كثيرة تدل على أنه هناك نظرة إسلامية للفن والجمال، نظرة تعلي من شأن هذه الأمور، فتتفكك بعض العقد التي نشأت من التعليم ما قبل الجامعي، ويبدأ الطلاب يتفاعلون معها، وبالتالي أنا كأستاذ أستفيد كثيراً من أعمال هؤلاء الطلاب. وبالتالي، كانت ملاحظة قينان وجيهة وذكية جداً وأنا قلتها بالصدفة حتى، فإذا كان هناك روح جميلة في لغتي المعرفية أو الأدبية، فأنا أدين لهذه المادة بالكثير، طبعاً لا أنسى ما حصل في باريس، بعد ثلاث وعشرين سنة تقاعدت من الجامعة وقررت أن أعود إلى قرية الغرباء، وتذكرت حكاية الأستاذ شاهر، لأن الإقامة عشر سنوات في فرنسا لم تكن في فرنسا، فقد زرنا الكثير من البلدان، وأكاد أقول معظم القارات، فقررت العودة، كتبت عن صديقي قينان الغامدي مقالاً قلت فيه إنني مللت من المدن الجميلة، فما بالكم بالمدن القبيحة، وأنني سأعود إلى قرية الغرباء لأمرين، الهدوء الذهني والنفسي، ثم الأمر الثاني والأهم، هو تدشين بعض المشاريع الخيرية الصغيرة، التي تليق بواحد مثلي، وأعتقد أنها ما زالت قائمة في ذهني في أقرب فرصة إن شاء الله سأقوم بها. حينما عدت إلى هناك وابتنيت بيتاً شعبياً صغيراً، اتصلوا فيّ من جامعة اليمامة، وقالوا نحن نريدك، لكن ظروفي العائلية لم تكن مساعدة، فرجعت مرة ثانية إلى الرياض، رجعت فعلاً مكرهاً لا بطلاً، لأنه لم أكن أريد لكني عدت إكراماً للزملاء في جامعة اليمامة وخصوصاً صاحب الجامعة الأستاذ خالد الخضير، حقيقة لأنه يمتلك ذهنية متفتحة وأحرجني في كثير من المرات، عدت رئيس قسم الدراسات الإنسانية وعميد كلية ستفتح السنة القادمة، ولأنني لا أتقن الأمور الإدارية ولا أحبها، وغالباً ما أفشل في إدارة نفسي، فقد بحثت عن مخرج يليق بي، فأنشأت العام الماضي كرسي غازي القصيبي للدراسات الثقافية، وقد أسعدني كل السعادة أن لم يسبق إليه أحد، وأن تكون جامعة اليمامة هي الحاضنة الرسمية الأكاديمية لكرسي غازي القصيبي. |
| اسمحوا لي أن أقول لكم فيما أعتقده بأن هذه الأمة هي أمة وحدة، غازي القصيبي لم نكتشفه جيداً بعد إلى اليوم، بالإضافة إلى غيره لكن هناك مشروعاً يشبه الحلم أرجو أن يتحقق وهو كرسي الدكتور نايف الروضان للبحوث المستقبلية، وأكثركم الآن يتساءل من هو نايف الروضان، وقد كنت مثلكم منذ بضعة أشهر، إذ لم أكن أعرفه، لكني تعرفت به من خلال بعض المقالات لأحد الأصدقاء، وقمت بالبحث عنه على شبكة الأنترنت، لاكتشف أن هذا الشاب السعودي من الشمال، يعيش معنا في الرياض فترة طويلة من السنة، له مختبر باسمه في هارفرد، يتعاون مع مايو كلينك كخبير في جراحة المخ، أستاذ كرسي أو أستاذ متميز كما يسمونه في جامعة أكسفورد، ومسؤول عن مركز تابع للأمم المتحدة في جنيف، مركز الدراسات الاستراتيجية، ومرشح لجائزة نوبل، والسؤال الّذي يطرح نفسه، لماذا؟ ألأنه طبيب مخ؟ لا، إنما لأن لديه عشرين كتاباً في الفكر الفلسفي، وفي الفكر الفلسفي الجديد أو الحديث، المبني على اشتغالاته في المختبر، وهذا الشخص غير حاضر للأسف الشديد في أجوائنا الثقافية، وفي محافلنا، وهذا محزن. سأل ذات يوم أحد كبار الفلاسفة الفرنسيين المحدثين، ما قيمة سارتر الذي هيمن على الثقافة الفرنسية لأربعين عاماً؟ فقال بكل بساطة اسألني عن رداءة الثقافة الفرنسية، التي يهيمن عليها شخص ما طوال أربعين سنة، لعلي أكون أكثر صراحة معكم. لذا أتساءل عن شخص مثقف يتمّ تجاهله مثل نايف الروضان، وتحتفي بهؤلاء الوعاظ الذين يؤثر بعضهم في المجتمع أكثر من الجامعات السعودية كلها دليل على خلل كبير في مجتمعنا، أرجو أن يكون كرسي غازي القصيبي وكرسي نايف الروضان نهاية مشواري الأكاديمي وبداية مشواري الثاني أو بداية مشوار العودة إلى قرية الذاكرة، لأن هناك يمكنني أن أنصت إلى نصيحة المعجب الآخر الذي في داخلي، ونصيحة أصدقاء مثل قينان الغامدي، بكتابة الذات كما لدي بعض الطموحات إن تبقى من العمر ما يسعفني لكي أواصل الكتابة في المجال الروائي ليس لأن لدي طاقة عبقرية استثنائية، لا. لكن لأنني متيقّن تماماً أن الرواية هي الفن الحواري بامتياز في مجتمعنا على الرغم من كل ما يقال عن جرأتها وعن صدامها وعن فضائحها هي أصدق خطاب موجود في المجتمع السعودي الحديث، الخطابات الأخرى مزورة ومنمطة، إذ تقول شيئاً وتخبئ أشياء كثيرة، الرواية فيما يبدو لي خطاب إنساني، اجتماعي، بشري، مفتوح ديمقراطي، تماماً وبالتالي حينما أعود إلى قرية الغرباء أرجو أن أعود إلى أصابعي وإلى قلمي لكي أواصل المغامرة في هذا الاتجاه. |
| في الختام، أشكر الأستاذ الشيخ عبد المقصود خوجه أن جمعنا هذا المساء، أشكر له الحفاظ على روح جده، على نسق الثقافة الإصلاحية في المملكة العربية السعودية وجوهرها، التي انطلقت من هذه الفضاءات الحضرية، أشكر له أن سمح لي بالالتقاء بالزملاء الذين شرفوني وكرموني كثيراً بما قالوه عني، وأرجو كل الرجاء أن أكون عند حسن ظنهم، والشكر أو وردة الشكر كلها للحضور الكريم، أرجو أن لا أكون قد أطلت عليكم،و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. |
|
الشيخ عبد المقصود خوجه: أخي مُعجِب إنك تُعجِب وتسر، اكتشفنا فيك الليلة القمة التي لم تكتشف بعد، ولي على الدكتور مناع ليس عتباً وإنما خصام، فأنت يا رجل تعرف هذه القمة وممعن في عدم معرفتنا بها، هذه قمة عظيمة، وما سمعته الليلة جعلني أتجمّد في مكاني، وأنا متعجب مما أسمعه من هذا المُعجَب وهو يتكلم، هذه منح، ونعم من السماء لهذه البلد. لذا أقول لضيفنا لقد شرفتنا، وكرمتنا، كرمت هذا الوطن من خلال تواصلك، ومن خلال ما أعطيت، ومن خلال ما ستعطيه، أنت رجل تستحق كل الاحترام، ولنا كلنا أن نقف احتراماً لك. |
| كلنا أيدٍ ممدودة إليك، ونحن نعدّ نفسنا تلاميذ في مدرستك، فآمل من الإخوان، وآمل منك أن يتم التواصل بيننا، ولنستطيع أن نسهم في أفكارك البناءة، وفي أعمالك الخالدة، التي تدوم، ونرجو أن يكون في الوطن الكثيرون من أمثالك، لأن ما سمعته الليلة، وما عرفته، جعلني أحس أنني غريب، وأنني جاهل، فلك منا التقدير والاحترام كله، ولا أزال أصر على ذنب الدكتور مناع، لأنه يعرف رجل كهذا، وأيضاً قينان الغامدي، ولم تخبرا عنه، قمة كهذه مغيّبة وأنتما نائمان! شكراً لكما على هذا التقصير. |
|
عريف الحفل: بقي أن نقول إن الوطن فيه الخير الكثير، وفيه اللآلئ الكثيرة، التي لعلنا في القادم من الأيام نكتشفها ونجليها، لأبناء هذا الوطن الأوفياء إن شاء الله. |
| سيدي نحن الغرباء وليست قريتكم هي قرية الغرباء، فنحن في شوق إلى معرفة المزيد والمزيد من هذه اللآلئ التي ذكر جزءاً منها الشيخ عبد المقصود، شكراً لك أيها المُعجِب، شكراً لهذه العقلية التي اكتشفناها، للأسف هذه الليلة، بينما هي بين أحضاننا طيلة وقت مضى. |
| نبدأ الحصة الثانية بطرح الأسئلة، وننقل المايكروفون الآن إلى قسم السيدات، الزميلة نازك الإمام، ليرحبن بضيفنا هذه الليلة، وليكن السؤال الأول من قسم السيدات فليتفضلن. |
|
|
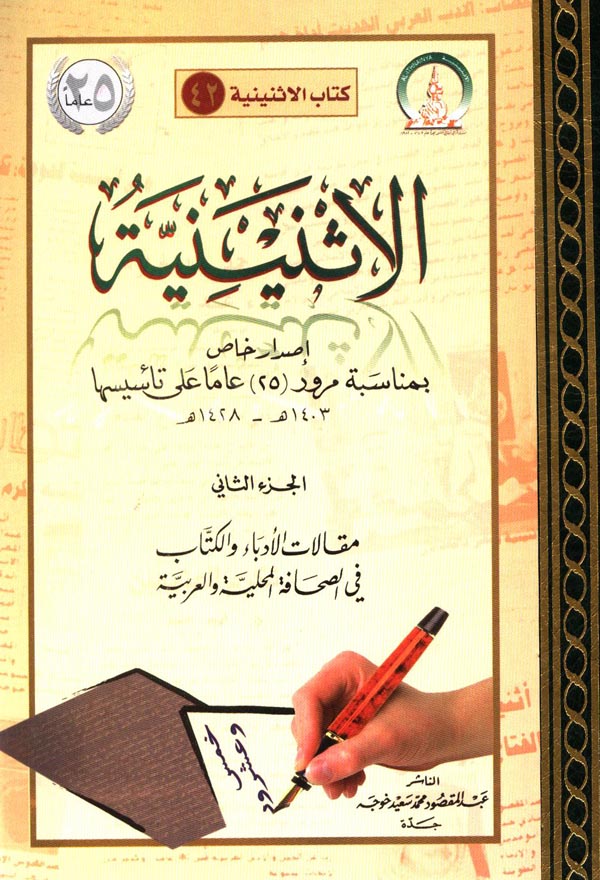
 شارع عبد المقصود خوجة
شارع عبد المقصود خوجة 00966-12-6982222 - تحويلة 250
00966-12-6982222 - تحويلة 250