| فتى دار التوحيد الذي صعد سُلّم الأدب |
| والصحافة: عثمان الصِّيني |
| لا أعرف لماذا اخترتُ مكة للدراسة الجامعية، ولكن بعد مرور ما يقرب من أربعة عقود على نزوحي من بلد الحب والإيمان وموئل الرسالة، إلى مكة المكرمة، حيث ولد سيد الكائنات صلّى الله عليه وسلّم، وتنزل الوحي في سماء مكة المكرمة، وشهدت جبالها وأوديتها انبثاقة النور وطلعة الفجر . |
| - جئت مكة عام 1392هـ فتعرفت فيها بداية على شخصيتين متفردتين هما فضيلة السيد محمّد علوي المالكي، وفضيلة الوالد الشيخ عبدالله محمّد بصنوي .وأزعم أن للرجلين من المواقف والسلوكيات الإنسانية الرفيعة ما يؤهلهما أن يكونا من الشخصيات الهامة والمؤثرة في تاريخ البلد الحرام، دون المساس، أو التقليل من شخصيات أخرى مؤثرة وفاعلة في تاريخ هذا البلد، الذي أنجب العظماء، والعلماء، والفضلاء . |
| في قسم اللغة العربية الذي دلفت إليه دارسًا، تعرفت إلى عدد من الزملاء، بعضهم سبقنا في سنوات الدراسة مثل الزملاء والدكاترة الكرام : محمّد يعقوب تركستاني ، والسيد زيد كتبي، وعبدالله باقازي، والمرحوم عبدالله الحسيني، وجميل مغربي، ومحمّد نور مقصود، وفهد الحارثي، وحسين الزّواد، وضيف الله العتيبي، وطالع الحارثي.. وكان هذا الأخير على قدر كبير من الذكاء، ولكن الأقدار لم تمهل طالعًا، فغربت شمسه في فضاء مدينة أدنبرة الاسكتلندية، ودفن السر مع صاحبه، والحياة مليئة بالمواقف التي لا يمكن تفسيرها كما يقول المفكر الإنجليزي جورج توماس . George Thomas |
| في شعبة اللغة العربية التي كانت تضم عددًا كبيرًا من خريجي دار التوحيد بمدينة الطائف، ونفر من أبناء مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة، في هذه الشعبة رأيت لأول مرة الزميل الدكتور عثمان الصيني، وكان ملازمًا للإخوة والزملاء سعيد السريحي، وعالي القرشي، وضيف الله الخديدي، وللتاريخ –وبدون ادّعاء- فإن جيلنا كان شغوفًا بالقراءة والاطّلاع، ومع أن أساتذة أجلاء كانوا يلقون علينا محاضراتهم في اللغة والأدب والنقد من أمثال أساتذتنا الكرام الدكاترة : حسن باجودة، ومحمود زيني، وناصر الرشيد، والشيخ علي بكر الكنوي، وراشد الراجح، وعبدالصبور مرزوق، ولطفي عبدالبديع، ومصطفى عبدالواحد، وجميل ظفر، وعبدالبصير حسين، وكمال أبو النجا، و محمّد علي حبشي، وغيرهم من المحاضرين والمعيدين، ويأتي في مقدمتهم حمد المرزوقي، وعبدالله صيرفي . |
| مع تلك المحاضرات القيّمة التي كنا نصيخ السمع جيدًا لها تلقيًا وفهمًا، إلاّ أن القراءة في فنون الأدب المختلفة كانت تمثّل مساحة مشتركة بيننا، ومع أن ميولنا كانت مختلفة إلاّ أن ذلك لم يمنع من وجود قاسم مشترك بيننا، فلقد كان النقاش على أشده بين المتحمسين للقديم، والمشايعين للمعاصر والحديث في الفكر والأدب العربي، ولقد دفعنا ذلك الشعور بالتنافس المحبب إلى قراءة طه حسين، وعبّاس العقاد، ومصطفى صادق الرافعي، ومحمّد حسن عوّاد، ونجيب محفوظ، وصلاح عبدالصبور، وعبدالرحمن شرقاوي، ونزار قباني، وعمر أبوريشة . |
| وعرفت عن قرب الزميل الدكتور حمد المرزوقي الذي كان يحاضر في علم النفس. وإنني أزعم أنه من أولئك النفر الذين كانوا يقرؤون بنهم شديد، وكان يقطع الطريق بين مكة المكرمة وجدة ليستمع إلى الأستاذ الراوية محمّد حسين زيدان، فلقد كان معجبًا ببلاغته في الحديث، وذاكرته التي كانت تختزن الكثير من القصيد العربي الذي كان ينشده أحيانًا وهو يبكي بكاءً فيه لوعة المبدع، وأشواق الفيلسوف المتطلّع دومًا للمدينة الفاضلة التي رسمها أفلاطون، ولكن لم يدخلها أحد من ذلك التاريخ البعيد حتى عصرنا الحاضر، ولم تبح بسرها لأحد، فظلت الأرواح تطوف بفضائلها، وتتحرق ألمًا لأنها ضنّت على الوالهين والعشاق بأن تطأ أقدامهم أرضها. |
| كان الزميل الدكتور عثمان محمود الصيني من أقرب الزملاء إلى نفسي، وتعبيرًا عن المودة الصادقة بيننا، حملت إليه يومًا نسخة من كتاب أستاذنا الناقد الكبير عبدالله عبدالجبار "التيارات الأدبية" ، فلقد كان هذا السِفر كما يقول أصحاب العرفان مثل الكبريت الأحمر . فلقد حدث أن زرت يومًا الأستاذ والأديب إبراهيم فودة، بصحبة الوالد الكريم الأديب الأستاذ حمزة بصنوي، وعبّرت للأستاذ الفودة عن رغبتي في الحصول على نسخة من هذا الكتاب، فأخرج من مكتبته نسختين أهدى إحداهما للوالد المرحوم عبدالله بصنوي، والأخرى لكاتب هذه السطور، فلّما انتهى اللقاء، أكرمني الوالد البصنوي بإهداء نسخته الخاصة، فحملتها في اليوم التالي، وكتبت عليها إهداءً للزميل (الصيني)، وطلبت منه ألا يبوح بسرها لأحد، وبعد ما يقرب من خمسين عامًا على صدور كتاب (التيارات) يظل المرجع الأبرز في الأدب السعودي، وكأنه كُتب بأسلوب هذه الحقبة، وخصوصًا للمنهجية الدقيقة التي اتبعها الرائد عبدالجبار، وإذا كانت مصر تفتخر بمحمّد مندور ناقدًا لم يتكرر، فيحق لنا أن نفتخر بعبدالجبار مربيًّا ورائدًا وناقدًا . |
| في يوم من الأيام افتقدت الزميل عثمان من الشعبة، فعلمتُ أنه غادر للطائف لوفاة والده في حادث مؤسف، فلم أتردد في الصعود إلى الطائف، ولكنني وجدت عثمان صابرًا محتسبًا، ولم تشغله الدراسة بأن يكون الأب الحنون لإخوانه، كما هو الزميل الرقيق مع رفاقه. |
| جمعتنا صحيفة (المدينة) الغرّاء مرة أخرى عندما أسند إليّ الزميل الصيني الإشراف على ملحق التراث، بعد اعتذار الزميل الدكتور محمّد يعقوب؛ لعودته إلى الجامعة الإسلامية بالمدينة، واستطاع أبو محمود أن يقدم لنا التراث في ثوب عصري يتواءم مع المرحلة التي نعيشها فكريًّا وثقافيًّا وأدبيًّا، ثم استطاع الزميل الأستاذ قينان الغامدي أن يلتقطه بحاسته القوية، ويدفع به إلى أتون العمل الصحفي، فهو واحد من القلة التي ولجت الصحافة من باب الأدب، فأجادت، وتمكّنت . |
| وأستطيع القول -مع احترامي لكل الزملاء الذين أُسندت إليهم رئاسة تحرير الوطن- بأن عثمان كان الجندي المجهول الذي يعمل دون أن يتطرق إليه ملل أو كلل، وكان قادرًا على تجاوز الصعاب، وكان في كل المواقف يصعد درجات السُلّم وبهدوء مثير دون أن يتراجع عن الهدف السامي الذي رسمه في حياته الصحافية . |
| وعندما ترجّل من كرسي الصحافة، اتصلت به لأقول له : إننا نرحب به زميلاً كريمًا في قسم اللغة العربية بكلية الآداب بجدة، ولكن عثمان كعادته معي ألقى على مسمعي نكتة من نكاته البديعة، ثم ضحك وأجاب قائلاً : ليس الآن أيّها العزيز.. فعلمت من يومها أن عثمان تشرّب حب العمل الصحفي، وهو يعلم أن بضاعته كذلك من الثقافة والأدب مرغوبة ومطلوبة في سوق الصحافة المتنوعة موائدها، والمتباينة أشكالها وألوانها. |
| صديقنا معالي السيد إياد مدني من سماته أنه يُحسن الاختيار ويُجيد فرز معروضات شارع الصحافة . ولقد وُفق في اختيار أبي محمود لكرسي المجلة العربية، الذي شغله بجدارة لحقبة طويلة صديقنا الأستاذ حمد القاضي، وحتى أطمئن البعض، وحتى لا تذهب الظنون بهم مذاهب شتّى، فإنني لا أتطلّع إلى شيء من وراء هذه الكلمات، ولكن بعض الوفاء لزملاء الدرس، ورفاق الأمس حملني على تدوين هذه السطور، والله وحده الشاهد والحسيب، واللهم اجعل ما تبقى من العمر خيرًا من أوله حتى نلقاك مطمئنين. |
|
|
|
|

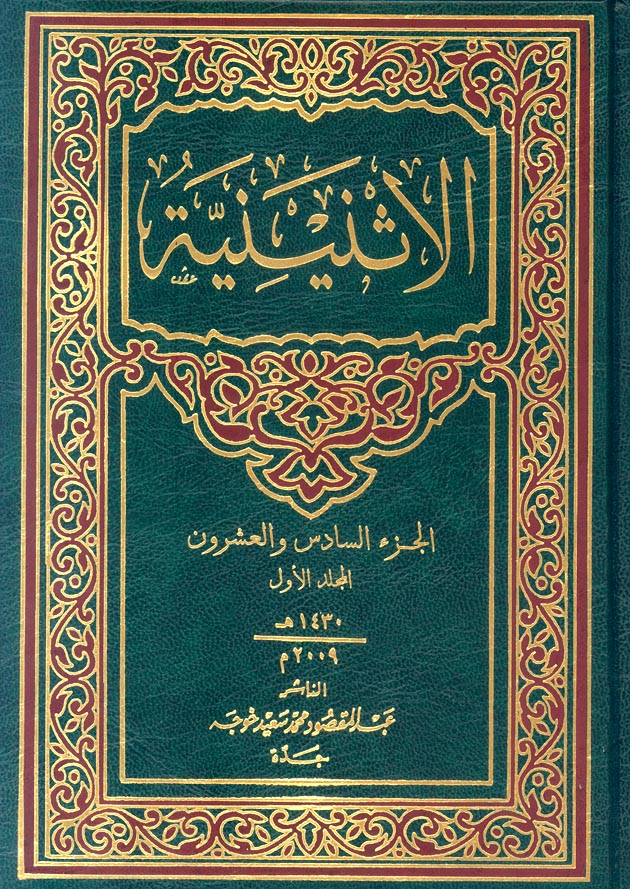
 شارع عبد المقصود خوجة
شارع عبد المقصود خوجة 00966-12-6982222 - تحويلة 250
00966-12-6982222 - تحويلة 250




