|
((كلمة الدكتور عبد الله مناع))
|
| كنت في الثمانينيات الميلادية من القرن الماضي في زيارة إلى بريطانيا. وقد شاءت الظروف حينذاك أن أقوم بزيارة لسفارتنا في (لندن)، حيث كان الدبلوماسي السعودي المتميز الأستاذ نوري إبراهيم يعمل قائماً بالأعمال: يتولى شؤون السفارة، ويشرف على كل أعمالها، وذلك بعد تقاعد سفيرها اللامع الشيخ عبد الرحمن الحليسي، وقبل قدوم سفيرها الأكثر لمعاناً الشيخ ناصر المنقور، ولأنني قمت بزيارته عند نهاية دوامه ودوام السفارة ككل، فقد حرص -بكرمه ونبله- على أن يوصلني إلى فندقي في طريق عودته إلى منزله. وقد كان، فجاورته في سيارته ذات المقود الأيسر -والتي جاء بها من المانيا- على عكس مقاود جميع العربات في بريطانيا ذات المقود الأيمن، نظراً إلى طبيعة السير على اليسار، وهو ما تنفرد به بريطانيا عن معظم دول العالم!! |
| ومع تباطؤه في القيادة، طال بنا المشوار، ما كان مدعاة لي لتأمل شوارع لندن بواجهاتها وعماراتها وفخامة ميادينها وتماثيلها، وبدقتها وروعتها. وقد حثّنا ذلك على تذكّر حال تخلفنا، مقارنة بما كنا نراه من حولنا من كمال حضاري!؟ ولكن.. لا أدري كيف تذكّرت فجأة بأننا أصحاب سهم قديم في هذه الحضارة، وأن وثيقة قبولنا أو أوراق اعتمادنا التي يمكن أن نقدمها –مجدداً- للعالم بأننا أمة ذات حضارة وفكر ووجدان إنساني راق، إنما تتمثل في شعرنا الجاهلي: صحيح أننا لم نخترع سيارة، أو باخرة، أو طائرة، أو هاتفاً، أو مطبعة طوال تلك السنين الماضيات، ولكننا قدمنا حضارة تأمّلية، قوامها فكرٌ ناصع، ولغةٌ لا يوجد أجمل منها أو أرقّ أو أدقّ، وبيان كالسحر، وهو ما تضمنته (المعلقات) الضاربة في أعماق التاريخ. ثم أخذت أستشهد بما أسعفتني به ذاكرتي من شعر (امرؤ القيس)، كقوله لرفيق دربه، وهو في طريقه إلى قيصر الروم (يوستينبان) للاستعانة به في استرداد ملك أبيه (حُجر بن عمرو): |
| بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه |
| وأيقن أنَّا لاحقان بقيصرا |
| فقلت له لا تبكي عينك |
| إنما نروم ملكاً أو نموت فنعذرا |
|
| أو كقوله عند قدومه في الصحراء على ذلك القبر المجهول، وقد بدأت علة حلته المسمومة: |
| أجارتنا إن الخطوب تنوب |
| وإني مقيم ما أقام عسيب |
| أجارتنا إنا غريبان ها هنا |
| وكل غريب للغريب حبيب |
|
| مرّت على تلك الذكرى أيام طويلة: ثلاثون عاماً أو يزيد، إلى أن فاجأني الصديق الشاب الأستاذ محمد عبد العزيز الفيصل الصحفي المتميز بجريدة (الجزيرة)، والمحاضر بجامعة الإمام محمد بن سعود، والذي يسعى هذه الأيام لنيل درجة الدكتوراه من الجامعة نفسها، بخبر صدور كتاب من مجلدين لوالده: الأستاذ الدكتور عبد العزيز بن محمد الفيصل عن (المعلقات العشر)، وتوزيعه في معرض الرياض الدولي للكتاب قبل الماضي. فعبّرت له عن سعادتي بصدوره قبل أن أراه، وعن تهنئتي لوالده بإصدارٍ كهذا. فقد كان داخلي يشتاق إلى صدور كتاب يحمل أدباً وفكراً وشعراً وبعضاً من تاريخ ذلك العصر الموغل في القدم، والعظيم في أهميته ثقافياً وحضارياً. فقد كان الشعر الجاهلي آنذاك هو عنوان ثقافة العروبة وفكرها. وكان يعبّر باختصار عن ثقافة أمة، ويشكّل محتوى إعلامها. ويبدو إنني قلت ما هو أكثر، أو إنني استهديته الكتابين، ليأتيني بهما ابنه الصديق الأستاذ محمد الفيصل، وقد صدَّرهما والده الدكتور عبد العزيز بإهداء كريم. فسحت في المجلدين.. بين الحين.. والآخر.. وقد كانت معرفتي بالأستاذ الدكتور عبد العزيز محدودة. وكانت تقف في تلك اللحظة عند معرفتي به (أستاذاً) للأدب العربي بجامعة الإمام، ووالداً لصديقي الصحفي. فأما قلمه وفكره وأبحاثه وشعره أو برامجه الإذاعية التي كان يقدمها من إذاعة الرياض، فلم أكن أعرف عنها شيئاً من قبل، إلا من لمحة خاطفة بدت في حديث الدكتور عبد العزيز عند أول لقاء به في أحد فنادق الرياض، عندما وجدته يشاركني أمنية حصول ابنه على درجتَي الماجستير والدكتوراه في إحدى الجامعات الأوروبية الشهيرة، كالسوربون مثلاً، وليس في جامعة الإمام التي منحته درجة البكالوريوس. غير أن الابن آثر أن يبقى في جامعته، وأن يكمل فيها مرحلتَي حصوله على الدرجتين.. ربما حباً لأساتذته أو تعلقاً بجامعته، وهو ما كان. غير أن معرفتي الشاملة بالأستاذ الدكتور عبد العزيز محمد الفيصل، كانت وكأنها تنتظر (ثقافية) الجزيرة لتمدني وتمد الآلاف من قرائها بما لم يكن يعرفونه عن الأستاذ الدكتور عبد العزيز، وذلك عندما أصدرت (ملفاً) خاصاً عنه -عن حياته وأدبه وشعره وأبحاثه وكتابه القيم النادر (المعلقات العشر)- في عددها الصادر في الرابع عشر من شهر فبراير الماضي، وقد عنونته إلى جانب صورته التي احتلت كامل غلاف (الثقافية)، بعنوان منصف دقيق وهو (رائد جغرافيا الشعر). فوجدت في داخله ما برّر جهلي بالدكتور عبد العزيز وأدبه وشعره وأبحاثه التي أوقفها على طلبته. فكيف كان لي أن أعرف الدكتور عبد العزيز تلك المعرفة العميقة،وأعيان أقلام (نجد) تستغيبه عندما دُعيت للكتابة عنه في هذا الملف؟! فالصديق العزيز الأستاذ حمد القاضي يكتب عن نجوميته (عالماً) و(أديباً)، ولكنه يقف طويلاً عند تاجيه: (الخُلق) و(الزهد). وهذا أديب نادي الرياض الأدبي الشاب الدكتور عبدالله الوشمي يصفه صراحة بـ(المتنوع المختفي)! وهذا أديبنا التراثي الكبير عاشق الأندلس الأستاذ عبدالله الشهيل يكتب عن تفعيله لـ(ما كان) في حياة الأمة من أدب وشعر وتاريخ، ليس للتفاخر به ولكن للبناء عليه. وهذا صاحب (الملف) ورئيس تحريره الدكتور إبراهيم التركي يتحدث عن (تضوع) أضواء الدكتور عبد العزيز، لا عن اتضاعه، وهو يقدم الملف، معتذراً عن تأخره، ومعبراً في ذات اللحظة عن سعادته بـ(اللحاق) بإصداره، حتى وإن بدا (قطرة) في بحر الدكتور عبد العزيز بن محمد الفيصل العذب!؟ |
| لقد ذكّرني غياب الدكتور عبد العزيز وابتعاده عن الإعلام وأضوائه في أكثر سنوات حياته، وهو ما عبّر عنه أدباء "الرياض" -كلاً بلغته وأسلوبه- في ذلك (الملف) الثقافي الجميل، بما كان عليه الشاعر العربي المصري الكبير الأستاذ محمود حسن إسماعيل الذي آثر الابتعاد -في بداياته- عن الإعلام وأضوائه وضجيجه، حتى بدا لمثقفي مصر وأدبائها وشعرائها كأنه يعيش بعيداً في (كوخ) فوق جبل أو رابية: يتأمل ويقرؤ ويكتب من دون أن يفتح بابه لـ(ميكروفون) إذاعي أو لـ(كاميرا) صحفي، إلى أن فتح نافذة الكوخ أخيراً، وألقى منها-كما صور ذلك الأديب الأستاذ أنيس منصور برشاقة قلمه-بـ(ديوانه) الأول: (أغاني الكوخ) الذي كان عنوانه كأنه مصادقة لما ذهب إليه أدباء وشعراء مصر في تفسيرهم لغياب (الشاعر) وابتعاده عن الإعلام وأدواته الصحفية والإذاعية آنذاك. فزحفت إليه أقطاب (الإعلام)، وقد أدارت رؤوسهم قصائد (أغاني) الكوخ، وتسلقت رابيته، واقتحمت عليه كوخه الذي قبع فيه سنيناً طوالاً، فاستكتبه رائدا الفن والغناء في عصره (سيدة الغناء العربي أم كلثوم، وأستاذ الأجيال محمد عبد الوهاب)، ليكتب لهما أربعاً من أشهر وأمتع أغانيه: (دعاء الشرق) و(النهر الخالد) لـ(عبد الوهاب)، و(رأيت خطاها على الشاطئين) و(يا ربا الفيحاء) لـ(أم كلثوم). |
| هكذا سعى (الإعلام) لشاعر (الكوخ) الأستاذ محمود حسن إسماعيل، ولم يسعَ هو إليه، فوضعه في قلب مشهده في ما بعد، وهو ما أحسب أنه سيفعله حتماً في اقتحام صومعة الأستاذ الدكتور عبد العزيز بن محمد الفيصل الأكاديمية بعد إنجازه الفريد في مجلديه عن (المعلقات العشر) التي أمضى- في جمعها وتحقيقها، وشرح مفرداتها، وزيارة مواطنها، وما أحاط بها من أخبار عن ظروف ولادتها، والأحداث التي بعثت على قولها.. إلى حين وصولها إلى أستار الكعبة-عشر سنوات من البحث والجهد والعناء، ومن السفر إلى المكتبات، والترحال في بطون أودية الجزيرة وشعابها، حتى يتثبت من كل كلمة يخطها، ومن كل سطر يكتبه في سفر أسفاره وأعظم إنجازاته الأدبية: (المعلقات العشر) بمجلديه. |
| لن تكون هذه الكلمة، مهما طالت، قادرة على الوقوف، أو حتى المرور على صفحات هذا السفر بحزأيه والبالغ عدد صفحاته ألفاً وأربع وسبعين صفحة. ولكنني سأتخير الوقوف بكلمة أو سطر عند القليل مما استلفتني وأثار عجبي وإعجابي بموضوعية ونزاهة الدكتور عبد العزيز العلمية الأكاديمية، كقوله بأن (شرح المعلقات السبع -أو العشر- بدأ في النصف الثاني من القرن الهجري الأول)، وأنه مع (بروز المدن الإسلامية الكبرى في القرن الثاني الهجري -دمشق والكوفة والبصرة- أصبح شرح المعلقات متداولاً في المساجد وعلى ألسنة الرواة)، وأنه (لم يبرز شرح المعلقات في كتاب مستقل إلا في آخر القرن الثالث الهجري). ولكل هذه المواقيت معناه ومغزاه في الابتعاد زمنياً عن النص القرآني -ما أمكن- ولغته المتفردة، وبعيداً عن شعر القوم ونثرهم!! وأن المعلقات هي سبع بالإجماع لـ(امرئ القيس، وزهير بن أبي سلمى، وطرفة بن العبد، ولبيد بن ربيعة، وعنترة بن شداد، وعمرو بن كلثوم، والحارث بن الحلزة)، كما ذكر أحمد حسن الزيات في كتابه (تاريخ الأدب العربي)، وأنها تسع عند (النحاس) و(ابن رشيق) وفي فهرس (ابن خير الإشبيلي)، وذلك بإضافة (دالية) النابغة الذبياني و(لامية) الأعشى. إلا أن (التبريزي) المتوفى في مطلع القرن السادس الهجري (502هـ) وآخرون ممن تبعوه، يعتبرونها (عشر معلقات) بإضافة قصيدة عبيد بن الأبرص.. ليزيد إعجابي وعجبي به عندما قال في مقدمته بأن أول من طبع هذا الشعر في (دواوين الشعراء الستة)، هو المستشرق الفرنسي (دي سلان) عام 1837م، وأن أول من تولى شرح هذه المعلقات -أو المذهبات كما كانت تسمى أيضا- هم أدباء وعلماء من خارج الجزيرة العربية، قبل أن يأتي ابن الجزيرة العربية الدكتور عبد العزيز ليقدم أول شرح جزيري لها، مع تحديد الأماكن التي شهدتها بالوقوف عليها، وليس بـ(القراءة) عنها أو تتبع أخبارها في بطون الكتب ومعاجم تقاويم البلدان، مع شرح معانيها إجمالاً، ومفرداتها تفصيلاً. فليست جميع كلمات المعلّقات في سهولة وسلاسة معلقة امرئ القيس: |
| (قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل |
| بسقط اللوى بين الدخول فحومل) |
|
| أو معلقة عنترة: |
| هل غادر الشعراء من متروم |
| أم هل عرفت الدار بعد توهم |
| (يا دار عبلة بالجواء تكلمي |
| وعمي صباحاً دار عبلة واسلمي) |
|
| أو معلقة طرفة: |
| (لخولة أطلال ببرقة ثهمد |
| تلوح كباقي الوشم في ظاهر اليد) |
|
| ولكنها تحتاج إلى شرح مفرداتها، ومعانيها الإجمالية، وهو ما كرّس الأستاذ الدكتور عبد العزيز بن محمد الفيصل، نفسه له طوال تلك السنوات العشر، ليأتينا في النهاية بهذا الإنجاز الأدبي العلمي التاريخي الباهر من دون شك، والذي تتخطى قيمته وأهميته وفائدته طلبة المعاهد والكليات من الدارسين والباحثين أو الساعين لنيل درجتي الماجستير أو الدكتوراه، إلى عموم مثقّفي الأمة العربية ورجالاتها ونخبها في الداخل والخارج، الباكين على حالها، وما أخذت تتدحرج إليه من ضياع وترمُّد. وتلك هي القيمة المضافة لهذا العمل الكبير الجليل. |
| لقد كان الخلفاء والسلاطين يجيزون حفظة الشعر ورواته إن أتموا (عجزاً) لصدر، أو استرجعوا بقية قصيدة لم يبقَ منها في ذاكرة الخليفة أو السلطان غير مطلعها.. بآلاف آلاف الدراهم والدنانير!؟ ترى بماذا يمكن أن يجاز -وفق هذه القاعدة- الأستاذ الدكتور عبد العزيز بن محمد الفيصل، عن جهده المحلِّق في إنجازه لهذا السفر؟!. |
|
عريف الحفل: شكراً لسعادة الدكتور عبدالله مناع الكاتب والأديب المعروف على هذه المعلقة-أقصد الكلمة- التي تفضل بإلقائها. وننتقل الآن إلى الكلمة الثانية، ونرجو منك الاختصار يا دكتور يوسف، كي نستمع سوية إلى ضيفنا المحتفى به الدكتور عبد العزيز؛ والكلمة الآن للكاتب والأكاديمي دكتور يوسف العارف. |
|
|
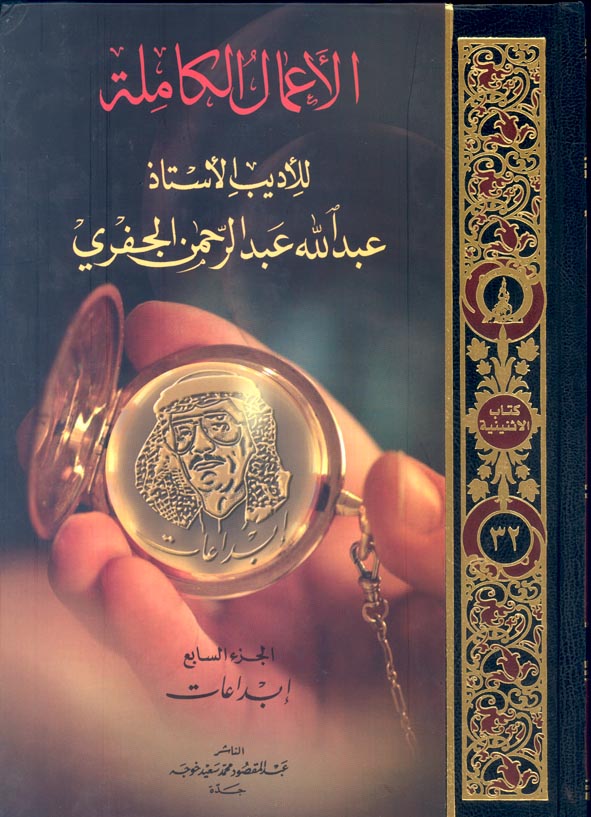
 شارع عبد المقصود خوجة
شارع عبد المقصود خوجة 00966-12-6982222 - تحويلة 250
00966-12-6982222 - تحويلة 250




