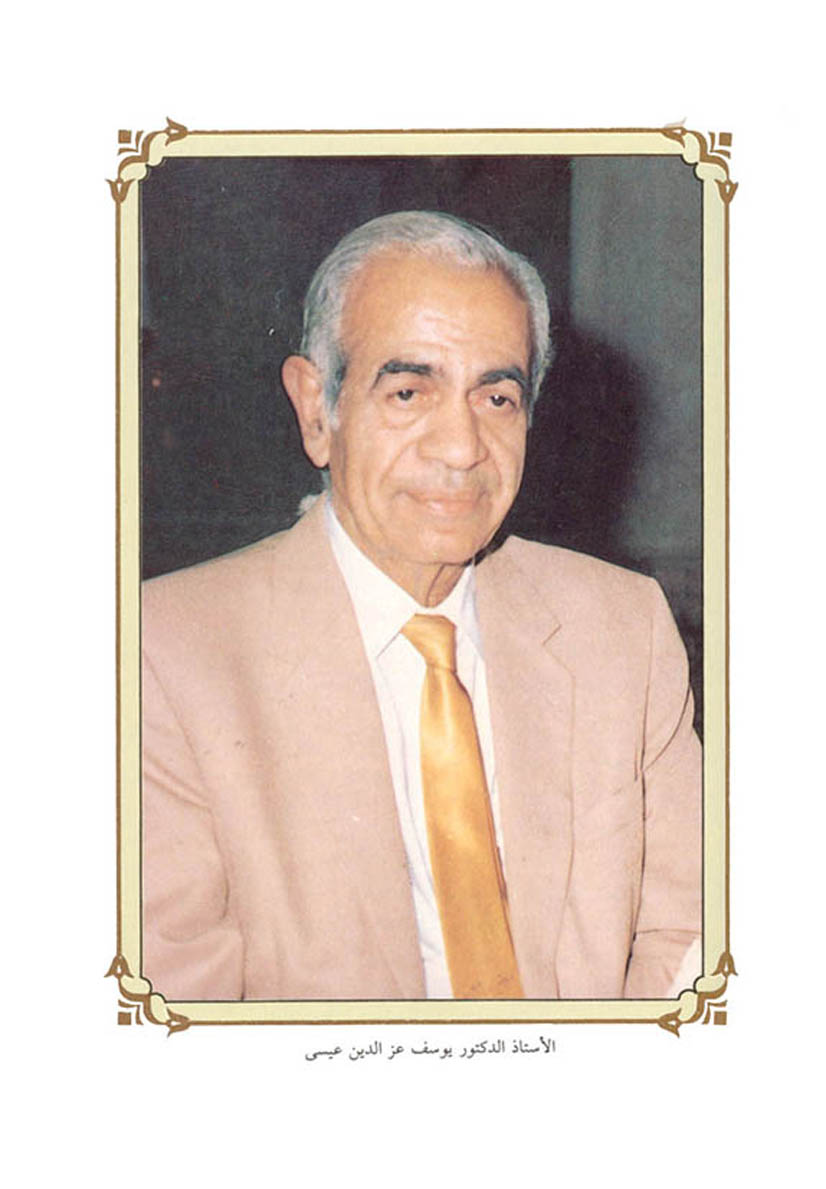| المقدمة
(1)
(2)
|
|
بقلم الأديب الحجازي الأستاذ حمزة شحاتة |
|
| الحجر مادة البناء الأولى. |
| فالإنسان يقيم به المأوى المقصود فيه الغرض على سد الضرورة والحاجة منه. |
| والبناء يصنع به منزلاً متكامل الصورة في النفع والتناسق والوثائق على نحو أوسع استيعاباً للمطالب المتطورة. |
| والنحات يصنع منه التماثيل والزخارف وفاتن الأشكال، لا يضع فيها دقة الصناعة وجمالها والنفع. بل المعنى والفكرة ورمز الفن وتعبيره، وأثرها في الخيال. |
| فصناعة النحت أتاحت للحجر تعبيراً أرقى من تعبيره في المأوى الحاجي، وفي المنزل الكامل. |
| والكلام هو وسيلة التعبير عن أغراضنا وأداة تشكيلها وتصويرها، فهو -بهذا- مادة البناء الأولى في مطالب النفس والفكر. |
| يصنع به المتحدث صور أغراضه ومراميه وشعوره. |
| ويصنع به الخطيب والكاتب وسيلة التأثير والاستفزاز، والاستهواء وترسيخ الغرض وتوكيد المطلب وعرض الفكرة والدعوة إليها. |
| ويصنع به الشاعر كل ذلك أو بعضه في صور أعمق فنية، وأوضح مثالية، وأفصح جمالاً، وأروع فتنة. |
| والناس لا يطلبون في المأوى الحاجي ما لا يحققه إلا المنزل المتكامل، ولا في المنزل المتكامل -من حيث توسع أغراض الصناعة والارتفاق- ما يطلبونه في صناعة النحت التي تستهدف التعبير الفني عن الفكرة؛ فهم أيضاً لا يلتمسون في الخطيب وما يلتمسونه عند الكاتب، ولا عند الكاتب ما يلتمسونه عند الشاعر. |
| فالشاعر إذن صاحب صناعة فنية مثالية رفيعة، تتصرف بمادة البناء الأولى في أبنيتها وصورها تصرُّفاً يتيح لها تعبيراً غنياً وأروع وأحفل بالفكرة والإشارة والرمز والمعنى والمضمون، أو تصرُّفاً أوسع مدى من تصرف المتحدث والخطيب والكاتب. |
| هذا الكلام مبدأ أو محاولة، لتبسيط فكرة التفريق بين المتحدث بالكلام المرسل مطلبه الإفصاح، والخطيب هدفه التأثير والاستهواء، والكاتب غايته ترسيخ الفكرة وتأسيسها، والشاعر يستهدف ما شاء في حياة الفكر والخيال والشعور وحركة النفس وخلجاتها واستجاباتها وحقائقها وأوهامها، أو في حياة الواقع والقانون والمنطق والقاعدة والعمل والتكوين، والرأي والعقيدة ولكن من هذا السبيل وبهذا الأسلوب سبيل الجمال وأسلوبه الخاص. |
| بهذا التفريق -إن كان معقولاً- تتفاوت مراتب الكلام حديثاً مرسلاً، وصناعة حديث، وكتابة أديب، وشعراً. |
| والشعر -على ما يبدو أنه الصحيح- كلام وصناعة وفن. ولكنه في كل صورة من هذه الصور، الترف الحافل بمعاني القدرة المعبرة وذخائرها النفسية، في أبهى الحلل والأثواب، حتى بساطته -وهي من أسمى صفاته وغاياته- إنما تكون ترف البساطة الفنية بالمذخورات، لأفقرها العاري أو المتكلف. |
| إن بواعث الشعر -فكرية كانت أو نفسية- هي ذات بواعث الحياة وانفعالاتها ومعانيه وخيالاته وصوره هي التي تجول في كل نفس وفكرة غامضة مكبوحة. أو واضحة طليقة، وباهتة أو لامعة. |
| والكلام هو وسيلة تصويرها والتعبير عنها، أو هو مادة بنائها، فلا جرم كانت ديباجة الشاعر وأسلوبه قوة وضعفاً وانطفاءً ونصوعاً، وصحة واعتلالاً، هي الدلالة والفارق والمقياس وميزان الحكم على قدرة الصناعة وحذقها وأهبتها واكتمال أدواتها. |
| وندير الكلام على طريقة أخرى فنقول: إن بواعث الشعر هي بواعث الغناء في كل نفس إنسانية، ونظن الأمر في هذه الفكرة من الوضوح بحيث لا يحتاج إلى دليل أو موازنة. |
| وباعث الغناء يقر في نفس كل إنسان تقريباً، فكل إنسان يغني لنفسه بكلام ذي معنى يصنعه ويستعيره أو يدندن بشيء يقل أو ينعدم نصيب المعنى وأثره فيه، وما في ذلك ضير ولا به غرابة فهو طبيعي بل ضروري في كثير من الأحوال، فلو سأل سائل، لماذا يغني الإنسان لنفسه؟ لما كان هذا السؤال إنكاراً أو اعتراضاً، وإنما يكون تقصياً للأسباب والبواعث والعلل. |
| أما إذا سأل: لماذا يغني الإنسان للناس؟ فإن السؤال هنا يشمل الإنكار أو احتماله ويشمل مسوغات الإقرار لفتح بابها أو قفله قبولاً أو رفضاً. |
| والإنسان إذا غنى للناس -احترافاً أو هواية- كان أول واجباته وأخلقها بالالتزام والرعاية من جانبه أن لا يقول شيئاً على أنه باب من أبواب الكلام يُفهم، بل شيئاً يستجاب ويطرب ويحرك الإقبال من باب حُسْن التصويت، ورخامة التنغيم، وقوة الاستجابة للمشاعر أولاً. |
| فهذه الصفات تنزل منزلة الأسلوب واتساق العرض وجماله وتأثيره في بسط النفس واجتذابها إلى ما تحتها أو وراءها من غرض هذا المغنى الماثل في المقطوعة المغناة أو القول المردد. |
| وقد يفتقد في المغني حسن الصوت ولطافته فيستعيض السامع من ذاك قوة النبر أو امتداد النفس أو عمق الترجيع أو القدرة على الضبط والتوازن أو سعة الحيلة في التصرف فهذا تحريك للإقبال والتأثر والانفعال في السامع بلون أو أكثر من ألوان القدرة والحذق يعوضه عن فقدان مطلبه الأساسي من المغني. |
| فإذا حرم المغني من ذلك كله ولم تبق له إلا قوة المعنى وجماله وبراعته في بناء المقطوعة، لم يَعْدُ أن يكون مردداً أو مرتلاً أو مُنشداً... وهذا على أي حال غير مطلب الغناء والتطريب وغير ما يستحق به رافع عقيرته!! اسم المغني أو المطرب. |
| * * * |
| وعلى أن الشعر كالغناء في بواعثه وغايات تأثيره كان لكل إنسان يحسن بواعث الشعر أن يقوله. كما كان لكل إنسان يحس بواعث الغناء أن يغني. لا حجر في ذلك على كليهما أمام قوانين الحرية والاختيار. أما أن يرفع المغني أو الشاعر عقيرته بين الناس فمسألة أخرى تختلف كل الاختلاف، فهو هنا عارض بضاعة، أو طالب مقايضة، أو ملتمس مكانة، أو مستهدف غرض أدبي في الجماعة، أو متطوع لها -احتيالاً على المحمدة- بما يفرض فيه أنه خير ما عنده، أو خير ما يقدر عليه؛ على معنى أنه مُغن أو شاعر، والمعنى الماثل في عديد هذه الصور يتضمن الدعوة إلى المشاركة فيما يستحق بحشم مشقة السعي والإقبال والتلبية، واحتمال المنة المظنونة. |
| والإنسان وحده يأكل ما يشاء أو ما لا يقدر على أحسن منه وأطيب، ليس لأحد عليه حجر في الاكتفاء بالميسور والتافه وبما ليس به غناء في إقامة البنية أو حفظ الرمق، ولكنه متى دعا الناس إلى وليمة وجب أن يزكي دعوته ببسط أسباب الكفاية والإمتاع والتوسعة لهم، وتوخي غاية التجمل والإحسان على مقدار غرضه من دعوته أو على مقدار حرمة ضيوفه عليه أو على أنفسهم فهذا هو الصحيح. |
| ولو سألنا الآن: ما هي أغراض الشعر؟ لوجدنا أنها الجمال والتأثير، وإبداع الصور، أو استعارتها لتوشينها وجلائها وتلوين الحقائق والأفكار، أو صنعها أو صنعهما، أو ما شاءت المذاهب والطاقات، والمعنى المنطوي في ذلك كله، والدائر على تفسير جهد الشاعر، إنما هو مباهاته المضمرة بقدرته على هذا النحو من الإنتاج الفكري الرفيع -ما في ذلك شك-. |
| والشاعر في وسعه أن يكتفي بميسور الشعر أو بما دونه لنفسه ولمن ينزل منزلتها عنده، ولكنه متى أقام المعرض لكفايته على أعين الناس وأسماعهم فقد أولم! أو رفع عقيرته بالغناء! فما يحسن به حينئذٍ أن يستبقى من غايات فنه بعضها حين يفقد سائرها، ولا أن يكون هذا السائر المفقود هو القوام، أو ما يدخل في باب المطالب الأصليه للشعر والغناء. |
| ونوضح الأمر فنقول: إن الأسلوب قوام الشعر كما هو قوام الغناء، أو كما هو قوام كل فاتن وجميل وقوي ومؤثر في جملة ما يتوقف حصول تأثيره، على اجتذاب الرغبة فيه وإثارة الإعجاب به وتحريك الميل إليه. |
| نعم! إن الأسلوب قوام الشعر، ومظهر غاياته ومقاصده وهو في هذا كالجمال تهيأ له الوسامة والقسامة وحلاوة الشارة على قانون مقاييسها الجسدية، ولا تتهيأ له الحركة والنبض والروح وتأثير انطلاق معانيه، فيكون جمالاً (أسلوبياً) تجتمع له أسباب القدرة ومظاهرها ولا تتم له بها الغلبة والسيطرة على المشاعر والنفوس، ولكنه يظل جمالاً سليماً في القاعدة والتعريف، جمالاً يحرك الإعجاب والميل إلى التأمل إن لم يحرك الرغبة ويبعث الصبوة ويثير الهوى. فهو بهذا خير من دلائل الحركة الباطنة والنبض، والمعنى، والتعبير الملحوظ -في جسم متنافر التركيب، أو شاذ المقاييس، أو مطموس معالم الوسامة. |
| فالأسلوب في الشعر هكذا؛ هو شارة الحسن وشياته في مثال الجمال، ولا معدى عن أن يكون صفة الشعر الأولى ومزيته وأساسه وقوامه. |
| ولا شك أن الجمال التام هو ما تجتمع له سلامة الصورة موازنة لمعاني التأثير في تعبير المفاتن الجسدية أو شيء من هذا إلى شيء من ذاك. |
| ولكننا نسأل: أي جمال -أسلوبي- يخلو من صفات التأثير ودواعيه وأسبابه؟ كما نسأل: أي كلام يمكن أن يخلو من المعنى؟ إنما أسوأ الفروض أن يكون وجود صفات التأثير ودواعيه وأسبابه في الجمال -الأسلوبي- وجوداً ناقصاً أو مرجوحاً فلا يكون بهذا النقص سبباً مباشراً في التأثير أو السبب المباشر له، بل معنى فيه، أو عنصراً في جملة عناصره، أو عاملاً من عوامله فهذا أخلق بأن يكون المعقول والواقع المفسر. |
| ولنذهب أبعد من هذا المذهب فنتصور جمالاً توازنت فيه معنويات الروح المعبرة المنطلقة، على مقاييس جمال الجسد وحسن شارته، ولكنه فقد جمال الاتساق في التصرف وبراعة الحركة في المشي والالتفاف والإيماء والاستجابة أو فقد لبوس النشاط المستمد من حذق القدرة في الإدراك والفطنة واللمح والحنكة والدربة المكتملة في استخدام المفاتن أو استخدام ما تدور عليه من انسجام الزينة والملبس! أفلا يكون بهذه العنجهية جمالاً يستثير العطف والمرحمة والإشفاق أو ربما استثار السخرية، لما طرأ على جملة أسلوبه من النقص والاضطراب والمفارقة بسبب فقدان هذه العوامل التي هي أسلوب، أو تكميل له؟؟ |
| فالأسلوب في هذه الحالة، هو فن القدرة على استخدام المظاهر وتطويعها للتعبير عما ترمز إليه تعبيراً تنهض به الفتنة ويستقيم التأثير. |
| إن فن الحركة وفن توزيع الألوان، أو الأنوار والتصرف في تسليطها وتقدير نسب سقوطها على الأمكنة والشخوص والمناظر والحالات، وفن تزويق الملابس بالتقصير والتطويل، والتضييق والإرخاء والشد واللف والضم والمواءمة أو المفارقة بين خطوط اتجاهاتها بالمعارضة والانحراف -إن كل ذلك أسلوب يضع صوراً من الجمال أخاذة السحر والفتنة تكبر الصغير وتجلو الغامض أو تكسب بالغموض المتوخى أسباباً مثيرة للافتنان... أو توارى القبح أو تصغ بالمغالطة عن الحقيقة صواباً فنياً يهز -أو يحرك- الإقبال. |
| فإن كان الشعر فناً والشاعر فناناً أو كانا صناعة وصانعاً فالحقيقة لا تختلف وهي أن الشعر موضوعه وغايته الجمال والتأثير في كل مدخل ومخرج من مداخله ومخارجه، وإلا كان كل كلام يغني عن الشعر وكل مبين عما يحس ويتخيل ويبتغي يغني عن الشاعر. |
| والناس؟ أفلا يحبون ويتألمون ويحسون ويصفون ويفرحون بالطبيعة ويتحمسون ويستجيبون لكل ما يستجيب له الشاعر ويستثير بعضهم بعضاً. ويفكرون ويحللون ويتنادرون ويتمثلون الأمثال والحكم -على نحو لا يختلف إلا باختلاف صيغ الكلام وأساليبه؟ فما حاجتهم إذن إلى الشعر والشاعر إن لم يكن أسلوبه في العرض والتركيب والتلوين والتصوير واستخدام الخيال والتصرف بعناصر الجمال تعقيداً... وتبسيطاً وتوليداً -جاعلاً لكل ما يعرفون ويحسون أبعاداً وصوراً وفتنة أعم وأغنى وأحفل ببواعث التأثير؟؟ |
| وهكذا، فما حاجتهم إلى النجار والبناء؟ أفلا يسع أحدهم أو يسعهم بالتعاون والاشتراك أن يصنعوا من الحجر والخشب ما يشاءون على النحو الممكن ومعناه المقصود!؟ |
| والآن -وإن كنت لم أستوف الكلام بعد إبقاء على صبر القارئ- أدعوه أو أعزم عليه -باسم الله- أن يخوض وحده معركة سافرة ضد ثلاثين شاعراً -على وجه التقريب- من شعراء الحجاز في هذه المجموعة التي اختار جامعها -غفر الله له- أن لا يقدم لهم أو لها سواي دون عباد الله قاطبة ففعلت بعد أن سدت في وجهي أبواب الهروب والإفلات. |
| والقارئ لا شك يعلم أن من مصطلح أدب التقديم الذي جرى فيه الناس على مألوف العادة والعرف أن يكون تنبيهاً عريضاً إلى المحاسن وإعلاناً عنها أو لها إشارة مجملة إلى نقائضها وأضدادها لا تخرج عن نافلة الاستبراء بحركة... أو بحركتين إن رؤي أن هذا ضروري لإثبات الأمانة. |
| وهذا -ولا أكتم القارئ- مزاج ثقيل الوطأة على مزاجي وعقلي أو هو امتحان عنيف لطبيعتي بما لا تواتيني عليه. فما يسهل عليَّ أن أنزل منزلة المعلن أو قارع الجرس أو السمسار يروج السلعة بالباطل أو بما يدخل تحته من صور الحق والجد المصنوعة الجاهزة للطلب!! |
| وإني لأعرف كما يعرف أي عاقل من القراء -فما يعنيني غيرهم- إن الجيد إعلان ذاته فحسبه من الداعي إلى الإقبال عليه التنبيه الرصين أو الإشارة المجملة. أما الرديء فهو أخلق بطول الكلام عنه وفيه وحوله، من الناقد أو العارض أو "المقدم". |
| والمقدم وهو هنا أنا -إذا كان القارئ لا يعلم- وسيط بين الشاعر وقرائه. فأول ما ينبغي أن يتصف به أمانة الوسطاء في دفع أسباب الخداع والتضليل، ووضوح البراءة منهما، ويشهد القارئ الجاد أني فعلتها بما قلت وإن كنت لم أفتح الباب على مصراعيه واعتماداً على فطنة الناس وزكانتهم. |
| ولقائل أن يقول: ولكن الناس يعرفون أو هذا هو المفروض فيهم، فما ضرورة تنبيههم إلى المساوي؟ أو يجهلون فما حكمة أن تفتح عيونهم على ما يسوء ويعثي؟ والرد على هذا يتلخص في أن الإنسان -الطبيعي- إنما يستهدف حتى من تحمل الخبر الخالص نفعاً لنفسه ولو جاء هذا النفع من باب اللذة والارتياح. وإذن، فلا أقل لمن يقدِّم مجموعة من الشعر -كهذه- من أن يدفع التهمة عن رأيه وفطنته وبصره وإلا كان قارع جرس، أو حامل طبلة، أو سمساراً. وما أحسب أن الجامع، يبطن الرضاء لي بهذه المنزلة، وعلى أعين القراء وأسماعهم، وفي هذا المقام الذي لم يحملني على التعرض لأذاه المؤكد إلا هو ومن استعان بهم علي. نعم إنه لكذلك كان شر ما في الدنيا صداقة جامعي الشعر وحاشدي الشعراء. |
| أوهبني بائع دابة سليمة! فما يكون اشتراطي العيب فيها تفادياً لاحتمالات السوء الممكنة، وأخذاً بخطة الحزم في سد باب الذرائع؟؟ فهذا ما آثرته لنفسي على بينة. |
| وأمر آخر! هو أن سعادة الوزير المفوض الأستاذ الكبير الشاعر محمد سرور الصبان كان قد سبقني -في غرة المحرم 1368هـ- إلى تقديم (شعراء ثلاثة!) فقال أحسن الله إليه: "الشعراء الثلاثة الذين نقرأ بعض شعرهم في هذه المجموعة ليسوا كل الشعراء الممتازين في البلاد ولكنهم -دون شك- من نخبة الشعراء الممتازين فيها". فماذا يقول القارئ في هذا وفي أنني -ثالث!- هؤلاء الشعراء على إباء منِّي وعناد بلغا حد الحرارة والتهديد بمقاضاة الجامع!؟ وعلى إيماني بخطأ الناس في اعتباري شاعراً لمجرد أنني أنظم في بعض الحالات؟؟ |
| إنها غمزة من الأستاذ الكبير للجامع ولثلاثة الشعراء مجموعته! غمزة زادها وضوحاً بقوله: "ومع أن هذه المجموعة ليست كل نتاج هؤلاء الشعراء، ولا كل جيد شعرهم، وسواء أكانت من مختارات الجامع! أو من مختارات الشعراء أنفسهم فإنها مجموعة صالحة للتعبير عن..." |
| ثم قال: "ولست هنا في معرض النقد". |
| وهكذا أرادت فطنة الأستاذ الكبير أن تدفع وهم القراء الذين عساهم يستمدونه من قلة في العدد لعلها تحملهم على ظن التفرد بالامتياز على سائر الشعراء، لثلاثة منهم!! وكأنما أراد سعادة الأستاذ الكبير أن يقول: إنهم شعراء ثلاثة، وليسوا الشعراء الثلاثة، وبين التعريف والتنكير هنا فرق ملحوظ يفسر الغمزة التي تناولت المختار من شعرهم بالتشكيك فيه؛ ويفسر تعريضه بقالبية هذا المختار للنقد، لو كان في معرضه! |
| لست أسوق هذا الكلام الذي طالت به المقدمة فانقلبت شيئاً آخر لا أعرف له اسماً، إلا لأدلل على ضرورة الجزم بوجوب الأمانة والفطنة والتحرز والأخذ بأسباب التحوط -ولو كتابة كما فعل الأستاذ- لكل من يقدم ثلاثة شعراء فما فوق!! |
| وهكذا يذهب سعادة الشيخ -دوني- حتى بحسنة السبق إلى هذا، ولكن! أيفوتني اقتفاء أثره؟ فما زلت أرى أن الناس ينالون الحظ أضعاف ما ينالون بجد المساعي حتى في دنيا الأدب والشعر... والتقديم! كلا! والله. وما يعيبني الرضاء بالميسور إن كان هو كل ما يتأتى لمثلي على وعورة الجهاد ووعثاء الإمعان في السعي وكمال العدة على أقوم الوجوه وأسدها. والأستاذ الكبير يعد أحد الشعراء في هذه المجموعة الزاخرة بالعدد الوافر من الشعراء التي أقدم لها مكرهاً لا مختاراً... بل هو حامل رايتهم في نظام الصف والترتيب. لهذا وحده يجعل الأمر أدعى لإبراء الذمة، وتخليص الضمير... وابتغاء مرضاة الله بقوله الحق! وإلا فماذا؟ |
| لقد وجد الأستاذ الكبير ما قاله في المجموعة الأولى فترى ما الذي كان يقوله مما يدفع به التهمة عن فطنته أو يوجه به الغمزة لو كان هو مقدم مجموعة اليوم لا أنا؟!. فهذه مجموعة ضخمة من الشعر! وعدد من الشعراء وفير: وهذا اختيارهم لا اختيار الجامع: -والحمد لله- ونحن نستقبل نهاية عام 1370هـ لا مطلع عام 1368هـ. |
| أهناك شيء آخر؟ إنه الحصر والاستيعاب على ما يبدو. فهل يرى سعادة الأستاذ الكبير أن أعرف الناس بهذا؟ أو أن أقتفيه فَأقول: عن هذا العدد من الشعراء الممتازين -وكلهم موهوب- هو "ما تيسر"! حشده الآن... أو في خلال سنتين مضتا أو ثلاث والبقية تأتي؟ وإن هذا الشعر الممتاز ليس هو أجود ما قالوه ولكنه منه ولا أجود ما قال أشباههم ولكن بسبيله؟ وأنه -على هذا- صالح لتمثيل دورنا في (تكوين الأدب العربي الحديث... أو للتعبير عنه وكان الله سميعاً بصيراً؟؟) |
| إنها غاية من غايات الاحتياط والتحرز والغمز لا أتعلق بغبار الأستاذ الكبير فيها. وما أكثر ما خانني حظي وأسلمني فلتكن مرزأة من مرازيه التي اعتدتها حتى ألفتها.. |
| ويحلو لي الآن أن أصرف حديثي إلى القارئ -مترفقاً على صبره- فأقول: إن الناس يتعلمون الرقص قبل أن يقوموا به علانية في المجتمعات. ويحذقون قيادة السيارات قبل أن يقتحموا بها الشوارع. أو أن هذا هو المفروض والواجب. فإذا خرج راقص في حفل عن مساوقة الموسيقى والإيقاع وداس في كل دورة من دوراته مرة أو مرتين على قدم من يزامله كان لا يصلح أن يرقص على أعين الناس وأسماعهم لأن الرقص عرض سليم واتساق وجمال وترابط وانسجام وقدرة على التصرف وتعبير، وقواعد. أو... لأنه أسلوب! |
| وإذا اضطربت عجلة القيادة بين يدي قائد السيارة فتأرجحت أو جنحت أو كان لا يتاح لها التماسك والربط عند وجوب أحدهما أو كليهما، أو كانت لا تنساب وتتدفق وتلف وتتحول في إحكام وسلامة واتزان يدل كل منهما على صحة التقدير وقوة السيطرة كان سائقها جاهلاً بخصوصيات القيادة كفن أو كصناعة أو كعمل... ولو اقتنى مصنع سيارات، لأن قيادتها فطنة ولمح وإدراك وحذق وحسن تقدير وصناعة. أو، لأنها أسلوب، فالأمر على هذا القياس بالنسبة للشعر والشعراء.. ولو كان حجازياً... ولو كانوا حجازيين؟؟ |
| إنه أمر يهول... |
| وما على القارئ الآن -وهذا هو الحق لا غيره- إلا أن يخوض المعركة وحده فيسأل نفسه، أو يسأل سواه -وله الخيرة- ما هو نصيب كل شاعر -في هذه المجموعة من قصة الأسلوب والدِّيباجة هذه، إشراقاً وقوة ومتانة تركيب؟ وما هي قدرته على التصرف وفطنته وحذقه في الصياغة والتركيب والتعبير والاتساق وسلامة الحركة ورشاقتها... وتجنب وطء الأقدام أثناء الرقص؟ وما هو حقه في ادعاء الشاعرية واكتساب رسمها؟ أو حقه في أن يرفع عقيرته بين الناس في الشعر؟؟ |
| فإذا عرف القارئ شيئاً -وسيعرف- فقد تهيأت له أسباب الحكم والتحديد واستعان بخير الطرق وأقلها مشقة على التقصِّي والكشف عن مزية كل شاعر وطابعه وخصوصياته وشخصيته وقدرته. وقد وقع على الجمال الذي يجتمع له إلى حسن الشارة والميسم في ظاهره. جمال المعنى وفتنة الدعوة والتأثير في ما تحت هذا الظاهر المجلو، أو وقع على القبح الشنيع يزيده شناعة أنه شعر من صناعة شاعر بين شعراء. |
| أما أنا فقد نصبت الميزان وأقمت المقاييس ومهدت الجادة بما وسعني من جهد ودفعت التهمة عن فطنتي بما حسب القارئ به وكفى. وأديت للوساطة حرمتها أو حقها من الأمانة ولم يعد للقارئ إلا أن يزن ويذرع ويحدد الفروق والمراتب والدرجات فما يتسع طوقي لأكثر من هذا ولو اتسع لكنت خليقاً بألا أتجاوزه اتِّقاء لما تجر إليه الجرأة على حرمات الشعراء من نصيب الدفاع وأوصاب الذياد في هذا الزمن المدبر الذي تضخم فيه كل شيء حتى الشعر والشعراء. |
| وهذا حق نفسي علي في التماس السلامة بالتقية والاحتراس أو بقبول تهمة العجز عن اضطلاعي بأعباء الملاحاة المتوقعة من نيف وعشرين شاعراً... وذوي عصبياتهم الأدبية، وأشياعها... فإن الأمر -على ما يرى القارئ- جدير بأن يروع القلب أو يخلعه، والإنسان مطالب باتقاء التهلكة فإن قال القارئ -متخابثاً- وهو مطالب أيضاً بأن لا يجهر بالسوء قلت إن تعميم الرمز والتضمين والإشارة وإطلاق الدلالة بالقواعد التي يكتشف بها النقص أو تفرق المعابث في الشعر والشعراء مثلاً ليس من باب الجهر بالسوء أو الهمس به. أفلا يقول الواعظ لوجوه الناس وعليتهم... وفي المسجد... وبملء صوته: "أيها الناس لقد فسدت أعمالكم وزاد إمعانكم في الضلال وركوب الموبقات الأوزار والسوء وكيت وكيت من الرذائل" فلا يكون لأحد من سامعيه أن يأخذ بتلابيبه إلى حيث يقاضيه فإذا ما رمى رجلاً بعينه أو بسامعه بشيء مما قال: لزمه ما يلزم المعتدي على كرامة مسلم فأقام البينة وأخذ بالجريرة؟ |
| ولم يبق للقارئ بعد هذا في عنقي إلا أن أسأل الله لي وله المغفرة، وحسن العاقبة، وسلامة المصير، ولطف الختام. |
| وبعد، فإن من شعراء هذه المجموعة من لا يفخر الحجاز وحده بهم ويتيه، بل كل بلد عربي، وهم: السرحان، وعواد، وقنديل، وحسين عرب، وأشباههم في معظم السمات وفي بعضها دون جملتها. |
| ومنهم مستحق الرثاء، ومنهم مستوجب التَّعْزير، حتى يعلن التوبة من رفع عقيرته بمثل هذا الهراء ظنه شعراً، فأفسد به -أو كاد- جو هذه المجموعة الرقيقة حتى أوشك أن يتحول به إلى جو مظاهرة من المظاهرات التي يغلب عليها عنصر الرعاع والدهماء. وغفر الله لي ولسعادة الأستاذ الشيخ محمد سرور الصبان فهي جريرة من جرائر تقديمه للشعراء الثلاثة في (غرة المحرم 1368هـ) فتحت هذه الشقوق والغيران فانطلقت منها هذه الأحياء الشاعرة تكثيراً للعدد أو تسويغاً لدعوة الأستاذ الكبير أو تحقيقاً لأمله العريض فيها أو إغراقاً للسوق بالعملة الرديئة على الطريقة الشائعة. |
| والله من وراء القصد وهو الغفور الرحيم. |
|
|
 شارع عبد المقصود خوجة
شارع عبد المقصود خوجة 00966-12-6982222 - تحويلة 250
00966-12-6982222 - تحويلة 250