| طفل الحجارة! |
|
دثِّريني.. واعزفيني عند طابور
|
|
الصباح المدرسيِّ على العيالْ
|
|
زمِّليني.. واقطفي من فُلِّ قلبي ما استترْ
|
|
واجمعي طوقاً.. أُزيِّن فيه هامات الرجال!!
|
|
|
| (1) |
| أنا هذا الطفل الفلسطيني، مع الحجارة وبعدها: |
| لا أنسى هذا المشهد.. لا أنساه! |
| أُلفِّعه بصور ضبابية أخرى تبعده.. تقذفه من ذاكرتي إلى أغوار نفسي، ليبقى فيها مع الجوهر، ولا يتسلّط على معايشتي ومسيرتي اليومية! |
| لعلّكم شاهدتم مشاهد أفظع وأقسى. |
| إذن لننادِ: يا إنسانيي العالم.. اتّحدوا! |
| وكيف يتحدون في هذا الدمار.. في لحظة قتل الأطفال -الغد، ولم يكن لهم غد أوسع وأكبر من مساحة ((خيمة)).. ولم تعد لهم أرض أثبت وأرسى من ((المخيمات))؟! |
| نحن نُرهق كل يوم.. لأننا بتنا نستهلك إنسانيتنا كلها في التعامل داخل إطار الخوف، والقسوة، والقتل، والأحقاد. |
| نحن نحتاج -لنجاري الآخرين- إلى بعض الأنانية، وبعض المادية، وبعض القسوة طالما قدرتنا على ممارستها محدودة.. وحتى نأخذ ما نحرص على عدم التفريط فيه، ولنعطي بمقدار الأخذ! |
| وبرغم طبيعة الحياة التي رمت بنا إلى المخيمات.. فعندما تطفو إنسانيتنا، ينتصر الخير لحظتها، وتسطع المحبة، وقد نعطي دون المطالبة بالمقابل! |
| (2) |
| قد تندهش، بل لا بد أن تندهش، وأنت تقرأ هذا الحس النفسي وتتساءل: |
| - كيف يكتب طفل فلسطيني بهذا العقل، أو بهذا الأسلوب؟! |
| أرجوك لا تندهش من الكلام.. بل لا بد أن تندهشوا جميعاً: كيف يكبر الطفل الفلسطيني عمراً بكامله في لحظة.. كيف يتحوّل من طفل بريء عفوي.. إلى مقاتل يضغط على الزناد، ويقتل خوفاً من أن يقتلوه؟! |
| وما الذي يتبقّى من طفولة هذا الطفل.. إذا رأى أمه أمام عينيه تُقتل، أو تُبقر بطنها، وإذا رأى أخته تغتصب، وإذا رأى والده يسقط.. ولا يكون سقوطه برصاصة واحدة، ولكن جسده يتحوّل إلى ثقوب غربال.. لأن القتل بالرصاصة في ضمير الحاقدين والقتلة لم يعد هو المطلوب والمرغوب للإنسان الفلسطيني.. بل القتل بالرشاش، وبالقنبلة الانشطارية! |
| عرفت كل أنواع السلاح، والقنابل. |
| كان المفروض أن أتعلّم في المدرسة: القرآن، والرياضيات، والمنطق!! |
| فاضطرنا الاستعمار الخارجي من أعداء الدين والأرض، والاستعمار الداخلي من أعداء الإنسان.. إلى أن لا نتعلم هذه الأسس في المدرسة، ولكن نتعلم في الشارع وفي المخيمات، وتحت الأنقاض، وفي المخابئ والملاجئ.. ونتخصص -كأطفال- في الضغط على الزناد. |
| فأي عصر هذا الذي نعيش فيه الموت؟! |
| (3) |
| أنا -يا سيدي- طفل لم أتخط العاشرة بعد.. تصوّر؟! |
| ولك أن تندهش مرة أخرى.. كيف ما زلت إنساناً، وكيف أن عواطفي الإنسانية تقودني في لحظات طفو إنسانيتي! |
| أرجوك أن تضحك أمام استخدامي لتعبير ((الطفو)) هنا.. فالطفو أصبح هو أملنا الوحيد في لزوجة هذا المستنقع الذي قذفونا داخله! |
| ودعني أصوّر لك هذا المشهد الذي لن أنساه: |
| كنت أكثر طفولة، وبراءة.. أشعر بتعاسة الحياة في بيتنا ((المخيم))، ولكنَّ الطفولة أرحم من عقل الكبار.. كانت طفولتي تمنحني الشعور المريح أحياناً.. وكنت ألعب مع إخوتي وزملائي في المأساة، وكنت أضحك وأركض! |
| تعوّدنا -يا سيدي- أن تكون الأرض خندقاً.. بدلاً من أن تبقى ((بياءة)) برتقال، أو مزرعة! |
| تعوّدنا -أيضاً- أن تنطلق رصاصة.. بدلاً من أن يرفرف جناحا ((سنونو)). |
| تعوّدنا أن تكون ملابسنا ممزقة.. بينما نجد أن الشيء الممزق في الآخرين: ضمائرهم وإنسانيتهم! |
| كانت الأحوال هادئة.. رضوا لنا أن نبقى في مخيم، وأن نمشي نحن الأطفال فوق الأرض، وخلال الأزقة الضيقة. |
| كان ذلك منتهى الكرم منهم لنا! |
| وذات صباح.. والشمس لم تلذع الأرض، امتدت خيوط الفجر ومزّقت ثوب الليل الحالك سواده. |
| خرجنا مجموعة أطفال نحمل كتبنا لندرس، لا بد أن نتعلم. |
| كان اليوم جديداً على الأرض، وعادياً لم يختلف عن اليوم الراحل في شعورنا. |
| الصباح مهما كان، وبالذات في يقظة طفل، كان مريحاً، وجميلاً ومبهجاً. |
| خرجت، وبجانبي طفلان آخران.. فرحا بالنهار الجديد مثلي، وتحمَّسا أن يتعلما كلمة جديدة.. لنحكي جميعاً بها وعنها طوال اليوم! |
| قادتني قدماي إلى ذلك المشهد، ونحن في الطريق إلى المدرسة: |
| طفلتان.. كانتا تقفان هذا الصباح الباردة نسماته، وكأنهما بدون ملابس. |
| كانتا ترتديان ملابس ممزقة، إنهما أختان من أسرة.. استشهد أبوهما في مجزرة ((تل الزعتر))، وقطعت يد أمهما. |
| توقفت مذهولاً.. كأنني أرى هذا المشهد لأول مرة، وهو مشهد معتاد! |
| كأنني -يا سيدي- قادم من قصر منيف، أو من بلد غني. |
| كأنني -أيضاً- لم أشاهد هذا المنظر من قبل. |
| تذكّرتُ أختي التي تكبرني بعامين، وقد طعنها جندي -يتكلّم العربية- بنصل، فهمدت جثة في مكانها. |
| بكيت، لا.. بل صرخت، وانطلقت أعدو كالمجنون.. ما أثار تعجُّب مَنْ كان معي من الأطفال، كانوا يتساءلون: |
| - ما به.. ماذا أصابه؟! |
| وركضت إلى أمي أحتمي بها من كل الآلام. |
| أمي لا تقدر أن تحتضنني إلاّ بيد واحدة.. فقد قطعوا لها يدها الأخرى.. كأنهم يعوّدوننا على التخلي عن الاحتضان.. كأن ليس لديهم أمهات، ولا أطفال! |
| (4) |
| مضى على ذلك المشهد وقت طويل! |
| عفوك.. نحن نعرف الأيام أكثر منكم.. نحسبها.. تبدو أطول من أيامكم.. ليلها أطول.. وحشتها أطول.. وحدتها أطول.. خوفها أطول! |
| لكنَّ ذلك المشهد لم يفارق عيني! |
| لعلّك تقول الآن ساخراً مني: |
| - إنه طفل.. فهذا المشهد عادي جداً.. يوجد في كل مكان.. حتى في أميركا.. حتى في الدول الكبرى والغنية.. مثلما هو في الدول الفقيرة، وفي الشعوب التي طاردها الاستعمار والحقد.. كأنهما يطاردان مستقبلهما! |
| لا بأس يا سيدي، احتمل هذا الطفل -أنا- فإن رسالتي لم تنته. |
| هناك ما هو أفظع، ربما تتصوره بخيالك، أو بإنسانيتك. |
| قالت لي أمي ذات ليلة، وأنا أطرح عليها سيلاً منهمراً من الأسئلة عن الصحف العربية، والذين يكتبون، والشعراء الفلسطينيين الذين ينشرون قصائد غزل، والكتب التي تتدفق من المطابع، أجابتني: |
| - هؤلاء يكتبون عن الحياة! |
| لما كبرت قليلاً.. كنت ألتقط حتى القصاصات التي يبعثرها الهواء، فوق التراب، وأقرأ، تعلمت قليلاً، وعدت إلى أمي أقول لها: |
| - هناك أيضاً الذين يكتبون عن الموت.. عنّا! |
| بكت أمي يومها.. وحينما جففت دمعتها الحائرة والمستمرة.. قالت لي: |
| - الكلمة الصادقة يا ولدي -تصوّر- الموت، ونكتبه.. لكننا نحن في هذا الجحيم، نطلع أقوى من الكلمة.. إننا نعاشر الموت.. نقاسمه لقمة عيشنا.. نسمح له أن يحتضننا ويقبِّلنا.. ثم ينهشنا! |
| مَنْ الذي يكتب عن الموت.. أعمق من الذي يعيشه، ويواجهه؟! |
| (5) |
| هل ما زلت مندهشاً -يا سيدي- من رسالتي هذه؟! |
| لو رأيتَ الموت ماثلاً أمامك مثلنا، فلن تندهش من كلمات يرسلها إليك طفل في العاشرة. |
| ستتهمني أن أحداً آخر كتب لي هذه الرسالة. |
| ليكن.. فقد كتبها معي كل الأطفال الفلسطينيين في المخيمات.. كتبتها معي أمي ذات اليد المقطوعة.. كتبها معي دم أبي الذي أهدره ((القبح)) في عالمنا.. كتبتها معي أثداء الأمهات اللواتي فقدن أطفالهن، ودموع الأطفال الذين فقدوا أمهاتهم وآباءهم.. كتبتها معي مأساة الأرض الفلسطينية التي لا تماثلها مأساة! |
| أسألك يا سيدي حين تكتب: |
| - لماذا تُهرولون إلى التاريخ فتنبشونه، وتأخذون منه أمثلة على جبروت الطغاة، والتتار، والسفّاحين؟! |
| وما يحدث في حاضرنا أشد فظاعة، وألماً.. أكثر سفالة وخزياً وعاراً.. أعمق مأساة. |
| التتار أرحم من اليهود، والطغاة أقلّ جبروتاً من هؤلاء الذين يقتلون الأطفال والنساء ونحن من دمائهم.. من أرضهم.. من وشائجهم! |
| تأكد أن التاريخ الذي يكتب الآن بالدم.. سوف يخجل كثيراً من الماضي، وسوف يتضاءل أكثر أمام المستقبل! |
| برغم كل شيء.. نحن نتفاءل.. دماؤنا التي أريقت تحوّلت إلى أنهار.. لكنها لن تتسرب إلى البحر، ولا إلى المحيط وتضيع فيه.. بل هي دماء سوف تروي الأرض كلها وتطلع من رحمها سنابل الغد! |
| (6) |
| أنا متفائل يا سيدي برغم المشهد الآخر: |
| في مجزرة ((صبرا وشاتيلا وبرج البراجنة)) الثانية: قطعوا اليد الأخرى لأمي.. أصبحت بلا يديْن. |
| سألتها والدموع تغطي عيني: |
| - لماذا تعيشين؟! |
| - قالت: لكل طفل فلسطيني. |
| ماتت أمي في اليوم نفسه.. لأنهم لم يسمحوا للهلال الأحمر أن يخلي الأمكنة من الجرحى ويعالجهم.. ماتت الطفلتان بثوبيهما الممزقيْن، فكان الموت أكثر سترة لهما من الملابس. |
| شاهدت رشاشات صوّبت على أربعة أطفال كانوا يصرخون بحثاً عن المخبأ، وعن أمهاتهم، ويحتمون بالعراء.. أطلقوا عليهم رشاشاتهم، فسقطوا في ذلك العراء! |
| المشهد أكثر ألماً.. والألم أكثر عجزاً! |
| ولي مطلب واحد فقط: ادعوا لنا أمام الكعبة. |
|
|
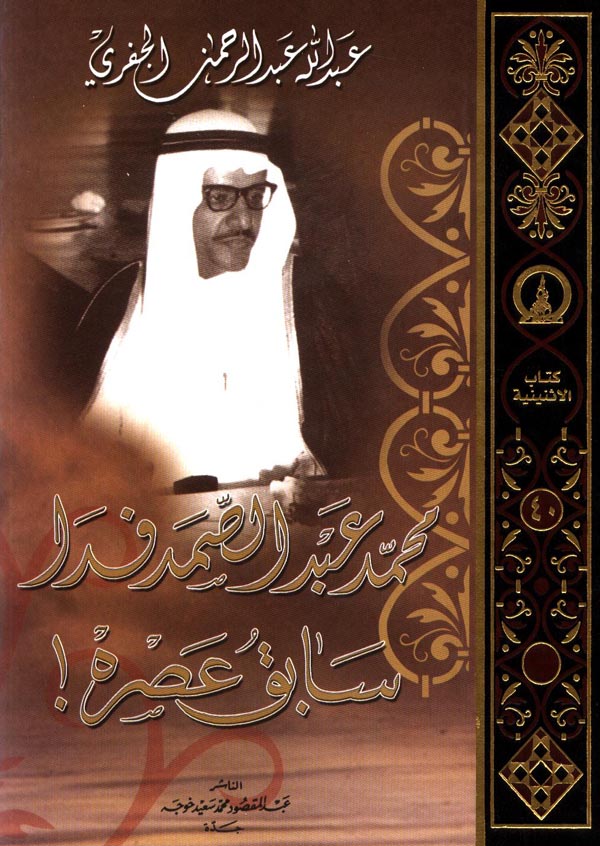
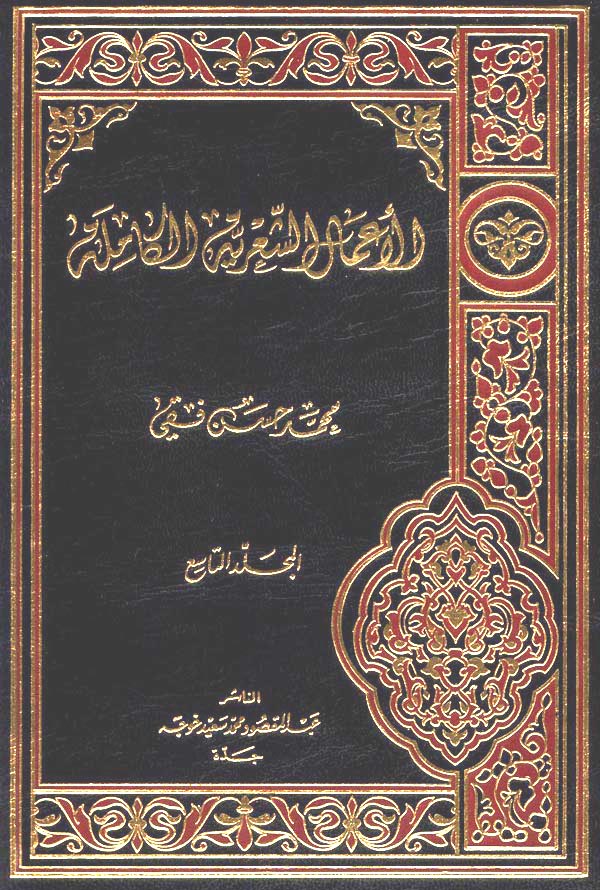
 شارع عبد المقصود خوجة
شارع عبد المقصود خوجة 00966-12-6982222 - تحويلة 250
00966-12-6982222 - تحويلة 250




