|
((كلمة سعادة الدكتورة ثريا أحمد عبيد))
|
| بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا الهادي الأمين، أصحاب المعالي، أصحاب السعادة، السيدات والسادة، أخي وأختي في هذا الحفل الكريم، أبدأ أولاً بالتعبير عن شعوري بالسعادة لما أعلنه أخي الشيخ عبد المقصود خوجه حول تكريم والدي بالأمس، وتكريم والده بالأمس، وهذا إن يدل فإنه يدل أولاً على كرم خادم الحرمين الشريفين وكذلك هو تأكيد بأن مسيرة هذا البلد تبقى في الذاكرة وتكرم حتى وإن بعد سنوات، في يوم 14 جمادى الثانية 1403هـ الموافق 28 مارس 1983م، وقف أمام العديد منكم كاتب وصحفي وقال محدثاً: إخواني أحييكم، وأشكر الله ثم أشكر جمعكم، فخور بكم ومعتزاً بانتمائي بالكلمة التي جمعتكم، وإنه لنبل منكم أن تجتمعوا، وجليل من صاحب الدعوة والدار، أن يجمع الكتبة والقلم بكم، شكراً لكم أن تهتموا بزميل لم يعد لقلمه وجود، ووفاء منكم أن تتذكروا إنتماء قد صار به الزمن، ولأن بقيت الذكرى فهي مستمدة من ذكراكم، ولأن دام الإنتماء فهو لمكارم أخلاقكم، فشكراً لكم وللصديق العزيز الأستاذ عبد المقصود، إن وقوفي أمامكم اليوم هو إحياء لذكرى والدي السيد أحمد عبيد الذي كرمتموه منذ ستة وعشرين عاماً، بعدما توقف عن النشر، وإن لم يتوقف عن الكتابة، فالكلمة كانت تجري في عروقه، والإيمان يملأ قلبه، وذهب إلى ربه، وبقيت الكلمة حية في ابنته التي تكرمونها اليوم، ولكنني عندما أوجه الكلمة لصاحب هذا البيت الكريم، تعجز الكلمة عن التعبير عن مشاعر الشكر والتقدير لمجرد أنه فكر في تكريم ابنة صديق لكم، وكان الأمين على الكلمة الصادقة البناءة، وأهم من دعوته كضيفة الاثنينية، أشكره على هذا العمل الرائع الذي يوثق الحركة الأدبية في بلادنا، إن مثل هذا الحوار يثري الجميع فكراً، ويوثق الحركة التنموية تاريخاً، وإنني إذ أكرم اليوم، فأنا أكرم مع رائدات الوطن الحبيب اللاتي كرمن من قبلي، وسيكرمن من بعدي، وأشكر الله على فضله دائماً، السؤال من هي ثريا أحمد عبيد؟ في أول جلسة في فبراير 2001م في نيويورك أمام المجلس الإداري المكون من 33 دولة لصندوق الأمم المتحدة للسكنى، قدمت نفسي كما يلي، قلت: أسرتي من الطبقة الوسطى في السعودية، ولها جذور ثابتة في المدينة المنورة، وتعلم والدي في مدرسة الحرم النبوي الشريف مثل أطفال ذلك العصر، لذلك تمتع بتعليم إسلامي ديني، وكان يؤمن والدي أن عليهما مسؤولية كمسلمين لتعليم أطفالهما ذكوراً وإناثاً، لأن العلم والمعرفة من الأسس الإسلامية، وجاءت الآية الأولى تأمر الرسول عليه الصلاة والسلام تأمره أن يقرأ، وهذا أصبح أمراً لكل مسلم بأن يقرأ، وأن يؤمن العلم لأطفاله، وأصبح التعليم حقاً من حقوق الطفل، كذلك وأنا ما زلت أوجه الكلام إلى المجلس التنفيذي، كذلك كبرت ضمن تراث قيمي يقول العلم نور، العلم يسمح للإنسان أن يقيم حياته ومجتمعه، وأن يحدد ما هو إيجابي فيبني عليه، وما هو سلبي فيغيره بشجاعة وثقة، يسمح العلم كذلك للفرد أن يأخذ قرارات مبنية على الحقائق والشواهد، ويختار طريقه من قرارات عديدة، ومع هذه القرارات تأتي المسؤولية والمساءلة، هذا أيها الوفود الكريم هو المناخ الذي نشأت فيه، مع المساندة الأسرية التي حظيت بها خاصة من والدي كرب الأسرة، استطعت أن أختار تعليمي إلى أعلى المستويات، وأن أختار تخصصي العلمي، وأن أختار زوجي، وأنظم أسرتي، وأن أعمل ويكون لي حياة عالية الجودة، ومن خلال منحة دراسية من حكومة المملكة العربية السعودية، غطت كل مراحل تعليمي الجامعي، وجدت السند الرسمي، لأن قيادة بلدي آمنت كذلك، بأن العلم والمعرفة من أسس الإسلام، وواجب وحق لكل رجل وامرأة، ولأسباب عديدة كان الحظ نصيبي، والحمد لله على ذلك، أن يكون لي والدين آمنا بأن الإسلام هو قوة دفع للتقدم الإجتماعي والتنمية للفرد والمجتمع، كان من الممكن أن أنشأ في مناخ مختلف تماماً، لا يقوم فيه الوالدان بمسؤوليتهم الدينية ولا يتمتع الأطفال بحقوقهم، كان الحظ حليفي أن أنمو في مناخ سمح لي أن أحصل على العلم، وأن أتخذ قرارات حياتي، أنا بالتحديد ما تهدف إليه البرامج العالمية، بما فيها البرنامج العالمي حول السكان والتنمية، والتي تطالب بالسماح للمرأة أن تختار حياتها آخذة في الاعتبار اللحظة التاريخية والوضع الاجتماعي، والمحتوى الثقافي، وهي كذلك تؤكد على دور الأب والأخ والزوج في مساندة المرأة، وتفهم احتياجاتها وطموحاتها، أنا أيها الوفد الكبير مثل لما تطمح له الحكومات والمنظمات الأهلية عند تنفيذ الاتفاقات الدولية الخاصة بالتنمية، أيها الكرام إنني نتيجة إيجابية لعملية اجتماعية أديرت جيداً وأديرت بكفاءة، المهم في الأمر أنني لست وحيدة، وهناك نساء كثيرات مثلي في كل الدول التي نخدمها، وفي مختلف الأوضاع الثقافية، نحن بحاجة إلى التعرف على هذه التجارب، ونبين أن مساندة المرأة في خيارات حياتها لا تهدد النسيج الاجتماعي، بل على العكس يقوم، إنها الطريقة التي يقوم المجتمع من خلالها بمهامه، مؤكداً على تمتع أفراده بحقوقهم، هذه وسيلة تنشط المجتمع وتدفعه إلى الأمام، وهكذا أنهيت تعريفي أمام المجلس الإداري وكانت هذه المرة الأولى يقوم موظف في هيئة الأمم المتحدة ويتحدث عن دينه، ومجتمعه وإسلامه، وهكذا أعرف نفسي أمامكم، سيكون حديثي اليوم عن مسيرتي الحياتية التي لم تنفصل أبداً عن والدي، فلقد كنت المختبر الذي اختبر فيه نفسه والتزامه بتنفيذ ما آمن به في وقت جاء قبل زمانه، وكنت النتاج الذي أراد أن يعبر من خلاله عن آماله لوطن أحبه مدى حياته، وعن إيمانه برسالة الله التي نادت بالعلم النافع والعمل الصالح، سأقف عند بعض المحطات في حياتي التي تعلمت من خلالها دروساً مكنتني من فهم مهمتي في هذه الحياة ودوري في أسرتي ومجتمعي، المحطة الأولى، هي مكان ميلادي بغداد العراق في سنة 1945م، كانت صدفة، فمن ثمانية أطفال كنت الوحيدة التي ولدت خارج المملكة، ولكن اخترت هذه الوقفة لأبين لكم بعض القضايا المعاصرة التي نعيشها تاريخياً، فعندما اجتاحت العراق الكويت، كنت ما زلت في العراق مع الأمم المتحدة، وكنا كموظفين من مجموعة الناس الذين لم يسمح لهم بالمغادرة، وفعلاً كان هناك تفاوض مع الأمم المتحدة لإخراجنا، فلما بدأنا بالخروج، في مطار بغداد لم يعرفوا هل يحترموني كعراقية، أم يعاملونني معاملة سيئة كسعودية، لأن جواز سفري سعودي، ووصلت الأردن ونفس الحكاية تكررت، ثم ذهبت إلى لندن لأضع بناتي عند أختي في المدارس وحصل نفس الشيء، وللأسف حتى عندما جئت من لندن إلى الرياض لأكون مع والدي بعد الإخلاء الذي تم وجدت في مطار الرياض يسألونني: هل أنا عراقية؟ أم أنا سعودية؟، فهذا مجرد درس تعلمته، كيف نأخذ الزمن الحاضر ونحكم على الماضي، أو نستعمل الماضي ونحكم به على الحاضر دون علم ودراية بمعنى هذا كله، وفي نفس الوقت بعد أحداث 11سبتمبر، وأنا أعمل في نيويورك، فأصبح وضعي كسعودية ولدت في العراق، تحمل مثل الذنب المقرر، في مطار نيويورك في الذهاب وفي الإياب، كان هناك تساؤل باستمرار عن من أنا؟ وما دوري؟ ولماذا أنا هنا؟، ولا أفهم إذا كان النظام الأمني في أمريكا غبياً، أو عنصرياً أو الإثنين معاً، إذ يحكم وبدل أن يحكم علي وعلى أعمالنا، حكم علي وكأنني من الناس المطلوبين، وقفت عند هذا الموقع لأن له معنى في حياتي وما أعاني منه. |
| الوقفة الثانية هي أنني ذهبت إلى الكتاب وكان عمري ثلاث سنوات، وكانت أمي لما سألتها عندما كبرت: لماذا أرسلتني إلى الكتاب؟، وأتذكر الأبلة الفلسطينية جالسة على الروشان بالخيزرانة الطويلة، قالت لي أمي: نحن ما عندنا بنات تجلس فاضية في البيت طول النهار، وكنت أقول لبناتي، هذا التعليم الذي مررت فيه ما قبل المرحلة الدراسية، وكان الكتاب ولكن نفعني الكتاب لأنني تعلمت القراءة من القرآن الكريم، وعندما ذهبت إلى الكلية الأمريكية بالقاهرة، أخذت سنة أولى وسنة ثانية في سنة واحدة، لأنني كنت بدأت القراءة، فكان أفادني في تلك المرحلة، الكم سنة التي أخذتها في الكتاب. |
| الوقفة الثالثة هي دخولي المدرسة في القاهرة، وكان عمري سبع سنوات، وقرر الوالد أنه يريدني أن أتعلم، وأخذني إلى مدرسة داخلية، وفي وقت عندما علمت أنه سيتركني بدأت في البكاء، وقال لي فيما بعد بدأ يحن، وقال أنه للحظة كان سيخطفني ويجري بي، ولكن كل ما قاله للمدرسات، خذوها بسرعة، وأخذوني وجلست أبكي، وقال لي أنه بكى فيما بعد لوحده، درست في آخر تلك المرحلة لما صار عمري عشر سنوات، وصرت آتي وأسليه كل صيف وكل شتاء على المملكة، بدأت صديقات أمي يصنعون لنا طعام العشاء لاستقبال البنت التي جاءت من القاهرة، وكان عمري عشر سنوات، فأتذكر واحدة من صديقات أمي، وضعوا الأكل مثل عادتنا على الأرض، لكن وضعوا طاولة صغيرة وكرسي وشوكة وسكينة لكي أجلس عليها، فنظرت إلى أمي، وأشارت إلي بعينها على أن أنزل وأجلس بجانبها على الأرض، جلست على الأرض وأكلت، ولما ذهبت إلى البيت مسكتني وقالت لي: لا تفكري أننا أرسلناك إلى مصر لتتعلمي حتى ترفعي رأسك على أهلك، هؤلاء أهلك مهما رحت وجئت، هذه بلدك، وأنت مصيرك هنا، وفعلاً بقيت هذه الكلمة معي طول حياتي، وعلمتني المدرسة الداخلية التكاتف والمحبة، وكانت هناك معي الأخت هنية النجادي، زوجة الدكتور توفيق الرحيمي، وعلمتنا الداخلية كيف نكون أخوات وكانت هنية الأخت التي لم تنجبها أمي، وكذلك كانت معنا حياة عبد اللطيف جميل، وإنجي عبد العزيز جميل -الله يرحمها- وكنا فعلاً أسرة وعائلة تعلمنا التكاتف والمحبة مع بعضنا، وفي تلك المرحلة، بدأنا بمناقشة المدرسات الأمريكيات عن الإسلام، ونحن كنا صغاراً، نفهم منه القليل ولكن نحاول أن نناقش ونثبت أن الإسلام هو ديننا ونحن فخورون به، وكنا حوالي عشرة أو إحدى عشرة وخمس عشرة سنة، وما زلت أحتفظ بالقرآن في ذلك الوقت الذي فيه علامات حول بعض الآيات التي كنت أحبها، سفري إلى كلية البنات في أمريكا، كان ذلك في صيف 1962م، وأنا في السنة الأخيرة من الثانوي قدمت طلباتي إلى كليات البنات فقط، لأنني شعرت أنني اجتماعياً سأكون مقبولة أكثر أن أذهب إلى كلية البنات، ثانياً أنا طوال عمري كنت في جو محافظ، وكنت خائفة أن أذهب إلى جامعة مفتوحة لا أستطيع أن أتحرك فيها، وكانت هذه جامعة صغيرة، فساعدتني على التأقلم الاجتماعي، ولكن أتذكر في ليلة يوم كنا نتغذى، وسأل أخي عصام الوالد وقال له: ثريا ستسافر؟ فقال له والدي: لا، وأنا كنت آكل، فرميت الأكل وقمت من السفرة، وبعد أيام جاءني وقال لي: لا يا بنتي، أنت ستسافرين، فقلت له: ما الذي حملك على تغيير رأيك؟، قال لي: هو وعد نفسه أنه لن يوقف اللقمة أبداً في حلقي مرة أخرى في حياته، وفعلاً أتذكر أنني خرجت ومشيت في الشارع بدون مدرسة إلى جانبي، ولا أبوي ولا أمي ولا أخي، ومشيت لوحدي لفترة ساعات طويلة، ولكن كان الشعور بالمسؤولية، وشعرت بثقل المسؤولية علي وأنا ابنة سبعة عشر سنة، يجب أن أحافظ على نفسي، وأحافظ على أسرتي، وأحافظ على بلدي، وأهم من ذلك عندما حصلت على المنحة الدراسية، قيل لي: ستبقي البنت الوحيدة في منحة دراسية إلى أمريكا، فإذا نجحت، فتحت أبواب البعثات لأمريكا للبنات، وإذا فشلت فأغلقتيها، وكان المرشد الثقافي الأخ عبد العزيز المنغولي، يقول لي: ما دمت البنت الوحيدة كلميني وأنا أدفع الفاتورة، ولكن إذا صرتم إثنتين، ما عاد فيه كلام من هذا، وفعلاً أربع سنوات جلست فيهم، وأنا لدرجة كبيرة كنت متحملة هموم أخواتي في المملكة، هل سأفشلهم أو هل سأفتح الباب أمامهم، ويوم أن أخذت البكالوريوس الليسانس، كان يوم عيد للجميع، ولبست ثياب المملكة، وكان التلفزيون مركزاً على هذا الرجل بزيه الأبيض وبالمشلح، ولكن أهم من ذلك عند عودتنا للوطن، توقفنا في روما لمدة ثلاثة أيام، ولم أكن أعرف ماذا كان الهدف، لأننا لم نكن نتفسح ولا شيء، وكان يقول لي إلبسي العباية، إخلعي العباية، ضعي الطرحة، إخلعي الطرحة، جلسنا وكأننا في تمثيلية ونقوم ببروفة، وأخيراً لما وصلت جدة، كان أيام زمان الناس يصلون عند الطائرة، وكنت أتذكر الوجهين، وبالأخص عم عبد الله، ثلاثة وجوه، عم عبد الله الصائغ، عم مدني... وأخي طاهر، يقفون تحت، وقال لي والدي: دعيهم كلهم ينزلوا من الطائرة في الأول، ثم طلب مني أن أضع المسفع، وكنا أيام زمان لم نكن نلبس العباية، كنا نلبس بالطو قصير، وأنا مرتدية البالطو فوق ملابسي، ومسك بيدي، وخرجنا سوية من الطائرة بطريقة دراماتيكية، ووقف أمام الناس وهو ممسك يدي بيده اليمنى، والشهادة بيده اليسرى وهو يشير بها، ونزلنا ولم نغطي بعد ذلك الوقت. |
| نأتي لوقفة أخرى، وهي جامعة (وين)، لماذا ذهبت إلى جامعة (وين)، وهي جامعة كبيرة وإن كان هناك أستاذ أريد أن أدرس عليه، ولكن أهم من ذلك، هي مدينة فيها كل تناقضات المجتمع الأمريكي، وأردت أن أكتشف تناقضات المجتمع الأمريكي، وكان فيها جالية عربية كبيرة وخصوصاً الجالية الفلسطينية، وكان فيها كذلك جالية يمنية يعملون في صناعة السيارات، وأردت أن أتعرف على هذه الجاليات العربية وعلى نمط الحياة في تلك المدينة، وهناك اكتشفت الصورة النمطية للإنسان المسلم من قبل الإعلام الغربي ومن قبل المجتمع الغربي، وبناء على تلك التجربة، قررت أن تكون رسالتي الدكتوراه وهي كانت في الأدب الإنجليزي مع علم الإنسان، الأنثروبولوجي، وكانت عن الصورة النمطية للمسلم من شمال إفريقيا في مسرحيات عصر النهضة في إنجلترا، طبعاً الموضوع بعيد جداً، ولكن جمع الأدب وجمع الاجتماع وركز على قضية التنميط، تنميط الشخصية، الأهم ما فيها أن أجد كيف جاءت صورة هذا المسلم في كتابات القرن 16م وما قبل ذلك، ووجدتها في كتابات الكنيسة خلال العصور الأولى ما كتبه الصليبيون عن المسلمين، وعن المسلمين في إسبانيا، كتب الرحالة الأجانب في إسبانيا، كتب التجار الأوروبيين وما إلى ذلك، وأخيراً وصلت إلى الصورة النمطية، وهي صورة سلبية وقاسية لدرجة كبيرة، ولكن المؤسف هو نأتي إلى ما ذكره معالي الدكتور محمد عبده يماني، الآن هناك مجموعة من الكتب أمتلك منها حوالي خمسين كتاباً، وهي الروايات التي يسمونها (best seller) وفيها شخصيات إسلامية ولم تتغير الصورة من العصور الوسطى إلى الآن، هي نفس الصورة النمطية للإنسان المسلم وهي الصورة السلبية، لذلك عندما قدمت نفسي في المجلس الإداري، ركزت على أن الإسلام هو ما جعلني ما أنا، وكان المهم أن الرسالة بهذه الطريقة، وإن شاء الله عندما أتقاعد وسيكون في نهاية العام القادم، سيكون هذا أول مشروع لي، سأعيد كتابة الرسالة، لأنه لها معانٍ كثيرة في هذه المرحلة. |
| الوقفة السادسة، قول والدي: من يتزوج ابنتي؟، كان يقول في المجالس عندما يخرج، من يريد أن يتزوج هذه؟، وقرر أن من يتزوجني يكون قادراً على تحمل ابنته التي لها فكر، ولها شخصية، ولكن من الغريب أن الرعيل الأول من الرائدات كلنا تزوجنا من الخارج، سميرة إسلام، ثريا التركي، فاتن أمين شاكر وأنا، كلنا تزوجنا من غير السعوديين، وفعلاً كان معنا إخوة سعوديين كثير في الجامعات ولكن كانوا لا يقتربون منا كثيراً، أكثر من صباح الخير، مساء الخير، كيف حالكم؟، فاضطررنا أن نتزوج من خارج البلد، وأراد الله لنا هذه الحياة، طبعاً عشت في لبنان خلال الحرب اللبنانية وكانت قاسية، واتخذنا قراراً أن نعيش في صيدا حتى نستطيع أن نربي بناتنا خارج بيروت، كان هذا مقصوداً، وكان أبو البنات يعمل مديراً لمدارس المقاصد الإسلامية، وبناتي ذهبن لمدارس المقاصد الإسلامية، قبل أن ننتقل إلى العراق، وفي خلال مرحلة الحرب تلك، رأيت الحرب بكل الآلام، وبكل المآسي، ورأيت الميت والمحروق والمجروح والمشرد والجائع والعطشان، والفاقد لعضو من جسمه أو جزء من عقله، ورأيت بشاعة النفس البشرية عندما تخرب، كما رأيت جمال النفس البشرية عندما تبني وتضع بلسماً على الجراح، ورأيت العربي يقتل العربي، والمسلم يقتل أخيه، وعشت تحت الاحتلال الإسرائيلي حين وصل إلى بيروت، وأنا كنت في جنوب لبنان، وأذهب إلى العمل كل يوم، كل هذا عمق في نفسي كراهيتي للظلم، ورفضي الوجداني للاحتلال، وعزز عزمي لخدمة الإنسانية مهما كانت الصعوبات والمعوقات، ومهما كانت الخطوات البناءة بطيئة، ومن تلك الفترة ولدت ابنتي الثانية تحت القصف السوري لمدينة صيدا، وهذا علمني درساً، شعرت وما زلت أشعر في برنامج عملنا نوجه عناية خاصة للمرأة الفلسطينية، لأنها تلد يومياً تحت القصف وتحت الاحتلال، الولادة تحت الاحتلال وتحت القصف، عملية قاسية جداً يجمعها الخوف مع آلام الولادة، ولكن الشعور علمني درساً، كيف نتعامل مع النساء تحت تأثير ظروف الحروب في كل مكان. |
| الوقفة السابعة، هي الانتقال إلى العراق مع بداية الحرب العراقية الإيرانية، ويظهر أنني عشت معظم حياتي في بلاد فيها حروب، ولكن الشيء الوحيد الذي أستطيع أن أقوله عن تلك المرحلة، أنه عندما انتقلنا إلى العراق في سنة 1982م، كانت بداية الحرب العراقية الإيرانية، وكنا نعرف مدى جسامة الحرب بعدد اليافطات السوداء التي تظهر على البيوت، تنعي شباب البيت، كل فترة من الزمان كانت المدينة سوداء مملوءة من هذه الرايات، ووضعت بناتي في مدارس عراقية، ولم يذهبوا إلى المدارس العالمية (International School)، وتركتهم في مدرسة عراقية من أجل اللغة والدين والتاريخ الإسلامي، أهم فترة في تلك المرحلة هي وفاة أخي إبراهيم، في الشهر الرابع من عام 1988م، وبعدها بحوالي سنة وبضعة أشهر توفي أخي طاهر وكانت صاعقة على الأسرة وعلى والدي بالتحديد، بدأت أرافق والدي إلى زيارة أخي في أمريكا، ثم رافقته في رحلة الوداع في أغسطس 1989م، وهنا سأقف لحظة لأننا وصلنا إلى لندن على أساس أن ننام ليلة واحدة ثم نذهب في اليوم الثاني باتجاه أمريكا، وفي تلك الليلة أصيب والدي بجلطة وأخذته إلى المستشفى، وعندما بدأته الجلطة كنت أكلمه بينما أنا أحضر طعام العشاء وأنا أكلمه، فقال لي شيئاً لم أفهمه، فقلت له: نعم، ولم أفهمه، وهو شعر بعصبية وصعد إلى غرفته، أنا قمت بترتيب المطبخ، فجهزت الشاي وذهبت إليه في غرفته، فوجدته يمشي في الغرفة، ويقول هنا كويس، مشيراً إلى أماكن في جسمه، وهنا مش كويس، لكن تحول كلامه كله إلى الفاتحة، يقرأ الفاتحة مرة تلو الأخرى، ونسي كل شيء آخر، نسي إسمي، ونسي من هو، يبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم، ويكمل الفاتحة ويعيدها، ذهبنا إلى المستشفى، وبقي فيه لفترة، أهم ما في الأمر أن كلامه تقلص وأصبح لا يقول إلا الرحمن الرحيم، طلب منه الطبيب أن يكتب اسمه، أحمد عبيد، فكتب بسم الله الرحمن الرحيم، وقرأها وأصر على أنها أحمد عبيد، وكان مكتوباً الرحمن الرحيم، بعد ذلك ولمدة ثلاثة أشهر كان اسمي عبد الرحمن وكان يناديني بعبد الرحمن، فكنت ولما استعاد صحته وذاكرته، سألته: في ذمتك، هل كنت تتمنى أن أكون ولداً، ولكنني ولدت بنتاً؟ فقال لي: لا، والله يا ابنتي. فأنا كنت أعتقد أن طريقة تفكيره، أنه في ساعة مرضه وألمه، أن الله رحمه بوجودي معه، فكان في ذهنه اسم عبد الرحمن. |
| الوقفة الثامنة، أنني قررت عندما أن آتي بعدما تم إخلاء العراق، وأن أبقى مع والدي بقية حياته، وفعلاً كما قالت أختي العزيزة، بحثت عن عمل وأردت أن أترك الأمم المتحدة، ولكن كل من يحدثني يقول لي: أنت لديك كفاءات أكثر من غير الإطار الجامعي، وليس لي تاريخ في الإطار الجامعي، ليس لك مكان في هذا البلد بالمعنى الوظيفي، وفي الأخير أخذت إجازة بدون راتب لمدة طويلة، ولكن أصر والدي أن أرجع لعملي، وقال لي: بنيت كل هذا، فلا تتركيه، وكان ربي له حكمة في رجوعي، لأن أخي غسان توفي من حوالي ثلاث سنين، وأصبحت أنا مسؤولة الأسرة ورب الأسرة، وكأن الله كان له حكمة في إصرار والدي في الرجوع إلى عملي. |
| الوقفة التاسعة هي الانتقال إلى أمريكا وحصولي على هذه الوظيفة، وتحدثنا عن الموقف، وفعلاً كنت أنوي أن أتركه مبكراً، وأتقاعد، وأعيش مع زوجي الذي لم يكن معي في أمريكا، فلما كلمني أخي فوزي الشبكشي، وسألني، هل أنت مستعدة؟ فقلت له أريد أن أسأل زوجي، مع أنني كنت أريد أن أذهب، فلما سألت زوجي، قال لي: يعني بعد خمس وعشرين سنة، بلدك تريد أن تكرمك، تقولين لهم لا من أجل زوجك، اذهبي، وهذا طريقك، وأنا معك، وفعلاً كلمت أخي سعادة السفير فوزي شبكشي، وتقدم كما حدثت، وكان انتقائي لهذا المنصب شائك، لأن برنامج العمل نفسه شائك وهو فضفاض، ممكن أن تركب فيه أية دولة ما تشاء، ولكن أردت في دخولي هذا الصندوق أن أدخل البعد الثقافي والقيمي لقضية السكان، وأصبح الحمد لله الكريم، عندنا برنامج حول الثقافة ودور الثقافة المحلية في قضايا التنمية وأصبح فعالاً، والحمد لله يستمر البرنامج، وأدخلنا عقلانية إلى هذه البرامج، وحصلنا على ثقة الدول التي تشعر أننا نحترم الثقافة ونحترم القيم الروحية والدينية ونعمل من أجلها. |
| الوقفة الأخيرة، هي أنني قضيت كل عمري المهني أخدم قضية المرأة ليس لتكون خارج مجتمعها، بل لتقدم الكثير لوطنها، والتقيت بنساء في مشارق الأرض ومغاربها، يجمعنا جميعاً التزامنا بالأسرة، نحب العمل، نرى أنفسنا كمواطنين، لنا حقوق وعلينا التزامات، وتجربة العمل كانت متنوعة، وهناك قصص، مثلاً في لبنان، كنا نعمل وساعدنا في بناء أو في إنشاء بيت أطفال الصمود، الأطفال الذين قتل أهاليهم في مخيم تل الزعتر، فأقمنا لهم مركزاً، وكان مركزاً جيداً، كذلك من القصص التي أتذكرها، ويمكن أن بعضكم قد يتذكر تلك المرحلة، وهذا كان أول مرة في عمل ميداني واسع، وكان في عمان في سنة 1978م، وطبعاً كان المجتمع العماني خارجاً من الظلام في ذلك الوقت، وبدأنا نعمل في الإرشاد في المجتمعات المحلية الريفية، وكنت أذهب إلى النساء ويذهب زملائي إلى الرجال، ونعمل فرق عمل فيها أخصائيات صحيّات، وأخصائيين صحيين، وحدث أنه بعد سنوات وأنا أسكن في مناطق في منتصف البلد، فقالوا لي أن الشيخ علي من وادي السحسن يطلبني، فنزلت ووجدته جالساً في الديوانية، وكلهم رجال، وكان يوجد هناك محل فارغ إلى جانبه، فقلت له: يا شيخ علي تريدني أنا، فقال لي: بنت الرجال، تجلس مع الرجال، وأشكركم لأنني جالسة معكم كبنت الرجال، وأخت الرجال. من خلال عملنا كذلك أنتجنا فيلماً عن المرأة الفلسطينية والولادة في الحواجز العسكرية، ونقلنا كل الخدمات الاجتماعية من خارج إلى المخيمات والقرى نفسها حتى تستطيع المرأة الفلسطينية أن تلد بكرامة في بيتها. |
| أولوية العمل الذي نقوم به، هو خفض وفيات الأمهات، كما قال أخي عبد المقصود، وتمكين المرأة بمهارات، ووقف العنف ضدها والوقاية من الإيدز، وكذلك قمنا بمسوحات سكانية، التعداد السكاني نحن مسؤولون عنه في دول كبيرة ودول صعبة، أنهينا تعداد السكان السوداني بكل صعوبات الوضع هناك، ونعمل الآن مع الحكومة العراقية في تعداد العراق مع كل الصعوبات هناك، في فلسطين أنهيناه، وبدأنا في تعداد أفغانستان، ولكنه أوقف بسبب الوضع الأمني وما إلى ذلك، ولكن طبعاً في دول أخرى نحن نساعد الدول في قضية الإحصاءات، لم أشعر خلال حياتي كلها أن كوني امرأة وقف عائقاً أمامي في مجال عملي أو علمي، لم أشعر بإهانة أن أعمل، أو أسافر، أو أناقش الرجال، فقد دربني الوالد على ذلك، وهنا أحكي لكم قصة صغيرة، ذات مرة كان يكلمني فرددت عليه ولم يفهم عني، فقال لي: يا ابنتي أتقري الكلام، ذات يوم سيكون لديك شيئاً مهماً لتقولينه، ولن يفهم عند أحد، أنقري الكلام، فأخذ يعلمني كيف أتكلم بوضوح. |
| أخيراً في الخاتمة، أرجع وأكرر أن تكريمكم لي يعني أن والدي أخذ القرار الصحيح بالنسبة لحياتي، وإن كان قبل زمنه وأمور أخرى، سألته: لماذا علمتني؟ فقال لي: حتى لا تعتمدين على زوجك مثلما والدتك معتمدة علي، حتى تقومي بمسؤوليات عديدة ضمن إطار الأسرة والمجتمع، وقدر الله أن يتوفى والدي وإخواني الكبار وأصبحت القائمة على أسرة السيد أحمد عبيد بما لهذه الكلمة من معنى، وكان موقف والدي نحوي إلهاماً من الله سبحانه وتعالى. |
| أنهي حديثي بأن أكرر شكري لكم جميعاً ولصاحب الحفل الذي غمرني بكرمه وتكريمه، وأعاد لنا جميعاً ذكرى حبيب أفتقده كل يوم من حياتي، أسأل الله الرحمة له، ولموتانا جميعاً، وأسأل العفو والعافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. |
|
الأستاذة دلال عزيز ضياء: شكراً للدكتور ثريا أحمد عبيد، وقد حلقت بنا عبر سنوات طوال من حياتها وحطت بنا في مرافئ معينة من حياتها، فأضافت لنا، واستفاضت، واستمتعنا معها، واستمتعنا بهذه الرحلة المليئة بالكفاح وبالإصرار وبالثقة بالله سبحانه وتعالى، الثقة التي وضعها السيد أحمد عبيد فيها وأكد عليها، فكانت والحمد لله، محل ثقة السيد أحمد عبيد ومحل ثقة أخوتها، ومحل ثقة الوطن المملكة العربية السعودية، رجالاً ونساء، ونحن نفخر جميعاً بأن تكون بيننا هذه المتألقة الرائعة، المتميزة المعطاءة، الدكتورة ثريا أحمد عبيد، الآن سنبدأ بسم الله بتلقي الأسئلة، نبدأ بأخوتنا الرجال، وسوف يقوم كل سائل بالتعريف بنفسه، وبإلقاء سؤاله، وأن يكون السؤال واحداً ومحدداً وليس متفرعاً. |
|
|
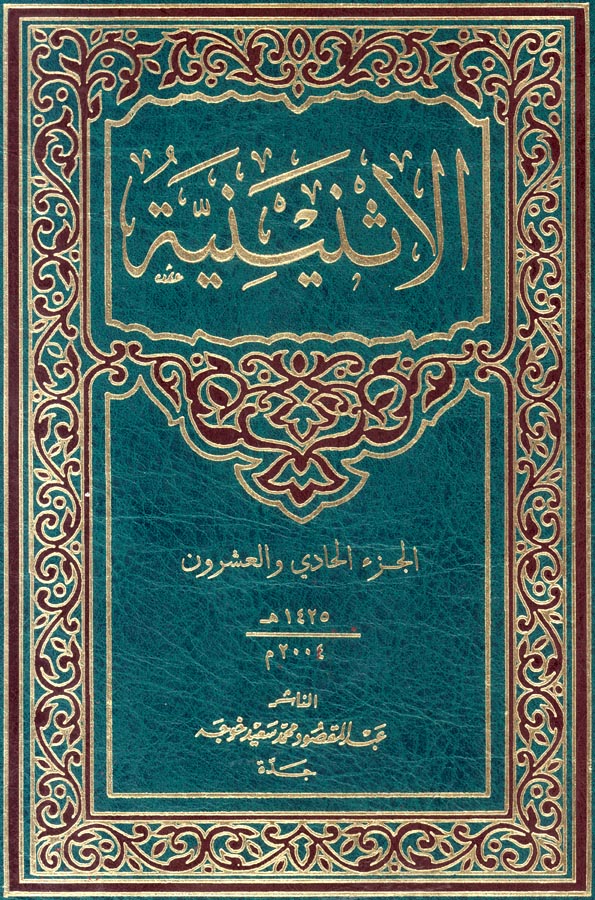

 شارع عبد المقصود خوجة
شارع عبد المقصود خوجة 00966-12-6982222 - تحويلة 250
00966-12-6982222 - تحويلة 250




