| (14) |
| يا للي رماك الهوى |
| ولقد كنا في كل بيت من بيوتنا.. نقتني مجموعة متنوعة الأشكال والأحجام من ـ الشراب ـ بتشديد الشين المكسورة ـ جمع شربه.. وهي إناء فخاري لطيف يوضع فيه الماء للشرب الصيفي منه.. بارداً مستساغاً ـ لا ضرر فيه ولا ضرار.. أي لا قدح منه.. ولا قداد!. |
| ولما كان الفن والتفنن ميزتين بارزتين لدى الستات والبنات بحكم الفراغ الطويل الكافي.. ليباهي كل بيت بمجموعته المختارة من الشراب ـ فقد كان لكل شربة غطاء قماشي رقيق من الشاش غالباً.. مدندش الأطراف، بالترتر وبالتللى وما إليهما.. ويأتي بعد هذا الغطاء القماشي.. وفوقه غطاء من النحاس أو الصفر المصقول وفي قمّة هذا الغطاء النحاس قبة صغيرة مجلوة براقة.. وقد يكون الباعث على أن يكون الغطاء ذاته.. وقبته آنذاك.. ما ساد في العهد نفسه.. سواء من انتشار الطربوش وزره فوق الرؤوس.. أو قيام القباب فوق المساجد والأضرحة الكبرى والمقابر. فلقد كان العصر عصر بدع سائدة.. وزخرف وثنى.. وطلاء خارجي مرموق البهرج والزخرفة والطلاء. |
| وكانت حالة اقتناء كل بيت للأزيار.. وللشراب الكبرى والصغرى منها هي نفس الحالة الاجتماعية السائدة الآن في اقتناء الثلاجات الكبرى والصغرى سواء.. بسواء.. لولا اختلاف المقامات بينهما.. فقد كان موضع جلوس الزير "بيت الماء" ومكان الشربة فوق المرفع في السيب نهاراً وبالطنف بالسطوح ليلاً.. عدا المفضل البارز منها.. فإن مكانه في الروشن.. أو الرشاون كما نسميه صاحب الصدارة في المنزل. |
| وللانصاف والإفراط في دقة المقابلة والمقارنة فقد كان هناك نوع من الشراب الصغير تحمل باليد.. للمناسبات الخارجية نزهة أو سواها.. وهذه الشراب الصغيرة.. تعادل تماماً.. تماماً.. ما نسميه "التورمس" الآن..لولا أن الفرق بينهما هو أن الماء يوضع في الشربة الصغيرة ليكتسب البرودة من طبيعتها الطينية الفخارية.. وأن الماء يوضع الآن بارداً ومثلّجاً |
| في التورمس؛ لتنحصر وظيفته في ضغط الماء كذلك. أطول مدة ممكنة.. فالشراب الصغيرة كانت عاملة برودة.. أما الترامس فهي حافظة لها.. ليس غير. ولأجل محدود!.. وأعتقد أنه لا زالت آثار الشراب كأنموذج تقريبي ممثلة في الدوارق الكبيرة والصغيرة مملوءة بماء زمزم في المسجد الحرام بمكة المكرّمة وبماء عين الزرقاء بالمسجد النبوي بالمدينة المنورة.. |
| ونعود حيثما كنا في رحلتنا.. أمام البركة ـ فالحق يقال أننا ارتوينا من المعسل ـ كما يرتوي البرشومي الذي كانت الباعة لترويجه وتزكية لمعدنه الأصيل تنادي عليه بقولها "وشرب من المعسل يليد" ويليد هذه تخفيف يا وليد التي هي قطعاً تصغير يا ـ ولد ـ ونترك هنا لسوانا من أمثال الأبوين.. أبي تراب وأبي مدين ـ تعقيب أسباب هذا التصغير ومدلولاته تحبيباً.. أو تحقيراً.. أو سواهما مما سيصلان بإذن الله إليه.. آجلاً.. في الغالب. |
| فقد ألف الباعة المتجولون في الأزقة والحواري من أبناء مدننا الحبيبة في سابق العصر والأوان أن يؤلفوا في نداءاتهم على بضائعهم ولها أغاني بسيطة ـ خفيفة الروح.. ورغم بساطتها ـ فإن قدرتها تتمثل في أن الأغنية وحدها تدلك على نوعية الشيء المباع دون ورود أو ذكر الصنف المنادى عليه بصراحة.. وذلك مضمونه ومؤداه أرقى أساليب الدعاية البلدية.. |
| ومن أمثلة ما كان يرد في هذا الباب الظريف.. يا اللي رماك الهوى.. واستوى يا ناعم ـ ويا حلاوة بلا نار.. يعنون المشمش.. والجمار.. إلى آخر تلك النداءات الرقيقة الممطوطة الملحنة تلحيناً خاصاً بها.. والتي نسأل أن يتوفق بعض متعقّبي الفولكلورات الشعبية وباحثيها في كتيب دراساتهم الفولكلورية من فنوننا الشعبية إلى جمعها وتسجيلها مع سواها في كتيب مطبوع ـ يوزع مجاناً ـ للأجر.. وللثواب فإننا لا ننصح بطبعها في أسطوانات معبأة أو ملحنة فاستغلال مثل هذه الفنون الروحية للتجارة والتكسب في السوق المشتركة بيننا.. وبين بيروت.. أمر يفسد نظرتنا إليها وعقيدتنا فيها.. |
| وهكذا ـ فبعد أن كفل لنا ماء المعسل.. الارتواء والنشاط استأنفنا الصعود إلى القمة. وصعود القمم.. حتى ولو كانت إحداها قمة جبل كرا.. مضن ومتعب.. ومع ذلك فقد واصلنا صعود البقية الباقية من الرحلة حتى استقر بنا المقام فوق رأس الجبل العالي الأشم. |
| وهنا أخذ شمل الركب يتبدد.. ويتعدد بتعدد المفارق.. كل إلى أهله.. إلى ذويه.. إلى أحبابه.. في "ديرته" الهنيئة الوادعة في واديها الخصيب.. في الهدا.. والمحرم.. والغديرين.. والحسانين.. والكُمَّل.. والمشايخ.. واللوامي.. الخ.. حسب قبيلته وربعه.. من قريش.. أو من الفعور.. أو من النمور.! |
| أما نحن.. الوالد وأنا.. فقد أصرَّ علينا الجدابيان محمد الكبير وأحمد الصغير.. قبل مواصلة السير أن نكون ضيفي الشرف.. نزيلين محترمين.. في واديهما.. وادي الأعمق . ونتيجة لإصرارهما فقد قبلنا شاكرين.. هذا الكرم.. العربي الرقيق.. والأصيل.. وكأنما عرف الحماران نفساهما.. أعزك الله.. بما تم بيننا وبين صاحبيهما.. فنهقا.. إعراباً تقليدياً عن فرحتهما لا لفتهما لنا بقبولنا الدعوة.. وقد داعبت أنفيهما رائحة الأرض الطيبة.. ودعاهما نداء الواجب والحنين إلى المربط.. بجوار بيت صاحبهما المعتاد.. فانطلقا انطلاق الآلف الخبير بالجادة.. خطوة.. خطوة.. وشبراً بشبر.. وحافراً.. بحافر.. نحو وادي الأعمق. حيث مكان الدعوة.. التي سبقتنا للتعريف به روائح النعناع.. والريحان.. وشذا الأزاهير
(1)
البرية.. والأغصان الرطبة.. وأنفاس الطين والماء.. ماء السماء الطاهر الطيب كما يرد تعريفاً له في المياه يجوز بها الوضوء. |
| وبتلك المقدمات الشعرية ـ فقد بدأنا نمارس الشعر الساذج الحي. شعر الطبع والطبيعة.. لا شعر الألفاظ المنسقة. والكلمات المنحوتة تظللنا غصون الأشجار الضخمة.. وتحثنا سهولة الدروب المعبّدة.. لا بالدركترات.. بل فإننا لم نعرفها حينذاك.. بأيدي الرجال سكان تلك الوديان.. وتحفنا على الجانبين تستثير.. وتثير.. قلوبنا الواجفة لفتات العذارى من البنات حاملات القرب واردات الماء.. أو الصادرات عنه.. |
| واكتملت أسباب الحفاوة القلبية بنا طبيعية لا تكلف فيها.. بالزفة الموسيقية تردد أنغامها دون نوتة.. أمامها.. كلاب الحراسة للبيوت وللحيطان وقد استحالت بمعرفة صوت الجدابيين ـ ورؤية الحمير ـ إلى هوهوة رتيبة تؤلف في مجموعها.. ترديداً رخيماً من كورس متفاهم متحد ومنسجم مع الجو الشعري الحالم! |
|
|
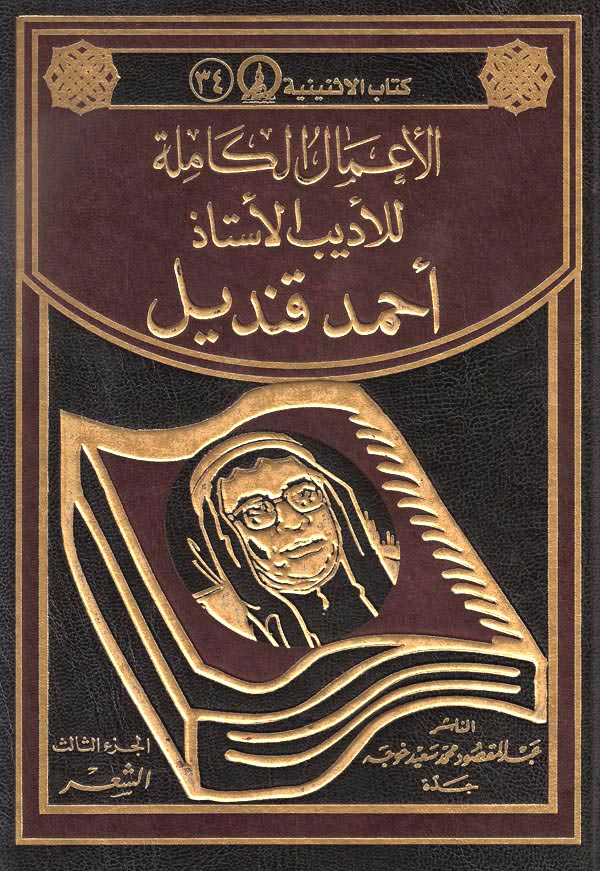

 شارع عبد المقصود خوجة
شارع عبد المقصود خوجة 00966-12-6982222 - تحويلة 250
00966-12-6982222 - تحويلة 250




