| الحكيم.. بين الأحلام والأوهام! |
| الوقفة موحية، وجذلة الأصداء، وغنية المعاني.. |
| البحر يتأمل صامتاً خفر الشمس الحزين.. أمواجه في لحظة |
| الوداع هذه ساكنة مغضية.. |
| والشمس تغرب، وتتوارى، والكون يتلفع بغلالة رمادية غزلها |
| الصمت، ونسجها الانتظار!! |
| في هذا التاريخ القريب - البعيد.. |
| في أحضان هذه اللوحة الناطقة.. في مثل هذا الوقت من كل صيف مع إيذان الشمس بالأفول.. بجانب هذا السياج المطل على البحر، وفي كل عام.. يتكئ كف يده اليمنى على عصاته الشهيرة، والفصيحة، والوفية.. وملء خطواته حيوية، وبحث عن خاطرة، وتأمل مستطرد، وقلق يتساءل، ويرفض، ويحتج، ويصر، وعبارة منقوعة في وسط أحد مؤلفاته الكثيرة تقول: |
| ـ (.. إنها دائماً حالة القلق، والبحث، والتنقيب!!) |
| هذا الإنسان: كاتب، فنان.. يتوخى التجديد.. يفتش عن الصورة الجديدة، والأسلوب المعبر، والحوار المستكنه من صميم البيئة.. |
| اشتهر بأسلوبه السهل العميق.. المغري.. الجاذب.. وبروعة الحوار الذي يسلسله في مسرحياته، أو في ((رواياته)) التي يتناولها القارئ، وتغذيه روحياً، وفكرياً، ولا تسبب له التخمة، أو القرف! |
| وعرفت معه ((عصاته)) التي خلدها في كتاب له.. جعل عنوانه: ((عصا الحكيم))، ولازمها بوفاء.. وشهدت أمتع لحظاته وهو محلق بالفكرة، وفي صوره الفنية، وشهدت معاناته، وساعات حزنه، ومخاض مشاعره، وتدفقها على الورق! |
| وفي كل تجواله في الحياة.. كان يعمل على إضاءة الجوانب المعتمة.. كانت مهمته واجباً يلح عليه أن يعطي الضوء، وأن يملأ ذهن القارئ العربي بأمتع الصور الحسية.. بارع في صياغة الحوار عندما يبني أحداث مسرحياته، ويتملكه الإرهاق غير أن دفق الفن في شرابينه وفي وجدانه، يشحذه بقبس جديد من ضوء الكلمة.. وتنساب عبارته الثانية القائلة: |
| ـ (إني بطبيعتي أحب الضوء، وأكره الغموض.. وإني لأقوم أحياناً بمحاولات يائسة كي أغمر في النور أفكاراً أو موضوعات طبيعتها الغموض)!! |
| إنه يصنع عبارته هذه، ويردفها بما يكملها، ويبلور معناها فيقول: |
| ـ (إن من واجب الكاتب عندما يفتح عيناً على الماضي الغائر، والحاضر المستقر أن يفتح العين الأخرى على المستقبل الآخذ في التكوّن عند الأفق)! |
| * * * |
| ـ اتكأت يده اليمنى على عصاه، ودفع بخطواته إلى شاطئ البحر، ووقف صامتاً صامتاً.. يتأمل الغروب، يقف مبهوراً.. مذاباً.. منتشياً، فالوقفة موحية، وجذلة الأصداء، وغنية المعاني.. |
| في كل عام - كهذا الوقت - تجده هارباً من ضجة المدينة.. من زحام المدينة.. من تصادم البشر، واختلاط الآراء والأفكار.. يهرب إلى حيث الهدوء، والصمت، والإيحاء.. ليجلس بعد دقائق مريحة، ويمسك الورق والقلم، ويكتب مسرحية جديدة - مأخوذة بأشياء الناس.. آخذة بإعجابهم وإطرائهم بعد ذلك! |
| وكان مما أبدعه.. حصيلة غروب شمس صيف - ((مسرواية)) إسمها - بنك القلق -.. كان يصور فيها الزمن المعاش، والناس، والحقيقة العلمية، ووقفات الإنسانية بعد لهاث عاصف، ويرسم الملامح الواضحة للقلق الذي استلب من الناس صفاءهم، وعفويتهم، وعبث بـ ((زهرة العمر))!! |
| هذا هو أمامي تخيلاً: توفيق الحكيم!! |
| هذا هو تصوراً: عصفور من الشرق. |
| العصفور الذي حمل معه شبابه في ازدهاره، ورحل إلى باريس طلباً للعلم ونهل من الثقافة، ودفعه نبضه، ورقته إلى ((غادة كاميليا)) عصرية.. أعطته حباً جارفاً، وأخذت منه حساً مرهفاً، وشعوراً لا يخون، ودعته يعود بعد ذلك بذكريات ندية، وبآهة شاردة.. ضاعت معها الروح زمناً.. كتب فيه: أهل الكهف، وشهرزاد. ويوميات نائب في الأرياف، ثم كمن عثر على غال - أبصر إلهامه يعطيه إبداعاً جديداً فكتب أدسم رواياته ((عودة الروح))! |
| وبعد هذه الرواية.. فكر أن يناقش مدى تيقنه من عودة الروح.. كان مضطرباً، وحائراً.. وفي ذات الوقت كان يتفاءل يخفق لم يعهده، وتراءى له خيط من الإمتاع.. |
| هل آن لهذا العصفور التائه أن يستقر!.. |
| وكانت التجربة مريرة، وقاسية.. تمخضت بعد ذلك عن عمل أدبي فني رائع.. في روايته: ((الرباط المقدس))! كان قد وصل إلى منطقة وقور، وصريحة، ومليئة بالضوء الذي يغمر فيه دائماً كل الغموض، والمبهم، وكل ما يحيره.. وبكل هدوء، وإيمان قال: |
| ـ (نحن مثل العناكب.. تفرز خيوطاً تسير عليها كلما أرادت السعي في الحياة.. خيوطنا نحن التي نفرزها ونسير عليها في حياتنا هي: المنطق المنظم، والتسلسل المرتب للزمان والمكان). |
| وهكذا شمخ ((توفيق الحكيم)).. وأسهم في حركة التجديد في أدب الرواية والمسرحية الكثير.. رأي لا يحتمل الجدل.. |
| والفرق الشاسع بينهما.. أن ((توفيق)) كان مبتكراً، وكان صانعاً لشيء لم يكن له وجود قبله.. أما نجيب فإبداعه ينحصر في دقة التقاطه وتصويره للبيئة، وللحياة الشعبية، وكتابة تاريخ فترة انتقال اجتماعية.. جعل النقد يلعب دوره بفن مع حركة الرسم للقسمات! |
| وكلاهما قمة.. لأن توفيق الحكيم.. اتفقوا على أنه الأب الشرعي للمسرحية العربية، وأنه صانعها، ولأن نجيب محفوظ ترسم مبدأ الحكيم، ثم بلوره، واشتق درباً متفرداً اسمه الرواية الخالصة.. في إطار التعريف الذي وضعه قبل توفيق الحكيم، والقائل: |
| ـ (معنى التجديد.. ليس الإلغاء، وإنماء الإضافة، التجديد ليس الانفصال.. إنه تجديد الأوراق والزهور في شجرة غائرة الجذور)!! |
| * * * |
| وأقبل صيف هذا العام.. ولم يكن ذا شبه بالأعوام التي سبقت.. |
| في هذا الصيف.. لم يقف توفيق الحكيم بجانب السياج المطل على البحر، وإنما اتخذ له مقعداً هناك، واحتضن عصاه الحبيبة، وأراح ذقنه على رأسها المعكوف، وأرسل بصره إلى قرص الشمس المخضب بالحمرة.. الملوح بالوداع، وجالت عيناه في مياه البحر الأزرق الداكن، وقد جلله السكون، والهيبة، وقال توفيق الحكيم بعد لحظات: |
| ـ ها قد شارفت على السبعين.. لم تعد ((وقفة)) موحية.. أضحت جلسة قانعة.. لكنها لم تتنازل عن الانتظار، فنحن ننتظر حتى قبل أن نشهد لحظة انطفاء شمعة العمر!! |
| سنوات طويلة من الفكر، والتأمل، والحب، والانتظار، والأعمال الجيدة، وشعر أبيض كله، ووجه تغضن، حفرته الأعوام.. والأمواج أمامه تنساب في دعة.. هدأت ثورتها.. خبا انفعالها.. لكنها لم تتوقف.. إنها تتحرك، وتسري! |
| وبجانب السياج المطل على البحر يتراخى ((توفيق الحكيم)).. يستمتع بنسمات المساء الوافدة وفي ذاكرته أبهج الصور، وبين اضلعه أمتع اللحظات، وفي رؤاه عمر حافل غني.. تؤطره فلسفة الحب والسلام، وإهداء الناس ما استوحاه، وتعلمه، وأرغده فنمى في أعماقه رهافة الفنان، وحسن المفكر.. |
| توفيق الحكيم استقبل السبعين.. كموجة استقرت في وسط البحر، ولم تصل إلى الشاطئ لئلا ترتطم وتتكسر عليه.. |
| وفي لحظة غروب.. في صيف عام.. قال لصحفي سأله عن إحساسه تلك اللحظة: |
| ـ أنا يا ابني حياة فيكم.. أنتم يا فرحتي المتجددة حياة لعمري الذي رأيته اليوم يستقر عند السبعين!! |
| وامتلأ صدري بمثل آهته الشاردة تلك.. يوم كان عصفوراً هرب من الشرق إلى باريس، وعاد ليضيع، وليتواجد، وليكتب ((عودة الروح))!.. |
| وامتلأ صدري، وأنا أبصر فناناً أعطى جيله كل إبداعه، وموهبته، وأهدى الجيل الجديد كل أفكاره، وتجاربه، وحبه، وعمره الحافل.. |
| وبهذا الامتلاء.. تخايلت في ذاكرتي صورة الفيلسوف اليوناني ((هرقليطس)) الذي عاش في جزيرة صغيرة ((شهدت مولد مرحلة جديدة من مراحل تطوير الفكر الإنساني)).. اسمها - أيونيا - ذلك الفيلسوف الذي قال عن نفسه هذه العبارة الشهيرة: |
| ـ (إنني أشبه العرافة التي تصدر في كلامها عن إحساس وإلهام، وترن في صوتها أصداء لحقائق سامية على مر العصور)!! |
| والوقفة - هنا - موحية، وجذلة الأصداء، وغنية المعاني.. |
| إنها وقفة.. تكون بعدها عودة الروح.. لأن الروح تبقى دائماً حياة في الحياة!! |
| إنها وقفة.. حتى ولو كانت على رصيف الصهد: |
| * * * |
| وعندما أحببت توفيق الحكم.. كانت بداية ذلك الحب روايته الوفية ((الرباط المقدس)). وعندما أشفقت على توفيق الحكيم كانت بداية تلك النهاية كتابه: عودة الوعي! |
| لكنني لا أستطيع هنا - في كلمات متشابهة، ومساحة مرهونة - أن ألغي عطاء توفيق الحكيم، وتأثرنا به. فقد استطاع طوال أكثر من ثلاثين عاماً أن يرفع عصاه ((ويؤدب)) أذهاننا، ويوسع من ضحكته ويشذب عواطفنا، ويرخي أهدابه ويدعنا نتساءل على مدى سنين عديدة! |
| توفيق الحكيم رائد المسرحية العربية بلا جدال!! |
| ومبتدع ((المسرواية)) بإبداع وتفوق.. |
| و ((مهدهد)) الوعي في عقولنا.. حتى بلغ إلى اللاوعي!! |
| ولن نستطيع أن ننتقص منه، ولكننا ننتقده وهو معلمنا، وهو مبتدع الصمت، ومفلسف البوح، وناظم ملحمة اسمها: الاستفادة من القلق!! |
| ولا أظن أن توفيق الحكيم في روايته. أو في ((مسرواية)) التي أصدرها بعنوان: ((بنك القلق)) قد خذل مفاهيم الجيل الجديد، ولكنه توقف بعد تلك الرواية بنا عند محطة.. لها دلالة البحث عن الوعي الجديد!! |
| وأحاول الآن أن أحصر عباراتي لئلا تتحول هجوماً عليه.. لا أستطيع ذلك، ولا أطيقه أيضاً. فقد أغنى مشاعرنا يوماً ما. وقد أثرى ذهننا في مرحلة ما. وقد امتلك وفاءنا دوماً!! |
| لكنني لا بد أن أفلسفه.. حينما لا أستطيع أن أتقبل منه!! |
| ولا بد أن أغار على ((عمر)) إبداع.. من شيخوخة الإبداع!! |
| إن توفيق الحكيم - فناناً، وأستاذاً، وشاهداً في محكمة الوجدان، وومضة في حكمة المعاني - من الصعب أن يسجن في ماضيه، أو أن تقيده سنوات عمره الماضي، لذلك نغار على إبداعه، ونشهد ضده من أجل براءة فكره، ونقاء مشاعره!! |
| ومن الممكن أن نتوقف عند نتيجة فنقول: هذا الفنان قد شاخ.. |
| لكن.. كيف يضيع عطاؤه طوال عمره الأدبي.. كيف يصبح مرحلة؟! |
| إن ((الحكيم)) يملأ دلواً ويفرغه، ويملأه مما أفرغه.. وليس لديه الآن غير ذلك. مع أننا كجيل تربى ونهل من فنه وأدبه.. نحتفظ ((للحكيم)) بقيمة هذه الأبوة، وبعالية تلك الأستاذية فيه لنا.. ولأننا نحبه، ويغمرنا حنانه، كلما استعدنا روائعه.. نتمنى أن يرتاح.. ويبقى شاخصاً في اللامدى.. يرهف سمعه لأصداء ما بناه، ويغمض عينيه سعيداً بضوضائنا!! |
| لقد دلنا بكلام جيد عن ((الوعي)).. وليس قدره أن يدافع عن الوعي.. بعد أن صنعه في جيل كامل، وإنما قدره أن يرتاح الآن!! |
| * * * |
| نأتي بعد ذلك إلى هذا السؤال المسبب.. والإجابة على خير ما يرام! |
| السؤال هو: كم عدد ((الكتب)) الجديدة التي تصدر كل شهر من داخل الدول العربية التي كانت مصدر إشعاع فكري، وملتقى مدارس أدبية حديثة، ومنابر للرأي وللإبداع، ومنتجعاً لحرية الرأي؟! |
| الإجابة هي: أن العدد في المليون، وأصبحت الكتب، والمواهب يخضعان للنظام السياسي الذي أحال الأديب والمفكر في تلك الدول إلى عجينة من صلصال يشكلها حسب أيديولوجيته و على الأقل حسب أهوائه.. ولا تملك المطابع هناك إلا أن تطبع هذه الإجابة: على خير ما يرام! |
| ولكن حرية الرأي، وحرية الفكر، وحرية الأديب في الدول التي كانت يوماً ما هي المصدر للكتب، وهي خلية النحل للطباعة وللترجمة وللتأليف وللحوار.. قد استحالت تلك الحريات إلى تروس في عجلة أنظمة الحكم تلك، التي اعتسفت الإبداع، ووجهت الرأي، وألقت القبض على الحرية! |
| وبهذه الحصيلة.. ساد العالم العربي ضباب، وغاز مخدر.. وانشغل الأديب والكاتب بالوظائف السياسية التي يوضع فيها، وأن انشغاله قد كان بسبب نفيه عن دائرة النطق والتعبير! |
| وبهذه الحصيلة أيضاً.. تمدد ((العقل)) العربي في الخوف تارة، وتبدد في الغرابة تارة أخرى.. فكانت هجرة الأقلام ((ظاهرة)) غير صحية.. تركت السطوع من وهج الكلمة، لتحترق في لهب الحروب الكلامية، الإعلامية! |
| وبهذه الحصيلة - ثالثاً - أصيب ((العقل)) العربي بشروخ وتصدعات.. لامست المنطق، ثم تسللت إلى العقيدة، وبالتالي زرعت القلق والزيغ في بعض تلك العقول التي كانت منارات للفكر وللأدب العربي.. فوقفنا نشاهد، بل ونتفرج على جرائم القلق والزيغ التي أعملت تهديمها في بعض عقول أصحاب الفكر والفكرة، فسقط ذلك البعض مفتولاً من الداخل.. وكان آخر من سقط في تنكره للأرومة، وفي زيغ العقل.. الكاتب الذي أصدر مسرحيات وروايات وقصصاً عظيمة: ((توفيق الحكيم))! |
| وحتى هذا السقوط.. لا يريد المواطن العربي القارئ والمثقف أن يتقبله، ويحاول أن يذيبه، وذلك عبر البحث عن مبررات تحمل التخفيف في الحكم على الأديب الذي أحبه جيل كامل وتتلمذ على يديه، فقال: |
| ـ لقد بلغ الحكيم مربط الشيخوخة التي تعني إعفاءه من تحمل مسؤولية ما يقول.. ولقد تأثر الحكيم نفسياً بفقدان إبنه يوماً ما، فرمته قسوة الفقد وفراغ الأيام في أتون هذا القلق الحارق له! |
| وتصدى لتوفيق الحكيم رجال الدين، وهم على حق في تصديهم وشجبهم.. وتصدى بعض حملة الأقلام، وبعض السفهاء، وبعض طلاب الشهرة، وبعض الذين خافوا على ((توفيق الحكيم)) من نهاية تآكل كل حصاد عمره الأدبي وتذروه كرماد الجثث، فكان خوفهم حباً ما زال الباقي في نفوسهم له! |
| * * * |
| ذلك كله.. يذكرني بالكاتب المسرحي الأمريكي الذي كان مبدعاً وشهيراً ((إدوارد البي))! |
| والتذكر هنا لا يعني المقارنة، أو طرح المثال المشابه للموقف الذي اختنق ((توفيق الحكيم)) بداخله.. ولكن التذكر يأتي بمعنى المقارنة بدون إلحاح على المفاضلة، ويأتي بمعنى استدعاء الظروف وتفتيش التاريخ المعاصر الذي غطى الغبار بعض جوانبه! |
| ففي عام 1961م اصدر ((إدوارد البي)) مسرحيته بعنوان ((الحلم والكابوس)) وتعرض يومها لموجة نقد عنيفة، وكانت الصحف تصدر في الصباح منددة بهذا الكاتب.. ولكن قراءه الذين أحبوه رفضوا كل رؤوس ((السونكي)) التي سددت إلى الكاتب وأقبلوا على المسرحية، ونفذت الطبعات المتلاحقة!.. |
| ولكن ((البى)) لم يتعرض إلى عقيدة الناس ورموز الإيمان في حياتهم كما هو حال ((توفيق الحكيم))! |
| أما النظرة إلى ما حدث، فهي تتلخص في ثلاث وقفات: |
|
ـ أولاً: إن كل ما يثير الضجة حوله، وتتكاثر ضده الانتقادات.. يتحول في انطباع الناس إلى أثر له قيمة، وقد يكون العمل لا يرقى إلى مستوى الإبداع والنفع، إلا أن (اللمة) دائماً تبتكر حدثاً، وتعكس علامات استفهام! |
|
ـ ثانياً: إن كل ما يسدد إلى تعبنا وأمراضنا النفسية وحيرتنا، وكل ما يكتشف خداع الإنسان لحياته ولقيمه ولتناولاته فيعريها.. هو أمر على درجة بالغة من الأهمية، فالإنسان يستمع إلى الصراحة ويحب من يتصدى بها، ولكنه لا يجرؤ أن يمارسها.. والإنسان يرغب في تلمس جروحه وأخطائه ويعجز أو يخاف أن يعلن عنها.. فإذا كان الإعلان عنها خارجاً على ذاته فهو يصغي باهتمام ويتعاطف معها في داخله! |
|
ـ ثالثاً: إن ما يمارسه الإنسان في يومه وليله.. لا يفصح عنه في الغالب، ويتجنب أن يوصف به.. فالازدواجية هي مشكلة الإنسان في هذا العصر، فهو في النهار ((دكتور جيكل)) وهو في المساء ((مستر هايد)) والذي يفرض على الإنسان هذا السلوك - حتى في صدوعه بالرأي - هو تعامله مع الآخرين ومصالحه المرتبطة بهم، ثم أحلامه الخجول أو الخائفة، المتوارية في شروره واضطراباته النفسية وعلله الأخلاقية العتيقة! |
| بعد ذلك.. تقدمت الأسئلة نحو المؤلف الأمريكي، تخدمها فكرة واحدة مستخلصة من هدف المسرحية، تقول: |
|
((هذه المسرحية هي فحص للمنظر العام لإنسان اليوم، وهي هجوم على عملية تبني القيم الزائفة وإحلالها مكان القيم الحقيقية، وهي إدانة لما يلمسه الإنسان من نخر بالنفس، وسقوط الهمم، وهي - أخيراً - وقفة ضد الأكذوبة القائلة بأن كل شيء في العالم المنزلق هذا، هو على خير ما يرام))! |
| فماذا قال ((إدوارد البي)) وكيف دافع عن تعبيره ورؤيته؟! |
| قال: ((إن كل عمل مخلص، إنما هو في عرف هذا العصر: عواء شخصي يصدر عن ذواتنا.. تعبيراً عن الألم أو السرور))! |
| * * * |
| وعند هذه النقطة، نعود إلى ((توفيق الحكيم)).. وقد كان مجمل الآراء التي تصدت بالنقد وبالشجب لهذا العمل الكتابي الذي ارتكبه.. يتلخص في أنه ((عواء شخصي يصدر عن الذات، تعبيراً عن الألم أو السرور))! |
| وبلا شك.. فإن ((الحكيم)) لم يحصد ((السرور)) أبداً في عمره، رغم الهالة المشرقة والعظيمة التي أطرت أدبه وكللته حتى المرحلة التي بلغها، فكانت حافة مهينة بالسقوط! |
| وفي رأيي.. أن أي مؤلف ليس في حاجة إلى ((مرافعة)) عن أدبه، وعن أعماله الفكرية وآرائه، بقدر ما ينبغي أن يحمل ذلك الأدب، وتلك الأعمال والآراء وثيقة وجودها! |
| إن أعظم مرافعة، تتم في صالح فكرتك أو قضيتك.. هي أن يلتف الناس حولها وينتصرون لها، رغم كل ما يثار حولها من غبار وتسفيه! |
| ودائماً.. تكون مشكلة أحلام الإنسان كامنة في أوهامه.. أو هكذا حصد ((توفيق الحكيم)) خلاصة عمره الأدبي ما بين الحلم والوهم! |
| فنحن نخلط بين الحلم والوهم، ونحن أحياناً نركز الوهم على قاعدة تصرفاتنا الصميمة، وعلى قاعدة همومنا الحياتية، وعلى قاعدة أوجاعنا النفسية.. فيصبح التوتر فكرة، وتصبح الشروخ معايشة: |
| إن ذلك كله.. هو حصيلة شروخ العقل العربي، وحصاد التوتر في نفسية الفكرة داخل جمجمة العربي.. وكل ما يثير الضجة الآن، هو بين حالتين: |
| إما أنه مسدد إلى أخطائنا، وانفلاتاتنا وضعفنا، فنحتضنه ولكننا ننكر انتماءه إلينا! |
| وإما أنه حصيلة قلق نفسي.. يجعلنا نضطرب ونظلم أعماقنا، بإلقاء مزيد من العفونة والقش فوقه!! |
| * * * |
|
|
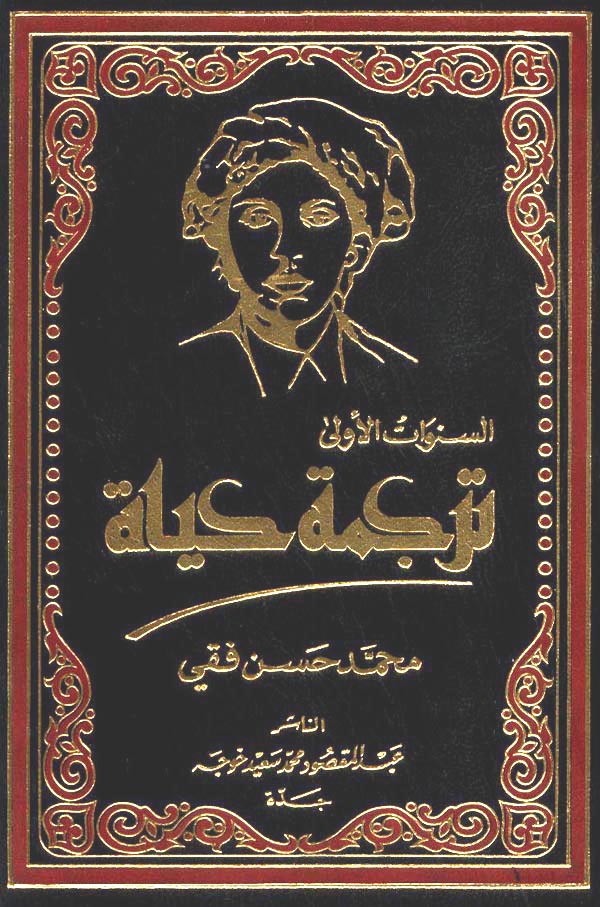
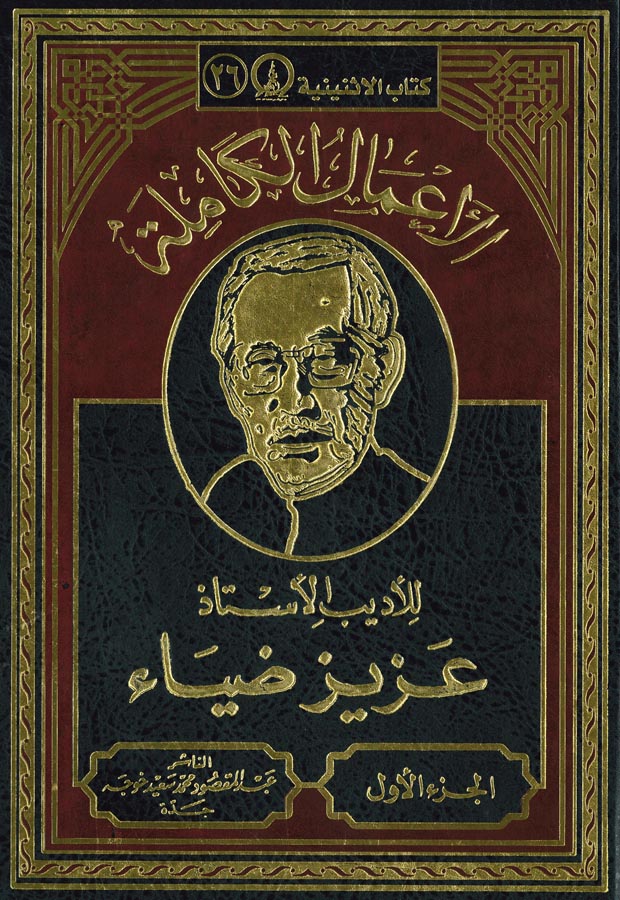
 شارع عبد المقصود خوجة
شارع عبد المقصود خوجة 00966-12-6982222 - تحويلة 250
00966-12-6982222 - تحويلة 250




