| الفصل الخامس: طرقات الهجر |
| * لكل امرأة ثلاث شخصيات: |
| ـ شخصية حقيقية... تحاول أن تخفيها. |
| وشخصية تتظاهر بها، وتحرص عليها. |
| وشخصية تظن أنها لها، وتفاخر بها! |
|
|
| ـ 1 ـ |
| * هل كانت رحلة ((علاء)) ملبياً دعوة ((عالية)): رحلة عتاب، وفتح صفحة جديدة؟! |
| هل كانت رحلة عتاب الحب، أم رحلة قسوة الصداقة بعد الحب؟! |
| تبقَّى الصدى من هذه الرحلة - بعد عودته إلى جدة - زاداً لخفقات قلبه الموجوعة من العتاب الذي حوّل الحب إلى صداقة!! |
| لم يعاتب ((عالية))... ولم تحاول هي أن تعاتبه، كان كل همها: التركيز على إقامة قاعدة الصداقة بينها وبين ((علاء))... كأنها تريد أن تقول له: أريد الاحتفاظ بك! |
| إعتادته أصداء صوت ((فيروز)) الذي يعشقه... وهي تغني: |
| ـ ((حاجي تعابني... يِئسْت من العتاب |
| ومِنْ كِثْر ما حَمَّلتني... هالقلب داب))! |
| في هذه الرحلة... وضع ((علاء)) ريشة خضراء في كتاب الحب، وأقفل الكتاب! |
| لم يعد بداء الشلل في دماغه، أو الانسداد في شرايين قلبه... لكنه شعر بحاجة ملحة جداً إلى إضاءة شمعة حب جديدة، بعد أن رفضت ((عالية)) شمعته وإضاءاته لها. |
| كأنّ قلبه قد ترمّل منذ افتعلت ((عالية)) قطيعتها الأولى له من باريس. |
| وكأنه - بعد رحلته هذه - يودّع الفرحة... وهو يحتضن جميع التذكارات التي منحتها له ((عالية)) من دفق عطائها الأول، عبر رسائلها إليه قبل اللقاء الأول في باريس... وحتى إبحارها في الغياب، والجفوة. |
| يحاول الآن أن يملأ صدره بالفجر القادم. |
| كانت الحكايات في صدره لها: مسافرة إليها دائماً. |
| وحين دعته للحضور إليها، (لاقناعه) بالصداقة بعد الحب... فقد أحالت حكاياتهما إلى سحابة صيف، رغم أن ((عالية)) كانت وستبقى: الحكاية الموعد والأجمل في عمره. |
| حين عشقها: نسي كل مواعيده تحت الأمطار والغيوم... هجر أرصفة الحب المؤقتة، وركض إلى وجهها / الخضّم... فقد كان وجهها: موعده مع الارتواء من شدة الظمأ... وكان دخولها إلى قلبه: تاريخاً وحيداً لبداية فرحه... حتى جعلته هي: تاريخاً حزيناً لبداية غربة مشاعره الجديدة! |
| * سألها يوم نحرته في وجدانها وقررت انفصال قلبها عن قلبه: لماذا تتحولين بعض الوقت إلى غابة... ولماذا رفعت نداء مشاعرك فوق احتراقي؟! |
| كانت الأسئلة تكبر في أمسياته، بينما إجابتها تسترخي. |
| وفي رحلته هذه إليها، بدعوة منها: أنهى كل أسئلته، وقال لها أمام الشمعة التي تحترق في المسافة بينهما على طاولة المطعم: |
| * لا أستطيع أن أجعلك أسطورة فبعد أن بذَرْت بيادري حلماً، أَغارَ عليها جرادُك!! |
| وكأنه بسؤاله هذا كان يبكي حزناً، والخوف يعصف بلحظات صدقه. |
| سألها ثانية: لماذا يتحول صدق الإحساس إلى أحزان؟! |
| حتى في الفرح: كان الحزن يسكن جوارحهما وكانت لحظات الضوء المنبعث من القلب: وجهها الذي يشكّل هلالاً في سمائه حتى غمره الخسوف! |
| * فقال لها ثالثاً، وهي صامتة تحدق في وجهه وهو يتكلم: أنت أنثى حرة، ومهرة جامحة، لكنك تكرهين أن تضلّي الطريق!! |
| كان قلبه يتوهج في حضورها أمامه حتى انسابت من هذا القلب الكلمات / قطرات ناره وحتى تحولت كلماته إليها: في عينيه دموعاً وشعر أنها صرخات الأشواق إليها، حتى وهي تصرُّ أن تنفيه بعيداً عن قلبها، وأسرارها، وعمق بحارها! |
| * * * |
| * كأنه الآن يشعر بكل برود النفس البائسة بكل اللا مبالاة بشفاء روحه من أدوائها!! |
| بكل الهدوء الآن، وهو مسترخ في غرفته الخاصة بمنزله لا يريد أن يفكر فيها لا يرغب أن يشتاق إليها لا يرتقب هاتفها كأيام زمان! |
| ابتسم في مصارحته هذه مع نفسه، وقال: |
| ـ متى يأتي اليوم الذي أكتشف فيه أنني نسيت رقم هاتف ((عالية))؟! |
| من هذه الاستراحة التي لها رسوم على الضباب مطبوعة ومن تأمل بواعث الشوق عندما تُغري الوجدان التائه في صحراء النوى أو الصدود: كانت أنفاس ((علاء)) تتكئ على هذه الأمسيات التي يرحل فيها القمر إلى مدن الانتظار؟! |
| يضحك ((علاء)): ماذا يتنظر القمر الآن وماذا ينتظر هو؟! |
| لا شيء يدور القمر دورته المعتادة لوظيفة محددة خلقه الله لها ويعود ((علاء)) إلى القمر وحدة، ليدور دورته المعتادة هو الآخر: ينام، يستيقظ في الصباح، يعمل! |
| أجود وقفة منحوتة من زمانه هذا: ما كانت على الماء مغروسة ولا تتطوح! |
| لقد نادى على هذه الاستراحة لقد تعبت منك! |
| ـ أيتها الاستراحة لقد تعبت منك! |
| كالسفينة المتعبة كان ((علاء)) يتابع مع محطة الـ CNN، ويتأمل مكتبته ينظر إليها كالطفل اليتيم أمام ثياب أبيه الراحل! |
| ويزدرد هذا الحزن ذلك لأن هذه الكتب المكدسة لن يقرأها أحد بعده فأولاده - بالتأكيد من جيل الحاسوب أو الكمبيوتر، والقنوات الفضائية، والأغاني التي صارت تُغنَّى بالسيقان! |
| تخيل هذه المكتبة التي أضاع عمره في تكوينها أنها ستتحول إلى مجرد ديكور عتيق في صدر الصالون، أو في طرف الدار وتصور أنه حتى لو فكر أولاده في التخلص منها، فلن يجدوا من يشتريها منهم، إلا أن يتبرعوا بها لمكتبة الجامعة، إذ لا مكتبة عامة في المدينة!! |
| لقد خالجه هذا الشعور وهو يشاهد خريطة العالم: تنكمش وتضيق، وتذوب حدود الدول، وتسقط مثل كتل ثلجية داخل هذه الشاشة الفضية التي أصبحت مصدر الفكر، والثقافة، والمعرفة لجيل هذا العصر، الذي يستقي منها الطفل والشاب: ثقافته المرئية والمسموعة بعد أن استطاع هذا الاختراع العجيب أن يُقلص من المساحة الزمنية التي كانت تعطي الفرصة لكل واحد، للقراءة والجلوس إلى الكتاب فجاءت هذه القنوات الفضائية لتأكل كل المساحة، وما يكاد الطفل أو الشاب أو الشابة ينتهي من أداء واجباته المدرسية أو الجامعية حتى يتكوّموا جميعاً أمام هذه الشاشة التي أضحت هي: فكر الجيل الجديد، وثقافته، وفنونه، وتقاليعه! |
| تمطّى ((علاء)) وهو يتثاءب وأقفل جهاز التلفاز، بعد أن قام بمسح سريع لكل القنوات الفضائية، وكأنه يحادث نفسه: |
| ـ كلها تشبه بعضها والأفلام المصرية القديمة في كل قناة، وأحياناً تعرض مرتين! |
| * * * |
| * لم يحاول ((علاء)) طوال هذا الأسبوع الذي انصرم بعد عودته من عند ((عالية)) أن يفتح لها تليفوناً ويحادثها بل فضَّل أن يجلد عواطفه، ويُدرّب نفسه على برود النفس اليائسة. |
| لكنَّ ((عالية)) فاجأته بعد مرور عشرة أيام على وداعها له، برسالة حميمة، وجد ((علاء)) أنها تختلف تماماً، وتُذكِّره برسائلها القديمة قبل لقاء باريس اليتيم. |
| فضَّ رسالتها بلهفة وقرأ: |
| * (عزيزي / علاء: |
| وحشتني بجد، ولو ما صدّقت إنت حر، لأن هذه المرة: صحيح وبجد وحشتني! |
| أقول لك اعترافْ وإلاّ بعدين يصيبك الغرور؟! |
| ولو برضه حاقول. |
| عندما علمت بمرضك قبل أن أطلب منك الحضور إلى القاهرة - بعد الشر عليك - حسِّيت بخوف شديد إني أفقدك، وحسِّيت كمان إن وجودك في حياتي وفي الدنيا: مهم جداً! |
| واكتشفت أيضاً: أنك أكرم وأنبل من عرفت وأنه خسارة بصحيح أن أفقدك أو تموت، خصوصاً إنه لم يبق في الدنيا ناس طيبين كثير! |
| حتسيبني ليه يا علاء؟! |
| إحذر أن تتركني بعدين أخاصمك. |
| من أجلي علشان خاطري تأخذ بالك من صحتك أصل الحكاية وما فيها: إني أنا أفهمك جيداً، وأنت تفهمني جيداً.. وأنت وأنا ((قاعدين، لما نشوف آخرتها إيه)) ويا رب هه السنة يكون فيها 1992 وردة حب علشانك)! |
| * * * |
| * مرت أربعة أيام وهو يعيد قراءة رسالة ((عالية)) إليه أكثر من مرة في اليوم حتى تمالك جأشه، وأمسك بالقلم، وكتب لها: |
| * (ياه.. أخيراً يا أغلى ((عالية))؟! |
| هذه الورقة الصغيرة / الكبيرة التي اخترت أن تكتبي لي رسالتك عليها، وقد رُسم في طرفها منطاد سافر بي إلى قلبك بكلمته التي كُتبت بجانبه: ((go for it)) هي التي بقيتُ أنتظرها! |
| حقاً - يا أغلى ((عالية)) أنا أحببتك كالذي لم يُحب إمرأة من قبل، ولن يجد إمرأة في روعتها من بعد بعد أن وجدتك أمامي هذه المرأة / الحلم التي كنت أحيا معها في الخيال والوجدان أحلم بانبثاقها في عمري كالنور والفجر. |
| أحتاج الآن لمن (يقرصني) علشان أصدّق أنني صاحي، ولا أحلم!!! |
| حقاً - با أغلى عالية - أنا الآن (مغرور) جداً لكني لست مغروراً عليك بل مغرور بك، وبخوفك عليّ، وبقيمتي لديك. |
| الآن أعدك أن آخذ بالي من صحتي / علشانك أنت وحدك. |
| حتى لو لم يبق في الدنيا ناس كويسين كثير، يكفيني أنك أنت كل الناس: الأصلاء، القيمة، التي أخاف عليها من الهواء الطائر كما يقولون. |
| لن تكوني وحدك بعد الآن ستجدينني مارد القمقم في الحكاية، أو الأسطورة!! |
| تصدَّقي؟!! عرفتُ منذ خصامك الضعيف لي: أنه صار من الصعب علينا معاً أن ننفصل، أو أن لا نلتقي، أو أن تتقطَّع بنا الأسباب! |
| تعرفي ليه؟! |
| لأن ما ربط بيننا قد شكّل (حياةً) حلُمْنا بها: أمتع، وأعظم، وأعمق من (زوجين) يتشاجران كل لحظة تحت سقف واحد! |
| كما قلت: ربما كان سبب التشاجر الدائم أن كل واحد فينا قد فهم الآخر من أقصاه إلى أقصاه!! |
| كنا عندما التقينا نكاد ننطق بكلمة واحدة معاً ونضحك لهذا التوافق الذي عذّبنا كثيراً، وكأنك بمجرد اكتشافك له فينا قررت الركض بعيداً، حتى لا يحدث الالتحام، أو التوحُّد الكبير لهذا التوافق! |
| هناك في الغيب دلائل أخرى ستكتشف لتشير إلى تأكيد هذا التوافق الذي نُسمّيه الآن أنا فاهمك، وأنتِ فاهماني (وادي إحنا قاعدين)! |
| سأنتظرك دائماً عند بوّابتنا معاً! |
| إن نسياني ضعيف في قوة حضورك بداخلي... وقد جعلتُكِ: طفولتي، ونضجي، وأجمل لحظات فرحي. |
| خفقي يبدأ من أبعاد جنونك من أجلك، لَكَزْت خاصرة الدروب ركضتُ بك مسافات الشوق والحلم شمخت في لفتاتك نحو الوعي وملأت المساحات بغبارك، وبخطواتك أنت مُهرة المستحيل، وسلطانة عمري فما قيمة الحياة عندما تخلو ممن نحب)؟! |
| * * * |
| ـ 2 ـ |
| * تمنى ((علاء)) لو أنه فقد ذاكرته ليرتاح من ((عالية)) والتفكير بها، وهو يغني لثومه عنها: ((أتْقَلِّب على جمر النار))! |
| تعتاده الذكريات، ووجه ((عالية)) يتماوج في خياله يريد أن يتذكر المزيد عنها، ومعها، بل هو ينساب خلف التخيُّل، والرؤى، والحلم الجميل الذي أفسدته ((عالية)) له، وبقي هو يرسمه في بقظة شجونه، وفي نعاس تعبه! |
| ولكن ترى من أين يبدأ مع ((عالية)) من جديد وهي التي أنهت الحب، وطالبت ببدء االصداقة؟! |
| هل يبدأ معها من خاطره: مراودة فقدان الذاكرة؟! |
| أم يبدأ معها من صدمة الذاكرة لتحتدَّ انتباهتها، فتنفلش بسبب هذه الصدمة: كل الرؤى، والتخيل، والحلم الجميل؟! |
|
((علاء)) الآن - في قسوة قرار السلطانة - يحاول أن يعبر بالشجون كل تضاريس الحياة الجبلية الوعرة التي رمتْه فيها حتى يصل إلى سهول النفس التي لا بد أن تُعشب وتُزهر حتى لو ذهبت ((عالية)) للأبد!! |
| حتى الآن ما حدث في رحلة القاهرة الأخيرة، يبدو مؤرجحاً في فهمه، موغلاً في الضباب، والغموض، والأسئلة: |
| * لماذا طلبت منه أن يُلحد عشقه لها إلى الأبد، ويزرع الصداقة بدلاً عنه؟! |
| * لماذا أنهت إليه خبر رحلتها التي سمّتها ((قصيرة)) إلى لندن، وذلك قبل أن تودَّعه بلحظات؟! |
| * ما هي خلفية هذه الرحلة، ومن ستكون برفقته؟! |
| كل الرحلات التي قامت بها، منذ عرفها، كانت ((عالية)) تحيطها بسرية تامة حتى المكان الذي تذهب إليه تضنُّ على ((علاء)) بمعرفته! |
| لكنه كان يحلم ان يترافقا معاً في رحلة إلى بلاد الضباب - وحدهما - ليتّسع الحوار هناك بجانب حافة تطل على ((التايمز)). ثم يسقط الكلام مختلطاً بآثار القوارب! |
| لكنها رفضته رفضت أن يترافقا إلى هناك، كأنها تحرّضه بالفعل على إغراق ذاكرته عنها في مياه نهر النيل / نهرها، أو نهر التايمز! |
| لقد أعطى ((عالية)) الكثير من تفاؤل حلمه بها، وقابلته دائماً بإفساد حلمه فيها حتى جعلته ينظر إلى الدنيا بكل ما فيها، وقد صارت هي كل دنياه ولا ينظر إليها بشيء واحد فيها، ولا بالإنسان: مفقود من نفسه! |
| لذلك فإن النظرة التي خلّفها كلام ((عالية)) وقرارها في نفسه تبدو نظرة كرنفالية من حيث ((واقعيتها!)) وتبدو - أيضاً - منطقية من حيث أن انطلاقها قد جاء من شيء واحد لا يريد أن يعرفه ((علاء))! |
| * * * |
| * أرهقته الأسئلة، والتفكير في فقدان الذاكرة فأراد أن ينطلق من داخل جدران غرفته الخاصة إلى النسمة الجميلة قبل أن تعتقلها رطوبة ((جدة)). |
| ـ إلى أين يذهب؟! |
| طاف هذا السؤال برأسه مع حيرته. فهناك (مجالس) البلوت، ومجالس الأنس والترفيه، ومجالس (الحش) في خلق الله، ومجالس التنظير في كل القضايا والموضوعات حتى يهجم التثاؤب على المتكلمين، فينتشرون بعد منتصف الليل بساعات، كل إلى سرير نومه مباشرة!! |
| لا بأس إختار مجلساً من مجالس التنظير في منزل صديقه ((عماد)) يضم ما يمكن أن يُطلق عليه تعريف: النخبة المثقفة، من كُتّاب، وصحافيين، وأكاديميين، ورجال أعمال. |
| كان دافعه للخروج في ذلك المساء: أن يُصغي بلا كلام وهو قليل الكلام. |
| وحين دخوله إلى المجلس كانت أصوات الحضور تعلو بالنقاش، ومحور ما يتكلمون عنه: القنوات الفضائية العربية التي أصبحت كالفرن فهي تريد طعاماً كل لحظة باعتبار بثّها ليلاً ونهاراً، ولذلك لا تهم جودة ما يُعرض والمهم: عدد الساعات. |
| وطرح أحد المتحاورين هذا السؤال: |
| * هل القنوات الفضائية لصالح الفن، أم هي ضده؟! |
| السؤال وجيه، والإجابة عليه تحتاج إلى ((وجاهة)) أكثر وانبرى لها أو بها عضو آخر في الجلسة، وقال: |
| ـ في البداية: من الضروري أن يحدث نوع من الهبوط في مستوى الإنتاج، لكنه - بالضرورة - سوف يرتفع، لأن هذه القنوات لا بد أن تغطي نفقاتها وتحقق ربحاً، وهذا الهدف لن يتحقق إلا من خلال الإعلانات، وصاحب الإعلان لا يعلن إلا في القناة التي تجذب المشاهد أكثر، وبالتالي فإن المشاهد لن يهتم بقناة، ما لم تكن جذّابة، وما لم تقدم له فناً جيداً لهذا لا بد من رفع جودة الإنتاج حتى يظل المشاهد مرتبطاً بهذه القناة. |
| وتطور الحوار فارتفع صوت شخص ثالث، يقول: |
| ـ إن شركات إنتاج التلفاز، أقصد شركات تصنيعه سوف تتطور خبرتها حتى تستغني عن ((الدش))، ويصبح تلفازك العادي قادراً على جعلك تشاهد العالم كله وساعتها لن يكون لهذا الكلام فائدة، لأننا لن نحتاجه، ولكن إلى أن يصنعوا هذا الجهاز الجديد، أو يسمحون بتصديره، سيرتاح من ليس لديه ((دش)) من هيصة القنوات الفضائية! |
| * اعتلى صوت رابع فوق كل الأصوات إلى درجة الطنين وقال: |
| ـ من فضلكم وقفة نظام، وحَّدوا المجلس، واسمعوني دقائق ألاّ تعتقدون أن الكتاب فقد دوره الآن في تفشي هذه القنوات الفضائية، ومن قبلها: كرة القدم، وكاد أن يختفي من حياة الجيل الحالي، وتراجع دوره؟! |
| * أجابه صوت آخر: نعم نعم، إلى درجة أن الأجيال القادمة - يقال - أنها قد لا تحتاج إلى الدواة والمحبرة ليسقوا بها عطش الورق، وأنه لا مكان للكتاب في خزائن هذا الجيل فالثقافة القادمة هي: الرقص الأسباني الذي يستحيل فيه الأصبع إلى فم!! |
| تعالت الضحكات، وتمايلت الرؤوس، وتقاربت بعضها إلى بعض في همس خفي. |
| ـ عاد الصوت المحاور يقول: إن الفكر القادم سيكون أكثر الكائنات العصرية قدرة على السفر، والرحيل، والتجول بين القارات وأنا لست ضد هذا الرأي، ولكني متحمّس له أيضاً بل أنا ضد التسرع في إصدار الأحكام العامة، إلاّ أنني لا زلت أتخيل الثقافة المرئية كأفلام رعاة البقر التي لا تتجاوز الإثارة فيها سطح الجلد. ورأيي: أن قرار الزمان في أن يستريح الكتاب هو لا قرار ليس عادلاً، وأن تقاعد الكلمة المكتوبة لأنها أصيبت بلين العظام هو تقاعد مبكر للشباب في الثلاثينات. |
| * عاد الصوت الآخر لمقاطعته. كأنه يُكمل له، فقال: نعم نعم أوافقك، وما أعتقده وأتصوره: ان الكلمة المكتوبة فقدت غريزة المشي، وموقفنا من الكلمة المكتوبة التي تمشي هو موقفنا من الحياة نفسها فجيل الأطعمة المحفوظة والوجبات السريعة اليوم، هو جيل يريد أن يلتهم الكلمة بنفس السرعة التي يلتهم بها الـ ((بيك ماك))، والطريقة التي يسمع فيها إلى عمرو دياب! |
| ـ واصل الصوت المحاور حديثه مستطرداً: لهذا... فلا بد أن يُكتب الكتاب بلغة تتناسب وجيل هذا العصر الذي يقرأ، ويستمع للأغاني، ويأكل، ويحب وهو واقف (!!) |
| * تدخل صاحب المجلس ((عماد)) في الحوار، وكأنه يحسم القضية، أو ينهي الحوار في هذا الموضوع، فقال: |
| ـ لقد أثبت تاريخ الفكر الأدبي: أن أروع آثار الفكر التي عرفها الإنسان هي: الكلمة المكتوبة، وأن الكلمة البسيطة القريبة من القلب والناس هي: الكلمة التي يعيشون بها، والتي تدق أبواب بيوتهم هو الذي يصنع دائماً قوالبه، وليست القوالب هي التي تصنع الإنسان وعلينا أن نسأل الآن: كيف نكتب لهذا الجيل؟! هذا هو الإبداع المنتظر! |
| وعاد اللجج واختلاط الأصوات، والآذان التي تقترب من الشفاه مواصلة للهمس الخفي وعاد صاحب المجلس ((عماد)) بصوته العالي يقول: |
| ـ من فضلكم وحِّدوا المجلس. |
| وكان يجلس في طرف المجلس رجل عجوز يتكئ على عكّازه رفع صوته أخيراً وهو يهمُّ بالوقوف ليخرج، فقال: |
| ـ تحدَّثوا عن الكورة / كرة القدم، أكثر واقعية لواقع هذا الجيل لقد أوصى بعض الموظفين أن تقام مباريات كرة القدم في يوم الخميس، أو يوم الجمعة وليس أول الأسبوع أو منتصفه، لأن المباراة حين تقام في يوم غير الجمعة، تكون فرصة للزوغان من الشغل! |
| * قهقه ((عماد)) بصوته العالي، وقال ساخراً: لا فُضُّ فوك يا عم ناصر هذه هي الموضوعات الهامة التي تحتاج منّا إلى نقاش، ورأي!! |
| ـ قال شاب صحافي: عودة إلى التلفاز، والقنوات الفضائية لو كنت ممن يصنعون خريطة الآلام السينمائية في سهرة التلفاز، لاخترت الأفلام الغنائية أو المرحة أو الكوميدية، حتى لا ينام الناس وهم في نكد. كانت ملاحظة الأستاذ ((حسن)) جيدة عن برامج العيد فالناس يضحون في العيد بالخرفان، والتلفاز ضحّى بالمشاهدين في العيد!! |
| * * * |
| * تسلل ((علاء)) من المجلس تاركاً وراءه الأصوات العالية، والهمس الخفي، ودخان ((الجراك)) والسجائر، والبايب وركض إلى عربته، يحلم بسرير نومه بعد هذه السهرة الدسمة! |
| * * * |
| ـ 3 ـ |
| * كان ((علاء)) يتطلع إلى الرسالة التي بعثت بها ((عالية)) إليه، وعليها رسم المنطاد ويظن أنها تحمل وراء سطورها ملامح ليلة جديدة، يبدأ منها انتظاره لقدوم ((عالية)) إليه: زمن فرح. |
| يتمنى الآن لو يمطرها بأسئلة عشقه لها بعد لأن عاد وجهها / مرآته وفجره: |
| ـ تُرى مَنْ يسكن أعماق قلبك اليوم؟! |
| أم أنك أقفلت هذا القلب بعد تجربة حبك الأولى التي صارعت فيها وحاربت حتى حصلت على حبيبك، واقترنت به، ثم اختلفتما، وحدث الطلاق بينك وبينه، وبينك وبين الحب؟! |
| صار قلبك - يا عالية - موجوعاً بالفراق الدائم. |
| وكنت ترفعين هذا القالب أبعد من متناول النظرة، والخفية كأنك عشت حياتك بعد تجربة الحب الفاشلة، وتعيشينها الآن: محطات تعتقدين فيها أنك تنتقمين من كل رجل تشعرين بعشقه لك، وأنت - في واقعك - تنتقمين من نفسك من نقائك من أحلامك من أمان وجدانك! |
| فهل تسمع ((عالية)) الأن هذه الأسئلة، وهذه الحصيلة التي خرج بها ((علاء)) من عشقه لها؟! |
| لعلها تعرف ما تفعله جيداً، وتصرُّ عليه لكنها أيضاً تحس في قرارة نفسها بشعور الضياع، وتفاهة الأيام التي تعيشها، وسخافة الكلام الذي يلوكه من حولها: أصدقاء وزملاء يُصنّفون من المثقفين! |
| عاد ((علاء)) إلى أسئلته هذه المرة عنها وعنه معاً: |
| _ تر لمن تصرخ خفقاتنا المترددة في أصداء الشوق والمتردِّية في الجحود؟! |
| قام إلى الهاتف يطلبها، ويسأل عن وصول رسالته إليها. |
| ردَّت عليه الخادمة بخبر سفر ((عالية)) إلى لندن قبل يومين. |
| أعاد سماعة الهاتف لتبدأ أسئلة أخرى في رأسه عن خلفيات رحلتها هذه التي أصرّت أن تضرب حولها كل هذه السرية العجيبة. |
| يحس أن شكوكه أخذت تتراكم في رأسه، وحيرته تفيض من جوانحه. |
| ـ لمذا يُعذِّب المحبوب مَنْ يحبه يالشك؟ |
| إستبد الشك بنفس ((علاء)) كأنَّ هذا الشك تحول إلى سكين تمزق كل شيء في داخله وتذكّر الرسام الفرنسي ((بول سيزان)) الذي كان يعاني من الشك في حبيبته التي خانته، ثم سقط في اليأس. وعندما يستبد به الشك واليأس، يبادر إلى لوحاته التي قضى الساعات والأيام الطويلة في رسمها وإبداعها فيمزقها، أو يقذف بها من النافذة! |
| فماذا يمزّق ((علاء))، ويقذف به من النافذة: عشقه لـ ((عالية))، أم يقذف بها، أم وفاءه لها منذ عَشِقها؟! |
| كان الرسام ((سيزان)) يمضي أياماً متتالية في الحقول يرسم لوحة جميلة، ثم يجمع أدواته عند الغروب وينصرف تاركاً اللوحة التي رسمها وراءه، لأنها لا تستحق أن يتجشم عناء حملها في رحلة العودة! |
| فهل أصبحت ((عالية)) في شعور ((علاء)) نحوها: مجرد لوحة جميلة.. ابتدعها من خياله العاشق لها، وأضاف العشق على ملامحها كل هذه الفنون التي كان يراها في ملامح ومميزات ((عالية)) بشعور العاشق لها؟! |
| ولكن ماذا قصدت ((عالية)) من وراء دعوة ((علاء)) للحضور إليها في القاهرة بذلك الإلحاح الشديد إليه، حتى ركض إليها؟! |
| هل أرادت أن تُحيِّد قلبه وعاطفته نحوها، ورصدهما في إطار الصداقة التي يمكن أن تكون بين رجل ورجل، وامرأة وامرأة؟! |
| كأنها في ذلك اللقاء الأخير أرادت أن تشعره بأنها: غير قادرة على ضم احتياجات كل منهما للآخر عاطفياً وعليهما أن يتواصلا صديقين، وتستمر دانتيلا العلاقة، لتتحول إلى علاقة باقية في العقل! |
| هكذا أرغمت ((عالية)) الرجل الذي عشقها حتى الذوب: ((علاء)) ليرضى بقدره معها، ويبتلع شفرات خيبة الأمل القاتلة، ويتكوّم - نتيجة هذا القرار - على نفسه، مثل: قط صغير داست على ذيله دبَّابة ثقيلة! |
| كان قرار ((عالية)) بالنسبة له يُشكّل: تساقط حروفه من على شجرة الكلام وبذلك حققت ((عالية)) واقعيتها الجارحة له، وطوى ((علاء)) خيمة رومانسيته وألقاها في نهر النيل ويكتشف أن قانون الحياة الذي يلزم الناس بقواعده أصبح مغرقاً في المادية، والمصالح الذاتية المحضة! |
| * * * |
| * بعد ظهر اليوم التالي على اتصال ((علاء)) بمنزل ((عالية)) في القاهرة جاءه عبر الهاتف صوت ((حامد)) صديقه مطفأً، أو أن ((حامد)) قصد أن يصبغ صوته بتلك النبرة: |
| ـ أهلاً حامد في أي مكان أنت داخل الكرة الأرضية يا ابن بطوطة؟! |
| * أهلاً علاء أحادثك من لندن، ولك عندي خبر إنما تدفع كام في الأول؟! |
| ـ من فضلك ما هو الخبر؟! |
| * عاليتك هنا في لندن رأيتها البارحة. |
| ـ أعرف أخبرتني بأسلوب الاستئذان الراقي. |
| * ولكن هل تعرف مَنْ تُصاحب في لندن؟! |
| ـ ماذا تقصد؟! هيَّا تكلم. |
| * شاهدتهما ليلة البارحة هي، و.. رجل الأعمال المعروف لدينا في بلدنا. |
| ـ أوه.. لماذا تصمت، مَنْ هو أرجوك؟! |
| * الوجيه ((محمد صالح)) وهو رجل ما زال وسيماً رغم نضج عمره وكبره، ويجيد الدفاع عن قوة شخصيته، ورجولته أمام ((عاليتك)). |
| ـ إسمع هل تمزح هل أنت متأكد؟! |
| * علمت أنهما يسكنان معاً في فندق (هيلتون / بارك لين) في جناح فخيم يا ولد إنت، يا فقايري! |
| ـ تظن أنها تحبه؟!! |
| * أظن أو لا أظن فالرجل الذي دعا ((عاليتك)) لقضاء أسبوع معه في لندن: لن يكون عاشقاً لها، ولا رومانسياً مهبولاً مثلك لأن رومانسيتك يا أهبل لن تعود عليها بأية فائدة، سوى الكلام المنمق الذي تكتبه لها، و ربما أخرجت لسانها لكلماتك بعد قراءتها! |
| هذا الرجل ((يا علاء)): واقعي يعجبه دفء الأنثى، فأراد أن يمتلكها بعض الوقت بس، لا أكثر!! |
| ـ تِعرف يا ((حامد)) ما الذي قالته لي آخر مرة رأيتها فيها بالقاهرة قبل نصف شهر؟! طلبت مني أن نبقى أصدقاء، لأنها اختارت أن تستكين إلى جوار أهلها، ومواصلة بناء طموحاتها وهما الجانبين الوحيدين اللذين لم يخذلا توقعاتها أبداً وهما عكس تجاربها العاطفية! |
| * لكنها - فيما رأيت - تنتقي هذه التجارب العاطفية الدسمة! |
| ـ قالت لي هناك، وصدَّقتها: إنها تبحث عن بلسم الشفاء من طعنات القلب التي سبَّبها لها مَن أحبتهم من رجال كانت أنانيتهم وغروهم، وطفولتهم: سبباً في شقاء قلبها. |
| * قاطعه ((حامد)): إسمع يا عمي أنا باكلمك من لندن، ما هو من الشرفية في جدة، بعدين الفاتورة تتقل!!.. المهم: أحسن الله عزاءكم في فقيدة عشقكم، مع السلامة! |
| * مسكين هذا الـ ((علاء))... إنه في معاناة أليمة لا يحسده عليها حتى الكارهون له! |
| وضع سماعة الهاتف في حالة فقدان لمشاعره، ولأفكاره الذهول يُغرقه في موجه وأصداء صوت ((عالية)) من حواراتهما في القاهرة أخيراً، ما زالت تتواصل في سمعه، وهي تقول: |
| ـ الأيام بتجاربها ((يا علاء))، والسنين بخبراتها تجعلنا معاً نصل إلى درحة من النضج النفسي والعاطفي يجمعنا في شكل جديد، ومتسع من الحب، يحوي كل معاني الحنان والفهم، دون استشارة |
| ولا استحواذ! |
| إذن لن تكون علاقة ((عالية)) برجل الأعمال ((محمد صالح)) هذا: ضمن الاستحواذ لا منه عليها، ولا منها عليه فكلاهما: يهدهد رغبته ويدلّعها، و.. بعد أن يكون كل واحد منهما قد أعطى للآخر وأخذ منه، و بعد ذلك: كل في طريق! |
| * * * |
| ـ 4 ـ |
| * توهج ألم ((علاء)) حين برقت دمعة / جمرة في عينيه. |
| أخذ القلم وبدأ يخط على الورق: بكاءه، ولوعته، و فجيعته. |
| هذه المرة هو يكتب لنفسه، ولا يكتب ل ((عالية)) بل لن يكتب لها بعد الآن! |
| دموعه تساقطت كلمات على الورق وهو يخاطب عشقه: |
| * ضُمِّي إلى جُحيمك من أحشائيَ: الظمأ |
| يا زهرة العشق أنثى أنت ما فتئت |
| تبعث الوهم في أصداء أفراحي |
| حتى إذا استغرقت في عينيك |
| كان ((الوهم)): يرويني! |
| ما أنت إلاّ كذبتي انتقلت |
| عَبْر الصبابات في حزني، وفي وصَبي |
| وأنا في الريح خلفك: |
| نورسٌ، جوالٌ مضني، ومغترب! |
|
| * ياه كم يصبح وقْعَها مفزعاً، عندما تتهاوى الأشياء ((العالية))! |
| فهل تتحوّل ((عالية)) في حياة ((علاء)) إلى: شيء.. مجرد شيء، دخل حياته، وخلَّف فيها الخنادق، والحُفَر، والتشققات؟! |
| كانت ((عالية)) بالنسبة له: أغلى من نزيف ضلوعه المسكونة بها فأصبح النزيف الآن: أغلى بكثير من ((عالية)) لأنه حصاده منها! |
| كانت ((عالية)): خطوة الحلم إلى تجسيد العطاء، وشموسها تمتد نهارات في رجاء عشقه لها فأفسدت ((عالية)) هذا الحلم، ومنحت ((علاء)) عطاء أخرس حتى غارت شموس نهاراته من وراء شفق ((عالية)) القاني، المضرّج بدماء ((علاء))!! |
| يمسح ((علاء)) دموعه فجأة... ويعتاده الصهيل كفرس أصيل، ملتاع بغربة الدروب، يطوِّف حول الأنهار... حتى أطلقته ((عالية)) الآن في مسالك الغضب... حتى أوان ((اليُتْم)) للقلب! |
| يتصور ((عالية)) الآن، وهي منتشية في حضن الرجل الذي دعاها إلى لندن في نزوة الأخذ والعطاء المتبادل بينهما. |
| ها هي ((عالية)) من جديد... يأخذها السفر إلى كرنفالات ما سمَّته لـ ((علاء)): النضج العاطفي والنفسي... وهو لا أكثر من ((علاقة)) عابرة كمحطة القطار السريع! |
| كأنه يراها الآن، وهي خارجة مع الرجل / العلاقة: يدها في يده... تطوف عيناها بتلك الوجوه العابرة، ولا تقدر نظرتها أن تتوقف أمام بسمة، أو نظرة دافئة بالحب... يلفها الضباب في وشاحه، وتشعر الرجل الذي تأبّطها بأنها: سعيدة جداً! |
| و((علاء)) الآن: تنغرس خطواته في رمل الصحراء تدقُّه الوحدة، إنتظاراً لشفاء عاجل من ((عالية)). |
| في صمته هذا ووحدته ترتد نظراته من الفراغ والأصداء... حتى تغيب بسمته ما بين الشفق، ووحشة الأمسيات! |
| تحرقه شمس الصحراء اللاهبة... وهو: حصان مسافات! |
| ـ يهمس كالمجنون الذي يخاطب نفسه: أنت يا ((عالية))... هل تعرفين القهر؟!... أنت هذا القهر الذي دفع قلبي الآن للتمرد على إمتلاكك له بعشقه لك! |
| هل تعرفين السخرية؟!... أنت التي حوّلتِ (العاطفة) النقية إلى: سخرية منك، وفيك. |
| في سمع ((علاء)) الآن: بقايا كلمات... انتحرت في بداية مساء مختلطة بصوت صديقه ((حامد)) والخبر الذي فجّره... مثلما ولدت في بداية مساء أمام صديقه ((حامد)) في باريس: عشقاً، وولهاً لـ ((عالية))! |
| تتشكل هذه البقايا الآن من التجربة القاسية مع ((عالية))... من اكتشاف، ووله... من فراغ، ولهو... من قيمة وبخس! |
| إنها الآن لا أكثر من ((بقايا))... يتعثر فيها صفاء النفس، لكنها ستذوب بعد أيام كأنها العدم... كأنها الحروف التي لا نقاط فوقها... كأنها الكلمات المجموعة من قصاصات جرائد... قذف بها جميعاً في السلة، ولا بد له أن يكتب سطراً جديداً نقياً! |
| * * * |
| * عاد ((علاء)) يهاجس نفسه... مشكّكاً في خبر صديقه ((حامد))! |
| ألآ يكون ((حامد)) مغرضاً... خاصة وأنه في خبر من وراء ظهر صديقه ((علاء)) أن يتقرب من ((عالية))... وتزأبقت معه حتى يئس منها؟! |
| صمم أن يتأكد من خبر صديقه حتى لا يظلم حبيبته. |
| فجأة... قرر السفر إلى لندن في فجر الغد، وحزم حقيبته ليصعد إلى المطار بعد منتصف الليل. |
| وفي الطائرة... حاول أن ينام، حتى يصل إلى لندن مستريحاً جسدياً ونفسياً. |
| لكنَّ مقعد الطائرة لا يريح الجسد للنائم فيه أكثر من ست ساعات... ونفسيته محبطة، يشدُّه إحباط فيها إلى هذا المعنى الذي انكسر، لا... بل تحطم لو صحَّت رواية صديقه عن سلطانته. |
| وبقي في مقعد الطائرة... مغمضاً عينيه، يسترجع شريط المعاناة الطويل في عشقه لـ ((عالية))... في عينيه ألف هاجس، وجواب واحد من الرمل. |
| يطلُّ عليه زمن الصمت الثرثار... وتنحني كل الأشجار تضامناً معه، في أصداء تلك الترنيمة القديمة التي كان ينادي بها على ((عالية)): يا سلطانة عمري! |
| عاجز هو - الآن، أن يعطي حتى ما تريده نفسه منه. |
| إنه لا يحب رؤية ((العنقود)) ساقطاً... وقد تناثرت حبّاته على الأرض... فهو يحرص على: أن يكون جَنْي سعادة الحياة في لحظة ((وقوف)) دائماً. |
| ربما أن ما قتلهما معاً - عالية وعلاء - هو: الخوف في لحظة ((وقوف)) دائماً. |
| إنه لا يطيق أن يطعن جوهر ((عالية))... لكنه يفتش بيأس ظاهر عن ذلك الجوهر الذي خيّل إليه أنه قد اندثر في: غرور ((عالية))، وصلفها، وعبثها، و... إهانتها لمشاعره! |
| كأنَّ ((عالية)) قد مارست بصدودها عنه، وباستعلائها الأحياني: السادية التي قتلت بها النداء ومنها. |
| يتذكّر - في عرض شريط، ذلك الموقف... حين خرجا من المطعم والليل يشارف على منتصفه، وكان القمر يتوسط ليل السماء... فقال لها: |
| * إنني معك... أقف أمامك وأنت جدول ماء نقي وصافٍ، وليس شرطاً أن انكفئ على الجدول لأرتوي... لكني أتوق أن لا يجف هذا الجدول من عطائه لارتوائي. |
| فهل جفّ جدول الماء... وهل بتنا نتأمل الجفاف وحده؟! |
| ـ قالت: حتى أنا التي تصفني بالجدول... قد جفّ نبعي مما لاقيت. |
| * قال: النبع لا يجف... إلاّ من كثرة الاغتراف منه. |
| ـ قالت: ماذا تقصد؟! |
| * قال: أقصد مغازلتك بالطبع فالجدول يغري العطاشى أن ينهلو منه. |
| * * * |
| * طلبت المضيفة من الركّاب ربط الأحزمة إستعداداً للهبوط في مطار لندن. |
| ولفحه الهواء البارد مع الخطوة الأولى من بوابة المطار إلى الشارع، ليستقل سيارة الأجرة إلى فندق ينام فيه أولاً بعد تعب الرحلة. |
| من هاتف غرفته بالفندق، إتصل بصديقه ((حامد))... واستمر رنين الهاتف دون إجابة. |
| واستيقظ من نومه بعد الظهر، وقد شارفت الساعة على السادسة، وكان جائعاً جداً.... طلب غذاءه، وهاتف الفندق الذي قال له ((حامد)) أن حبيبة قلبه تسكنه مع الرجل الذي اختارته: محطة، أو أرادت أن تتلمس في كنفه شيئاً تطلبه أو ينقصها. |
| سأل استعلامات الفندق عن اسمها، وعرف رقم غرفتها، وطلبها. |
| سمع صوتها متكسراً في الهاتف كأنها تصحو من النوم: آلو... ألو. |
| أقفل السماعة... وسارع إلى الاستمتاع بحمّام ينعشه... وسد صراخ جوعه... وارتدى ملابسه، متجهاً إلى الشارع... في طريقه إلى الفندق الذي يضم السلطانة، و.... أمبراطورها. |
| واستطاع أن يعثر على زاوية استراتيجية في مدخل الفندق، تمركز فيها وغطى وجهه بالصحيفة التي أخذها معه... يتمنى الآن أن تقف أمامه لدقائق قصيرة، يحدثها فيها عن: ((همَّ)) الحكايات التي اغتالت ((عالية)) بدايتها... بينما اكتفت هي باللذة العابرة، ونسفت سهرها في عينيه. |
| يريد أن يحدثها أيضاً عن: موته في زفرة إصراره على حياتها... وموته لا يمكن أن يكون إلاّ: وحشية مجده عندما لا تكون! |
| * * * |
| * ها هي..... لا، ها هما. |
| لم يرها تبتسم معه بهذا الإشراق... كأنها فتاة مراهقة في ذراع رجل فتّاك مفتونة به. |
| طويل، عريض... يضع أشياء بين شفتيه - سيجاراً - عنوان الوجاهة! |
| وتبدو هي بجانبه: لا شيء. |
| وخيّل إليه أنه كان يرى كلمة مكتوبة على ظهر ((عالية)) أثناء خروجهما من بوابة الفندق... هي: النهاية |
| * * * |
| ـ 5 ـ |
| * يطلّ الآن زمن الليالي الحزينة من حنايا الضلوع. |
| يفصله: الهواء... زحام البشر... الطريق الطويل... الطائرة... ((الآندرقراوند))... الهاتف. |
| يفصله: هذا القُرْب البعيد ما بين وريده ودمائه. |
| يتطلع إلى السماء في حلكة ليل لندن، وحلكة أضلعه... فيرى النجوم تغادر موكبها، حين أصبحت لحظته الآن: ماء. |
| يطلّ زمن الغياب في الحضور... في اللحظة التي كانت فيها بين يديه صحبة من القرنفل إختطفها بائع ورود... تركته يتيماً! |
| ويجيء ((علاء))... يجيء... يجيء... حتى يتشكّل ((فانتازيا)) نوى! |
| حزم حقيبته من جديد، عائداً إلى ((جدة))... بحصيلة عشقه المذبوح. |
| حبيساً صار في أدراج الليل الصامت وحده... يردد إنشاد ((الزيدوني)) / قتيلاً: |
| - (أضحى التنائي بديلاً عن تدانينا). |
|
| أمام البحر - على امتداد شاطئ جدة - كان يشعر أنه الطريد في فلوات الصدمة... ملتاعاً، في عينيه ليل مسهد، وفي صدره أحلام فاسدة مرتدة إلى صدره كالسلاح الفاسد... خطوته الآن إلى العشق: شاغرة! |
| هذه الزهرة البرية - عالية - تحوّل وهجها في قلبه إلى رسم. |
| تحوَّلت الزهرة البرية إلى زهرة بلاستيكية بلا عبق ولا شذا... بلا جذور في أعماقه! |
| تحوَّلت إلى ((فازة))... توضع في ركن من أركان صدره، لتضيف منظراً إلى المكان، وليس لها عطر ولا رائحة! |
| وبقي ((علاء)) يترصّد عودة السلطانة إلى القاهرة... ليراها في ملامحها الجديدة التي استقرت في أعماقه. |
| بعد أسبوع من عودته... عثر عليها في بيتها بالقاهرة: |
| * حمد الله على السلامة... متى عُدْتِ من رحلتك السرّية؟! |
| ـ إضطرب صوتها... لكنها قادرة على التماسك، فأجابته: يعني... قبل يومين. |
| * إن شاء الله إستمتعت بالرحلة؟! |
| ـ يعني... مش بطّالة. |
| يعني - مني هذه المرة - هل تسمحين لي بالقدوم إلى القاهرة لأراك؟! |
| ـ صمتت قليلاً... ثم أجابته: أهلا بك... لكني خلال هذا الأسبوع سأكون مرتبطة بالتزامات مع أهلي. |
| لا بأس... سيكون موعد حضوري بعد عشرة أيام، تكونين فيها قد جلست مع نفسك، وأجبت الأسئلة الدائرة بين نفسك وبينك، وأنهيت التزاماتك العائلية... إلى اللقاء. |
| * * * |
| * تحوّل صوت ((علاء)) وهو يحادث ((عالية)) إلى: عاصفة... بنبرة ساخرة لامزة، في المشهد الأخير للمعشوقة ((عالية)) في عيني عاشقها! |
| وحيد هو الآن... كأنه عِرْي حقول في ليلة شتائية مرعدة. |
| وحيد بعد كل غضبه مما صُدم به... مثل رصاصة فارغة، بعد أن أطلقها ضد قلبه للرحمة... تسرقه أمواج الفجيعة: منكسراً يغرق في الصبر... ترميه في لجّة الأصداء من قصة عشقه هذه... والأصداء: ثكالى موحشة... حتى تغيب اللحظة في سدم الشوق: شظايا. |
| الآن... هو يتواطأ مع فجيعته، وغضبه، وانكساره... فيرى ((عالية)) في كل أنثى، ومثل أية أنثى! |
| صارت النهارات: هروبه من الليالي التي يتكثف فيها وجه ((عالية)) الأخير! |
| يشعر الآن... كأن ((عالية)) تهرب من كل الماضي... تنزلق... تنسرب إلى أمواج من جديد. |
| فجأة... إستغرق في الضحك، كنوبة جنون تلبّسته. |
| كان - لحظتها - يُقلِّب في ألبوم صورها... وكانت حريصة في رحلة باريس، ثم في كل لقاءات القاهرة على تجنيب نفسها من صورة تجمعها مع ((علاء))! |
| هذه صورها وحدها... وصورة من رسالة منه إليها، عثر عليها بين الصور، وتاريخ كتابتها قبل لقائهما في باريس بأسبوع واحد فقط. |
| تناول أوراق الرسالة، وأخذ يقرأ... ومع القراءة كانت موجة الضحك أو القهقهة تعلو أكثر. |
| قال: سبحان الله...كنت أكتب هذه الرسالة وأنا في قمة اشتياقي لرؤيتها... لدفئها... للمسة يديها! |
| الآن - يجدها صدفة مع الصور - ويعيد قراءتها... فيقهقه!!! |
| ـ عاد يهمس لنفسه: يا سلام... ((جاءت معذبتي...)). |
| نعم... ((معذّبته)) التي كادت تودي بحياته، ليس شرطاً بالموت، وإنما بالانكسار، بالحزن، باليُتْم الوجداني... لم يكن يهمها ما يجري له، أو ما يعاني منه... كانت حريصة على حماية نفسها مما كانت تسميه له: ((وجع القلب))! |
| فماذا كتب لها في ذلك الزمان الغابر؟! |
| * (غالية القلب / عالية: |
| ـ لأنك هذه الأنثى - الزئبقية، الوارفة - طلعت من ضوء الصباح: سؤال عشق على شكل نخلة سامقة! |
| ناديتك... حين ائتلاقك في العمر: |
| ـ تعالي... دثّريني من صقيع غربتي. |
| أنا الذي كتبت اسمك... منذ لحظتك الأولى. |
| مزجت إسمك بأشواقي، وأُلفتي، وحنيني... حين كنت وحيداً: ألاحق طفولتي الهاربة نحو حصاد الصمت. |
| حين اشتعل السؤال في أوردتي: لهيباً... شظايا جراح عميقة! |
| حين الطريق بعيدة... وأنت أقصى رحلتي! |
| أتيتك... أنا هذا الذي يمتد، يمتد... يطوف بأمنيات القلب... يحاصره الرحيل: يوماً... شهوراً. |
| كم نعدد قفزات السنين؟! |
| كم نواجه عصف الريح، والأنواء، وتموُّه البدء!؟ |
| وصوت النفس يعلو تارة ويغوص في وجع بليد. |
| لما أتيتك... افترت ضحكة المستقبل المأمول. |
| الغد... ذلك الموعد الممنوح من دفء يديك! |
| لأنك هذه الأنثى - المضيئة - إنتضيتك من انتظاراتي الطويلة... من اغتصاب الموت لقصائدي العذراء! |
| كان قدري... أن أزرع العشق سنبلة، وتودعني جذوره! |
| أختصر العمر في لحظة لا تضيع في خرائط الوقت. |
| وثْبتي: موجة بحر لا نهائي. |
| ومرساتي: تصادر نبضة، جعلت مَهْرها: ضلوعك! |
| وحزني: عندما تسترخي غيرتك عليّ!! |
| أنا الذي ما زلت أناديك: وأصابعي تجوس في حلكة شعرك الليلي: |
| ـ هل أتعبك حبي لك؟! |
| وأنت: انبلاجة صبح الوطن. |
| أنا الذي ما زلت أزرعك في حقولي... بنفسجة الروح التي تُعطّرني... أناديك: |
| ـ إجتثِّي من بين ضلوعي الأحزان. |
| أنت وحدك... تبقين موعدي مع استدارة الضوء، وعنفوان الهناء. |
| وتصلبين خفقتي... كلما أشرعتِ سيف غضبك، ليقطع توحد هذا الحب! |
| أنا هذا الفارس الذي لن يتعب من ركض مهرته... صوب اندهاش الأمسيات. |
| صوب ساحات الليل المترع بهمسك. |
| صوب أنفاسك التي أشربها... فتروي عطشي إلى الأجمل من الحياة! |
| أمامك أتضوأ: طفولة قلب... أصغي إلى خفقاته فيك. |
| أورق قلبي بأسراره... حينما لمسه شعاع منك. |
| فهل تُمهلين زماني في عينيك؟! |
| دعي هذا الزمان يطل من شرفاتك على الحلم. |
| إنه منتهى خفقتي... وشهقتي... واحتضاري! |
| لأنك هذه الأنثى - المهرة... |
| أبدأ بك الشموس الساطعة على مدني. |
| أملأ بك ضوء القمر... ومواكب النجوم. |
| أصعد بك إلى هذا الموت يحييني... من اتساع الحياة لي وحدي... في عينيك)!! |
| * * * |
| * ياه....... كل هذا العشق، و ((عالية)) تواصل قسوتها، وصدودها، وتمارس معه: العقاب على ما صدر منه في باريس؟! |
|
((علاء))... لا يعرف أن الاختلاف في الحوار بينهما، يؤدي إلى ممارسة هذا ((التأديب)) له منها! |
| أقفل ((ألبوم)) الصور، و...... مزّق الرسالة وهو في دهشة من نفسه!! |
| غداً... موعد السفر إليها، ليكون اللقاء الأهم، والأشق عليه. |
| * * * |
| ـ 6 ـ |
| * نقل ((علاء)) ساقيه فوق أرض مطار القاهرة، كعصفور يهم بالتحليق لأول مرة باتجاه النيل الذي عشقه، كذلك العشق لـ ((عالية)). |
| دخل إلى الفندق الذي يسكنه دائماً كلما اشتاق إلى النيل... وكان صامت الملامح، كثير الإطراق، كأنه لا يجيد إلاّ الصمت! |
| لم يحاول أن يغادر غرفته بالفندق منذ وصوله... لم يتصل بأحد من أصدقائه الذين يفرحون بقدومه إليهم... ولا حتى بـ ((عالية)). |
| أمضى شطراً من الليل ما بين ((كافتيريا)) الفندق، والجلسة أمام النيل... حتى أدركه التثاؤب، وتهيأ للنوم... فإذا برنين الهاتف يفزعه: |
| ـ صوت عالية: القاهرة نوَّرت... لماذا لم تتصل بي فور وصولك؟! |
| * أردت أن أكون مع نفسي لليلة واحدة، وأنت داخل نفسي... أو لعلني أستعد للغد! |
| ـ وماذا في الغد؟!... طبعاً أنا أيضاً. |
| * أنتِ أيضاً....... ربما. |
| ـ لماذا تقول: ربما؟! |
| * لأن هذا العصر لم يعد يقطع بشيء، وبَشر هذه الأيام يخافون من التأكيد حتى ينفكّوا من الالتزام. |
| ـ حوارك غريب... المهم، سنتغدى معاً غداً. |
| لو سمحْتِ لي... دعينا نلتقي في الصباح المبكر: أهدأ، وأبرد! |
| * * * |
| * في الصباح... إنطلق إلى مقهاه المفضل على النيل. |
| السحب تركض في الفضاء الرمادي الحزين، ركْضَ الهارب من العاصفة... لكنه يشعر بهذه السحب تتجمع في نفسه استعداداً للقاء. |
| حبّات المطر تتساقط فوق أوراق الشجر ونوافذ البيوت القاهرية، وليس موعد المطر ولا فصلها... كأنه تخيل المدينة في هذا الصباح ما زالت غافية، والشوارع مزدحمة كعادتها. |
| جلس إلى أقرب نافذة تطل على النيل، ليتحدث مع هذا الرفيق الأسمر العجوز الذي قذف في عمق الإنسان كل شيء. |
| نظر إلى السماء... وكأنه يبحث عن شمس ما في هذا الصباح. |
| ضحكت له السحب الداكنة التي تُطارد وجه الشمس، وهي تغطِّيه حيناً، وتسفر عنه حيناً آخر... وكأنهما عاشقان يتحاوران بالأحضان، حتى خُيِّل له أنه يمكنه أن يجذب قرص الشمس في هذا اليوم بيده ليتدفأ بها!! |
| حاول أن يركض وراء خصلات السحابات البيض القليلة التي كانت تتدلى من سقف الأفق، وكأنها جدائل شَعر فضية أرسلتها فاتنات من بنات الجن على ظهورهن العارية. |
| تحت مرمى بصره... إنبسط النيل الأسمر العجوز، فسبحت فيه أشعة أفكاره، وامتدت حول النيل... تذكّر أول مائدة ضمتهما في القاهرة هنا... غمرته هزة عنيفة لم تكن من أثر النسمة الماطرة الباردة، وليست من هذا النيل / جدَّ المصريين الأصيل العريق. |
| لقد كانت فكرة لقاء ((عالية)) مرة أخرى في هذا الصباح... استهدافاً لهذا المكان بالذات! |
| تداعت الأفكار أمام عينيه وكأنها أسراب الحروف المهاجرة في كتب الأشعار المسافرة، يقرأها على جبين الفضاء الرحب كأنها زائر غريب... يشق الفضاء، ويمتطي صهوة الحزن مخترقاً أحشاء سحب اللا عودة. |
| كان يقبع على الطاولة كنِسْرٍ هدَّه الزمان... يلتفت للنيل لفتة عصفور يبحث في قلبه المشقوق عن فتات الذكريات، ليحاكي بها هذا العجوز الأسمر الذي لا تفارقه نضارته. |
| تنفَّس خليطاً من الهواء الذي يحمل نبض هذه الأرض، ونسيم وهجير ((عالية))... حس اليوم، وألوف المشاعر، وتعاقب الفصول. |
| حمل جواز سفر قلبه من جديد، وأخذ يعبر رحلة الاغتراب بفكره ووجدانه داخل اللا شيء... كأنَّ سفر الفكر أصبح له زاداً جديد المذاق، يضيفه كطبق جديد من حين لآخر إلى مائدة حياته، كشوق تحوّل إلى قرنفلة في حدائق التجوال، يرطب بها أريج حياته المر الذي لا يحمل إلا قبظ الرحلة، ولهب المشوار الطويل. |
| كان ينزوي في مقعده ذاك الصباح كمسافر فقد عناوينه، ولكنه لم يضل الطريق. |
| أحس فجأة بدوار، وكأنَّ ضربة شمس صرعته في وَقْد صيف ريفي... برغم برودة الطقس الصباحي. |
| شرب الشاي وشعر بشيء من التحسن... أخذ يفكر في أمره - أمر نفسه - فماذا رأى في هذه ((العالية))؟! |
| فكرة أنه كان يهيم بها... تجعله يحس بالضياع الآن!! |
| أين هي تلك المرأة الاستثنائية الأسطورية التي عشقها يوماً ما... هل كان ذلك خيالاً؟! |
| وما هي الحقيقة كيف تحول بحر العسل إلى نار من الألم؟! |
| لماذا أصبحت ((عالية)) فجأة: فيلماً صامتاً بدون ألوان... وكيف استطاع قلبه أن يتحول إلى كتلة جليد وهو معجون بالحنان؟! |
| هل تحوّلت الرئة البللورية فجأة إلى جهاز لا يدخله الأوكسجين، ولا يزفر إلا بثاني أوكسيد المعاناة والألم والوجع؟! |
| قد يكون كل ذلك... ولكن لماذا يراها، ويتخيلها الآن بهذا الشكل... هل هي بوصلة اتجاهات الروح التي لا تتحرك إلا عندما تعرف الحقيقة؟! |
| وهل هذه الحقيقة هي التي حوّلت ((عالية)) إلى تمثال امرأة من صلصال: تغمره الشقوق، ويفتقد حتى إلى لمعة الحياة؟! |
| هل هي نيران التجربة التي أحالت إصابته العاطفية إلى ما يسمى ((إصابات العمل)) التي يصاب بها الموظف أثناء عمله؟! وإذا كان ذلك صحيحاً: كيف له أن يضمِّد الجروح الغائرة التي اكتوى بها، وهو لا يملك التأمين ضد هذه الإصابات، ومَنْ سيدفع له التعويض... مَنْ سيدفع له ثمن الحزن والغضب، وموقفه القادم على رصيف الزمان؟! |
| لقد انتهت القصة المليئة بالدماء، والدموع، والقصص، والحكايات، والقصائد والأسف، والأغاني والرسائل، والمحادثات الهاتفية... أصبحت هذه القصة: لفافة تبغ محروقة، لم يبق منها سوى رماد ضئيل، وفلتر إسفنجي، وعبارة عميقة عن انهيار جسور المودة الإنسانية بين إثنين. |
| لقد انتهت المشاعر في غياب الفهم، وتضاءل معنى الفهم في غياب المشاعر... وحدثت الجلطة العاطفية التي نتج عنها: سقوط جسر الوصال بينهما تحت وطأة أقدام الخيول المُحمَّلة بالمال... هذه الخيول التي علكت لجام الشفافية والعشق، وأحالته إلى طوق فسفوري يضيء من بعيد كشموس النيون الصناعية في لحظات المطر، ينظر إليها التائه فيعتقد أنها قمر الحياة!! |
| * * * |
| * هبطت ((عالية)) فجأة... رآها فتخاذلت ساقاه، وأحس بشيء ما يشدُّ عنقه، ويكاد يخنقه... شعر وكأنّ لسانه قد جف في حلقه وكاد يسده، وتعرَّقت راحتاه، ومد أصابعه تحت أذنيه وأخذ يتحسسهما بقلق ظاهر... فقد كان سر اضطرابه: أنه تخيل نفسه - فجأة - أحمق القرية الذي يتابعه الأطفال بالحجارة والسخرية، وتعرف نواعير المياه وعصافير الحقل قصته! |
| إندفعت ((عالية)) في حديث حسبه مجامر صغيرة يتطاير منها الهجير، والسأم، وتثاؤب الأيام... وساده حزن مَنْ لا يسمع إلى أحد. |
| أخذ يتأملها ولا ينصت إليها... فلم تعد ((عالية)) تحمل الوجه الفرعوني الأليف، بل لقد تحوَّلت العيون الناعسة الحالمة إلى دائرة من الزئبق المتحرك في كل اتجاه. |
| إختفت الجبهة العريضة السمراء التي كانت تنسدل فوقها خصلة الشعر السوداء الجميلة، لتحل محل خصلة هلامية لا روح فيها... وكأنََّ هذه الجبهة أصيبت بفقر الشجاعة! |
| تحوَّلت الكلمة المدللة الناعمة فجأة إلى لهجة دفينة بأعماق الحارات ونزق رعاة البقر! |
| وكان عبئاً ثقيلاً على كليهما أن يستمر المكان والزمان والكلام... لقد تحوَّل المكان لثقب إبرة، وتحوّل الزمان إلى ليمونة جافة يحاول كل منهما عصرها بطريقته... والكلام توقف كقطار عتيق في حقل مهجور. |
| وتحوّلت الطاولة إلى وادٍ سحيق من الجليد وحبات البرد. |
| وهمس لنفسه وهو يتأمل وجهها: |
| ـ لكم كان الخيال أجمل وأروع من الواقع!! |
| * سألته: ما بك تحملق هكذا في وجهي؟! أنت لست ((علاء)) الذي اعرفه... أنت شخص آخر!! |
| ـ أجابها: لا أدري... كأنني أفيق من إغماءة طويلة! |
| هاجس في نفسه، يلح عليه أن يخبرها بما أرى... بسكِّينها التي ذبحته بها. |
| لا..... سيتركها في هالة السلطانة، أمام نفسها على الأقل! |
| * قالت: مضطرة أن أذهب لقضاء حاجة في العمل، ونلتقي في المساء على العشاء في أي مكان تختاره... هاتِفْني أنتَ في البيت بعد المغرب. |
| وقف يشد على يدها، وكأنه الوداع الأخير... وهو ما زال يحدق في أعماق عينيها اللتين طالما رآهما في حلم يقظته: عميقتان، واسعتان، رائعتا النداء والوميض... ويراهما الآن: بكامل الانطفاء والترمد. |
| وعندما ينطفئ العشق في داخل القلب... تتحوّل مرئيات العاشق إلى برودة كطقس الشتاء! |
| وانطلق إلى الشارع يجوس في ربوعه وأعماقه، يندس في الزحام، وكأنه يهرب من شيء ما... يجرُّ ساقيه المتعبتين في استرخاءة الغريب حين يحيل غربته إلى امتلاء، وحين يشم أنفه ريح الأشياء، ويقتفي أثرها بحثاً عن اكتشاف جديد. |
| سار وحيداً تحت حبّات المطر، سعيداً بها وكأنها قطعة حلوى تتساقط في كف طفل... فجأة لمعت الشموس في لحظات المطر: ابتسامة حقيقية احتوت المقهى والرصيف والطريق. |
| طائر نورس البحر... كأنه كان ينتظر انتهاء الفصل الأول من رواية حياته، ليباشر الفصل الثاني منها. |
| لقطه بمنقاره الفضي، ضمَّه تحت جناحيه كأنه يبحث عنه من سنين ليحميه من أسنان البرد وجنون العاصفة! |
| تبسَّم وهو يحمل جواز سفره مرة أخرى وتأشيره مرور إلى قلب ((عالية)): الصالحة لسفرة واحدة. |
| الآن... أسقط تعبه كله، وهو يهمس لنفسه مؤثراً المشي على قدميه: |
| ـ الذين يخافون لا يتعبون... إنما هم يركضون بإستمرار في دروب التوقُّع الغامض غالباً! |
| إنهم - أيضاً - الذين لا يحبون. |
| لقد انتهى المشوار... لأنه فشل أن يكون (الواجد) لقلب ((عالية)) وفي قلبها. |
| حمل همومه، وسيوفه، وأغصانه، وبطاقة قلبه الحزين. |
| إنه يعود من جديد إلى: اختصار الوقت. |
| والتفت إلى صديقه الأسمر العجوز - النيل - ونظر إليه بحنان... وقذف إلى مياهه عملة معدنية قديمة، وأُمْنية! |
| تبسّم كل منهما للآخر - النيل وهو - وكأنهما يقولان لبعضهما البعض: |
| لا غالب...... إلا الحب! |
| و............... مضى وسط الزحام: يعود إلى التسلية التي تشيخ فيها طفولته!! |
|
|
|
|
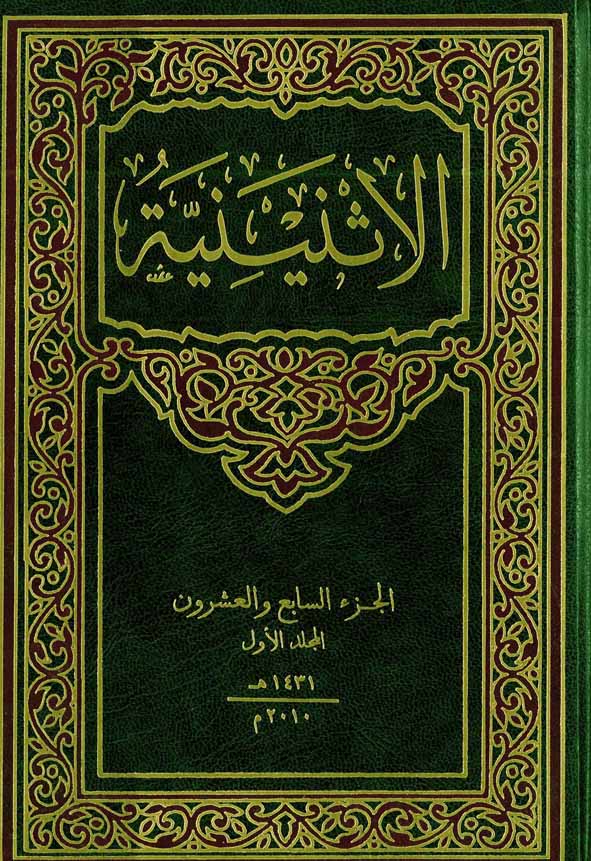
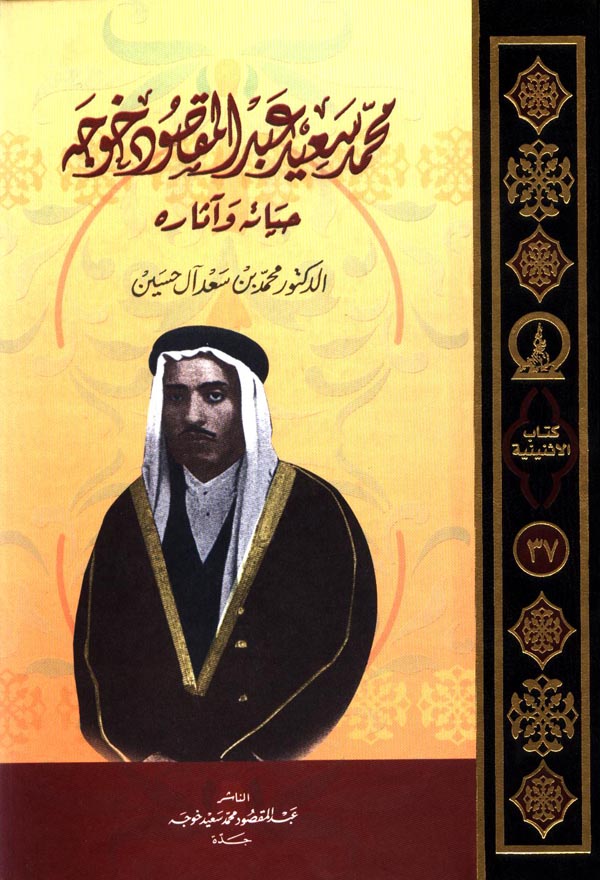
 شارع عبد المقصود خوجة
شارع عبد المقصود خوجة 00966-12-6982222 - تحويلة 250
00966-12-6982222 - تحويلة 250




