| الفصل الثاني عشر: انفلونزا أمريكية استعمارية! |
| * المساء من حوله يتنفس رتيباً.. مسترخٍ هو في لغة الكون. |
| يسترجع ((آخر لحظة)) من لقاء البارحة، ودّعته فيها وهي تمنحه عناق المسافر المتخلف عن رحلة الهناء إليها. |
| قرر أن لا يثقل عليها أكثر، بعد أن تطلب السؤال في عينيه وهو يحدق فيها، لكنه يحتاجها حقاً في ما تبقى من عمره، وهي أهم غرسة حب في هذا العمر، وأجمل أنغامه.. هي المرأة التي حملت ذخائرها كلها: أنفاسها، ونبضها، وخفقها.. وقذفت بهم في البحر حتى إشعار آخر! |
| الآن... لديها أولويات لا بد أن تنهيها، وكان يمازحها قبل ليال عبر الهاتف، فقال لها: |
| ـ بخ.. بخ لصلابة الإرادة عندك التي استطعت بها ((تأجيل)) عواطفك، أو ربما إعادة برمجتها وتوجيهها بالريموت لشاطئ آخر... فاخبريني لأكف عن مزيد من سفح عواطفي! |
| * أجابته: الحب الذي أشعر به هو ((إحساس مرة لن تتكرر)).. أنا أمنع نفسي عنه، وعنك... الحب هذه الأيام ينزل من قيمة المشاعر التي تحوطه! |
| ـ قال: ما هو الحب؟!.. كيف يقتنع رجل بعواطف امرأة تقول: إنه ليس الرجل الذي يمكن أن يدخل قلبها لأنها - فقط - تخاف من الحب؟!.. بقية المشاعر: ما هو اسمها، ما هو تعريفها.. حب أيضاً... كيف؟! |
| * قالت: تفكيري.. أن الحب مقرون بالرغبة! |
| ـ قال: وإذا كان.. فهل الرغبة جريمة؟!.. الرغبة فسيولوجية وليست نفسية، العاطفة: نفسية.. ممكن لرجل أن يحب امرأة ولا يطلب منها تنفيذ الرغبة، ولكن... مجرد أن تقول له: أنت لست الرجل الذي يمكن أن يحتل قلبي، ينتفي الحب. |
| * قالت: أنا لا أفكر في لحظة يمكن أن يحبني فيها رجل... ما أشعر به هو أعمق من الحب، لذلك.... أخاف! |
| هكذا ضرَّجته ((سارة)) بسيف واقعها، أو.... تغيرها، وهو ينزف الشوق لها وهي أمامه، وصدرها بعيد عنه كأنه عطش السنين! |
| وحدها.. تُشكّل مدّه العاطفي، وتصنع جذره في داخله: حروب ردة على الحب والفرح في نفسه. |
| عندما تنفيه عنها.. يصرخ داخله فيه: كيف تهربني حبيبتي إلى مدارات المنافقين: وليس في الحب نفاقاً ولا خديعة؟! |
| لم ينم.. بقي متضامناً مع مناخ ((سارة)) الكلثومي في الليلة السابقة، يهمس: ((سهران لوحدي)).. يحاول أن يقرأ تلطمه عبارة من كتاب جديد يقرأه: (هل نحلم إلا بما كان لدينا... ثم أضعناه)؟! |
| يريد أن يحبها أكثر، برغم محاولاتها: نسف العاشق في قلبه.. هي المرأة التي لا ينبغي أن يكف الحب عنها.. في حياته تشكل كل الدروب والأصوات في مسيرته، وتصحح كل الأفعال والأسماء. |
| وهو الرجل.. كرستالها الذي يطلب منها أن تشعله وتطفئه وتكسره.. طاقته الإنسانية من تفاصيل أنوثتها، ومن قاموس فكرها، ومن نهرها. |
| هما - معاً - صارا يحلمان بالأمان في عصر يتفجر بالإرهاب، وبالخوف، وبغياب الحكماء والمصلحين، جنباً إلى جنب مع تفجر المعلومة والاتصالات... وفي حلمهما هذا يريد كل منهما أن يطمئن على جيل أتى به من الأبناء والبنات، ولا بد أن لا يدعه يفرّط في قيم رائعة حفظتهما من التعدّي على هذه القيم! |
| هما - معاً - تحدثا مراراً عن ضرورة التعامل مع هذا الخوف.. بما يواجهانه ويتفوقان عليه، ولكن.... كيف؟! |
| تلك كانت أسباب دموعهما التي تتسلل أحياناً عندما يشتعل الحوار بينهما عن واقع هذا الجيل الجديد، وعن ما يواجهانه في هذا الواقع، واندلاع قلقهما.. حتى يكادا أن ينسيا لحظة الحب بينهما! |
| يقفز إلى الهاتف ويطلبها، مفتتحاً حديثاً جديداً بسؤال: |
| * ماذا تفعلين.. أو... ماذا ترتكبين؟! |
| ـ علت ضحكتها وهي تقول: صدقت.. إنه ارتكاب حقيقي، فأنا أتفرج على التلفاز كما تسميه! |
| * قال: حسناً... وماذا يرسل؟! |
| ـ قالت: بل ما الذي صرت أرسله أنا؟! |
| * قال: نعم... خبريني. |
| ـ قالت: هل تعلم.. أن الناس من إدمانهم على مشاهدة التلفاز: انسطلوا؟!... أو أن الفرجة على التلفاز تؤدي إلى ((الانسطال))... هل صحيح التصريف للكلمة؟! |
| * قال: لا عليك من التصريف... نحن في هذا التلفاز نُقعنا. |
| ـ قالت: قناة من هذا الزحام.. أوردت خيراً عن الانفلونزا الأمريكية..... |
| * قاطعها: لحظة.. لحظة، حتى الانفلونزا صارت أمريكية، أو هناك انفلونزا صدرتها أميركا ((تريد مارك))؟! |
| ـ قالت: لا تقاطعني... انفلونزا أميركية استعمرتني، والليلة سمعت عنها في التلفاز. |
| * قال: قلتِ استعمرَتْكِ؟! |
| ـ قالت: نعم يا مثقف... صار لي من سنين ما مرضت، والانفلونزا الأميركية: مرض غريب، وحاقد.. وأنا منرفزة، كل جسمي يوجعني! |
| * قال: طبعاً... ما دام أنها انفلونزا من تصدير العم سام.. لا بد أن تكون مرضاً حاقداً، لأنها مصدَّرة للعالم العربي، |
| ـ قالت: أبعدنا عن السياسة.. تعرف أنك وحشتني؟ |
| * قال: الله... وحَشْتِك لزوم العدوى، والا وحشتك بجد؟! |
| ـ قالت: إيه أخبار النتن ياهو.. باني المستعمرات وهادم البيوتات؟! |
| * قال: أنت مريضة بأنفلونزا صناعة أميركية.. فأبعدي من فضلك عن اكتئاب: صناعة صهيونية... لا جديد، لا فائدة، لا أمل! |
| ـ قالت: كم الساعة الآن؟! |
| * قال: يتوقف الزمن عندما ألتقيك وجهاً أو صوتاً. |
| * * * |
| * ركد ((فارس))بعد هذه المحادثة الهاتفية مع ((سارة)).. انبطح أرضاً على وجهه، ورفع ساقيه إلى الخلف كطفل يكتب واجبه المدرسي ويغني: ((يا قمرنا يا مليح.. شد حصانك واستريح))! |
| أمامه كتاب لا يريد أن يكتمل بالقراءة.. استوقفته فيه عبارة زلزالية: |
| ـ (أنا نتاج مجتمع قمعي، وممارسة الحرية بكل أهوائها تحتاج إلى تقاليد أجيال تنعم بها... تقاليد موروثة)! |
| طوّح بالكتاب إلى منتصف الغرفة.. وارتفع صوته يدندن: ((مش قلتلك))؟! |
| كأنه الآن يحاول - عبثاً - استنطاق شيء، حتى ولو كانت (عربة) التاريخ في زمن الصاروخ. |
| تُرى... هل هو متأمل الآن، أم متكأكئ.. يرفض أي استنطاق من داخله؟! |
| فجأة.. قهقه كمجنون في الربع الخالي وحده. |
| حدق في ظلال ضوء تسلل إلى غرفته من خارجها.. حدّق أكثر حتى تجسد له وجه ((سارة)) أمامه.. يريد أن يستبقي هذا الوجه تحت جفنيه.. يستبقي عينيها الرائعتين اللامعتين بكبرياء عمقهما. |
| توحَّد مع تحديقه، وبالأصداء، ومع نمنمات ظلال الليل... حتى فجّره سؤال من داخله: |
| ـ لماذا لا أبكي... لماذا الناس لا يبكون بقدر ما يكظمون الألم؟! |
| كأنه الآن يقرأ ((سارة))، فيعرفها أكثر من معرفتها لنفسها.. لكنه افتقد فيها تلك المرأة الأنثى، الناضجة، المفكرة، الحبيبة القريبة... فهي في رضاها النفسي تجعل منه شهرياراً.. وهي في شتاتها تتحول إلى لا مبالية حتى تشعره أنه يركض في اتجاهاتها المتصادمة. |
| يتجمَّع في استحضارها تخيلاً كأنه يسافر إليها، والخطوة ما بين قرطها وكتفها: عُمْر أنفاسه! |
| في مائه وظله: ميناء يعاني من ثورة الغناء لها.. وما زال يحبها، وهي تعود إليه هذه المرة: برقاً، وخطى مغتربة، وباباً مزلاجه من الفرار.. وما زال يحبها ويرسل مع همسته إليها قسمه: |
| ـ أنت لن تكوني منافيَّ.. وأكره أن أستقر في شعورك: سجناً أو سجاناً حتى لظلك... أجيء إليك، أفاجئك كالنشيد.. فلا تجعليني قرصاناً من غيم وسحاب! |
| خطواته التي اندفعت نحوها لمرة واحدة فقط، كانت منذ ربع قرن.. تكاثرت - جيئة وذهاباً - تواصلاً وفراقاً.. وتكاثراً - هما - خلالها: أولاداً، وهموماً، ومواقف وتجارب، ونزقاً وتمرداً.. وكان الأهم: أن أحدهما لم يندم على ما مشاه، ولا حتى على ما ارتكبه وقد كان في حينه: رغبة لهما ومتعة واستقلالاً، ودفئاً عاطفياً شديد الحميمية... وما زالت في جوانحه، لها هتفة حياة تخصها وحدها، وفي صدره: وشم من ملامحها لا يبهت. |
| شاركها مراحل نضوجها منذ عرفته وهي فتاة ناهدة نحو الحياة تقفز إلى السابعة عشرة. |
| هدهدها يومها.. احتوى افتراضاتها.. تشاركا معاً في ابتكار لحظات جنون وجدانية عبقرية. |
| جذبته إليها وفيها ميزة رائعة.. هي: هذا التفرد الملحوظ في شخصيتها الذي يختلف عن أية فتاة كانت في ذلك العمر... حتى اختلط فيها التفرد بالتمرد وهي تكبر بنضوجها ووعيها. |
| وصبر على ألوان تمردها، واختفائها وظهورها... لكنها أبقته في حياتها مثل: سدوم، وعمورية، وسد مأرب، والسد العالي، وبرج إيفل، وتمثال الحرية... في الغالب: جعلته سداً، وفي بعض الأحيان تعاملت معه كبرج، وتمثال شمع! |
| أحبها حتى الوله.. لا، بل كان يتنفسها، أو يتنفس بوجودها في حياته. |
| حاول أن يتمرد على سلطانها وصولجانها، وأحياناً على ديكتاتوريتها عليه... ومرة أسكتها وهي تزأر عليه، وقال لها مبتسماً: |
| ـ قرأت لك عبارة لكاتب مسرحي عربي هو محمد الماغوط.. اسمعيها: ((الحرب لا تبكيني... أغنية صغيرة قد تبكيني))!.. أنت هذه الأغنية الصغيرة، الجميلة، الدافئة الشجية التي تنفيني وتعيدني للوطن.. كأنّ وجودك في وجودي هو معمار حياتي. |
| حاول أن يقتني همستها ولا يصادرها... وكان أمامها لا يقف على قدميه، بل على أطراف قلبه وأضلعه، وأطراف رموشه، ويعترف... يعترف: أنه لن يستطيع العودة من عندها إلى مكان آخر حتى لو كان الجنة! |
| الآن... يستعيد هذه الأصداء، ولا يدري: هل يرتاح بها، أم يزداد احتراقاً وعذاباً؟! |
| هو هذا البحار الذي اكتشفها مرة واحدة، وتمنى أن لا تغرقه في بحارها. |
| إنها هذه المُطْلَقة في شذا عمره وخصوبته.. بدونها وفي غيابها: يتكسر زمانه، يصير عمره جافاً... بلا طفولة، بلا شباب، بلا حلم... وتضطره أن يختفي من أمامها ومن سمعها بعض الوقت حتى تفيض الأشواق، وتعلو ((ونّة)) القلب. |
| لقد سقط في ليالي معاناة جديدة في مقاطعة صوتها لسمعه.. اختفت من جديد، وكأنه يجلد قلبه بإصراره على مواجهة صمتها بصمته! |
| * * * |
|
|
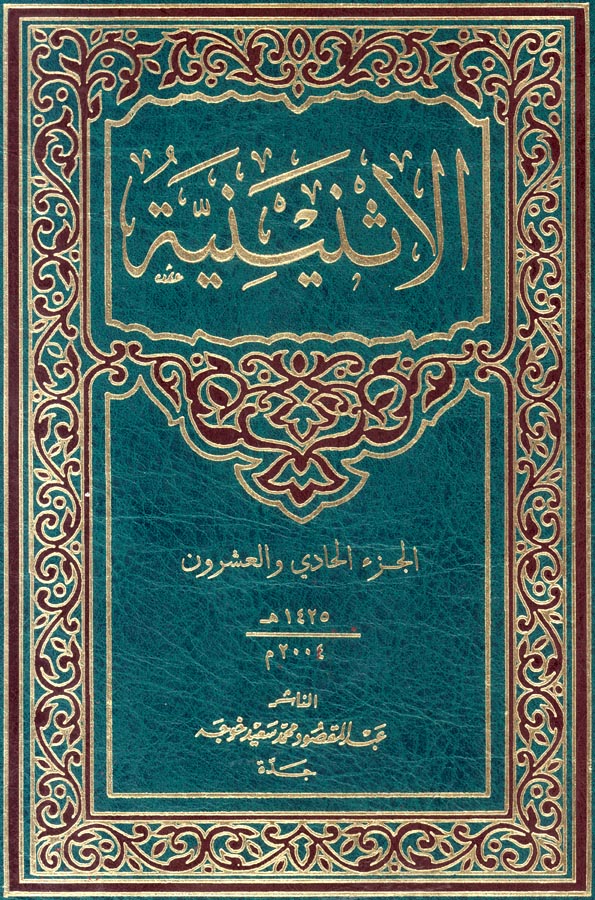
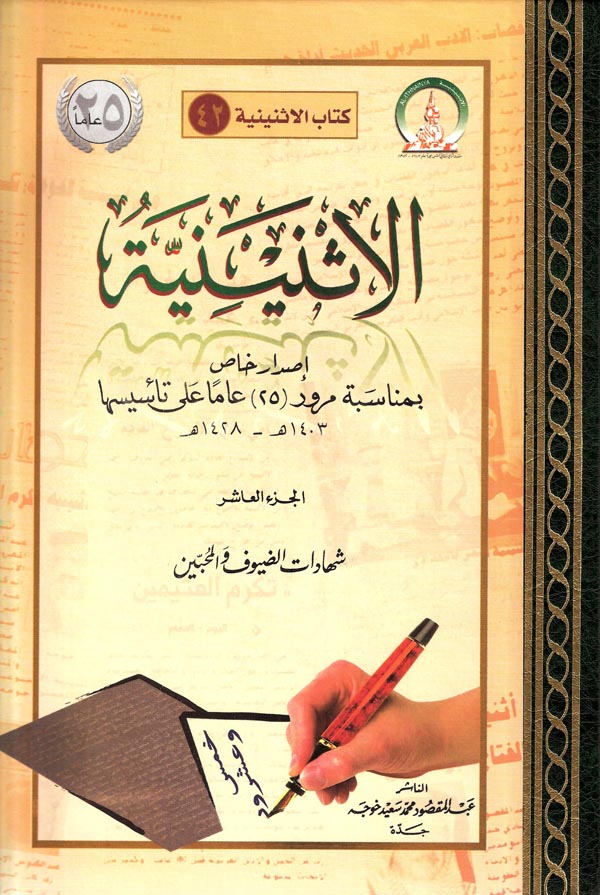
 شارع عبد المقصود خوجة
شارع عبد المقصود خوجة 00966-12-6982222 - تحويلة 250
00966-12-6982222 - تحويلة 250




