| الفصل الأول |
| (1) |
| * لم يعد يملك شيئاً من تلك الكنوز العظيمة التي كان يخاف عليها ويخبّئها كجوهرة، وكان يضنّ بالإفصاح عنها.. حتى لمن أعتقد أنهم أقرب إليه من حبل الوريد! |
| الآن.. هو وحده حين هبط المساء الرمادي على نافذة غرفته. |
|
((جدة)): المدينة الممتدة أمامه بزحام شوارعها، وبكثافة سياراتها وركض الناس فيها.. تبدو مدينة ليس فيها شيء من التلذذ، ولا من البهجة أو الترفيه. |
| ارتفع صوت الأذان من علوّ مئذنة المسجد الذي يجاور بيته. |
| ـ ردّد بخشوع: لا إله إلا الله، محمد رسول الله.. حق والعزة لله.. رضينا بالله رباً، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم: نبياً ورسولاً.. اللهم رب هذه الدعوة التامة، والصلاة القائمة.. آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. |
| شمَّر ((زياد)) عن ساعديه في طريقه إلى الوضوء ليؤدي صلاة المغرب. تطلّع إلى وجهه في مرآة المغسلة.. وهمس كأنه يخاطب وجهه: |
| ـ يا هذا الوجه المرهق.. لعل قطرات ماء الوضوء تغسل عن ملامحك التعب والنَّصَب... فما الذي أتعبك؟! |
| هل التعب يجيء من التلقّي للوجوه، وللسحنات، وما يشكِّلها من عبارات، أو ألفاظ، صار الناس يتبادلونها اليوم بقليل من الحب.. بكثير من المصلحة؟! |
| أنزل أكمام ثوبه على ساعديه، ووقف خاشعاً يؤدي الصلاة. |
| وفي أذنه كان الهاتف يصك سمعه برنين متواصل فيه الإصرار العجيب على النداء وطلب الإجابة. |
| في انتهائه من الصلاة.. قال: |
| ـ ألا يؤدي هؤلاء الناس الصلاة؟! |
| ـ ربما كانت مكالمة خارجية، أو... لعلها: معاكسة في هذه الظاهرة المستفحلة التي تشير إلى ما حدث من متغيرات إجتماعية، وأخطر تلك المتغيرات: في السلوك، وأسلوب التعامل مع الآخرين. |
| وقف أمام نافذة غرفته... يحب في هذا الوقت أن يتأمل الكون.. يرتفع عن الأرض، ويلتحم بالسحاب، وبالنجمة، وبقرص الغروب القاني الذي يُجسِّد له حقيقة وحدته. |
| وحده يعيش في هذه ((الفيلاّ)) الصغيرة التي وفِّر قيمتها من بيعه لأرض قديمة، كان يتناساها بعد أن تركها له والده ضمن تركته التي خصه بها.. ودفع قيمة الأرض: مليوناً، ونصف المليون الآخر: كان يجمِّعه في البنك من بقايا راتبه الشهري، ومن الحوافز في راتبه.. |
| على أيام الحوافز (رحمها الله). |
| الرطوبة تعلو في مدينة ((جدة)) كساحل، وينزلق الطلّ كقطرات المطر فوق زجاج النوافذ، وزجاج سيارته الرابضة أمام باب الفيلاّ.. وكان يقوم بغسلها بعد عصر كل يوم: ذلك الفتى ((التكروني)) الذي اتفق معه على مائة ريال في الشهر... حتى اختفى التكروني نهائياً... |
| فلعله كان بدون ((إقامة))، مثل غيره الكثير! |
| ـ ياه... مَنْ يغسل لي هذه السيارة اللعينة؟! |
| يبرر لنفسه هذا التقاعس قائلاً: |
| ـ نعم.. إنها الرطوبة، هذه التي تكسّر جسم الإنسان، وتصيبه بالكسل. ولكن... هل الرطوبة حقاً أم ((التربية)) التي تعوَّد فيها على تلبية مطالبه، وأن هناك مَنْ يخدمه دائماً؟! |
| - ربما... كان أبي موسراً، والخدم في حياته كثير، والآن... لا بد أن أخدم نفسي. |
| أنفاسه تكاد تختنق بهذه الرطوبة العالية في فصل ((الجوزاء)) من شهر مايو/ أيار... ولا شيء في كل هذا الادِّعاء بالحياة! |
| يشعر في أيامه الباردة هذه، الصامتة كالخرس.. وكأنه فقد كنوزه العظيمة تلك التي طالما احتفظ بها، ورفّهت عنه، ودللها: الحلم، والتخيل، والأمل، والتفاؤل. |
| إنه عصر: فساد الحلم، والتخيُّل السِّري، والأمل التائه، والتفاؤل المصاب بالتضخم!! |
| فماذا تبقّى له.. وهو الآن في آخر خطوة في ((الأربعين)) مدلجاً إلى أول خطوة في الخمسين؟! الذكريات، الأصداء، الصور التي تعتاده في استرخاءاته كأنها الأشلاء! |
| ها هو يتماسك الآن... لديه رغبة في الصراخ، لا... بل في البكاء. |
| ولكن... ما الذي يصرخ عليه، أو ما الذي يصرخ فيه؟! |
| يغوص في عمق الأسئلة... والأسئلة تخلعه من أعماقه. |
| الليل بظلال أضوائه البعيدة القادمة من الميناء: يتكثّف في صدره، ويمدّ فيه جسور الصمت والوحدة. |
| أقفل النافذة، وأسدل ستارتها عليها، وأضاء ((الأباجورة)) في ركن الغرفة، مكتفياً بإضاءتها.. وأدار جهاز التسجيل بعد أن وضع ((كاستًّا))، انبعثت منه أنغام ناعمة وهادئة... فهو يقاطع سماع الأغاني الحديثة هذه التي يسمعها بقدميه، أو بأقدام وأيدي مَنْ يؤدونها، وقد فقدت إبداع الموسيقى، وجمال الكلمة، وعمق الصورة الشعرية... إنها لا أكثر من ((ديسكو)) غربي، بترجمة رديئة. |
| وحملته تلك الأنغام الناعمة إلى بهاء الذكريات، وترديد الأصداء. |
| ترقرقت جوانحه.. وهو يحس برغبة (حميمة) في البكاء الذي يريحه دائماً. |
| إذن... هذه هي الحياة، وهؤلاء هم الأحياء. |
| * * * |
| * أفاق من هودجة الموسيقى لمشاعره.. والعطش يجفف ريقه. |
| قام إلى الثلاجة، وشرب الماء مع الصمت الذي يكتنفه ويدثره. |
| يحتاج الآن إلى مَنْ يشاركه هذه الوحدة المتبتّلة، وهذا الصمت المرنّ. |
| اتجه إلى المطبخ، وأخرج من أحد أدراجه: مبخرة تعمل بالكهرباء، ومن درج آخر تناول كيساً بداخله قطع من بخور ((العُود)). |
| هذا العبق الدافئ... هو الآن: أجمل مَنْ يتقاسم معه: متعة الموسيقى، وبهاء الذكريات، ورنين الأصداء في الصمت. |
| وتصاعد البخور في أرجاء غرفة النوم.. وقد استرخى على أريكة أمام السرير في طرف الغرفة. |
| تناول جهاز ((الريموت كونترول)) وأشعل به التلفاز. |
| الساعة التاسعة مساء/ موعد نشرات الأخبار... وكالعادة: |
| ـ حروب، قتل، تفوق القوة واستئسادها على الشعوب الضعيفة: محدودة الإمكانات الدفاعية.. غنية بثرواتها أو بإستراتيجيتها. |
| ـ إسرائيل.. ولعبة العدوان ما بين مدّ وجذر. |
| ـ صعود وهبوط العملات العالمية التي يتحكّم فيها: الدولار، وينحني له ((اليَنْ))! |
| ـ محاولات العلماء لاكتشاف دواء جديد للأمراض المستعصية. |
| تذكّر أنه ((جائع))... يشتهي هذه الليلة: ((سندويتشات طعمية))، أحسن مَنْ يعدها متبّلة: موقعه في البلد.. والمهمة صعبة. |
| من الأصداء.. يأتيه صوت أمه رحمها الله، وهي تقول مازحة بالمثل الشعبي: ((عند البطون.. تذهب العقول))! |
| ارتدى ملابسه، وقاد سيارته.. يقتحم بها: زحمة الشوارع بالسيارات، كأنّ نسبتها أعلى بكثير من نسبة الناس. |
| لا يحب السرعة.. يبتسم وهو يستعيد ما كان يقوله لأمه حين يخرج إلى الشارع قبل أكثر من ثلاثين عاماً: |
| ـ ((لا تخافي عليّ يا أمي... أنا راح أمشي من تحت الجدر))!! |
| حتى وهو يقود عربته الآن... كأنه يمشي من تحت الجدر، أو لصيقاً به، ومن حوله السيارات المنطلقة كالصواريخ: تنط، وتتلوّى. |
| دعسة واحدة على البنزين، وانطلقت به العربة إلى الزحام... يتوخى السلامة، وتحاشي المتهورين... وكله من أجل "((ساندويتش طعمية))! |
| ـ ((أوه يا زياد... كل هذا ليس من أجل الساندويتش، بل بسبب إضرابك عن الزواج))! |
| صوته من الداخل يعلو ويختلط برجفة جسده. |
| حقاً... لأن بيته يفتقد دفء الرفيقة، والأنيسة، والشريكة في الحياة. |
| ـ ((هذا مبدأ.. يا واد يا زياد))! |
| صوته من الخارج.. يتسلل إلى أعماقه، ليبرر هذه العزلة. |
| * * * |
| * حين بلغ الثلاثين.. كانت أمه تلح عليه أن يتزوج، تطارده بكلماتها، تُحرِّضه على نفسه: |
| ـ ((يا ولدي.. الزواج سُتْرة ومصونة.. الزواج تكمل به نصف دينك)). |
| يبتسم في وجه ((ست الحبايب))، كما كان يناديها.. ويرد عليها: |
| ـ ((إن شاء الله يا أمي.. حتى يجي النصيب)). |
| * تجادله قائلة: ((متى يجي النصيب يا ولدي.. لمّا أموت يعني، بدّي أشوف أولادك)). يصمت... ويأخذ أمه بين ذراعيه ثم يُقبّل يدها. |
| واصلت أمه إلحاحها عليه.. حتى فاجأته يوماً، قائلة له: |
| ـ ((خلاص لقيت لك بنت الحلال... أمها صاحبتي من الشباب وحتى الآن، ما رأيك في بنت عمك ((سالم الوادي))؟! |
| فوجئ ((زياد)) بقرار أمه.. قال لها: ولكنك صاحبة أمها، وأنا لا أعرفها.. حتى لا أعرف وجهها. |
| ـ قالت له: ((وي... بسيطة أخليك تشوفها، هادا زواج ما هو لعب.. أنا أعرف)). |
| وتوالت ضغوط أمه عليه.. حتى خضع لرغبتها. |
| دخلت بيته امرأة جديدة.. جميلة، سمراء، طويلة.. شعرها فاحم بلون الليل. |
| في الأسبوع الأول بعد شهر العسل.. اكتشف أنها لا تعرف طريق المطبخ في بيت أهلها.. وبقيت أمه هي التي تطبخ لهما. |
| وفي الشهر الثاني.. ارتفع صوتها، تحب الصراخ، وإصدار الأوامر إليه.. وقد طالبته بخادمتين: واحدة لها، والأخرى لأمه! |
| وأحبطت أمه في اختيار ((ست البيت)). |
| واحتمل ((زياد)) كل هذه الطباع والسلوكيات من زوجته، حتى لا يزداد حزن أمه. |
| وطال احتماله حتى انتهاء عام على اقترانه بهذه المرأة الصعبة. |
| ـ قالت له أمه: ((أعرف يا ولدي أن أبغض الحلال إلى الله الطلاق، ولكني أراك تحتمل فوق طاقتك، وعاشروهن بمعروف أو فارقوهن بإحسان... أنا رفعت إيدي)). |
| وتنفّس الصعداء.. أزاح هذا الكابوس، فلعلها تجد كابوساً يتوافق معها. |
| وفي تنفسه ذلك.. كان يطوح بيديه مثل الخارج من بوابة السجن.. يتنسم الحرية. |
| والتفت إلى أمه يقول لها: |
| ـ ((ما قصّرت يا أمي... سأستقدم لك خادمة تسهر على راحتك، فقد كبرت على شؤون البيت.. استريحي، واستمتعي بحياتك)). |
| لكنَّ أمه استراحت للأبد بعد عام... وبكى في وحدته، والوجوه تتزاحم من حوله، والظلال يتراكم بعضها فوق بعضها الآخر. |
| وكأنه تعود على هذه الوحدة بعد تجربة زواجه الأولى، وبعد فقده المؤلم لأمه/ بَركة عمره وست الحبايب. |
| يذهب إلى عمله كل صباح، بعد أن يوقظه رنين الساعة التي يضبطها من الليل.. ويعود بغدائه معه من أي مطعم، أو ينام ثم يصحو ليُعدّ لنفسه طعاماً. |
| ـ (ياه يا ((زياد)).. العمر يركض، لا زواج، لا أولاد... حتى ولا خادمة تنظف البيت، وتطبخ لك)؟! |
| طاط، طاط، طاط.. أبواق السيارات من ورائه تدعوه أن يتحرَّك بعد أن أضيئت الإشارة الخضراء.. وكان يعيد ذلك الشريط في مشواره لجلب عشائه، وكثيراً ما استرجعه في ذهابه وإيابه. وقف أمام بائع ((الشاورما))، ونقَدَه قيمة ((الساندوتش)) وقفل راجعاً إلى بيته! |
| في طريق العودة.. واصل حواره مع نفسه: |
| ـ يتهمونك يا ((زياد)) بأنك فقير من الأصدقاء والأصحاب... ((يووووه)) على رأي الشاعر: ((ما أكثر الأصحاب حين تعدهم... لكنهم في النائبات قليل))! |
| يعرف ((زياد)) أنه ينتمي إلى عصر اسمه: أنا.. ومن بعدي الطوفان، لذلك فهو لا يلوم أحداً من أصدقائه، أو ممن صاحبوه وقتاً طويلاً ثم انفضُّوا عنه.. ((الدنيا تلاهي))، أو لا بد له أن يجد لهم العذر وإلاّ أصيب بالإحباط وبالاكتئاب من كثرة المنفضين الذين لم يسمع أصواتهم عبر الهاتف من شهور طويلة، فما بالك بالذين لم يعد يلتقي بهم؟! |
| آخر تواصل جاءه من صديق: ورقة وجدها قبل يومين في مقبض باب ((الفيلا)) من صديق لم يسمع صوته من عام مضى.. كتب له فيها: |
| ـ ((زياد... أعذرني، لم تذهب من خاطري.. لكني صرت متعدد الرحلات. تمنيتك في باريس قبل شهر حين جئت على بالي... معليش يا زياد، أضع لك رقم هاتفي الجديد، أرجوك أن تتصل بي لأنني اشتقت إليك))! |
| تنهد ((زياد)) بعد قراءة الرسالة القصيرة، وهمس لنفسه: |
| ـ ((كثَّر خيره.. فيه الخير برضه، أحسن من كثير مثله.. نسوا أو تناسوا، فماتوا في وجداني))!! |
| في غرفة نومه.. سقط داخل ((الكنبة)) المواجهة لجهاز التلفاز، بعد أن التهم سندويتشه، وصنع فنجان شاي أخضر له.. ورفع ساقيه وطواهما تحته، وأضاء التلفاز.. حتى يشعر بالنعاس، وقد انتهى يوم آخر من الأسبوع، ومن الشهر، ومن السنة... أي من عمره الذي ينسرب منه بطيئاً ومملاً!! |
| * * * |
| (2) |
| * اختلط ليل جدة بالطل، والهمسات الضبابية. |
| وجه ((زياد)) يفيض في هذا السكون بالملل، وبالوحدة. |
| فيلم الغم والنكد على شاشة التلفاز: انتهى بما هو متوقع.. بحيث يُحرم المشاهد من قدح ذهنه، وانتشاء خياله. |
| أقفل التلفاز... ودسَّ وجهه بين خيوط الضوء المنسربة إلى غرفته من فجوات الستارة... فإلى أين سيذهب بوجهه من هذا السكون؟! |
| هذا المساء... كان يقص على نفسه حكايته، هكذا يفعل بين فترة وأخرى.. ربما ليتذكَّر أنه ما نال يعيش دون أن يحيا. |
| منذ موت أمه.. وهو يثق في ذاكرته التي سجَّلت المواقف، والصور، والذكريات... لم تخنه يوماً، وإن كان يهرب أحياناً من هذه الذاكرة حتى لا تحاصره بصدى لا يحتمله، ويفرّ منه كلما تصاعد في نفسه. |
| كان أصدقاؤه يحسدونه على هذه الذاكرة... حتى أرقام الهواتف يرددها بسلاسة، ولم يحتج يوماً إلى أجندة تليفونات يحملها... ويضحكون في وجهه وهم يقولون له: |
| ـ ذاكرتك مخيفة... فهل تخاف أن تفقد ذاكرتك، أو تتمنى الاحتفاظ بحيويتها؟! |
| لكنه - الآن - كمن يقف على أطلال.. أو أن ذاكرته تشبه الأطلال. |
| يشتاق إلى: ((ذكريات زمان))، ويحنّ للماضي. |
| يعيش أكثر شهور السنة.. منغمساً في العمل، ومسترخياً في صمت الكون من حوله حين يدخل بيته، ويبقى فيه.. لا تصاحبه إلا الوحدة، ولا يحاوره إلا الصمت. |
| لكنه ((يحيا)) شهراً واحداً في دورة الزمن.. يقتطعه من السنة، ويسميه البعض: إجازة.. ويسميه هو: انطلاقة! |
| شهر واحد في العام.. يحزم فيه حقيبته الصغيرة، ويحجز مقعداً في طائرة، ويسوح في أرض الله الشاسعة! |
| أما في العيدين... فهو في عيد الفطر يحرص أن يقسِّم الأيام الأربعة على أهله! وأقربائه.. يزورهم ما بين: مكة المكرمة، وجدة، والطائف.. وفي اليوم الخامس من العيد: يسترخي في صومعته هذه.. يجلس مع نفسه، وخواطره، وأفكاره. |
| وهو في عيد الحج.. يكون ملبِّياً، ثم يفيض من عرفات، ويذوب في جموع الحجاج.. يتعرّف عليهم، ويدعو معهم... لا يذكر أنه ترك الحج ذات عام وسافر بعيداً، لكنَّ هدير الحجيج، وأصواتهم الداعية، ومشهد الشُّعْث الغُبْر: (يخمش) قلبه، كما يصف، ويزرعه فوق هذه الأرض الطاهرة. |
| كان يحمل أمه معه في كل عام، ويحججها.. وكانت تلهج بالدعوات المستفيضة له: |
| ـ ((روح يا ولدي... ربنا ينوِّر طريقك، ويبعد عنك الشر، ويسبغ عليك الرزق))! |
| كان يُقبِّل قدميها، ويبكي.. وهو يقول لها: |
| ـ ((إدعي لي يا أمي... رضاكِ هو ثروتي في هذه الدنيا))! |
| * * * |
| * طفرت دمعة دافئة من حدقتي ((زياد)) وهو يشاهد في خياله هذا الشريط من الذكريات والمواقف. |
| هواياته محدودة... ربما كان من أهمها: القراءة. |
| إنه يعشق الكتاب، ويعتبر الوقت الذي يجلس فيه للقراءة، هو: موعد عشق لا يمكن أن يشاركه فيه أحد.. حتى قبل موت أمه، كانت تعرف طقوسه هذه مع القراءة وتحترمها، وتقفل عليه باب غرفته بعد أن تزوده بالشاي في ((التُّرْمُس)). |
| واستفاد كثيراً من القراءة.. فقد انعكست هذه الفائدة على مداركه ومفاهيمه، فلم يعد يجرؤ أحد أن يقول له: ((يا حمار)).. وانعكست على تفكيره، فصار يملك رؤية واضحة، ولديه قدرة على إبداء الرأي السليم... وانعكست حتى على مشاعره، فارتقت القراءة به من حيوانية الجنس إلى رقة العاطفة، والحلم، ودفء اللقاء... لكنه كان يفرُّ من أسْر الرومانسية لوجدانه، لأنه يعتقد: أننا نعيش في عصر مغرق في الماديات، لا تنسجم الرومانسية مع ملامحه. |
| ـ وقال له أحد أصدقائه في أحد حواراتهما: لكنَّ الرومانسية صارت في هذا العصر المادي كما تقول: ضرورة.. حتى تنتشل عواطف الناس من الجفاف، وحدة الطباع، ووحشة النفس! |
| وفي كل ليلة... يقرأ، ويحرص أن تكون قراءته للشعر بعد منتصف الليل، رغم فراره من الرومانسية. |
| ويحرص على ممارسة هوايته الأخرى، وهي: السباحة... وأثناء بحثه عن ((فيلا)) لشرائها، كان يبحث عن المسبح أولاً، حتى عثر على ((فيلته)) هذه... وصار وقت سباحته محدداً في اليوم بعد أدائه لصلاة العصر، فهو لا يحبذ أن ((يُعسِّل)) في إغفاءة ما بعد الغداء، أو بعد الظهر. |
| ويعتقد أنه بنظام حياته هذا: يستمتع بالوقت، وبتنظيمه لفائدته هو. |
| لم يفكر في تكرار تجربة الزواج ثانية.. وكان يهرب من ضغوط وإلحاح أقاربه عليه... فهذه حياته التي ارتضاها لنفسه، ويشعر في تنظيمه لها: أنه يمتلك: حريته، ويُعِّبر عن إنسانيته. |
| ـ سألته عمته في ثاني أيام عيد الفطر من العام الماضي: ((أنت مضرب عن الزواج، والا إيه؟!... أصابعك يا ولدي ما هي زي بعض... ما صلحت الأولى، ربك يعدِّلك ويصلح لك الثانية... ها أخطب لك))؟!. |
| * ويقفز زياد.. ويقول لعمته: ((لا... دخيلك، أنا كده مبسوط، وعايش سُلطان)). |
| وتزم شفتيها، وتشيح بوجهها... فهذا الرفض من ابن أخيها لا يعجبها. |
| ـ وتقول له ابنة عمه الأكبر من والده، وهي تكبره كثيراً وآخت بينهما الرضاعة: ((قول لنا على المواصفات اللي تبغاها في زوجتك، وتأكد أننا سنجدها)). |
| * ويرد عليها: ((يا أختي... والله العظيم مبسوط كده، بعيد عن الصراخ والنكد اليومي)). |
| ـ تجادله: ((يعني لازم تكون كل زوجة في طباعها وسلوكها زي طليقتك!!.. لا تخلّي التجربة الأولى تعقِّدك يا خويا)). |
| * ينفعل: ((تعقِّدني إيه، وعقدة من إيه؟!.. كل ما هنالك أن الزواج قسمة ونصيب، ويوم ما يجي النصيب.. لا تخافي، راح أندبّ، واتهبّب... يعني أتزوج))! |
| ويطارده هذا الهاجس، وأصداء أصوات أهله.. وفراره الدائم من هذا الارتباط. |
| نعم... يعرف أن الزواج نصف الدين، ولكنه لا يريد أن يظلم بنت الناس التي سيختارونها له، أو حتى التي سيختارها... لقد تعوَّد على هذه الوحدة. |
| بعض أقربائه الأبعد، الذين لا يزورونه إلاّ ((في الشديد القوي)) كما يقولون: ينظرون إليه شزراً، وبريبة.. كأنهم يتهمونه بأنه: رجل عابث، ضد الالتزام. |
| ـ فهل هو رجل عابث بالفعل؟! |
| طرح هذا السؤال على نفسه في أصداء الذكريات هذه، وابتسم.. ثم همس: |
| ـ لو كنت عابثاً.. ما شكوت من الوحدة، ومن صقيع هذه الجدران، رغم الحرارة والرطوبة في الخارج... معليش، مجتمع الهمس والشائعات يبقى خطيراً يُدمّر وشائجه من أعماقه. |
| سكنه هذا.. يشبه قلعة تاريخية، ويخيّل إليه: حتى حجارتها نائمة. |
| وقته الضائع هذا - بعد العمل - يعاني من البلل... لولا أنه يجففه ويطرد بلله حين يلوذ إلى القراءة، وحين يقذف بجسمه في مياه المسبح. |
| هو رجل متماسك جداً... صراخه يعلو من داخله، فلا أحد يسمعه غيره. |
| بكاؤه ليس دمعاً... بل آهة، وصمتاً، وتأملاً... وأحياناً يتحوّل بكاؤه في شكل ابتسام! |
| كل ليلة.. يزعجه رنين الهاتف القابع بجواره، ويرمقه بنصف نظرة، و..... ((يخصره))، لا يعير رنينه أي التفات... فهو إما: معاكسة/ من هذه الظاهرة المؤلمة، وهو إما: ((رغي))! |
| ـ ((ليس شرطاً... ربما كان من يطلبك لديه موضوع هام))؟! |
| يقول لنفسه هذه العبارة/ السؤال... ويرد على نفسه: |
| ـ ((لم يعد في حياتي ما يُشكِّل هذه الأهمية... ومَنْ يُهاتفني، لا بد أنه يقصد شيئاً لمصلحته))! |
| ـ ((ولمَ لا؟!... الناس بالناس يا ولد، أنت تحتاج الناس، وهم يحتاجون إليك... أجب على الهاتف.. لا تكن أنانياً))!! |
| يحدث - أحياناً - أن يستجيب، ويرفع سماعة الهاتف، ويصغي: |
| ـ ((هلا زياد... كيفك؟!.. يا أخي مكروب والله، تصوَّر، المقاول ابن الـ......... بعد أن بدأ في العمارة، اختفى، وطاردته ومازلت، ويعتذر بقلة العُمّال، وهو متشعب يعمل في أكثر من عمارة... يا أخي الناس جرى لهم إيه؟!.. أعوذ بالله، كله كذب، وتدليس))؟! |
| * يرد عليه بعد أن نفث صديقه ثورته: ((إنت عارف اللي جرى للناس، وانت واحد من اللي جرى لهم، وجرى عليهم... فضفض يا خويا فضفض، بس.. تقدر تعمل حاجة، تصلح السلوكيات، وتهذب التعامل؟!... روح نام، الساعة الآن بعد منتصف الليل، نزعتني من أحداث رواية مثيرة.. الله يكافيك))! |
| ـ يأتيه صوت صديقه محبطاً: ((يا برودك يا أخي.. رواية؟!.. يا لذيذ يا رايق.... تصبح على دراما يا أخ))!! |
| يتلفّت حوله بعد أن أعاد سماعة الهاتف.. يتطلع إلى جدار الغرفة، إلى التلفاز المقفل، إلى الرواية التي قَلَب كتابها، وأطل عنوانها: (الجدار)... كأن هذا الجدار ينقصه حتى يقرأه في رواية! |
| كل شيء حوله - كما خيّل له لحظتها - أنه: يخفق.. له أنفاس، ونبض. |
| إنه - في وحدته - يخاطبهم جميعاً في وقت واحد، وأحياناً يخاطب كل شيء على حدة... فمخاطبة الجدار تختلف عن مخاطبة التلفاز المقفل، عن مخاطبة الكتاب... وفي كل هذه الأشياء، ومن خلالها: يرى ملامح البشر، وطباعهم.. وتتطاير ذرّاتهم حتى تستقر فوق وسادة نومه. |
| ـ هل هذا انتحار بطيء؟! |
| وجّه السؤال إلى نفسه... ولم يتأوّه، بل شعر أن بخوراً يتصاعد من ضلوعه هو العبق!! سمع ساعة الحائط تدقّ الواحدة بعد منتصف الليل. |
| النوم يجافيه... دندن بصوت خفيض: ((أراك عصيّ الدمع، شيمتك الصبر))! |
| تلك حاله... وهو يمتح من أعماقه المعاناة، والدمعة، والصبر. |
| مزارع الوحدة في صدره.. طرحت ثمار الصبر. |
| ومع ذلك... فهو يملك قدرة رائعة للحسم بعد التفكير. |
| يتمتع بقدرة كهذه مثلاً: يقول لنفسه: أريد أن أنام.. ويذهب إلى سريره، ويضع رأسه على الوسادة، وبعد دقيقة واحدة يعلو شخيره. |
| ـ يقول لنفسه: أريد أن أسافر... فيخرج من بيته لشراء تذكرة، والحجز، و.... يسافر. |
| كان ((يمارس)) هذه القدرة التي تمتعه كثيراً، ليؤكد بها: تصميمه، وإرادته. |
| ورغم أنه لا يستمتع بإجازته السنوية إلاّ ((شهراً)) واحداً في السنة.. لكنه يختفي أحياناً: |
| أيام الأربعاء، والخميس، والجمعة.. ليظهر يوم السبت في العمل! |
| ويسأله زملاؤه بدهشة: أين كنت؟! |
| ويرن عليه الهاتف.. ((يلعلع)) فيه صوت أحد أصدقائه: ((أين كنت.. بحثنا عنك ليلة الخميس.. علي: كان عنده عشاء، أم أنك كعادتك لم ترد على الهاتف))؟! |
| ـ يقول له: ((مِنْ متى ألبّي دعوات عشاء أو غداء.. ألا تعرفني))؟! |
| * يرد عليه صديقه: ((يا أخي أخرج من عزلتك المصطنعة هذه.. أم أننا لا نعجبك))؟! |
| ـ يقول له ببرود: ((ربما بالفعل لا تعجبوني.. فدعوني في عزلتي))! |
| إنه لا يُحدِّث أحداً عن حياته الخاصة.. ولا يقول: أين اختفى في نهاية الأسبوع؟! |
| لكنه يفعل ذلك الاختفاء كل شهرين مرة.. يذهب إلى القاهرة، إلى الدار البيضاء.. ويعود إلى جدار بيته، وسادته الخالية، وكتبه الصديقة، والهاتف الذي يرنّ ولا يستجيب لرنينه في أغلب الأحيان، والتلفاز الذي يفكر في تشغيله في مواعيد الأخبار، أو المسلسلة اليومية. |
| تستطيب اللحظات في وحدته هذه.. حين يجلس مع ذكرياته، وتأملاته، وحواره مع نفسه ولها. |
| وفوجئ بعد مغرب يوم برنين جرس باب ((الفيلا)).. وقام متثاقلاً ليجيب. |
| يعرف أن فتيان الجيران في الحارة.. يفعلون هذا العبث أحياناً، يضغطون على جرس الباب ويختبئون... فقط لإيذاء الغير! |
| لكنه حين أشرع باب ((الفيلا)).. وجد أمامه صديقه الذي حادثه قبل أيام بالهاتف، واشتكى له من المقاول، والكذب: |
| * أهلاً سامي... تفضل، خطوة عزيزة! |
| ـ عزيزة مين يا عم؟!.. انت راجل انعزالي، إندياحي، استبطاني، جدراني. |
| * على هونك... أنت تشتمني أم تمدحني؟! |
| ـ لا أعلم... ((انداحت)) الكلمات بتلك الألفاظ.. فهل تعرف معانيها؟! |
| * لا عليك... كثير من الكلمات لم نعد نعرف معانيها.. وكثير من المعاني جهلنا كلماتها.. أهلاً بك، شَقّة غريبة. |
| ـ وبعدين معاك؟!.. في الأول: عزيزة، ودحّين: غريبة... تكون اتزوجت؟! |
| * لما تكمِّل عمارتك، ويوفي المقاول معاك... أتزوج! |
| اختفى ((زياد)) في المطبخ، ليعود بعد دقائق يحمل صينية الشاي والأكواب. |
| ـ سأله صديقه سامي: ((فين الخدّامة؟!.. آه، إنت ما عندك خدّامة، يا أخي بلا قرامة، فكّ الكيس شوية، واستقدم خدّامة فلبينية على الفرَّازة.. خليهم يورُّوك صورتها.. وأهي: تخدمك، وتقوم بتنظيف البيت، و.......، أو تقتلك!! |
| * أعوذ بالله من أفكارك... إطفح الشاهي. |
| ـ إسمع... إيه رأيك تبيعني هذه الفيلا؟! |
| * وأسكن أنا فين؟! |
| ـ لا، لا... ما حتسكن في الشارع، أشوف لك شقة برْحة وهواءها بحري في عمارتي.. الفيلا كبيرة عليك، خاصة وأنك مضرب عن الزواج! |
| * يادا الزواج... يا حبيبي أنا كده مبسوط في عيشتي وفي سكني.. والله عال: واحد شايل ذقنه، والثاني تعبان منها، إسمع انت.. شوف سكة تانية. |
| ـ أصل فيلتك تلزمني.. أحتاجها، الله وكيلك بعد انحسار ((الطفرة)): الفلوس شحَّت، لكنها ماشية بحمد الله.. كام شقة أأجّرها، على كام فيلا.. مستورة. |
| * لما الفلوس شحِّت.. من فين تدفع لي قيمة الفيلا؟! |
| ـ لا.. ما تخاف، لي فلوس عند عدة إدارات ومؤسسات، وأطالبهم بها.. لكنَّ الكثير منهم يدّعي: ((ما في سيولة))، بس أخلّص فلوسي وادفع لك! |
| * يا صديقي... أهلاً وسهلاً بك، أنستنا يا حبيِّب، عساك طيب، وتسلم.. وما عندي فلل للبيع.. بلاش وجع دماغ. |
| أوف... زفر ((زياد)) من صدره وهو يقفل باب الفيلا في ظهر صاحبه. |
| وركض إلى حجراتها... كأنه يُطمئن حجارتها، وأبوابها، ونوافذها.. أنه لن يُفرّط فيهم. |
| * * * |
| (3) |
| * كان ((زياد)) يتأمل وجهه في المرآة. |
| يضحك في وجهه، أو على وجهه.. ليس دميماً، بل له ملامح وسيمة، وتعبيراته لمّاَحة.. تجذب إليها. |
| وجهه... يحتاج إلى باطن كفَّيْ أنثى: يحضنه، يدفئه من ثلج هذا اليُتْم العاطفي. |
| استمر يضحك وهو يخاطب نفسه في المرآة: |
| ـ يا هذا الوجه... مجهد أنت، أم يتيم من ابتسامة الفرح، ومن انتشار الحب على قسماتك؟! |
| ضوء الشارع يتسلل إلى غرفته من فجوات الستارة. |
| قام... وأحكم إقفال الستارة، إنه يتناغم مع هذا الضوء الخافت في ركن غرفته.. مثلما تنساب موسيقى ((موتزارت)) في أجواء مشبَّعة ببخور العود الذي يحبه دائماً. |
| آه ((موتزارت))... كيف، والغناء كله اليوم: مبتلي بأصوات نشاز تغطي الأجهزة قبحاً؟! |
| واصل ضحكه أمام المرآة... في حضرة ((موتزارت)) وعبق العود! |
| ـ ((ترى.. هل أنا مجنون))؟! |
| مازال يضحك... حتى وجد نفسه يقهقه: |
| ـ ((إعقل يا واد يا زياد))! |
| يخفت ضحكه... تتراءى له: بعض الوجوه العابسة الكريهة: وجه رابين، وكريستوفر، ومحمود المليجي، واستالوني، وقارئة الفنجان العربي! |
| تراءى له بعض الوجوه التي تدَّعي البشاشة والفرح: وجه الختيار عرفات، والرئيس جيفرسون بيل، ووجه الممثل العربي في أفلام هذا العصر! |
| تراءى له بعض العيون: عيون المها بين الرصافة والجسر.. فأين الرصافة، ومَنْ نسف الجسر؟! |
| ـ آه.. أيتها العيون التي تنبلج كفجر نقي بعد ليل شديد الظلام. |
| أيتها العيون.. السحر الذي يحيل الدمعة إلى ابتسامة. |
| أيتها العيون.. شلال رؤى مطرّزة بالحلم، وبالدلال! |
| عاد يضحك.. يقهقه، يتوتر، وفجأة: تناول زجاجة عطر من فوق التسريحة وقذف بها على المرآة.. فدوّى تهشم الزجاج في أرجاء الغرفة. |
| انخرط على الأرض.. متكوِّماً: يبكي.. يجهش بالبكاء.. يصرخ.. ينادي: |
| ـ يا أمي... أين أنت؟! |
| ـ يا حبيبة القلب... من أنت؟! |
| لو تطلَّع إلى المرآة المهشمة الآن، فلن يرى وجهه. |
| لو بحث عن مرآة أخرى... فكل المرايا مكسورة... يرى عليها: نظراته المكسورة مثل المرآة، وملامحه المسكينة، وعضلات وجهه المتوترة. |
| من يحتويه الآن.. يحضنه.. يمسح على شعر رأسه.. يسقيه بيديه ماءً بارداً.. يغسل له وجهه ودموعه؟! |
| يقفز فجأة... يصرخ: |
| ـ لا... لست مجنوناً، فقط... أنا يتيم الأم والأب، بل يتيم الحب! |
| يركض إلى ستارة النافذة، يفتحها، ويقذف بضلفتي النافذة إلى الخارج... يخاطب كل شيء أمامه: |
| ـ أيتها المدينة التي تغيظ برطوبتها.. بصمتها مثلي.. بهذه الأكوام من الحجارة، والخشب، والتراب: المعالم التي تدل على إقامة عمارة هنا، لن يلتقي سكانها بعد ذلك إلا كالغرباء. |
| الغربة - أيتها المدينة المتباعدة دروبها وطرقها - الغربة هي هؤلاء الناس/ النمل... في خطي سيرهم للذاهب وللقادم، كخطين، مستقيمين لن يلتقيا. |
| الغربة هي: هذه الماديات.. الفلوس، الحجارة، الذهب، الرصيد في البنوك، لذّة التناسي، تحطيم كل ما يصادف المرء في طريقه! |
| ماذا تبقَّى في صدور الناس من حب، ومن كراهية؟! |
| الآن... لا أحد يحب، لا أحد يكره... اللون الرمادي هو الطاغي. |
| هذه الأشجار التي غُرست على أطراف الشوارع، وفي منتصفها: كيف تُسقى... والناس يشكون من قلة المياه؟! |
| ـ ((هذه الأشجار تُسقى بمياه الصرف الصحي... يا أبله، ألا تشم الرائحة))؟!! |
| أيتها المدينة المتثائبة دائماً بحشود السأم.. مَنْ يُحزِّمك لترقصي، فيعرف الناس أنّ لهم أفراحاً؟! |
| الخطوة: شبر... الشبر قد يستهلك عمراً كاملاً! |
| ترك النافذة مفتوحة، وأسدل الستارة. |
| ـ عندما نتحدث عن الحياة... لا بد أن نكون أحياء. |
| وهو يشعر أنه لم يكن حياً... يتشابه كثيراً مع الـ ((رومونت كونترول)) الذي يشغل به التلفاز، ويُشغِّل به: عقله وأفكاره حسب مصالحه... والمؤلم: أنه يضطر أحياناً إلى تشغيل عاطفته بهذا ((الرومونت))! |
| فماذا أعطته الحياة.. وماذا أخذت؟! |
| مبدأ العيش دائماً: خذ، وأعط. |
| وما يغلب على حياته اليوم هو: العطاء المستمر.. دون أن يحظى بأخذ أبسط الأشياء التي يرغبها! |
| رياح ثارت من داخل نفسه.. فجّرتها ضحكة أمام مرآة. |
| هل يعني هذا: أن يتحاشى بعد الآن الوقوف أمام المرآة؟! |
| ولماذا... والرياح مصدرها: النفس، والملل، وهذا اليُتْم في الحب؟! |
| إنه لا يريد أن يتحوّل إلى فيلسوف... فقط: يريد آدميته، ويحافظ على إنسانيته، ويحيا أحلامه وطموحاته. |
| يخيّل إليه في بعض لحظات تفكيره في حياته: أن طموحاته قد أحبطت، وأن أحلامه قد سُرقت منه، وزوّر السُّراق هويتها وملامحها. |
| خيط الفجر الأول يتقدم إلى حضن السماء.. إشعاع النور من يوم جديد. |
| فرك عينيه، وقرر أن يغتسل.. وتوضأ انتظاراً لأذان الفجر. |
| فتح المصحف، وأخذ يقرأ آيات من القرآن الكريم، وقد انسابت دموعه على خديه في صمت.. ولم يكفَّ عن تلاوة القرآن حتى ارتفع الأذان. |
| شعر كأنّ جسده كله مهشم كتلك المرآة التي حطّمها... آوى إلى فراشه بعد. أدائه لصلاة الفجر، يفتش عن النوم. |
| * * * |
| * في منتصف النهار استيقظ على حرارة غرفة نومه... اكتشف أن الكهرباء قد قُطعت، لا يندهش فهذا هو فصل الصيف، وموسم قطع التيار. الكهربائي عن البيوت. |
| قفز من فراشه وهو ينظر إلى الساعة التي شارفت على الثانية عشرة ظهراً: |
| ـ ((ول...... راح الدوام، خصموا عليك يا واد يا زياد)). |
| يبدو أنه من شدة التعب والسهر.. أقفل رنين الساعة التي ضبطها على موعد صحوه كل صباح، وواصل النوم. |
| وإذن... ماذا يفعل بقية اليوم حتى الليل؟! |
| في النهار.. تتسع الغربة حوله،!ربما في نفسه.. لكنه في الليل يشعر بالتوحُّد مع نفسه، ومع أفكاره وتأملاته، كأنّ الليل هو وطنه، أو عائلته. |
| أمسك ببطنه.. كأنه يريد أن ينقذها من (المغص الشديد). |
| هكذا هو دائماً... يعاوده المغص كلما انتابه شعور الوحدة، كأنَّه في زنزانة، وتراه يمشي في أرجاء بيته قابضاً على بطنه. |
| ماذا يفعل الآن... هل يذهب للطبيب؟! |
| يعرف التشخيص.. سيقول له الطبيب: توتر، قولون عصبي، مرض العصر. |
| أبوه: كان يعاني من ذلك القولون، دون أن يعرفوا اسمه آنذاك.. فهل القولون مع التركة المتواضعة التي خلَّفها والده: وراثة؟! |
| كانت أمه تسارع حين يؤلمه المغص، فتحضر له (نانخة) من العطار، توفرها في البيت، حتى تجدها فوراً لابنها عندما يثور عليه المغص. |
| ـ ((نانخة الآن... وهل يوافق الطب الحديث))؟! |
| سارع إلى نوع من الكبسولات سبق أن وصفها له الطبيب، وتناول منها حتى يخف ألم المغص... وربما لا يكون ((قولوناً))، لا بأس.. عليه أن يستريح بعد الدواء. |
| ـ ((لو كانت معك زوجة رفيقة.. لرعتك الآن يا واد يا زياد))! |
| ـ ((يا عمي روح... المغص أهون))!. |
| تعالى رنين الهاتف... لا بد أن يرد حتى لا يشعر الآن بالعزلة وهو مريض: |
| ـ أين أنت يا رجل... كنا نضبط دفتر الدوام على دخولك للإدارة؟! |
| * أعاني من مغص حاد... أشكرك على اتصالك وسؤالك عني. |
| ـ يا أخي لا تشكرني... المدير سأل عنك عدة مرات. |
| * إذن... أخبره عن مرضي. |
| ـ ((ها. ها. ها... مريض، وإلا عندك أحد))؟! |
| * ((يا بني آدم حرام عليك.. إن بعض الظن إثم، ألم تلاحظ صوتي))؟! |
| أنهى المحادثة السمجة مع زميله الغِتت في العمل وفي الهاتف.. وهمس في داخله: |
| ـ ((علشان كده.. أقول ما أرد على التليفون... ولا على نوع بشر)). |
| كبسولة الدواء.. فعلت مفعولها، ارتاح كثيراً، وكأنه قادر لأول مرة على التنفس، بل والتأمل، والعودة إلى الحديث الدائم الذي لا ينقطع بينه وبن نفسه. |
| عاوده صوت زميله الغِتت متمهلاً عند عبارته الشك: ((مريض.. وإلا عندك أحد))؟! |
| ـ ((أحد مين يعني... وفين))؟! |
| يشعر الآن بالجوع... عليه أن ((يتخطّر)) قليلاً، ويدخل المطبخ، ويعدُّ وجبة الغداء... في نفسه أن يطبخ اليوم بعد تلاشي الألم، ولكن عليه أن يختار ما يأكل.. مثلاً: شوربة خضار، فتح الثلاجة فلم يجد فيها الخضار.. لا بأس، شوربة عدس. |
| ـ ((آه... والله فكرة، غذاء الأصحاء الفقراء.. مع كبسة رز..... الله)). |
| ما نصنعه بأيدينا... نتحمل نتائجه ولا نشكو! |
| لكنه طبخ شوربة لذيذة... وأكل، وشبع، وحمد الله على النعمة والعافية. |
| عليه أن يرتاح الآن في هذه القيلولة. |
|
((تعسيلة)) بعد الظهر.. لا ينصح بها الأطباء، وترفضها الشعوب كثيرة الإنتاج... إنهم يعملون من الصباح حتى بدء المساء.. ويتناولون الوجبة الكبيرة. |
| حاول في أكثر من ظهيرة أن يهرب من تلك ((التعسيلة)) التي تُكسّر الجسم، ولكنه يقع فيها كثيراً أيضاً. |
| استرخى بعد تلذذه بالشاي الأخضر.. هو ضد التدخين الذي يُعطب القلب. |
| من جديد.. استطرقته عبارة زميله في العمل: ((مريض... والاّ عندك أحد))؟! صحيح... إنه لم يفكر في ((المرأة)) منذ تجربة زواجه الأول. |
| كيف كان يعيش، ويتفوق على رغباته؟! |
| هل هو رجل كابت لنفسه.. مكبوت بإلغائه لهذا الجانب الهام؟! |
| لم يفتش عن أنثى... حتى أنه لم يفتقدها في حياته، ولكن..... حتى الحيوان يحتاج لنصفه الآخر، حتى الأشجار تتلاقح. |
| هل هو رجل مريض، أو غير سوي؟! |
| ـ ((أعوذ بالله... ليه أفاول على نفسي؟!... هادا الكلام: فاول))! |
| ـ ((هل هو رجل بائس حقاً... قال إيه، ويتهمه البعض بالرومانسية، صح.. رومانسية مع وقف التنفيذ))!! |
| عند رؤيته للأفلام.. كثيراً ما كان يتوقف أمام جمال أنثى: وجهها، أو قوامها، أو سحر العيون، أو قوة الجاذبية.. فهو ((يفهم)) في الأنثى، ولكنه جعلها كالغول، والعنقاء، والخل الوفيّ... وقذف بها في أودية النسيان.... فهل استراح؟! |
| صدَّ العديد من المحادثات الهاتفية الـ...... رومانسية. |
| ـ يقول: ((ما هي نتيجتها... وجع القلب، وعوار الدماغ))؟! |
| ولكن... أين: المشاعر، وخفقة القلب، وجحافل الشجون التي يفيض بها صدره.. |
| مع آلام المغص من الوحدة، بل من العزلة، والامتناع عن ممارسة وظائفه الفسيولوجية؟! |
| أية أنثى سيختار؟! |
| هل سيحب في البدء؟! |
| الحب... لا اختيار فيه، لكنه يقود كل الأحاسيس إلى إنسانة لا غيرها. |
| قام يركض إلى المرآة... أوه، لقد نسي أنه هشمها. |
| مرآة الحمام... هذا وجهه، شعره سيزحف إليه البياض.. فمتى يتزوج، وينجب، ويربي.. قبل أن يموت؟! ((يا هَنَى مين يعيش))! |
| ـ "يا سيدي... الأعمار بيد الله، فهل تقبل بي فتاة في العشرين؟! |
| الدُّهن في العتاقي يا سيد... اتكل على الله، وشوف.. |
| حيشوف... الصباح رباح))! |
| والصباح الذي سيقرر فيه الإقدام على هذه الخطوة الجريئة بالنسبة له.. ربما كان في الغد، وربما جاء بعد نصف عام، أو اكتمال سنة... المهم: أن رأسه اتحد مع قلبه وانتفضا معاً!! |
| * * * |
| (4) |
| * قادته خطواته إلى سيف البحر... هذا ((الكورنيش)) الممتد من أضواء ((أبحر)) التي توصوص من البعيد كالنجوم، إلى أضواء الميناء الصفراء... يذرعه في الليل مئات البشر: مَنْ أصابه الملل، ومن رغب في نزهة مع عائلته بعد تعب النهار، ومن فاض به ((القرف)) فلم يعد يدري ماذا يريد، ومن تكالبت عليه هموم لقمة العيش، أو هموم الانسجام مع الناس. |
| زحام شديد.. يتزايد أكثر في مسائي الأربعاء، والخميس/ الإجازة... الشباب ينطلقون بسياراتهم: صخب يراه حتى في التعبير عن العواطف، وفي التدليل على ((الطَّفش)). |
| ـ ((أين يذهب الناس؟! |
| صحيح... فكيف نلوم الشباب دون أن نوجد لهم البديل.. كالأندية مثلا))؟! |
| شرائح أخرى من الناس.. اقتعدت الرصيف المشرف على البحر، و((الموجة تجري ورا الموجة)) في غموض الليل، وبياض الموج، وهدير البحر! |
| ملكوت رائع وعظيم - يا أي فلان - يفسد هذا الصخب الذي تشكّل من أصوات السيارات التي يقوم أصحابها باستعراضاتهم.. ومن النظرات الجائعة التي تختلس النظر إلى ملاحة أنثى، أو غموض شكلها خلف عباءتها.. ومن عربات الباعة المتجولين ((بالبليلة)) أو الآيسكريم.. ومن أصوات الأطفال المنطلقين. |
| اختار ((زياد)) بقعة رملية بعيدة قليلاً من هذا الكرنفال الشعبي، افترشها وحيداً، مقابلاً للبحر الفسيح/ العميق أمامه... واصطحب معه جهاز تسجيل تصاعد منه صوت مَنْ كانت ((كوكب الشرق))/ أم كلثوم.. وهو يصدح بإحدى أغانيها الشجية الشجنة: ((ياللي كان يشجيك أنيني))! |
| البحر أمامه: بساط مخيف.. يحصد كل تلك الأضواء التي تتجمع من أبحر، وامتداد الكورنيش، والميناء.. وتتماوج على سطحه بلا تعب! |
| هذا الامتداد الذي امتزج فيه سواد الليل ببياض الموج المندفع نحو الثبج.. لا يفلسفه ((زياد)) بالغموض والأسرار، بقدر ما يتأمله، ويستغرق فيه، ويغرق.. لأنه يولّد عنده أسئلة مختلفة، وتشكيلاً رائعاً لعظمة الخالق، واستخلاصاً لطيبة النفس البشرية التي تتشابه مع هذا البحر في: المدّ والجزر، والأسرار، والأمواج، والعمق، والغدر، وجمال الزرقة اللانهائية.. كأنها تتحد مع زرقة السماء. ! |
| كأنه هو الآخر يتحرر من افتراس الأفكار له، وقد جذبه ((التأمل)) إلى فلسفة الوجود والكون.. وأغراه كثيراً بالدخول الأعمق إلى ذاته، لعله يحصر إحباطاتها، ويلاحق الأماني والأحلام كفراشات الربيع في صدره، رغم شبه العزلة التي سوّر حياته بها. |
| ماذا لو كان صيّاداً/ نوخذه... هل كان قد عرف أسرار البحر، والموج، وهذه اللانهائية والعمق معاً في زرقته؟! |
| كل إنسان هو صيّاد.. لرزقه، ولحظِّه، ولمواهبه. |
| قناعة.. لا بد أن تستقر - في النهاية - داخل الإنسان... حتى يكسب منها: نقاطاً مضيئة كهذه التي تمتد من ((أبحر))إلى الميناء عبر امتداد الكورنيش. |
| * * * |
| * عندما يكون وحده في البيت.. يفلسف وحدته تلك بأنها: الغربة من داخل النفس. |
| وهو الآن يتلفّت، ويرصد هذه - الوجوه المتلاطمة كالموج... فيشعر - أيضاً - بالغربة، ولكنها هذه المرة: غربة من خارجه، وحوله، وتنعكس على واقعه وتعامله، وتُلوِّن مرئياته واحتكاكه اليومي. |
| إنه يلتفت بحثاً عن ((سحنة)) تنتمي إلى سحنته.. إلى طين هذه الأرض، ويكاد لا يرى أحدا يدفئ وجدانه ونفسه بالألفة.. لأنه لا يرى أحداً يعرفه، أو من أهل وطنه! |
| أبصر من مكانه الذي تباعد فيه عن الزحام: تجمعاً حول البقعة التي ثبّتت فيها ((بلدية جدة)) مجموعة ألعاب للأطفال، وكأنها خناقة. |
| دفعه الفضول الذي يصيبه مرة في العام، وركض نحو ذلك التجمُّع يستطلع الخبر. |
| وهناك سمع الحكاية: أطفال يلعبون، ويتسابقون للفوز بلعبة من تلك الألعاب.. واشتبكوا، فجاء الآباء والأمهات، و..... اشتبكوا، والناس: بين متفرج سلبي، ومحاول أن يفض الاشتباك ولو بأسلوب تلك (الفرعة)! |
| ضحك ((زياد)) وأصوات الآباء والأمهات المتشابكين: تشتبك بسمعه.. ولا صوت يتكلم اللغة العربية، ومن أراد أن يتكلم ليُشهد المتفرجين: كسَّر فيها حتى قتل سيبويه مرة أخرى! |
| وجاء البوليس.. وتفرّق الناس، وانتهت (الفرعة).. وعاد ((زياد)) إلى بقعة الرمل التي استقبلته وحيداً، وقد نسي في ركضه نحو الخناقة: جهاز تسجيله.. ولكنه لم يعثر عليه بالطبع. |
| لملم غيظه، وصمته، وهذه الحصيلة من نزهة الكورنيش، وقاد عربته خارجاً بها من زحام السيارات بصعوبة. |
| ـ ترى... أين يذهب الآن؟! |
| شعر بالجوع.. فانعطف إلى شارع معروف بتكاثر المطاعم فيه. |
| لا يرتاح لتناول وجبته داخل مطعم وهو بمفرده. |
| في المطعم أثناء انتظاره لتجهيز طلبه من الطعام.. كان يقف إلى جواره رجلان، ليسا من سحنته ولا طينته أيضاً.. صوتاهما يعلوان بجانبه: |
| * قال الأول: أخبرني الكفيل بأن أعماله تقلَّصت، وليست لديه فلوس.. فإذا رغبت في نقل كفالتي منه إلى شركة، أو أي مكان، فهو لا يمانع.. فهل تتحدث مع كفيلك عني؟! |
| ـ أجابه الآخر: ولكنَّ أعمال الشركة التي أعمل فيها مختلفة عن عملك، |
| * قال الأول: أرجوك... ممكن أعمل أي شيء، لا أريد أن أعود إلى بلدي! |
| ناوله البائع لفافة عشائه... ليخرج من المطعم مباشرة إلى عربته، متجهاً نحو منزله. |
| ـ معقول... وكيف لا يعيد الكفيل الأصلي عامله إلى بلده؟! |
| سمع أحد زملائه في العمل يقول ذات مرة: أن هناك أشخاصاً يطلبون عشرات التأشيرات من دول معينة، ويستقدمون عمّالاً منها، ويطلقونهم في البلد ((يسترزقون)) حسب شطارتهم، في مقابل أن يدفع كل عامل لهذا الكفيل مبلغاً محدداً في نهاية كل شهر!! |
| ـ ماذا جرى للناس؟! |
| سقط منه هذا السؤال على التراب وهو يقفل باب عربته، ويفتح باب منزله... يحمل لفافة عشائه. |
| * * * |
| * إنها الساعة الحادية عشرة ليلاً... عبق شجرة ((النيم)) التي زرعها في حديقة منزله: ينتشر عطراً.. يتسلل من النافذة القريبة. |
| نصحه البعض أن لا يغرس شجرة ((نيم)).. فأوراقها التي تتحَتْحت: غزيرة، وجذرها يمتد عميقاً إلى الأرض، وربما يضر بالعمق. |
| يحب رائحة ((النّيم)) أو شجرة الليل التي لا تمنح هذا العبق إلا في الليل. |
| خرج إلى الحديقة.. هذا المساء انحسرت الرطوبة، مفسحة لنسمة هواء عليل. |
| هذه المدينة لا تعرف الشتاء، ولا ينتعش فيها الربيع... لذلك هو ((يفر)) في مثل هذا الوقت من السنة إلى الخارج. |
| إنه الفصل الذي يحبه في أوربا: الخريف... وربما خالف الكثير من الناس الذين لا يحبون الخريف، والبعض سخر منه، لكنَّ الخريف: له همس بين أضلع ((زياد)). |
| ـ لا بد أن أبدأ في طلب الإجازة السنوية، وأرتب برنامج رحلتي. |
| أين يذهب هذا العام؟! |
| يحب ((باريس))... لكنه يخاف. |
| هذه العاصمة الفرنسية الجميلة/ عاصمة الثقافة ونور الفكر.. صارت موحشة بسبب تعدد حوادث الإرهاب فيها. |
| حثالة القرن العشرين: تطفح بهذه الظاهرة التي أخذت تتفشّى في العالم.. حتى في أوطان المسلمين الذين يقتلون بعضهم البعض بادّعاء الإصلاح، والعودة إلى الدين!! |
| جلس ((زياد)) تحت شجرة ((النيم))، وهمس: |
| ـ الإسلام العظيم... لم ينتشر بالإرهاب، ولا بقتل الأبرياء والأطفال والنساء. |
| بعض فتوحات الإسلام.. تحقق بالحرب التي لا تطعن في الظهر، ولا تقتل في الغفلة. |
| بدأ يكلم نفسه كالمجنون: |
| ـ ((وأنا مالي... اللهم احفظ لنا أمننا. |
| طيب... أروح فين؟!.. بهوت بالدولار الإمبراطور، والسعر نار.. ولو أنني أشتاق كثيراً إلى الجبل، وشجرة الأرز، وشلالات المياه هناك.. وغزل الطبيعة للإنسان. |
| أروح......... هناك (!!)، لا، لا، لا... صارت الإجازة ((هناك)) شيئاً مقرفاً أولاً، ثم مُتعباً))!! |
| أجّل خياراته إلى الغد، والأيام القادمة. |
| الليل: يحرره من السأم والقرف.. وإن كان يكرّس لديه: الهواجس، ومحاصرة التوقعات في يومه الجديد. |
| في مكان ما من أرض الله الشاسعة: سيختفي شهراً، أو أقل.. حسب الصحبة التي تنبعث له كالحظ. |
| في السفر، والركض بين الأمكنة: يتجدد نفسياً.. يشعر أن هذه الانطلاقة لا تنحصر في ساقيه فقط.. بل في أفكاره، ورؤيته، وحتى في وجدانه الذي يصاب أحياناً بالتكلُّس. |
| البعض من الذين يواظبون على السفر في الإجازات والصيف.. ينحصر اهتمامهم في التسوُّق/ كل النساء.. وفي السهر، و............/ كل الرجال. |
| والبعض: يفلسف السفر بالمتعة فقط... وتفسير المتعة يختلف من شخص لآخر! |
| الناس في السفر: يعرفون أنفسهم من الداخل لفترة محدودة.. وهو أحد هؤلاء: يعرف نفسه، بل ويجدها... ربما لأنه طوال العام ينغمس في العمل، ويغمسه الفراغ فيه. |
| لكنَّ ((زياد)) لا يعاني من الفراغ... لديه القدرة على حشد وقته بما يعتقد أنه يستفيد منه، حتى لو كان: تأملاً، وحواراً مع نفسه! |
| يبتسمم وهو يتذكّر كلمات ابنة عمه/ أخته بالرضاعة، وهي ترفع صوتها الحاد في سمعه وتقول: |
| ـ ((والله راح تتجنن يوماً ما.. انت ما تزهق من الرغي مع نفسك، ولا من وجهك على المراية... هبْ عليك يا شيخ، والله ما أتمنى أسلوبك هادا.. في رأي إنه: بلادة)). |
| عودته هذه الخدينة على الصراحة، و((التلبيخ)) له كلما رأت ما تظن أنه من الأخطاء البشعة. |
| * * * |
| * عيناه تومضان بالبلل.. تماماً كانعكاس الضوء على ورقة شجرة غسلها المطر. |
| ليست هناك في عمق عينيه: صورة محدّدة، لكنَّ رؤيتهما واضحة من وضوح تفكيره. |
| ـ قال: ((وليكن مثل هذا الجنون الذي يثير أختي... إنّ قلة من الناس تستمتع بهذا الجنون العجيب)). |
| أحياناً... يصبح الوضوح مع النفس، وبالتالي مع الناس: جنوناً في تعريف الذين تعوّدوا على الغمغمة، واللجلجة... هو لا يغمغم، بل يصرخ، يتحدث مع عقله ووجدانه بصوت مرتفع.. قد يسمعه مَنْ حوله، أو مَنْ يعاشره. |
| وفي طريق العودة من نفسه كل ليلة... يكون جهاز تكييف غرفة نومه في أعلى برودته، وإلاّ جافاه النوم.. ويسحب ((اللحاف)) فوقه، يتغطّى به كاملاً، وينام... وقد فعل! |
| * * * |
| (5) |
| * جلس على الكرسي الملاصق لمكتب رئيسه في العمل، وبيده ورقة. |
| ـ قال له: جئت أطلب موافقتك على منحي إجازتي السنوية. |
| رفع رئيسه رأسه عن الأوراق، ونظر إليه من فوق نظارته ذات النصف زجاجة، وقال له: |
| ـ لكننا لا نطيق فراقك شهراً.. وأنت موظف ((شغِّيل)) وكفء، وعملك يتعطل. |
| * أشكرك على هذا الإطراء.. لكني في حاجة ماسّة إلى أن أفارق نفسي قليلاً... فقد مللت من عشرتها أحد عشر شهراً، وأريدها تنطلق بعيداً عني، وعن أفكاري المعتادة التي دائماً ما نتجادل عنها أنا ونفسي. |
| ـ لكنَّ الإدارة تعاني من نقص في الموظفين والعاملين... والميزانية لا تسمح بأن نملأ الوظائف الشاغرة، وعلينا أن ننجز أعمالنا بهذه الإمكانات المحدودة. |
| * أرجوك... لو بقيت أكثر من ذلك، فلن تستفيدوا مني شيئاً.. سيكسوني التبلُّد، ويفيض القرف مني، ويزداد رفضي لأشياء كثيرة دهستني بعجلات السأم... ((اللي نصبح فيه، نمسي عليه)). |
| ـ حسناً... وأين وجّهت بوصلة سفرك؟! |
| * صدّقني.. لم أحدد حتى الآن، فهل تقترح؟! |
| ـ ربما لأنني ألغيت سفر إجازتي هذا العام.. لم أفكر في المكان، لكنَّ الأمكنة تنادي أصحابها - كما يقولون - وإجازة سعيدة. |
| كأنه يلتصق بنفسه... هو الآن ذلك الطفل الذي انبعث من أعماقه، يريد أن يتجدد... أن يركض، بل ويرفس، وينطلق إلى حبة مطر تُرقرق هذا الجفاف في وجدانه. |
| ترى.. إلى أين يهرب من هذا الجفاف، والصمت، والوحدة؟! |
| إلى الغابات، أم إلى الأنهار.. إلى الأمطار، أم إلى زقزقة العصافير؟! |
| ليس شاعراً، وإن تمنّى وحاول ذات مرة أن ((يُشَخْبط)).. وبعد أن أعاد قراءة ما كتبه، قال لنفسه: |
| ـ ((ربنا اسمه: السّتير... حذار أن يراها جنس مخلوق))! |
| ولعله مزّق الورقة.. فهو لم يعد يذكر! |
| الآن... كل شيء في داخله يتقافز، ((ينطنط)).. يغرق ويطفو. |
| ـ ((ولكن... إلى أين - يا واد يا زياد - إلى أين))؟! |
| في لحظة - لا قبلها ولا بعدها - سيكون هناك... أين؟! |
| إنه حتى الآن لا يعلم.. ويضحك وهو يستعيد مشهد ((عادل إمام)) في مسرحيته، يقول: ((أنا هناك.. تعالي هناك))... وهو لا يعرف إلى ((هناك)) أين؟! |
|
((زياد)) يفرح بالسفر.. فهو طفل كبير وربما لأنه ((بيتوتي)) لا يحب أن يخرج من بيته كثيراً.. يسكن مع نفسه، فإذا حان موعد السفر: انطلق في.... تلك اللحظة! |
| * * * |
| * الصدأ... الصدأ... الصدأ: |
| إنه يغمر كل نفسه... بل وشعر بهذا الصدأ يؤثر في أعضاء جسده.. فهو - تارة - يشكو من صداع، وتارة يشكو من آلام عظامه.. وفي زوايا نفسه: أشياء ترابية علقت بضلوعه، ولا بد أن يزيحها وينظف ضلوعه... فإذا نظَّفنا ضلوعنا - أي مشاعرنا - نجحنا في تنظيف أفكارنا من تلك الأشياء القبيحة: كالحسد، والبغض، وهمّ مراقبة الناس الذي يقتل! |
| هذه العمارات الشاهقة التي بنيت على امتداد المدينة، وحتى في شوارعها الخلفية... لم تعد تتصف بمعنى: السكن.. بقدر ما صار القاطنون فيها يعانون من الضوضاء والصخب في الشوارع، ومن تلوث الجو، أو البيئة كما يقولون، ومن المجهول كلما قاد رجل سيارته.. فالخارج من بيته: مفقود، والعائد إلى بيته: مولود... فالحوادث بلغت إلى إحساس الناس، وتفوقت على مضمون الخبر! |
| ضياع... يختلط أحياناً بهذا ((الإسفلت)) الأسود، المحفّر في بعض الشوارع.. كأنه يؤثر في تشكيل تماوج النفس الإنسانية. |
| ـ ((يا سيدي.... الرزق هو الأهم، وهو من عند الله عز وجل)). |
| همس ((زياد)) بهذه العبارة في قفلة مشواره من إدارته إلى بيته... مروراً بما التقطته عيناه من شوارع، ومبان شاهقة، وإسفلت لا يكون ((طريقاً)) في بعض الأحيان. |
| خطوة إلى داخل بيته... تُرى: أي الخطوات يتذكّرها الإنسان، أو أنه لا ينساها أبداً؟! |
| خطوة مؤلمة في حياة ((زياد))، لن ينساها أبداً مهما مضى عليها الزمان.. تلك الخطوة التي دفعت قدميه إلى داخل بيته، بعد أن دفن جثمان أمه وعاد من المقبرة، وكأنَّ الدموع جفّت في عينيه.. وكان يحتاج إلى البكاء ليخفف مصابه... واستمر في ذلك الذهول حتى مساء اليوم الآخر، حين تفجَّرت الدموع من عينيه، ولكنها استقرت في قلبه. |
| دخل غرفة نومه: منتشياً... وعليه أن يبدأ في تحديد ((النقطة)) التي ينطلق إليها في السفر. |
| أخرج جواز سفره من حقيبة يده التي تشهد على كثير من رحلاته، وجولاته. |
| استمتع كثيراً.. لكنه كان يفرُّ من العبث، لعله كان يبحث عن: غناء روح، فيصطدم بوجوه كالأظافر، وبنفوس كالشهب... وهو الذي يهدهد العاطفة بين جوانحه دون أن يعلن عنها أو تكشفه من الداخل. |
| هناك ((صور)) أخرى.. أضافها إلى ((ألبوم)) حياته، أو ذكرياته.. بعضها بهتت الملامح فيها وبعضها الآخر: يكاد يخرج من الإطار أو الألبوم، ليتحدث معه! |
| ـ ((أوه.. الألبوم، أين هو))؟! |
| اشتاق إلى تلك الصور داخل الألبوم التي: أسعده بعضها، وأحزنه بعضها، واستقر بعضها في حشاشته لا ينمحي أبداً! |
| فتح ضلفة الدولاب المثقل بالكتب، وبأوراقه الخاصة، وبعدة ألبومات حفظ صور ذكرياته فيها. |
| أخرج الألبومات، ووضعها على ((الكومدينو)) بجانب السرير.. حتى يحين موعد لقائه مع نفسه ((عندما يأتي المساء، ونجوم الليل تظهر))! |
| * * * |
| * وأخيراً... حل موعد الإجازة السنوي. |
| نعم... إنه يحتفل به، ويشعر حين ينطلق إلى السفر كأنه: صاروخ يكتشف القارات، أو كأنه قوس قزح ينتشر في سماء العمر. |
| إنه يخرج من هذا الروتين الممل لبرنامج يومه الذي تعوّد عليه حتى البلادة. |
| لا شيء يستطيع أن يفعله هنا.. يقوم به، أو يجلس، أو يطير.. الأشياء مدجَّنة في التعوُّد الصامت حتى الخرس. |
| كل صباح.. يستيقظ من نومه على منبّه الساعة، لا يفطر - كما تعوّد أيضاً - يخرج من بيته، يدخل سيارته، يخرج منها، يدخل الإدارة، يخرج منها، يدخل مطعماً، يخرج منه، يدخل بيته. |
| نادراً ما تقوده قدماه إلى ((شلة)) مجتمعة في بيت صديق أو زميل في العمل.. يؤجل ذلك إلى: مناسبة زواج، أو عزاء، أو حتى ((طهور))... الواجب لا بد أن يقوم به، ولا يبقى وقتاً طويلاً. |
| هذا اليوم يبدو سعيداً بموافقة رئيسه على الإجازة.. عليه أن يحتفل. |
| قرر أن يذهب إلى زميله في العمل ((أسعد)) وشلة بلوت، والتقطيع في خلق الله... من زمن بعيد لم يُرغم نفسه على سهرة نميمة، فهو ينفر من هؤلاء المشّائين بنميم. |
| لكنه سيذهب الليلة إلى دار ((أسعد)).. تهفُّه نفسه على ((صكة)) بلوت، و((الكوجراتي)) المشهور به مجلس زميله أسعد، فهو لا يقدم الشاي ولا القهوة.. فقط ((الكوجراتي)) الذي يقيم له دعاية في سهرته بأنه: يُصفِّي الدم، ويخفّض الكلسترول! |
| ـ ((يا واد يا زياد... مالك وللنميمة، وتضييع الوقت في البلوت ونرفزته))؟! |
| لا.... سيذهب، خمسة تفاهة لا تضر.. خاصة وأنه يعيش اليوم وبعض الليل في وحدة، وصمت، ومخاطبة الجدار... وهو الليلة يحتفل بقرار الإجازة، فلا بد أن يغتسل قليلاً من الصمت، والوحدة ليكون ((فِرشًّا))، حتى لو غضب أنصار الضاد! |
| كأنه الليلة سيخرج من جحره الذي لا يزوره فيه أحد إلا نادراً، ولا يبرحه هو إلاّ نادراً... |
| لا بأس بليلة واحدة يُسخّن فيها للرحلة القادمة بعد أيام. |
| بعد أيام؟!! |
| نعم... غداً سيذهب بالجواز إلى السفارة لأخذ التأشيرة، ثم يحجز ويقطع تذكرة. |
| ولكن... إلى أية سفارة سيذهب؟! |
| ومادام هناك تأشيرة... فلا بد أن الوجهة ستكون أوربية، فأكثر الأقطار العربية - والحمد لله - لا تطلب تأشيرة لدخولها.. وإن بدأ البعض في إعادة التأشيرة بعد حوادث الإرهاب، والتخريب... أي أنه: تخريب في الوشائج وصلة الدم بين العرب فيما بينهم. |
| مع حلول المساء... قاد عربته إلى منزل زميله ((أسعد)) وقد تكاثرت السيارات أمام باب فيلته.. ربما عدد السيارات أكثر من عدد الزائرين في الداخل، باعتبار أن الكلمة الساخرة تقول: لا ممكن أن يقود الشخص سيارتين في وقت واحد.... لو تمكّن))!! |
| دلف إلى الباب الداخلي، وبمجرد أن دفع به.. اندفعت إليه أصوات ((البشكة)) المختلطة، المتنافرة كالعادة. |
| كان لا بد له أن يرفع صوته الخفيض دائماً، حتى يسمعه مَنْ في المجلس: |
| ـ السلام على من اتبع الهدى. |
| البعض التفت إليه، سمعه فردّ عليه السلام.. والبعض الآخر سادراً في النقاش الصارخ، ولاحظه زميله صاحب البيت ((أسعد)) فقفز من مقعده مرحِّباً به: |
| ـ ((هلا والله... عاش مين شافك أيها الانعزالي))!! |
| * ((هلا بيك.. ما هذا الصخب؟!... يا أخي/ كل مكان أذهب إليه صار صاخباً، لذلك.. لم يعد أحد يسمع، لأن الكل يتكلم))! |
| ـ سمعت أنك قررت السفر في إجازتك السنوية... أين ستتجه؟! |
| * صدّقني لم أقرر بعد.... الليلة - في حواري مع نفسي - سأقرر إن شاء الله. |
| ارتفع صوت أحد الأفراد ((البشكة)) أعلى من كل الأصوات، قائلاً: |
| ـ يا جماعة.. من فضلكم، خمسة صمت.. حتى ننظم الكلام. |
| * رد واحد آخر من مقتعدي الأرض في حلقة ((البلوت)): ((نظم يا خويا، واحنا مالنا... وإلا أقول لك: تعال العب بلوت، تِنْجلي.... قال ننظم قال))!! |
| ـ أصرّ المتكلم على توصيل ما يريد قوله.. فوَاصَل كلامه: يا جماعة... الجرائد تكتب كل يوم ولا أحد يردّ إلا مَنْ رحم ربك، وعلى سبيل المثال: المناهج والمقررات الدارسية.. والله إني أشفق على حال ابنتي الصغيرة في أولى ابتدائي، وهي تحمل حقيبة ثقيلة على جسمها الصغير وأيضاً على عقلها الصغير واستيعابها... فأين هو التعليم المتطور.. هل هو في كثرة المناهج؟! |
| اختلطت الأصوات ثانية، عادت إلى التصادم.. الكل يتحدث. |
| تسلل ((زياد)) من المجلس في انشغال ((البشكة)) بالصراخ.. وركض إلى عربته متجهاً إلى بيته... وهو يزفر: |
| ـ ((أفْ... علشان كده لن يتفق العرب، صاروا أكثر من الهنود))! |
| * * * |
| * لم يُبدِّل ملابسه بعد... فجأة تحوّل البيت إلى ظلام دامس. |
| مرة ثالثة في هذا اليوم والليلة.. يُقطع التيار الكهربائي، احتفالاً بحلول فصل الصيف. أخذ يتلمس طريقه إلى المطبخ بحثاً عن شمعة تضيء هذه العتمة. |
| ـ ((الله... ما أجمل السهرة على ضوء شمعة، إنه عودة عصر النقاء، والبساطة، بدون تعقيد الحياة))! |
| ولكن... أي نقاء وبساطة في هذه الرطوبة التي تنقع الناس؟! |
| إذن... الفرار، إلى حيث المناخ البارد، أو الربيعي.. إن أمكن!! |
| * * * |
|
|
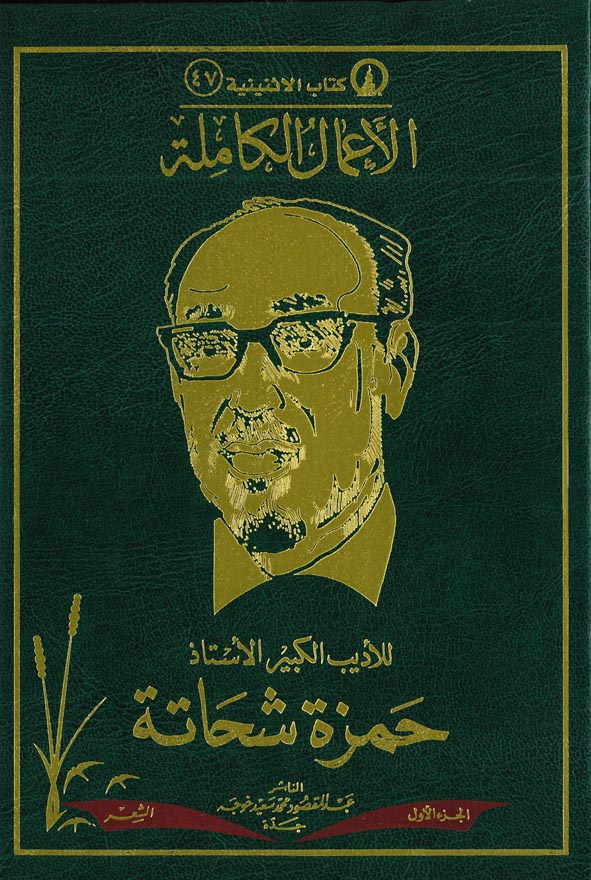
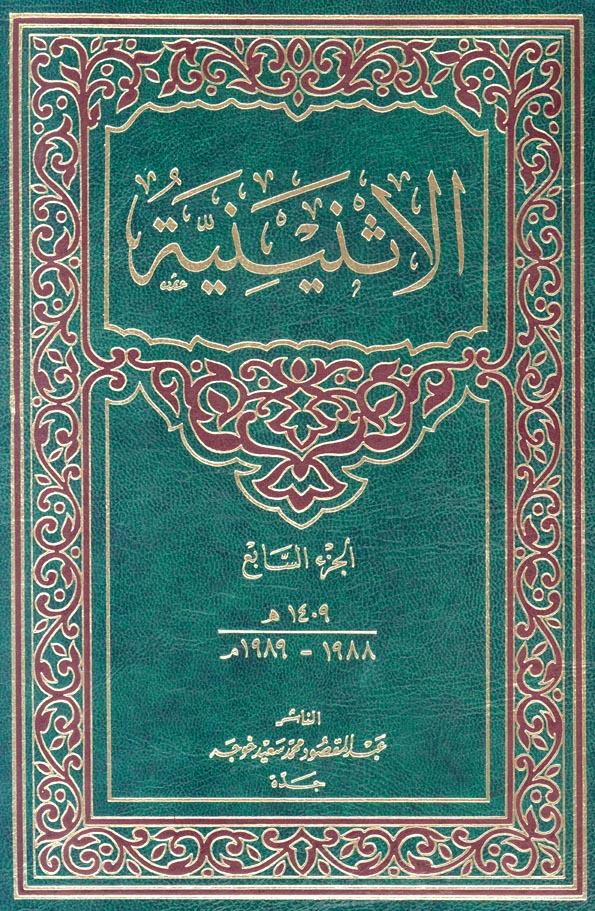
 شارع عبد المقصود خوجة
شارع عبد المقصود خوجة 00966-12-6982222 - تحويلة 250
00966-12-6982222 - تحويلة 250




