| اليوم ما في فطور.. |
| ولا في كتاب.. الين يجي يحى بك |
| عندما قالت أمي عن الاضاءة الساطعة في الزقاق |
| :ـ. القابْلة رايح يكون منوِّر اكتر... زي النهار... وتضرب فيه (المُزّيكة). |
| أدركت على الفور أن يوم (الطهور) قد تقرر غدا. |
| وما كدت أفرغ من السلام وتقبيل أيدي الضيوف، ومنهم ذلك الذي قالوا انه (أمير) |
| وقالت أمي انه الذي استلم مدينة حلب في الشام من (الباشا التركي)... حتى أخذت التمس الانطلاق إلى (فوق)... و (فوق) هذه تعني المجالس، والمطبخ الذي لابد أن أجد فيه (أمي باجي) و (مَنَكْشة) وربما أمي أيضا. وما توقعتهُ كان هو الواقع، فقد كان الجميع ومعهم أمي نفسها منهمكين في تجهيز العشاء الفاخر الذي سيقدم للضيوف ومنهم ذلك الأمير... |
| وبالمناسبة، لابد أن أذكر، أن ألوان الطعام التي تعد للعشاء الفاخر للمدعوين والمدعوات ـ في تلك الأيام ـ كانت متعدّدة... أو متنوعة، إذ التَّعَوُّد عليها كان من بقايا الحكم العثماني، الذي استمر في المدينة المنورة بالذات منذ ذلك اليوم الذي استلم فيه السلطان سليم العثماني مفاتيح الحرمين الشريفين من الخليفة العباسي (محمد المتوكل على الله الذي نزل له عن الخلافة) وبذلك جعل سليم نفسه أول خليفة عثماني للمسلمين. وهذا مع ما يسجله التاريخ عليه من تصرفات القهر والقسوة والبطش، إذا بدأ تطلعه إلى السلطة بخلْع أبيه السلطان بايزيد الثاني، ثم بقتلِ إخوتهِ حَسَماً لاحتمال تآمرهم وثورتهم عليه... وما كاد يتربع على عرش السلطنة. حتى عمد إلى التعبير عن مدى عدائه (للشيعة) بقتل أربعين ألفاً منهم في الأراضي التركية، ثم هاجم (شاه) فارس وانتصر عليه انتصاراً ساحقاً أسفر عن استيلائه على (ديار بكر) و (كردستان) وغيرهما من أراضي الفرس. |
| ولم تكد تمضي ساعة من الزمن حتى كان (محمد علي) و (اسماعيل)، يتناولان الأطباق من الباجي ومنكشة، طبقاً وراء آخر... ويهبطان بها إلى الديوان أو هو القاعة الكبيرة. وهذا بعد فرش (الصُّفرة الطويلة المزخرفة أو المطرزة) وعلى امتدادها الأطباق، والملاعق والشوك والسكاكين... وهناك في أركان القاعة اللمبات الكبيرة، ذات عدد من الفتايل، تحيطها زجاجة طويلة، ويحيط بالزجاجة أيضا غلاف زجاجي منفوخ البطن، ولكنه أحمر اللون، شفاف، ومزخرف بزخارف جميلة من الزهر الملون المُعَشق على الزجاج بأسلاك أو ما يشبهها من الذهب. |
| كنت أرى كل ذلك من نافذة صغيرة، هي واحدة من جملة نوافذ تطل على الديوان أو القاعة من المجالس... ولا ننسى ما يسمى (الجِلا)... الذي يُشبه أنبوبة بالغة السعة تمتد من القاع إلى السطح، وهي التي يتسرب منها الهواء، ليس إلى القاعة أو الديوان فقط، وإنما إلى المجالس أيضا عبر تلك النوافذ، ومع الهواء ضوء الشمس في النهار... ومما قد يحسن أن يذكر، ان (هذا الجِلا)، يمكن إغلاقُه، فيمنع الأمطار، والغبار، كما يمنع العصافير والحمام من الدخول إلى القاعة أو إلى المجالس... أما كيف يغلق، وكيف يُصنع، فسؤال يوّجه إلى اخواننا المهندسين الذي أسمع انهم يفكرون في العودة إلى نظام البناء القديم... واعتقد أن في المدينة، حتى اليوم قصوراً من أملاك الصافي وآل المدني وآل هاشم، وآل أسعد، وآل الرفاعي ماتزال على ما كانت عليه منذ أجيال، يمكن أن تعطيهم فكرة عن قصور وبيوت تلك الأيام، التي لم تكن تعرف المكيّفات، لا في الصيف ولا في الشتاء. |
| من تلك النافذة الصغيرة المطلة على مهرجان الضيافة في القاعة، رأيت وسمعت الكثير من الأحاديث التي كانت تدور بين الرجال... ولأن أمي كانت مشغولة بعملها في المطبخ مع الباجي و (مَنَكْشة)، فقد ظللت (أتفرج) ولا يزعجني أحد... ولكن كان مما سمعته أيضا وهو ما سمَّرنى على النافذة، صوت مُغَنٍ، وعزْفٌ على العود... ولم أكن أجهل العود في الواقع إذ كنت أرى الخالة (عزيزة عثمانية) تحتضنه وتعزف عليه وتغني بصوتها الجميل، ولأنها كانت ترى انجذابي اليها واعجابي بها ـ وقد كانت رائعة الجمال ـ فقد كانت ـ رحمها الله ـ تصر على أن أكون إلى جانبها، وأن (أصفق مع من يصفقن من الحاضرات) وفي الجانب الآخر من مجلسها تلك العجوز التي يسمونها (مُولَّدة) ـ والجمع (مواليد)... تضرب على (الطار) (أبوشناشن) ولا أدري ان كان مايزال هذا هو اسمه حتى اليوم... |
| فالذي رأيته من موقعي في النافذة، كان شيئاً جديداً لأنها المرة الأولى التي أرى فيها رجلاً يغني... وآخر يعزف على العود، وثالثاً كبير الكرش، دائم الضحك، والضجيج بالآهات وكلمات الاعجابب وهو الذي يمسك (الطار أبو شناشن)... |
| أدركت مما شاهدت، ان (عمي) يقيم هذا الحفل، لهذا الأمير بالذات، لأن الحفاوة به كانت موجهة اليه من الجميع... وكان بعض الحاضرين يناديه أو يسبق الكلام الذي يوجهه اليه بكلمة (سيدي) بينما كان هو بالغ التواضع... يعتذر عن سماع الكلمة بكلمة (استغفر الله) وكلمة (سيدك ربّك). |
| ومع ان المشهد كان مُسلياً، والأغاني، تتلاحق... مع عزف العود، ودق الطار أبو شناشن فلا أدري كيف غلبني النعاس... واستسلمت للنوم في مكاني... وأحسست بمن يحاول أن يحملني دون أن يوقظني من نومي... وتخابثت، فلم أنهض وامشي... وكم كانت دهشتي بالغة، حين أحسست أن الذي يحملني على كتفه، ويصعد بي إلى الطابق الثالث، ويضعني برفق ما بعده رفق على فراش (الكريولة) المزخرف الفخم، هو (عمي) زوج أمي... وحين فتحت عينتي، ورأيته لم أملك إلا أن الفّ ذراعي حول عنقه... وأن أقبله... وكانت أمي خلفه بالضبط... وقد أثر فيها المشهد كله.. فأسرعت تحضنني وتقبلني... ورأيت خلفها (أمي باجي) و (منكشة) أيضا وفي يد كل منهما لمبة علاقي من ذات الفتيلتين.. علقتاها في الجدار، على مسمارين معدين من قبل... والذي لم أفهمه انهما كانتا تبكيان... وترددان في همهمة تكاد لا تسمع (ما شاء الله... ما شاء الله). |
| وما دمتُ قد وُضعتُ في هذه (الكَرْيولَة)... فمعنى ذلك أن الطهور حاصل غدا دون أي شك... ومع ان أفكار (الهرب)... واللجوء إلى المزارع... والعمل وراء حمير السواني... أو حمل (زنبيل) الخضرة للناس، لم تتلاش من ذهني حتى في هذه اللحظات المفعمة بما لا يخطر على بال من العطف والحنان والحب، فان ما اتجه اليه كل تفكيري الآن هو ذلك الرجل الذي قالوا انه سوف يقوم بعملية (الطهور) واسمه (يحي بك)... وقد اضافوا اليه انه (سَرْ طبيب) المستشفى العسكري. ولم أعن بمعرفة معنى (سَرْ طبيب) هذه، ولكني تأكدت انه ليس ذلك المزين الذي يقطع ويكبس بالبن والملح... وكلمة طبيب توحي بأنه (دكتور) مثل عمي ومما زادني شبه اطمئنان ورضى، انه من زملائه وانه (يحي بك).. ولقب (بك) هذا معروف ان الذي يلقب به لابد أن يكون شخصاً مرموقاً محترماً. ولا أدري كيف لم يخطر لي ببال أن أسأل محمد علي أو اسماعيل عن الرجل، الذي لا أشك في انه كان بين ضيوف تلك الليلة. |
| وبعد أن غادر الجميع الغرفة وكنت مغمض العينين متظاهراً بالنوم، أخذت أتأمل فراشي على هذه الكَرْيولَة... كان شيئاً ممتعاً مريحاً للغاية وضوء اللمبتين العلاقي، وإن كان ضعيفاً لأنهم خفضوا ارتفاع الفتيلتين، الا انه أعانني على رؤية هذه الزخارف التي زخرف بها الفراش والوسائد... وشْيْ ومطرَّزات لأزهارٍ وورود ملونة، وبعضها موشى بما يسمى (التّرتِر) الفضي والذهبي يلتمع تحت ضوء اللمبتين... مما جعلني أتذكر الكثير من الحكايا التي كانت تحكيها لي أمي أيام كنت أنام إلى جانبها، في ليالي الرعب في حلب، ثم في السطح تحت ضوء القمر في بيتنا في زقاق القفل، بل وتلك الحكايات التي كنت اسمعها من (بدرية).. وكلها أو أكثرها عن السلطان أو بنت السلطان، التي كانت دائماً تنام على فراش وثير من الحرير، وسرير من الذهب والفضة وحولها الجواري، وفي أيديهن المراوح من ريش النعام والطاووس، يروِّحْن عنها ما حولها خوفاً عليها من الحر، ومن الذباب والبعوض... وحولها دائماً من يقوم برش ماء الورد والزهر، ثم تلك الجارية ذات الصوت الجميل التي تردد أهازيج النوم ومنها ما لعلي أحفظه حتى اليوم لكثرة ما سمعته تردده أمي، أو (بدرية)... أو غيرهما ممن كن يتطوعن بالحكايات قبل النوم. |
| مثل: (نينّي.. نينّي نِينّيِ بالتُّركي.. ما أحلاكي وما احسنكي |
| أحمد باشا خدامِك... يشيل لك بُقشَة حمَّامِك |
| ويحصانه يمشي قدّامك... |
| نينّي... نيني الخ..) |
| ولابد أن هذا الترف في الفراش، وذكريات حكايات بنت السلطان وأهازيج نومها قد أودعتني للنوم فعلا... وفي ذهني بنت السلطان تلك، التي كانت تتمتع دائماً بمثل هذا الترف الذي أتمتع به أنا الليلة... |
| أما غداً والطهور... ويحي بك... فقد غمرت الجميع مشاعر الارتياح إلى هذا النعيم. |
| * * * |
| كانت العادة المتبعة، ان توقظني من النوم، (أمي باجي)... وتأخذني إلى مائدة الافطار، حيث آكل نصيبي من (الشُّريك) والجنبة (الكَشْكَوان)، وجرعاتٍ من الحليب الذي لا أدري لم لا أحبه ـ وحتى الآن ـ ومُربَّى المشمش التي تصنعها أمي... أو (أمي باجي)... ولكن هذه العادة اختفت في صبيحة هذا اليوم الذي وجدت نفسي فيه على ذلك السرير الوثير. |
| ايقظتني أمي بنفسها... ولكن دون أن تدعوني إلى مائدة الافطار... وقالت: |
| :ـ. اليوم ما في فطور... ولا في كتّاب.. إلِينْ يِجي يحي بك. |
| :ـ. يعني الطهور ياففم؟؟ |
| :ـ. أيوه يا حبيبي... لازم ما تفطر... ولكن لازم تروح بيت الما... وتتوضا... وأنا اللي أغسل لك وجهك بالصابون.. |
| :ـ. هوه الطهور رايح يكون في وجهي يا ففم ؟؟ |
| :ـ. سوىّ نفسك ما تفهم... ؟؟؟ لا تكتر كلام.. هيا قوم روح بيت الماء.. وأنا جيه وراك.. |
| وتم لها كل ما أرادت... من غسيل وجه وتنظيف جيد ما بين الفخدين... ولكن منعتني من ارتفاق السروال.. |
| :ـ. طيب والسروال يا ففم؟؟ |
| :ـ. السروال بعدين... |
| :ـ. بعد الطهور؟؟؟ |
| :ـ. ايوه بعد الطهور. |
| :ـ. فهمت.. عشان لا يتوسخ بالدم.. موكدة؟؟ |
| :ـ. كده.. هيا اخلص... يحي بك لابد انه مع عمك في الطريق. |
| كان الوقت بعد شروق الشمس... عندما صدحت الموسيقى العسكرية... فملأت قلبي رعباً ما بعده رعب... وزاد من ارتباكي وخوفي دخول (أمي باجي) وهي تلهث، تعباً لتصعيدها في السلالم إلى الدور الثالث... وما كادت تقف في الغرفة حتى قالت بالتركية ما فهمت منه (انهم جاؤوا..) |
| وبالفعل ما هي إلا لحظات حتى رأيت عمي ببزته العسكرية... يدخل متقدماً رجلاً طويلاً عريض المنكبين وبكامل بزته العسكرية أيضا وخلفهما انسان يحمل أقنعة بيضاء أخذ يلبسها يحي بك... ولبس هو أيضا أحدها... وقد حرصوا جميعاً على أن يعلقوا على وجوههم ابتسامات ربما ليبعثوا في نفسي طمأنينة وارتياحاً... والواقع أن الذي ملأني رعباً حقيقياً هو ذلك الذي كان يمسك بيده قطنة صغيرة، وحقنة... |
| اداروني وجهاً لقفا... فما استطعت أن أرفع صوتاً ببكاء أو نحوه.. الواقع أن صوتي قد فقد تماماً ووجهي إلى الوسادة... ولا أدري ما الذي فعلوه بعد ذلك... |
| بل لا أذكر أين ذهبوا ؟؟؟ عندما استيقظت كان الوقت بعد الظهر... وكانت أمي إلى جانبي على السرير... كنت أشعر بظمأ شديد... فطلبتُ ماء... ولم أطلبه بصوتي... وانما باشارة من يدي إلى فمي. |
| ولكن حتى الماء جاءوني به بحساب..... لم تزد الجرعة عن ملعقة شورباء.. |
| ثم ـ مرة أخرى ـ ذهبت في نوم عميق. |
| كان السؤال الذي لم أتوجه به إلى أمي أو إلى غيرها هو: (هل تم الطهور.. أم انه سوف يتم في الليل... أو غداً...... بعد الذي شاهدته في الصباح... وبعد تلك القطنة والحقنة في يد الرجل، لم أعد أفهم شيئاً مما يدور حولي.. |
| واضيئت اللمبتان العلاقيتان... وكانت أمي باجي، هي التي اشعلتهما.. وجدت في نفسي الجرأة لأسألها |
| :ـ. ايش اللي سار يا أمي باجي؟؟ |
| التفت اليّ.. ووجهها تملأوه ضحكة عريضة وهي تقول: |
| :ـ. سُنَّتْ خلاص... |
| وقبل أن تتم جملتها... دخلت أمي... وانكفأت عليّ.. احتضنتني... وهي تقول: |
| :ـ. خلاص يا عزيز أنت دحين رجَّال... وسيد الرجال... |
| ومرة أخرى صدحت الموسيقى في الشارع... ولكنها في هذه المرة صدحت أغنية تركية كنا نرددها وان كنا لانعرف معاني الفاظها وهي تقول: |
| اسكدارا كَيدركن... بير منديل بولدوم |
| منديلنِنْن ايجِينْده لوكُوم دولدورمُ |
| وعرفت، معناها: فيما بعد: |
| عندما كنت أمشي في إسكدار ـ وهي منطقة في استمبول ـ وجدت منديلاً... وقد ملأت المنديل بحلوى الحلقوم.. |
|
|
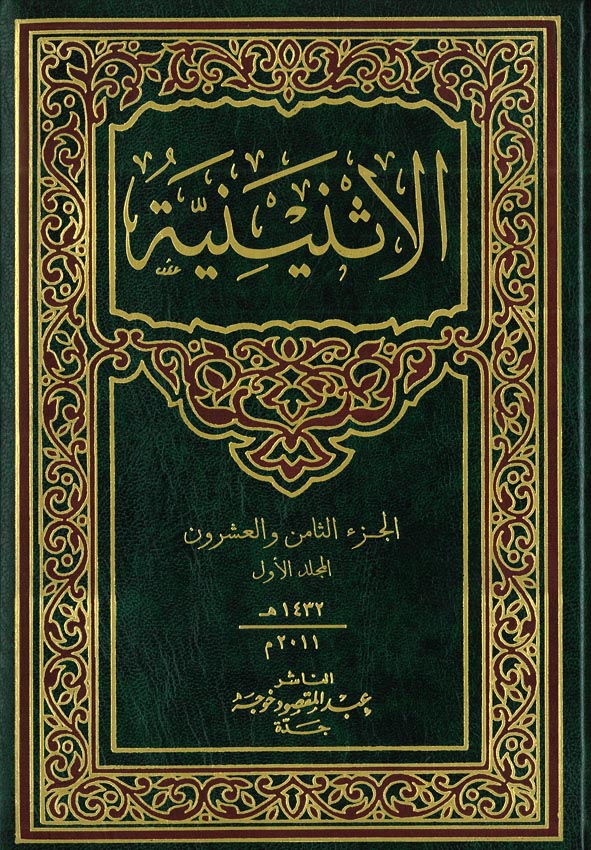
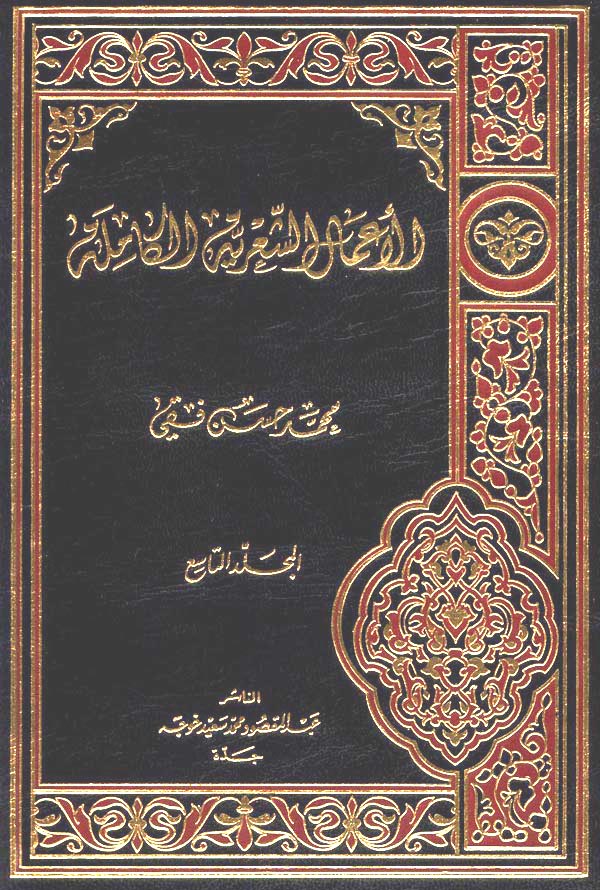
 شارع عبد المقصود خوجة
شارع عبد المقصود خوجة 00966-12-6982222 - تحويلة 250
00966-12-6982222 - تحويلة 250




