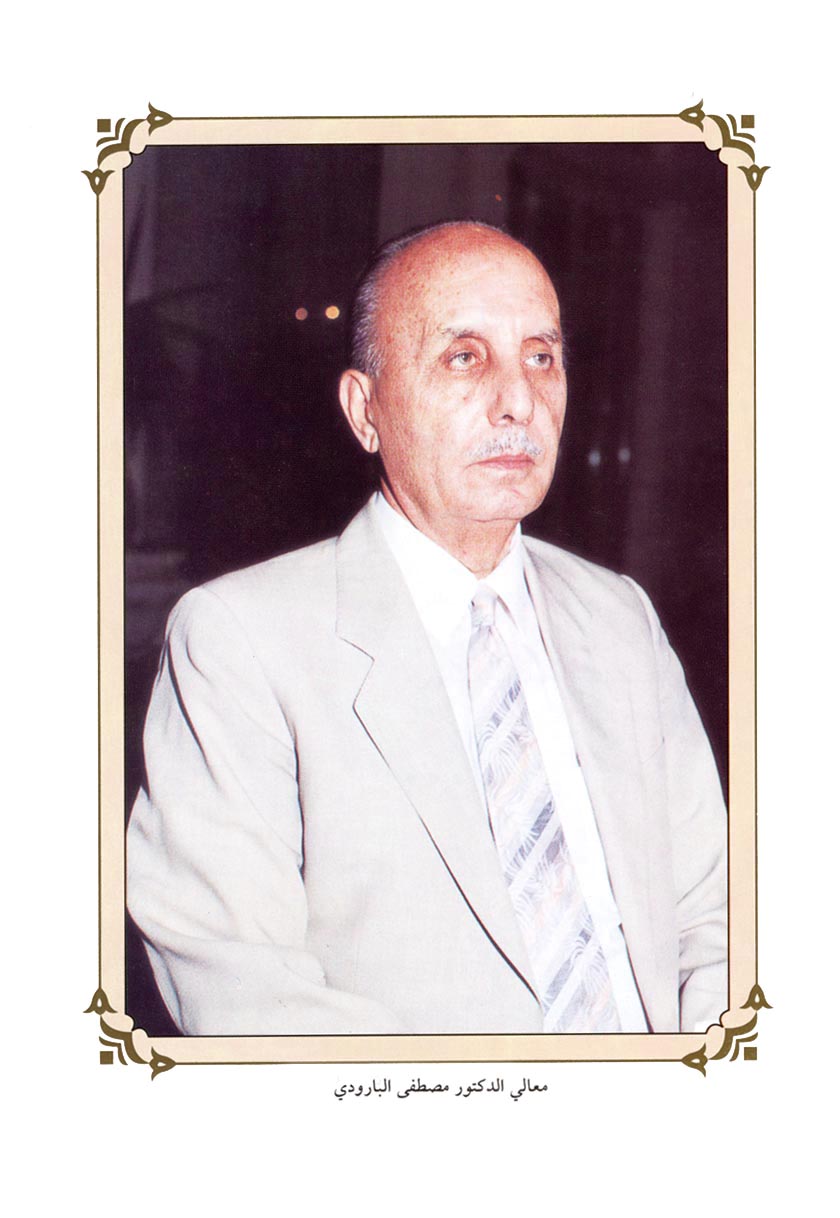| الحكم ـ على المذهب المالكي |
| ولم اكن في السن التي أفهم فيها، معنى كلمة (حُكْم)... ولكن المراحل الطويلة التي ظلّت أمّى، ومعها الخالة فاطمة، والعم محمد سعيد وغيرهما، يطوونها للوصول إلى هذا الذي أسمع إن اسمه (الحُكم)، جعلتنى لا أشك في انه شىء هام جدا، يتوقف عليه الكثير من الامور، ومنها، أو هو مقدمتها كلها، زواج أمّي، ومنها حكاية أن أبلغ من العمر سبع سنوات بالتمام والكمال، التي جاء العم محمد سعيد، ذات يوم ليقول: |
| :ـ. القاضى، كتب يطلب فتوى مفتى المذهب المالكي، لأن المذهب الحنفي لايجوز فيه الحكم بالطلاق، حتى ولو بلغ الولد السبع سنين، مادام لم يثبت أن زاهد قد مات. |
| كلام كهذا.. أو قريب منه، كان بالنسبة لي غامضاً، وغائما، ولكنّه مع ذلك أحيا في نفسي أملا، في أن لايصدر حكم أو فتوى من الشيخ أو هو المفتى المالكي، يجيز الطلاق، وكان مما بعث نوعا من لأرتياح في نفسي ـ وهو أمر غريب بانسبة لتلك السن ـ أن احداً لم يقلْ حتى الآن أن أبي قد مات... ومادام المذهب الحنفي لا يجيز الطلاق الا إذا ثبتتْ وفاة أبي، فبارك الله في هذا المذهب، وألف الحمد لله.. وبهذه المشاعر انتهزت فرصة اللحظات التي تأخذني أمي في حضنها للنوم في الليل لأقول لها: |
| :ـ. يافغَّم.. جاكي خبر إنّو أبويا مات ؟؟؟ |
| وأحسست بارتباكها، أو بوقع مفاجأة السؤال عليها، حين قالت بعد لحظة صمت وتردد: |
| :ـ. لأ.. لأ ياعزيز، ماجانى خبر انو مات ؟؟؟ |
| :ـ. مادام كده ياففَّم.. أنا سمعت العم محمد سعيد يقول مافى طلاق، مادام ماجاكي خبر انو أبويا مات.. |
| :ـ. صحيح.. المذهب الحنفي كده ياعزيز |
| :ـ. طيب، وأنتى ايش مذهبك ؟؟؟ |
| :ـ. مذهبي حنفى.. |
| قالت الجملة الاخيرة وصوتها يكاد يكون همسا لايسمع، ولوأنى كنت أنظر إليها لرأيت في ولكني أكن أنظر إلى وجهها، كنت فيما يشبه دوامةً تدور بذهني بحثا عن أى سبيل يوقف حكايةَ الطلاق، وبالتالي هذا الزواج، الذي أصبحت أعي تماما أنه لن يتم الاّ بحكم الطلاق.. ولذلك وجدت نفسي كأنى أكاد أقفز فرحا بأن مذهبها (حنفي) فألُفٌّ ذراعى حولَ عنقها وأنا أقول:ـ. |
| :ـ. خلاص ياففَّم.. مادام ماجاكي خبر موت أبويا.. وأنتى مذهبك حنفي.. يسير مافى طلاق وكمان مافى جواز. |
| لا أشك في أنها ذُهلت، وهى تسمح كلَّ هذا مني، وأنا في سنٍ تعتقد هي، ومعها الجميع، أنى لاأدرك شيئا من هذه الأمور.. وأنى مجرد طفل صغير، ليس عليّ الا أن أسير في الدرب الذي يريدون لى أن أسير فيه. |
| والتزمت أمى الصمت وذراعي يلتف حول عنقها.. وقد زدت على ذلك أن أخذت أقبلها.. ليس مرةً واحدة وإنما مراتٍ وبلهفة لم أعهدها في نفسي أو في تصرفاتى من قبل. |
| وكأنها ـ في هذه اللحظات، ومع هذا التصرف من جانبي ـ قد استوعبت جميع احتمالات المستقبل الذي ينتظرنا معا، إذا لم تتزوّج، ولا سبيل إلى الزواج مالم يتم طلاقها أو تطليقها فإذا بها تجلس في الفراش وترفع ذراعي عن عنقها بلطف، وتلتفت إليّ ناظرة في وجهى الذي كانت تعصف بملامحه اللهفةُ على أن تظل تنتظر أبي، أو تنتظر إلى أن يجيئها خبر موته وقالت بصوت لم تحاول أن تجعله هامسا، كما هي عادتها هذه اللحظات التي تسبق النوم: |
| :ـ. أسمع ياعزيز... أنت دحّين سرت تفهم كتير.. وعشان كده لازم تفهم أكثر.. أنت فاهم انّو أبوك سافر من زمان.. من يوم ماكان عمرك تسعة أشهر... ومن يوم ما سافر أنا ماستلمت منه حِسْ ولا خبر.. وكمان ما أرسل لي ولا مجيدى، أصرف على نفسي وعليك... وأنت كمان لابد مانسيت، أيامنا في حلب بعد موتّ جدّك رحمة الله عليه... ما نسيت عيش الشعير الأسود والِكرسنِة.. اللى نغمّسه في موية الرمان والملح. مانسيت ياعزيز، كيف سافرنا من حلب،... والحمى اللى كانت تجيني كل يوم... هاديك الحمّى اللى لو كانت موّتَتْنى، زى الكثيرين اللى ماتوا... كان ايش اللى يجرالك ؟؟؟ كنت تروح فين... ؟؟؟ مين اللِّى يربّيك ؟؟؟ مين اللي يعرفك؟؟؟ نحمد الله اللى ربنّا أراد ورجعنا المدينة.. لابد إنك متذكر كيف وصلنا المدينة على الجمل وقبل الجمل.. البحر، إلى ينبع... أنت متذكر كيف لما وصلنا المدينة في الصبح أنا صلّيت، ولحست تراب الأرض.. وحمدت الله.. علشان كنت بأقول في نفسي.. لو أنا مت.. فيه في المدينة اللى يعرفوك.. ويعرفو جدَّك احمد صفا.. ويعرفوا أبوك.. ويعرفونا كلنا.. ياعزيز.. حتى دحّين.. حتى اليوم، لو أراد الله أنى أموت.. وتفضل أنت وحدك مين اللى يربّيك ؟؟؟ مالك أحد أبدا.. الا الله.. وعشان كده.. عشان كده... |
| ولم تكمل كلامها... وزحمها البكاء... وفى هذه الفترة التي كانت تتحدث فيها أمى بصوت مسموع، كانت منكشة قد استيقظت، ولعلها لم تكن نائمة، فجلست في فراشها ولكن ملتفتةً إلى الجدار، ومرت لحظات دون أن تكمل أمي جملتها، لأسمع منكشة تقول بعربيتها المكسرّة: |
| :ـ. عشان كده.. أنتى لازم واحد رجّال.. لازم واحد بابا |
| وفهمت ماظلّت ترطن به من كلام خلاصته، أن هذا الزواج لابد منه، وأن الرجل الدكتور رجل طيب، ـ وبطريقتها في التعبير ـ ظلّت تكرر انه طيّب جدا وإلى أقصى حد ولكن أمى التزمت الصمت لحظات.. التفت إلى منكشة، وأخذت تحدّثها بالتركية كلاما طويلا، ثم التفتت اليّ تقول؛ |
| :ـ. ايوه ياعزيز.. هادا الرجّال طيّب زى مابتقول دادتك منكشة.. وكمان أنا شرطت عليه انك تكون زى ولده.. يعني.. |
| ومرة اخرى زحمها البكاء.. وعادت تكلم منكشة بالتركية.. ثم قالت؛ |
| :ـ. لوكنت ياعزيز كبير شويّة.. يعنى لوكان عمرك عشرة ولا أتناشر سنة أنا ما كنت أتجوز أبد.. كان يمكن أنك تكون أنت رجّالنا... يمكن تشتغل... أعلمّك في البيت القراية والكتابة.. وتتعلم حسن الخط عند الخطاط... وتسيركاتب... عند واحد من التجار.. لكن أنت عمرك سبعة سنين بس.. ايش اللى يمشِّي السنين إلينْ تسير رجّال ؟؟ |
| من جانبي وأنا أصغي إليها، واسترجع في ذهني الكثير الذي مر بّنا منذ ذلك اليوم الذي خرجنا فيه من هذا البيت إلى (البابور) وإلى أن عدنا إليه.. وعلى الأخص منها تلك التي عشناها بعد موت جدّى... استطعت أن أتصورّها تماما.. أياماً رهيبة، أشعر اليوم بعد هذه المراحل التي قطعتها في مسيرة العمر، بالمصير الذى كان يمكن أن انتهى إليه لوماتت أمى وأنا في الشام قبل أن نعود إلى المدينة ؟؟؟ مرّت بذهنى مشاهد أولئك الذين كانوا يموتون جوعا ويتساقطون في الشوارع، وعلى الارصفة وتنقلهم عربات نقل الموتى... أحس الآن وأنا أكتب هذه السطور، بقلبي يغوص في صدرى رهبة ورعبا فلا أملك الا أن أحمد الله على ما أغدق على من النعم... بل لا أملك الا أن أسلم بأن ما تقبّلتْه أمّى في النهاية مَنْ نصيحة من حولَها من الصديقات وفى مقدمتهن، الخالة فاطمة، بالزواج من هذا الدكتور، كان قدرا مقدورا، أراده الله لي خاصّة.. ولها به كل الخير. |
| ولم تمض أيام طويلة، وأجواء الحياة بينى وبين أمى والدادة منكشة، لاتخلو من الضيق والترقب، في انتظار هذا الذي يسمّى (الحُكم)، اذ جاءنا العم محمد سعيد ذات يوم في الصباح الباكر، ليقول لأمى: |
| :ـ. تبغي تروحي عشان تستلمى الحكم وحدك.. ولاَّ نبغي أحد يجي معاكي؟؟؟ |
| وكلمة (الحُكم) هذه كان لها في نفسي وقع لاشك انه يختلف عن وقعه في نفس أمى. اذ بينما رأيت في وجهها ما يشبه الارتياح، أحسست كأن شيئا يضغط على صدرى، وكأن قشعريرةَ بردٍ شديد تسري في جسمى... ولا أدرى من أين أخذ العرق يتفصّد من جبيني باردا.. مسحت العرق بكمّي،....لم أشعر بالبكاء أو الرغبة فيه... ولكن من أغرب مايمر بالمرء أحيانا ـ وهذا ما عرفته بالتجربة فيما بعد من أيام العمر ـ انّه يتمنّى أن يبكى.. أن يذرف دفقا من الدموع تحجَّرت في عينيه، فلا يستطيع. |
| وسمعت أمّى تقول:ـ. |
| :ـ. ياريت ياعم محمد سعيد أروح معاكم. |
| :ـ. يكون أحسن.. لكن أنا لازم أروح السوق، أقَضِّي.. أصله خالتك فاطمة عندها اليوم ضيوف مقيّلين... لمّا أرجع، قبل الضهر نروح سوا... بس انتى خليّكى جاهزة. |
| قال العم محمد سعيد هذه الكلمات، ومشى... والتفتٌّ إلى أمّى لارّاها وابهام يدها اليسرى على خدّها... وكان هذا يعبّر عن حيرتها وارتباكها... ولكن لم يطل وقوفها اذ اتجهت إلى الديوان، وكانت منكشة قد جهزّت وجبة الصباح... وجلست على طرف الدكة تنتظر وما كادت ترى أمى داخلة حتى نهضت وهي تقول بالتركية كلاما فهمت أنه يعنى الدعاء إلى الله بأن (يتمّمّ بخير). |
| وعاد العم محمد سعيد في الموعد الذي حّدده، وكانت أمى في ملايتها، وقد لفت نظرى أنها ـ ربما لأول مرة ـ لم تجهّزنى بالثوب النظيف، والحذاء، وتمشيط الشعر، كما هي عادتها منذ عدنا إلى المدينة واشترت لى من (مغازة) العم إسماعيل تلك الثياب والأحذية الجديدة. وزاد المسألة تعقيدا، عندى أنها التفت اليّ وهي تقول: |
| :ـ. انت خليك مع دادتك منكشة... ماهو لازم تيجي معايا. |
| لم أحاول أن اتشبّت بها... وكأني تذكرت، أنها تصطحبنى إذاكانت تخرج وحدها.. ولكن لاحاجة بها اليّ، مادامت ستذهب مع العم محمد سعيد. ولكنى ظللت أشعر بذلك الشي الذي يخمش صدرى أو هو قلبي.. وكلمة (الحُكْم) اياها تطن في كيانى كلّه... انها الحكم بطلاقها من أبي.. وكما قال العم محمد سعيد (على المذهب المالكى)... |
| وكانت حكاية المذهب المالكي هذه بالنسبة لى لغزا، لم أفلح في حله إلى سنين طويلة من عمرى... ولا بد ان اقول أنى اختزنت في اعماق نفسي ما يشبه الحقد أو الغيظ على هذا المذهب، الذي كان السبب في طلاق أمى، وبالتالي في الأذن بزواجها... كان الذي استقر في نفسي، انه لولا هذا المذهب لما اتيح لأمى ان تتزوج... وكان مما ظللت احاور به نفسي، هو: ما الذي يمنع ان أبحث عن عمل...حتى ولو لم أتعلم الكتابة والقراءة ولم ابلغ الثانية عشرة من عمرى... لقد رأيت، اكثر من مرة اطفالا، في سنى ـ السابعة من العمر ـ يعملون في سوق الخضار... يحمِّلون على اكتافهم وأحيانا على روؤسهم، مايشتريه بعض الناس فلا يحملونه بانفسهم في (الزنبيل)...وانما يحمِّلونه لهؤلاء الأطفال الصغار الذين سمعت، انهم يذهبون بما يحملون خلف الرجل، إلى ان يصل بيته.. فيعطيهم نقودا..وهم يقومون بهذه العملية مرات عديدة في اليوم... وفى كل مرة ياخذون نقودا... وانا اعلم أن النقود هي التي نحتاجها لنعيش... وهنا لم انس ان أمى عندها الجنيهات العسمنلى، التي استلمتها من الرجل الذي يستأجر الدكانين في زقاق الزرندى... فوجدتُنى اتساءل في حَردٍ وغيظ. |
| :ـ. (وما دام عندها الفلوس...فما الذي يجعلها تتزوج ؟؟؟)... لم نعد نجوع، ونأكل خبز الشعير والكِرسِنُة، نغمسه في عصير الرمان والملح، كما كان الحال في حلب... أيام الحرب..... |
| على اية حال قد ذهبت أمى مع العم محمد سعيد لتستلم الحكم... وها انذا في البيت ومعي هذه العجوز... منكشة... التي لم أعد احبها... كنت اشعر نحوها بعداء وبغضب اتمنى معهما لو انها تموت... فهي... هي سبب جميع ما يحل بي من بلاء. وعندما كنت مستلقيا على الطُواَّلة في الدكة. والافكار الكثيرة تعصف بذهني ومشاعرى، في انتظار (الحُكم) الذي ستستلمه أمي، فوجئت بمنكشة تقترب مني بخطوات ثقيلة متئدة، وفى يدها طبق صغير، فيه كمية من قطع الحلوى (السكرية).. تقدمه الي، وفى عينيها وقد تدلى عليهما جفناها الثقيلان، ما يُعبر عن الرغبة في استرضائي وتدليلي... ولا ادرى كيف جروءت على أن ارفع يدي، وانسف الطبق بما فيه من الحلوى عن يدها... ثم استدير مواجها الجدار. لا أريد ان اراها... فاذا بها لاتقول شيئا، ولا يبدو على وجهها انها قد انزعجت أو تألمت من الحركة.... انحنت تجمع حبات الحلوى السكرية... وحين التفت اليها اكاد أسمِعُها شتيمة من تلك التي تعلمتها من الاطفال الذين العب معهم، رأيت عينيها تذرف الكثير من الدمع... احسست بالندم والاسف.. ولكنى التزمت الصمت... كأنى كنت اريد أن تفهم انى كرهتها، وانى لم اعد اطيق ان اراها. |
| * * * |
| ارتفع صوت المؤذن لصلاة الظهر... ولم تعد أمي بعد... وقدّرت انها ماتزال تنتظر (الحكم) في المحكمة... وعادت إلى ذهنى مشاهد المحكمة.. والقاضي جالسا على مقعده الضخم، وامامه تلك المنضدة الصغيرة التي يجلس وراءها الكاتب... ووجدت نفسي اتساءل ترى إلى متى يجب ان تقف أمى امام القاضي لتستلم (الحُكم)... ثم كيف تستلمه ؟... هل هو ياترى شيء ما ؟.. صندوق مثلا... ؟؟ عصاة ؟؟؟ قطعة قماش ؟؟؟ ام هو شيء أضخم من كل ذلك... يستلزم ان يحمله لها حامل ؟؟؟ فإذا حمله وخرجت به من المحكمة لابد ان يراها الناس ويروا مع هذا الذي يحملُ لها (الحكم). |
| وانتهى سيل اسئلة ودفقُ الأفكار، حين سمعت باب الزقاق يفتح ويغلق... فنهضت مسرعاً كالملسوع... واسرعت اقابلها، فأدهشنى ان لا أرى معها حاملا ؟ ولا اراها هي تحمل شيئا سوى ورقة... مجرد ورقة لا اكثر ولا أقل. |
| ولم تتكلم، وهي تدخل... ولكن كان وجهها محتقنا اشد احتقان لم ار مثله من قبل.. وجلست على طرفِ الدكة وطلبْت من منكشة ماءً.. ثم خلعتْ عن راسها الملاية و (البيشة) وبعد ان شربت جرعتين أو ثلاثا.. نشرت الورقة التي في يدها... واخذت تقرؤها... واستغرقت القراءة وقتا، كنت أنا خلاله انتظر ان تقول شيئا... أي شيء... إلى ان قالت في النهاية: |
| :ـ. خلاص... هادا هوه الحكم على المذهب المالكي... ومن هادى الساعة انا لازم أمسك (العِدّة)... |
| وبطبيعة الحال لم افهم اكثر من ان الورقة التي في يدها وظلت تقرؤها هي الحكم، بطلاقها من أبي... اما حكاية أن (تمسك العدة)، فلم تفهمها حتى (منكشة) اذ رطنت بالتركية كلاما كان دون شك حول الموضوع، فاجابتها أمى بالعربية تقول:ـ |
| :ـ. العدة يعنى ما أخرج من البيت.. ولا أتجوز الا بعد تلاتة اشهر.. |
| ثم بعد ان التزمت الصمت دقائق، وماتزال الورقة منشورة بين يديها التفتت اليّ وهي تقول: |
| :ـ. انت ماتقدر تفهم هادى الأشياء... لكن شوف... القاضي المالكي قايل هنا أنه حَكَم بطلاقي طلقة واحدة رجعية... يعني ياعزيز... لوجا ابوك في هادى الاشهر التلاتة يمكن أرجع له... قول يارب.. |
| وفعلا... كان هذا الكلام مفاجأة بالنسبة لى.. اذ وجدت نفسي اقفز اليها وألُف ذراعى حول عنقها وانا اهتف بصوت مرتفع.. يارب... يارب.. |
| * * * |
|
|
 شارع عبد المقصود خوجة
شارع عبد المقصود خوجة 00966-12-6982222 - تحويلة 250
00966-12-6982222 - تحويلة 250