| سبيلنا إلى بناء الكيان القوي |
| مما لا يجهله المسلمون، أن عقيدتهم السامية، وشريعتهم السمحة، وما في هذه العقيدة من مُثل عليا، وما في الشريعة من مضامينَ تستهدف خير البشر كافة... كل ذلك ظل - طيلةَ القرون التي طواها الزمن - وحتى هذه اللحظة من القرن العشرين هدفاً للدَّس والتآمر والتصميم الخفي والمكشوف، للقضاء عليها، بأساليب تراوحت بين المواجهة المسلَّحة حين تتاحُ الفرصة لها، وبين الالتفاف والتربُّص وما تستلزمهما الحركات الخالية من أساليب الهدم والتخريب. |
| والتاريخ الإسلامي في جميع مراحله، بدءاً من اليوم الذي ارتفع فيه نداءُ الدعوة إلى الله من وادي إبراهيم، وشعاب مكة، ومروراً بعصورِ الفتح وامتدادِ الظلِّ وارتفاع الرَّاية، وانتهاءً عند واقعنا اليوم، يقدَّم لنا الدليلَ تِلْو الدليل على أن الدعوة إلى الله... إلى شريعة محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، وإلى جوهر هذه العقيدة، وما يشع من محتواها من المبادىء والمُثُل العليا السامية، الهادفة إلى الهُدى والحق، ظلت الظاهرةَ الكبرى والنادرة المثال، بأعجب أثريْن وتأثيرين في حياة الإنسان. |
| أحد الأثرين، أنها تملك القدرة، بطبيعة كونها كبرى رسالات السماء، أن تتألَّف القلوب، وأن تترقرق في الوجدان، وأن تسري في المشاعر، وأن تتغلغل في العقول، فإذا بها تجد المؤمنين بها يدخلون رحابَها ويتفيَّأون ظلالها، ويجدون فيها الأمنَ والطمأنينة والاستقرار النفسي، والاقتناعَ العقلي، ويكون في كل ذلك سبيل ما ينشده الإنسان من الحب والدعة والسلام في ضميره، ومع نفسه، وفي أسرته ومع مجتمعه، وفي وطنه، ثم في الوطن الإسلامي على امتداده الواسع في الآفاق. |
| والأثر الآخر، ويسعنا أن نعتبره نتيجة للأول، وهو أن ما يجده الدين الإسلامي من سبل إلى ضمير الإنسان وقلبه ووجدانه وعقله، يثير فيمن أعماهم التعصب، وطوَّقتهم الهرطقة، وعنكبت في عقولهم وضمائرهم رواسب تحجرت من الضلال والتخبط في ما يوسوس به الشيطان من الانحراف، يثير في هؤلاء جميعاً ثائرة الحقد الأسود والضغائن المظلمة، التي تستلزمها طبيعة الهزيمة، فإذا بهم يجمعون أمرهم سراً وعلانية على مهاجمة الإسلام والمسلمين، والتسلل إلى صفوفهم عبر ما يمُدونه من جسور التشكيك والتضليل، وما يتفنَّنون فيه من التلَوُّن والتنكر، التي تخفي حقيقة مكرهم وتستر خطرَ مخططاتهم وأهدافهم، وما يرفعونه من شعارات زائفة يحرصون على أن تبرق بالغنى والرغد، وتوهم بالدعة والرخاء. |
| ولا بد لنا أن نواجه حقيقة، وأن نتنبه لها، وأن نعي خطرها، وهي أن المسلمين بعد أن عانوا ما عانوْه من عصور الانحطاط، من استغراقٍ في الجهل، واستسلام للدخيل المشبوه من البدع والخرافات، - وصلوا إلى مرحلة من التخلف، سهل معها على أعداء الإسلام والمسلمين، أن يخدعوهم عن حقيقة عقيدتهم، وأن يُموِّهوا عليهم ما في جوهر هذه العقيدة من حَثٍّ على الحركةِ والحياة، فكان ما نشهده اليوم من واقع مرير. كان هذا الواقع الذي مزَّق نفوسَنا حسرةً وأسفاً وتفجُّعاً، والذي نلتمس إلى تغييره مختلف السبل، وفي مقدمتها كلِّها... إظهار ما في ((جوهر العقيدة)) من حيوية وقدرة على أن تساير حياةَ العصر، تطوراً لا سبيل إليه إلا ((بالحركة))، وتقدماً لن يتم إلا ((بالعلم))، وقوة كيان لن نصل إليها إلا ((بالعمل))... وكل ذلك على أساس متين من الإيمان المطلق بالله سبحانه، وبأن في عقيدتنا ما يغنينا عن كل ما يُرفَع من شعارات، ليس فيها إلا البريق الكاذب، والوهم المأفون. |
| على أساس هذا الإيمان، وعلى ضوئه نستطيع أن نرى سبيلَنا إلى الحركة، ((لنتطور))، وإلى العلم ((لنتقدم))، وإلى العمل ((لنبني الكيان القوي))... هذا الكيان الذي نستطيع أن نواجه به أعداءَنا، ومن يدعمون هؤلاء الأعداء، مهما كان لهم من الشأن في ميزان القوى، وفي حساب التكتل والعنفوان. |
| وفي مثل الظروف التي نعيشها في هذه المرحلة من تاريخنا، ليس لدينا من عمل أشد إلحاحاً وأقدس غرضاً وأنبل غاية من ((التضامن)) والتكاتف والوقوف وقفة رجلٍ واحد، أمام التحديات على اختلافها، وفي مقدمتها هذا العدو الذي وجدَ في تفرق الصف، واختلاف الكلمة، وتباعد القلوب، سبيله إلى الاستهتار بنا، استهتاراً ليس من المبالغة في شيء أن نقول، إنه لم يسبق له مثيل قط، حتى في أشد عصور الانحطاط والتخلف والظلام. |
| * * * |
| ظاهرة ربما ينفرد بها العالم العربي، ومنه المملكة العربية السعودية بالطبع، وهي الإغداق، بالحمد والثناء، والتقريظ والإطراء، وإلى حد يقترب من نوح النائحات وعويلهن، على الذين يرحلون عنّا رحلتهم المحتومة، إلى دار البقاء... ولأن الصحف والمجلات هي الساحة التي جرت العادة أن تمارس فيها (عمليات النياحة) هذه، والتسابق إليها أو تسابقها هي إلى الكتاب، تستمطر دموعهم، أو هو نواحهم وبكاءهم. فإن جمهرة قرائها الذين ربما لم يسبق لهم أن عرفوا شيئاً، عن الراحل العزيز، حين يقرأون كل هذه الزحمة من الثناء والإطراء، لا بد أن يضربوا كفّاً بكف تحسّراً، ليس على الفقيد الغالي، وإنما على ذلك الجهل الكثيف، الذي يكتشفون أنهم كانوا غارقين فيه عمرهم كلّه، بالنسبة لهذا الراحل الذي يجدون فيما يكتبه الكتاب، إنه كان يتمتع - رحمه الله - بكل هذه الخلائق والصفات، التي كان يجدر بهم أن يعرفوها، حين كان يدب على ظهر الأرض، إن لم يكن لشيء فليعيشوا الاعتزاز والفخر به، وربما ليؤدوا إليه بعض ما يستحق من التقدير والتكريم. |
| ولا أستثنى نفسي من الذين يُطلب إليهم، أن يسبقوا إلى كلمة تنشر في هذه الجريدة أو تلك، عن الفقيد. وفي غمرة المفاجأة الحزينة، استجيب للطلب، وأسرع فأملى (هاتفياً كلمة، أو كلمات، تنشر بين غيرها ممّا يكتبه الزملاء والرصفاء... وأقرأ ما كتبت وما كُتب، فأجد نفسي أتساءل: ترى هل هذا الذي أمليت ونشر، هو ما ينبغي أن يقال... هل عبّر عن حقيقة المشاعر من جهة، وحقيقة الشخصية التي وصفتُها بما وصفت من جهة أخرى؟؟؟ |
| ولا أدري كيف سيكون وقع هذه الكلمة اليوم، حين أصارح نفسي والقراء، بأن الكثير، بل الأكثر، مما يُكتب، أو يستكتب، ينطبق عليه ما أسميه (إنشاء)... ولا أعني (إنشاء المعاني من علوم البلاغة)، وإنما الذي أعنيه أن الأكثر مما ينشر، ليس أكثر من كلمات فيها الثناء والإطراء، وفيها (ألفاظ) التقدير والتكريم، ولكنها تفتقد حرقة الحزن، وشهقة البكاء... كما تفتقد، صدق النظرة في التقدير والتكريم. |
| وأكتب هذه الكلمة اليوم، بعد رحيل علمين من أعلام الشعر عندنا، وهما الأستاذ طاهر الزمخشري، والأستاذ محمد علي السنوسي، لاحقت الصحف والمجلات رحيلهما بهذا الإنشاء الذي ذكرت، ولقد عكفت على قراءة ما كتبه الأخوان، ولا أتهم، أحداً بضعف الأداء والعطاء، ولكني حين التمس حرقة الحزن ولأواءه، وشهقة البكاء وآهاته، أفاجأ بأني أجدها صادقة مشتعلة، ومن أعماق القلب، في هذه القصيدة التي نُشرت للأستاذ عبد الله حمد القرعاوي وقدّم المحرر لها بأنها جاءت متأخرة عن وقتها. |
| يقول الشاعر، في مطلعٍ من أجمل ما قرأتُ من المطالع، في هذا العصر، في مثل هذه المناسبة: |
| بسمة كنتَ في قلوبِ الحزانى |
| كيف أصبحت دمعةً في القلوب |
|
| ثم يقول: |
| كنت فينا قيثارةَ النغم العذ |
| ب (حجازاً)، وكنت (عزف) الجنوب |
|
| ويحلِّق القرعاوي بعيداً في مشاعره نحو الزمخشري حين يقول: |
| رحل العاشق المتيّم عنّا |
| وبأجفانه ارتعاش الكروب |
|
| ويقف وقفة كشفت عن مأساة الزمخشري الحقيقية التي ندر أن عرف عنها إلاّ خلَّص أصدقائه وهي رحيل زوجته - أم أولاده - عنه منذ أكثر من ثلاثة عقود من السنين... فقد كانت رحمها الله سيدة (نادرة) في ذكائها، وسعة أفقها، بل وفي ثقافتها أيضاً... لو قلنا إن الزمخشري (قد ضاع)، ولم يجد نفسه، منذ ذلك اليوم، فإننا لا نتجاوز الحقيقة في شيء. |
| يقول الأستاذ القرعاوي في هذه الوقفة الرائعة حقاً: |
| حمل الهمَّ، صابراً، ليس يشكو |
| باسماً للأسى بلحنٍ طروب |
| منذ أن فارق الأليف أليف |
| وهو في التيه شارد كالغريب |
| حضن الابن والبنات وأروى |
| كلَّ حي بدمعه المسكوب |
|
| هذه القصيدة، في تقديري، هي العمل الفني الوحيد، الذي خرج عن (الإنشاء)، وعبّر عن حقيقة الشعور الذي يكنه الشاعر للراحل العزيز. |
| وكانت القصيدة مفاجأة بالنسبة لي، إذ لم يسبق أن قرأت للأستاذ القرعاوي شعراً، وإن كنت كلّما جمعتني به مناسبة أرى في قسماته، وفي عينيه نبض الحس الصادق، وألق الروح الحزين. |
|
|
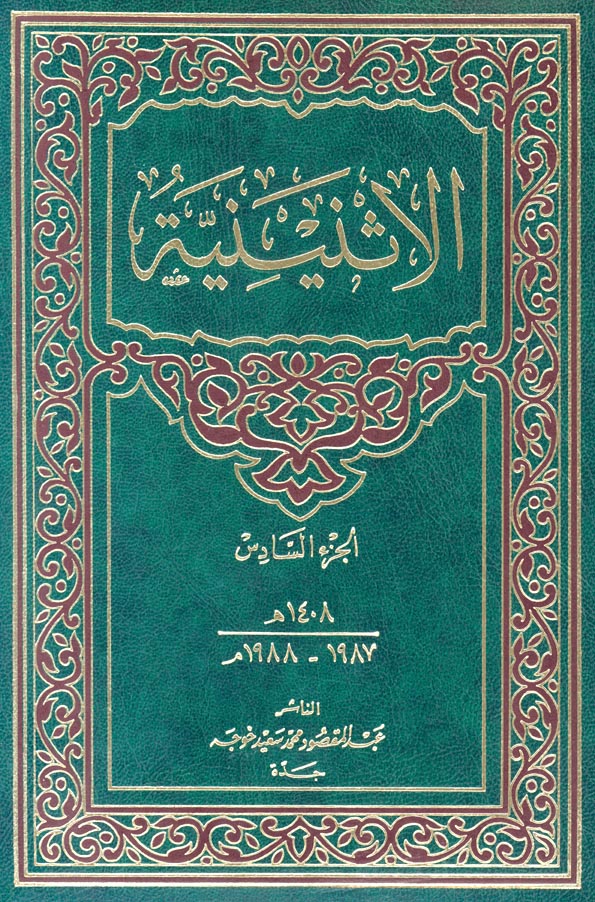
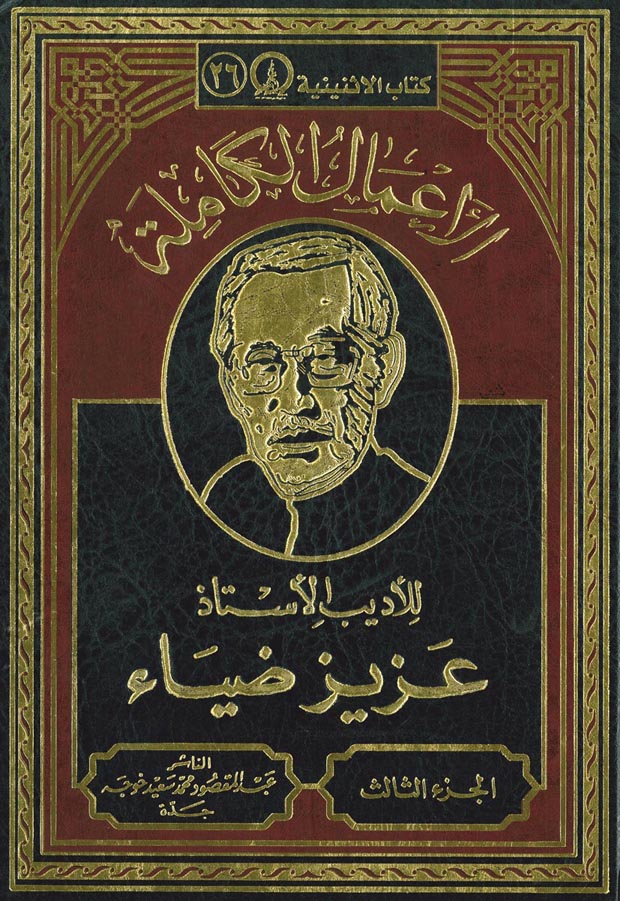
 شارع عبد المقصود خوجة
شارع عبد المقصود خوجة 00966-12-6982222 - تحويلة 250
00966-12-6982222 - تحويلة 250




