| في أجواء (الندوة الثقافية الكبرى، عن الموروث الشعبي، وعلاقته الإبداع الفكري والفني) |
| كان لا مناص من الإذعان والاستسلام لمختلف عوامل الشد، والاستدراج، التي جرت العادة أن يمارسها شهر رمضان المبارك، بشمولية واسعة، تكاد تستوعب كل ما حولنا من مسيرة أيام العام، بحيث توجّهها إلى حيث ما عمّقه تعاقب الأجيال والقرون، في حياتنا، في هذا الشهر من قنوات، لا بد أن تجري فيها الحياة، رغم ما فيها من انقلابات، وتغيرات، تجعلنا نشعر أننا قد انفصلنا تماماً عن مألوف حياتنا طوال العام، وهو كما لا ينبغي أن يفوتنا، انفصال طوعي تخالجنا فيه فرحة ما أكثر ما تعود بي شخصياً إلى أيام تلك الطفولة اللاهية التي لم يكن يفرحها شيء كما يفرحها أن يتاح لها السهر الذي يُحرِّمونه علينا، ويرغموننا على أن ندخل الفراش، بعد صلاة العشاء مباشرة، وتحت التهديد بالعقاب إذا ما خطر لنا أن نظل مستيقظين تحت اللحاف. ولكنّهم لا يلتزمونه معنا في ليالي رمضان. |
| ومع هذا الإذعان لمقتضيات الشهر المبارك، وجدت نفسي أفقد مزاج الكتابة، وأستمتع بمزاج (اللهو العجايزي).. وأعني به الانصراف إلى (النبش) عن القديم الذي أهمل طويلاً من الكتب.. التي انقطعتُ عن مطالعتها عهداً، كاد يفرض نفسه تصرفاً لا انفكاك عنه.. وهذا بالطبع بعد قراءة ما يتيسر من القرآن الكريم فترة من الوقت مع ساعات الصباح الأولى.. |
| ولا أدري.. فإني أميل إلى الاعتقاد أن افتقاد المزاج للكتابة أو لأي عمل فكري، مشكلة تواجه كل مشتغل بالفكر والفن. ولذلك فإن الأيام التي انقضت، وانقطعت خلالها عن الكتابة كانت أيّام مسايرة لمتغيرات الشهر المبارك من جهة، ومحاولة استعادة (المزاج) من جهة أخرى. |
| ولكن ضياع المزاج، ومتغيرات الشهر الكريم، لم تنسف عن ذهني هاجس الرغبة في استيفاء معالجة موضوع (الموروث الشعبي، وعلاقته بالإبداع الفكري والفني).. وضايقني هذا الهاجس، في الواقع إلى حد أني وجدت نفسي أرجّح أن الدكتور فهد العرابي الحارثي قد مارس على رجال الفكر، الذين حضروا الندوة، ثم غادروا موقعها إلى بلدانهم - وأنا واحد منهم - طريقة من طرق التسلط الروحي - ربّما بمجموعة من التعاويذ التي أسمع في هذين اليومين أنها وجدت من يدعو إلى الاستعانة بها لتحقيق ما يكاد يدخل في باب الكرامات.. وقد كانت هذه الكرامات دائماً ظواهر يعجز عن تفسيرها العقل، ولكنّها قائمة، أو يمكن أن تثبت وجودها المعجز الغريب، وليس في المملكة فقط، وإنما في الكثير من بلدان العالم العربي، وربّما على الأخص منها، مصر، والمغرب - كما يقال - موريتانيا. |
| المهم والواقع بالنسبة لي على الأقل، هو أن هذا الهاجس ظل يلح عليّ، ويذكرني بأني طرحت ما يبدو لي أنه سؤال يستحق أن نجد الإجابة عنه، وهو وصف (الشعبي) للموروث فقد قلت إن هذا الوصف أو الصفة حين تميّز هذا الموروث، فإنها تفتح الباب أمام توهّم أن هناك موروثاً أو مواريث، غير شعبية.. فما هي؟ وما هي الصفة التي توصف بها إن وجدت؟ ولقد ذهبت إلى أبعد من ذلك حين قلت إن هذه الصفة مقحمة ولا لزوم لها، إلا إذا قصد بها الإيحاء بأن المقصود هو ما اصطلحنا على أنه الشعر (الشعبي) وهو هذا اللون من الأداء أو العمل الفني، الذي يكتب أو يقال باللهجة (العاميّة). وهنا يرد سؤال عن العاميّة: ما الذي يجعلها توصف بـ (الشعبية)؟ فإذا اصطلحنا على أن هذا هو الأليق بها، أو المتّفق مع طبيعة شيوعها، واستقرارها أو حتى رسوخها، في المتداول، بين جميع طبقات المجتمع في أحاديثهم، وما يدور بينهم، في الأسرة، وفي الشارع، بل وحتى في الأوساط الرسمية بين الرؤساء والمرؤوسين، فهل يعني هذا - بشكل ما - أن تفقد (الفصحى) صفة الشعبية.. وعندئذٍ فما هو الوصف الذي ينطبق عليها؟ |
| ثم، كلمة (موروث).. لقد لفت نظري منذ اللحظة التي كنت أقرأ فيها اللافتة العريضة في القاعة التي عقدت فيها الندوة، أنها هي أيضاً مختلف عليها، أو على ما تعنيه تحديداً، إذ نجد كلمة (الموروث) تعني (الذي ترك الميراث)، ويمكن أن تعني (المال الموروث) أيضاً ولكن أجد أن المجلة (العلمية الفصلية) التي تصدر عن مركز التراث الشعبي لدول الخليج العربية - الدوحة - قطر.. تختار كلمة (المأثورات)، والمركز هو (مركز التراث). ولعلّ تفضيل كلمة (المأثورات) كان الغرض منه الابتعاد عن المعنيين اللذين تحملهما كلمة (الموروث) التي اختارتها مجموعة العمل التي وضعت عنوان الندوة. وأنا أفضلها على الموروث، لأنّها أكثر وضوحاً من جهة، وأكثر استيعاباً للمعاني، أو المواد التي يُعنى أو يمكن أن يُعنى بها ويستهدفها البحث من جهة أخرى. |
| ومع هذه المجلة الفصلية، التي أجدها عملاً فريداً نادراً في موضوعها، إضافة إلى ما يبذل من جهد مدروس لإخراجها، طباعةً وتصويراً وورقاً، أجد أنها هي أيضاً تستعمل كلمة (شعبي) وصفاً للمأثورات وللتراث.. ولكن دون تعليل، أو محاولة للتوضيح، باستثناء ما نجده في القسم الإنجليزي منها، وهو كلمة (فولكلور Folklore).. مما يرجّح الظن بأن (الشعبي) هذا ليس أكثر من ترجمة للكلمة الأجنبية (إنجليزية أو ألمانية أصلاً) (Folk) التي تعني (شعب.. أو قوم).. أو - وهو الأصح - (عامة الناس). كما تعني كلمة: (Folklore)، العادات والتقاليد عند عامة الناس، أو التقاليد والعادات (الشعبية) بمفهوم متعارف عليه في اللغة الإنجليزية - وربما في الألمانية أيضاً - وهو (عامة الناس). |
| ولا أخفي أني في الوقت الذي وقفت فيه عند كلمة (شعبي) صفة للموروث، أو للمأثور، ووجدت أنها اعتمدت الترجمة عن الإنجليزية لكلمة (فوك Folk) تساءلت عما إذا كانت توجد كلمة أخرى يمكن أن تصف هذا الموروث أو المأثور وتؤدي نفس الغرض؟ وأعترف أني لم أجد سوى كلمة (عامي).. وقد بدا لي - ولا أزال على شبه يقين - أن هذه الكلمة، (عامي) أكثر تحديداً لحقيقة الصفة التي يجب أن يحملها الموروث، وذلك من واقع مقولة لـ (ألكساندر كراب) مؤلف كتاب (علم الفولكلور) الذي فرغ من تأليفه في عام 1949، ونقله إلى العربية الأستاذ (رشدي صالح) رحمه الله، وأصدرته (مؤسسة التأليف والنشر - دار الكتاب العربي) في عام 1967.. وهي (يريد الفولكور أن ينشئ من جديد التاريخ الفكري للإنسان، لا كما تمثله كتابات الشعراء، والمفكرين المرموقة بل كما تصوره أصوات (العامة)، الأقل جهارة). ولا أجد مبرراً لاستعمال كلمة (شعبي)، وصفاً للموروث إذ من المفروغ منه، أن الوصف بنصه هذا ينطبق على كل ما ينسب إلى الشعب وينتمي إليه وليس على المأثور فقط. |
| و (الشعب) هنا، تقابله في اللغة الإنجليزية كلمة (People) ويمكن أن ينسحب معنى الكلمة إلى (فوك Folk)، فإذا قلنا (شعبي)، نجد كلمة (Folk)، وكل ذلك يكاد لا يوجد له أصل في اللغة العربية، مما يدل على أن الكلمة، وصفاً للمأثور أو الموروث، مأخوذة أصلاً من اللغة الإنجليزية التي قد لا يُستبعد أن تكون بدورها مأخوذة بتحريف بسيط عن الألمانية. وقد يستبعد التحريف، إذا أخذنا في الاعتبار أن الإنجليزية والألمانية تنتميان أصلاً إلى الجرمانية أو السكسونية. |
| * * * |
| كانت متابعة موضوع (الموروث الشعبي) هذا الذي قلت إنه الهاجس الذي ظل يلحّ عليّ تلزمني بأن أواصل المناقشة أو هو البحث، إن لم يكن للوصول إلى نتيجة أو نتائج تضيف جديداً، فليتاح للقارئ (المتابع)، أن يستبعد عنّا تهمة العبث بالوقت، ويستبعد بالتالي عن هذه الجريدة، تهمة نشر ما أسميه (الخبع واللبرع). |
| ولكن كانت الوعكة التي أدخلتني قسم القلب في مستشفى عرفان، لفترة زادت على عشرة أيام، حالة حاسمة، توقّفت معها عن الكتابة، إلى أن عاودتها في هذه الكلمات القصيرة، التي يصر تحرير هذه الجريدة على أن يواجه الكاتب بها قراءة طوال سبعة أيام. |
| وكان ينبغي أن أنتهز فرصة الانقطاع عن الكتابة، لأتخلص من هاجس (الموروث الشعبي، وعلاقته بالإبداع الفكري والفني)، ولا أخفي أني بعد خروجي من الوعكة، أصبحت أكثر ميلاً للتخفّف من المواضيع الثقيلة، ومنها هذا الموضوع. ولكن يبدو أن أسلوب (التسلط الروحي) الذي مارسه الدكتور الحارثي لم يقتصر على شخصي، بل استطاع أن يصل إلى القسم الثقافي في جريدة عكاظ، الذي وجدت في مكتبي بعد خروجي من المستشفى أسئلة منه تقول: |
|
((الموروث الشعبي.. ما هو تعريفكم له؟، وكيف يكون شعبياً أو لا يكون؟ وكيف نستطيع أن نفرق بين الموروث الشعبي، والأدب العامي، ونضع لهما الحدود؟ |
| وكيف نستطيع وضع الحدود بين فكرة إحياء الموروث الشعبي واستثماره، والدعوة إلى الأدب العاميّ؟ وكيف نستطيع أن نطوّر هذا الموروث، ونكتسب منه سمة تمنحنا خصوصيتَنا العربية؟ |
| وأخيراً، في أسئلة القسم الثقافي، في جريدة عكاظ، سؤال يشبه (قنبلة) أعتقد أن تفجيرها سوف يظل ينتظر تورّط ذلك الذي يجرؤ على أن يضغط زر التفجير.. أو أولئك الذين وهبوا القدرة على رؤية ما وراء المنظور من قضايا عالمنا العربي. |
| يقول السؤال: (هل الدعوة إلى الموروث الشعبي، دعوة إلى تفتيت مفهوم وحدة العروبة؟). |
| وقد لا يكون من قبيل الصدفة، أن أجد السؤال الأخير - (القنبلة) - يعود بي إلى حوار دار بين الشاعر الأستاذ (نزار قباني)، وبين الأستاذ (جوزيف) الذي يقول نزار إنه يتستّر وراء اسم (جهاد فاضل) لأسباب ذكرها في رده، على ما يبدو وكأنه تلفيق في الحوار الذي نشرته مجلة الحوادث، حول ديوان نزار (قصائد مغضوب عليها). |
| إنها (العروبة) التي هجاها أبشع هجاء الشاعر نزار في ديوانه، والتي يشعر السائل في القسم الثقافي من جريدة عكاظ، أن الدعوة إلى الموروث الشعبي دعوة إلى تفتيت مفهوم وحدتها. |
| فإذا كان من حظ علاقة الموروث الشعبي بالإبداع الفكري والفني، أن ينتظره قراءٌ بأي نسبة عددية، فإن الأرجح، أن الأسئلة التي طرحها (القسم الثقافي في جريدة عكاظ) هي التي تستحق أن ينتظر القراء الإجابة عنها، من جانبي، وكذلك من الدكتور الحارثي، وفريق العلماء الذين عقدوا الندوة الثقافية الكبرى عن هذا الموروث وعن علاقته بالإبداع الفكري والفنّي.. وهي الندوة التي تعتبر منعقدة، ومفتوحة الأبواب طوال السنوات العشر القادمة. |
| ولا بد أن أصارح القراء بأن معالجة الموضوع كلّه، بما فيه أسئلة (القسم الثقافي في جريدة عكاظ) أصبحت تفرض عليّ شخصياً نوعاً من التفرّغ، والانقطاع للبحث.. والإذعان لهذا المطلب، حين أشعر أنّه ما ينتظره القراء، فإني لا أنكر - في نفس الوقت - أن الحياة الفكرية تطالب من جانبها بأن يكون لها النصيب الأوفر من الاهتمام، ومحاولة المعايشة، لأنّها أكثر حيوية وتفاعلاً (يومياً)، من بحث، يمكن أن يُستوفى (على مهل)، خصوصاً وأن الوقت متسع فضفاض، يستوعب أو يمتد عشر سنوات. |
| ومن أهمّ ما وجدت نفسي، أبتسم، وفي نفسي بعض الدهشة، وأنا عاكف على قراءته في هذه الجريدة، ربما في الأسبوع الماضي، هذه المقطوعة التي لا أدري هل أسميها قصيدة أم مقالاً ينطبق عليه وصف (النثر الفني) أو (الشعر المنثور) أو (القصيدة الحداثية) كما يفهمها التراثيون، وهي للأستاذ الكبير عبد الله بن إدريس بعنوان (تقريري إليكم).. وقد تصدّرت الصفحة الأولى من (ملحق) ثقافة اليوم. |
| والمقطوعة، حين اختار لها الأستاذ بن إدريس عنوان (تقريري إليكم)، قدّمت في الواقع قصة معاناة الأستاذ، واضطراره لإجراء عملية جراحية، مع الطريف والباسم من تفاصيل الرحلة: من لحظات (الهاجس الهامس) إلى أن احتواه الهناء: (بهذي المئين) تجيء إلى غرفته سائلةً (وكلٌ بعطر الدعا يسكب). |
| ومع أن المقطوعة، قد تجاوزت شرط القافية والروي، فإنها لم تتجاوز الوزن ودقّة التزام التفعيلة، أو التفعيلات التي فرضها البحر الذي اختاره (للتقرير). ومن هنا له أن يقول، إن المقطوعة (شعر موزون) ارتدى عباءة الشعر الحديث، وكأن الأستاذ الشاعر أراد أن يقول لشعراء الحداثة، وكتابها ونقّادها: (لا بأس بمحاولة التجديد، في حدود الاستغناء عن القافية مثلاً، أو حتى الاستغناء عن التزام بحر بتفعيلاته في القصيدة كلّها، حيث لا يوجد ما يمنع أن ينتقل الشاعر من بحر إلى آخر، في مجموعة من الأبيات يختار لها بحراً، ثم يختار للمجموعة التالية بحراً آخر، وهذا مع التزام البعد عن تنافر الجرس الموسيقي، الذي لا تصنعه القافية، بقدر ما يصنعه الوزن بتفعيلاته التي يختارها حسُّ الشاعر، وانفعال وجدانه بهذا الجرس. |
| والقصيدةُ (تقريرٌ) كما اختار أن يسمّي الشاعر موضوعها، وكانت مفاجأة لي أن أعلم أن الأستاذ عانى وعكة اضطرته لإجراء عملية جراحية.. فعسى أن يغفر لي أني لم أكن بين (المئين) الذين زاروه في غرفته، أو على الأقل اتصلوا به من بعيد.. وفي التقرير ما يذكرني بأن الأستاذ قال في مقدمته لديوانه (في زورقي)، إنه يستجيب لدواعي الشعر ويخضع لسلطانه في واحدة من حالتين ذكرهما.. وإحداهما أن تكون أجواؤه النفسية مهيّأة للتفاعل مع الحدث أو القضية المراد التفاعل بها. ولا شك أن الوعكة التي استلزمت إجراء العملية كانت من الأجواء النفسية التي هيّأت الشاعر للتفاعل معها. |
| ومن المفروغ منه أن الأستاذ كتب القصيدة بعد أن منَّ الله عليه بالشفاء، فهي عطاء أجواء الرضى التي عبّر عنها بضراعة الشكر والحمد لله سبحانه.. ولكن يستوقفنا الأستاذ، في أجواء الرضى والامتنان هذه، حين يذكر (ذات وجه صبوح) و (عين كما عين ريم الفلاة.. وتلفظ في رقة عذبة.. تخفف من رهبة الموقف) ويسألها الأستاذ - والأرجح أنه كان في (المركبة).. (من تكون؟) وتجيبه أنها (جون مير)، وأن بلدها (كندا).. ثم تمد يدها وهي تقول: (سأراك غداً.. بعدما تستفيق.. فإلى الملتقى).. |
| وللقارئ أن يرجع إلى القصيدة لقراءة التفاصيل عن مراحل إجراء العملية، ومنها (مساء المنام، ليسرح في عالمٍ غائمٍ مستهام).. ولكن ما وجدت نفسي أتساءل عنه، هو (ذات الوجه الصبوح).. لقد طوى الأستاذ عن القراء في (تقريره)، أنها رأته بعدما استفاق.. ولم يقل لنا شيئاً عن أثرها أو تأثيرها على أجوائه وهو يتماثل للشفاء.. بل حتى بعد أن غادر المستشفى معافى والحمد لله.. ومع أن الأستاذ بن إدريس يذكر في ديوانه أن تخصصه الدراسي هو الشريعة وعلومها، التي درسها أولاً (جُثِيًّا على الركب)، فإنّه يتسامح، (في حدود) فيكتب قصيدة عن (جارته) ((بهية)). التي يقول في قصيدة بهذا العنوان: |
| غرست حسنك في حسي وفي خلدي |
| وأشعل الشوق حسن فيك فتّان |
| سلبت مني رواء العيش مزدهراً |
| في (تونس)، فإذا الخضراء قيعان |
|
| ولا أملك إلاّ أن أضحك، كما ضحكت لأول مرة أقرأ فيها هذه القصيدة في ديوانه، حين يقول: |
| إذا تريدين عوناً في (معاملة) |
| أو أي أمر فإني اليوم معوان |
|
| والذي يضحكني هو (المعاملة) التي أجد الأستاذ مستعداً لتقديم العون فيها إذا كانت (بهية) تريده، إذْ لم يسبق أن جال بذهني قط، أن الأستاذ - وهو في رحلته إلى (تونس) أو منها - يستطيع أن يقوم بأي عون، في باب (المعاملات) التي تتراكم في الدواوين، ويجري وراءها المحتاجون لإنهائها في المملكة، وليس في تونس الخضراء. |
| ويبدو، أن (بهية)، عفا الله عنها، قد التزمت الصمت، ولم يخطر لها أن ترعى حق الجوار على الأقل، ولكن الأستاذ لا ييأس، ولا يحرجه صمتُها البارد، فيمضي قائلاً: |
| أجارتي: هل تردّين الجوابَ لنا |
| قبل الرحيل، ((وما في الرد خسران))
|
| ولتسلمي أبدَ الأيام في دعة |
| أيامك البيض، أزهار وريحان |
|
| وحكاية (الخسران) في الرد، الذي ينفيه الأستاذ أو يستبعده، هي أعجب ما في منطق القضية كلّها.. إذ كيف نفهم عدم الخسران إذا (ردت الجواب)، وهو الذي يفتح الباب، إلى ما بعد، مما لا يعلمه إلا الله. |
| * * * |
| وفي (ثقافة اليوم) من العدد نفسه الذي تصدر الأستاذ بن إدريس صفحتها الأولى، قصيدة لشاعرنا الكبير الأستاذ محمد حسن فقي.. وليس جديداً أن تتحفنا ثقافة اليوم في كل أسبوع، برائعة من روائع الشاعر الكبير، ولكن الجديد الذي استوقفني، وربما لأول مرة أن الأستاذ الصديق يرسل في قصيدته هذه شواظاً من الجمر أو هو اللهب، إلى: |
| .. القزم الساخط.. والمستهين بالطود ظهرا |
| وإذا بي أغضي عن النقد يأتيني جهارا من القميء وسرّا |
| وإذا بي أرى الذي جبرت له الكسر، ((لئيماً)) يطوي على الغل صدرا |
| وإذا بي أرى الكريم الذي جدَّ وأسدى يشكو من الدهر عسرا |
| وسمعت النهيق يطغى فيجتاح رخيم الأصوات طوعاً وقهرا |
|
| وحين يتوقّع القارئ، بعد المقطع الأول، الذي تتلاحق فيه ألسنة اللهب، أن يواصل الشعر ثورته، وإرسال شواظه، نجده يعود إلى هذه التأملات التي ما زالت تحتضن خيال ووجدان الأستاذ، منذ عهد طويل، وفي الكثير من عطائه المتدفق، حافلاً بألوان من التحليق والسبح في عوالمه الخاصة به. |
| وإذْ يندرُ أن تجد الشاعر يكشف عمّا في نفسه من الألم، ومشاعر الاستنكار الساخط على ما يلقاه في دنياه من وخز الحقد، ونغز الغل الكامن في الصدور، فإنّ هذا الشواظ من اللهب في هذه الأبيات القليلة، تقول لك إن دنياه، في السبعين من حياته، لم تخل من ذلك القزم، وذلك اللئيم الذي (جبر له الكسر)، ثم ذلك الذي (ينهق) فيجتاح نهيقه رخيم الأصوات طوعاً وقهراً.. |
| ولا يُغني الكلام عن تأملاته بعد هذا المقطع، عمّا في كل بيت من أبيات القصيدة العامرة من الآفاق، التي يحلّق فيها فكر لا يزال يعالج متناقضات الحياة، ومفارقات الأضداد فيها.. ولعلّي، إذْ أقف عند هذه (الغضبة) النادرة، لا أجد ما يمنع أن أشارك الصديق مشاعره، وعلى الأخص نحو ذلك (اللئيم) الذي (جبر له الكسر).. ولا أدري إذا كان يذكر مجلسنا في المستشفى اللبناني، وأحاديثنا عن أولئك الذين لا أجد ما يمكن أن يوصف به واحدهم، إلاّ أنه اللئيم حقاً.. وما أكثرهم.. بل ما أعجب أن تكون الحياة أحفل بهم وأكثر ترحيباً بوجودهم وكأنها لا تشعر أو لا تستروح ما ينتشر من نتن مسيرتهم بين الناس. |
| لم أستطع أن أقرأ الكثير الكثير من روائع الشاعر العظيم، في ديوانه الضخم بمجلداته الستة، وأعتبر أنها بعض جناية الظروف التي نعايشها، وقد أصبحت لا تترك لنا من حق الاستمتاع بالفن الأصيل، إلاّ ما نلتقطه من فتات، أو ننغبه من قطرات. |
| وبعد، فإن ما أجده يستحق أن أعايشه من حركة الفكر حولي، وفي كل ما تقذفنا به المطابع ودور النشر إلى جانب الصحف والمجلات، لا يزال أكثر مما تستوعبه هذه المساحة من (حروف وأفكار).. وهو ما أرجو أن أعود إليه في الأسبوع القادم. |
| * * * |
| لم يكن رحيل توفيق الحكيم عن دنيانا مفاجأة للذين كانوا - وأنا واحد منهم - يتابعون أخبار صراعه الحزين مع نهايته التي كنا نقرأ ونسمع أنه هو نفسه كان يتوقعها، إن لم نقل يستعجلها. وأنا أصف صراعه بأنه (حزين)، لأني لم أكن أشك قط، في أنّه، في كل مرةٍ استعجل فيها نهايته، كان يعايش حزنه المتجذّر أو العميق على فراق الحياة التي أحبّها، أو التي كان لا بدَّ أن يحبّها، وهي التي وجد فيها نفسه، ليس فقط كاتباً مبدعاً، تتهافت الجماهير على قراءة أعماله، بل - ومنذ أكثر من أربعين عاماً (عملاقاً). قد ينافسه رصفاؤه. وفي مقدمتهم الدكتور طه حسين، والأستاذ عباس محمود العقاد، ولكنه - بينه وبين نفسه - كان يؤمن بأنه قد قطع شوط الرهان أو هو ((السباق)) إلى المجد، فسبقهم.. لأنه كان يفهم - ربما أكثر من غيره - وهما من هذا الغير ، أن العمل الفني إبداع - يسميه بعضهم خَلْقاً - وقد كان منذ بدايته الأولى كاتباً مبدعاً - ونتأثّم فلا نقول ((خلاّقاً)) ولقد كان أول عهدي به، في كتاب صغير الحجم أو (مسخوطه) بعنوان (أهل الفن).. قد أنبش حفائر ذاكرتي، لأجده عن (أم كلثوم) وربما عن الشاعر (رامي). ولكن بأسلوب الإبداع، وذلك الحوار الذي تميّز به الحكيم في أكثر من 90% مما كتب. ثم ذلك المقال الذي نشرته مجلة الرسالة، بعنوان (من طه حسين إلى توفيق الحكيم)، ولعلّه سلسلة مقالات بهذا العنوان، قدم فيها الدكتور طه، توفيق الحكيم، الذي ربما كان يتعثر في شق طريقه إلى الأضواء.. وفاجأنا الشيخ أحمد حلواني في دكانه في القشاشية ذات مساء بأنه قد جاء بمسرحية (أهل الكهف) من القاهرة، وفي سنة تالية أو رحلة أخرى، همس بطريقته الخاصة، أنه قد جاء بـ (يوميات نائب في الأرياف).. ويمكن القول بالنسبة لي شخصياً: (وكرّت السبحة). إذ وجدت نفسي أتهافت على قراءة توفيق الحكيم، أكثر مما أقرأ الآخرين من العمالقة، ومنهم بالطبع (الدكتور طه، والعقاد، والمازني الخ..) ولذلك فقد اجتمعت لديَّ مجموعة وافرة من كتبه، كنت أمتنع عن بيعها، كلّما اضطرتني الظروف إلى بيع مكتبتي كلها، والأستاذ أحمد عبد الغفور عطّار قد يذكر أنه ساعدني على بيع إحدى هذه المكتبات - وأعني التي أسميها مكتبات كلّما تجمّع فيها عدد لا يقل عن ألف، أو نحوها من الكتب). |
| والإبداع عند الحكيم عملية فيها من اليسر بقدر ما فيها من البراعة في التكوين إذ ما أسهل أن ترى هذه الشخصيات التي يبدعها، تعايشك، أو تعايشها، وتنعقد بينها وبينك علاقات متباينة، فأنت مع هذا.. تتعاطف معه، وتنتظر له النهاية السعيدة، ثم مع تلك الفاتنة، تعبس في وجهها، رغم كل ما تسبح فيه من هالات الإغراء، لأن الحكيم قد استطاع أن يقيم بينها وبينك هذا الحاجز من مكرها، وقدرتها على العبث.. ثم حتى مع شخصيات (عودة الروح).. ما أكثر ما تتعاطف، وتذوب، مع هذا وتلك من الذين تزدحم بهم الرواية التي أعتبرها شخصياً من أفضل ما أبدع الحكيم. ويطول الحديث، إذا رحت أستعرض الشخصيات التي أبدعها ذلك الذهن الذي كان عبقرية نادرة، لم تستوف بعد حقها من التقدير، رغم كل ما أغدقته عليه صحافة مصر، وبعض أدبائها وكتّابها من إعجاب، بل رغم جائزة الدولة التقديرية، إذا كان قد مُنحها فيمن منحوها من الأعلام. |
| له كتاب صدر في عام 1942، أي في أيام الحرب العالمية الثانية، ولا شك أنه مما أوحت به أحداث تلك الحرب وظروفها، التي ألّف فيها العقّاد كتابه عن (هتلر)، وُصف بأنّه يتملق فيه الحلفاء، وقيل إنه اضطر - رحمه الله - إلى الهرب إلى السودان في تلك اللحظات التي أوشكت فيها قوات روميل أن تحتل الإسكندرية من موقعها الذي بلغته في العلمين. |
| هذا الكتاب أعطاه الحكيم اسماً عبر عمّا تنذر به الحرب، وما كانت تفرضه على مصر من الظلام فعلاً، إذ لم يكن بدُّ من دهن النوافذ باللون الأزرق الغامق، وإطفاء الأنوار عند سماع صوت صفارة الإنذار.. سماه: (سلطان الظلام)، ولم يستطع إلاّ أن يظل عاشق الإبداع كما هو دائماً.. يتأمل في دعة وهدوء عجيبين مصير الإنسانية، فيقول - وهو يعني الحرب قطعاً: (إن الظلام الزاحف على الإنسانية يخيفني) ثم يعلق على تصريح لوكيل خارجية أمريكا قال فيه: (ليس في مقدورنا أن نتكهن بشيء عن العودة إلى ظلام القرون الوسطى، على الأقل - فيما يتعلق بشؤون الفكر والروح).. فيتساءل الحكيم: (هل في الإمكان حقاً أن يمحق الإنسانية ظلامٌ، بعد هذا الشوط الذي قطعته في سبيل النور؟). |
| وحتى في هذا الكتاب لم يستطع الحكيم إلا أن يظل المبدع.. إذ نرى فيه قصة في حوار تمثيلي بعنوان: (تلميذ الموت). ويهديها إلى (أعداء الإنسانية..) ثم قصة أخرى بنفس الأسلوب يهديها - ولا أدري لماذا - إلى أهل النرويج، وإلى الشعب اليوناني ((منبع الفكر الحر والديموقراطية))، ثم قصة أرجّح أنه كتبها وألحقها بالكتاب، بعد أن حفّت الهزيمة بروميل وجيشه، وجيش حليفه الإيطالي. وهي بعنوان (محاكمة الطاغية).. لم يقل فيها إن الطاغية الذي يقصده هو (هتلر)، وإن كان واضحاً أنه لم يقصد سواه، إذا اختار لقاعة المحكمة مكاناً مشهوراً في أيامها، وهو (حانة البيرة) التي بدأ فيها هتلر عقد اجتماعاته بمن التفّوا حوله من أنصاره.. ولا بد أن يضحكك، أن يختار الحكيم (المهاتما غاندي) رئيساً للمحكمة.. وكان غاندي أيامها يقتلع بأظافر (المقاومة السلبية)، كتل الصخر التي أقامت بها بريطانيا استعمارها في شبه القارة الهندية. |
| على أن من أجمل ما أبدعه الحكيم في هذا الكتاب، قصة في إطار مسرحي من ستة مناظر، وينتهي المنظر السادس فيها بهذا الحوار: |
|
الملاك الأول (يصغي): ما هذه الأصوات والتراتيل؟ |
|
الملاك الثاني: تلك صلوات يقيمها رفاقك من أجلك.. فقد علموا أنك على الأرض في خطر. |
|
الملاك الأول: أمِنْ أجلي أنا يصلون؟ ألا فلتكن صلاة الملائكة أجمعين، من أجل أهل الأرض المساكين. |
| ولا أحتاج أن أقول إن الحكيم لم يحظ بما حظي به الدكتور طه حسين من ثناء وإعجاب والسبب، عندي، أن الإبداع الذي تعشَّقه الحكيم والتزمه، لم يبلغ أن يكون هاجس الثقافة في مسيرة المثقفين والثقافة العربية.. إذ إنه الهاجس الدخيل أو الطارئ بالنسبة لأجناس الأدب الأخرى. |
| ولا سبيل إلى التماس الينابيع الكثيرة، التي انتزع منها أو نهل توفيق الحكيم أدبه الإبداعي الثر، ولكن لا شك أبداً في أنه نهل الكثير من اللغة الفرنسية، وما ترجم إليها من الآداب العالمية الكبرى، ومنها (التراثية) كالأدب الإغريقي بملاحمه المعروفة، ومنها الحديثة كأعمال أكابر كتّاب إنجلترا وفرنسا وروسيا.. وإني لأذكر بالمناسبة تمثيليةً للحكيم بعنوان (نهر الجنون).. لا تختلف كثيراً عن قصة للكاتب الإنجليزي: هـ. ج. ويلز بعنوان (مملكة العميان).. وإني لن أنسى أني قد أخذت عليه - على الحكيم - أنه لم يشر مجرد إشارة إلى قصة ويلز.. ولكني قرأت فيما بعد، أن ويلز والحكيم كانا عالةً على أسطورة من أساطير الإغريق. |
| ثم.. قد أخذوا على الحكيم أنه تملّق عهداً، لم يسيء إليه فيمن أساء إليهم من رجال الفكر، ثم انقلب على ذلك العهد، في كتابه الذي ظهر في عهدٍ تالٍ. وقالوا إنه النفاق في العهدين.. وربّما وجد من حمل عليه بضراوة.. ولكن فيما يختص بهذا النفاق الذي عيّروا به وانتقصوا من شخصية الحكيم، أريد أن أقول، إن النفاق هو الوباء المتأصل والمتجذّر في الحياة العربية منذ نهاية عهد النبوة وحتى اليوم.. وهو يصيب الكثيرين، مئاتٍ وألوفاً، ولكن من أعجب أعراضه، وأشدها إثارة للعجب، أنه يتميّز عن جميع الأوبئة بأنه لا يستشري، ويأخذ في التضخم والانتشار، إلاّ بين القادرين على التعبير.. بين الشعراء والأدباء، وحملة الأقلام. |
| فلنتأمل تاريخنا العربي الطويل، ولنحاول أن نجد الذين نجوا من هذا الداء العياء.. أو من هذا الوباء اللعين.. ما أقلَّهم؟! وما أشد ما عانوه من قسوة الظروف.. بل ما أشدَّ ما عاناه حتى الذين أصيبوا به، من قسوة هذه الظروف التي كثيراً ما أطاحت بالرؤوس على النطع، وبالسيف في يد السيّاف. |
| فما هو الجديد عندئذٍ، بالنسبة لتوفيق الحكيم في كتابه (عودة الوعي).. بل ما هو الجديد، في أن يعود المبدع الكبير، إلى نفسه، وإلى نفاقه عهداً مضى مكفراً عمّا التزمه من صمت، كان دائماً هو النفاق.. إذ ما أكثر ما كان الصمت أعجب وأخطر صور النفاق. |
| * * * |
| لو كان حصاد المحاصيل والغلال الزراعية، أو حتى حصاد أو توافر الأموال بأنواعها في الخزائن الخاصة أو البنوك، يتزايد ويتراكم ويفيض، كما تتزايد وتتراكم وتفيض الأفكار والمعلومات، والملاحظات النابضة بخلفياتها المختلفة، إلى جانب الأحداث التي لم يعد في الوسع ملاحقتها إلاّ بإدخالها أجهزة الكمبيوتر.. لكانت النتيجة المنطقية أن يصاب العالم بتخمة، تتنوع أسماؤها بتنوع الأصناف، بحيث نسمع عن تخمة حبوب، أو تخمة فواكه، إلى جانب تخمة دولار وأسترليني، أو تخمة عمارات. وناطحات سحاب، تنافسها تخمة الذهب والفضة والأسهم والسندات. |
| وأجد نفسي مضطراً أن أكاشف القارئ بهذه الملاحظة، لأنّ حصادي أو محصولي من الأفكار والمعلومات، والملاحظات، والتعليقات على زخم الأحداث التي تلاحقت خلال الشهرين، بلغ الحد الذي جعلني أقف حائراً متسائلاً: هل تتوافر لديَّ الطاقة لمعالجة كل هذا الحصاد، بل هل يوجد، في عالم اليوم، القراء أو القارئ الذي يجد متسعاً من الوقت لإلقاء نظرة - أجل نظرة فقط - على هذا الذي أتمنى أن أراه منشوراً، ليس في هذه الصفحة فقط، بل في أضعافها مساحةً، وفي جميع صحف المملكة ومجلاتها. |
| وتساءلت مرة أخرى: ولكن ما هي الفائدة التي يمكن أن يحققها الكاتب - أي كاتب - من عرض حصاده على قراء الصحف والمجلات؟ وما هي إلا لحظات حتى وجدت هذا السؤال يستدرج أسئلة.. سلسلة من الأسئلة، منها - على سبيل المثال: هل يستهدف الكاتب أن يفيد القارئ؟ وكيف يقيم أو يقوّم هذه الفائدة وهو يتدفّق بهذا الذي يملأ الصفحة والصفحات من الكلام؟ أليس صحيحاً ومنطقياً، أن (خير الكلام ما قل ودل)، فما حاجتنا إلى التطويل أو إلى الشرح والتعليل.. وهل هذا الذي نكتبه وتنشره لنا الصحف والمجلات، هو (خير الكلام)؟ فإذا لم يكن كذلك - وهذا هو الأرجح - فلماذا نكتبه، ولماذا تنشره الصحف؟ |
| لا شك أبداً أن هناك فجوة واسعة وعميقة الغور، بين مفهوم الكتابة والغرض منها.. ويبدو لي، أنه لو أتيح لمن يكتبون أن يروا هذه الفجوة، وأن يدركوا أنهم في الواقع لا يحققون فائدة، ولا يستهدفون غرضاً من أي نوع، وأن الصحف والمجلات التي تنشر ما يكتب إنما تنشره لأنها متورطة أصلاً في عملية بالغة التعقيد والتشابك إلى جانب ما يفرضه الجهاز بطبيعة علاقته بالدولة من جهة، وبالجمهور من جهة أخرى، من مسؤوليات إضافة إلى تكاليف الإنفاق الذي لا سبيل إلى وقفه أو [ترشيده]، بعد أن بلغ حجم الجريدة أو المجلة، هذا المستوى طباعة متطورة، وتوزيعاً يغطي شبه القارة، وبين كل منطقة وأخرى ما لا يقل عن ألف كيلومتر.. وعلى ضوء هذه الحقيقة الماثلة، فلا بد للجريدة أن تملأ صفحاتها التي تجاوزت العشرين ولا سبيل إلى ذلك إلاّ باستكتاب الكتاب، والمحررين من كل مستوى، وبمؤهّل أو حتى بلا مؤهّل، وبغض النظر عن المادة المكتوبة، ولا حاجة لتوخي سلامة المكتوب من الأخطاء اللغوية والنحوية، لأن مصححي الجريدة - أعانهم الله - يستطيعون أن يتلافوا كل ذلك. |
| وهذا الواقع، بكل تعقيداته ومفارقاته والملاحظات التي تنصب عليه، هو ما بدا لي كأني أواجهه لأول مرة، بعد عودتي من رحلة علاج واستجمام قمت بها إلى أمريكا وجانب من كندا.. |
|
|
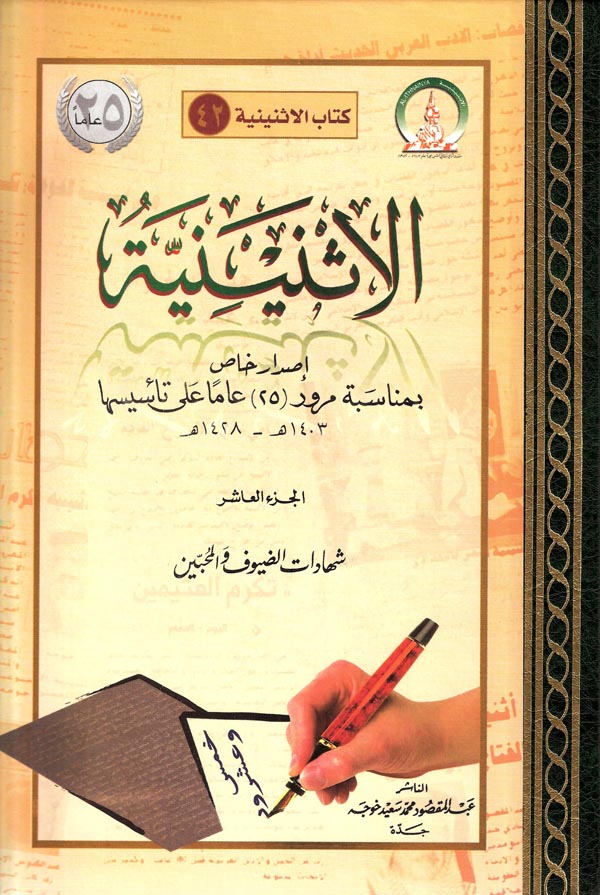
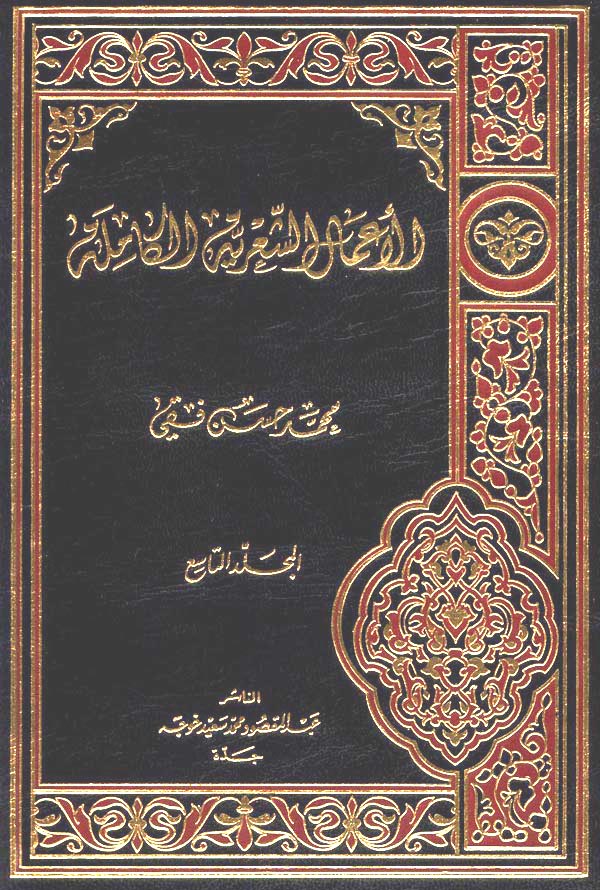
 شارع عبد المقصود خوجة
شارع عبد المقصود خوجة 00966-12-6982222 - تحويلة 250
00966-12-6982222 - تحويلة 250




