| أدب المرأة .. وأدب الرجل |
| لمعت في سماء الأدب في زماننا عشرات من الأديبات برزن في فنونه المختلفة، وكثر منهن الشواعر والكواتب ومؤلفات القصص والمسرحيات، وزاحمن الرجال في تأليف هذه الفنون وغيرها من أجناس الأدب، حتى بدا للناس أنه لم يعد هنالك من فرق في الحياة الأدبية بين الرجال والنساء لأنهن بلغن من القدرة على الإجادة ما استطاع الرجال أن يبلغوه منهما. |
| وليس هنالك من سبب يدعو إلى إنكار هذه الحقيقة أو الشك فيها، فقد شهدتها الأجيال والبيئات المتباينة، والعصور المتعاقبة، وبرزت في زماننا بروزاً منقطع النظير لعلها لم تشهد مثله فيما سبق من العصور. |
| وحسبنا أن نقرأ أسماء ميّ زيادة، وعائشة التيمورية، وسهير القلماوي، وعائشة عبد الرحمن، ونازك الملاكة، وأمينة السعيد، وغادة السمان، وجاذبية صدقي، وطلعت الرفاعي، وعزيزة مريدن، وعاتكة الخزرجية، ولميعة عباس، ووديعة الشبيبي، وسعاد الصباح، وعشرات من مثيلاتهن نبغن في تأليف الشعر، وكتابة المقالة ونقد الأدب، وتأليف القصص والمسرحيات. |
| وإذا كان من طبيعة المرأة الحس المرهف، وحدة الانفعال، والعاطفة المشبوبة، والخيال الخصب، فإنها تجد مجالها الأرحب في فن الشعر أكثر مما تجده في غيره من فنون الأدب. |
| وقد يكون في هذا ما يفسر لنا الكثرة الكثيرة المشهودة في عالم الأدب من الشاعر اتنوفي بعض البلاد العربية يفوق عدد الشاعرات عدد الشعراء، كما أن عدد الشاعرات يقل إلى درجة الندرة في أقطار أخرى. |
| ويرجع هذا التفاوت فيما أرى إلى التفاوت بين تلك الأقطار في درجة الأخذ بأسباب الحضارة، والاتصال بالعالم الخارجي، وفتح أبواب العلم، والثقافة أمام بنات حواء، وفي تشجيعهن على قرض الشعر وإنشاده في المحافل والمجتمعات، وفي نشر أشعارهن في الصحف والمجلات، ثم في تلك الحفاوة بهن، وبما ينظمن، وبما يكتبن، باعتبار ذلك شيئاً جديداً مستطرفاً في تلك البيئات العربية، والمجتمعات الإسلامية، ولكل جديد لذة. |
| ولقد كان لذلك الترحيب أثره في تشجيع المرأة الشاعرة على البوح بمكنون شاعريتها، والتصريح بمخزون عواطفها، وموالاة النظم، في أغراض الشعر المختلفة التي تثير مواهبها، فقد وجدت من ينشر ومن يقرأ، وسمعت وقرأت كلمات الإشادة من المعجبين الذي سمعوا ألحاناً جديدة أضيفت إلى اللحون المأثورة التي ترددت على أسماعهم من عزف القدامى والمحدثين من الرجال. |
| وأدى ذلك إلى إذكاء روح التنافس بين الشاعرات من النساء، إذ كانت كل شاعرة تريد أن تعلن عن شاعريتها، وتثبت تفوقها في هذا المجال على بنات جنسها، وكان لهذا التنافس أثره في غزارة الإنتاج، وفي إجادته وإتقانه أيضاً. |
| وثمة عامل آخر كان له تأثيره في روح الشاعرية وصقلها في بنات حواء، وفي تشجيعهن على المضي في الطريق إلى مداه. |
| وهذا العامل هو أخذ الآباء والأزواج بأيدي بناتهم أو زوجاتهم إذا كان لهم حظ من هذا الفن، وبخاصة في محاولتهن الأولى، حيث صلبت أعوادهن، واستطعن الوقوف على أقدامهن. |
| ويحضرنا من الأمثلة على ذلك باحثة البادية ملك حفني ناصف، التي كان لأبيها العالم الأديب الشاعر حفني ناصف الفضل الأكبر في إرهاف شاعريتها، وتنمية مواهبها. |
| ونازك الملائكة التي تمرست بفن الشعر حتى أصبحت إحدى طلائع التجديد في الشعر العربي الحديث، وقد كان لأبيها الأديب صادق الملائكة، أثر كبير في تشجيعها والأخذ بيدها، وقد كان واحداً من الشعراء المعروفين في العراق، كما ظهر تأثيره واضحاً في شاعرية أمها "أم نزار الملائكة" وأختها "إحسان" وأخيها "نزار". |
| ورباب الكاظمي ابنة الشاعر العراقي الكبير عبد المحسن الكاظمي أفادت من توجيهات أبيها إفادة واضحة، حتى لقد شك بعض المعاصرين في شاعريتها، وذهبوا إلى أن ما نسب إليها من الشعر ليس إلا من صناعة أبيها الذي نحلها إياه. |
| وقد عرف الأدب العربي على امتداد تاريخه الطويل كثيراً من الشواعر المجيدات في سائر العصور، وفي مختلف الأمصار، تقرأ لهن الشعر الجزل الرصين، كما تقرأ لهن الشعر العذب السلس الرقيق، وفي هذا وذاك تجد العبارة المحكمة الأنيقة، والمعنى الجيد الملائم للغرض الذي أنشد فيه، ولا تجدفيما تقرأ ما يشعرك بالاختلاف بين شعر النساء وشعر الرجال. |
| ولقد درج القدماء فيما كتبوا من السير، وفيما ألفّوا من كتب الطبقات، وفيما ترجموا لأعلام البشر على أن يترجموا للجنسين معاً، وألا يفصلوا بين الرجال والنساء، لأنهم لم يترجموا لهم ولم يتحدثوا عنهم إلا في موهبة من المواهب، وكأنهم لا يرون فرقاً بين الرجل والمرأة في تلك المواهب أو الأعمال. |
| ذكر محمد بن سلام في كتابه "طبقات الشعراء" أصحاب المراثي، فجعلهم طبقة واحدة تتكون من أربعة شعراء: متمم بن نويرة، والخنساء، وأعشى باهلة، وكعب بن سعد الغنوي. |
| وكذلك فعل ابن قتيبة في كتاب"الشعر والشعراء" فذكر النساء بين الرجال. |
| ولا شك أن عدد النابهين من الرجال في مختلف المجالات كان أكثر بكثير من عدد المذكورات أو النابهات من النساء. |
| وقلّ مِنَ المؤلفين منْ خصّ النساء بالإحصاء أو بالترجمة أو بالدراسة كما فَعل بن عمران المرزباني في كتابه "أشعار النساء" الذي ذكر محمد ابن إسحاق النديم في "الفهرست" وياقوت في "إرشاد الأريب" أنه يقع في ستمائة ورقة، وذكر القفطي أنه يقع في خمسمائة ورقة. |
| * * * |
| وإذا كان للمرأة ذلك النشاط المتصل في عالم الشعر في مختلف البيئات والأزمان فذلك لأنه أقرب إلى طبيعة المرأة، ورقة مشاعرها، وحرارة عاطفتها، وسعة خيالها، ولذلك وجدت لها متنفساً آخر في عالم الأدب، وأعني به في فن القصة الذي ازدهر في الأدب العربي في العصر الحديث، وأخذ يزاحم فن الشعر في كثرته ورواجه، وكثرة كتاب القصة التي برّز في كتابتها عدد كبير من القصاص العرب وأرسوا دعائم هذا الفن، ورفعوا منارته بين فنون الأدب العربي. |
| وفي مقدمة الذين اشتهروا بكتابة القصة من المصريين المويلحي، والمنفلوطي، وجرجي زيدان، وطه حسين، والعقاد، والمازني، ومحمد حسين هيكل، ومحمود تيمور، وتوفيق الحكيم، ومحمد عبد الحليم عبد الله، ويوسف السباعي، وإحسان عبد القدوس، ونجيب محفوظ، ومحمد سعيد العريان، ومحمد يوسف غراب، ويوسف الشاروني، وإبراهيم المصرين وصلاح ذهني، ومحمود كامل، ولطفي جمعة، وسعيد عبده، ويوسف جوهر، وحبيب جاماتي، ويوسف إدريس، وغيرهم كثيرون لا يحصون عدّا، وهذا في مصر وحدها إلى كثير من رواد هذا الفن في سائر أقطار العروبة. |
| وقد كان من أسباب رواج فن القصص إقبال القراء عليه خاصتهم وعامتهم على السواء لما يجدون من السهولة واليسر في استيعاب القصص، وما يجدون في قراءته من المتعة، ومن العزاء والسلوى فيما يتضمنه من وصف التجارب التي تشبه تجاربهم، ووصف أحوال المجتمعات، وبسط الأحداث التاريخية، واستخلاص العبر منها. وكذلك كان ترحيب النقاد بهذا الفن وكاتبيه من أهم العوامل في قوته ومحاولة دفعه أو دفع كتابه إلى الأمام، وإشعال روح التنافس بينهم. |
| وكان للمرأة حظ كبير من الفن القصصي في العصر الحديث، ونبغ في كتابة القصة عدد من النساء في مصر وغيرها من ديار العروبة من أمثال جاذبية صدقي (مصر) ووداد سكاكيني، وألفة الأدلبي (سورية) ونازك الملائكة وأختها إحسان (العراق) وسميرة عزام (الأردن). |
| وهكذا نرى أن المرأة قد قاسمت الرجل فن الشعر، ولا يختلف حظ أحد الجنسين في هذا الفن الإنساني عن حظ الجنس الآخر. |
| وفي فن القصة يقل حظ المرأة عن حظ الرجل، لا من حيث القدرة عليه، ولكن من حيث ذيوع النتاج القصصي الذي تنشئه المرأة مع ما قدمنا من أن هذا الفن القصصي أقرب إلى طبيعة المرأة، وقد يكون ذلك لقدرة الرجال على الاتصال بوسائل النشر التي تقوم على صلات وعلاقات قد لا تزاولها المرأة. |
| ويروي التاريخ الأدبي عن بعض النساء منذ العهود القديمة كلمات جيدة في الوصايا المأثورة اللائي خصصن بها أبناءهن وبناتهن، وهي ثمرات ناضجة لتجاربهن في الحياة، وخبرتهن بتصريف الأمور، ومعرفتهن بأسرار النفوس، وما تتقرب به النساء إلى قلوب الرجال، في عبارات محكمة، ومعان فريدة، يسهل حفظها، وجريانها على الألسنة حتى كانت أشبه بالأمثال السائرة. |
| أما فن الخطابة، الذي هو فن قيادة الجماهير، فقد تهيبت المرأة موقف الخطيب، ومواجهة الجماهير، لأن الخطابة موقف الرؤساء والقادة والزعماء، ولهم منازلهم في نفوس الجماهير، وفي عقول المخاطبين، وإن كان من الرجال من تهيب ذلك الموقف فأحجم عنه، وكان منهم من خانته شجاعته، فأفحم أمام العيون الشاخصة، والآذان المصغية. |
| وإذا كانت الخطابة تعتمد على الإقناع والتأثير، فإن قدرة المرأة على التأثير لا تقل عن قدرة الرجل، وربما كانت أقدر منه على التأثير في نفوس الأفراد والجماعات، ولكن منطق الرجل في الإقناع أقوى من منطق المرأة على كل حال. |
| * * * |
| لقد عالجت المرأة الشاعرة سائر الأغراض الشعرية، وعبرت عن سائر العواطف التي عبر عنها الرجل الشاعر، ولا غرو في ذلك إذا كانت هذه العواطف مشتركة بين الجنسين، وإن كانت تختلف من حيث الحدة والمقدار. |
| وإذا كانت الفطر السليمة والأخلاق الكريمة تأبى أن تقع العين على قبيح، وتنفر كل النفور مما يخل بالمروءة، ومما يخدش وجه الحياء منظوراً أو مسموعاً أو مقروءاً، فإنها تنفر من الابتذال والإسفاف والفحش وذكر السوءات في ذلك الفن الأدبي الجميل سواء في أدب الرجال وأدب النساء، بل هي أشد إنكاراً لما يقع من ذلك في أدب النساء من التصريح بما ينبغي إخفاؤه، والكشف عما يحرص الشرفاء على ستره، مما يكون بين الرجل والمرأة، مما أصبح يسمى في زمننا "الأدب المكشوف" وقد كان يسمي "أدب الخلاعة والمجون".. |
| وقد اشتهر بهذا الشعر جماعة من الشعراء على مر العصور وفي مختلف البيئات، منهم امرؤ القيس، وأبو نواس، والحسين بن الضحاك، ومطيع بن إياس، وابن حجاج، وابن سكرة، وأبو الرقعمق، وراشد بن إسحاق المكنى بأبي حليمـة، ومن شعـراء القرن الذي نعيش الشاعر العراقـي معروف الرصافي، ومن شعراء مصر عبد الحميد الديب، ومحمود غنيم، والعوضي الوكيل، وأحمد مخيمر وغيرهم ولا نجد ما يدعو إلى إيراد شيء من أشعارهم على سبيل التمثيل أو الاستشهاد. |
| وأكثر النقاد يرون في هذا الأدب الماجن الخليع انحرافاً عن مبادئ الأخلاق، واستثارة للغرائز الوضيعة في الإنسان، وتهييجاً لقوى الشر فيه، ومثلاً رديئة للفن الذي يتصف بالسمو والجمال، ومنهم من يرى في الكشف عن السوءات والتحدث عن المخبئات لوناً من التجديد، ومظهراً من مظاهر الصدق في التعبير عن النفس، وتصويراً لبعض جوانب الحياة التي ينبغي أن تظهر، لتظهر الصور المختلفة للحياة. |
| وكان العقاد ينعت كاتباً معروفاً من كبار كتاب القصة في مصر بأن أدبه هو "أدب الفِراش" لأن أكثر قصصه كانت تدور حول "الجنس" ويقول العقاد في ذلك إنه لا حاجة للناس إلى تفصيلات ما يجري في المخادع وراء الأبواب، ولكنهم يحتاجون إلى فهم الجنس لو زادهم ذلك علماً بمواطن الضعف فيه، ومبلغ الاعتماد على حفظه أو تفريطه في الحياة الاجتماعية والحياة الفردية تبصيراً بحقائق الحياة، وهواجس النفوس، لا تبصيراً بشيء يعرفه الحيوان قبل أن يعرفه الإنسان! ولك أن تسأل القارئ بعد الفراغ من قراءة كتاب يعرض للعلاقات الجنسية: ماذا تعلمت من هذا الكتاب؟ ! |
| فإذا كان قد تعلم منه سرّاً نفسياً فقد وجد فيه ما يستحق القراءة.. وإذا كان كل ما تعلمه منه سرّاً "مادياً" ليس إلا.. سرّاً تحجبه الجدران ليس إلا.. فهو عملية هدم لإزالة الجدران، وعملية هدم لإزالة الأخلاق والآداب. |
| ويرى المازني أن النزوع إلى الأدب المكشوف شبيه بالنزوع إلى العري عن اللباس، وأن النزوع الملحوظ في أدب القصة الأوروبية إلى تناول المسائل الجنسية بلغة صريحة، أو إلى الأدب المكشوف كما يقولون، شبيه بالنزوع إلى العري، بل الحركتان فرعان من أصل واحد، وهما في الغرب متسايران بخطا متقاربة.. |
| ولم يتحمس للدعوة إلى الأدب المكشوف والدفاع عنه أحد كما تحمس الكاتب المعروف سلامة موسى - وقد عرف الناس ثورة سلامة موسى على الأوضاع المألوفة، والقيم السائدة - الذي صرح بأن "موضوع الأدب هو موضوع الطبيعة البشرية على حقيقتها". ولا نزاع في هذا مع اقتصاره على "الطبيعة البشرية" لأن الأدب هو محاكاة الطبيعة كلها، سواء أكانت طبيعة داخلية تنتظم مشاعر البشر وعواطفهم وانفعالاتهم، أم كانت خارجية تشمل الكون والحياة بما فيها من الكائنات التي تؤثر في حياة الإنسان ومشاعره. |
| ويغلو سلامة موسى في انتصاره لهذا "الأدب المكشوف" حتى يذهب إلى وصفه بأنه يسمو بالنفس البشرية إلى ما هو أرقى من المألوف، وهذا نص كلامه في هذا الرأي الغريب: |
| "إذا عالج الأديب موضوع الحب فهو لا يقنع بما هو مألوف من العلاقات الجنسية، بل يسمو بها إلى ما هو أرقى من المألوف، فإذا احتاج في ذلك إلى صراحة تامة فيجب أن يمنح هذا الحق! إن للأديب قيداً واحداً فقط يتقيد به هو إخلاصه في عمله، وله الحق ما دام مخلصاً أن ينال الحرية في أن يبحث بصراحة كاملة جميع مسائل الجنس كما يبحث العالم مسائل الغازات السامة مثلاً، وليس في الأدب كله ضرر نشأ من الصراحة يساوي أو يقرب من الضرر الذي نشأ من الغازات السّامة" ! |
| لقد رأينا الكاتب في هذا الكلام الصريح يخلط بين الأدب المكشوف، أو الأدب الذي يكشف عن السوءات في الشعر والقصة والمسرحية والمقالة، وهو موضوع الحديث، والبحث عن الغريزة الجنسية أو غيرها من الغرائز البشرية. |
| ذلك أن البحث العلمي يرمي إلى تبين الحقائق لمن تعنيهم، والمعرفة المجردة بتلك الحقائق التي يضيف بها الباحث جديداً إلى ما توصل إليه المفكرون والباحثون في أي مجال من مجالات المعرفة من قبل. |
| أما الأدب فإنه تعبير ذاتي عن النفس البشرية ونوازعها التي تختلف من إنسان إلى إنسان. |
| والفرق كبير بين العالم الباحث عن الحقيقة واليقين الذي تقره عقول ذوي العقول والأديب الذي لا يعبر إلا عن نفسه ومشاعرها وخلجاتها وما يحوك في صدره وما يتفاعل هو ومختلف أحاسيسه وما يرى وما يسمع. |
| وقد يستحسن من الكاتب أن يتذكر الغازات السامة وهو في معرض حديثه عن أدب الجنس، ولكنه لم يوفق في تسويته بينهما في وجوب منح الحرية المطلق للأديب في التعبير عن الغريزة الجنسية كما منحت للباحثين(!) في الغازات السامّة بدعوى أن الضرر الذي يؤدي إليه دون الأضرار التي تصيب البشرية من الغازات السامة! |
| ولعل في هذا الحديث عن رأي واحد من المشجعين للأدب المكشوف وما أندرهم ورأي أعدائه وما أكثرهم ما يكفي، وإن كنا نعتقد أن الذين تصدوا لذلك "الأدب المكشوف" واستهجنوه وهاجموا أصحابه كان هدفهم ما ورد وما يرد منه في أدب الرجال. |
| وكان العقاد يصف القصص الذي كان يكتبه أديب معروف في مجال القصة، وكان يدور حول ما يكون وراء الجدران بين الرجل والمرأة، كان يصفه أو يسميه " أدب الفراش" وكان يلمزه دائما بهذا الوصف، وكان أنصار "الواقعية" يعدّون هذا اللون من أدب المخازي من "الواقعية السوداء" ! |
| وهو عند هؤلاء وأولئك أدب بغيض منكر، ينفر منه الذوق السليم، ويرفضه كل من كانت عنده بقية من خلق أو دين إذا صدر عن الرجل، وهم له أشد إنكاراً إذا صدر عن المرأة التي يزينها التصون والعفاف والحياء، ويرزي بها التبذل والاستخفاف، والبوح بما يخدش وجه الحياء.. |
| وقد جرؤت بعض النساء في هذا الزمان ممن يزاولن صناعة الشعر وكتابة القصة على التصريح بما لا ينبغي للحرة أن تصرح به أو أن تعلن عنه غير عابئة بالقيم السائدة في المجتمع الذي تعيش فيه. |
| ونكتفي في هذا السياق بالإشارة إلى شاعرة معاصرة يحسبها الناس أو تحسب نفسها إحدى المجددات في دولة الشعر الحديث، وهي تعبر عن تجربة من تجاربها في قصيدة صارخة نجتزيء منها بهذه الأبيات التي تعبر فيها عن لهفتها: |
| بـي شـوقٌ أدمنـه سَتْراً |
| وحنينُ يوشـك أن يعرَى |
| لو فـوقَ يديكَ هفا شَعري |
| لو طوَّق ساعدكَ الخضْرا |
| لو فوقَ الجفن، على عُنُقي |
| تتحسسني ثغراً، ثغراَ |
| لو نـامَ المتعَبُ مـن سفَرٍ |
| يتوسَّدنـي صـدراً عِطراَ |
| فأغيبُ بـدفْءِ جوانحـهِ |
| وأعودُ لأسألـه.. أُخْرَى! |
|
| هذه هي الأبيات الخمسة الأخيرة من تلك القصيدة التي لا يجمل أن تصدر عن امرأة، فليست هذه الصراحة المكشوفة هي الصراحة المحمودة في الفن الشعري، لأنها لا تعبر إلا عن نداء الجسد، وليس فيها شيء من الخيال الجميل الذي يصور السمو الروحي المنشود في كل شعر، والذي لا يتوقف عنده ناقد من النقاد. وطالما مجّدنا العاطفة والصدق الشعوري إلا في مثل هذا النموذج الحسي الصارخ. |
| ومنذ سنوات نشرت إحدى القصص المثيرة التي اهتزت لها بيئات الأدب في الوطن العربي كله. وهي قصة كتبتها امرأة عربية من سوريا تدعي "كوليت خوري" واختارت لها عنواناً مثيراً "أيام معه". |
| وعرف الناس من تعنيه بصحبتها في تلك الأيام، وهو شاعر عربي معروف جل شعره في المرأة ومفاتنها، ويقول الأستاذ نديم نعيمة إنه فتش عن المرأة في شعر ذلك الشاعر محاولاً أن يلتقي بها إنسانة حية تعاني كغيرها من الناس مشكلة الحياة والوجود.. وكما تبدو لعين إنسان، فأخطأها، ولقي مكانها الأنثى كما تبدو لعين الذكر، فهي دائماً كما صورها ذلك الشاعر "نبيذية الفم، جائعة الشفتين، مشنجة العروق، سعيرية النهدين ملتهبة المفاصل، جحيمية البدن، إن لبست تذيب تحرّقا إلى عُريها، وإن تعطرت فلكي تشحن الفضاء برائحة الغريزة، لا يرتاح لها سرير، ولا يخشع من صخبها ليل، ولا يهجع من وهجها عصب".. |
| ذلك ما صور به الناقد ذلك الفارس في المرأة في عدد من دواوينه التي أخلصها لوصف فتنتـه بها، ولقد هامت به الكاتبة، وسجلت في كتابها ذكريات الأيام "السعيدة" التي قضتها في أحضانه بعيدين عن أعين الرقباء. |
| ولقد أثار هذا الكتاب جماهير الأدباء والكتاب الذين أتيح لهم أن يقرءوه، وكانت بنات حواء أكثر من الرجال ثورة عليها، وإنكاراً للأدب الرخيص الذي صورته في كتابها، فقد رأين فيه جريمة لا تغتفر، لأنه يسيء إساءة بالغة للجنس كله، وتعرية للمرأة العربية، وتجريداً لها من الحياء ومن القيم الأخلاقية التي عاشت مرفوعة الرأس في ظلالها. |
| وقد يذهب بعض المعقبين إلى أن صنيع "كوليت خوري" ومثيلاتها من الأديبات العربيات، إنما هو تقليد ومحاكاة لصنيع بعض المستهترات من الكاتبات الأوروبيات، وفي مقدمتهن الكاتبة الفرنسية المعروفة "فرانسوا ساجان" وقد لا يرون بأساً في هذا التقليد الأعمى، ويعدونه علامة من علامات التحضر والرقي، وخطوة في سبيل اللحاق بركب الغرب في نهضته المشهودة. |
| وأنا أقول إن الجمال في مقدمة ما ينشده الرجل في المرأة، وفي مقدمة ما تتباهى به المرأة، وتعمل دائماً على صيانته واستدامته، لتبقى لها منزلتها في عالم المرأة، وتظل محببة إلى قلب الرجل، فإذا حرمت هذا الجمال احتالت له بوسائل مصطنعة تخفي بها دمامتها وقبحها. |
| ولا شك أن جمال الروح وأدب النفس وعفة اللسان أو القلم يضيف إلى الجميلة ما يزيدها جمالاً، ويهب من حرمت بهاء الوجه أو جمال الجسد تقديراً واحتراماً يرفع من شأنها، ويمكن لها في قلب الرجل. |
| ولا عبرة بما أصاب بعض المجتمعات في الشرق أو الغرب من فساد وانحلال، أو تغيير في قواعد السلوك، أو تشويه للقيم الاجتماعية، فإن هنالك قيماً خالدة باقية ما بقيت السموات والأرض، وفي مقدمتها القيم الروحية والقيم الخلقية، والفضائل النفسية، وفي طليعتها فضيلة الحياء، وليس في استطاعة مدع أن يجهر بإنكارها أو التشكيك فيها. |
| * * * |
|
|
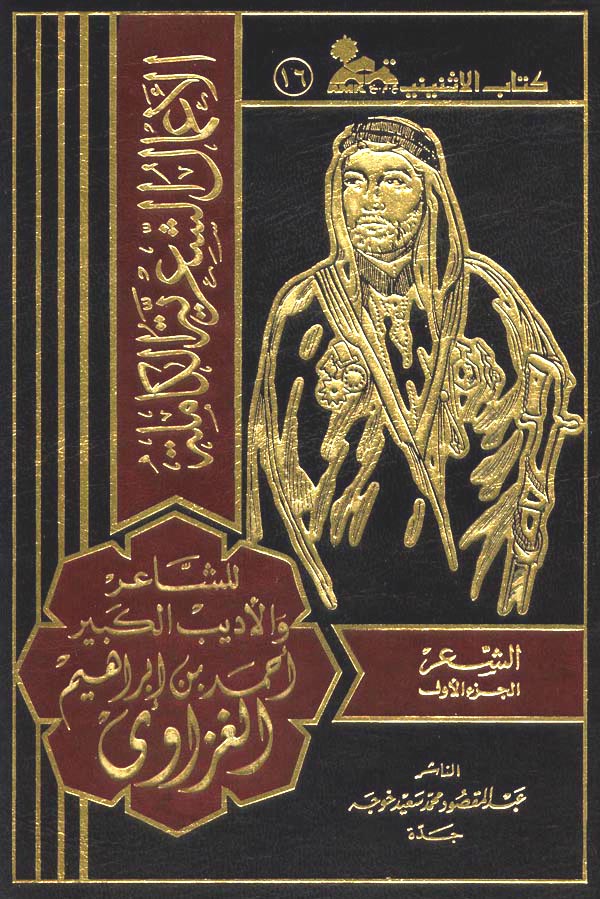
 شارع عبد المقصود خوجة
شارع عبد المقصود خوجة 00966-12-6982222 - تحويلة 250
00966-12-6982222 - تحويلة 250




