| أحمد تيمور
(1)
|
| كتب العلامة ابن خلدون مقدمته التي درس فيها طبيعة العمران، وأحوال المجتمع الإنساني، وما يسمو به من الأعمال والصناعات، وما ينحط به من العلل والآفات. وكتب في تلك المقدمة فصلا جاء فيه أن كثرة التأليف في العلوم عائقة عن التحصيل، وذكر أنه مما أضر بالناس في تحصيل العلم والوقوف على غاياته كثرة التأليف، واختلاف الاصطلاحات في التعاليم وتعدد طرقها.. فيحتاج المتعلم إلى حفظها كلها أو أكثرها، ومراعاة طرقها. ولا يفي عمره بما كتب في صناعة واحدة إذا تجرد لها، فيقع في القصور.. |
| وإذا كان قول ابن خلدون في أن كثرة التأليف وتشعبها تعوق تحصيل العلم، يصدق على أكثر الناس لما فيه من تشتيت الجهود، وبلبلة الأفكار، واضطراب العقول بين موادها المختلفة، فإن هذا القول يفقد صدقه عند عالمنا الكبير المغفور له أحمد تيمور الذي لم يعقه عن تحصيل العلوم كثرة كتبه، ولا تعدد مراجعه في كل فن من فنون المعرفة التي عرض لها بالدراسة العميقة ثم بالتأليف النافع.. |
| قضى أحمد تيمور حياته الغالية، وبذل أمواله الوافرة في التنقيب عن أصول العلم ومراجعه، يجد في طلبها ويشتريها بالحر من ماله، ويستنسخها لنفسه، حتى اجتمع له ما لم يجتمع لواحد من المولعين باقتناء الكتب ونفائس المخطوطات في زماننا، وأصبحت مكتبته الخاصة ثالثة المكتبات في الديار المصرية، بعد دار الكتب المصرية، والمكتبة الأزهرية. |
| ولم تكن المكتبة التيمورية في حياة صاحبها مظهرا من مظاهر الزينة والترف، ولا سببا من أسباب الإدلال على الناس بكثرة ما اقتني منها، وما جمع من شواردها، كما يفعل ذلك بعض السراة الذين يزينون دورهم بخزائن الكتب، وتنسيق مجلداتها، ليفتنوا بها روادهم، ويروهم أنهم من العلم بسبب، وهي لا تعدو في حقيقة أمرها أن تكون أشبه بالدمي الصامتة وبالتماثيل المنصوبة التي قد تبهظ أثمانها، وحظ صاحبها وحظ روادها منها لا يعدو النظر إليها في خشية واستحياء. وغاية ما يشتهون أن يقال إن هذا الكتاب منه نسخة بمكتبة فلان، ليتيه بذلك ما يشاء، ويزداد به زهوا وخيلاء، ثم يتوارثها الأبناء والأحفاد في جملة ما يتوارثون من الحطام وسقط المتاع، وما انتفعوا وما نفعوا. |
| ولكن مكتبة أحمد تيمور ظلت طوال حياته نزهة طرفه، ونور عقله وقلبه، وأمل رواده، وكعبة قصاده، ينهل من بحارها ما شاء، وينهلون منها ما استطاعوا، وهو راض قرير العين، سعيد سعادة الأمجاد بقري الضيفان. |
| ولم يشأ أحمد تيمور أن تظل تلك المكتبة الزاخرة بعد وفاته حبيسة بين جدران داره، ليرثها أبناؤه في أغلى وأعز ما يورث من متاع الحياة الدنيا. |
| ولكنه كان يؤمن بشركة العلم، ويعرف إثم من يحبسه عن طلابه، فأهداها إلى حيث يرِدُها البعيد والقريب، وينتفع بذخائرها النفسية كل راغب من غير حرج أو تثريب. |
| إن للعلم حقا بل حقين، عرفهما أحمد تيمور ورعاهما، وقام بهما خير قيام، وهما حق التحصيل، وحق الإفادة بذلك التحصيل. ولم يقصر أحمد تيمور في رعاية الحقين، فأكرم نفسه بالعلم الذي حصله، والمعرفة التي أفادها. ثم وقف ما جمع وما حصل على طلاب المعرفة الذين رأى أنهم يحتاجون إلى ما جمع، ولا يجدون إليه السبيل إلا في مثل ما صنع. |
| * * * |
| ويرسم أحمد تيمور لنفسه صورة الرجل الفاضل، وهي صورة فذة في زماننا، وهي أيضا صورة كريمة ترفع من شأن العلم، وتعظم من دولة الأدب، وتعيد لهما سيرتهما الأولى من رعاية الذين استطاعوا هذه الرعاية، والذين ملكوا أسبابها، أيام كان للعلم صولته، وكانت للأدب دولته، وأيام كان جلال الملك وعظمة السلطان لا يجدان لهما مظهرا إلا في مساندة العلماء وإشادة الأدباء. |
| فقد عرف تاريخنا الحديث بيت تيمور، وصلته الوثقى بأصحاب السلطان، بل ومشاركته في هذا السلطان. |
| والسلطان والجاه صنوان، وحيث يكون السلطان يكون الجاه. ولكن الجاه الذي يستمد من السلطان هو أيسر ألوان الجاه، لأنه جاه لا عناء في تحصيله بعد الحصول على السلطان، وما يتيح لصاحبه من الصولة بالأمر والنهي والحل والعقد، والاستعلاء بما يملك من أسباب الترغيب والترهيب. |
| وقد عهدنا أصحاب الجاه والثراء والسلطان، إلا قليلا ممن عصم الله، تغرهم النعمة، وتفتنهم الدنيا، فيصدون عن ذكر الله، شامخين بأنوفهم، متعالين على بني جلدتهم، يتهافتون على شهوات النفس تهافت الفراش على النار، ويتهاوون في حمأة الرذائل، فتحول نعمة الله عليهم نقمة، وبلاء لمن يخالطهم من بني البشر الذين ينظرون إليهم نظرة السادة إلى العبيد، أو نظرة الأحرار إلى الأرقاء. |
| ولكن أحمد تيمور يصدف عن ذلك الجاه الذي استمده من كرامة المنبت، ومن عراقة البيت، ومن سلطة الآباء لأنه جاه لم يبنه بيده، ولم يحصله بجهده ولذلك طلب الجاه الذي يبقى، والمجد الذي يغني، وهو مجد العلم النافع، وجاه المعرفة الباقي، مع الخلق العالي، والدين القيم، والتشبث بالفضائل النفسية، ومكارم الأخلاق التي حلاه بها الله، فإذا كان صحب أولئك هم المُجّان والفسّاق فإن صحب أحمد تيمور هم حملة العلم وأركان دولة الأدب، وإذا كان نديم أولئك الكأس والشراب، فإن نديم أحمد تيمور هو القلم، وأنيسه الكتاب، ولذلك صان الله نفسه الزكية، فتعالت عن الآثام، وصان ماله فلم ينفق منه إلا في حلال. |
| * * * |
| وصورة أخرى من صور كمال النفس، وتماسك الشخصية، تطالعنا في أحمد تيمور.. فقد كان على صلة باللغة الفرنسية إلى درجة الإجادة والإتقان، فقد تلقاها طفلا، وأتقنها يافعا، كما كان على معرفة باللغة الفارسية واللغة التركية، وقد اطلع على ما شاء من العلم الذي انتهى إليه أصحاب هذه اللغات والآداب التي كتبت بها. |
| ومن عادة الذين يقفون على بعض ما وقف عليه أحمد تيمور أن يشمخوا بأنوفهم، ويتنكروا لقوميتهم ومقوماتها، ويدلوا على قومهم بهذه المعرفة المجتلبة، فيجترون كلام غيرهم، وأفكار الأجانب عنهم، وكثيرا ما ينتهبونها، وينسبونها إلى أنفسهم منتهزين غفلة الناس عن مصادر إفادتهم. وقد يأخذك العجب حين تقرأ أو تسمع أن رجلا عربيا أو امرأة عربية، عاش كلاهما حياته أو أكثرها في أرض العروبة والإسلام، ثم صاغ شعراً، وألف دواوين باللغة الفرنسية أو غيرها من اللغات الأجنبية في حين أنه لم يخط في الأدب العربي سطرا واحدا أو بيتا من الشعر، وماذا يكون "مركب النقص" الذي يذكره علماء النفس إذا لم يكن مثل هذا؟. |
| ولكن أحمد تيمور كان كما قلنا يعرف نفسه ويعرف مقوماته الأصيلة وما تحتاج إليه من كشف وتوضيح، أو دعم وتوكيد فأكبّ على علوم العربية والثقافة الإسلامية يكمل بها نفسه، ويتعمق فيها، وأن يصل إلى مستوى رفيع من المعرفة بأسرارها، ويتيح له أن يبحث فيها، وأن يكتب عنها، ويدل على مصادر علمها وموارده، حتى استطاع أن ينفع بما انتفع. |
| ولقد كان خير ما ورَّث أحمد تيمور أبناءه تلك الخلال الإنسانية الرفيعة فأشربهم حب العروبة والإسلام، وحب عملها وأدبها، إلى جانب ما ورثهم من المثل العالية في نبالة النفس، وفي مكارم الأخلاق. فكان كل واحد منهم صورة لأبيه، أو صورة الخلف الكريم للسلف الصالح. |
| * * * |
| أحمد تيمور وأبو العلاء |
| والكتاب الذي نقدمه اليوم عن أبي العلاء المعري هو واحد من تلك الآثار التي لا تكاد تحصى مما كتب العلامة أحمد تيمور التي يهتدي الباحثون عنها كل يوم إلى كتاب جديد منها، يضيف إلى كتـاب المعرفة فصولا جديدة عزيزة، وهي في الوقت نفسه جهود نافعة. |
| والحقيقة التي لا بد من الإقرار بها أن هذا الكتاب ليس أول كتاب في التاريخ عن أبي العلاء المعري، فقد فاضت الكتب منذ قبض فيلسوف المعرة إلى زماننا هذا بالحديث عن أبي العلاء، واستقصاء أخباره، وتتبع آثاره وأفكاره، والبحث على أسرار نفسه، وهواجس فكره، وصحة معتقده، ثم دراسة عامة لأدبه، وما أبدع في فنيّ المنظوم والمنثور. |
| وكان أبو العلاء جديرا بهذه العناية المتصلة، جديرا بأن يملأ الدنيا ويشغل الناس بعد مماته كما شغلهم في حياته، إذ كان أبو العلاء أشبه بالظاهرة الجديدة أو الظاهرة الغربية في العصر الذي عاش فيه، فقد اجتمع حوله من أسباب العلم الأصيل بحياة أمته وتاريخها، كما اجتمع له من صنوف علمها وفنون أدبها ما لم يجتمع لواحد من معاصريه، وعرف من أحكام الدين وثقافة الإسلام شيئا كثيراً. وغذى نفسه بألوان من الثقافات الوافدة التي تعظم من شأن العقل والاحتكام إلى المنطق إلى جانب ما تحوي من الأساطير والخرافات، وكان من نتيجة ذلك كله، أن يكون في عقله وفي قلبه ألوان من الحضارات ومزاج من الثقافات ظهر أثرها في كلامه وفيما أملاه من العلم والأدب. ومهما يكن من جهد يبذله إنسان، فإن طاقته البشرية وعمره المحدود لا يتسعان لهضم هذه الثروة الطائلة من المعارف التي أفنت الأجيال، وانتهبت أعمار الأمم والجماعات. فكان من أمر أبي العلاء، ما كان مما حير الناس في فهم كلامه، وإدراك مراميه. |
| وأصبحت الكتب التي ذكرت أخباره، ونقلت أفكاره ملتقى لكثير من الأقوال المتباينة، والآراء المتناقضة، حتى اتهمه من اتهم، وأنصفه من أنصف، وكان كل من الفريقين يستند إلى ما قرأ، ويعتمد على ما سمع، وكان فيه ما يدعو إلى الشك، كما كان فيه ما يحمل على اليقين. ولذلك لم يكن الذين أنصفوا أبا العلاء مخطئين، ولم يكن الذين أنصفوه مسرفين. |
| ويستطيع قاريء كتاب أحمد تيمور عن أبي العلاء أن يستغني عن تلك الآثار الكثيرة من كتب الطبقات ومراجع الأدب التي تحدثت عن فيلسوف المعرة. وأستطيع أن أقول في غير تحفظ إن ذلك القارئ لن ينقصه شيء ذو بال من المعرفة التي ينشدها عن أبي العلاء، وستفضي به قراءته الممعنة إلى الاعتراف بأن هذا الأثر من آثار أحمد تيمور كتاب فذ بين كتب السير وتراجم الرجال، لأنه يرى دراسة عميقة واعية، فيها النظرة الفاحصة التي تنشد الحقيقة، وتبحث عنها في مظانها، إن جشمت النفس ما لا تطيق، وإن أكدت الخواطر، وأوهنت العزائم في تحقيقها. |
| * * * |
| وسيرى القارئ في هذا الكتاب، كما يرى في سائر مصنفات أحمد تيمور دقة صاحبه وحرصه على أمانة العلم، فلم يستشر مرجعا إلا صرّح به، ولم يفد من رأي إلا أسنده إلى صاحبه. وهنا تروقك غزارة ما قرأ وكثرة ما وعي، وترى صبره الطويل، وقدرته العجيبة على الفحص والتدقيق. |
| ثم هو لا يجتزيء بما قرأ وما استوعب، ولا بما استطاع أن يؤلف بين الروايات والأخبار، وكان ذلك حسبه.. ولكن فكرته الخاصة تتجلى لك واضحة بين السطور، وأثر فقهه العميق يتضح في رد هذه الشبهة، أو تفنيد تلك الرواية، بكلام العارف الواثق بمعرفته، المطمئن إلى رأيه، والذي لا يتهافت على طلب مالا تسغيه العقول، أو يأباه المنطق السليم. |
| وتحدث أحمد تيمور في كتابه هذا عن أهم النواحي التي يحتاج إليها القارئ في التعرف على أبي العلاء، فتحدث عن نسبه وأخباره، ودرس شعره، وبحث عن معتقده. وسيروعك في كل ما تقرأ ما تطالعه من آيات تمكّن الكاتب من موضوعه، وجمعه بين علم الرواية وعلم الدراية. وسترى مصداق ذلك في أول صفحة تطالعها من صفحات الكتاب. فبعد أن يورد المؤلف نسب أبي العلاء كما نسبه ابن خلكان يقول: "وهذا أصح ما وجدناه بالمعارضة على ما في كتب الأنساب، فإن فيما ذكره ياقوت في "إرشاد الأريب" إسقاطاً لبعض الأسماء واضطرابا في ترتيب بعضها، فاعتمدنا على رواية ابن خلكان بعد تصحيح ما حرف منها، فإن خزيمة بن تيم الله جاء في النسخة المطبوعة ببولاق جذيمة بالجيم والذال المعجمة. وما نص عليه في كتب اللغة والأنساب خزيمة بالخاء والزاي مصغرا. "وتيم الله" بن أسد هكذا في جميع ما وقفنا عليه من الكتاب، وجاء به أبو العلاء في سقط الزند: "تيم اللات" في قوله: |
| "سألته قبل يوم السير مبعثه إليك ديوان تيم اللات ماليتا"، وقد يكون هذا تحريفا في النسخة، إلا أن من خبر شعر أبي العلاء ومذهبه في تكلف الصناعة والتجنيس، رجح أنه ما أتي بقوله "ماليت" أي ما نقص، بعد قوله "اللات" هذا ربما كان غير "تيم الله" المذكور مقدما، وهو مردود بما ذكره الشارح في سياقه نسبه - عند شرح البيت… |
| أرأيت أثر العلم في مقارنة الروايات بعضها ببعض؟. |
| ثم أرأيت أثر العقل في تصحيحه وترجيحه مستندا على ما يعرف من علم الأنساب وعلم اللغة، وما يعرف عن مذهب أبي العلاء في شعره، وولوعه بالصناعة والتجنيس؟. |
| ثم أرأيت إلمامه بكافة ما تفرض العقول من احتمالات ؟ ثم احتزاره بعد ذلك الذي لا ينكره عليه عارف بقوله "والله أعلم؟!" تلك طريقة أحمد تيمور، وهي طريقة العارفين المحققين والعلماء الثقاة، الذي لا يقطعون بالحكم ولا يجزمون بالقول، وإن بدت الحقيقة في كلامهم أوضح من الشمس في رائعة النهار، لأنهم لا يعرفون تواضع أولي العلم، ويؤمنون بأن فوق كل ذي علم عليماً. |
| وعلى هذا النحو من الرواية والدراية يمضي المؤلف في تحقيق كل خبر، حتى تأتي على الكتاب كله وليس في ذهنك إلا العلم الأكيد والحقيقة المصفاة. |
| وقد يستطرد المؤلف حرصا على إفادة القارئ بما يعز عليه تحصيله والوقوف عليه. وذلك منهج مسلوك عند قدامى المؤلفين في العربية وأدبها، ومن أظهر الشواهد على ذلك أنه عندما عرض لقول أبي العلاء في حادثة بعينها "الكلب من لا يعرف للكلب سبعين اسما" واستطراده إلى القول بأن جلال الدين عبد الرحمن السيوطي جمع أكثر من ستين اسما للكلب ونظمها في أرجوزة سمّاها "التبرَّي من معرة المعري"، ثم أورد تلك الأرجوزة إتماما للفائدة لعزة وجودها، ثم أعقبها بشرح مفصل يميط اللثام عن الأسماء الواردة فيها، وأتبعه بما استدركه على الناظم من أسماء الكلب، وصفاته، حتى استغرق هذا الاستطراد عددا كبيرا من الصفحات. |
| وكذلك استطراده حرصا على الإفادة إلى إيراد قصيدة "عدي بن الرقاع" التي مدح بها الوليد بن عبد الملك، وقد أوردها كاملة لأنها ـ كما يقول ـ لا توجد برمتها في كتب الأدب المتداولة في الأيدي، مع تشوق كثير من الأدباء للوقوف عليها. |
| * * * |
| ذلك أحمد تيمور العالم الذي لا يشق له غبار. |
| أما معرفة أحمد تيمور بالشعر والأدب، فحسبك دليلا عليها في هذا الكتاب الفصل الذي عقده لدراسة شعر أبي العلاء، وقد تكلم فيه عما كرره من المعاني وعن سرقاته، وعن مآخذ الشعراء من شعره، ومقارنة بعض معانيه بمعاني غيره. |
| وحديثه في كل موضوع من هذه الموضوعات يدل على قدرة بارعة في تذوق الشعر، والغوص في بحاره، وسبر أغواره، والوقوف على أسراره، وكل ذلك يرفع أحمد تيمور إلى مستوى النقاد الكبار، ولا تلحظ في نقده أثرا للتعصب على الشاعر، ولا رغبة في مجاملته، إنما تري الحق واضحا، والإنصاف كاملا في ذكر ما للشاعر وما عليه، وفي هذا الفصل تجد الموضوعية وحدها هي التي توجه ناقدنا الكبير إلى الحكم الصحيح، وإلى الرأي الصادق، وقد يقتنع بكلام غيره فيسجله، وكثيرا ما يكون الرأي جديراً بالتقدير والإعجاب. |
| ويستهل تيمور في كلامه في سرقات أبي العلاء بقوله "هذا باب لم أقف عليه مجموعا" فيسهل عليّ تناوله، واستيفاء الكلام فيه، وإنما أذكر منه ما اتفق لي العثور عليه في كتب الأدب عند كتابة هذه النبذة، أو استخرجه الخاطر الكليل أثناء مطالعة ديوانه! ثم يعرض عليك عددا كبيرا من أبيات أبي العلاء أفاد فيها من غيره. |
| واستخراج مآخذ الشعر بعضهم من بعض ليس بالدرجة التي قد يتصورها أكثر الناس، فإن الأخذ أو الاحتذاء كثيرا ما يدق ويخفى، حتى لا يفطن إليه عامة الأدباء وأكثر خاصتهم، إذ أن الذين يحاولون الإفادة من غيرهم، إنما يبذلون جهدا كبيرا في إخفاء معالم سرقاتهم فيخرجونها عن صورتها الأصلية، ويكسون المعاني كسوة جديدة حتى لا يفطن إلى موضوع الإفادة أكثر من يمر بها. ولذلك كانت فطنة تيمور إلى مآخذ أبي العلاء من الشعراء أو مآخذهم من معانيه إحدى الآيات على قدرته الفائقة على النقد والتمييز. ومن أمثلة ما أورده من سرقات أبي العلاء قول البحتري: |
| نشوان يطرب للسؤال كأنما |
| عنـاه ملك طـئ أو معبـد |
|
| أخذه أبو العلاء وزاد فيه زيادة لا تخفي على الأديب، فقال: |
| فما ناح قمري ولا هب عاصف |
| من الريح إلا خاله صوت سائل |
|
| فالبحتري جعل ممدوحه يطرب لصوت السائل طرب المنتشي من المغني المجيد، وأبو العلاء جعله كلما سمع صوتا من تطريب حمام أو إزعاج أرواح، خاله صوت سائل لمزيد اعتنائه بالسؤال وولعه بالنوال. |
| ولا يرى أحمد تيمور السرقة إلا في المعاني المختصة التي عرف أصحابها أما المعاني المشتركة فلا سرقة فيها لشهرتها، وجريانها على ألسنة الشعراء، فلا فضل فيها لمتقدم على متأخر. فقول أبي العلاء: |
| مني إليـك مع الرياح تحيـة |
| مشفوعة ومع الوميض وصول |
|
| لا يعد من السرقة في شيء، وإن سبقه غيره إليه لأن إرسال التحية مع النسيم أو البرق من المعاني الشائعة التي تداولتها الشعراء، ولم تزل تتداولها. وإنما يظهر التفاضل بينهم فيمن يحسن سبكها وإبرازها في اللفظ المقبول، والتلطف في تصويرها… وما أقرب هذا الرأي من رأي القاضي علي بن عبد العزيز الجرجاني في وساطته بين المتنبي وخصومه. |
| وتبدو عناية أحمد تيمور بدراسة "السرقات" حتى لقد عزم أن يؤلف فيها كتابا، قال "والكلام في السرقات الشعرية وأنواعها، واستيعاب ما قيل فيها، لا يتسع له في مثل هذا المختصر، فإذا منََّّ الله بتوفيقه، وكان في العمر مهلة، وضعنا فيها رسالة تستقل بجمع أشتاتها، وتفصيل ما أجمل منها" ولا ندري أألّف هذا الكتاب في فسحة الأجل القصير، أم اخترمه الأجل دونه وليت "لجنة نشر المؤلفات التيمورية" تظفر به بين ذخائرها، لتخرجه أثرا نافعا كعهدنا بسائر آثار أحمد تيمور. |
| * * * |
| أما الفصل الذي خصصه للبحث عن عقيدته فقد درس فيه اختلاف الناس في عقيدة أبي العلاء، ومعتقدة في الله تعالى، وفي النبوات والرسل. |
| وقد تأمل المؤلف المختلفين فيه، فوجدهم على ثلاثة أقسام: |
| فريق متزندقون، يكفرونه ويحبونه لكفره، ومنهم متفرنجة هذا العصر، أو مؤمنون يبغضونه لذلك. وفريق يذهبون إلى صحة إيمانه، وربما تغالوا فألحقوه بالأولياء الواصلين، ورووا له الكرامات. وآخرون متحيرون أمسكوا عنه، ووكلوا أمره لخالقه. |
| ثم بدأ بأقوالهم فيه، وعقَّبها بما ثبت من أقواله. وقد عرض هذه الأقوال بأمانة العالم، ودقة المحقق، وعدالة القاضي. وانتهى به البحث إلى إنصاف المعري مبرئا نفسه من العصبية، قال: "إني لم أنتصر له في بعض المواقع جنوحا إلى عصبية، أو استرسالا مع هوى. ولكني وقفت في الكثير من أقواله على اعتقاد صحيح، وإيمان ثابت لا يخالطه شك. فكان تأويل ما عداها بما يحتمله اللفظ أولى من التسرع إلى إكفار مؤمن، والحكم عليه بالزندقة، خصوصا وأن ما يدل على إيمانه صريح في لفظه، والذي يوهم محتمل لوجهين، فحمله على ما يوافق الصريح من أحد وجهيه أحق وأصوب". |
| ولا شك أن قراءة هذا البحث المستفيض ستفضي بالقارئ إلى مثل ما أفضى بأحمد تيمور إلى الإنصاف المبني على التثبُّت واليقين في صحة عقيدة أبي العلاء، لأن المؤلف الأمين لم يحاول أن يسوغ أمرا غير معقول، كما أنه لم يحاول أن يخفي نقيصة رماه بها المكفرون. ولكنه نظر بعين العدل، حتى انتهى إلى الرأي الصواب. |
| ولأدع القارئ بعد ذلك يجول في هذا السفر الممتع، ليجني بنفسه ثمرات الجهد المشكور الذي قدمه أحمد تيمور، وليرى أنها ليست شهوة الكتابة أو شهوة التأليف تلك التي كانت تدفع أحمد تيمور إلى أن يكتب ما كتب، وإلى أن يؤلف ما ألّف، وإلى هذا العناء الذي أفني فيه عمره صبيا لم يبلغ الحلم، ويافعا في غرة الشباب، وكهلا في مرحلة النضج والاكتمال، ثم شيخا في الوقت الذي تخلد فيه النفوس إلى الدعة وطلب الراحة من معاناة رحلة الحياة. |
| ولكن كتابة أحمد تيمور في هذا السفر إنما هي ثمرة من ثمرات العلم الذي خالط عقله ولبه، والذي سد أمامه منافذ الحياة، فلم يعد يرى شيئا غيره. وكان لا بد لتلك الطاقة القوية أن تبوح بمكنونها، وتفضى بما استودعته من أسرار الحكمة والمعرفة، وهي معرفة تتسم بالغزارة والتنوع. وتشهد بذلك الآثار الكثيرة التي خلفها ذلك العالم الجليل في اللغة والأدب والتاريخ مما دعا جماعة من أفاضل العلماء المعاصرين الذين يقدرون العلم، ويعرفون أقدار الرجال بالحق إلى أن يؤلفوا لجنة تعنى بالتنقيب عما خلف أحمد تيمور، والكشف عن آثاره التي لم يتح لها سبيل النشر في حياته لتنشرها في الناس، وتتم الغاية التي رمى إليها عالمنا الكبير. |
| وربما عرض للقارئ سؤال عن تأخر نشر أكثر هذه المؤلفات القيمة إلى ما بعد وفاة كاتبها، مع ما منَّ به الله تعالى عليه من بسطة في الرزق، وما آتاه من الحكمة وبسطة العلم، ومع الجاه العريض والاسم المذكور الذي كان يدفع كبار الوراقين إلى أن يهرعـوا إلى بابـه في طلب نشر آثاره التي لا |
| يشكون في رواجها، وإقبال الناس عليها، ولا فيما تدر عليهم من الربح والشرف الذي يشتهون. |
| ولست أجد لتأخير طبع ما تأخر من آثار العلامة أحمد تيمور ومصنفاته إلا شدة تعلقه بالحقيقة، ومداومة البحث عنها في مظانها حتى لا تبدو لأعين الناس إلا كاملة كما يراها العالم المتبحر بالتحقيق والتدقيق .. |
| والتحقيق يقتضي الصبر والأناة، ولا يحسب للوقت حسابا، فما لم يكمل اليوم يكمل غدا، وهو دائما يحس بالحاجة إلى الكمال، ومطلبه صعب عسير، فلذلك كثرت إضافاته واستدراكاته على ما خط قلمه في أول مرة، فكان لا يقنع بما كتب ولا بما أضاف، وإنما كان يطلب المزيد. وما أكثر ما تحتاج الحقيقة إلى المزيد الذي يجليها، ويزيل عنها كل لبس أو إبهام. |
| وكان أحمد تيمور لا يقنع دون الكمال، ولم يكن في الأجل المحدود مجال لزيادة تحقق له ما كان ينشد من الكمال، وإن بدا عمله كاملا في أعين الناس، ظاهراً للعيان، خالداً على مر الزمان. |
| * * * |
|
|
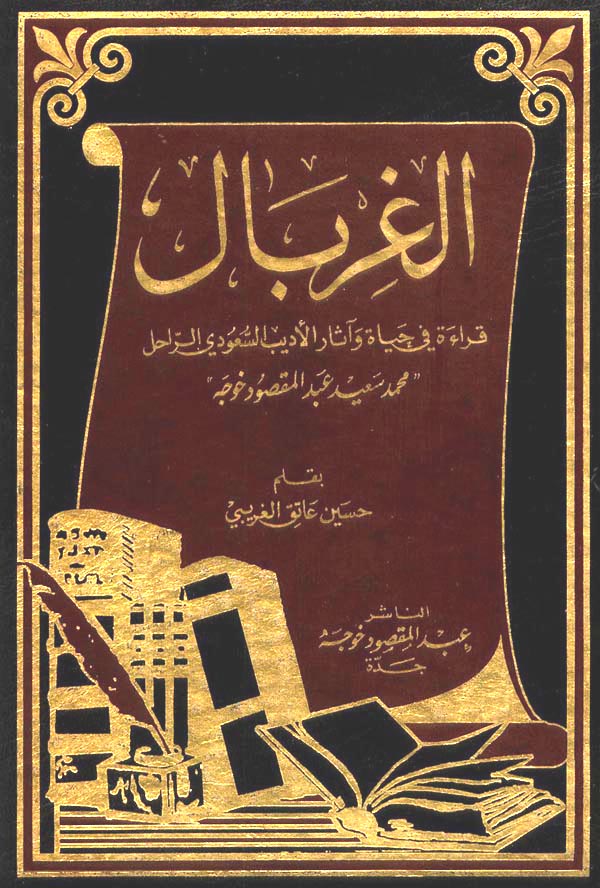
 شارع عبد المقصود خوجة
شارع عبد المقصود خوجة 00966-12-6982222 - تحويلة 250
00966-12-6982222 - تحويلة 250




