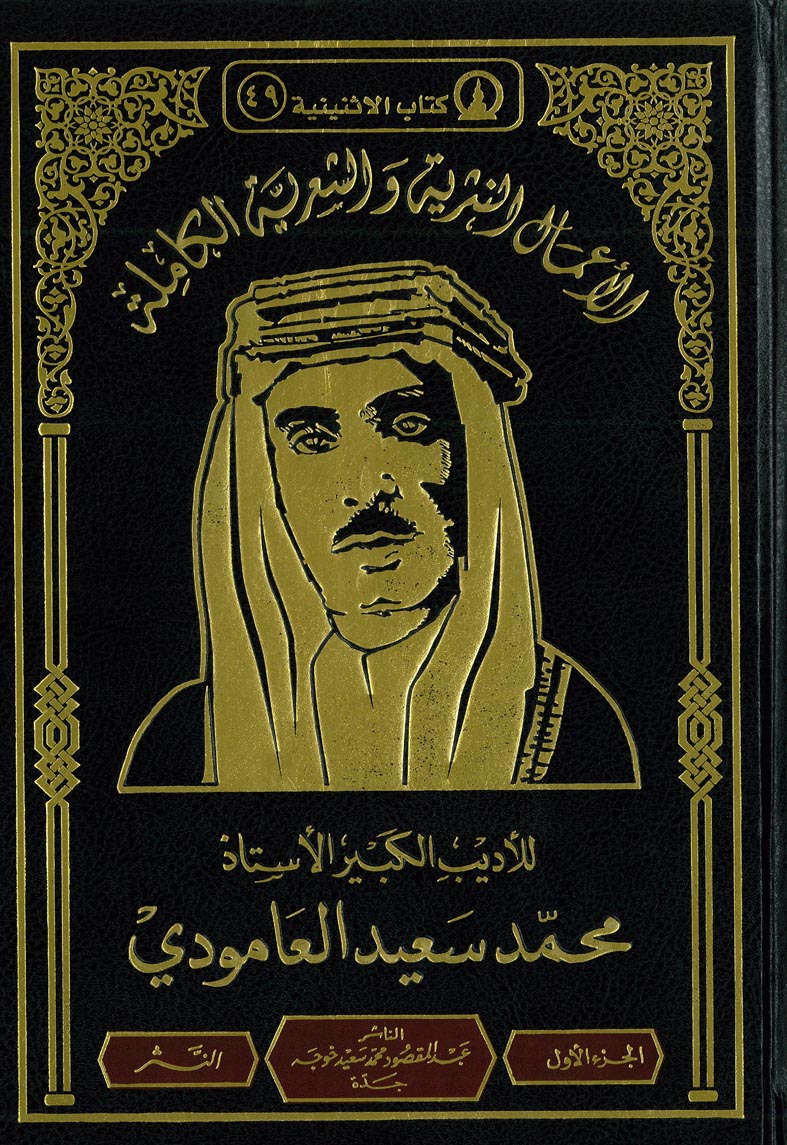| طموح الإبداع عند العوّاد |
| الإبداع مطلب، لا يعيش القلقَ عليه، والاحتراقَ بجمر التشوق إلى الوصول إليه، إلاّ الفنان. وليس الشاعر، أو الرسّام، أو الموسيقار هو وحده بالضرورة الذي يستحق أن يوصف بأنّه فنان.. إذ ما أكثر ما يبهرنا ويحملنا على لحظة تأمل وإعجاب شكل حقيبة أو قلم، أو حتى زجاجة عصير أو منديل ورق.. إذ في الشكل وتكوينه وألوانه إبداع عكف على الوصول إليه وإلى لمسة الجمال فيه إنسان ظل يعايش القلق على صورة لهذا الشكل، أحس أنها هناك في آفاق خياله ووجدانه، لا يهدأ له بال حتى يراه مرئياً ومحسوساً، يتلقى مشاعر الارتياح والإعجاب منه بالذات، ثم ممّن يراه. ولكن الشاعر أو الرسام أو الموسيقار يتميّز بأن مطلب الإبداع عنده نهج حياة، ومسيرة إلى هدف، يراه ولكن لا يصل أبداً إليه، وبقدر ما يعوق المسيرة ويدمي قدميه في دروبهما من الصخور والأشواك، ويلفح وجهه من ألسنة اللهب، بقدر ما تتنامى وتتسمق شخصية الفنّان فيه. |
| وقد كان الأستاذ الصديق محمد حسن عواد رحمه الله، ذلك الفنّان الذي كان مطلب الإبداع فيه نهج حياة ومسيرة إلى هدف رآه منذ فجر شبابه أو يفعه، فعاش قلق الوصول إليه في دروب يجهل الكثيرون حتى من رفاق دربه، كم عانى وشقي فيها من الأشواك والصخور، ومن لفح اللهب العاصف، والريح السموم. وكان أعجب ما تميّز به أن أصالة الفنان فيه قد ظلّت تسخر بقسوة المعاناة، وتشمخ بكبريائها عن التماس وقفة لالتقاط الأنفاس، كان يسعه دون شك ككثيرين غيره أن يقفها، وأن يجد الدوحة التي يستظل بها. والمنهل النمير الذي يروي حرقة الظمأ الطويل في حياته. ولكن أين يجد، عندئذٍ، لذّة التسيار وراء ذلك الهدف البعيد.. البعيد.. هدف الإبداع وقد ظل نهج حياة، لا شك أنّه ارتضاه، بعفوية طفل، وإيمان عجوز؟. |
| وبقدر ما يتلاحق الثناء عليه، والتحسّر لفقده، بما يكتبه الكاتبون اليوم، فإن ما يستحقه العواد، وما قد ينبغي أن تتوخّاه مسيرة الفكر اليوم، وفي المستقبل المنظور هو دراسة عناصر الأصالة، وكبرياء الفنّان في شخصيته، إذ في ذلك ما يضيء درب هذه المسيرة بالنسبة لجيل الشباب الذين أرى لهفتهم على الانطلاق نحو ذلك الهدف البعيد البعيد.. هدف الإبداع الذي يتلامح لهم اليوم، وهم في غضارة الصبا، وأحلام اليفع، وطموح الفتوة، فيلتمسون إليه السبل والدروب. |
| وأصالة الفنّان هي صدقه مع نفسه قبل كل شيء، وليس التزام الصدق مع النفس، ومع الغير من السبل التي يسهل الانطلاق فيها، ولعلّ هذه الحقيقة هي سرّ الشقاء الذي طالما لازم حياة أكابر روّاد الفكر والفن. ومنهم عندنا هذا الرائد الذي نحتفل اليوم بالذكرى الخامسة لوفاته، ولم يخطر لنا قط أن نَفِيَه حقّه من التكريم في أيام حياته.. وإني لأشعر بلذعة الحسرة والأسف على أني لم أمض في تنفيذ رغبة تكريمه التي تداولت الرأي فيها مع الأخ الصديق الأستاذ عبد المجيد شبكشي.. قبل رحيل العواد ربما بثلاث أو أربع سنوات.. إذ عصف بالفكرة والرغبة ما نسمّيه مشاغل الحياة، وما يستحق أن يسمّى في الواقع ألهياتها وتفاهاتها.. إذ ما الذي يمكن أن يبرر الانصراف عن بادرة وفاء يستحقها العواد من رصفائه ورفاق دربه إلاّ الاستغراق السخيف في هذه الألهيات والتفاهات؟. |
| وحق، والكلام عن طموح الإبداع عند العواد، رحمه الله، أن يتسع ويترامى، ويستوعب الكثير من أعماله ومن نبض فكره، وشعل اليقظة في وجدانه، ولا أدري الآن شيئاً عن صحة ما أسمع من أخبار عن دراسات يتوفّر عليها بعض الأكاديمين عندنا، ولكني لا أشك في أن مثل هذه الدراسات سوف يثري مسيرة الفكر في المملكة، ويضيف إلى التراث المعاصر فيها ما لا يزال يتراكم عليه من تجاهل الأقطار الشقيقة وضعف احتفالها به أو حتى إحساسها بوجوده. |
| ولا تحضرني اليوم أسماء ومواضيع الكتب التي عكف على تأليفها العواد رحمه الله، ولعلّ الأستاذ محمد سعيد باعشن يوالي جهده المشكور في إصدار ما لم يسبق أن صدر له من الكتب، والأرجح عندي أنه سوف يجد الكثير الذي يستحق أن ينشر حتى وإن لم يأخذ شكل كتب، وأعني رسائله إلى عشّاق الحرف من الناشئين والشداة طوال حياته، فقد كان لا يتردد في الكتابة إليهم والأخذ بيدهم، بالتشجيع، ولكن دون أن يجاملهم، فيحجب عنهم رأيه وتأمّلاته بأسلوب فيه الود بقدرما فيه من صدق الرغبة في التوجيه. |
| ولعلّ من أواخر ما أصدره العواد من كتبه، في فترة رياسته لنادي جدة الأدبي، هذا الكتاب الذي لم يحظ بما يستحقه من التفات الدارسين، وهو (الطريق.. إلى موسيقى الشعر الخارجية) مع أن العواد قد فجّر فيه قضية الشعر الحر التي تعيش الساحة الأدبية صراعاً ومعارك متلاحقة حولها. إذ أراد أن يقول كلمته الحاسمة في الموضوع، وهي كلمة العالم، وليست كلمة من لا يجد ما يقوله إلا ترديد عبارات يزعم أنها تدعم انتصاره لهذا الشعر، لأن الذي قالها هذا، أو ذلك من النقاد في اللغة الإنجليزية أو الفرنسية، مع أنه لا يقرأ هذه اللغة أو تلك وإنما هو ينقل ما يجده من دراسات عن هؤلاء النقاد في اللغة العربية. |
| ويبدأ الأستاذ العواد رحمه الله، مقدمة كتابه بقوله: |
| (لماذا أكتب هذا؟) ثم يجيب قائلاً: (فيضان حركة الشعر الحر، في البلاد العربية كلّها، جعل كثيراً من المحترفين، أو من متسرعي الشهرة، أو المعجبين به من غير أهله، يستسهلون اقتحامه بنماذج مشابهة له في الشكل العام، ولكنها جوفاء ليس فيها روح الشعر، ولا طبيعته، فلا إحساس بالموهبة، ولا اعتراف بسلامة التخطيط، وليس هناك غير الشكل وغير الفوضى. فأما الشكل، فلعلّهم وهموا أنه هو المراد من (الشعر الحر) وأما الفوضى، فلعلّهم زعموا أنها عملية تهريج مريحة يستطيعون أن يضلّلوا بها من لا يدركون الفرق بين الشعر الضوضائي والشعر السليم). |
| ثم يمضي ليقول عن الفريق الثائر على الشعر الحر: (وجرفت الوسوسة والتعصب بعض هؤلاء إلى إشاعة أن الشعر الحر دسيسة على اللغة العربية دبّرها الاستعمار لتحطيمها). |
| ثم يفاجئنا بقوله: (إن الخليل بن أحمد - واضع علم العروض - هو مبتكر الأساس الذي يقوم عليه بناء الشعر الحر وهو (التفعيلة)). |
| وعن الخليل بن أحمد الفراهيدي الذي يرى العواد أنه مبتكر الأساس الذي يقوم عليه بناء الشعر الحر، كتب العواد تعريفاً به - وضعه قبل المقدمة.. ومما يلفت النظر إلى نقطة من مكوّنات شخصية الفنّان، أنه يقول عن الخليل: (له شعر ضئيل الكمية جداً، يروى له في قطع صغار لم تقرأ منها غير أربعة أبيات، جاءت في حكايته مع الأمير سليمان بن حبيب بن المهلّب بن أبي الأزدي.. وكان قد خصص للخليل راتباً، فكتب إليه مرة (يستدعيه) من البصرة فكتب له الخليل: |
| أبلغ سليمان أني عنه في سعة |
| وفي غنى غير أني لست ذا مال |
| شحًّا بنفسي أني لا أرى أحداً |
| يموت هزلاً.. ولا يبقى على حال |
|
| فقطع عنه سليمان الراتب فقال الخليل: |
| إن الذي شقّ فمي ضامن |
| للرزق حتى يتوفاني |
| حرمتني مالاً قليلاً فما |
| زاد في مالك حرماني |
|
| والعواد يورد هذه الحقيقة، وهذه الأبيات للفراهيدي، لأنها تلمح إلى شيء طبع عليه والتزمه طوال حياته من التعفّف، وكبرياء الفنان الذي ارتضى، بل واستعذب قسوة المعاناة في درب مسيرته، مؤثراً أن يمضي في طريقه، على أن يلتمس وقفة لالتقاط الأنفاس يقفها، وأن يجد الدوحة التي يستظل بها، ومنهل الماء النمير الذي يطفئ حرقة الظمأ الطويل في حياته. |
| لست أدري، والكتاب القيّم الفريد بين يدي، هل خطر لأنصار الشعر الحر، وخصومه، أن يقرأوه، وأن يجدوا فيه ما يحسم قضية الصراع بينهم، أو على الأقل ما يحملهم على التخفّف من الانهماك في مقولات النقاد الإنجليز والفرنسيين التي يزخرفون بأسمائهم ما يكتبونه من بحوث في الموضوع، على ضوء آراء العواد في هذا الكتاب. |
| رحم الله العواد.. فسوف يظل منهلاً، لا بد أن يجد من ينهل من فكره وأدبه وعطاء الفنان الكبير في شخصيته، من عشاق الكلمة، جيلاً وراء جيل، على امتداد المستقبل، لأنّه الفنّان الذي شق طريقه إلى حياة طويلة، وعمر مديد، بعد أن انطوت على جثمانه الأرض التي عاش الانتماء إليها، والإخلاص لترابها، طوال حياته الحافلة بالعطاء. |
| ولا عجب في أن تمتلئ صوامع الفكر في ذهني، وأن تفيض بما ظلّت تختزنه في مهرجان الشعر العربي، في دول الخليج، ليس من الشعر فقط، وإنما من هذه التي كانت تسمّى (أوراق عمل) أحياناً، وتسمّى (محاضرة) أحياناً أخرى.. ومع أن الصحف كانت تواصل نشر (فعاليات) المهرجان يوماً بيوم، فإن مما كنا نتهافت عليه هو (مجلة المهرجان) التي كان الأستاذ عبد الله بن محمد الشهيل وراء صدورها صباح كل يوم، متخصصة بأخبار فعاليات المهرجان، ولكن ليس في شكل نشرة عادية، يمكن أن نتصور طباعتها على الآلة الكاتبة، ونسخ مئات الصور منها بجهاز النسخ، الذي أصبح من الممكن أن يؤدي دور المطبعة - أيام زمان - .. كلا.. فقد كانت المجلةُ مجلةً (بحق وحقيق)، إذ كانت الصور فيها بالألوان، وعلى ورق صقيل متميّز، وكانت الحروف حروف مطبعة أو طباعة متميّزة، وهذا إلى جانب المانشيتّات بخط جميل.. ولا حاجة للتحدث عن صياغة الأخبار التي أدهشني أنها كانت لها القدرة على مصادرة كل محاولة اصطياد للأخطاء اللغوية أو النحوية، مما جعلني أتساءل: وأقدم للتساؤل بـ (ألف ما شاء الله)، متى كان يستطيع الأمين العام الأستاذ الشهيل، أن يتفرّغ، لمتابعة إصدار المجلة، وبهذا المستوى الذي جعلها الوحيدة التي نحرص على تواجدها بين أيدينا كل صباح. |
| لقد أتيح لي، في مراحل من العمر، أن أشارك في مؤتمرات تصدر نشرات يومية تقريباً عن نتائج الاجتماعات، أو اللقاءات، ولكن ما أعظم الفرق بين مجلة المهرجان اليومية، وبين أي نشرة من نوعها موضوعاً وأهدافاً. |
| والمفاجأة التي يحسن بي أن أكاشف بها الأستاذ عبد الله، هي أني حاولت أن أحتفظ بأعداد المجلة فلم أوفّق، لأنها تذهب مع ما يذهب من الصحف، التي يزوّدنا بها قسم العلاقات العامة كل صباح، وكان لا بد أن يذهب قبل أن نجد أنفسنا مضطرين للمطالبة بغرفة أخرى للنوم، ونترك الأولى للصحف والمجلات وما أكثرها.. وكم هو صعب، أو معجز، أن نجد الوقت لقراءتها.. وهذا بالنسبة لي، إذ لا أستبعد أن يكون بين المشاركين في المهرجان من يستطيع أن يقرأ، وأن يرى صورة، لعلّها نادرة في أي بلد غير المملكة، للإنتاج الصحفي بهذا الكم، ولكل صحيفة بهذا العدد من الصفحات، وبهذا المستوى من الطباعة بالألوان، إلى جانب القدرة على التواجد في كل غرفة من غرف الضيوف قبل الثامنة صباحاً.. حاولت أن أحتفظ بأعداد المجلة، فلم أوفق، ورجوت أن يفضل بجمعها لي أحد المختصين في العلاقات العامة، (علاقات المهرجان).. ولكن يبدو، أن أعدادها قد نفدت، ووجدت نفسي أعود إلى جدة، خالي الوفاض بادي الإنفاض، إلا من هذه الكتب التي شرّفني بإهدائها من فخرت بهم من شبابنا وأبنائنا الأكاديميين الذين أتاحت لي مناسبة المهرجان، ومشاركتهم بأوراق عملهم أو هي محاضراتهم، أن أستوعب لمحات من المستوى الرفيع الذي يتمتع به كل منهم ولا بأس هنا بأن أعترف بأني لست الذي يستطيع أن يزن أو يقترب من المستوى الذي يتمتعون به، ولكن قد يكون من حقي أن أقول إن كثيراً من الآراء الظالمة، ولعلّها الحاقدة، التي يتبجّح بها من يجدون مجالاً لنشر آرائهم الفطيرة في الصحف، قد اكتشفت أنها ظالمة وحاقدة فعلاً، وأن شبابنا من الأكاديميين يملأون مراكزهم بل يستطيعون أن يملأوا المجال الفكري والثقافي بمستوى مشرّف، يستحقون عليه التقدير المنصف، والإعجاب الصادق الخالص من شوائب الحقد يدفعها الجهل، والأميّة الفكرية، التي أتطلّع أن تتنبّه لها الصحف، فلا تفسح لها مجال التبجّح السخيف.. وإذا لم ننس أن الأكاديميين هؤلاء من أبنائنا لا يزالون في مقتبل العمر، وأن المجال مفتوح أمامهم للمزيد من الجهد، والمزيد من فرص أعمال (التنوير) كما أسميها، والتي يضطلعون بها في الجامعات التي تتولّى مسؤولية بناء الإنسان. ومن المفروغ منه - بطبيعة الحال - أن من أتيح لنا أن نشهد وأن نسمع حوارهم ومناقشاتهم، لا يمثلون في الواقع إلا جزءاً من (الكل) الأكاديمي، وهذا الكل فيه العلوم والتكنولوجيا، والطب والهندسة وعلوم البحار، والفضاء، فإذا ذهبت إلى أن عملية بناء الإنسان، التي كثيراً ما دعا إليها عاهلنا العظيم، خادم الحرمين الشريفين، الملك فهد بن عبد العزيز، تتم بحمد الله على خير وجه، وأننا في مستقبلنا القريب سوف نكون في الطليعة من حركة العلم والتقنية في العالم، فإني أقول ذلك على أساس من إدراك عميق لحجم ووزن الجهد الذي يبذله هؤلاء الشباب. |
| ومن الكتب التي عدت بها إلى جدة، ديوان جديد للشاعر الصديق الأستاذ حسن عبد الله القرشي.. وأجد نفسي أستسهل التحدث أو الكتابة عنه، لأنه ظل في يدي طوال الفترة التي قضيتها في الطائرة في عودتي من الرياض.. وقد لفت نظري عبارة الإهداء التي أعطتني أو هي خلعت على شخصي ما لا ينطبق على واقع مسيرتي الفكرية، وعلى الأخص منها (النقد) في هذه الأيام.. إذ قد لا يعلم الأستاذ القرشي أن (الناقد) الذي يعتمر ذهنه قد أصبح مما عفّى عليه الزمن، أو جرفته إلى رمال الشاطئ موجة (النقد المنهجي) الحديث ومن أبطاله إذا كان لا يعلم، الدكتور عبد الله الغذامي، والأستاذ سعيد السريحي.. ولست أدري إن كان القرشي قد تورّط فأهدى هذين المنهجيَّيْن ديوانه الجديد.. فإذا كان قد فعل، فإني أنذره بأن ورطته معهما ومع فريقهما المتنامي ستكون شديدة التعقيد، ولعلّه يذكر ما طرحه الأستاذ السريحي من آرائه الطريفة، وعلى الأخص منها رأيه في العلاقة بين كتابة الكلمة (على الورق) وما يطلب من القارئ أن يفهمه من معانٍ، توحيها (الكتابة) نفسها بالطريقة التي مثل لها بكلمة (عراق).. فقد ذهب إلى أن الألف في كلمة (عراق) تمتد بقامتها، لتكون نخلة أو مئذنة، أو لا أدري الآن ماذا قال، فالباقي عندئذٍ هو (عرق) والكلمة عندئذٍ تعبّر عن عَرَق الجهد والمعاناة والكفاح الذي ترمز له الألف إذا كتبت بطريقته معبّرةً عن كبرياء هذا العَرَق.. وبعد هذه الكلمة، تُترك الورقة بيضاء.. وعلى القارئ أن يعايش هذا الفضاء، وأن يذهب بخياله وراء الكثير من المعاني، التي يوحيها (الفضاء الناصع).. الخ الخ.. |
| على أية حال، فقد أهداني الأستاذ القرشي ديوانه وفي عبارة الإهداء مبالغة صارخة تصفني بأني (الناقد العبقري).. وقد ذكّرتني هذه العبارة أو المبالغة بقصيدة للأستاذ محمد حسن عواد رحمه الله، في ديوانه الذي لا يحضرني اسمه الآن، يصفني فيها بأني (ناقد) وأنه يطالبني بأن أقول كلمتي عن الديوان وعن شعره كله.. وقد لا أفاجئ الأستاذ القرشي إذا كاشفته بأن استجابتي للأستاذ العواد كانت (شرسة) وأسفرت عن معركة ساخنة، اشترك فيها متعددون، ولا يطيب لي اليوم أن أتناول ديوان القرشي ومجموعة شعره في دواوينه ابتداء من (البسمات الملونة) وانتهاء عند هذا الديوان، الذي أتيح لي أن أقرأ الكثير من قصائده في الرحلة من الرياض إلى جدة.. بذلك الأسلوب الشرس، وإن كنت لا أخفي أن مقولة (الطبع يغلب التطبع) تستعمر ذهني كلما قرأت شعراً، أجد فيه ما ينبغي أن يقال ولكن بعيداً عن أسلوب المنهجيِّين، الذي أعترف بأني أكاد أعجز عن استيعابه، وفهمه.. ولعلّ ما يعزّيني في هذا العجز أن الذين استوعبوه وفهموه لا يزالون يعدُّون عندنا على أصابع اليد الواحدة. |
| والأستاذ الشاعر القرشي يسمّيه المنهجيون والحداثيون شاعراً تقليدياً، بمعنى أنه لا يزال يحترم عمود الشعر، قافية ووزناً، بل أفهم أنه (أستاذ) في (العروض) بحيث يتنبه لعيوب القافية والوزن التي قد لا يتنبه لها (أمثالي).. وملاحظتي على شعره منذ أول ديوان له وهو (البسمات الملونة)، أنه يضحّي بالجمال في الشطر الأول، من القصيدة، في بحثه عن القافية.. وهذا يعني أنه يلهم المعنى الجميل والأداء المشرق بما يسطع في الكلمة من روح الشعر، ولكن حين ينطلق، في الشطر الثاني لاستيفاء المعنى، تحكم عليه القافية بأن يضحّي بكل الجمال، أو بأكثره.. فعلى سبيل المثال (العاجل) نجد في قصيدة بعنوان (عيناك) في ديوانه الجديد الذي سمّاه (رحيل القوافل الضالة).. قوله: |
| حلم الطفولة فيهما |
| غض كزهر الأقحوان |
|
| ولا أجد كيف يتهاوى حلم الطفولة بكل ما فيه من تسام وبراءة وجمال، ليكون شيئاً تافهاً (كزهر الأقحون).. |
| وقوله: |
| خفر يرف عليهما |
| أبداً فيزهو الحاجبان |
|
| فزهو الحاجبين هنا، بعد هذا الخفر الذي يرف، تعبير هابط عن مستوى الشطر الأول، وكان السبب هو البحث عن (القافية) للأسف، إذ لا علاقة بين هذا الخفر، وبين الزهو في الحاجبين. |
| ثم حين يقول: |
| عيناك يا لون الرحي |
| ق صفا وشعشع في الدنان |
|
| فإنه مرة أخرى يهبط عن مستوى الصورة الجميلة، التي رسمها للون العينين وهو لون الرحيق صفا وشعشع.. ولكن في (الدنان).. وقد يعذر الأستاذ القرشي، إذا كان لا يعلم أن الدن أو الدنان، لا تكون شفّافة، تتيح رؤية لون الرحيق.. لأنها فيما أعلم تصنع من الفخار أو الخزف، فلا يُرى ما فيها.. ولكنها القافية.. التي كم يؤسفني أن أجدها تفترس الشاعرية، وترغمها على أن تتنازل، فتضحي بالجمال، في سبيل الجرس، أو الرنين، الذي تصدح به القافية كالعادة في الشعر العمودي المتوارث عبر العصور. |
| وفي هذا الديوان الصغير للأستاذ الشاعر حسن عبد الله القرشي، اكتشفت أنه مغرم بـ (السودان الشقيق).. ومن حقه أن يختار موضوع غرامه أو إعجابه، ولكن عسى أن لا يدخل في شريحة أولئك الذين يوصفون بأن (نجمهم كوانيني).. والصديق الأستاذ محمد حسين زيدان يستطيع أن يعطينا خلفيات هذا الوصف الشائع أو الذي كان شائعاً في مكة وجدة والمدينة، إلى عهد ليس ببعيد. |
| وفي قصيدة عبّر بها الأستاذ القرشي عن معايشته لليلة عرس سودانية كتبها متحللاً من قيد الوزن والقافية، وأكاد أقول إن إبداعه في هذه القصيدة كان أكثر انطلاقاً من إبداعه في القصائد العمودية.. ومع ذلك فقد استوقفتني في هذه القصيدة بعض التعابير التي التزم فيها القافية، فتورّط في نفس المشكلة، ومن ذلك قوله: |
| رقصت.. فأشعلت مزهوّة.. كبرياءَ الزمان.. |
| إني أفهم أن يشتعل كبرياء أي كائن إلاّ الزمان.. ولقد حاولت أن أتعمّق المعنى وأن أتصور كيف يشتعل (كبرياء الزمان).. فلم أجد الصورة التي ربما أرادها الشاعر.. ثم يقول: |
| أوغلت في الرقص.. نرجسة.. بل زبرجدة.. بل قضيباً من الذهب المتوهّج بالماس، ولست أدري كيف يمكن أن توصف أي راقصة بأنها (نرجسة).. أو (زبرجدة).. أو حتى (قضيباً من الذهب المتوهّج بالماس).. إذ لا أشك في أن الأستاذ القرشي لا يجهل أن الرقص في حياة أي شعب (فن) يمكن أن توصف مؤدّيته أو مؤديه، بمعانٍ، وليس بماديةٍ، كالزبرجد أو قضيب الذهب المتوهّج بالماس.. أليس الزبرجد مجرد حجر، والذهب أليس هو مجرد معدن قاسٍ ومثله الماس؟ وفي الرقص.. حركة، وفي هذه الأحجار والمعادن جمود، قد لا نرفضه في مبانٍ، أو في تحفة توضع كمادة (ديكور) في بهو أحد عظماء التاريخ.. ولكنّا نرفضه في راقصة، تملأ الحياة من حولها شهقات إعجاب، وأنات هيام. |
| وبعد.. فقد أسرفت في معايشة ديوان الأستاذ القرشي، وأخشى أن يكون (الطبع) فعلاً غلب التطبّع.. ولكني لا أشك أبداً في أن صدر القرشي يتسع لمعايشةٍ ناقدة، فيها مجال للحوار الذي أرجو أن يتاح في لقاء قريب. |
| * * * |
| يبدو أنه لا فرق بين صوامع الغلال، وبين صوامع الفكر في الأدمغة، من حيث إن الزمن الذي أودع الله - جلّت قدرته - فيه خصيصة القدرة على التعامل مع كل كائن وموجود بطريقة تستهدف الإفناء أو الإعدام، عبر مداء، قد يعطيها الفرصة للمقاومة، وقد يطيب له أن يختصر، فإذا بالكائن الموجود لا وجود له، معطياً الفرصة لمن يملأ الفراغ من عناصر الحياة والأحياء. |
| وأقول هذا، حين اكتشفت، منذ أيام، أن المخزون في صوامع فكري من حصاد الأيام ليس مما يصلح للعرض أو النشر، لأنه تفاعل مع الزمن، أو أن الزمن هو الذي تفاعل معه فجعله مادةً غير مرغوب فيها، وهذا قد لا يختلف كثيراً عن تعامل الزمن مع الغلال في الصوامع إذ يجعلها في حال اصطلحنا على تسميتها (غير صالح للاستعمال الآدمي)، وذلك لأسباب منها (عسر الهضم)، أو (مرارة المذاق) أو (تغيُّر الرائحة). |
| وقال لي (الخازن) أو هو (أمين الصوامع) في دماغي: إن الصوامع طافحة بالكثير الذي (يصلح للاستعمال الآدمي)، فما الذي يجعلك تصر على اختيار هذا الذي لا يصلح، أو هذا الذي (يصلح للاستعمال الآدمي)، فما الذي يجعلك تصر على اختيار هذا الذي لا يصلح، أو هذا الذي ترفضه أجهزة الهضم الفكري عندهم؟ |
| قلت: أعلم قدرتك وبراعتك الفائقة في العثور على ما يصلح، ويجد حسن الاستقبال والترحيب، ولكن - عافاك الله - المسألة من وجهة نظري الخاصة مسألة فشلتُ طول عمري في إقناعك بها أولاً، وتدريبك على التعامل على ضوئها ثانياً. |
| وابتسم الشقي، وأغضى متوجّساً وهو يقول: |
| أعرفها يا سيدي.. ولا أنسى أبداً كم سببتْ لك ولي شخصياً من إرباك وإزعاج. ولا أدري، كيف لم تتعلم أنت من تجارب الأيام، إن المسألة من وجهة نظرك هذه، ليست هي المسألة من وجهة نظر القراء - أو بعضهم على الأقل - ثم.. يا سيدي.. لو سمحت، أليس في وسعك أن تقول لي ما هي هذه (المسالة) من وجهة نظرك؟ |
| قلت: سؤال ذكي.. ولكنه محرج.. ومع ذلك فليس ما يمنع أن أقوله لك.. إنها (الحريّة).. |
| فإذا بالشقي يخفق صدره بيده مندهشاً ويقول: الحرية؟ هل قلت الحرية؟ |
| قلت: أجل.. إنها (الحرية).. حرّيتي الشخصية في أن أختار أو آمرك أن تختار من المخزون في الصوامع عندك، الموضوع الذي أجد فيه نفسي، ومشاعري، ووجداني من جهة.. وأعتقد أن فيه - في نفس الوقت - ما لا ترفضه بعض أجهزة الهضم من جهة أخرى. |
| قال: |
| واليوم.. ترى ما هو الموضوع الذي تجد فيه نفسك ومشاعرك ووجدانك كما تقول؟ |
| قلت: اليوم؟ قد أعفيك من البحث في الصوامع، إذ في ذهني موضوع لم تبق صحيفة أو إذاعة، أو تلفزيون، ولاحقته، ولا تزال تلاحقه، بفنون من العرض والمتابعة، فيهما المألوف و (المحفوظ عن ظهر قلب) من جمل الإنشاء المشحونة بالحماس، ينصب على عبارات التقدير والإعجاب، بجماهير الانتفاضة في الأرض المحتلة.. إلى جانب الكثير من الأخبار عن التصريحات التي يفضي بها مسؤولون على جميع الأصعدة، وفي جميع أنحاء العالم ومنها القطبان اللذان يفتحان، بكل تصريح، من تصريحاتهما (القليلة والنادرة والمحسوبة بدقة) الأبواب على مصاريعها للتعليق المتفائل، أو الذي يبلغ من التفاؤل حد (الرقص).. وذلك يتفق مع منطق الأشياء، إذ لم نستطع قط أن ننسى أن هذين القطبين، هما - قبل أي مسؤول عربي أو غير عربي.. هما القادران على اللعب، ببراعة أين منها براعة أبطال كرة القدم في إصابة الهدف، الذي لا أدري كيف لا ينشرخ صوت المعلّق وهو يصرخ فرحة بكلمة (هدف).. وقد كان من هذه التصريحات ما بشر بأن القطبين قد أخذا يقتنعان بأن للفلسطينيين حقاً في أن تكون لهم أرض، ودولة، في فلسطين، ولكن بمفاهيم خاصة سوف تظل تشكِّل عُقَداً، يتعذّر حلّها، وإذا تعذّر الحل، فإن القضية لا بد أن تظل تراوح، رغم كل ما يتلاحق من عبارات التقدير والإعجاب، بجماهير الانتفاضة بل ورغم كل ما يسمع، ويشاهد من صيحات داعية إلى الوقوف إلى جانب تلك الجماهير. |
| والإعجاب، المشتعل حماساً بالمقاومة - على اختلاف أساليبها ومواقعها - أصبح بمرور الوقت، تصرفاً تقليدياً، تدرك إسرائيل أولاً، ويدرك معها القطبان ومعهما من يدور في فلكيهما، ثانياً، أنه شيء مألوف ومعروف، بأخذ مجاله في أجهزة الإعلام، فترة من الوقت، تطول أو تقصر، ثم يأخذ في التلاشي والهمود أو الجمود.. وتعود إسرائيل إلى موقعها وموقفها ومسلسل تصرفها، وكأن شيئاً لم يكن، وكأن الشهداء، من الرجال والنساء والأطفال - مهما كثر عددهم أو قل - مجرد عناصر شغب، اقتضى أمن إسرائيل أن يقضي عليها، والعالم - كله - يعلم أن (أمن إسرائيل) هذا يبرّر القتل، والسحل، والقصف الجوي، والبحري والاجتياح والغزو، ومجازر صبرا وشاتيلا، وأي مجزرة مماثلة وقعت، أو تقع في فلسطين أو في لبنان، أو في أي أرض عربية، حتى لو كانت بغداد. والعجيب أن التبرير والرضى، والصمت التام عن كل ما تمارسه إسرائيل من عدوانها قضية متفقٌ عليها بإجماع منقطع النظير، والأعجب من ذلك أن الدول العربية التي تتولى أجهزة إعلامها صياغة عبارات الإعجاب المشتعل حماساً، تظل تلتزم من جانبها هي أيضاً الصمت، ولا نقول (العجز) عن القيام بأي عمل، أكثر من ((الاستنكار))، ((والتنديد))، وفي الأحوال التي يزداد فيها (العيار)، تستجمع هذه الدول قواها، فتتقدم إلى منظمة الأمم المتحدة.. أو إلى مجلس الأمن لتحصل، بعد الكثير من (الخطب الرنّانة) على قرارات، بالإدانة ليس أسهل على الولايات المتحدة الأمريكية من أن تقذف بها تحت أقدام تمثال الحرية في نيويورك، بـ (الفيتو).. وما هي إلاّ لحظات، حتى يصبح القرار مجرد فقاعة لا يملك بقية أعضاء المجلس إلاّ (الفرجة) على انفجارها.. والسلام. |
| ويذكر القراء، من جيلي، أن النظرة إلى أنواع المقاومة الشعبية التي كان يقوم بها الفدائيون الفلسطينيون، كانت تعتبرها معارك في فراغ لا نهاية له.. فإذا كانت له نهاية ما، فليست إلاّ (الحل السلمي) الذي نصّت عليه فيما مضى قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن، والذي نلهث في هذه الأيام إلى شيء لا يختلف عنها كثيراً، ننتظره، ليس من مجلس الأمن، ولكن من (المؤتمر الدولي)، الذي لا أدري شخصياً ما الذي يجعلنا نطالب به، وبهذا المستوى من الإلحاح، والمتابعة، رغم أن القطبين، ومن يدور في فلكيهما يواجهون إلحاحنا بالمطالبة به، ببرود، ينذر بأننا سنخرج منه بأوراق خاسرة لأن يد الخصم مزدحمة بالأوراق الرابحة، وهي أنه يحتل الأرض، ويمارس الاستيطان فيها، ويتصرف مع أصحابها، تصرف المالك في ملكه.. يرفض مجرد الاحتجاج أو الإضراب، فضلاً عن (الانتفاضة) المسلّحة بالحجارة، وصيحات الغضب والاستنكار. |
| وأذكر اليوم أن أحد القراء اختار أن يتحدث إليّ دون أن يذكر اسمه عن هذه الانتفاضة التي يسمع ويشهد في التلفزيون واقعها، ووقائعها وتصرف قوات (جيش الدفاع الإسرائيلي) حيالها، فكان كمن يدلق عليّ جردلاً من الماء البارد، إذ قال: (إننا ندفن رؤوسنا في الرمال، إذا كنا نظن أن هذه الانتفاضة، التي امتلأت بأخبارها والحديث عنها والإعجاب بها، يمكن أن تحقق نصراً حاسماً، يضع نهاية ما لغطرسة إسرائيل، واستهتارها وخروجها على جميع الأعراف والقوانين، بل وعلى جميع قرارات الإدانة، ودع عنك الاستنكار والتنديد.. وأنت تعلم - كما يعلم جميع الذين يملأون الصحف بالكلام - أن كل ما تقوم به الانتفاضة، وكل ما يُبهرنا من بطولة الأطفال، بل والنساء، يفتقر إلى شخصية الدولة، أو الدول، التي تقف عملياً إلى جانب هؤلاء الأطفال وتفتقر أيضاً إلى (الأرض) و (الحدود)، وهما ما سرقته واغتصبته ولا تزال تغتصبه إسرائيل.. ولا تنسَ يا سيدي، أن المجتمع الدولي - كله - يعترف بالعدو دولة، ويعترف لها بالأرض التي احتلّتها، أرضاً لها.. بينما لا توجد دولة اعترفت للفلسطينيين بدولة، أو بأرض. |
| قلت للمتحدث الكريم: |
| وعلى هذا الأساس من يأسك الظاهر، ماذا تظن أنه الذي يحقق هذا النصر؟ |
| قال: إن ما يحقق النصر للانتفاضة،أو لأي تحرك مماثل من الشعب الفلسطيني هو المواجهة المسلّحة، تهب لها الدول العربية، إذا كانت صادقة فيما نسمعه من تصريحات المسؤولين فيها.. |
| ثم أضاف: إننا حين نوالي حملات الإعجاب والتشجيع لهؤلاء الأطفال وحجارتهم نقترف نوعاً من خدعة الالتفاف والانفلات من مسؤولية الدول العربية، إننا نرفع المسؤولية عن كواهل الدول العربية، وهي التي تملك ما لا يملكه الأطفال وحجارتهم، من جيوش وأساطيل وطائرات، ومختلف أنواع الأسلحة والذخائر والمعدات.. إنك تعلم أن جميع الدول العربية، لديها ما فوق الكفاية من الأسلحة، وما فوق الكفاية من الجيوش والقوات البرية والبحرية والجوية.. ماذا تفعل كل هذه القوات إذا لم تهب لنجدة الأطفال، وهم يقفون في وجه العدو، وكل أسلحتهم حجارة الأرض، التي آمنوا، وسوف يظلون يؤمنون، أنها أرضهم؟. اغتصبها العدو، وساعد هذا العدو على اغتصابها مجموعة الدول الكبرى التي أعطت نفسها حق التصرف في مقدرات الشعب، والعبث بحقوقه، رغم أنوف الدول العربية التي عرفت طريق الانسحاب من المعركة الأولى، وهي ترى كيف طرد العزّل من السلاح، عن هذه الأرض، على وعد العودة الذي لم يتحقق، لأن المعركة قد انتهت في الواقع منذ ذلك اليوم.. ولم تكن المعارك التالية، أو الحروب الأربع التي خاضها العدو، أو شنَّها، إلاّ معارك التوسع والاستيطان، والمزيد من طرد أصحاب الأرض.. ثم معركة إسرائيل الكبرى، التي يثبت أنها قد انتهت فعلاً، ولم يبق إلا القليل جداً لتصفية حسابها. إن إسرائيل اليوم تحتل وتستوطن، وتستثمر، كل فلسطين بما فيها القدس.. إضافة إلى الجولان. |
| قلت لصاحبي، وأنا أحاول ألاَّ أضحك بصوت عالٍ: |
| إنك تطلب حرباً، تدخلها جميع الدول العربية.. |
| قال: وماذا أقلّ من ذلك؟ ثم هل هذه الدول بكل ما لديها من قوات.. أشد ضعفاً وأقل شجاعة.. وإيماناً بالحق.. بأننا والفلسطينيين، شعب واحد.. أمة واحدة؟.. |
| قلت: ولكنك تنسى أننا اقتنعنا - ولا تسألني متى وكيف؟ - بأنه لا حل إلا الحل السلمي.. اقتنعنا بأن إسرائيل قد وجدت لتعيش.. ورضينا لها بأن تعيش ويعيش الفلسطينيون معها على أرضهم بسلام. |
| قال: وما الذي جعلنا نقتنع بهذا الحل السلمي؟ |
| قلت: الدول التي وافقت على قرار مجلس الأمن الذي فرض الحل السلمي في إطار نقاط حددها في حينه، لم توافق عليه في الواقع إلا وهي ترى المشكلة.. أو لهذه المواجهة المسلّحة التي تطالب بها، أبعاداً لا يراها غيرها.. منها التقدير الدقيق لموازين القوى.. ثم التقدير الأكثر دقة للتيارات التي لا تزال تصطرع وتتصارع داخل المنطقة، وهي تيارات أثبتت أنها لا تزال قادرة على التحكم في الوضع بحيث يتعذر التسامح بتعريضها لأي نوع من التحديات، إلاّ بمغامرة يفتقر الإقدام عليها إلى بطولة من طراز لم تلده المنطقة بعد.. بعبارة أخرى.. إن المواجهة المسلحة التي يحلم بها أمثالك رهينة بتطورات أخطر كثيراً من مجرد الفشل في الوصول إلى حل سلمي.. هو الذي نجري هنا وهناك في محاولة الوصول إليه.. إنها رهينة بذلك التغير الجذري في النظرة إلى المشكلة بحيث تتحول من مكانها في السفوح، إلى المكان الذي لم نجرؤ على التطلع إليه في القمم.. |
| قال صاحبي: ولكن انتفاضة الأطفال بهذه الحجارة.. ماذا تعني؟ أليست بشيراً بالتغير الجذري في النظرة إلى المشكلة برمتها؟ إنها انتفاضة أصحاب الأرض من داخل الأرض.. انتفاضة الذين ولدوا على الأرض التي احتلّتها إسرائيل في عام 1948.. ومعهم أطفال الضفة الغربية والقطاع، والجولان.. أليست هذه هي الحركة التي لم تكن تتصور إسرائيل قط أنها يمكن أن تصل إلى حد أن يفهمها ويعيها ويتسلح بالحجارة في سبيل الدفاع عنها حتى الأطفال.. فماذا تستطيع أن تفعل إسرائيل في مواجهتها.. في مواجهة حجارة بأيدي أطفال؟ |
| قلت: ما تستطيع أن تفعله إسرائيل كثير ورهيب بكل معيار.. إنك ترى أن (قوات جيش الدفاع) هي التي تواجه الحجارة التي يقذفها الأطفال.. بل ترى أن عناصر هذا الجيش تصوب مدافعها الرشاشة، لتقتنص طفلاً هنا وامرأة هناك وشاباً مراهقاً هنالك.. ولكن ما تراه هو (شذرة) صغيرة جداً من عناصر جيش الدفاع.. ما الذي يمنع أن تتضاعف هذه الشذرة حجماً.. وأن تحصد أرواح المئات، وراء المئات.. بل حتى الألوف.. وما الذي تخشاه إسرائيل؟ وما الذي تتحسب له؟ إنها تملك تعهداً مكتوباً.. ومنصوصاً عليه في الأمم المتحدة.. بأنها وجدت لتعيش، ولم ينص التعهد، أو الوعد بحمايتها، لتعيش، على كيفية العيش والوجود.. ليس هناك أي نص دولي.. أو أمريكي، يمنعها من أن تعتبر نفسها في حالة حرب مع الأطفال.. وحجارة الأطفال.. وصيحات الأطفال.. وحالة الحرب في منطق إسرائيل، نزول (جيش الدفاع) بكل ما يملك، إلى الشوارع والأزقة والمنعطفات، ليحصد أرواح كل من يشاهد ماشياً على قدمين.. وليهدم كل قائم من البيوت، ويدمّر كل مسجد، أو جامع، أو قبة أو مئذنة.. بل قد لا يجد ما يمنع أن يهدم المسجد الأقصى، بمن فيه من المصلين.. |
| قال صاحبي: إنك تتكلم من منطق الخوف والجبن. |
| قلت: للأسف.. إنه منطق العالم العربي.. منطق أجهزة الإعلام.. منطق العالم الذي يتفرّج.. يتسلّى وهو يرى، الأطفال.. يرمون الجندي المدجج بالسلاح بحجارة يلتقطها من الأرض.. الأرض التي يقول للعالم إنها أرضه.. وسوف تظل أرضه إلى الأبد. |
|
|
 شارع عبد المقصود خوجة
شارع عبد المقصود خوجة 00966-12-6982222 - تحويلة 250
00966-12-6982222 - تحويلة 250