| نبض الإنسان وجماليات المكان |
| في سِيَر عاصم حمدان |
|
بقلم: محمد الدِّبيسي - ناقد وأديب
|
| بعد الأستاذين الرائدين محمد حسين زيدان، وعزيز ضياء
(1)
، يجيء الأديب المدني عاصم حمدان ليسجل بعض ذكرياته، ويدوّن أجزاء من سيرته الذاتية، دون أن يتبع ذات المسار الذي اصطنعه الأديبان الرائدان زيدان وضياء، اللذان اختطا لسيرتيهما ما يطابق والشروط الفنية للسيرة الذاتية، ويحقق لها شيئاً كثيراً من الضبط الزمني والتسلسل المنطقي ولا سيما ضياء، فيما كان حمدان رهيناً لانسياب الذاكرة وفيضها العفوي، وكان صنيعه السيري متأتياً عبر ثلاثة كتب: |
| 1- ذكريات من الحصوة. |
| 2- هتاف من باب السلام. |
| 3- رحلة الشوق في دروب العنبرية
(2)
. |
| صدرت خلال عقد ونصف من الزمن، دون تراتب نصي بين موضوعاتها أو زمني لمراحلها، غير وحدة النسق الفني: السيرة، والقضاء المكاني: المدينة المنورة. |
| كان زمن سيرة الزيدان وضياء، زمن التحولات، إذ عاشت المدينة وفقاً لمضامين تلك السيرتين ثلاث عهود سياسية، حفلت بمتغيرات على صعيد السياسة والثقافة والمجتمع، ومن ثم انطوت سير الأديبين على مظاهر تلك المتغيرات وبعض انعكاساتها. أما العهد الذي أراد حمدان أن تتشكّل سيرته في إطاره؛ فهو عهد الاستقرار وبدايات طور جديد من أطوار العلاقات الاجتماعية والثقافية والعلمية في العهد السعودي. |
| ومن هنا بدأ حمدان يسجل صفحات من تلك الأطوار، كما وعى وقائعها ولا سيما الاجتماعية، وكما استقرت في نفسه، وبمقدار ما ستمده من مخزون خاطره ومكنون ذكرياته عن تلك الوقائع. |
| وسوف يكون كتابيه: (هتاف من باب السلام لمحات من ماضي المدينة المنورة، رحلة الشوق في دروب العنبرية) موضوعاً لهذه المقاربة، وسنحاول الكشف عن البنى والمضامين فيهما. |
|
|
|
|
|
1- هتاف من باب السلام:
|
|
- العنوان:
|
| يختار الكاتب لعنوان سيرته، ما يدل على مكانها وزمانها، وما يوضح طبيعة مضمونها. |
| فالهتاف، بهذه الصيغة المصدرية للفعل: هتف، وهو: "الصوت الجافي العالي، وقيل: الصوت الشديد، وقد هتف به هتافاً: أي صاح به، وفلانة يُهتف بها أي تذكر بجمال، وهتفت الحمامة هتفاً: ناحت"
(3)
. |
| وتتراوح الصيغة المصدرية لأول كلمة في العنوان ما بين الصوت والجمال في معناها المعجمي، ومن ثم يحدد العنوان مصدر هذا الصوت وذلك الجمال: من باب السلام، أشهر أبواب المسجد النبوي الشريف، ومن هنا يتأتى المكان، كمحور في السيرة دالاً على موقعه المادي والمعنوي، ومكوّناته الموشاة بالقدسية والجلال، لتعقبه الجملة التفسيرية: لمحات من ماضي المدينة المنورة. |
| مما يعني تجاوز السيرة لحيز الـ (هتاف من باب السلام)، لتنفتح على ماضي المدينة المنورة، وفق ما تفضي به الجملة التفسيرية الإضافية في العنوان. |
| وبدلالات وجماليات العنوان كعتبة نصية تُجسِّد هذه المضامين الدلالية، وتؤسس في ذهن المتلقي الإطار الموضوعي الزمني والمكاني للسيرة. أو اللمحات من ماضي المدينة المنورة، كما يحدد كاتبها. |
| والسيرة كما يعرِّفها منظرها الأول فيليب لوجون: "حكي استعادي نثري، يقوم به شخص يعبر عن وجوده الخاص، وذلك عندما يركز على حياته الفردية، وعلى تاريخ شخصيته بصفة خاصة"
(4)
. |
| وكاتبنا ينطلق قصداً إلى التعبير عن وجوده الخاص وتاريخ شخصيته، وذلك بصيغة ضمير الغائب/المروي عنه "الفتى" الذي ظل ثيمة تشير إليه؛ لما تحققه الصياغة بهذا الضمير من مساحة تقيه "السقوط في فخ الأنا الذي قد يجر إلى سوء فهم العمل السردي، وأنه ألصق بالسيرة الذاتية، وذلك على الرغم من أن الكاتب المحترف قد ينعت نفسه في محاولة فصل "الأنا" السردي عن "الأنا" الكاتب؛ ولكن ذلك قد لا يكون إلاّ بمقداره"
(5)
. |
| والكاتب بقدر عنايته بأن يكون وفياً لشرط التسجيل، واستيعاب المراحل التي مرَّ بها في حياته ويومياتها المتعددة والمتنوعة، وتوفير قدر من الروابط التركيبية بجمالياتها الأسلوبية في السيرة؛ فإن البعد التربوي والنظر بإجلال إلى ماضيه المستعاد، يعدُّ مثالاً معبراً عن ماضٍ أراد له بدءاً أن يكون صوتاً للجمال. |
|
- الإطار الأسري:
|
| يقول: "من باب المصري تنتقل خطوات الفتى إلى موضع آخر يحفل بحياة صاخبة هذا الموضع هو "سوق خراج" يتذكر كيف أن والده يأخذه ليحلق رأسه عند واحد من الأخوين "الخستة" وكان يوم الحلاقة يوماً صعباً عند هذا الفتى، فالمعلم شديد عندما يمسك برأسه فلا يتركه إلا وقد اجتث شعر الطفولة الفاحم اللون، وهو لا يجد تفسيراً لما يسمعه من والده بأن تربية الشعر أمر غير محبب، وأن إمالة الكوفية إلى الأمام لا يفعله غير المطاليق من الرجال..."
(6)
. |
| في موقف كهذا تتجلى بساطة الحكي مع الحرص على تأسيس شيئاً من ملامح اليوميات الأسرية والاجتماعية المعتادة في مجتمع بسيط، يكون الوئام الأسري الحميم والطاعة المطلقة للأبوين إحدى ركائزه المهمة، والاهتمام بالمظهر الشخصي الشكلي من أصل اهتماماته. وليس ثمة ما يحمله هذا المقطع من السيرة سوى تأكيد معنى الطاعة المطلقة للأب والإنصات لتوجيهه ورأيه التربوي. غير أن تكوين معنىً كهذا يجيء من أكناف المكان المحدد بعلاماته الأصيلة (باب المصري، سوق الحراج)، مع الإشارة إلى دهشة الطفولة وغياب تفسير موقف الأب لدى الابن، وإذا كان ثمة ما يستحق الإشارة إليه غير هذه الإشارات، فهو تمكين المعنى من التشكل بهذه الصياغة العفوية، التي تأخذ معنى التسجيل المباشر لهذا الموقف. |
| وفي إطار هذا المحضن السري تتخذ السيرة منحاً آخر في تسجيل العلاقة بالأم، يقول: "أغلق على نفسه الباب، وارتمى على الأرض، دخلت عليه أمه لتشاهد ماساته، واستفسرت كعادتها -بشيء من القسوة- لماذا فعلت ذلك؟ أجابها بصوت خافت ت فلقد تعلم من أبيه أن رفع الصوت في المنزل من ضروب الأخلاق السيئة - أجابها. |
| يا بني - تذكرت المرأة الصابرة التي لا تعرف في حياتها سوى منزل الجد، في تلك البقعة النائية في أرض السكة، ويعاوده صوت أبيه الأجش عندما يصل برفقة أخوته إلى دار جده: "يا أبا سليمان؛ الأبناء اليوم في ضيافتك، وإذا ما ارتفع صوت المؤذن لصلاة المغرب يجب أن يكونوا في دارهم برفقتك.."
(7)
. |
| وإذا كان هذا المقطع قد حمل جزءاً من يوميات سيرة الكاتب، فإن ما يحرص عليه ويكاد يتكرر في كل مقطع هو التركيز على تسمية المكان وتحديده، وكذلك تقديم ما يعبر عن القيم التربوية التي تضطلع بها الأسرة ويتوافق عليها المجتمع، وهو يتكئ كثيراً على هاتين الركيزتين المكان وقيم الترابط الأسري، وما يمكن أن يقدمه من خلالهما من مواقف ودلالات. |
| إذ ينوِّع في الشكل البنائي للصياغة، فهو يبدؤها بالحديث بضمير الغائب، عن "الفتى" الذي يسير في الدروب ويغشي الأماكن، ويتألف مع الناس في مطاوعة وائتلاف شديدين مع المقررات الأسرية والاجتماعية. ويعيد كثيراً ما يعبر عن طبيعة علاقته بأسرته، ليكشف بعض سمات تلك العلاقة وطوابعها، وقد يأخذه طابع هذا الحكي السيري إلى صيغ إخبارية، تنضح بالحنين إلى الماضي، وإن كانت تعبيراتها لا تكشف عن مثاليته ونقاوته المطلقة، فإن بنائها أسلوبي ومكوّناتها اللغوية تنحو إلى ذلك. |
| ومن تنويعاته في البناء، ما يسفر عنه المقطع الآتي من حديث إلى المخاطب "الابن" عندما يقول: "لم يكن يا بني يغري أباك في صباه ما كان يغري أنداده من لهو بريء، كان يرى شباب الحي يؤمون بالمقلاع، وينقرون بأصابعهم على الأواني الحديدية الفارغة، ويرفعون أصواتهم بـ "الزومال" ثم يحركون أرجلهم إلى الأرض حتى إذا ما لامست الأقدام هذه الأرض ازداد تطاير وتصاعد تلك الذرات حتى ينشأ من ذلك كله هالة تشبه السحاب، فلا يكاد الإنسان يرى صديقه أو يتبين ملامحه، وسمعهم في السيح وحوش عميرة وحوش مناع، وزقاق سيد أحمد يتغنون بشاب اسمه علي البدوي، ولقد كان التغني -يا بني- يتصل بشجاعته وقدرته على القشلع بكلتا يديه.."
(8)
. |
| فهو في سياق الوصف الحركي للعبة "المزمار" يستبقه في نفي المشاركة في اللعبة أو الاستسلام لإغوائها، مع ما يباطن وصفه لها من تشويق جمالي، ويلون الوصف كعادته بالنص على تسمية الأمكنة الجزئية بالمدينة "الأحوشة" والأزقة والحارات، والأشخاص "علي البدوي". ويوسع متلقي هذه السيرة أن يتصور -وفق البنى والسياقات النصية السابقة- نوعية ومكوّن فضاء السيرة: المكان/المدينة، في الحقبة التي يصورها النص، والتقاليد الثقافية الاجتماعية السائدة فيه، كما لا يعدم استشعار فورات الحنين الذي يختزله النص إلى تلك الأزمنة والأمكنة. والاعتداد الجسور بها، وهي تمثل صوتاً/ هتافاً يحاول الكاتب أن يطلقه بين السطور. |
| ويعاود الكاتب عبر الإفضاء بسيرته واختطاط آلية صياغتها، بين ضمير الغائب المروي عنه/الفتى، والمخاطب/الابن، كما في المقطع السابق، الانتقال مرة أخرى إلى الغائب، بصيغ مختلفة، يحاول عبرها تقديم ملمح آخر من السيرة عبر انتقاء إحدى اليوميات المعتادة في ذلك الماضي، يقول: يستيقظ الرجل من نومه بعد أن ألقى ذلك المنهك على الأرض في "حلة" المناخة، وبعد يوم طويل في المعاناة قضاه في جمع حفنة "من القروش" لقاء حمله في عربة "الكرو" لشيء من متاع الناس في أحياء المدينة، يسكب الماء على وجهه من ذلك الإبريق، الذي بصنعه أرباب المهنة، في مكان غير بعيد من سوق التماره، يتوضأ من ذلك الماء الذي أصابه طلٍّ من سماء الأرض المباركة..."
(9)
. |
| وكأن الصوت هنا يحمل مرة أخرى ما يستهدفه الكاتب أصلاً من تقديم وتأكيد ما يختزنه المكان/المدينة، والزمن/الماضي من قيم إنسانية وجمالية تتجلى في هذا لمقطع في الإشارة لإحدى صور الكفاح الحياتي اليومي للناس، في مثاله السالف. دون أن يتدخل صاحب السيرة في الزج بذاته في خضم هذا المشهد، الذي يعبِّر في مكانه من سياق النص عما يحيط بالكاتب من نماذج مجتمعية تشكل رصيد ذاكرته وتقدم الأجواء التي انبثق منها. |
|
- الإطار المجتمعي:
|
| ومن أمثلة ما يحيط به من أجواء، يستدعي تفصيلاتها مبتدئاً بإقرار وجوده فيها وتأثيرها المباشر والعميق في تكوينه، قوله: "توقظه المواجع من نومه، لم يؤذن الفجر بعد بالطلوع، ولكن آلات جلب المياه من الآبار تنبعث في صوت مميز من بين غابات النخل الكثيفة، والممتدة على الضفة اليمنى من مجرى سيل ((أبي جيدة)) والفتى يعرف من بين أسماء تلك الحدائق بستان الطيبية"
(10)
. |
| إن مكمن حياد الكاتب في تشكيل هذه الصور من ماضيه، وهذه الملامح من سيرته تتمثل في عدم اصطناعه جماليات التعبير وتحلية صياغته الأسلوبية بتعبيرات خيالية أو لغة إنشائية فوارة، بل في تمكينه لحرارة تكونها العفوي، وإعادة تسجيلها كما تمثَّلها، وفقاً للمقطع السابق، وهو ما يحسب له من جانب، ومن جانب آخر، لثراء هذه الصورة وما تحتويه من صدقية وجمال، مما يعطيها تجسداً واقعياً حقيقياً يرفعها إلى مستوى التأثير المباشر في المتلقي، وهي ترصد أحد عناصر التكوين الجمالي الحقيقي للمكان وطبيعة تشكله، فهو يمازج بين تكوين الزمن والمكان في انعطافة عفوية معبرة. |
| ومن أشكال تنويعه في الخطاب السيري، وصفه لنفسه بـ "صاحبنا" وهو نفسه "الفتى"، بحسب ما يتأتى له الخطة الكتابة ويعبر عن مراده منها، يقول: "يصل –صاحبنا- إلى الموقع الذي يفصل بين سوق "العباشة" وباب "المصري" سمع الرجل الصالح يناديه –مداعباً- على بعد "يا أبا..." يسرع صاحبنا فأبناء الحارة كانوا يجيبون النداء، ولا يتأخرون عن "الفزعة" يمد يده في أدب ويأخذ تلقيمة الشاي من الرجل الكبير، ثم يدخل إلى مقهى "محمد سلطان" ينتظر دوره بالقرب من "المنصة" الخاصة بصنع الشاي، يتكئ في طمأنينة على الجدار المبلل بشيء من الرطوبة، حتى إذا ما أتى دوره، نادى عليه صاحب الشأن وأعطاه "براد" الشاي، يحس بنكهة النعناع "المديني" التي إذا ما تسللت إلى أنف الإنسان، بعثت فيه شيئاً من حيوية الحياة وزحمها بل وجمالها..."
(11)
. |
| فهنا تنطوي (الحارة) على كون حياتي مأهول بالناس والأشياء والحراك المعيشي متعدد الجوانب، يرصد الكاتب وقائعه ويوثق منعطفاته، لا يتنكب إعادة إلاّ بالكيفية التي تجلَّى فيها في لحظة تكوينه الأولى، موالياً رصد صورة أخرى من صور الحياة بالمدينة كما وعاها، متنقلاً بين الأمكنة في فضائها الرئيس المدينة، وبين مكنونها الجزئي (الحارة)، مشاركاً في حراكها المعتاد؛ دخول المقهى والشروع في الشراكة مع الناس في يومياتهم. يعيد استحضار تلك الصورة ويستعيد نشوة النعناع المديني، التي لا تزال حواسه تحتفظ بمذاقه. مؤكداً ما ذكرناه من مكمن جودة تشكيل تلك الوقائع اليومية، دون توجيه لبعاد حدثيتها أو استباق تحديد تأثيرها، أو اصطفاه دلالة لوقعها في نفسه، فيوفي تقديمها تسجيلاً حقه من الإحاطة بمكوناتها وكيفية تشكلها بقدر من الأناة، والاقتصاد في التعبير، وهي تنطوي على زخم إنساني يعبر عن البساطة في التكوّن والحضور. |
| فـ (المقهى، ومنصة الشاي ومذاقهُ، والجدار المبلل) على ما تمثله فعلياً من طقس اعتيادي في يوميات الناس في ذلك الماضي، فإنها في سياقها النصي الذي اختاره الكاتب، تجسد ملمحاً من ملامح تشكل القيم الاجتماعية والثقافية السائدة في المجتمع آنذاك،وتشي بقدر من جمالياته التي تتأتى هنا بطوابعها الحقيقية وسمتها المعبر عن مكونات شخصية الكاتب وشخصيات مجتمعه، والأمكنة التي احتوت خطوات حياته الأولى والبيئة التي وسمت شخصيته بسماتها. |
| وإذا ما أردنا قياس نسبة حضور شخصية الكاتب في النص، موازنة بحضور الأمكنة والآخرين، والوقائع غير المرتبطة به بشكل أساسي-كما سيلي لاحقاً، لوجدنا حضوره يتوارى نسبياً في ظلال الآخرين، والمكان والناس، فهو معني بتقديم البيئة المجتمعية التي أنتجته، والمكان الذي خبر زواياه وحاراته وأزقته وأناسه يرصد يومياته وحراكه وتبديات مظاهره الطبيعية. ملتزماً بالحقيقة وممتنعاً عن حن صياغاته اللغوية بمغذيات أسلوبية ومجازية مساندة
(12)
، وهو شديد القناعة بأن الحقيقة وحدها ورسم جغرافياً الأمكنة وسيرتها كما كانت أدعي على تحقيق عنصر التوثيق وتسجيل السيرة، ما يمنح كتابته مشروعيتها السيرية. |
| وبعد أن قدَّم (الأب، والأم) وأعطاهما حضوراً نصياً يفصح عن القيم التربوية والأخلاقية في بعدها الثقافي، ونطاقها المكاني في تلك الحقبة؛ فيمنح (الجدَّة) حضوراً سريعاً في لمحة يبطنها بالإشارة إلى عادة المدنيين في مديح النبي صلى الله عليه وسلم . محققاً نوعاً من الاتساق النصي بين الأسرة والمجتمع، ويجلّي مركزية (الجدَّة) في مجتمعها، فيقول: "الجدة (...) المرأة الصالحة الكاملة الكريمة -رحمها الله- والتي تسكن حوش المغربي في زقاق الطيار -كثيراً- ما ارتفع صوتها بمديح المصطفى عليه صلوات الله وسلامه في السالمية، والفيروزية، والمصرع، بستان أم الشجرة، وعرس لا يتوّج بحضور تلك السيدة- التي تغذيت من حنانها، وارتويت من لبن "السعن" المنتصب من باب دارها- ذلك العرس أو هذا الفرح يعد ناقصاً..."
(13)
وقد يجرح السياق هنا ترقيمه لاسم الجدة بـ (....) ولو اكتفى بوصفها بالجدة؛ لكان أجدى من حرصه على الإشارة عن موقفه من ذكر الاسم، وامتناعه عن ذلك. |
| واللافت في هذه النصوص -كما أسلفنا- أنها لا تكاد تخلو من اصطحاب المكان بأسمائه المعروفة ومحدداته الجغرافية، التي تتوالى في منظومة النص، ويمنح كلاً منها السمات التي تميزه، مثلما يحدد بعض مظاهر اليوميات المعتادة في حركة حياة الناس فيها. |
| ونلحظ أن "أنا" الكاتب السير ذاتي وهي بصدد الكلام (تتماهى في موقف مباشر للتواصل الشفوي مع مخاطبه)
(14)
كما يقول فيليب لوجون، ولذلك يمكننا أن نعد طبيعة النظم الكتابية لهذه السيرة متناغمة مع شفهيتها، وهو ما يعطيها إمكانية أكبر للتواصل مع ذهن وذائقة المتلقين، بحسب ما نجده في المقطع التالي، يقول: "الشهر شهر الرحمة "رمضان" واليوم "جمعة" والمكان مسجد المصطفى صلى الله عليه وسلم -يرتفع التكبير من المقام لصلاة "الميت" تتزاحم الأقدام لحمل جثمان أحد رجالات البيت الحرام، ولا تسعفني الذاكرة إذا ما كان الرجل الذي حملوه إلى بقيع الغرقد في ذلك اليوم المبارك هو الشيخ سالم جان شاه.. -رحمه الله- أم رجل آخر
(15)
ومع أن هذا المقطع لا يقدم إضافة جديدة للمنسوب الدلالي للسيرة، فإنه يدل على إدراك الكاتب لقيمة التسجيل. كما تدل جمله وتراكيبه والاحترازات والاستطرادات فيه على سيطرة الشفاهي عل نظام هذه الكتابة. |
|
* الشخصيات والأمكنة:
|
| يبين الكاتب في ثنايا السيرة ما يرسِّخ الجغرافيا الاجتماعية لها، ويمنحها إمكانية الوقوع على مظاهر ثقافية تختزن ألواناً من النسيج المجتمعي وتنوعاته، يقول: "وتسترجع ذاكرة الفتى الحي الذي نشأ فيه، هذا هو المدرج طريق يفصل الدور عن مجرى السيل وإذا خرج الفتى رأى أمامه بيت العم أمين شيخ، ثم بيت السادة آل الزهدي، هنا تسكن المرأة التي احترق قلبها على فناها الذي ذهب في ميعة الصبا وريعان الشباب، وكثيراً ما ردد شباب الحي أنشودة المغناة: |
| الدنيا حلوة وجميلة |
| والمدة ما هي طويلة!! |
|
| تُرى هل كان خالد زهدي رحمه الله يرثي نفسه بهذا القول
(16)
... ونستشف من هذا المقطع اتجاه ما رسخ في ذاكرة الكاتب من مواقف مرَّ بها حياته تعكس حسًّا إنسانياً معبراً، ولوناً من ألوان الثقافة الشعبية السائدة. |
| إن وسمنا لهذه المقاربة بالجماليات يتخذ مشروعيته من كثرة اتكاء الكاتب على المكان لاستظهار جمالياته وتمكين حضورها في النص، واسترجاع الأحداث المعبرة عن خصائص ذلك المكان "الذي يبدو كما لو كان خزاناً للأفكار والمشاعر والحدوس، حيث تنشا بينه وبين الإنسان علاقة متبادلة يؤثر فيها كل طرف على الآخر"
(17)
. ولذلك ظل المكان بعناصره الجزئية ومواقعه المتعددة مسيطراً -إضافة إلى الأشخاص- على معمار النص وتشكلاته البنائية: |
| - عددحضورالشخصيات (76). |
| - عدد حضور الأمكنة (54). |
| ويمكن أن نعد هذه الحفاوة البالغة بهذين ترجمة لما يقتضيه عنوان هذه السيرة من تطبيقات نصية، وفي المقطع السابق ما يعبر عن مجال من مجالات تحقق تلك الحفاوة والدلالة عليها. فهو يجمع بين موقفين تغذيهما المفارقة، الأول: تراجيدي شجي يصور أثر الفقد، والآخر: في إشارته إلى الغناء، كمظهر يدل على تعدد محتويات ذلك الخزان/المكان وما فيه من أفكار ومشاعر وحدوس. |
| فالمكان مفتوح بالدلالة السمتمترية لهذا الانفتاح وليس بالمعنى الاصطلاحي الفني فقط، وهو ما يعد تجاوزاً "إلى ما هو أبعد في العمق الإنساني وأكثر تعقيداً؛ فمع المكان يقع الإنسان في ظل استشعار العواطف الذاتية. والإنسان في تعامله مع السطح المكاني يستشعر معاني اللذة والألم والخوف والأمن، وما يترتب على هذه المشاعر من أحاسيس داخلية ومواقف متداخلة تجعل النفس الإنسانية مكتنزة بعوامل المكان بشكل يصعب استقصاؤه"
(18)
. |
| وهكذا يتمثل المكان في وعي الكاتب، ليس بالتطبيق الحرفي للمقولة النقدية السابقة، ولكن في تطابق مضامينها مع استراتيجية النص الأدبي الذي نحن بصدده، إذ لا يفوت الكاتب لحظة استرجاع الوقائع والحالات الإنسانية في مجتمعه أن يصطفي منها ما يعيد هذه السيرة إلى الالتحام بدلالة عنوانها ومركزية فضاءها المكاني/الحرم النبوي، يقول: " لم تطل الطريق بالفتى كما طالت به ظهر ذلك اليوم، هذا مسجد "الغمامة" وهذه بقايا من السوق القديم الذي ترسخت معالمه في النفس، وتغلغلت رسومه في مساريها العميقة، وهذه البوابة التي دأب الدخول منها "للحرم" إنه "باب جبريل" لم يبق من أهله إلاّ "حسن برقاوي" تذكر في تلك اللحظة العم "حسب الله" وهو يدق مسماراً في هذا الكرسي أو يصلح بالمطرقة اعوجاج أبواب غرف "الرستمية..."
(19)
. |
| فالأمكنة والأشخاص قريبون من الكاتب، أو لعلّه كان قريباً منهم، منذ أراد أن تكون سيرته مشهداً يحضرون من خلاله، قاطعة الطريق بالفتى المساقة من الشجن الخفي، وهو يعيد توثيق حضور شخصياته وأمكنته. فقد أعلن بدءاً من العنوان أن الهتاف إنما ينطلق م باب السلام/المكان، وأن هذه السيرة لمحات من ماضي/الزمن ـ المدينة المنورة، ومن ثم فهو ملتزم -كما أسلفنا- بمقتضيات هذا العنوان. وجاء البناء النصي متوافقاً مع كشوف السيرة وانعطافاتها، المتكرر والعادي من محطاتها، والملفت العميق من صيروراتها. |
| ويترك الكاتب لذاكرته حرية الاندياح، ويسترجع ذكرى الأشخاص الذين نشأ بينهم، ويستطرد كثيراً في توصيف مناحي أنشطتهم واهتماماتهم، حتى يكاد ينسى وجوده بينهم، عندما تجاوز الوصف الذي ما فتئ يكرره في بداية كل مقطع "الفتى" ولا يجد مفراً من الإقرار بما فعلته به صروف، يقول: "واختفى ولد الحارة في زحمة الحياة، وتوارى عن الأنظار -رفاقه- من أهل الحلة، وافتقدته رحبة باب المصري، ولم يُر إلاّ في اليوم الذي حملوا الرجل الصالح إلى -مثواه الأخير- في ضحى يوم أغر يتذكره ـ العبد الفقير إلى الله -ويزداد حنينه- كل يوم، للأيام الخوالي التي قضاها في كثير من الحبور بين المناخة وباب المصري.."
(20)
. |
| ولا يعادل ولعه بشخصيات ماضيه الذي انبثق وجوده بينهم، إلاّ الأمكنة التي يقارب عددها عدد الشخصيات؛ في توظيف نوعي لدلالاتها في السياق النصي. وحرصه على وصف شخصياته بالمثالية ليس بخلع الصفات أو إنزالها عليها، وإنما من خلال ما يفضي به سياق ذكره لها، ورسم وجودها في النص، وهو إن كان ينتقي هذه الشخصيات دون غيرها؛ فإنه لا يغامر كثيراً في إحاطتها بهالات إعجاب أو تأطيرها بنعوت مناقبية. وغالباً ما يجعلها تالية للحدث الرئيس الذي يريد من خلالها الإشارة إلى موقف، أو عرض تشكل قيمة، وإن كانت هذه القيمة في سياق المعتاد مما تتوافر عليه طبائع البشر واعتيادات الحياة، يقول: "كأنني بالرجل الوديع المبتسم -في سوق العياشة"- ينادي الغادي والرائج يشتري شيئاً من ذلك الخبز المتميز الذي يدعونه في البلدة الطاهرة بـ "الشريك" ويعرض في مدن أخرى مثل مكة شرفها الله بـ "السحيرة" يقول الصوت "الشريكة" ستة هلل.. قرش ونصف! |
| الأجيال الصاعدة قد يأخذها شيء من الدهشة إذا ما عرفت أن "أفة" اللحم كانت ببضعة ريالات..
(21)
. |
| فالسيرة مليئة بما يحيط بالكاتب من معطيات ووقائع وشخصيات، يقدمها أحياناً في سياق مقارنة ما كان فيه من لمحات ماضية، وبين حاضره اليوم. وهذه الوقائع تنتظم في مكانها من السيرة، فمهما تتنوّع وتتكرر مواقع حضورها في النص، فنطاقها قادر على صهرها في لحمة السيرة، مما يمكّن هذه التنويعات من ترسيخ البعد الدلالي لهذا الحضور، وترسيخ جماليات المكان بتنوع أنشطة الناس وانساق حضورهم. |
|
* الحرم.. المكان المقدس:
|
| وكما يحرص الكاتب على تغذية سيرته بالأمكنة التفصيلية (الحواري والأزقة) في إطار المكان الرئيس/المدينة، فهو كذلك يغذيها بالأزمنة التفصيلية في إطار التحديد المطلق للزمن/الماضي، ومن ثم فهو لا يكترث بتحديد السنوات، بينما تتقاطع في النص أجزاء كثيرة من سيرة الأزمنة والمواقيت التفصيلية (رمضان - الجمعة ت الفجر- الظهر...) إلخ. |
| فهذه المواسم التي تستعيد لحظاتها الحواس وتستردها الذاكرة، وتتناغم فيها فاعلية المكان مع فعل الزمن، توثّق ملمحاً من ملامح تقاليد المكان وجمالياته، عندما يقول: "انقضت صلاة الظهر، أحس في تلك اللحظات بشيء من التعب، سلك الدرب إلى باب العوالي طرق باب صديقه "الزين" أجابه صوت بأنه غير موجود!! وسأل -نفسه- متى يستريح صديقه من هذا التجوال في أماكن متباعدة من البلدة الطاهرة؟ واليوم يا صديقي أضحى النزوح إلى داخل النفس، ولم يعد يروي الظمأ ذلك الماء الذي كان يسكبه الرجل الذي يحمل "جملته" ويسقي بها المصلين عند باب السيدة فاطمة- رضي الله عنها ت ماء تفوح منه رائحة الكادي وثياب تتضمخ برائحة "العود" المشتعل في مجمرة "الشريف حسن طاهر" رحمه الله، لم يطل به المقام في دار "الزين"كعادته قطع الطريق بين باب العوالي وسوق "الخضار" في شيء من الترقب والحذر..."
(22)
. |
| فقد كدَّه التجوال وأضحى في حمأة المقارنة بين زمانين ومكانين، ليستعيد المكان البصري الحقيقي، ويعيد تشكيل صورة من صوره، وإن كان مكاناً منقولاً إلينا عبر السياق النصي نقلاً بصرياً، فإن دلالته البصرية هاته، تتأكد من خلال كونه مكاناً حقيقياً هو المدينة، وإذا كنا " نتحدث عن أمكنة إدراكية تشكل عقل المدرك فالمكان البصري التجريبي يصنع المعرفة في دواخلنا، فنحن نكتسب فكرة المكان بالنظر واللمس -والمكان السمعي- والمكان البصري، أمكنة تتشكّل في عقولنا باستمرار، وفي المدينة المنورة، ورغم تشكل المكان البصري عبر تاريخ المدينة الحبيبة، إلاّ أن هناك المكان الحقيقي الثابت الذي يجعل أبصارنا وعقولنا دائماً مرتبطة به، المكان الشريف، هذا المكان الذي يجعلنا ننطلق للفضاء البصري المتخيل، ويعيدنا للتاريخ.."
(23)
. |
| وليس بوسع المتلقي إدراك جمالية هذه الصورة للمكان، إلاّ عبر القضاء البصري المتخيل الذي يعيدنا للتاريخ كما يقول مشاري النعيم، فهذه الصورة وغيرها تشكّل جزءاً من تاريخ المكان وجمالياته، التي ما فتئت بكل تجلياتها، ومكنها في السجل السيري تميل إلى معنىً كان حظه أقل حضوراً وتمثلاً نصياً في هذه السيرة، وإن كانت مآلاتها الدلالية تحيل إلى هذا المعنى، بدءاً من توثيق حضوره في العتبة النصية الأولى للعنوان : "باب السلام" وما حفلت به من إشارات ضمنية عديدة إليه. ومروراً بمقاطع أخرى احتواها النص وأكّدت عليه كذلك، يقول: "لا أعلم يا بني إذا ما كنت قادراً يوماً على الإمساك بيدك يوماً كما فعل جدك معي- في طفولتي وشبابي وسرت بك حول رسوم المواضع التي عبقت أرجاؤها بذلك التاريخ المشرق الذي كان بدايته عندما اختار الخالق -عزّ وجلّ- تلك الأراضي المباركة لتكون مهاجراً وموئلاً لحبيبه وصفوة خلقه -سيدنا محمد عليه صلوات الله وسلامه- ثم ضمته أحشاؤها متباهية، ويحق لها أن تتباهى- واحتضنت جسده الشريف ذرات ترابها الزكيّ، متفاخرة، ويحق لها أن تفاخر، ومنذ ذلك اليوم أو تلك اللحظة في تاريخ هذا الكون..."
(24)
. |
| ويبدي "الفتى/الأب" -الذي ورث عن أبيه السير في دروب المكان المقدس، وحاس زواياه وساحاته- شكَّه في أن يكون بوسعه أن يتخذ ذات الصنيع مع ابنه، مقدماً في هذا المقطع معطيات تلك القداسة، حيث يضم المكان في ثراه بدايات انطلاق التاريخ الإسلامي، وتأسيس دولة الإسلام بالمدينة، واحتواءها المسجد والجسد الطاهرين، وبلا مغالاة في الوصف أيضاً يتداخل البعد التربوي والقيمي مع افتخاره بمعطيات وحيثيات ذلك الحب للمكان والتعلق بذراته في وجدان الابن، في صياغة تنمّ رغم مباشرتها عن تحسس قيمة المكان في الوجدان، وهي من المقاطع التي لم تتكرر كثيراً في السيرة. اعتماداً على أن كل سياقاتها ومضامينها النصية تحيل إلى هذا المعنى كما أشرنا من قبل. |
| وقد شكَّلت فكرة المقدس بعداً قاراً في أذهان كل من استقوا من هذا المكان مجريات سيرهم، مثل من قدمنا الإشارة إليهم في مستهل هذه المقاربة، وهم لا يتجهون إليه بوصفه مقصدية رئيسة، ولكن لأن موجبات السياق وقدّر سيرهم وتكوناتها تقتضي استصحاب أو استلهام بعض علامات هذه القداسة، فمجتمعهم كمشهد للسيرة تنسحب عليه شروط ومقتضيات صيرورة المجتمعات ومتغيراتها وأحوالها العامة. بيد أن ما منحته فكرة المقدس له أو الديني الضارب في جذوره في أعماق وعيهم وإحساسهم يجعل من ظلاله لازمة طبيعية، يتغايرون في سمات توظيفها واستثمارها، وإن كان أكثرهم في التأكيد عليها -حداً يصل إلى توسل معاني إشراقية عميقة وموحية- عاصم حمدان، باعتبار ما أنجزه من مؤلفات في هذا الجانب. |
| ولا يكاد يفضي بمواقف أو حالات عايشها في إطاره، دون أن يصطفي منها ما يعزز قيمة هذا المكان في التزاماً بمحددات المعنى الذي أشير إليه آنفاً. |
| ففي استحضار موقف وفاة أحد الأعلام بالمدينة، ممن عايشهم الكاتب وتحقق من قيمة حضورهم، يقول: "ولقد أدركنا من أهل العلم نفراً كريماً ونادراً في علمه وخلقه ومسلكه كفضيلة الشيخ عبد العزيز بن صالح - رحمه الله- الذي صعد منبر مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم -لأكثر من أربعين عاماً- فلم تخرج منه كلمات الكفر والشرك في حق أحد من أتباع الديانة السماوية الخاتمة، وكان -يا بني- رفيقاً بجيران المصطفى -صلى الله عليه وسلم- ومقامه الطاهر فوجد أبناءه قد تأدبوا بذلك الأدب الرفيع الذي عمل ت أبو محمد - شيوخاً وشباباً وأطفالاً ليواروه في التربة التي أحب وتأدب مع صاحبها وصحابته وآل بيته رضوان الله عليهم"
(25)
. |
| فمجمل ما يشير إلى هذا المقطع -ليس في موقعه في سياق الشخصيات التي حفلت بها السيرة، وإنما فيما يريده الكاتب من الإشارة إليه- تميّز واختلاف خطاب الشخصية التي ذكرها (الشيخ ابن صالح) الديني وتأثيره في المجتمع المدني، ومن ثم يتخذ حديثه عنه صبغة مقالية، تؤكد على طبيعة الدور الذي قام في تعزيز قيم التسامح والمحبة والدعوة باللين، ويتم ذلك في إطار يستدعي مقارنته بغيره ممن لا يتخذون ذات المنحى. وبوسعنا عدَّ هذه المقطع ضمن استهداف المؤلف للبعد التربوي والقيمي الذي أراد استظهاره والإشارة إلى نماذجه في هذه السيرة. |
| إن (هتاف من باب السلام) الذي تجاوز به مؤلفه مأزق التصنيف الفني، وأراده (لمحات من ماضي المدينة المنورة)، ما بعد منتصف العقد الخامس من القرن الرابع عشر الهجري ليقدم صورة بانورامية عن ذلك الماضي، بوقائعه والاتجاهات العامة فيه، وتشكيلاته الاجتماعية كما وعاها مدوّن بعض لمحاته/الكاتب. الذي اختار صيغة في الأداء التعبيري تستجيب لها ذائقته وتطاوع وعيه،وتحقق ما يريده من نقل أجزاء من سيرته للمتلقي، يريدها تارة درساً في القيم التربوية والإنسانية المثلى، ويجعلها أحياناً تسجيلاً لذكرياته وتحريراً لشيء من مجريات حياته، ويتخذ منها تحفيزاً لحضور أشخاصٍ طيبين غيبهم الزمن، وحياة طواها المتغير، وهي مع ذلك كله، تقدم صورة لجماليات المكان/المدينة المنورة، واتكاءً على أهميته الرمزية وقدسيته. |
|
2- رحلة الشوق في دروب العنبرية:
|
| وهي الإصدار الثالث بعد (ذكريات من الحصوة)، وتتسق مع (هتاف من باب السلام) في تقديم الجمالي والاتكاء على القدسي في المكان. وتنوّع وتعدد حضور الشخصيات المحورية والضمنية، وحضور المكان نفسه كمشهد يحتويهم ويؤثر فيهم. دون أن ينظم كتابته في تسلسل زمنين ودون أن يكون لسيرته ببدايتها وامتدادها والمحطات التي شكلتها خطاً بينياً متصاعداً ومتنامياً باتساق، كما هي التقاليد الفنية لكتابة السيرة، بل جعلها مختارات عفوية، يحرص على تدوينها كلما وافته لحظة الكتابة. ولعلّه يكون بذلك أقرب إلى أستاذه محمد حسين زيدان، شديد الاعتداء بالمكان متمرساً بالإحاطة بمجريات تاريخه القريب. |
| ومن هنا قد يجوز لنا أن نعد كتابيه: (ذكريات من الحصوة، هتاف من باب السلام)، تجربتين سيرتين رسخَّتا لديه القدرة على ترتيب الأفكار والمضامين، ووحدة الموضوع وانتظامه في حيز مكاني بشكل نسبي، مع إغفاله جانب بناء السياق على المقدمات والتنامي الصاعد راسياً. بالرغم من حرصه على امتداداته الأفقية العميقة والالتزام بوحدة المكان الجزئي، والعناية بالنصوص المحاذية للنص الأصلي/المتن. وتوظيف دلالاتها لخدمة المتن وتكريس وحدته الموضوعية. |
| وهو ما يحرره بشكل أكثر حضوراً في كتابه: (رحلة الشوق في دروب العنبرية) آخر إصدار سيري له، وهو ليس الآخر ترتيباً باعتبار الموضوع، بل باعتبار الزمن، فحركة التدوين لديه كما أسلفنا أفقية وليست رأسية، تنتقي من الفضاء المكاني العام/المدينة المنورة، موضوعها ومكانها الجزئي/"العنبرية". |
| فبهذا العنوان المجازي بطابعه الشعري الواضح وإيقاعه الشفاف، يلج حمدان ميدان العنبرية، المحتشد بعراقته التاريخية، وبوصفه علامة مهمة من علامات الجغرافيا الحضارية بالمدينة المنورة، إضافة غلى ما يزخر به من نسيج مجتمعي متلاحم، ومكوّنات جمالية. |
|
* النصوص المحاذية:
|
| يحدِّد جيرار جينيت الجانب الوظيفي الوحيد للنص المحاذي في أنه عبارة عن (خطاب تابع ومساعد ومخصص، يوجد لخدمة نص أكبر هو النص المتن، وهذا النص المتن هو السبب في وجود النص المحاذي، ويسبب هذه الخصيصة، تبدو الوظيفة الأولى للنص المحاذي مرتبطة هذه التبعية من حيث الوجود الوظيفي)
(26)
. |
| وتتحقق هذه الفرضية في كتاب عاصم حمدان منذ صفحة الغلاف الأولى التي تتضامن عناصرها التشكيلية واللونية واللفظية لإسناد النص المتن. والتوجه للمتلقي بخطابها وإغرائه بالدخول في النص المتن وفقاً لجيرار جينيت
(27)
. |
| فالغلاف الذي يشكِّل البياض عنصره الأساس، ينطلق من قاعدته السفلى تشكيل لسكة حديد القطار (المكوّن، المادي والعلاماتي في منطقة العنبرية)، وتمر هذه السكة في البياض اللوني بشكل أفقي حتى تضيع فيه. وقد حفت جوانبها ببياض يتلاشى بتدرج عند جانبي السكة، ويمتد على هذا التشكيل في الأعلى عنوان الكتاب، وقد امتد حرف اللام في "رحلة" والألف واللام في "الشوق"، بشكل مستطيل متوازي وراسي لافت. وجاءت عبارة "في دروب العنبرية" تحت العبارة الأولى ببنط اقل حجماً، وبلون أحمر موافقاً لاسم المؤلف في أعلى الجهة اليمنى من الغلاف، وجاء اسم وشعار الناشر لخط دقيق جداً على يسار الغلاف. |
| ومن إيحاءات هندسة الغلاف وعناصره اللفظية واللونية والتشكيلية، تتضح لنا العلامات النصية الأولى لموضوعه، مغفلين السياق والدلالة الاصطلاحية للفظة: (رحلة) بمعنى الانتقال من مكان إلى مكان ووصف مسيرة وتفاصيل هذا الارتجال، إلى الدلالة الوضعية السياقية لها في هذا الكتاب. الذي يشكل جزءاً من سيرة كاتبه. ولو أردنا استبدال هذه اللفظة بلفظة: (سيرة)، لما وجدنا في المعنى إخلالاً في المعنى بل تأكيد وتعميق لدلالته. |
| ومن هذا المفتتح الإغرائي للعنصر النصي المحاذي الأول، إلى العنصر الثاني، وهو الإهداء الذي قدَّم فيه المؤلف كتابه إلى أسرته؛ زوجته وأولاده، ونصَّ على الأولى بالكنية، والآخرين بأسمائهم، وختم إهداءه بتقديمه إلى نفسه التي اعتبرها من خلال الضمير (أنا)
(28)
كل هؤلاء. |
| فمن محضنه الأسري الأول تشكلت رحلته في دروب العنبرية. وإلى محضنه الأسري الثاني يهدي الوثيقة التسجيلية لتلك الرحلة. وكأن ما فات عناصر المحضن الثاني إدراكه من سيرة حياة الكاتب، وتلك الرحلة والدروب، يدركونه ويعايشونه عبر سيرتها وحياتها النصية. |
| هكذا أراد الكاتب أو أوحى الإهداء، وهكذا حاول الكاتب استعادة الماضي بالكتابة واستلهام إيحاءاته ولذّاته بالتوثيق؛ ولذلك كان هو نفسه ممن أهدى إليهم هذه السيرة. |
| وأما العنصر النص المحاذي الثالث، فهو المقدمة التي كتبها الأديب الكاتب محمد صادق دياب بصياغة أسلوبية راقية. أحسنت استيعاب مضمون الكتاب، واتخذت مدخلاً قصصياً سيرياً في التمهيد لمتنه النصي. بل يمكن لنا أن نعدها لافتة تغري بالنص. وتشهد بالكتاب وقيمة الموضوع يقول: "ذكريات عمرها عشرات السنين تنسكب في لحظة إثارة منحني إياها مؤلف هذا الكتاب الأديب والمؤرخ الصديق عاصم حمدان، فلقد تفضل عليَّ بطلب كتابة مقدمة هذا الكتاب الذي أخذني عنوانه إلى دروب التاريخ ورائحة الزمن الجميل.. فعاصم حمدان لا يكتب تاريخاً، ولا يسجل واقعاً فحسب، ولكنه يرسم بالكلمة صوراً إبداعية لا يتقنها إلاّ مصوّر فنان يلتقط صوره بعدسة القلب والعقل والوجدان"
(29)
. |
| وهنا تتحقق الوضعية الوظيفية للنص المحاذي بحسب جينيت، حيث تجتذب مثل هذه المقدمة رغبة وذائقة المتلقي، وتلبي حاجته في اكتشاف المكتوب. وكما يرى كاتب المقدمة فالمؤلف لا يكتب تاريخاً بقدر ما يرسم بالكلمات بمهارة فنان. وتُضاف القيمة الدلالية لهذه المقدمة بإسنادها الوظيفي للنص المتن، وتقديم ابرز مضامينه وذلك بقلم مقدم فنان كذلك، أجاد استيعاب حمولات النص واستشفاف أبعاده. |
| ووقف على خواصه الدلالية والجمالية، ولم يكن له بد أن يشارك في وضع خامته الأولى وبدايته بذلك السرد الحكائي في رسم الانطلاقة من مكة إلى المدينة وقطع الدروب والمواقع بينهما. وبذلك تفضي هذه المقدمة إلى تحريك حالة الاستعداد القرائي المولوج إلى عالم النص. |
| أما المصاحبات التوضيحية الأخرى المهمة المساندة للنص التي تكشف الفضاء البصري له، وتقربه لإدراك المتلقي. فهي الصور الفوتوغرافية التي وضعها المؤلف في نهاية الكتاب تحت عنوان "صور لبعض المعالم القديمة"
(30)
. ليوضح من خلالها ابرز مكوّنات حي العنبرية قديماً وحديثاً في الحقبة التي تتحدث عنها السيرة. وقد ذيِّل كل صورة منها بما يكشف عن موضوعها ويبين للقارئ عناصرها، وقد اشتملت هذه الصور على العناصر والمحاورات من مكوّنات الحي/العنبرية؛ من دور ومدارس ومؤسسات حكومية، وتكايا وأزقة وأحوشه. |
| ولعلّ أبرز هذه المكوّنات وأهمها وأعرقها تاريخاً مبنى (سكة الحديد الحجازي) الذي شُيِّد في عهد الدولة العثمانية في العام 1325هـ- 1909م. وهو ما يشكل بعداً توضيحياً مباشراً للنص المتن، أراده كاتب السيرة، الذي دوَّنها وعيّنه على مجريات تاريخها القريب وجغرافيتها الاجتماعية. |
| ولنا أن نتصور ما أضافته هذه النصوص المحاذية الفرعية، إلى النص المتن من قيم دلالية تضيف إلى منسوبه الإبداعي، وتقايس المسافة بين المدوّن نصياً عبر المتن، وبين المحاذيات من نصوص وصور وتشكيلات أخرى في الغلاف، يقدمها المؤلف بين يدي نصه المتن. الذي جاء هذه المرة مغايراً لما كان عليه في مؤلفه السيري السابق (هتاف من باب السلام) وتكمن المغايرة ـ إضافةً إلى ما قدمنا الحديث عنه آنفاً من نصوص محاذية - في ضبط مقالات الكتاب بمفتح يلي المقدمة بعنوان: "رحلة الشوق بين العنبرية والحارة"
(31)
يليه عشرة مقالات مرتبة رقمياً بالعدد، وبعنوان واحد يتكرر في بداية كل مقالة بعنوان: "ذكريات من باب العنبرية" يتبعها مقال بعنوان: "يوم رحلت"
(32)
ينعي فيه فقد والده أحد أشهر أعيان الحي، ومختتم بعنوان: ((وجه مضيء))
(33)
، وفيه يصور لوعة الإحساس بفقد ذلك الأب، يوم عاد إن عاد الابن إلى العنبرية. فاستعاد تفاصيل لقائه بالأب، في كل مرة يعود فيها إلى إليهما؛ إلى الحي والأب. |
| وفي هذا الضبط النسبي للمتن ما يساعد المتلقي عل تكوين ناظم سياقي بين مراحل هذه السيرة وانتقالاتها وإحداثياتها المكانية، ومدها الدلالي المتصاعد؛ ففي المفتتح بضغط مضامين الكتاب ويختزلها في صفحتين ونصف، ويلخص سيرة الدرب من المنزل إلى المدرسة إلى الحي ومكوّناته مروراً بالأشخاص/الناس. الذي يتمثل أثرهم في حياته؛ بائعة الخبز "وحيدة" و "موسى"صاحب مقصف المدرسة إلى المقرئين في الحرم النبوي الشريف. إلى الأحياء الأخرى والأزقة وما تحتشد به من نبض حياتي وإنساني، يبسط أثره في نفسه، وينظم تعبيراته تجاهه، ويرسم تكوينات الأشخاص والأمكنة. |
|
* بنية النص ودلالاته:
|
| يستهل المفتتح بالحديث عن "الفتى" ويختمه بـ "الذكرى التي عادت به إلى الماضي يعيشه حباً وشوقاً وحنيناً في أعماق نفسه إلى أيام مضت في الرحاب الطاهرة قضاها متنقلاً بين السيح والحارة.."
(34)
. |
| وبعد هذا المفتتح يلي سرد الذكريات، وقد نص على وصفها بهذا التصنيف وهو ما يعزز انتمائهما للحقل السيري بحسب مدلول هذه اللفظة، وباعتبار المحاميل السياقية النصية التالية، التي والى بينها ترتيباً بالضبط العددي، ولم يتجاوز طول أياً منها ثلاث صفحات إلاّ قليلاً. |
| أما فضاءاتها النصية فكلها في مدار حكاية (رحلة الشوق في دروب العنبرية) أعيانها من الأشخاص والأصدقاء، والأهل والجيران، والأزقة والحارات المحيطة بها والمفضية إليها. ومآل كل الأمكنة وقلبها النابض (المسجد النبوي الشريف) لا يفتأ يستلذ ذكر أجوائه ومؤذنيه وعلمائه وحلقات العلم في رحابه. |
| وكثيراً ما يبتدئ الحديث عن (الفتى) يتتبع سيره في الدروب المتعددة والمتوالية عبر النص. تشده العنبرية بوثاق الانبثاق والميلاد، وابرز المكوّنات الإنسانية والمكانية التي وعتها ذاكرته فيها. |
| ومما ساقه من حديث عن أبرز ما استقر في ذاكرته من مكوّناتها، حديثه عن "كتَّاب المعلمة زينب مغربل -رحمها الله- وكثيراً من سيدات المجتمع اللاتي تعلمن القراءة والكتابة وعلوماً أخرى يرجعن الفضل في تلقي العلم قبل أن تكون هناك مدارس نظامية لتعليم المرأة إلى المعلمة المغربلة. وشعرت بشيء من الحزن لأن هذه الرائدة توفيت قبل سنوات قليلة وبعد وفاة زوجها الذي كان يدعونه بالباشا لأناقته دون أن ينوّه بدورها التربوي.."
(35)
. |
| ثم يتقصى طريقة برفقة أخته إلى هذا الكتَّاب، ويصف كل ما يعرضه ويشاهده في هذا الطريق (مجرى السيل، والدكة، والأسواق، وأشجار السدر) ثم يقول: داي ماضٍ ترسخ في أعماق النفس طيبة وشذاه كيف نتطلع لأن أقتلع من النفس حباً تمكن! أو أن أمحو من الذاكرة مشاهد انطبعت أو قل أن شئت ترسخت في الأعماق السحيقة أو البعيدة من هذا الذي يسمونه شعوراً، وهي تسمية تحاول الاقتراب من تلك المنابع الأولى للتكوين العقلي والنفسي. ولكنها تعجز عن الإحاطة بها. فالمعنى يحاول الانقلاب من لفظ التعريف هذا. واللفظ يحاول اللحاق ويظل مجهول في هذا الكون أكثر مما هو معروف. وكثيراً ما عبر ذاكرته، قصور رؤية الكاتب الإنسان.."
(36)
. |
| ويكاد هذا المقطع أن يكون أعمق تعبيراً عن رؤية الكاتب تجاه ماضيه وتجاه تدوينه. شعوره ومنطويات ذاكرته، وخزين وجدانه التي يعيها تماماً. دون أن يجد في الذي يسمونه شعوراً قدرة على تفسير تملًّك ذلك له. فالمعنى ليه أكبر من اللفظ، والمجهول في الكون كثير شرود لا يحيط به ولا يتمكّن منه. |
| جاء هذا المقطع التعبيري ببعده الفلسفي المفاجئ، تالياً لحديث معتاد يفضي به في مستهل الحلقة الأولى من الذكريات، التي كانت وطأتها وظلالها النفسية أقوى من أن يتجاوزها دون تأمله، ومعاودة تحليله في نفسه واستقراء مظاهره على تفكيره. وبقدر ما في المقطع من عمق في استظهار معنى أن يسترجع الكاتب ذكرياته ويدونها مجترحاً لذَّة الاسترجاع والتدوين، فإنه يحاول الفكاك منه بالعودة مرة أخرى لرسم الجغرافيا الإنسانية والحركية للمكان. يستقطر جمالياتها من تكوينات وأبعاد عاطفية وآثار روحية، وفقاً لما تعبَّر عنه المقاطع الآتية: |
| - ".. مع إطلالة كل يوم يحمل أبناء الحارة أطباقاً، ويقصدون مكان العم محمد الفوال، ثم يعرجون على فرن حاجي بهاء. يشترون التميزة بأربعة قروش.."
(37)
. |
| - ".. أناقة المعلم محمد عثمان تذكرني بأناقة رجلين آخرين هما الأفندي محسن بري وإبراهيم البسام -رحمهما الله - وكان حانوت المعلم مواجهاً لباب جبريل.."
(38)
. |
| - ".. لقد كان الوجه المعروف لدى الحي هو العم محمد بن عبد الحيدري واحد من الرجال إذا مشى من حوش مناع إلى العنبرية حيث دار صديقه السيد حبيب محمود أحمد -عافاه الله- التفتت الأنظار إليه.."
(39)
. |
| - ".. لن ينسى الفتى صورة ذلك الفتى الأسمر الذي كان يسند ظهره غلى كوبري المدرج، والناس في القيلولة نيام، ممسكاً بالآلة الخشبية بين يديهن نافثاً فيها من أنفاسه التي تحمل أنات حزينة لا يسعك إلاّ أن تفتح روشان منزلك، فتسمع إنشاد (جمعه) والعرق يتصبب من جبينه قطرات حرَّى.."
(40)
. |
| فالأنماط النوعية المتعددة لهذه الشخصيات وتنوّع مناشطها المهنية، وحضورها الاجتماعي ومواهبها، وسماتها الشخصية ومظاهر الحضورية في النص، وزاوية النظر إليها من قبل الكاتب تتعدد تبعاً لذلك التمايز والتنوع بينها، هم لحمته التي تشكل الذاكرة، وتتخذ موقعها فيها بذلك الالتصاق. وتتابع التأثير، يختارهم وفقاً لمجريات السياق في مواضيع عدة من السيرة. وينبئ وصفه لهم ورصده لحركتهم في الحياة والنص عن عمق تأمل ودقة استقراء. ويوجه خارطة النص ومعماره السياقي تبعاً لحركاتهم، وبما يستدعيه الإحاطة بحضورهم في حياته، وتنوعهم تتنوع للحياة ذاتها، وتباين مذاقاتها واختلاف مراحلها وأحوالها. |
| والأشخاص لديه كائنات مكانية، فلا يكاد يذكر أحدهم حتى يحدد موقعه من الذاكرة والمكان ولذا نجد اطراداً في النص بين الشخصيات والأمكنة. |
| أشخاصه يأخذون من المكان قيمته ويعطونه العلامة الفارقة بين مكان وآخر، فهم هويته الشعبية المائزة في تداخلها مع معطيات الأحوال ومناحي الاهتمام. وتوظيفه لهم في سياق السيرة يتأتى من موقفه من ذاته وسيرته، فلا يعنُّ له ذكر خطواته ومعارج تكوينه في العنبرية ومنها وإليها، حتى يظهرون، وكأنه لا يكون إلاّ بهم ولا يستلذ تتبع تلك الخطوات إلاّ معهم. |
| وبين الحمالي في لغة الوصف وتتبع المراحل والانتقالات وتوثيقها، وبين الدلالي الموضوعي فيها تماس والتحام؛ فالمتشكل من المد الجمالي في المكوّنات الموصوفة والمحددة، هو الحقيقي كما تكوَّن في وعيه، وهو المنتوج الدلالي الطبيعي الذي تنم عنه سياقات النص ومقاطعه. |
|
* التغايرات بين رحلة الشوق، وهتاف من باب السلام:
|
| بالإضافة إلى الإطراد بين الشخصيات والأمكنة في (رحلة الشوق...)، وما يشكله من علامة فارقة في السياقات النصية للسيرة مماثلاً بذلك صنيعه في (هتاف من باب السلام..). فإن ثمة تغايرات بين الأولى وبين سابقاتها مما كتبه المؤلف في نفس الموضوع، ومن ذلك تداخله مع الخط السيري للمواقف والحالات التي يصفها أو الأشخاص والمراحل التي يتحدث عنها. فبعد كل بضة أسطر، يفضي بما يشبه المنولوج واستظهار مخزونه العاطفي والنفسي والتعبير عنه. وقد يكون هذا الحديث هو أصدق ما يتمثله من تلك المواقف والأحداث. |
| وكان لا يتخذ المنحى نفسه في تجربته السابقة إلاّ قليلاً جداً. وهو ما نعده شاهداً على عمق تمثله لحياته ومجرياتها في هذا المكان بالتحديد "العنبرية" عن غيره من الأماكن. ولا يعني ذلك أن الأماكن الأخرى لم تكن لديه على ذات المستوى من القيمة، بل هو اختلاف في الدرجة لا النوعية. |
| فالأماكن المدنية بجملتها. تشكّل الفضاء الذي يحوي ويظلل هذه السيرة، ويشكّل الإحساس بها والوعي بقيمتها؛ المدماك الأساس في كيان تجربة حياته وكتابته السيرية. |
| و (رحلة الشوق...) بمقالاتها العشرة. هي الحيز الجزئي الذي تنطلق منه الأحداث. ويحضر الأشخاص. وتتقاطع الدروب والذكريات. |
| والذكريات هي ما بقي من ذلك كله؛ يستعيده ليسجل مجرياته، ويستنطق مكامنه القارة في وعيه. ولا يتزيد في الاستطراد في توصيفه وتقييمه وعرض تفصيلاته، إلاّ بالقدر الذي يقتضيه شرط التسجيل والتوثيق، ويحدد موقف الكاتب من ذلك وأثره في نفسه. |
| وهو يصوغ الأحداث كما هي. ويصف الأشخاص كما خبرهم. ويحيط بالصورة كما تكوّنت بطبيعتها. |
| وإذا كان ثمة مدعاة لتلوين تلك الصياغة بما يظهر الأثر النفسي الذي تركته فيه؛ فإنه يوشي ذلك بنوستالجيا حميمة، تفصح عن المسافة بين الزمن والأمكنة في تلك الذكريات. ولحظة استرجاعها بالكتابة. |
| فالمتواليات من الأحداث في المقالات العشرة، تتنوع بالقدر الذي يخطوه من موقف إلى آخر، ومن حدث إلى غيره. |
| وتأتي الشخصيات لديه بمستويات وأنماط متعددة. وظروف تشكل مختلفة ودلالات متمايزة. لكل منهم ما يميزه لديه. ولكل منهم قيمة لديه ومكان في ذاكرته باقٍ فيها. ومن ما سقناه في ثنايا هذه السطور، وكذلك قوله: |
| ".. وذلك البناء المتواضع المشرق على (السيح) مجرى سيل (أبي حيدة) في ذلك المكان تلقى دراسته الأولى، إنه الكتَّاب الذي كنا نقرأ فيه القرآن الشيخ محمد صالح البيجاني الذي كان من حفظة كتاب الله.."
(41)
. |
| إن ما تعبأ به رحلة الشوق من إظهار الطاقات الإنسانية للمكان من خلال التسجيل السيري، وهي ترصد حركة المجتمع وانعطافات تلك الحركة وتجلياتها في مسارب اليومي المعاش، والنبض الحار لهذه الحركة، يستجيب لرغبة المؤلف في منح النص إمكانات موضوعية قادرة على نقل أنساق هذه الجغرافيا الاجتماعية للمتلقي. كما وعاها وعاشها "الفتى" المنقاد لخطوط هذه الجغرافيا ومخرجاتها والتحولات التي طالتها في وجودها الحقيقي، ووجودها النصي. |
| والسيرة هي تعكس إلينا ذلك الوجود الحقيقي، لا تقدم منطوقها التسجيلي ودلالتها السيرية فقط، بل تقدم كذلك الثقافة بمفهومها العام؛ والمعتقدات الاجتماعية والأفكار السائدة، وأنماط العيش والسلوك والفنون والأدب. |
| ولذلك نجد المؤلف ينساق أحياناً إلى الحديث عن الأدب وأسماء رموزه "الصبان، شحاته، ضياء، الزيدان"
(42)
الذين عايش في فتوته أوج حضورهم الأدبي، ولما كان لبعضهم من تماس مباشر بالحركة الاجتماعية، ولما كان للبعض الآخر من مقولات ومواقف مأثورة، فإنه يتناص معهم بالكتابة، بحسب ما يستدعيه الموقف الذي هو بصدد تقديمه من استصحاب ذكرهم. |
| ولعلّ من أهم ما يشير إليه في هذا الصنيع، هو تعايش النخب المثقفة مع الحياة الشعبية وجماهيرها، والاقتراب منهم والتماس الحميم بين الطرفين في تلك الفترة. فلم يكن ثمة انفصال أو تعالي في موقف تلك النخب على واقع الناس الاجتماعي. وهو ما أشار إليه الكاتب في مواضع عديدة من النص. |
| إذ كانت الحياة على مثال من التناغم بين حركة الثقافة/المعرفة، والحياة العامة.. ولعلّ من يقرأ سيرتي الزيدان وضياء، يلحظ تمثلات عديدة لذلك. |
| أما صاحب هذه السيرة، فهو من جيل يشكل قنطرة تصل الحضور المؤثر لتلك الرموز بالجيل اللاحق -جيل صاحب السيرة- ومن جاء بعدهم. |
| ومن المضامين المهمة في رحلة الشوق، موقفها المتوازن في التسجيل والتوثيق، وعلو نبرة الاعتراف، بحسب منظورها الرئوي، وموقفها النصي من الحياة في تلك الحقبة، وما تحفل به من مظاهر ومواقف وحالات. |
| إذ كان المؤلف أميناً في تقديم حياة تلك الحقبة بألوانها وإشراقاتها وبجوانبها المتعددة، شديد الاعتداد بما أحاط وجوده في العنبرية، وفي المدينة المكان الرئيس من ظروف وتحولات وانتقالات. |
| وإذ ما كان لنا أن نستظهر أبرز القيم الدلالية التي يمكن استنباطها من هذا النص، فهي كما يلي: |
| 1- العناية بهندسة النص وإقامة كيانه بالتقاليد المعتبرة في هذا المجال إلى حد ما. من خلال اختيار العنوان، وصيغة الإهداء، وكاتب المقدمة والربط بينها وبين المتن النصي، ومدى ما أضافته النصوص المحاذية، والصور التعريفية من إضافة دلالية تتسق مع النص/المتن. |
| 2- اختيار المفتتح، واحتوائه على تصور إجمالي يحدد الركائز التي ينطلق منها صاحب السيرة، والأجواء التي تشكلت فيها سيرته. |
| 3- ضبط نمو النص التصاعدي عبر تقسيم مقالات الكتاب وترتيبها عددياً. مما يسهل على المتلقي إدراك إبعادها الموضوعية، وسماتها الفنية وسياقاتها النصية. |
| 4- تقديمه صورة حقيقية للحياة في المدينة المنورة. في الحقبة التي عاشها فيها، وما حفلت به من أنماط وسلوك ومظاهر تعايش وحراك يومي. |
| 5- توثيق حياة الأشخاص الذين يشكلون عناصر البنية السيرية، وتسجيل نوعية التواصل بينهم. واختيار طرائق التعبير عن حضورهم في الأمكنة، وطبيعة علاقتهم بالكاتب والبيئة الاجتماعية. |
| 6- الاطراد المستمر بين أولئك الأشخاص والأمكنة، ما يعكس طبيعة ودلالات هذا الاطراد ومدى إضافته لمنسوب النص الدلالي. |
| 7- العناية بالتصوير الجمالي للمكان ومكوناته، من خلال أساليب العرض وتعبيرات الوصف التي يجعلها تالية للمواقف التي يسجلها. ومن ثم يستنبط منها قيماً معينة تمد النص بدلالات متعددة. |
| 8- اختيار البناء النصي الملائم لقدراته. من خلال آليات السرد وتوظيف ضمير الغائب في الحديث والإفضاء بما تختزنه الذاكرة من مجريات السيرة. |
| 9- التوغل في الهامش والمتن الاجتماعيين، بغية استظهار واستصحاب الشخصيات والمواقف والمظاهر الثقافية والاجتماعية التي عايشها الكاتب، وكشف وجودها في النص. |
| 10- مغايرة النسق الكتابي الذي اعتمده في تجربته السابقة (هتاف من باب السلام) حيث يتداخل في التعليق والوصف والأحكام القيمية، وتوجيه دلالات المواقف موضوعياً واستظهار أبعادها، والتنويع في أساليب العرض والربط بين المقاطع والسياقات النصية في هذه التجربة. |
|
|
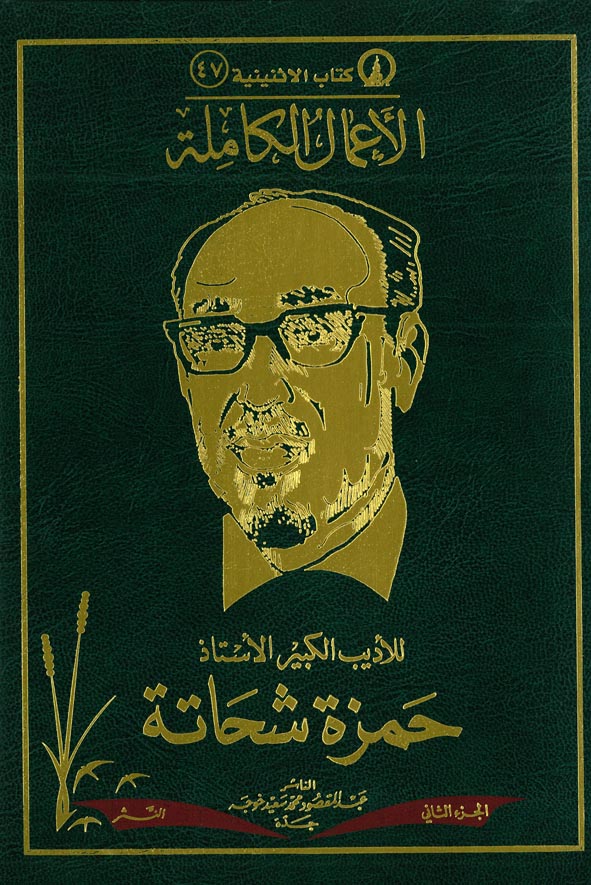
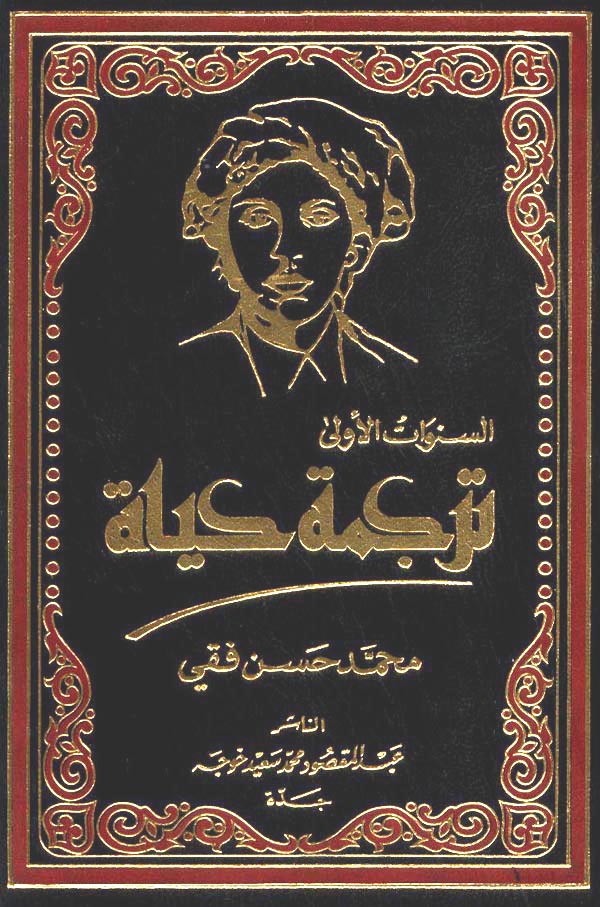
 شارع عبد المقصود خوجة
شارع عبد المقصود خوجة 00966-12-6982222 - تحويلة 250
00966-12-6982222 - تحويلة 250




