| مأسَاة أم
(1)
|
| ها هو العيد! |
| أجل يا أماه ها هو العيد قد أصبح قريباً منا.. وها هم "الأولاد" يتحدثون كل يوم عن العيد السعيد، وها هو "محمود" زميلي في المدرسة قد أراني ما أحضره له أبوه من فاخر الثياب. "ثوباً حريرياً" قال لي إن قيمته عشرون ريالاً، وإحراماً مطرزاً قيمته ثلاثون، و "حذاء جميلاً لامعاً" ما أخبرني عن قيمته بعد، ولكنها لا تقل هي الأخرى عن العشرين، أو الخمسة والعشرين فقد كنا نلعب، وكان معنا "إبراهيم" ابن أحد الجيران، وكان يقول إن حذاءه الجديد قد فرغ منه الصانع بالأمس، وقيمته خمسة وعشرون ريالاً، أرسله بها أبوه إلى الصانع... وأنا يا أماه!... |
| وأنا يا أماه.. قالها ذلك الابن في حرارة وحيرة وأمل، وأصغت إليه الأم التي أعياها النطق وحبس لسانها الألم المكبوت، وسرعان ما ترقرقت من عينيها دموع، حاولت عبثاً أن تخفيها عن وحيدها الحبيب، ولكن لا مناص! |
| ورأت نفسها أمام سيل من الذكريات.. ها هو الماضي يمر أمامها كأنه حلم، كان زوجها بالأمس يحمل عنها أعباء الحياة، وكان يؤدي في مثل هذه الأيام البهيجة من شهر رمضان الكريم، مهمته المحببة إليه.. مهمته التي يتولاها في إخلاص أصيل كل زوج، وكل أب، يشعران من الصميم بمعنى الأبوة ومعنى الحنان! |
| إنه فلم.. ويا له من فلم رائع، كان بالأمس صورة للسعادة، فأصبح اليوم صورة للشقاء، وكان في عالم الحس رمزاً للفرح، وعنواناً للرجاء، فأصبح في عالم الذكريات مثاراً للألم المضني، ومبعثاً لليأس المميت. |
| كانت كمثيلاتها من الزوجات الفارغات، لا تحمل أي تفكير يمس العيش من قريب أو بعيد، وكانت المسؤولية أنأى الأشياء وصولاً إلى الرأس الذي تحمله هذه المرأة، وعلام تفكر؟ وفيم تجعل من نفسها إنساناً مسؤولاً وقد بسم لها الحظ ما شاء له أن يبسم، وأصارت لها المقادير من زوجها "حسان" زوجاً مثالياً، يحمل عنها -على أحسن الوجوه- كل مسؤولية وكل تفكير، ويؤدي لها -كأجمل أداء- ما يتطلبه "البيت" من مختلف الشؤون! |
| والآن ماذا.. لقد أصبحت هذه الحقائق في خبر كان، وانطوت مع أيامها الذاهبات، لقد مات زوجها تاركاً لها هذا الابن في التاسعة من سنيه، وتاركاً لها قليلاً من المال، ما لبث أن ذهب هو الآخر أيضاً، صرفته في الشهور الأولى التي أعقبت الوفاة. |
| وقد شاء القدر أن يرحمها ويترفق بها، فاستطاعت أن تحمل عبئها الجديد ولكن في شيء من الضيق، كانت تحترف لوناً من ألوان التطريز، هُديت إليه من أيام الصبا، فها هي اليوم تعود إليه! |
| هو ذا مورد للرزق الحلال، يسد الرمق، ويضمنُ الخبز، ولا يتجاوز الضروريات! |
| هو ذا مورد متواضع، يكفل الغذاء، ولكنه يعجز عن الكساء! |
| وغلب التجلد، الحزن، وعاد للأم التي هدها الألم، وأضنتها الذكرى، تفكيرها الطبيعي، واتزانها العاطفي، وعزمها الصميم، واستجابت لإحساس الطفل في وله وتأميل، راحت تحدثه أطيب الحديث.. أحمد. أحمد "ثوب من الحرير" (إحرام مطرز) (حذاء) كل هذا سيأتي مع العيد.. كل هذا سيحضر إليك تماماً تماماً كمحمود وإبراهيم. |
| كلمات معسولة أرسلتها إرسالاً، ووعود لا أقل ولا أكثر وكأنما أُلهم الطفل ما في هذه الكلمات من إبهام وغموض، فألقى بنفسه في أحضان أمه الحيرى، يسألها في إلحاح ممض، أصحيح يا أماه؟ أصحيح هذا الذي تقولين؟ أصحيح أني سألبس كما يلبس محمود وإبراهيم؟ أصحيح يا أماه؟ ولماذا لا تحضرين ذلك الآن؟ لماذا لا توصين ذلك الصانع بعمل الحذاء من اليوم؟ أجل يا أماه، لقد قال لي إبراهيم إنه ذهب إلى الصانع مراراً، وبعد عشرين يوماً استطاع أن يتسلم حذاءه الجميل، وأنا أخشى.. أخشى يا أماه أن يأتي العيد قبل أن نتحصل على المطلوب. |
| - أحمد. أحمد. (ثوب من الحرير) (إحرام مطرز) (حذاء لماع) كل هذا سيأتي مع العيد كل هذا سيحضر إليك تماماً تماماً كمحمود وإبراهيم. |
| نفس الكلمات راحت تكررها الأم في إغراء وابتسام؛ ونفس الوعود حاولت بها أن تُلهي وليدها وهي فيما يشبه اليقين بأنه عما قريب سينسَى كل هذا ينسَى الثوب والحذاء والإحرام، ينسَى محموداً وإبراهيم وغير محمود وإبراهيم من أتراب المدرسة ورفقاء الحارة وأبناء الجيران. |
| لكن الطفل -وللطفولة في كثير من الأحيان نوع من الفهم، يتحدى المنطق، ويتخطى الكلمات- لم يستطع أن يلهو أرادت له أمه أن يلهو، وهو بعد لا يمكنه أن ينسَى ما أصبح كل همه ومتمناه.. وكيف ينسى وها هو العيد قد أصبح على الأبواب، كيف ينسى وغداً -بكل تأكيد- سيأتي إليه كل من رفيقيه، في تيه ما بعده تيه، يزهوان أمامه بملابسهما العيدية الجديدة، وهي وحدها في نظر الأطفال، رمز العيد السعيد.. |
| ولم تجد الأم الشقيةُ بدّاً من الإفصاح، وقد برح بها شجنها المكظوم، وأرهقها تهافت الغلام وأفنى عليها إلحاحه المثير، لم تجد بدًّا من أن تبوح.. وقد ذهبت بها همومها المتخافتة كل مذهب. وأحست لأول مرة، بأنها أعجز ما تكون بياناً، أمام المنطق الساذج، منطق الطفولة في براءتها وطهرها وما أروعه من منطق ساحر غلاّب، يتلاشَى أمامه في استحياء، منطق الختل والخداع، منطق اللف والدوران.. |
| أحمد أحمد أنت تريد لباساً جديداً، ولكننا يا بني لا نستطيع هذا الآن، لأن "الفلوس" التي معنا يا أحمد أوشكت أن تنفد، وموردنا الجديد ضئيل.. لا يكفي إلاّ للطعام والشراب فاصبر أيها الحبيب كن مطمئناً لا تنظر إلى إبراهيم أو إلى محمود هذان لهما أبواهما.. وأما نحن.. وأما أنت فقد أراد الله.. لنا -وإرادته لا ترد- أن نفقد أباك في وقت نحن أحوج الناس فيه إليه، نحن الآن نكتفي بالطعام، وبالضروري من اللباس، وأما ما عداهما فلنا عنه مندوحة، في هذا الظرف على الأقل، فكن واثقاً كل الثقة مؤمناً كل الإيمان بأن حالنا هذه لن تدوم، وأن الله الذي لا يَنسَى أحداً من خلقه، سوف لا ينسانا، سوف يتغير كل شيء يا أحمد.. وسوف يحلو العيش ويطيب، وأخيراً سوف تنعم بأفخر اللباس، عند كل عيد جديد. |
| - سمعت كلامك يا أمَّاه.. ولكن آه. اسمعي مني، هؤلاء الأولاد سوف يسخرون مني، هم من الآن يتهامسون وأحياناً يقولون لي: أنت يا أحمد ليس عندك فلوس تبتاع بها الثياب، آه يا أماه لا أريد أن يقولوا هذا، لا أريد أن يسخروا مني، لا بد من اللباس، لا بد من تدبير الفلوس ها هو خالي عيّاد ألا يمكن أن تستديني منه ما تبتاعين به هذه الثياب، أرجوك يا أماه، وإذا لم يوافق خالي أو لم توافقي أنت فأنا سأشتغل.. سأشتغل كما يشتغل سائر الناس سأشتغل لإحضار الفلوس، سأشتغل لنبتاع ثياب العيد، سأشتغل يا أماه، وهذا أفضل من أن أدع الأولاد يسخرون مني ويتهامسون ويقولون ما يقولون. |
| - دعك من هذا الكلام يا بُني، هؤلاء الأولاد لا يسخرون، إنهم فقط يضحكون، إنهم فقط يلعبون.. الصغار لا يعرفون السخرية.. دعك من هذا الكلام، وأمَّا خالك "عيَّاد" فهو لا يستطيع ما تريد وإن هو استطاع فأكبر الظن أنه سيرفض منا هذا الطلب شأنه في هذا شأن سواه من الناس في هذا الزمن الذي نعيش فيه. |
| - لا بأس يا أمَّاه ولكن ما رأيك في أن أشتغل لإحضار الفلوس؟ إني خالٍ من الدروس ومن اليوم إلى أن يأتي العيد وإلى أن تفتح المدرسة يمكنني أن أشتغل في أي عمل كان ويمكنني تدبير ما يكفينا لشراء الملبوسات أليس كذلك يا أماه؟ |
| - لا، لا يا أحمد اصرف عنك هذه الأفكار، الشغل يحتاج إلى أشياء أنت منها خالي الذهن؛ يحتاج إلى سبق تمرين، وأنت ما زلت تلميذاً في الابتدائية ومن كان في مثل هذا الدور خليق به أن لا يحسن أمراً من هذه الأمور؛ والشغل أيضاً يحتاج إلى مجهود وأنت ما برحت طفلاً صغيراً لا تقوى على أي عمل، فدعك من كل هذا، واصبر فإن الله مع الصابرين. |
| - إني صابر يا أماه، ولكن الشغل الذي أستطيعه موجود وهو لا يفتقر إلى تمرين، ولا يحتاج إلى مجهود كبير، إنه شغل يقوم به الكثيرون من أترابي فلا يلقون منه العناء الذي تخشين، وهو شغل أيام معدودات، مهما كان من بلائه، فلن يضيرنا شيئاً، فاسمحي يا أماه، اسمحي لولدك الصغير أن يشتغل.. يشتغل من أجل الفلوس، ومن أجل الملبوس. |
| قال الابن هذا، وقبل أن يتلقى من أمه أي جواب على عباراته الأخيرة، انفلت من أمامها في خفة وحماس، وما هو إلاّ أن خرج من باب الدار يعدو كما يعدو الغزال، وهناك حيث إحدى العمارات قد أوشكت على التمام، والعمال منهمكون في إكمال دورها الأخير... هناك وجد أحمد مكاناً له بين صغار العمال وبدأ بالعمل الذي أُسند إليه. |
| ولم تكن الأم راضية كل الرضى عن هذا الصنيع، فقد غمر نفسها إحساس غامض مريع، لم تستطع له تأويلاً، جلست وقد أحاطت بها الكآبة من كل جانب، لا تعرف ماذا تقول.. ها هو ولدها الوحيد وكله اندفاع يغامر في الحياة، ها هو يذهب إلى العمل، قبل أن يستمع إلى الكلمة الأخيرة من أمه الرؤوم، وهو في هذا إنما يعبر عن إرادة الحياة.. وبعبارة أصح عن إرادة "التفوق" الكامنة فيه، وفي أمثاله من الصغار... إرادة "التفوق" يا لها من عصا سحرية.. إرادة "التفوق" حتى الكبار لم يسلموا من هذه اللوثة.. حتى الكبار لم يسلبوا هذه الإرادة.. ولكنها في الصغار -وفي الصغار على الدوام- تبدو أعمق وأقوى وأصدق وأسمَى.. |
| ذهب الصغير إلى العمل، وبقيت الأم مشدوهة حيرى، تضرب أخماساً في أسداس يرهقها إحساسها الغامض.. وراح القدر يعمل عمله الرهيب في ضبط وإحكام، وتلاحق وإسراع. |
| كان هذا أول أيام العمل، بل أول أيام الوجود، بالنسبة إلى هذا الصغير. وكان هذا أول أيام الحيرة، وأول أيام الشكوك بالنسبة إلى الأم الرؤوم. بالأمس فقدت زوجها العطوف، فاستطاعت أن تواجه "المصاب" بقوة الأمل الحنون، أملها في فلذة كبدها كان لها كل العزاء.. والآن ماذا يخبئ لها القدر؟ رحماك يا الله. |
| كان هذا أول أيام العمل، فهل هو آخرها يا ترى؟ |
| نعم كان هذا هو اليوم الأول، وكان هذا هو اليوم الأخير. وكانت المأساة.. وكانت الفجيعة.. وحدث ما لم يكن في الحسبان، ونفذ القدر إرادته الجبارة.. تلك التي تقف أمامها أي إرادة للتفوق. أو أي إرادة لإثبات الوجود.. ولم ينقض ذلك اليوم الأليم حتى انقضَى معه أمل وتصرمت فيه حياة وتجددت فيه أحزان وتهدمت الدار وهي في نظر أصحابها أقوى ما تكون بناءً، وكان ماذا؟ كان فريق من العمال ضحاياها وكان أحمد ذلك العامل الصغير أول من رأته الأعين من هؤلاء.. أجل هذا الغلام الوحيد بين فريق العمال والبنائين، هذا الطفل الحساس -وقد كانت تنتظره أم شذَّ عن إرادتها وخرج عن طوعها- إنه قد.. مات. |
|
|
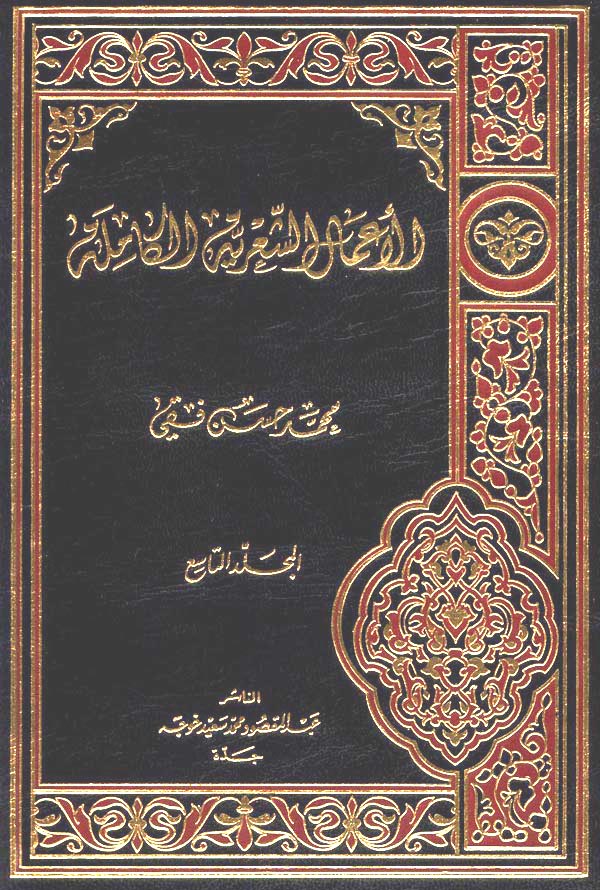
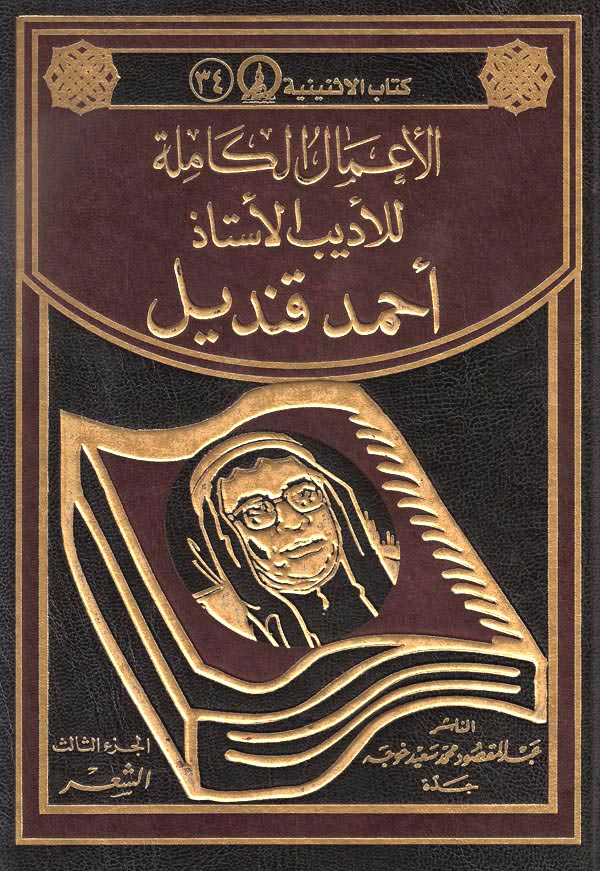
 شارع عبد المقصود خوجة
شارع عبد المقصود خوجة 00966-12-6982222 - تحويلة 250
00966-12-6982222 - تحويلة 250




