| اليتيم المعذب |
|

|
|
* * *
|
|
| إلى الذين يناقشون أخطاء غيرهم في ضوء ما عرفوا من أخطاء أنفسهم أهدي هذه القصة. |
| - إيش هاذا اللي انت شايله؟ |
| - هاذا.. هاذا شيء ربنا قسم بو. |
| - أيوه.. لكن ايش هو؟ |
| - هوه.. تسألي ايش هو؟ قولي الحمد لله؟ |
| - أيوه.. لكن برضه ايش هو؟ |
| - والله هو بزره.. ولدتها أمها في الصحية وماتت الأم غريبة.. والبزرة قلبي انشرح لها.. طلبتها من الدكتور أربيها.. ما قصَّر الدكتور الله يجزيه بالخير سلمني هيا. |
| - بالله ما قصّر أعطاك هيا؟.. الله يجزيك بالخير يا دكتور!! انت بالله راجل هادا طولك! وهادا عرضك! ينضحك عليك.. يعني أحنا ناقصين غلب.. رايح تجب لي غلب فوق غلبي.. صدقوا أهل المثل لما يقولوا: "ما كفاني أبويه راح أبويه جاب أبوه". |
| * * * |
| قالت هذا وهي تضرب بيدها على صدرها في أسف واستياء، ثم ولَّته أكتافها وهي تُواصل تقريعها في ألفاظ جافية وعبارات قاسية: (قال أعطى له هيا الدكتور ما قصَّر.. إلهي يقصِّر عمرك أنت والدكتور اللي أعطاك هيا). |
| لم يأبه الشيخ لجفاء زوجته، ولم يُكلِّف نفسه عناء الاستماع إلى تقريعها الجافي.. فقد دلف إلى مخدعه وشرع يُهيِّئ للطفل مضجعاً فوق (الكرويتة) ويسنده ببعض المخدات. |
| كان شيخاً تبدو عليه سِمات الصالحين من أصحاب التقوى. كان عف اللسان لا يفلت منه الحرف البذيء، ولا تبدر منه الكلمة إلاَّ في معروف أو إحسان.. كان يعرف سلاطة لسان زوجه، ويعرف من سوء طواياها ما يُثير روح الجبان؛ ولكنه كان يؤمن في قرارة نفسه أنها إنسانة تستحق الرثاء والعطف أكثر مما تستحق المقت. |
| كان يرى أن بعض الأشرار والعصاة والآثمين، وكذلك أصحاب النوايا السيئة في الحياة من الجبابرة، إلى الطغاة، إلى السفَّاكين والقتلة، قد يستحقّون العطف على ما امتحنوا به لملابسات خاصة أكثر مما يستحقّون اللوم. |
| كانت له فلسفة عميقة في تنشئة الطفل وتربيته وتعويده على ما يتعوّد.. كان يرى أن بيئة الشخص وعادات محيطه مسؤولة في المقام الأول عن جميع تصرفاته في الحياة. فزوجه إذا كانت شريرة أو سليطة اللسان فمن الغبن أن يمقتها.. وجاره الأناني الظالم لا يراه مسؤولاً إلاَّ إلى حد. لأن الملابسات التي صادفته في الحياة هيّأته من حيث لا يشعر لمثل هذا الخلق.. وكان يرى أن اللصوص والقتلة لو صادف نشأتهم تهذيب عادل لتورَّعوا عن سفك الدماء، ووجدوا في أعمق خفاياهم وازعاً دينياً، يهديهم إلى الاستقامة والنبل. |
| كان يرى هذا الرأي في الحياة. وسواء بالغ في تقديره. أو تجنّى به على تحديد المسؤولية في نظر المشرِّعين فإن حماسه لما اعتنق كان لا يدانى. |
| وتركت هذه الفلسفة أثرها في تكوينه فانطبع عليها، واندمج في تفاصيلها حتى ملكت تفكيره في جميع ما يُصادفه من أخطاء الحياة، وحتى أصبحت أحكامه على مساوىء الناس لا تصدر إلاَّ من هذا المعين. |
| كان يؤذيه غش المحتالين، ولا يجهل أساليبهم فيضحك ملء نفسه لما يبذلونه من جهود حسبوها تفنناً وبراعة.. وكان يغبنه بعض (الشطّار) فيأسف في نفسه لما فقدوا من تربية ويسأل الله لهم العون. |
| كان يرتفع عليه الصوت الجريء أو السفيه، فتملك الفلسفة عليه أعصابه وتسمعه يهمس إلى نفسه في صوت خافت (إن صاحبي مسكين فقد عوَّدته بيئته ما تعوَّد)!!. |
| ويُصادفه عتلٌّ في الحياة لا تضمر طواياه حباً لأحد، ولا يتمنّى الخير للخير، ولا تسمو أخلاقه عن الإثم، أو سوء الصنيع. فلا يلبث أن تعاوده الفلسفة، وتسمعه يتساءل: (تُرى ما هي أنواع الرواسب التي تركت أثرها في تكوين هذا الضعيف، وكم عدد العقد النفسية التي لوت استعداده نحو هذا الطريق)؟. |
| فهل نستغرب بعد هذا ونحن نراه يصمد أمام زوجه العتية وهي تغلظ له القول: (أنت بالله راجل.. هادا طولك.. وهادا عرضك يضحكوا عليك.. ما كفاني أبويه.. راح أبويه جاب أبوه)!!. |
| إنه يعلم أنها نشأت مظلومة في بيت أبيها، وأنها كانت تعاني من طغيان امرأة أبيها مما جعلها تشعر بالنقص، وأنها اليوم بعد أن زال عهد الطغيان، وأصبحت سيدة بيتها الجديد تأبى إلاَّ أن تكمل ما كانت تشعر به من النقص بهذا الاستعلاء المقيت، والغلظة الجافية. فهل يلومها على ما جنى غيرها؟ وهل يؤاخذها فيما ليس لها منه بد؟ إنه -فيما تراه فلسفته- ظلم يأبى خلقه العالي أن يرتكب وزره! |
| فليتغافل -إذن- عن غلظتها وجفائها، وليدلف إلى مخدعه ليهيىء للطفل الذي انشرح صدره له، والذي استوهبه من دكتور الصحة مضجعاً فوق (الكرويتة)، ويسنده ببعض المخدات. |
| * * * |
| يا واد انت مين يعرف أبوك؟ أنت رزية.. ربنا رزانا بها في الدنيا وبس.. يعني كان الدكتور حق الصحية اللي ضحك على الشيبة اللي مات الله يرحمه.. وخلاه يشيلك يجيبك عندي ما قصد إلاَّ أذيتي؟ يعني أنا اليوم اثنا عشر سنة وأنا غاطسه في غلبك!.. تقدر تقل لي ايش الفائدة اللي جاتني من هادا الغلب؟ |
| شوف يا واد.. أنا ما عاد أقدر أصبر أكثر مما صبرت.. بكره أهرج لك عمك أبو فروة يأخذك يشغلك عنده في الحجر والطين لو تجيب حق أكلك، وتريحني من خلقتك طول النهار. |
| وأعتقد أن القارىء سوف لا يفوته أن (الواد) الذي عزمت السيدة أن ترتاح من خلقته ليس هو إلاَّ طفلنا الذي تركنا الرجل الطيب ينقله من الصحة إلى البيت، ويمهِّد لنومه في مخدعه الخاص فوق (الكرويتة)، كما لا يفوته أن السيدة هي نفسها السيدة التي استقبلته بالجفاء الذي استقبلته به في فصلنا الأول. وقد شاء سوء طالعه إلاَّ أن يحرمه الحنان والعطف، وحسن التوجيه، فقدْ فقدَ الرجل الذي تبنّاه قبل أن يحبو على الأرض، كما فقد أبويه من قبل. وترك لرحمة السيدة العاتية تذيقه من قسوتها ما يسيء عقيدته في الحياة، ويترك في نفسه رواسب لا تمحى آثارها. |
| نشأ الطفل -ونحب أن لا ننسى اسمه (علوة)- في حجر من لا تختلج فيه عاطفة من الشفقة. وعندما درج في حنايا البيت كانت الغلظة تلاحقه إذا تحرك أو سكن، إذا نطق أو صمت، إذا أحسن أو أساء، فانطوت خفاياه على شعور غامض لوّن له الحياة بلون قاتم لا يلمح فيه ضوء، ولا ينفذ منه نور، وهيّأ له عقله الصغير أنه لا معدى في الحياة من أن نعيش ظالمين أو مظلومين. |
| علمته مربيته كيف يخضع لجبروتها فرسب في نفسه تقديس القوة بكل ما في القوة من طغيان وعسف، وعلمته الاستهانة بحقارته فانطبع على تحقير الضعيف عن عجز، أو حاجة، أو رِقَّة. |
| واليوم وقد طفح الكيل وهو يتخطى عامه الثاني عشر، فإن ظروفه الخاصة تسلمه إلى العم أبي فروة ليمتحنه بأقسى ما يتحمله فتى ضعيف، ويضع على كاهله ما تنوء به سنه الصغيرة. |
| كان المعلم أبو فروة مهندساً معمارياً من الطراز الناجح في مكة، ولم يكن يعتمد في نجاحه ما يعتمده المهندسون من أصحاب الشهادات من أدوات هندسية، وقواعد حسابية، ومعادلات فنية.. بل كانت معلوماته الواسعة في الهندسة تتركّز في عصاه الطويلة التي يتوكأ عليها؛ ويلكز بطرفها حماره القصير الأسود!! |
| كان كثير من ملاّك الأراضي في مكة يقدسون كفاءته في الهندسة المخاخية، ويعتمدون في مهام أعمالهم المعمارية. |
| - (يابا.. ايش رأيك في هذه الوصلة الأرض.. نبغي فيها ديوان بشمسة، ومجلسين بمخلواناتها، وصففها، وخزائنها، ونبغي المبيت يكون فوق المخلوان.. قدامه خارجة، ومطبخ؛ ودقيسي كبير شوية). |
| ويهز (اليابا) عصاه ثم ينقر بها الأرض كأنه يستوحي عمارها من الجن تخطيطاً يتفق مع أوضاعها، ثم يشرعها ويبدأ في قياس الأرض بها.. إنها وحدته القياسية التي لا تخطىء، فطولها محدود بالذراع والبنان، ومعدلها دقيق المعيار.. إن في استطاعته أن يمسح الأرض بعصاه في لحظات، ثم يفترش الأرض فيسوّي قطعة من رملها بكفه، ثم يخططها بما يشبه الرموز، ثم يستوي واقفاً لينقر بعصاه من جديد ثم يصور الخريطة لزبونه في صفحة الفضاء بإشارات تستوعب مساحة الأرض مستعيناً بعصاه لتقريب الأبعاد، وتحديد مداخل العمارة ومخارجها؛ ومكان الغرف منها. |
| وكانت شهرة (اليابا) متَّسعة باتِّساع أعماله في نواحي مكة، وكان يشرف على مئات البنّائين في عشرات العمارات، فإذا رجته مربية (علوة) أن يضم (علوة) إلى أعماله في الطين والحجر لتستفيد بأجره اليومي، وتزيح كابوسه الثقيل عن صدرها طوال ساعات النهار، فإن الأمر لا يكلف (اليابا) أكثر من أن ينادي به: (روح يا واد اسأل عن بيت عبد الرحمن عطرجي في الشبيكة، وقل للمعلم سلمان يشغلك عنده حتى أجي). |
| واندمج (علوة) في نفر من أترابه كانوا يحملون زنابيل التراب على أكتافهم في صفوف أخذ بعضها برقاب بعض، يهيمن عليها مراقب طويل الهام، صارم السحنة، يهتز في يده حبل طويل مفتول يُلهِب به ظهورهم كلما غدوا بالزنابيل مثقلة أو رجعوا بها فارغة. |
| لم يكن العسف على (علوة) جديداً فقد ألف هذا اللون من الحياة في بيت مربيته وانطبع تفكيره المحدود بمعانيه القاتمة، فأصبح لا يستغرب القسوة على المهين والضعيف بقدر ما يستغرب الشفقة التي لا يسمع عنها إلاَّ فيما يقصه الأطفال من جيرانه دون أن يعرف مدى ظلها على وجه الأرض. |
| ومضت الأيام بـ (علوة) طويلة مملّة كان لا ينتهي من نهاره فيها بين العمل القاسي، والشِّدة المريرة، حتى يستقبله بيت مربيته في جفاء أقسى. |
| وغاب في أحد الأيام مراقب العمل فاستطاع الصغار أن يتلكأوا وراء الحفر، وسمعهم (علوة) يذكرون بركة "ماجل" في أقصى المسفلة ويصفون متعتهم على ظهور الحمير التي استأجروها لنقلهم إليها في يوم له أن يلهو في زمرتهم، وأن يمتطي صهوة حمار مما يركبون، فشاقه الحديث، وراقت له الفكرة، وتمنى لو أتيح له بالثمن، إن مربيته لا تُبيح له قرشاً واحداً من أجره اليومي. |
| - "انت يا واد إن كان بدي أقعد أحاسبك على اللي صرفته عليك حتى صرت في هذا الطول، أخاف تغرق في الحساب.. حط يا واد فلوس الأجرة كلها في تبسي السموار اللي في الطاقة، ترى أن لقيتها ناقصة هللة.. أهلهل جتتك.. حط الفلوس وتعال غسل النحاس اللي ملموم طول النهار.. شوفو هناك جنب الحنية اخلص قوام علشان تجيب القاز وتفرش الخارجة.. اخلص يا واد لا تنحل قلبي داهية تنحل اللي وراني وجهك في يوم أغبر. |
| وبذلك لا يجد (علوة) مندوحة لأن يتمتع (بهللة) واحدة من (فلوس) أجرته فهل يجد مندوحة لإقناع مربيته لتمنحه (أجر) ركوب الحمار وفرصة للخروج فيها؟ |
| إن هذا آخر ما يمكن أن يُقال في شأن مربيته، وإنها فكرة لا يصح بحال أن يجرؤ عليها فتى كفتانا (علوة). |
| كان يعلم بحكم ما فطر عليه في بيت مربيته أن التماس الحنان، واستدرار الشفقة أساليب يسمعها من صبيان الجيران عندما يقصّون قصص أمهاتهم، أما حقائقها فمعانٍ لم تصافح حياته فيما عاش، وكان يعلم بحكم ما نشأ -أن من حقوق مربيته أن تتمتع بخشونة سطوتها على مثل شخصه الضعيف! وأن عليه أن يحني هامته لكل ما يناله من قسوتها، وأنه ليس له أن يدَّعي لنفسه بجوارها حقوقاً إلاَّ إذا استطاع أن ينتزع لنفسه ما يستطيع انتزاعه اختلاساً، أو تحايلاً؛ أو بأية صورة تتفتَّق عنها ذهنيته الصغيرة. |
| كان يختلس من قيمة القاز (هللة) واحدة، ومن قيمة العيش والسكر والشاي والفحم ما يستطيع أن يختلسه بصورة لا تترك أثرها.. وكان يحاول ألا يشتري حاجاته إلاَّ من حانوت مزدحم عل أمل أن يزوغ بالبضاعة في غفلة من صاحب الحانوت، فإذا أطبق عليه صاحب الحانوت فلا مانع عنده من استيفاء ما يستوفيه من ضرب، أو شتم، لأن الحياة فيما يصوِّره عقله المحدود لا تعدو أن تكون غالباً فيها أو مغلوباً، فإذا غلبت فما أحلى أن تهنأ بما تهنأ به المربية في البيت، ومراقب العمال بين أكوام التراب، وإذا غُلِبت فما أحرى أن تحني هامتك صاغراً. |
| وكانت متعته بما يظفر من اختلاس تتجلى في المزامير التي يشتريها.. فينفخ فيها سيالاً من روحه المعذبة لا ينظمها نغم معروف، أو لحن منسَّق، ولكنه يذوب فيه أنين قلب معذب مجروح!! |
| وكان يجد لذَّته بما يختلس عند بائع البليلة أو (الليم) أو صاحب القثاء الذي يفترش الأرض ببضاعته بين زحمة الصبيان وهو يصيح (شرشوا) فينهال الصبيان على قثائه يلتهمونها مغموسة في إناء الماء المالح الذي يسميه (الشرش). |
| كان (علوة) تُغريه شهوة أمثال هذه المعروضات كما تُغري أترابه من الصبيان. ولكن مربيته لا تقنع بمثل هذه الترَّهات فتمنعه (الهللة) الواحدة إذا سولت له نفسه أن يقتطعها من أجره وتذيقه من ألوان الضرب ما لا يحتمله جسمه فتفتقت حاجته عن شتّى طرق الاختلاس، وتعلم بالتدريج كيف يقتطع الهللة والهللات من أثمان السلع الصغيرة التي تكلفه مربيته بشرائها، واستمرأ هذا اللون بمرور الأيام حتى فقد حساسيته بما يفعل وأصبحت الحيلة لشهواته جزءاً من كيانه. |
| كانت قهوة (الحمارة) في الشبيكة مجمعاً للحمّارين في أكثر ساعات النهار، وكانت ساحتها الصغيرة تكتظ بعد صلاة العصر من مساء كل يوم بهم أكثر ما تكتظ في بقية اليوم.. كانوا يصفّون حميرهم تحت جدران البيوت القريبة من القهوة يميناً وشمالاً استعراضاً لطالبي الإيجار. |
| كانوا يخضبون أجزاء من جسمها بالحنّاء في لون وردي جميل، ويحلّون براذعها بأقمشة براقة، ويُنيطون بأعناقها قلائد من الودع أو الفصوص و (الشناشن) التي توسوس كلما اهتزت رؤوسها في إيقاع لذيذ!! |
| وكان المكارون يدربون الأقوياء منها على الخطو المنظم عنقاً أو شداً، ويعلمونها الطريد في أسلوب لا يختلف كثيراً عن أسلوب الطريد في الخيل، بل إن بعضها كان لا يعجز أحياناً أن يسابق الخيل، كما أن بعضها يحمل من أثقال الركاب ما تنوء به البغال. |
| وكان متعودو الأسفار بين مكة وجدة يعتمدون أقوياءها في رحلاتهم الشاقة.. فقد كان منها مَن يقطع الرحلة بين البلدين في نحو 8 ساعات، بينما تقطعه الجمال في ليلتين متواليتين قبل أن تعرف قفارنا خطوط السيارات. |
| كما كان بعضها معداً للمتنزهين في ضواحي مكة البعيدة يستأجرونها من مواقفها في الشبيكة، ويمتطون صهواتها في الأصائل الجميلة من أيام الربيع والصيف. |
| وكان يوم الجمعة عيد المتنزهين على صهواتها.. تزدحم مواقفها في الشبيكة بطوائف الشغّالين، والعمال، وصغار الطلبة، وأنواع من الطوائف التي تحتفي بعطلة الأسبوع من هذا اللون، وتبذل في متعتها جزءاً مما اقتصدته من أجرتها في أيامه. |
| وكان لها عدا موقف الشبيكة موقف في خريق المعلاة وغيره في مدخل أجياد، وغيره عند باب الصفا.. يكتظ بالباحثين عن النزهة فوق صهواتها. |
| ولم يكن لصاحبنا (علوة) عهد بهذا اللون من الحياة. فقد عاش في ربقة مربيته لا يعرف طريق الشارع إلاَّ لشراء أغراضها، ولا يتصل بإنسان إلاَّ ليقضي حاجة محدودة كلَّفته مربيته بها.. أما فكرة العطلة فشيء جديد لم يطرق سمعه قبل اليوم الذي سمع فيه زملاءه من عمال الطين والحجر يلغطون به.. ورآهم يحسنون له مرافقتهم في أصيل يوم الجمعة الذي اتفقوا على قضائه فوق صهوات الحمير. |
| كان قد اقتصد بطريقته الخاصة التي تعلمها من قسوة مربيته ما يزيد عن العشرين قرشاً.. سرقها من أثمان الحاجيات التي يشتريها لها، واستطاع أن يغيب بها عن البيت دون إخطار أو إنذار. |
| ورأى نفسه لأول مرة يعتلي صهوة شيء.. أي شيء!! فهزته النشوة أكثر مما هزهُ الحمار، ولذّ له الانطلاق في فضاء الله المتَّسع، وتمتع بأصيل لم يظفر في حياته المجدبة بما يُضاهيه جمالاً ولذة. |
| وعاد إلى مربيته بعودة الليل يبكي.. قال: "إني رحت إلى السمّان كما أمرتني فلما وزن السمن زاحمني بدوي بكتفه فوقع السمن على الأرض، فأمسكت بالبدوي فضربني، وجرى. فأسرعت إلى مركز الشرطة أشكوه فأرسلوني مع أحد العساكر فقضينا طوال ساعات العصر نبحث عن البدوي فلم نعرف له مكاناً". |
| لم يكن في قصته حرف صادق. ولكنها كانت قصة محبوكة أتقن الخوف تأليفها، وكان يمكن أن تجوز على مربيته لو أرادت المربية أن تقدِّر درجة الصدق فيما ألَّف. ولكن مربيته لا يعنيها الصدق في أعماله بقدر ما يعنيها الربح والخسارة منها، فإذا خسرت اليوم السمن الموهوم فإنها خسرت إلى جانبه ساعتين أضاع الولد في أثنائهما خدمة البيت، وترك أعماله معطلة.. ولا يعوِّضها ويشفي أساها من ذلك إلاَّ (علقة) حامية تُدمي أطرافه وتُنهِك جسمه. |
| وتلقى (علوة) (علقتها) بأطراف ألفت (العلقات)، ومرنت أحاسيسه على آلامها كما مرنت أحاسيس فقراء الهند على تعذيب أجسامهم بما لا يحتمله جلد. وأصبحت تجد من غرائب اللذة فيها ما لا يصدقه عقل. |
| واستمرأ (علوة) عادة النزهة التي تعلمها فوق ظهور الحمير، واستهان في سبيلها بكل الصعوبات التي كان يتخيل أنها لا تُحتمل فأصبحت ديدنه في كل أسبوع يُلفق في سبيلها ما يصادفه من تلفيق، ويختلس من أجلها ما تقع يده عليه دون أن يُبالي بفداحة ما يرتكب!! وكيف يُبالي؟ وهو اليائس الذي فقد العدل، كما فقد الحب. وأصبحت الحياة لا تعدو في نظره المحدود أكثر من ختل لا يظفر فيه الضعيف، إلاَّ إذا وطن نفسه على مثل المكاره التي يلقاها من مربيته القاسية، والتي وطن نفسه بمرور الأيام عليها. |
| * * * |
| لم يظفر (علوة) في حياته المريرة التي كان يعيشها في بيت مربيته، أو بين عمال الحجر في مكان شغله براحة تُسِره إلاَّ في العصاري التي كان يختلسها للنزهة مع رفاقه فوق صهوات الحمير، أو في الساعات القليلة التي كان يكلفه فيها (اليابا) بتوصيل المقاهي إلى بيته في "دحديرة" جبل أبي قبيس. |
| كان (اليابا) يعيش مع زوجته التي أشرفت على الشيخوخة، وفتاة لها لم تنهد في صدرها أثداء، وخادم أثقل السن واللحم على عجزها، وتركها قعيدة في المطبخ كأنها صندوق عتيق ضخم لا يريم شعرة عن مكانه أمام (الكوانين). |
| كانت الزوجة ربة البيت، ورئيسة جاراتها في الزقاق، وكبيرة على كل من يعرفها من أول "الدحديرة" الصاعدة في جبل أبي قبيس إلى نهاية العمران قبل قمته العالية. كما كانت مسؤولة في نظر نفسها أمام جميع الملمّات الهامة التي تلمُّ بأقربائها، ومن يلفُّ لفَّهم من معارف مهما شطَّ دار أحدهم أو بعد. |
| كانت صديقة المرضى في كل البيوت التي تعرفها أو تسمع بها، وكانت حَفِيَّة بكل من يحتاج إلى معونتها رغم إمكانياتها الضيقة، وكانت تشعر بإحساس عميق بالميل إلى بر ومساعدة الضعيف في حدود طاقتها.. وعندما كان (علوة) يتردد على بيتها يحمل زنبيل "المقاضي" كانت تلمح بعض معاني البؤس ينطق بها محيّاه فلا تملك إلاَّ أن تخفي في صدرها زفرة مكتومة، وتتمنى لو استطاعت أن تتغلغل إلى نفسه لتعرف خفاياه.. ولكنها كانت لا تجرؤ، خشية أن تتفتَّح لها آفاق تُسيئها، ولا تقوى على علاجها. |
| وتبيَّن لها بمرور الأيام أن مقاضي الزنبيل لا تصل إلى بيتها في مقادير تتساوى مع ما تعرفه من مشتريات زوجها. وأن حبات الموز أو المشمش يبدو فيها أثر النقص فأدركت بإحساسها أن يد (علوة) تمتد إلى الزنبيل لتشبع حرمانه من الفواكه، أو تسد جوعه وما كانت تعلم أن قسوة مربيته واستئثارها دونه باللذيذ الطيب علَّمه الاختلاس.. وأنه بعد أن حذق فنون الاختلاس مما تأمنه عليه مربيته من أثمان مشترياتها، أصبح يستطيع أن يشبع رغبته من كل فواكه السوق بثمن ما يختلس من دراهمها، ولكن طبيعة الاختلاس كانت تأصلت في نفسه، وهيأته القسوة للثأر لضعفه من كل قوي.. فمرن على الختل، وحذق فنونه، وشعر أنه منقاد إلى معانيه انقياد الشاعر الفحل إلى ما يسبق لسانه من معاني الشعر. |
| ما كانت ربة البيت لتعلم هذا أو تفهمه.. فلم يتبادر إلى تفسيرها إلاَّ أن (علوة) يُشبع جوْعته، أو حرمانه من الفواكه التي يحملها إلى بيتها. فراضت نفسها الكريمة على تحمُّل ما يسيء.. وكانت تعلِّل لزوجها أسباب النقص إذا شعر به.. بأنها تستوفي نصيبها من الفاكهة، كانت تفعل هذا إيثاراً لمثل هذا الصنف الجائع المحروم؛ وتشعر في قرارة نفسها بارتياح لا يعدله حرمانها من لذَّة الفاكهة. |
| واستمرأ (علوة) هذا الاختلاس، ولم يستيقظ ضميره المتبلِّد لسوء ما يفعل.. كما أبت طيبة ربة البيت أن تعاتبه أو تتركه يشعر بأنها تفهم ما يختلس، وكان إذا بدا على ابنتها أو خادمتها أنهما أدركتا النقص سارعت ربة البيت إلى تعليل الحال بما يسكتهما وإن لم تقتنعا، وأمرتهما ألا يفصحا عن مثل هذه الظنون أمام زوجها؛ فكانتا تطيعان ما تقول براً بشمائلها الكريمة. |
| وكان (علوة) لا ينتهي بزنبيل المقاضي إلى بيت (اليابا) حتى يتشاغل بما يؤخِّر مقامه في البيت ويحاول أن يشارك الفتاة بعض أعمالها التافهة، أو يُعنى بصفِّ عرائسها وينظم الخرز عقوداً للعرائس، ويُضيِّع الوقت في ترتيبه، وتبويبه فإذا طال غيابه عن (اليابا) اعتذر له بخدمات تكلَّف بها في بيته.. وكانت الأم تصادق على ما يخترعه عنها لأنها لا تمانع في سرها بما تظنه استجماماً.. يغتنمه أمثال (علوة) من عناء أعمالهم التي لا تحتملها أجسامهم الذابلة. |
| ولكن (علوة) كان منقاداً إلى معاونة الفتاة الصغيرة بشعور مبهم لا يتبين معانيه.. فقد كان قدَّها الرشيق، وأعطافها الدقيقة، ونظراتها الساهية تستهوي عواطفه في غموض لا يفهم تفسيره. |
| وكانت الفتاة على صغرها لا تجهل مركزها من (علوة)، وتقدِّر حفاوته بعرائسها.. ولعلَّها كانت تشارك أمها في العطف على إنسانيته المعذبة في شعور صامت لا تفهم من معانيه حرفاً. |
| وطالت الأيام على مثل هذا النسق في بيت (اليابا) ثم انقطع (علوة) عنه فجأة وغابت أخباره عن العائلة، وسئل (اليابا) عنه فلم يعرف شيئاً، وأرسل إلى مربيته العجوز فذكرت: أنه ترك بيتها إلى غير رجعة، وأنها دائبة البحث عن مقرِّه دون جدوى. |
| * * * |
| كانت شؤون الأمن بين المدنيين في هذا العهد الذي تجري فيه حوادث روايتنا -أواخر العهد العثماني- مسؤولة من قومسير البوليس الذي يُعيِّنه والي الحجاز التركي في مكة، أما شؤونه في أطراف المدن والبادية فكانت مسؤولة من شريف الأتراك، أو رجال الجيش منهم.. فإن الوالي التركي يندب العدد الكافي منهم لإقرار الأمن الذي يحاول إقراره بالبندق، والمدفع، ولهذا كان الأتراك يكثرون من إنشاء الحصون والأبراج على طول الطرق ويوكلونها إلى حراس أشدّاء يتناوبون الإقامة فيها، كما أن شريف مكة كان يبذل بحكم مكانته بين القبائل، وسطوة حرسه الخاص (البواردية) ما يمكن بذله في سبيل الأمن، ولكن شؤون الأمن بالرغم من هذا أو ذاك كانت مثلاً عالياً للفوضى والعبث. |
| ولعلي لا أبعد كثيراً إذا علَّلت أهم أسباب العبث والفوضى بتوزيع المسؤولية في البلاد بين حاكمين كانا يتنازعان الاختصاص في أوضاع غير محدودة، ومسؤوليات غير مركَّزة. |
| فالدولة العثمانية كانت تولي أمر الحجاز أحد أشراف مكة من البيت القديم الحاكم فيها.. ومع هذا كانت لا توليه ثقتها الكاملة.. بل تندب إلى جانبه من يمثِّل سلطتها من الأتراك في وظيفة (والي) ليُشرِف على شؤون المال والإدارة والأمن.. فيرتبك شأن الإمارة وتضيع الحدود بين صاحب الإمارة وصاحب الولاية، ويتعذَّر معرفة المسؤول الأول عن شؤونها. ولو وكلت أمر أحدهما إلى الآخر لتركزت المسؤولية، وتحددت الاختصاصات. |
| لم يوكل أمر أحدهما إلى الآخر.. فأباحت لهما تنازع الاختصاص.. لذلك كانت أمور الرعايا تتراوح بين السلطتين، وكان في استطاعة القوي منهما أن يوسع دائرة نفوذه على حساب الآخر، وأن يفرض شكيمته في البلاد دونه.. فلا غرابة أن يعبث العابثون في بحبوحة هذه الفوضى، وأن يستغلوا فرصة تنازع الاختصاص لصالحهم. |
| كان بعض أشراف مكة لا يتورَّع عن تشجيع بعض العابثين.. ليُثبت للقصر العالي في الآستانة عجز الوالي، وعجز دوائره البوليسية، والدفاعية عن إقرار الأمن.. كما أن بعض ولاة الأتراك كان لا يبالي بتمرُّد العابثين إلاَّ إذا كانوا من قبائل توالي بيت الشريف ليثبت لمراجعه في الآستانة أن منشأ الفوضى بيوت الموالين للأشراف. ولذلك كان بعضهم يتكلَّف الإغضاء عن كثير من حوادث السرقة ليحصر جهوده في حوادث خاصة يرى أنها تستطيع إثبات علاقتها ببيوت الأشراف. |
| بذلك ضاع الغرض السامي من إقرار الأمن في البلاد، وحل محله تربص المتنازعين على الحكم للدسيسة ضد بعضهما.. ولهذا وجد العابثون بالأمن ميداناً واسعاً لأعمالهم.. فكانت بعض القبائل تعبث بأمن الطريق، فينطلق عسكر الوالي في أثرهم حتى يظفر بهم في القليل، أو يشردهم في الأكثر ليستأنفوا عبثهم في مناطق أخرى. |
| وكان بعضها يفرض الأتاوات على الحجاج فيدفعونها صاغرين، ثم يصل الأمر إلى شريف مكة فيزبد ويرعد ثم لا يفعل إلاَّ ما يفعله الأتيكيت، أو يصل إلى الوالي فيأمر جنده بالكر والفر، وإطلاق البنادق في أعقاب المعتدين.. فلا يظفر إلاَّ بما يُسكت الرسميين وإن لم يقنعهم. |
| وكانت مكة إلى جانب ذلك ممتحنة بطائفة من السرقة والنشالين استطاعوا أن يبرعوا فيما امتهنوا براعة نادرة المثال في تاريخ أمثالهم. |
| وقد اشتهر منهم في هذا العهد الذي نقصُّ حوادثه: |
| "أبو سعيد -أمين جاوي -حامد مخربش -عبد الرحمن عورة -الدنكاشي -وكثير غيرهم". |
| كان بعضهم يراهن على نشل ما في جيبك. ثم لا ينتهي حديث الرهان حتى تكون محتوياته قد انتقلت إليه دون أن تشعر، وكان بعضهم ينذرك لتتحصن ضد عدوانه، ويعين لك الساعة التي يسطو فيها ثم لا يخلف إنذاره رغم جميع الاحتياطات التي تحاولها. |
| وكانوا مع هذا معروفين بأشخاصهم لدى المسؤولين والأهالي، ولكن ذلك لم يمنعهم من العبث لأن فكرة إقرار الأمن في البلاد لا تشغل رؤوس المسؤولين في بيت الشريف ومركز الوالي بقدر ما يشغلها العمل لسياستهما المتضادة. |
| كان الأهالي يقولون -وقد ظلوا إلى وقت طويل يقولون- إن الدولة العثمانية رحيمة!.. ولكنها لم تكن رحيمة بقدر ما كانت مهملة.. ولم يكن إهمالها يصدر عن عجز بقدر ما يصدر عن غرض.. كانت دبلوماسية ممثِّلها التركي، تقتضيه أن يفسح صدره للعاتين، وأكثرهم في مكة من الحجاج وبعضهم من الأهالي لئلا يهيئ أعداء من كل صنف، وبحسبه أن يتربَّص الفوضويين ممن يشتبه في موالاتهم أو قربهم للأشراف ليُضيف ذلك إلى أدلَّته ضد الأمير دون أن يبالي بالغرض الأساسي من تعيينه في مثل هذا المنصب!! |
| ولو استطاع أن يتفق أصحاب الإمارة، وأصحاب الولاية على إقرار الأمن للأمن لما عجزوا عن تحديد المسؤولية وإيقاف العاتين عند حدودهم! |
| وقد ظلت ذيول المأساة إلى عهد طويل بعد جلاء العثمانيين من الحجاز.. فإن الملك حسين الذي استطاع أن يستقل بأمره في الحجاز ضرب بيد من حديد على جميع العاتين والسرقة في مكة، ولم يعجز عن قطع دابرهم فيها.. وقد فعل قريباً من هذا في كثير من المدن؛ ولكنه عجز عن تأمين جزء هام منها أخصه في طريق المدينة. |
| وتلك هي ذيول المأساة فإن الحسين كان يخشى تمرد القبائل القوية التي كانت تعيش مدلَّلة في عهد العثمانيين وأن يسري هذا التمرد إلى جيرانها فتسوء العاقبة. فحاول أن يداريها بالقسوة مرة والرأفة أخرى، وهو يؤمل أن يصل على مر الأيام معها إلى نهاية حاسمة، ولكن الأيام جلته قبل أن يقضي أربه منها. |
| ويبدو هذا واضحاً في معاملته مع غير القبائل القوية وشذَّاذ اللصوص في المدن من جميع الألوان الذين لا تجمعهم عصبية واحدة، فإنه حزم أمره في شأنهم دون أن يبالي، واستطاع أن يقضي بحركة واحدة على جميع أعمالهم. |
| لم يسترسل الفصل السابق بنا في غير مجرى حوادث قصتنا، فإنه بحث كان لا بد منه لاستطراد قصة (علوة) الذي كنا رأينا قسوة مربيته تعلِّمه الاختلاس وتدفعه في حركة لا شعورية إلى مهاوي الحياة، والذي رأيناه ينقطع فجأة واحدة من بيت (اليابا) ويغيب عن بيت مربيته؛ ويتركها تدأب في البحث عنه في غير جدوى. |
| لم يولد (علوة) منحرف الأخلاق أو مستقيمها، وإنما وُلد كما تولد العجائن اللدنة قابلاً للتكيُّف والصيانة.. وأكبر ظني أنه لو مدَّ في حياة مربيه الأول الذي استهداه من دكتور الصحة.. لهيّأه المربي لما كان يعرف من ألوان الصلاح، وبثَّ في روحه هلاماً طاهراً يضيء اتجاهه ويهديه الصراط السوي. |
| لكن القضاء فجعه فيه، ووهبه سيدة لا ينبض في فؤادها حنان، ولا يومض في حناياها بصيص من عطف.. ولقد كانت صادقة كل الصدق في أول يوم دخل الطفل فيه بيتها عندما ضربت بيدها على صدرها وأعلنت زوجها استياءها في ألفاظ جافية وعبارات قاسية. |
| كانت صادقة لأن هذا الصنف لا يضمر أصحابه بما جُبِلت عليه قلوبهم إلاَّ أسوأ ما يضمره الحقد والشر. |
| فلا غرابة أن تقسو في معاملته رضيعاً، وصبياً، وغلاماً، ولا غرابة أن تؤثِّر القوة في معنوياته اللدنة وتهيئ منه إنساناً لا يؤمن بالخير في الحياة لأن في الخير حروفاً لم تطرق سمعه حين نشأ؛ ولم يصادفه من معانيها ما يدله على مظانِّها في الحياة. |
| نشأ (علوة) منساقاً -بعوامل لا يفقه كنهها- إلى الثأر من الحياة.. في أشخاص من يواتيه الظفر بهم، فكان لا يتورع عن اختلاس أو ختل أو سرقة ما يستطيع فيه الاختلاس، أو الختل، أو السرقة.. وكأنه بهذا يريد أن يضيف إلى ثأره في الحياة ريّاً لروحه الظامئة من طول ما أرهقه الحرمان. |
| وإنه لماضٍ في طريقه ذات مساء في منعطف من دروب أبي قبيس إذ صادفته فتاة صغيرة السن تحلّى جيدها بقطعة ذهبية راقه بريقها، وقدَّر لها ثمناً صالحاً للتوسعة على شهواته فلم يتكلَّف أكثر من أن يدنو إليها ويربت على كتفيها فيما يشبه الحنو، ثم يترك يده الأخرى تعالج عقدة الحلية في هدوء، ثم يسلم رجله إلى الريح قبل أن تنتبه الفتاة الصغيرة إلى ما حدث. |
| ومضى من فوره إلى زقاق الصاغة على أمل أن يبيع الحلية قبل أن يتنبَّه أصحابها إلى فقدها، ولكن القدر كان مخبوءاً له على كثب منه في شخص (بصّاص) سري لاحظ ارتباكه فقبض عليه، فتلعثم؛ فقاده إلى جاويش تركي في أقرب نقطة حيث استجوب فاعترف بسذاجة اللص البدائي. |
| * * * |
| قدَّمنا في فصل سابق أن شؤون الأمن في مكة كانت مسؤولة في بعض نواحيها من أمير مكة على رأس حرسه و (بوارديته) إن كنا نذكر البواردية -وهم نوع من الحرس كان يتكلَّف بإحضار الخصوم إلى بيت الشريف في مجلسه أو قائم مقامه في دهليز البيت- كما كانت شؤون الأمن في نواحٍ أخرى أهم مسؤولة من والي مكة يمثِّله فيها قومسير للبوليس على رأس ثلَّة من الجند (الجندرمة)، وكانت أعمال الجندرمة في البوليس شبيهة إلى حد ما بأعمال (البواردية) في بيت الشريف. |
| وكان يتبع البوليس (بصَّاصون) مختصّون بالرقابة السرية يتعقَّبون المجرمين في أثواب مدنية، ومع هذا فقد كانوا غير مجهولين بأشخاصهم وأسمائهم من المتوطِّنين في مكة.. أما معتادو الإجرام فكانوا وثيقي الصلة بهم وكانت إشارة واحدة من أحدهم إلى البصاص كافية لإفساح الطريق أمام إجرامهم.. لهذا كانت أعمال المجرم العاتي لا يشوبها خطر إلاَّ إذا اختلف مع البصّاص أو أساء معاملته. |
| وكان فتانا (علوة) أصغر من أن يحذق شيئاً من هذه الأسرار، لهذا كان لقمة سائغة للبصّاص عند أول خطوة أراد أن يخطوها في جد. |
| لم يشفع له سنه لدى (البصاص) كما لم تنفعه سذاجته أمام ضابط البوليس، وأمام القومسير فيما بعد، وليس هذا خطأ حكَّام الترك وحدهم.. لأن دراسة النفوس الملتوية فكرة لم يتناولها نظام خاص في كثير من شعوب الأرض. |
| وأعتقد أن الحياة سيدميها السير طويلاً قبل أن تنتهي إلى اليوم الذي تشعر فيه بحاجتها إلى هدم أكثر آرائها في علاقة المجتمع بالمجرمين.. فليس الإجرام فيما أعتقد أكثر من مرض له أسبابه السيكولوجية وأعراضه التي تتنوَّع بتنوُّع جراثيمه الخاصة.. فإذا استطاع العلم في أحد الأيام تشخيص حقائق المرض، واستطاع أن يتتبَّع أنواعه التي لا يحدها حصر، وأن يتعقَّب الجرثومة المتأصلة في حقيقة كل نوع على حدة.. فسوف لا يعجز عن علاجه بغير الطريقة التي اعتادتها الحياة إلى اليوم.. وعندئذٍ سيبدو مقدار تعسفنا في امتهان المجرمين، وتسرعنا في الأحكام على أعمالهم قبل التثبُّت من دوافعهم إلى الإجرام.. ورحم الله خليفتنا الفاروق الذي أبى أن يعاقب السرقة في سني المجاعة، فقد كان أغزر دراسة لأركان الجريمة من ملايين الحكام الذين افترضوا خصومتهم للمجرمين دون أن يكلفوا أنفسهم النظر في دوافعها الحقيقية. |
| وفتانا (علوة) أحد ضحايا هذا الافتراض الظالم.. فقد نشأ في بيت عطَّل أحاسيسه بما يفعل، وترك عقله الصغير يحدد علاقته بالمجتمع في إطار ضيق أغراه بالختل، وعلمه الاختلاس ودرَّبه عليه دون أن يشعر حتى ألِفه.. والإنسان عبد لما ألِف.. فإذا ساقه سوء الطالع إلى طريق (البصّاص)، ثم إلى موقف الحاكم. فهل نأمل من (البصّاص) أن يشفق على ضعفه؟ أو من الحاكم أن يُكلف نفسه دراسة الدوافع الحقيقية إلى الإجرام؟ |
| إن في هذا من التكلُّف في نظر الحياة اليوم ما لا يتَّسع له مدى عاقل.. أما السبيل الطبيعي المتفق عليه فليس سوى الامتهان الذي يليق بأمثال هذا البائس. |
| إذا كان بعض الموهوبين قد هداهم العلم إلى حقائق كبيرة درسوها في نفسيات المجرمين.. فأولئك قلة في أطراف الأرض لم تعترف حكوماتهم بآرائهم إلى اليوم، في الغالب الأعم، اعترافاً رسمياً يؤهل درجها كقواعد في أنظمة الحكم، وإلا لهدمت تلك الحكومات جميع سجونها، وأقامت على أنقاضها مستشفيات تعالج فيها أعتى المجرمين، كما تعالج الأمراض المستعصية، وتُعِدُّ لهم بفنونها حياة تؤهلهم للاستقامة والشرف. |
| * * * |
| سيق (علوة) إلى سجن القلعة على كتف الجبل المعروف في أجياد، فلم يتألم إحساسه لما ناله من امتهان وصفع، وشعر في قرارة نفسه أنه إذا خاب اليوم في صفقة مع الحياة، فلا يجب أن يجزع لقسوتها.. لأنه سيقسو إذا ظفر بعد اليوم دون أن يعتد بآلام غيره إذا تألم. |
| سيق إلى السجن فاستقبل فيه طوائف من البشر كأنها النحل تطن بين خلاياه.. كانت كل طائفة تتجانس في مستواها، تحتل غرفة من عشرات الغرف المتزاحمة حول ردهة السجن، فمضى يرود الخلايا غرفة بعد أخرى، لعله يأنس إلى ظل يقيه الشمس، حتى انتهى إلى سقيفة نائية مهجورة في طرف ناء من السجن.. فأوى إليها في جسم متهالك ولم يبرح مكانه منها حتى اقترب منه أحد المسجونين: |
| - واد أنت قاعد هنا لحالك ليه؟ |
| - والله يا عمي أنا محبوس. |
| - طيب موكلنا محبوسين زيك.. بس هادي وصلة عفنة شوية.. ما أحد يقعد فيها.. شوف الغرف التانيه ادخل أي واحدة منها، واجلس. |
| - ما أعرف أحد يا عمي. |
| - أنت من أهل مكة. |
| - ومتى حبسوك؟ |
| - دوبهم. |
| - وليش حبسوك؟ |
| - كدبوا علي وقالوا سرقت من الولد الصغير ريال مغربي كان لابسه في حلقه. |
| - وأنت ما سرقته؟ |
| - لا والله يا عمي. |
| - ومين أهلك؟ |
| - ما عندي أهل. |
| - كيف يعني، طلعت مزروع في الأرض؟ |
| - واحدة هناك ربتني.. حرمة في البيت ولا عندها رجال.. ولا تدري إني انحبست. |
| - طيب ما أحد راح قال لها؟ |
| - لا والله. |
| - طيب وأنت أكلت ولا لسع؟ |
| - ما أكلت. |
| - وعندك فلوس؟. |
| - عندي واحد مجيدي وعشرة قروش. |
| - خليهم معاك وتعال كل معنا لقمتين. |
| ومضى به السجين إلى الغرفة التي تحتلها طائفة. وكانت تضم نحو ثمانية أشخاص ظنهم لأول وهلة من رؤساء السجن، لما رأى من نظافة ثيابهم ووجاهة الفرش المبسوط في غرفتهم.. كان أحدهم يتكىء على حشيّات نظيفة من القطن.. وقد عقد الدخان سحاباً كثيفاً من سيجارته في جو الغرفة، وجلس اثنان في ركن آخر من الغرفة على وسائد ليِّنة يلعبون (الضومنة).. بينما تفرَّق غيرهما في أركان أخرى من الغرفة يتبادلون الحديث أو يقتلون الوقت في لعبة (الانن). |
| كان نظام السجن في هذا العهد من أرفق أنظمة السجون في العالم، إذا قيست تقاليده بتقاليد غيره.. فقد كانوا يبيحون للسجين أن يرتدي ملابسه الخاصة، وأن يستحضر لأكله ما شاء من طعام، ولنومه ما شاء من فرش.. ولمّا كان السجن في العادة لا يخلو سجناؤه من طبقات تختلف باختلاف مراكزها وغناها، فقد كانت كل طائفة تجتمع إلى طائفتها في غرفة خاصة لتشترك فيما تستحضره فيها من طعام أو شراب.. فأصحاب الغنى متميِّزون بغناهم، كما هو الحال في المتوسطين والفقراء. |
| ومن العادات المتَّبعة في السجن: أن أغنياء المسجونين تصلهم الأطعمة من بيوتهم في كميات وافرة، تفيض على أمثالهم عدة مرات، فكانوا يطعمون بعضها، ويوزعون أكثرها على المعتقلين في غرفهم الأخرى.. لأن السجن لا ينفق على هؤلاء الفقراء إلاَّ في القليل النادر. |
| وكان السجناء الأغنياء لا يستغنون عن خدمات زملائهم من الفقراء في سائر أغراضهم في السجن.. وبذلك يجد البؤساء مورداً طيباً يُهوِّن عليهم لأواء السجن، ويحمل عنهم مصائبه!! |
| وقد وجد (علوة) في الرجل السجين وأفراد طائفته ما أغراه بالبقاء عندهم رهن خدمتهم! |
| واختلط (علوة) بكثير من نزلاء السجن في الأسبوع الأول لدخوله السجن، وكان بحكم صغر سنه، يستطيع التنقل بين سائر الغرف دون حَرَجٍ من أصحابها.. فقد كانوا يُكلِّفونه بكثير من خدماتهم داخل السجن، فيمضي فيما يكلِّفونه بنشاط لم يعهده فيما كانت تكلِّفه به مربيته من قبل؛ ولعل ذلك كان نتيجة لعدم شعوره بروح الكراهية التي كان يشعرها في بيت مربيته، أو لأنه أدرك أن ما يجمعه بزملائه في السجن، أقرب كثيراً إلى معاني التفاهم من جامعته بغيرهم. |
| وزاد اختلاطه بهم بمرور الأيام، فكان يستمع إلى قصصهم، وينصت في عناية إلى رواية البطولة في أحاديثهم.. هذا فذ في سطوه، وذاك حكيم في نشله، وأولئك من المعدودين في فن العبث بسلطان الدولة.. صور لا يحصيها العدد، تمثِّل في مجموعها ألواناً من حياة الإجرام مطبوعة بطابع الفروسية القديمة. |
| استمع (علوة) إلى عشرات القصص وعشراتها من هذا النوع فتأثرت نفسيته الضعيفة بروعة ما فيها من بطولة زائفة، وتعشَّق أمجادها الكاذبة، وتمنى لو أتاحت له الأيام أن يقفز إلى صفوف المعدودين في طلائع الإجرام. |
| وعرف في السجن مجرماً من عتاة اللصوص كانوا يدعونه (أمين جاوي) وكانوا يكبرون فيه سطوته، ويتحدثون عن نوادره في الجرأة والبسالة.. فأُعجب بمميزاته كما تحدثوا عنها، وهاله فيه القوام الناهض، والنظرة الثابتة، والمحيّا الناطق بالقوة والتحدي. |
| وبدا "لأمين جاوي" أن الفتى (علوة) أحد المعجبين به، فحنا عليه حنو الكبار، وكان يربت على كتفه مشجعاً كلما سمعه يروي حكايات مقته على مربيته، أو ينعى قسوة الأقوياء على الضعفاء في الحياة. |
| وتوثَّقت الصلة بين فتانا وأستاذه.. وكان الأستاذ نابغة في فنون النشل، فلم يبخل على تلميذه بدروس طويلة تعلم فيها أفانين النشل، وحَذِق ألاعيبها وكثيراً من حيلها. |
| * * * |
| كانت قهوة العم سالم تحتل بناءً واسعاً في أعالي خريق المعلاة، بجوار مسجد الجن قبل أن يمتد العمران بشكله الحاضر إلى ذلك الجزء، وكان يدير أعمال القهوة فيها كهل من أمهر أصحاب المقاهي في مكة، وأكثرهم عناية بالروّاد، وأشدُّهم حزماً على خدمه ويقظة لجميع وسائل النظافة في مقهاه. |
| كان روّادها في أمسيات أيام القيظ الشديد يتمتعون بمائه البارد المعطَّر، قبل إنشاء معامل الثلج في مكة.. فقد كان يصفُّ قِلال الماء -ونسميها رباعي- بالمئات في مكان استراتيجي من مقهاه يتعرض لهبوب الريح، فلا يكاد رائده يحتل كرسيه بين (المراكيز) المصفوفة، حتى يصيح الصائح (ربعي يا وليد) في صوت مجلجل لا ينتهي من آخر مقطع فيه، حتى يكون (الربعي) قد وصل إلى (الطرابيزة)، وبدأ الظامئون يطفئون حرارة القيظ من مائه البارد المعطَّر. |
| ويتوالى مجيء الطلبات في سياق مطَّرِد، لا أثر فيه للتلكؤ، لأن صاحب المقهى على كثب من عماله فيها يتبع حركاتهم دون أن تطرف له عين. |
| وكانت مساحة مقهاه من أوسع المساحات في مقاهي مكة، وأنقاها هواء.. وكان لمقهاه سطح مشرف يعد إلى جانبه الساحة الواسعة حيث يتوسَّد النائمون كراسي نظيفة يجدون فيها متنَّفساً مما ضاقوا به في بيوتهم، كما يجدون وسائد وأغطية لا تقل في نظافتها عن سائر موجودات المقهى. |
| وكان خدمه يحرسون نوّام المقهى في ساعات الليل بالتناوب، دون أن يجرؤ أحدهم على التراخي، أو يخل بواجبات ما وُكِّل إليه من عمل. |
| وفي إحدى الليالي، وبينما كان زبائن المقهى قد توسَّدوا كراسيهم الطويلة، واستغرقوا في سُباتهم إلاَّ نفراً قليلاً في أحد الأطراف البعيدة من المقهى كانوا يهزجون ببعض أغانيهم البلدية في أصوات هادئة، إذا بضجَّة ترتفع في طرف آخر من المقهى وبصوت صارخ يتهدج: (حرامي.. حرامي.. امسكوا الحرامي)، فاستيقظ أكثر النوّام على صوت الصارخ، وجرى بعضهم إلى مصدر الصوت، وتبعهم الحرس فتقاطروا مسرعين للنجدة.. ثم علا الصخب، وكثُرت الضجة، وجرى بعض خدم المقهى يحملون فوانيسهم إلى مكان الضجة، فرأى المجتمعون في ضوئها شبحاً هزيلاً يتسلل بين الكراسي؛ ثم يعدو في خفَّة القط إلى الحائط بجوار المقهى يُطِل على قبور المعلاة فيتسلقه ثم ينحدر إلى القبور فيضيع أثره بينها. |
| وتحمس الحرس، ورجال من رواد المقهى، وبعض حملة الفوانيس فتتبعوا أثره وراء السور حيث رأوه ينحدر؛ فلم يجدوا له أثراً.. وفتشوا بعض القبور التي وجدوها مفتوحة فضاعت جهودهم هباء. |
| وعندما عادوا إلى المقهى علموا أن الشبح استطاع أن ينشل كيس النقود من بين مخدّات النائم وكان فيه مبلغ من (المجيديات) وبعض القطع الفضية (الاستانبولي). |
| وعلم صاحب المقهى بما حدث في الصباح، فشدَّد عقوبته على الحرس، وفصل بعضهم، وأضاف غيرهم بعد أن أوصاهم بالحرص. إلاَّ أن جميع الترتيبات ضاعت هباء، لأن شبح الليلة البارحة عاد مرة أخرى إلى الظهور، واستطاع أن ينشل نائماً آخر، ثم يذوب وراء سور القبور. |
| وعلم صاحب المقهى بالأمر، فاشتد حنقه على اللص الساخر، وحلف ألا يغادر مقهاه من ليلته حتى يكشف الأمر؛ ويعرف سر ذوبانه بين القبور. |
| ورأى أن يبدأ فحصه في ضوء النهار.. فاكتشف بين القبور المهجورة قبراً يتصل قاعه بسرداب صغير سُدَّت فوهته بحجر ضخم، وأزاح الحجر، فرأى السرداب لا يزيد عن حفرة تتَّسع لجلوس رجل ضئيل الحجم.. فأدرك أن اللص يتخذ مخبأه عندما يذوب بين القبور في هذه الحفرة التي يغطي فوهتها الحجر.. |
| فإذا تعقَّبه الساهرون، ثم افتقدوا أثره بين القبور اكتفوا بتفتيش القبور دون أن يرعى انتباههم حجر متروك في قاع أحدها. لأن قياع القبور لا تخلو مما تحدَّر إليها من الأحجار المحيطة، ولأن أضواء الفوانيس لا تستطيع الكشف عما خفي وراء مثل ذلك الحجر. |
| وبذلك استطاع صاحب المقهى، عندما استأنف اللص عودته من ليلته الجهيدة أن يترصَّده بجانب الحفرة، وأن يضع يده عليه في يُسر وسهولة. |
| وسيق اللص في زفَّة صاخبة إلى نقطة البوليس في سوق المعلاة.. وبدأ يستقبل اللطمات من كف المفوَّض التركي في النقطة. |
| ولو استطاع القارىء أن يهتك الأستار عن حقيقة اللص، لأدرك أنه صاحبنا (علوة)، وعرف أنه لم يكمل مدة السجن المقررة، حتى استطاع أن يحذق كثيراً من الحيل التي تعلمها من أستاذه في السجن (أمين جاوي)، وأنه لم يغادر بابه حتى كان قد وطد عزمه على العمل لنفسه، ولنفسه فقط، بين مجتمع لا يظفر فيه إلاَّ الغالب. |
| كان أستاذه يرى في الحياة آراءً لها خطورتها.. كان يعتقد أن اللصوصية بمعناها الصحيح لا تقتصر على جماعة محدودة سمّاهم الناس لصوصاً، بل هي حالة متأصلة في جميع الطبقات دون استثناء إلاّ في القليل الشاذ.. فالعميل المحتال، والتاجر المستغل، والمتموِّل المخادع، والوجيه المنتفع بوجاهته بطرق لا تقرُّها النزاهة، والقوي المستفيد من قوته في قضايا يعلم زيفها، ومالك الأرض أو معمِّرها الذي يضيف ببعض حججه الكاذبة قيراطاً يعرف أنه لا يملكه.. كل هؤلاء، وأنواع من أمثالهم، أكثر خطراً منهم على الإنسانية، يجب -في رأيه- أن يُضافوا إلى اللصوص، بل يُدرجوا في أوائل قوائمهم.. ولكن العرف التقليدي تغاضى عن حقائقهم في كبرياء وتضليل، بل مضى إلى أبعد من هذا فكلُّل جهود الممتازين منهم بأكاليل من الغار، وسمَّى بعضهم أبطالاً، وأهداهم من النعوت ما يغري!! بينما اضطهد غيرهم، وألصق بأوصافهم ما جرَّدهم من معاني المروءة والشرف. |
| فسارق الزهر مذموم ومحتقر |
| وسارق الحقل يُدعى الباسل الخطر |
|
| وجدت هذه الأفكار الخطيرة سبيلها سهلاً إلى نفسية (علوة) الناقمة على أوضاع الحياة فتركت أثرها فيه، وأعدَّته للشر، أكثر مما أعدَّته مربيته في تربيتها المنحرفة.. فلم يغادر سجنه حتى كان قد وطَّد عزمه على ما وطَّد. |
| وقادته رجله إلى السجن بجرمه الجديد، ولم يمضِ على مغادرته أسبوع، فاستقبله في تبلُّد وبرود.. ولعله سُرَّ بلقاء أستاذه في الغرفة التي تركه بها. |
| * * * |
| وقبل أن يمضي يومان على دخوله السجن، أسرَّ أستاذه إليه أنه بالاشتراك مع بعض الزملاء قد قرروا الهرب وأنهم دبَّروا لذلك خطة محكمة لا ينقصها إلاَّ التنفيذ العاجل، وأن في استطاعته إذا أراد الاشتراك، أن يُعِدَّ نفسه للتنفيذ في ساعة متأخرة من الليلة الآتية. فسُرَّ (علوة) لعناية أستاذه به وشاركهم فيما دبروا، واستطاعوا معاً بفضل الخطة المحكمة التي نظموها أن يجدوا أنفسهم طلقاء قبل أن يلمع الفجر.. إلاَّ أن سوء طالع (علوة) قاده من حيث لا يدري إلى (خريق المعلاة)، حيث لمحه الجندي الذي صحبه إلى السجن في جريمته الأخيرة، ولما أراد أن يستوقفه ليتحقق أمره أسرع (علوة) يطلق العنان لساقيه؛ ولكن الجندي -وكان من العدّائين قبل الجندية- استطاع اللحاق به قبل أن يفلت. |
| وسيق مرة أخرى إلى السجن بعد أن ضوعفت عقوبة سجنه، وأُدرج اسمه من جديد في (قوائم) العتاة من أصحاب الإجرام. |
| وكانت وطأة السجن عليه في هذه المرة أشد مما عرفها من قبل.. فقد آلمه نجاح رفقته دونه، كما آلمه فقد أستاذه الذي كان يأنس إليه، ويجد في صحبته ما يخفِّف عنه وحشة السجن. |
| ولم يطل ألمه كثيراً فقد جمعته الصدف بسجين من طلبة العلم كان كثير القراءة، كثير الصلاة، فاستهواه ترتيله الجميل لآيات القرآن، وخشوعه الطويل على مصلاه كلما حان وقت الصلاة. فآثره بتقديره، وتوافر على خدمته.. وعندما علم أن جريرة الشيخ في السجن لا تعدو تهمة كيدية، شعر نحوه بعاطفة من الميل لم يشعر بها نحو غيره من قبل. |
| وأحس الشيخ بميل (علوة) إليه فبادله حباً بحب، ثم سمع قصصاً من حياته فعرف موطن العلَّة في تربيته وأدرك بواعث الحقد والكراهية التي تأصَّلت في أعماق نفسه.. فأغرته بالجريمة، وعلَّمته من ألوان الشر ما حسبه يفي بثأره في الحياة.. فوطن عزمه في سره على تتبُّع موطن الداء من نفس الفتى، وأن يحتال حتى يستأصل الجرثومة من موقعها، ويحل ما تعقد حولها من طحالب. |
| لم يواجه الشيخ فتاه بما كان من آثامه في الحياة، أو يحاول تسفيهه، وتشنيع خطاياه.. وإيراد ما يناسب المقام من صيغ الوعّاظ ليُقيم الدليل على فحش ما جنى خشية أن يستثير أنانيته وعناده.. بل تناسى جميع جرائره وآثامه، وتحبَّب إليه حتى ملك عليه عواطفه ليستطيع أن يوجِّه قيادهُ في أناة ولين من حيث لا يدري. |
| حتى إذا تمَّ له ذلك عمد إلى شرح نواحي الخير والشر في الحياة.. في أسلوب لا يمتُّ بصلة إلى ما اقترفه (علوة) فيها. ليكون البحث عاماً لا علاقة له به من قريب أو بعيد، وكان يدلِّل فيما يشرح بما يحضُره من أقاصيص أخَّاذة أو فكاهات مُسرية، فكان الفتى يصغي بكل جوارحه إلى حديثه الطريف، ويستحثُّه ليواصل ما قطع منه، ويستعذب روح الفكاهة فيما يقص عليه من حكايات. |
| وكان يزيد في عجب (علوة) مدى الفرق بين ما عرفه عن حقائق الحياة التي استقاها من بيئته الخاصة، وبين ما تكشَّف له من آفاق جديدة فيما يحدثه الشيخ.. فكان الشيخ يُدرك وجه تعجُّبه، ويتطوع بالتفسير. |
| - (أنت يا (علوة) ما شفت الدنيا إلاَّ من جهتها السوداء.. قست عليك اللي ربتك، وقسا عليك اللي اشتغلت معاهم في الحجر والطين، وما وجدت واحداً في طريقك من أهل الخير، فظننت الدنيا كلها كدا أهل شر، لكنك لو واجهت الدنيا من جهة ثانية كان شفت أنه فيها كمان بياض يفتح النفس، وشفت أناساً من أهل الخير تتعب أناساً من أهل الخير). |
| وكان الشيخ يشفع نظرياته في الموضوع بقصص لأهل الكرامة والنبل ومحبي الخير في الحياة، فيترك (علوة) يحس بحقيقة جهله، ويزداد تعجبه من تصوراته الخاطئة التي كان يرسمها لذهنه عن حياة الناس.. وبذلك تحلَّلت العقدة في أعماق (علوة) وبدأت آفاقه تتَّسع لنظريات الشيخ. |
| واستمر الشيخ في ترويض (علوة) بأسلوبه الحكيم الهادىء، حتى تعشَّق (علوة) بمرور الأيام مبادىء الشيخ وتمنى لو أُتيح له الانطلاق ليصافح الحياة من جوانبها البيضاء، ويبحث عن وجه الخير فيها. |
| * * * |
| وعندما انتهت أيام سجنه وأسلموه إلى الباب.. تنفس الهواء الطلق ملء رئتيه، ومضى في خطوات ثابتة يتلمس الحياة من جانبها الأبيض. |
| كان قد عول على طرق أبواب العمل الشريف، فأخذ سمته إلى طباخ كان يعرف دكانه في القشاشية بجوار البريد القديم، عسى أن يجد لديه عملاً يقيم أود حياته الجديدة.. لكن الطباخ ما كاد يسمع طلبه حتى عرف فيه (شقياً) قديماً، فأشاح بوجهه دون أن يُجيب بحرف واحد. |
| ترك دكان الطباخ وأخذ طريقه في انكسار إلى مقلاة للحمص كانت على خطوات منه، فلم يكد يرحب به صاحب المقلاة، حتى تذكر أنه عرف الشخص قبل اليوم، فاستدرك الأمر بطرده من الدكان. |
| وخيَّم الليل على (علوة) وهو في طريقه يذرع الشوارع والدروب، ويتسكع بين الدكاكين علَّه يجد من يقبله في عمل، أو يسأله لشغل، حتى دبَّ التعب إلى أعصابه، وأنهكه الجوع. |
| وكان يملك من دنياه (مجيدياً واحداً)، استبقاه في جيبه من النقود القليلة التي كان ينفحه بها بعض أصحاب الخير في السجن فاشترى منه بعض العيش والتمر، وعوَّل أن يواصل سيره إلى أحد المقاهي في الخريق ليأكل مما اشترى وينام على أحد أسرة المقهى إلى أن يوافيه الصبح. |
| إلا أن صاحب المقهى ما كاد يلمحه حتى تذكر قضيته ليلة حادث السرقة التي اختبأ بعدها في القبر المهجور، فأبت غيرته لزبائنه أن يقبل نومه عنده، فطرده في قسوة واضحة، وفعل مثله صاحب مقهى آخر، حتى أبت جميع المقاهي في الخريق قبوله لديها، لأن أصحابها كانوا قد علموا جميعهم في ليلة الحادث بما جرى قرب مقاهيهم من مكان الحادث. |
| فمضى به الدرب بأسوأ ما يمضي فيه إنسان كسير القلب مكدود، ولقد ساورته أفكاره القديمة عن آرائه القاتمة في الحياة؛ ولكنه صمد، وأبى إلاَّ أن يواصل الجهد حتى يصافح الحياة المشرقة التي بشَّره الشيخ بحقائقها. |
| وعادت به قدماه إلى حيث أتى، فلما انتهى إلى القشاشية، دلج إلى المسجد الحرام، فأدّى فريضته كما تعلمها من الشيخ، ثم بسط طعامه فأكل ما استطاع مكدود مثله أن يأكل، ثم افترش (إحرامه) حيث كان، وأراد أن يهجع، ولكن الشرطي المكلَّف ما كاد يراه مضطجعاً. حتى أمره بالجلوس، أو مغادرة المسجد، لأن النوم ممنوع فيه. |
| وحاول الجلوس فأبى النوم ذلك عليه. فغادر المسجد إلى القشاشية مرة أخرى، ثم دلج يصعد في الأزقة الضيقة إلى جبل أبي قبيس. |
| ولم يصل إلى قمته حتى كان التعب قد أرهق مفاصله فأوى إلى صخرة في القمة، وافترش (إحرامه) لينام فأقضَّ مضجعه نباحٌ عالٍ، ونظر فإذا عدد لا يحصى من الكلاب تطارد ذئباً بين مخارف الجبل، وحقَّق نظره فإذا الذئب يختفي بين شغاف الصخور القريبة منه، بعد أن ضلَّت الكلاب سبيلها إليه، ووقفت على عدوة مما اختفى توالي النباح في أصوات مزعجة. |
| وجفاه النوم، واشتد به القلق، وأحس أنه على كثب من خطر الذئب الكامن وراء الصخور. فابتعد عن المكان ما أمكنته قدماه المرهقة، وحاول النوم من جديد. ولكن القلق كان قد زاد الكرى عن أجفانه المثقلة، وسمع أصوات الكلاب تدنو نحوه، فأيقن أن الذئب قد غادر مخبأه إلى حيث يطارده الكلاب، فوجف قلبه خوفاً؛ وازداد اضطرابه. |
| وكانت ليلة ليلاء قاسى من أهوالها ما لا يحتمل، وعز عليه أن يظفر فيها بهدوء أو راحة. |
| * * * |
| واستأنف سعيه من الغداة بحثاً وراء الرزق. فاستطاع بعد عناء شاق أن يجد عملاً في أحد مصانع النوْرة، وكان ترتيبه في المصنع سياقة الحمير الموثَّقة بأكياس النوْرة من مصنعها وراء جبال أبي لهب إلى مركز بيعها في حارة الباب من مكة، فصادف ما لا يحتمل من وصف الجري، والانغماس في حفر النورة واستنشاق ذراتها الحادة على من لم يألف العمل فيها. ولكنه كان قد اعتزم الثَّبات؛ وآلى على نفسه أن يروِّضها في حياته الجديدة. |
| واستمر يتخذ مأواه كل ليلة من مكانه المختار في قمة أبي قبيس، وبعد أن قطع الكلاب دابر الذئب الذي يرتاد المخارف فيه، فكان ينعم بمرقده الخشن يؤرقه نباح الكلاب العابثة في آفاق الجبل؛ ثم لا يلبث أن يغزوه النعاس. |
| وظل على أمره في ذلك أياماً.. استطاع في أثنائها أن يُشبع حاجته إلى الطعام، ولكنه توجَّس شراً قبل أن يتمَّ أسبوعه الأول، لأنه لمح رجلاً كان يعرفه من رواد مقاهي الخريق يطيل النظر إليه وهو يفرغ وسقة من النورة في دكان البيع، ثم رآه يتجه إلى المشرف على البيع في الدكان، ويُسِرُّ إليه في صوت خافت كلاماً أحسَّ أنه يعنيه، فوجف فؤاده واضطرب. |
| وصوَّر له خياله أن ماضيه بات مكشوفاً منذ الساعة لأعمامه في العمل فتوجَّس الشر، وبات ليلته في أسوأ ما يبيت حزين مهموم، كان يقول في نفسه: أمن العدل أن أعاقب بجرائر ساقتني إليها ظروف كنت أجهل مقاومتها؟ وإذا كان الله قد شمل التائبين بعفوه، فما بال عباده يناصبونهم العداء، ويغلقون أمامهم، أبواب الحياة؟ |
| وتلقى في صباح اليوم التالي أمر رئيسه بترك العمل، ولم يتورَّع الرئيس أن يضيف إلى أوامر الطرد بعض النصائح: -يا واد ما دام انت حرامي وردِّ حبوس جي تمتحنا بنفسك ليه؟.. روح شوف عينك زي اللهبة من أول يوم جيت عندنا.. هيا روح أقلب وجهك. |
| وصعَّد (علوة) زفرة أودعها كل آلامه وقال: |
| (يا عمي أنا كنت حرامي.. ولكن تبت، وعاهدت ربي ما عاد أسرق أحد.. والله يا عمي أنا فرحت بالشغل اللي لقيته عندك، وقالي عقلي يا واد ما دام الحالة ماشيه كده تقدر تنسى كل شيء، وتبتدي تمشي مستقيم في الدرب الجديد زي الناس المهديين). |
| ولكن العم صاحب المصنع، أبى أن يقتنع بأمثال هذه الكلمات، ورأى من الخير لمصنعه أن يحتاط بإبعاد من توجَّس فيه الشبهة، ونسي في مثل هذا الحال أن واجبه كإنسان أن يُسدي إلى مثل هذا البائس فرصة جديدة إلى الحياة البريئة التي يتوق إليها.. وتلك حالنا في الحياة، كانت ولا تزال تعد الآثمين، والخاطئين، والجاهلين لأسوأ معاني الإجرام. |
| لم يتكلف صاحبنا أمام هذه التوسُّلات أكثر من نظرة يشيع فيها الازدراء والاحتقار. |
| - تروح يا واد.. وإلا أزهم لك العسكري؟ |
| وبذلك راح (علوة) ولم يرح.. لأن أقدامه ساقته إلى دروب طويلة كان لا يعرف وجه الطريق فيها: أما روحه فكان لا يدري أتركها على كثب من مهابط المصنع، أم اصطحبها معه بين متعرجات الدروب الضالة.. ذلك لأن شعوره فقد الفهم والحساسية. |
| وطوى يومه وليلته لأن جيبه لا يحوي ثمن رغيف يُشبعه، ثم أرشد إلى مكان التكية القديمة في المسعى فزاحم حتى نال رغيفاً وشيئاً من (الشوربة) فسدَّ جَوْعته، ثم طوى يومه وليلته حتى ظفر بمثلها في صباح جديد، وظل أمره على ذلك أياماً كان لا يتبلَّغ فيها إلاَّ وجبة واحدة ينالها كل صباح من مبنى التكية. |
| وراودته نفسه بسؤال الناس ولكنه كان يزجرها، ويُحسن الصبر لها لتكفِّر عن أخطائها فيما مضى.. تلك الأخطاء التي كان يشعر في قرارة نفسه أنه لا رأي له فيها. |
| وعوَّل على أن يبحث عن معلمه القديم (أبو فروة)، لعله أن يقبل ضمَّه إلى عماله في البناء ولكنه ما كاد يسأل عنه حتى علم أنه فارق الحياة. وكاد أن يسوقه الحديث إلى السؤال عن زوجه الصالحة، وابنته الجميلة.. ولكنه آثر أن لا ينكأ جروحاً قديمة بذكريات كهذه وأن يبعد ما استطاع عما يشتمُّ فيه روائح الماضي. |
| ووفق له عمل في ذات يوم بين عمال الحجر، ولكن العمال ما فتئوا أن عرفوه فوشوا به.. فلم يتركه صاحب العمل يتمُّ يومه.. فاستأنف البحث عن غيره، وغيره. حتى اشتغل عند سمّان، ونجّار، وحدّاد في أيام غير متعاقبة. فلم يفلح في الدوام عند أحد.. لأن ماضيه الكريه كان يأبى إلاَّ أن يتعقَّبه حيث اتجه. |
| واشتغل خادماً في أحد البيوت فطرده صاحب البيت بعد ساعات من التحاقه عنده، وصادفه تاجر فأْتمنه على شيء من بضاعته يتجول بها ثم علم بعد يومين بأمر ماضيه فلم يقبل بقاءه لديه.. فظل على أمره أياماً طويلة.. ولكن عزمه مع هذا كان قد توطَّن على الجَلَد وآلى ألا ينحرف مهما بلغت به المعاناة. |
| * * * |
| ومضى به الثَّبات إلى غاية طويلة سمع في نهايتها إنساناً يحدثه عن مدينة جدة وسهولة الكسب فيها، فلم يفكر طويلاً فيما سمع، بل اصطحب أول جمّال رآه يغادر جرول إلى طريق جدة، وساير جمَّاله ماشياً على قدميه بعد أن تزوَّد ببعض التمر والعيش. |
| وهداه تفكيره في جدة إلى الاستغناء عن (إحرامه) وثوبه والاكتفاء (بسرواله) فلم يتوانَ فيما فكر.. بل سلمها إلى أول مشترٍ نقده فيهما ثلاثة (مجيديات). |
| وقصد من تَوِّه إلى حلقة الخضار فاشترى بضاعة من الكرّاث بجميع ما يملك ثم انتحى إلى ناحية من الطريق فقسَّمها إلى حزم، وانطلق ينادي في الصباح الباكر معلناً عن بضاعته بصوت عارم أودعه كل آماله في الحياة. |
| وأحصى نقوده في نهاية اليوم فوجد أن مجيدياته أوشكت أن تتضاعف، فشجعه هذا على استئناف العمل، وإضافة شيء من الليمون إلى بضاعة الكرّاث. |
| ودام عمله في الكرّاث والليمون أياماً وجد في نهايتها أن نقوده تتَّسع إلى إضافة نوع أو نوعين، فلم يتلكّأ في المزيد، ولم يبخل بجهده فيه. |
| ووجد مع الأيام زاوية صغيرة تنحرف في رأس زقاق يطل على أحد الشوارع الرئيسة فاحتلها ببضاعته، واستطاع أن يعرض بضاعته فيها على أنظار المارة، وأن يستغني عن التجوُّل، فدرَّ عليه ذلك أخلاف الرزق، وشهد الناس من طيبته وسماحته ما حبَّب إليهم معاملته فكانوا يفضلون قضاء حاجاتهم منه، وجرَّبه أصحاب البيوت القريبة فثبت عندهم حدبه على الصغار الذين يرسلونهم لقضاء ما يحتاجون منه، وبرّهم بأصنافه الطيبة، وتعفُّفه عن الغش والمغالطة، فساروا بسمعته إلى كل من يعرفون حتى بَعُدَ صيته، واشتهر في حيِّه الواسع بمعاملته الصادقة. |
| وتوسعت أعماله بعد عام قضاه في تجارته الجديدة، واستطاع أن يضيف إلى أصنافه حتى تعدَّدت الأنواع في دكانه، وتفاقمت أرباحه. |
| وطالت إقامته في جدة.. أما أصحاب السوابق من الآثمين والمجرمين فكانوا يجدون في بيته الواسع الذي بناه في ضاحية البغدادية مأوىً يلوذون به كلما أحوجتهم الحاجة أو مسَّهم الجوع. |
| وكان أصحاب البيوت المجاورة له في البغدادية يرون عنايته بالأشرار ولا ينكرون ما يرون تقديساً لما شاع عندهم من خلاله العالية، وبرِّه الذي كان لا يقصره على عالم من الناس دون آخر!! |
| وعندما اتَّسع حاله تذكر موطنه الأول في مكة، ونازعه إليه الحنين فاقتنى في بيته دابة خصصها لرحلاته إلى مكة كلما استفزه الشوق إليها. |
| وكان لا يمكث في مكة طويلاً لأنه كان يتحاشى الوجوه القديمة التي تعرف ماضيه، ويحاول ألا يظهر أمام أحد من معارفه هرباً من الفضول. |
| ونازعه الشوق في إحدى روحاته إلى مكة إلى العائلة القديمة التي كان يرسله عمه أبو فروة لخدمتها في البيت، وتذكر عطف سيدة البيت، كما تذكر عيني ابنتها النجلاوين فساقته قدماه إلى دارهما في زقاق الجبل وراء الصفا. |
| وقابلته الفتاة بسرور واضح، وقادته إلى أمها المريضة على سريرها فعلم منها أنهما افتقرا بعد موت عائلهما أبي فروة، وأنهما باتا يخشيان أن يفرق الموت بينهما قبل أن تُبنى الفتاة على شاب يضمن لهما الهناء والسعد. |
| وتراءت له في الحال فكرة خطوبة الفتاة فلم يتردَّد كعادته في حزم الأمور، وتقدَّم إلى الأم في شأن ذلك بعد أن ساق إليها ما جهلت من فصول حياته، وأنبأها بنتائج الظفر التي بلغها، فوافقت الأم ولم تعارض الفتاة فانتقل بهما إلى بيته في جدة وعاش سعيداً معهما. |
| * * * |
| ووقف على دكانه في أحد الأيام زبون كانت أسماله البالية تنمُّ عن فقر مدقع، فلما حقَّق (علوة) فيه النظر، عرف في أسماله زميلاً قديماً من زملاء السجن، فخالجته الشفقة في شأنه، وأبت مروءته أن يتقاضى منه قيمة ما اشترى.. فكان لشفقته رد فعل كلفه ثمناً غالياً في الحياة. |
| وأطال الفقير نظره إلى (علوة) في دهشة المتعجِّب، وحاول أن يعرف في ملامحه شخصية مرت به قبل اليوم، فلم تسعفه الذاكرة. ولكنه أيقن أنه يعرف هذه الملامح، وتمنى إلى (علوة) أن يساعده فيما نَسي. فتخابث عليه وأبى أن يكشف عن شخصيته لزميله القديم حياء من إذاعة سر لا يشرِّفه في محيطه الجديد. |
| وتردَّد الفقير على دكان (علوة) استدراراً لعطفه. فكان (علوة) لا يبخل بعطاياه الطيبة. بصورة أغرت بطول الترداد، واستطاع الفقير بمرور الأيام أن يعرف قصره في البغدادية، كما استطاع أن ينضمَّ إلى بعض البؤساء الذين تشملهم حسنات الدار؛ وتجمعهم مائدته في أكثر الأوقات. |
| وعرف من زملائه حقيقة (علوة) كزميل قديم، فاستغرب أن يواتيه الحظ في مثل هذا اليسر النادر، وكَبُرَ عليه أن تبخل الأيام على مثله بما يغني حاجته إلى الطعام والمأوى.. وتلك أحاسيس تثير الحسد بما في الحسد من مشتقّات. |
| وليس غريباً أن يشعر هذا الصنف من الناس بمثل هذه الأحاسيس المُمِضَّة كنتيجة لحرمانهم وقسوة الناس عليهم، فقد كان (علوة) نفسه يتعذب بمثل هذا المرض قبل أن يصادفه الشيخ، ويُعنى به، ويشفي مركَّب النقص في أعماقه بوسائله العلمية التي أحالته من مجرم آثم يجدِّف على الحياة ويتمنى هلاك من فيها، إلى إنسان جديد.. يتعشق خير الناس؛ وينبض فؤاده بحبهم. |
| ولو صادفت بائسنا الجديد مناسبة تهيَّأ له فيها اختصاصي من أطباء النفوس لاستطاع بوسائله أن ينتزع جرثومة الشر، وأن يبذر في مكانها ما استطاع أن يبذره الشيخ في أعماق (علوة) من بذرة الخير!! |
| فرح الفقير باهتدائه إلى حقيقة (علوة) التي كان يحاول إخفاءها حياء من بيئته الجديدة، فأراد أن يستغل هذا الحياء إلى أبشع حدود الاستغلال.. فواجه (علوة) بما فهم من حقيقته، وأردف بأنه سوف لا يتخلى عن كتم سره! حرصاً على سمعته! ما ظل (علوة) يبره بما يصلح شأنه بين الناس. |
| ولم يأبه (علوة) في أول الأمر بما لوَّح به الفقير، كما أنه لم يمانع في إسداء المعونة إلى إنسان يعاني مثل هذا البؤس.. إلاَّ أن المعونة أبت أن تقف عند نهاية تحدها.. لأن أطماع الفقير كانت تتطور كلما تطورت الأيام.. حتى باتت أقرب إلى الضرائب منها إلى معاني الإحسان، كما تطورت أرقامها إلى مقادير فاحشة. |
| وعندما غضب (علوة) لكرامته، أبى الفقير أن يُداهن عواطفه الثائرة.. فقد كان يشعر أنه يتقاضى أقل مما يستحق ثمناً لصون شهرته مما يشوبها في نظر الناس، وأبى (علوة) أن يعترف باستخذائه لما يضمر الفقير.. فكانت الجفوة، وكان الكره.. ورؤي الفقير بعدها يولي ظهره إلى (علوة) وقد لاحت على محيّاه معاني الغدر الذميم!! |
| وشاعت في جدة على أثر هذه الحوادث قصة أرملة غنية.. سطا عليها أحد اللصوص فاغتالها، ثم سرق مدَّخراتها من المال، والنفائس، دون أن يترك وراءه أثراً ينمُّ عليه. فنشط رجال المباحث في البوليس للتحقيق في الحادث.. فلم يتبيَّنوا ما يُنير لهم التحقيق، فاستاء قومسير الجندرمة، وأعلن بين مشايخ الحارات ووكلائهم عن مكافأة سخية لمن يُرشد إلى ما يضيء التحقيق. |
| وفي ذات مساء، استأذن الفقير على قومسير البوليس.. فلما أذن له، قصَّ عليه ماضي (علوة)، وما كان يشوبه من شوائب.. ثم قال "وهو اليوم يرأس عصابة من أخطر اللصوص يسرقون ما تناله أيديهم ثم يأوون إلى بيته.. ليقسِّم بينهم ما سرقوا، ويحتفظ لنفسه بالنصيب الأوفر وقد حاورني أحدهم للانضمام إلى عصابتهم فأبيْت، وأخبرني هذا عن حكاية سطوهم على الأرملة، واغتيالها، وسرقة مدَّخراتها من حلي ومتاع، ونقله إلى بيت (علوة) توطى لاقتسامه.. وفي استطاعة حضرة القومسير أن يتأكد من حقيقة (علوة) التي أرويها في دفاتر البوليس في مكة، وأن يأمر بمهاجمة البيت ليجد متاع الأرملة مختبئاً في أي مكان خفي منه! |
| ولم يتسرَّع قومسير البوليس قبل أن يتحقَّق من شخصية (علوة)، فاستدعى شيخ حارته ليتعرَّف منه على هويته بصورة سرية.. إلاَّ أن شيخ الحارة خيَّب جميع الظنون التي خامرت القومسير في شخص (علوة)، وأكد تأكيداً لا يقبل الجدل: أن (علوة) مثل نادر للاستقامة والشرف، وأن مبالغته في الإحسان إلى المعوزين، وفيهم المتشرد والآثم وإفساح بيته لإيوائهم، هي عيبه الوحيد إذا صح أن في الإحسان عيباً. |
| وأظهر القومسير لشيخ الحارة مبلغ اقتناعه بما زكّى به (علوة)، بعد أن حذَّره شديد الحذر من إفشاء حرف واحد مما سمع، فخرج شيخ الحارة مطمئناً إلى نتيجة ما دافع به، ولم يبح لنفسه أن يفشي شيئاً مما حدث براً بما وعد. |
| وانتدب القومسير بعد هذا من تحرّى حقيقة (علوة) في دفاتر البوليس بمكة.. فانتهت إليه النتائج بأنه لص سابق تعود الإجرام، وأنه غافل الحراس في إحدى المرات وهرب من السجن ضمن عصابة من زملائه، يرأسهم (أمين الجاوي) المشهور بجرائمه في مكة. |
| انتهت هذه النتائج إلى بوليس جدة، وليس في منطق البوليس من أي لون كان أن يصيخ إلى غير ما تنطق به صحائف السوابق.. لأن توبة المجرم فصل لم يدرَج إلى اليوم في قواميس البوليس. |
| وفي ذات أمسية من أمسيات جدة المشرقة بإشراقة القمة الساطع وكان (علوة) قد ارتفق حافة نافذته المطلة على البحر المترامي، يشرف منها على الأمواج اللامعة تحت ضوء القمر، فاجأه دخول أحد الخدم: |
| "عمي.. يا عمي (علوة).. إن فلاناً الفقير أسرَّ إلى عم جمال الطباخ بأنه رماك عند البوليس بتهمة القتل، وأن البوليس لا يلبث أن يقبض عليك". |
| - طيب روح انفلق أنت وهو. |
| وقبل أن يروح الخادم (لينفلق)، ترامى إلى سمع (علوة) دمدمة خافتة وصلت إليه من النوافذ الخلفية المطلة على باب القصر، فأسرع إلى النافذة يستوضح الأمر. |
| * * * |
| قال الخادم يحدث طباخ القصر، بعد أن استولى البوليس على ما في القصر رهن التحقيق، وطرد منه جميع الخدم. |
| - (والله يا عم جمال.. أنا شفت عمي (علوة) وهو يجري إلى المخلوان في الساعة اللي كان البوليس بيهاجم فيها القصر.. ولكن فين راح بعدها ما أدري.. فص ملح وداب.. دخل البوليس إلى كل غرفة فلم يجد له أثراً، ودخل حتى في المخلوان فلم يجد له أثراً.. ما أدري إن كان له باب سري خرج منه.. لكن فين هذا الباب السري؟ ما أدري.. ما فهمته أنا ولا قدر البوليس يفهمه. |
| * * * |
| وبذلك أُسدل الستار على الرجل التائب، وضاع في غمرات الحياة كضحية لما نسميه (صفحات السوابق). |
| ورؤي (علوة) بعد سنوات من الحادث في مدينة من جزر جاوا، يصاحب أستاذه القديم (أمين الجاوي)، الذي علمه بعض فنون اللصوصية في السجن!! فهل عاد سيرته الأولى؟؟ |
| - إذا صح هذا فمن المسؤول؟؟ |
|
|
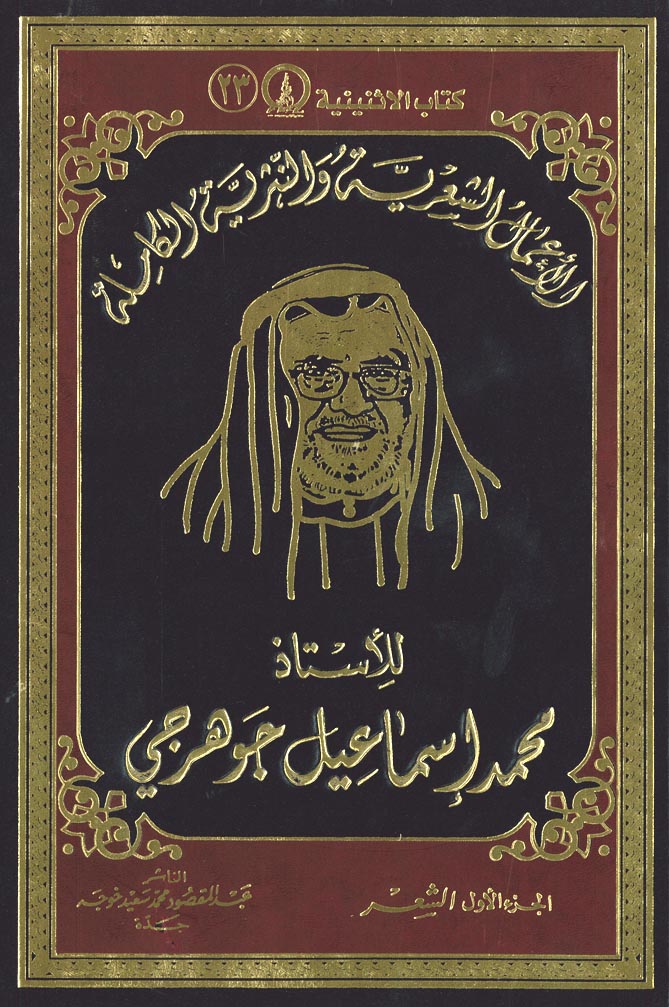
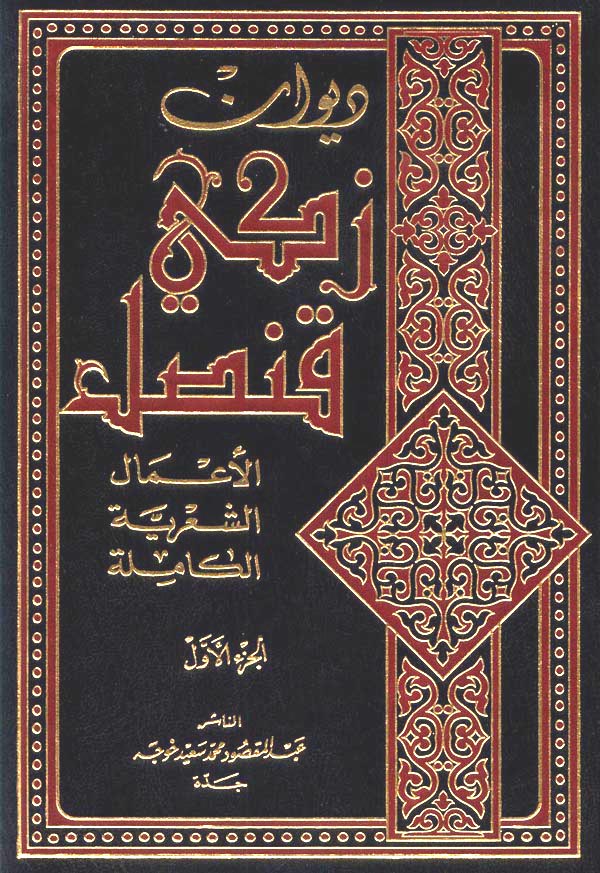
 شارع عبد المقصود خوجة
شارع عبد المقصود خوجة 00966-12-6982222 - تحويلة 250
00966-12-6982222 - تحويلة 250





