| موت خالتي الحبيبة |
| وصباحٌ ثانٍ، لا أكاد أذكره اليوم، بعد الترحال الطويل في دروب الحياة بكل ما نطويه ونجتازه فيها من فلَوات ومفاوز وآجام، بل ومن أدغال يراوغنا فيها المجهول الذي يظل متحفزاً لا ندري من أين... ومتى يطيب له أن يمارس لعبة العبث بالمصير... لا أكاد أذكر ذلك الصباح، إلا وفي الأغوار البعيدة من النفس إحساس لم يغْفُ قط، بأن الحب هو وحده الينبوعُ الذي كان ومايزال يروي دَوْحَ المشاعر والعواطف النبيلة، ومنها الحزنُ الذي توغل له الجذور في الأعماق وتمتد، وتتكاثر له، وتتواشجّ الفروع والأغصان، في آفاق المسيرة مهما طالت وترامت الدروب. |
| في ذلك الصباح، لم يوقظني أحد، بل لعلّ أمّي وجدّي كانا يحرصان على ألا اتنبّه فضلا عن أن استيقظ.. ولكن الهمس بينهما وتلاحق الأنفاس اللاهثة تنفلت لها النأمة فتُسمع رغم محاولةِ الكبت، نبّهتْني ففتحت عينّي، ولعّلي قد التفتُّ صوبَ هذا الهمس لأرى جدّي وأمّي يقفان إلى جانب سرير خالتي مما يلي الرأس... ولم يطل بي الوقت لَتِكرَّ على ذهني النعسان نفس الصورة التي غلبني النوم في الليلة البارحة، وأنا أتأمّلها... خالتي في سريرها الصغير من النحاس الأصفر اللامع، وحولها جدي وأمي، وتلك العجوز (لتافت باجي) التي لم أرها في هذه اللحظات من الصباح، الباكر... أرهفتُ السمع، للهمس بين جدي وأمي، ولكني لم أفهم شيئا إذْ كانا يتحدثان باللغة التركية... |
| ومرةً أخرى، وجدتُ نفسي أتساءل... ما هي المسألة؟؟؟ ما الذي حدث؟؟ أعلم، دون شك، أن خالتي تعاني من هذا السعال، ولم أنسَ كيف أسرع جدي يحملها من المقعد الذي كانت تجلس عليه في تلك الغرفة المترفة من منزل (لتافت باجي) ومشى بها مسرعا إلى هذا السرير... وأعلم كذلك، أن أمّي تحرص على أن تعطيها أكثر من نوعٍ من الأدوية التي يجيء بها جدي مع تلك الأغذية، التي كان يتكلّف الحصول عليها من السوق القريبة من دكانه بالقرب من (السرايا)... والتي كثيرا ما يعود متوترا، إما لانه لم يجد ما يحتاجه في تلك السوق، وإما لأن المبلغ الذي تجمَّع لديه من حَفْرِ الأختام لم يكن كافياً لشراء ما يريد. ولكنّها البارحة بعد أن استراحت على السرير، أذكر أنها سألتْ عني، وأني أسرعت إليها فسألتني عن (البستان)، والخبّيزة، وعن الورد، والزهر الأصفر الذي قلت لها أنه كثير جدا في ذلك البستان... بل أذكر أنها طلبت من أمي أن تأذنَ لي بالذهاب لأجيئها بهذا الزهر... ثم ـ وهذا هو الذي لم أنْسَه ـ لقد رأيتها تبتسم... بل وتضحك ضحكتهَا الخفيفة الخافتة فما هي المسألة في هذا الصباح؟؟؟ وما الذي حدث أو يحدث؟؟؟ كنت ما أزال مستلقيا في فراشي في تلك الزاوية من الغرفة، وكانت أشعة الشمس الشاحبة قد أخذت طريقها عبر تلك النافذة إلى هذه الزاوية بالذات أرأيت وجه جدي واضحا الآن، وهو يلتفت إلى أمّي بجانبه... وعلى الأرض كانت السجادة التي يصلّي عليها في غرفته... فما الذي جعله يجيء بها إلى هذه الغرفة؟؟؟ قال لها شيئا واستدار يتجه إلى الباب... وتحت إبْطِه المصحف الصغير... وفي كفّه منديله الأبيض الكبير الذي يجّفف به عرقه في العادة... لم يكن مقطبا أو عاقداً ما بين حاجبيه الكثين كما يكون حين يستبد به الغضب والتوتر... على العكس من ذلك كان هذان الحاجبان قد ارتفعا إلى أعلى في جبهته العريضة تحت (الطاقية) البيضاء... رأيته يمسح بالمنديل عينيه ووجهه... كان يبكي دون أدنى شك... جلست، ثم أخذت أنهضُ، قبل أن يخرج من باب الغرفة، فما كاد يلحَظُني حتى توقف، واستدار نحو أمي التي رأيتُها تنحني على خالتي في سريرها وتجهش بالكباء. بدا كأنّه قد يئس من أن يمنعها عن البكاء، فالتفت إليّ، ومد يده.. وهي الحركة التي أفهم منها، أن أضع يدي في كفه لنمشي معا إلى حيث يريد. |
| ولكني لم أضع يدي في كفه، وإنما اتجهت إلى أمّي التي كانت تدفِنُ وجهها بين كفيها على صدر خالتي... ذُهلتُ حين لم أرَ وجه خالتي، ولم تبد منها حركة رغم أن جسم أمي كان يهتز مع النشيج الذي لم تنقطع عنه... كان وجهها... رأسها كلّه تحت ذلك الغطاء، وردىّ اللون، على الوسادة المؤطَّرة بالدانتيلا... |
| تهيبّت أن أرفع الغطاء عن وجهها، فهي على الأرجح مستغرقة في نوم عميق وعندي الكفاية من التحذير بأن أتوخَّى عدم ازعاجها إذا كانت نائمة... ولكن هذا البكاء وهذه الحركة على صدرها كيف لا توقظها؟؟؟ وفجأة أحسست كأن قلبي يغوص، بل أحسست كأني أنا نفسي أسقط في هاوية بعيدة القرار... يبدو أن جدّي قد أدرك ما أعانيه، إذ وجدت نفسي بين ذراعيه، على صدره، يحملني ويخرج بي من الغرفة، ولم أشعر بنفسي إلا وأنا مضطجُعُ على الأرض في تلك الغرفة من منزل (لتافت باجي) وأسمع جدي يحادث العجوز التي كانت هي أيضا تبكي بحرقة... وتقول له كلاما رجّحت أنه وعد بألا تسمح لي بالخروج... وما كاد يغادر الغرفة، حتى ارتفع صوتي بعويل، لعلّي لم أعهده من نفسي قط... شرعت العجوز تحاول أن تضع رأسي في حضنها وهي جالسة إلى جانبي على الأرض، ومع بكائها وصوتها المرتعش أخذتْ تردد كلمات التدليل... نفس الكلمات، التي كانت تدلل بها خالتي.. |
| لم أكن، بطبيعة الحال، أحتاج إلى فطنة أو ذكاء، لاسّتوعب فكرة أن خالتي قد ماتت، كما مات قبلها رضيعُها عبد المعين، وشقيقي عبد الغفور... وكما يموت هؤلاء الذين تلتقطهم عربات نقل الموتى من الشوارع والطرقات... وفي اللحظات التي كنت أرفع فيها صوتي بذلك العويل الصارخ، وأسمع كلمات التدليل، ترددها (لتافت باجي)، تحاول أن تُدَهّدِه عني الإحساس بالفجيعة، كان يلح على ذهني هاجسُ اصرارٍ غريب على رفض الواقع برمّته... كان هذا الهاجس، يحفزني على أن أصرخ، في وجه هذه العجوز، بل وفي وجه جدّي وأمّي... وأقول لهم... لا... لا... أبداً. خالتي خديجي لم تمتْ كما مات عبد الغفور وعبد المعين... خالتي لا يمكن... أبداً لا يمكن أن يأخذها جدّي إلى (المقبرة) كما سبق له أن أخذ عبد الغفور وعبد المعين... لا... أبداً وهنا تعصف بذهني، وتصعقُني فكرةُ أنها ستدفن... خالتي أيضا تدفن كما يدفِنون الموتى في تلك الحفر؟؟؟ ويهيلون عليها التراب؟؟؟ ثم تظل هناك، لا تستطيع أن تعود إلينا... كما ظل عبد الغفور وعبد المعين... فلم يخطر لهما أن يطلبا العودة إلى أحضان أمهاتهم؟؟؟ ـ. |
| ولا أكاد أستوعب هذه الصورة بكل بشاعتها وهولها، حتى وجدت نفسي أنهض عن الأرض وانفلت من يَدَيْ (لتافت باجي)، وما أسرع ما وصلت إلى الباب الذي نخرج منه إلى منزلنا قبل أن تتحرك العجوز، وتتناول عكازها... ولكن البابَ كان مغلقا... ومع العويل الصارخ أخذت أضربُ الباب بقبضتْي يدي الاثنتين، ضرباتٍ متوالية سريعة، يدهشني اليوم، بعد هذا التجوال الطويل في مسيرة العمر، أني مارست تلك الحركة العاصفة، في تلك السن. |
| ولست أدري، كيف أخذت أناديها؟؟؟ بلى... أناديها هي... هي خالتي.. خالتي... وحين رأيتُ (لتافت باجي) تتقدم بعكازها، وقد سقطت عن عينيها نظارتها البيضاء لتستقر تحت أنفها المفلطح الأفطس، والدموع تملأ وجهها... انقض على قلبي رعب ساحق... فأخذت أصرخ مستنجدا بها... بخالتي التي تعودت أن استنجد بها، فتحميني، تضمني إلى صدرها بين ذراعيها..: (تعالي قوام يا خالتي.. افتحي لي الباب... يا خالتي قوام... قوام... قوام..) |
| ولكن (لتافت باجي) كانت قد اقتربت مني يسبقها نشيجُها، وعباراتُ التدليل والهدهدة تتعثر وتتهاوى في حنجرتها المختنقة بالنشيج وبصوتها المرتعش... أدركت عدم جدوى محاولة الخروج من الباب، فارتميت على الأرض منكفئا بوجهي إليها على ذراعيّ. ظللتُ أبكي بصمت.. وظلّت (لتافت باجي) واقفة، ربما، حائرةً لا تدري كيف تتصرف وكل ما يسعها أن تفعله، هو بكاؤُها الذي لا ينقطع، وعبارات التدليل، ولكن... هذه خطوات مسرعة، وحركة أسمعها آتيةً من منزلنا وراء الباب المغلق.. وقد سمعتْها العجوز ايضا فالتزمت الصمت لتُنْصِت... رفعت رأسي عن الأرض، ثم جلست وفي حسباني ـ أنهم ـ هناك قد سمعوا صراخي فجاء جدي ليأخذني إليها... إلى خالتي.. ولست أدري كيف امحّت عن ذهني تماما حقيقة أنها ماتت... كان يقيني في هذه اللحظة أنها قد استيقظت من نومها وسمعتني استنجدُ بها، وهي التي طلبت من جدي أن يأخذني إليها. |
| ولكنّها لحظات قصيرة... إذ تلاشى وابتعد وقع الخطوات... وساد الصمت.. غير أن لم أيأس... ظللت أتوقع أن أسمع تلك الخطوات تقترب... ولكن دون جدوى.. فقد عادت العجوز إلى تنهداتها، ثم جلست إلى جانبي ووضعت يدَها على كتفي، وجعلت تتوسّل إليّ بعربيتها السورية المكسَّرة، أن انهض معها، فالباب مغلق ولا يستطيع أن يفتحه أحد إلا جدِّي... ثم لا أدري كيف خطر لها أن تَعِدَني بأن تخرج بي من (باب الزقاق)، ونستطيع أن ندخل منزلنا من (باب الزقاق) أيضا... وأدخلت يدها المرتعشة في جيب على جانب من بطنها، لتخرج مجموعة من المفاتيح، تؤكد لي وهي ترفعها أمام عينّي أن عندها مفتاح باب بيتنا... اقتنعت أنها جادّة فنهضتُ ووقفتُ، بينما تناولت هي عكازَها ونهضت وأخذت تمشي ويدها اليسرى على كتفي وقبل أن نصل إلى تلك الغرفة المترفة التي غادرناها البارحة، استدارت لنجتاز معا باباً صغيرا إلى غرفة رحبة في صدرها سرير بفراش وثير... أدركت أنها غرفة نومها... اجلستني على مقعد بالقرب من السرير وهي تمسح رأسي، وتقول أنها (ترجوني) ـ هكذا ـ أن آذن لها أن تتوضأ لتصلّي... ثم أخذت تدب إلى باب صغير هناك، غابت خلفه، وعادت بعد لحظات تطل، وفي يدها مشنقة مبلّلة، أخذت تمسح بها وجهي وعنقي... ثم ذهبت لتتوضأ كما قالت |
| أحسست، في مجلسي على المقعد، بحاجة إلى الإستلقاء. وترامت إلى سمعي أصوات أطفال رجَّحتُ أنها أصوات أولئك الأطفال الذين ذهبتُ معهم إلى (البستان) وعدت بالخبيزة وأخبار الأزهار الصفراء التي تمنّت خالتي البارحة أن تأذن لي أمي أن أذهب لآتيها بها.. خطر لي، والعجوز ماتزال غائبة، أن أتسلل إلى (باب الزقاق)، وأن الحق بالأطفال في رحلتهم إلى ذلك البستان... وأن أملأ الثوب الذي أُلفُّ ذيلَه على خاصرتي، ليس بالخبيزة وانما بتلك الأزهار الصفراء، وأيضا بأي زهرة من أي لون... فإذا عدت بها، أضعها كلها بين يديها... حتى لو غضبت أمّي وأرادت أن تضربني أو أن تحسبني مع الفيران، فأن خالتي تستطيع أن تشفعَ لي... ولكن كيف الوصول إلى باب الزقاق؟؟؟ لم أكن أعرف شيئا عن منزل (لتافت باجي)... وعادت أصوات الأطفال تترامى إلى سمعي، ومع هذه الأمّاني في نفسي اشتد احساسي بالحاجة إلى الأستلقاء، ولم تظهر العجوز من مكمنها وراء ذلك الباب الذي دخلته لتتوضأ... تَهيَّبتُ أن أستلقي على فراشها الوثير... ولكن قبل أن أتزحزح عن المقعد الذي أجلستني عليه، رأيتها مقبلة تحمل طببقاً وضعته على منضدة أمامها... وأخذت تدعوني لآكل... ولكن يبدو أنها تنبّهت إلى أني أغالبُ النعاس... فأسرعت تردد عبارات التدليل المألوفة بنبرةٍ فيها شحنة كبيرة من الاشفاق والعطف... ثم عندما وقفت أمامي، تناولت يدي ومشت بي خطوة إلى الفراش. |
| * * * |
| استيقظت لأرى جدّي إلى جانب (لتافت باجي)... وكان الذي أيقظني هو جدّي إذ يبدو أنه كان يَهُمٌّ بحملي، وقد أدركت ذلك حين أحسست بيده توضع تحت عنقي في. الفراش الذي كنت أنام عليه... وانقضت فترة، قبل أن استجمع ذاكرتي وأدرك أو أتذكر ما مرّ بنا من الاحداث... أسرعت أجلس، وأتأهب للمشي. وحين رفعت نظري إلى وجه جدّي رأيت عينيه محمَرتين ولكنّه يحاول أن يبدو هادئا بابتسامة خفيفة لا تكاد تظهر. أمّا (لتافت باجي) وهي تقف إلى جانبه، فقد كانت ماتزال دامعةَ العينين... استوعبت في هذه اللحظة الموقف برمّته... وحين مدَّ جدي يدَه، أسلمتُه يدي، كما هي العادة، ومشينا معا، إلى منزلنا. وبعد اجتياز الممر الصغير، كان في ذهني أن ندخل غرفة خالتي، ولكن جدي اتجه نحو غرفته التي وجدت فيها أمّي قابعةً فيها على المرتبة التي كانت تنام عليها في غرفة خالتي... لم يسبق أن رأيتها كما أراها الآن... شعرها منكوش،... ووجهها محمر محتقن... وماكادت تراني أدخل، متقدماً جدي، حتى انخرطت في البكاء... مدّت ذراعيها فأسرعت إليها وارتميت على صدرها... وقال جدي، بالتركية، ما فهمت منه أن (لتافت باجي) أخبرته أني لم آكل شيئا حتى الآن... وأضاف: وهو يتناول الكيس الذي يضع فيه مشترياته الصغيرة: من الأغذية. |
| :ـ. أصلّي العصر... وانتي وعبد العزيز تأكلوا... |
| ولم أجرؤ أبداً في تلك اللحظة أن أسأل عن خالتي... أين هي؟؟؟ وكرّت على ذهني مشاهد عربات نقل الموتى... وأولئك الذين يسقطون في الشارع وتلتقطهم هذه العربات... ثم عبد الغفور وعبد المعين، اللذين أخذهما جدي إلى (المقبرة)... أيقنت الآن أنّه نقلها هي أيضا إلى تلك المقبرة... أحسست كان الدم يجمد في عروقي حين تصوّرت أنها هي أيضا قد دفنت وأهيل عليها التراب... |
| واليوم... بعد هذا الترحال الطويل في دروب الحياة... وأنا أكتب هذه المذكرات أو الذكريات، تزدحم في القاع السحيق من أغوار النفس، الكثير من مشاعر الحزن والأسى ومشاهد الفجائع والحسرات، ولكن هذا الحزن الذي أطبق على قلبي يوم ماتت تلك الخالة الحبيبة، كان هو أولَ الأحزان وأبعدَها أثرا وتأثيراً في النفس... لأنّه كان الحزن الذي ارتوى من ينبوع الحب الخالد، فامتدت له الجذور في الأعماق، والفروع والأغصان في الآفاق... لانه كان الحزن على حبيب... لا أجد ما يمنع أن أقول أنه أول حب وأول حبيب. |
| * * * |
|
|
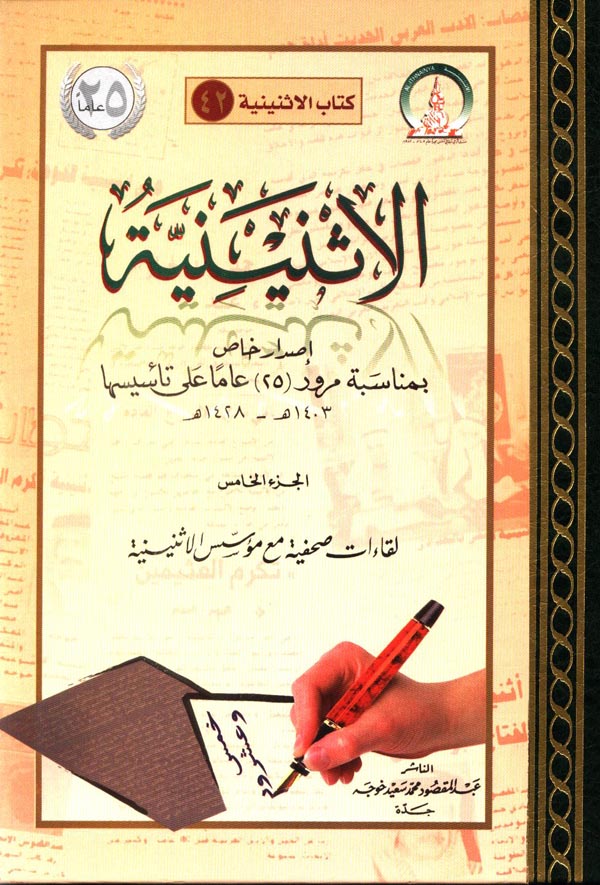
 شارع عبد المقصود خوجة
شارع عبد المقصود خوجة 00966-12-6982222 - تحويلة 250
00966-12-6982222 - تحويلة 250




