| تحكم القافية وسلطانها في الشعر العربي |
| وأجد نفسي أعايش هاجس القافية في الشعر العربي، منذ فرغت من كتابة كلمة في حصاد الأسبوع الماضي عن شعر الصديق الشاعر الأستاذ حسن عبد الله القرشي، وأثر تحكم القافية وسلطانها في استلاب نسبة كبيرة من روح الشعر وإشعاعه ونبضه، فيما قرأت من قصائد ديوانه الجديد: (رحيل القوافل الضالة). |
| وقد تغريني معايشة هذا الهاجس بأن أرى أن سلطان القافية في الشعر العربي خليق بأن تلتفت إليه دراسات النقد، التفاتة فيها التخصص والتوسع، اللذان يمكن أن ينقضا الكثير من أحكام الضعف، والهزال أو الشحوب، التي نصدرها أو أصدرها النقاد على الكثير المتراكم من الشعر العربي، القديم والحديث على السواء. وذلك لأنّي في تجربتي مع شعر فريق من الشعراء المعاصرين في المملكة، ومنهم القرشي، وقبله طاهر الزمخشري رحمه الله، وحتى العواد، وهاشم رشيد، وغيرهم، واجهت دائماً كيف تعصف القافية في عجز البيت بالإشراق ونبض الشعر وروحه في صدره.. ولعلّي أسرف قليلاً على نفسي إذا ذهبت إلى أن هذا التحكم والسلطان اللذين تمارسهما القافية على الشعراء الذين أصبحنا نسمّيهم (تقليديين)، أو (عموديين)، هما - وليس الوزن بتفعيلاته - من الأسباب التي عملت على إفراز الشعر الحديث، الذي عادى تعنُّت وتسلُّط القافية، فأخذ يتمرد، ثم أسرف في التمرد إلى هذا الحد الذي استفز مشاعر أولئك الذين توهّموا أن التمرد استهدف أو يستهدف (التراث)، وهم ينظرون إلى (التراث) متوجًّا بالقرآن الذي سبق أن قلت، ولا أزال أقول، إنه ليس تراثاً، بل لا يصح أن نطلق عليه هذا اللفظ، لأن لفظ التراث إنما يطلق على إرث الميت، والقرآن كلام الله الحي الذي لا يموت. |
| ولعلّ من أهم الحقائق التي تغيب عن أذهان عامة المثقفين اليوم أن (القافية) لا علاقة لها بالعروض وقوانينه وأوزانه وبحوره التي وضعها الخليل، وعالج عناصر بنائها ابتداء من السبب والوتد والفاصلة، وما يكوّن كلاً من هذه من (الضرب) عدداً، وانتهاءً عندما أصبح لا نهاية له اليوم، من محاولات إضافةٍ إلى التفعيلات، أو إنقاص واختصار منها فيما حملته موجة التجديد من تطلع شعراء زعموا، ولا يزالون يزعمون أن هذا العبث بعدد التفعيلات، وحركاتها، تطرح ما افتتنوا به من الرغبة في التجديد أو هو التمرد على التراث تحت مظلة التجديد. |
| وأجد (نازك الملائكة) تقول في كتابها (قضايا الشعر المعاصر): (إن القافية بقيت ((ملكة)) تتحكم في الشعر، فلم يخرج عنها شاعر معروف، ومضى ذلك حتى السنوات الأخيرة بعد قيام حركة الشعر الحر، واستسلام الشعراء الشباب لها (حركة الشعر الحر) بلا تريّث ولا تمحيص) ثم تضيف: (فلقد بدأنا مؤخراً نقرأ قصائد لا قافية لها على الاطلاق، وارتفعت أصوات غير قليلة تنادي بنبذ القافية نبذاً تاماً). |
| ونازك تجيد الإنجليزية إجادة عالية، واطلاعها على الأدب الإنجليزي والشعر منه على الأخص، اطلاع متعمّق ومنهجي، ومن هنا تقدم لنا معلومة جديرة بأن يعيها الذين يلاحقون موجة الشعر الحر الذي ينبذ القافية، كلّما اعتقلت أداءه مشكلتُها. وتقول نازك: (كان هذا صدى للشعر الغربي، وهو قد عرف الشعر المرسل الذي يخلو من القافية منذ مسرح (شكسبير). فقد كان هذا الشاعر الكبير يكتب شعراً بلا قافية في الغالب، فلا يأتي بقافية إلا في خاتمة الفصل إيذاناً بانتهائه). وتضيف: (والشعر الغربي اليوم أغلبه بلا قافية.. ومن هنا جاءتنا الفكرةُ فاستجاب لها بعض الشباب ومضوا في تطبيقها) ثم تعلّق قائلة: (على أننا لا نملك إلا أن نلاحظ أن الذين ينادون اليوم بنبذ القافية هم غالباً الشعراء الذين يرتكبون الأخطاء النحوية واللغوية، والعروضية الشنيعة). |
| ونحن نفهم من التعليق أنها من أنصار القافية، وأنها تأخذ على الشعراء الشباب ظاهرة رفض القافية أو الاستغناء عنها أو نبذها، كأنها تدعو إلى التزامها، ولا ترى - مع ذلك - ما يمنع التنويع، بحيث لا بأس عندها بالثنائيات، والرباعيات، وتستشهد بالموشح و (البند) وفنون الشعر الشعبي. |
| وليس لأحد أن يصادر رأيها، ولكن إذا كانت تسلّم بأن القافية (بقيت ((ملكة)) الشعر تتحكم فيه فلم يخرج عنها شاعر معروف)، فإن من الحقائق التي تفرض منطقها أن القافية بتحكمها وسلطانها على الشعر العربي، كانت مسؤولة إلى حد كبير عن الهبوط بما قد يتوافر أو يتاح للشاعر من نبض الإبداع في (الصدور) من أبيات القصيدة عندما تتحكم فيه القافية في (الأعجاز) منها. وبيت المتنبي المتداول الذي يفخر فيه بشاعريته، ويبرهن به المفتونون بشعره على عظمته، ويقول فيه: |
| أنام ملء جفوني عن شواردها |
| ويسهر الخلق جرّاها ويختصم |
|
| أرجح أنه أراد بهذه الشوارد، (القوافي) وليس الكلمات، أو القصائد كما يذهب بعض الشرّاح، لأنّ الكلمات إن لم تكن مبذولة كالمعاني فيما يرى الجاحظ، فإنها متراكمة في محفوظ الشعراء من الشعر في تلك الأيام.. وفي ذلك دليل على أن تحكم القافية وسلطانها هو ما كان (يسهر الشعراء جرّاها)، وأن قدرة الشاعر على التخلص أو الانتصار على هذا التحكم (الشرس) هو الذي يميّزه عن غيره من شعراء جيله أو غير جيله في ساحة الشعر. |
| ومع أن القافية ظلّت تتحكم في الشاعر، وهي لا تزال تفعل، كما نرى ذلك في شعر القرشي - على سبيل المثال - فإن المعركة بينها وبين أكابر الشعراء القدماء لم تحسم (إلاّ بطول التفتيش وإعادة النظر بعد النظر، بحيث جاز للأصمعي أن يقول (زهير والحطيئة وأشباههما من الشعراء (عبيد الشعر)، لأنهم نقَّحوه، ولم يذهبوا فيه مذهب المطبوعين). وكان الحطيئة يقول: (خير الشعر ((الحولي)) المنقَّح، المحكّك).. وكان زهير يسمي كبر قصائده (الحوليات). ويقول سويد بن كراع (يذكر تنقيحه شعره): |
| أبيت بأبواب القوافي كأنما |
| أصادي بها سرباً من الوحش نزّعا |
| أكالئها حتى أعرّس بعد ما |
| يكون سحيراً أو يعيد فأهجعا |
|
| فإذا كان هذا حال أكابر الشعراء القدامى مع القافية، فعذر المحدثين قائم لا يرفض ولكن مشكلتهم (وأعني المحدثين) أنهم كسالى، يتعجّلون نظم أبيات القصيدة، فتكون نتيجة المعركة انتصار القافية عليهم، في غالب الأحيان، وهذا رغم أن ما يلهمونه - أحياناً - من المعاني الرائعة، المنتزعة من الحياة المعاصرة، في (صدور) أبيات القصيدة، يمكن أن يحتفظ بروعته وجماله لو أن القافية لم تتحكم لتهبط بالأعجاز إلى القاع، بعد أن كان المتوقع للمعنى الجميل أن يظل في السماك. |
| والمعركة بين الشاعر والقافية مغرقة في التاريخ، وقد ظلّت قائمة محتدمة في جميع العصور، وحتى هذا العصر. ولكن الفرق بين الشعراء القدامى، وشعرائنا اليوم، أن القدامى كانوا كثيراً ما يربحون المعركة، إذ يغلب على ما اختزنته كتب وموسوعات التراث من شعر أولئك الشعراء ظاهرة (التمكن) من مشكلة القافية رغم الكثير من عقدها، وعلى الأخص من هذه العقد، عقدة (الرَّوي)، التي بلغ من جبروتها أن قالوا: (لا قافية بلا رَوِي). ويقرر أبو العلاء المعرّي في شرحه المطوّل العلمي الرائع، في مقدمته للزومياته قائلاً: (أمّا الرَّوي فأثبت حروف البيت).. وعرّفوا الروي بأنه من (الروية) وهي الفكرة، لأن الشاعر يتفكر فيه.. وقيل إنه من (الرواء) وهو الحبل الذي يُضم به شيءٌ إلى شيء.. إذ هو (أي الرَّوي) يضم أجزاء البيت، ويصل بعضها ببعض. ثم قالوا (جميع حروف المعجم يصح أن تكون رويّا إلا سبعة أحرف في مواضع).. فإذا شرحوا مواضع هذه الأحرف السبعة، فحدّث عن التفاصيل ولا حرج.. ثم هناك (منازل الرَّوي) وهي ثلاثة.. وما أشد تعقيد التفاصيل التي تجيء عن (ألف التأسيس) في الروي الخ.. الخ.. ثم يقف أبو العلاء عند ما يسمّى (الإشباع) ويذكر لنا أن الذين وضعوا كتب (القوافي) توسّعوا في هذا الإشباع حتى جعلوه (حركة ما قبل الروي). |
| وحين نجد أن القافية علم مستقل بذاته، وقد تفرّغ للتأليف عنها علماء أجلاء منهم القدماء، أمثال (المبرد) في كتابه: (القوافي وما اشتقت ألقابها منه) تحقيق الدكتور رمضان عبد التواب، و (أبو يعلى) في كتابه (القوافي) تحقيق الدكتور عوني عبد الرؤوف. و (التبريزي) في كتابه (الكافي في العروض والقوافي). ومنهم المعاصرون أمثال الدكتور عوني عبد الرؤوف بكتابه: (القافية والأصوات اللغوية).. فإن ما بدا لي أنه جدير بالتساؤل هو ما إذا كان الخليل قد عالج القافية، ووضع لها التعاريف، وما يعتبر قواعد وأُسُساً هي التي توسّع في شرحها واستقصاء متعلقاتها العلماء، أم أنه تجاوزها، واكتفى بوضع قوانين (العروض) في بحوره وأوزانه التي قالوا إنها خمسة عشر بحراً، وإن الأخفش أضاف البحر السادس عشر وهو (المتدارك). وما يجعلني أقف مع هذا التساؤل وأجد الجرأة على طرحه، هو (كتاب العروض) تأليف أبي الفتح عثمان بن جني الذي حققه الدكتور حسن شاذلي فرهود، من أعلام الأكاديميين في المملكة. وتم طبعه في مطابع دار القلم - بيروت. إذ ليس في هذا الكتاب أية إشارة إلى القافية، فضلاً عن التفاصيل الكثيرة والطويلة والمعقدة التي نجدها في مقدمة أبي العلاء للزومياته.. والكتاب يحمل عنواناً لا بد أن نفهم منه أن ما بين دفتيه هو (علم العروض) كما وضعه الخليل، وليس جزءاً منه أو فصلاً من فصوله، وحتى في المقدمة التي كتبها الدكتور فرهود لا نجد ما يشير إلى أن كتاب ابن جني هذا بعنوانه (علم العروض) جزء من (كُل)، باستثناء إشارة عابرة ومختصرة عن الأسماء المختلفة التي ذكرتها المصادر والمراجع لكتاب ابن جني هذا حيث يقول: (ذكره ابن الأنباري باسم ((العروض)). وذكره القفطي تحت عنوان (مختصر العروض) وذكره جرجي زيدان وقال: (هو مختصر لطيف في برلين وفيينا وليدن)). وليس مما يتفق أن يكون (كتاب العروض) مختصراً من العلم الذي وضعه الخليل، وأن يصل الاختصار إلى حد إسقاط (علم القافية)، أو (القافية) إطلاقاً وبدون أية إشارة أو تنبيه من المؤلف العلَم الكبير (ابن جنّي) ولا من المحقق الدكتور فرهود. |
| ومع ذلك فإن أبا العلاء المعري في مقدمته للزومياته، وفي المعلومات الضافية عن القافية يشير، في كلامه عن (الإشباع) من الحركات، عن حرف يسمّى (الدخيل) إلى أنه (يقال) (إن الخليل لم يذكر الإشباع، وإن سعيد بن مسعدة ذكره، فيجوز أن يكون اسماً وضعه ويجوز أن يكون تلقّاه عمّن قبله من أهل العلم). وبهذه الإشارة القصيرة العابرة أضاء أبو العلاء جانباً مما بدا لي غامضاً يفتقر إلى إيضاح، أرجو أن يفضل به مَنْ يمكن أن يجد وقتاً لمعالجة الموضوع من أبنائنا الأكاديميين، وفي مقدمتهم الدكتور فرهود. ويستتبع السؤال، بطبيعة الحال سؤالاً آخر له أهميته، فيما أعتقد، وهو إذا لم يكن الخليل قد وضع وأَصَّل علم القافية، فمن هو الذي وضعه، من العلماء؟ |
| وبعد: |
| فلقد أهمل شعراء الحداثة القافية أو هم قد تجاوزوها، بل قد أهملوا وتجاوزوا أوزان الخليل وبحوره، ويبدو أن تجاوز الوزن ظل أقلّ اتساعاً أو توسُّعاً من إهمال القافية، إذ لا نزال نجد في بعض ما نقرأ من شعر الحداثة أثراً للتفعيلة، تتكرّر على نمط يختاره الشعر، كلّما أسعفه السياق، أو استعذب ما تصدح به التفعيلة من الجرس أو الموسيقى التي لا يزال يفتقر إليها الشعر. |
| ونجد نازك الملائكة تعطيهم بعض الحق حين تقول في كتابها (قضايا الشعر المعاصر) ما يفهم منه أنها تشعر بتحكم القافية وسلطانها، وأنها - (كما ترى) - قد عطّلت تدفق الكثير من الشعر في صدور أو قلوب الشعراء. |
| ولا تحدد نازك الملائكة فريق الشعراء أو زمرهم الذين تحكُّم القافية وسلطانها قد عطل تدفق الكثير من الشعر في صدورهم وقلوبهم، كما أنها لا تحدد الفترة الزمنية التي عاشها وعانى من تحكم القافية فيها هؤلاء الشعراء، وهذا قد يتيح أن نرجِّح أنها عنت فريق أو زمرة الشعراء المحدثين أو المعاصرين، ونحن لا ننسى هنا أنها تعالج (قضايا الشعر المعاصر). |
| وهنا نجد أنفسنا أمام ظاهرة تستوقف الناظر إلى مشكلة القافية كعقدة، أو (مَلِكَة) تتحكم في تطلع الشاعر إلى الانطلاق في إبداعه. والظاهرة باختصار أن الشعر العربي في جميع مراحله.. وعبْر جميع أجياله، خضع لحكم هذه (المَلِكَة).. عانى منها، واضطر إلى مراجعة القصيدة أو (تحكيكها) أو (اعتصار رحيقها)، مدة قد تبلغ (الحول).. كما هي الحال مع الحوليات، أو كما هي الحال مع الحطيئة وأمثاله ممّن سمّوا عبيداً للشعر، وفَصَل الناقد بينهم، وبين من سمّوا (المطبوعين) الذين لا يحككون، ولا يعجزهم اختيار المعنى، كما لا تعجزهم أو تتحكم فيهم القافية. |
| ولا أعرف إن كان هناك من الأكاديميين المحدثين في العالم العربي، أو من المستشرقين من عُنيَ بإحصاء أو (فهرسة جامعة للقوافي) في الشعر العربي، تظهر لنا عدد المرات التي وردت فيها هذه القوافي في شعر الشعراء.. وتلك العلاقة بين المعنى الذي يسطع به (الصدر) والقافية التي تحكّمت في هذا المعنى في (العجز).. وظاهرة أثر هذا التحكم في ارتفاع أو هبوط المعنى في البيت. |
| ومن المفروغ منه أن خزانة الشعر العربي منذ العصر الجاهلي أو قبله، وإلى ما نسميه عصر النهضة الذي تُعزى بدايتُه إلى البارودي، قد استوعبت ألوف أو ملايين القوافي ولكنها تتردد أو تفرض نفسها على الشاعر، بحيث تأتي في قصائد هذا.. كما يمكن أن تأتي هي نفسها في قصائد الآخر. وليس في ذلك ما يعيب القصيدة أو شاعرها بطبيعة الحال ولكن هذا - وأعني التعدد الواسع والضخم للقوافي - قد كوّن رصيداً، أتاح لكل شاعر أن يسحب منه، بحيث نجد أن شعراء المائة الرابعة، ومنهم المتنبي، لا تستوقف إبداعهم القافية، لأنها متوافرة في هذا الرصيد السخي.. ولعلّ هذا هو السبب أو العلة في أن يضطر شاعر من فحول الشعراء كالحطيئة إلى (التحكيك) والمراجعة وإعادة النظر مرة أو مرات، قبل أن يرضى عن القصيدة التي يلقيها أو يصدح بها، إذْ لم يكن قد تجمّع ذلك الرصيد الضخم الذي يجده شعراء المائة الرابعة، ثم بعدهم شعراء عصر النهضة. |
| ويستوقفني شعراء المائة الرابعة بالذات، لأنهم الذين وجدوا هذا الرصيد الضخم من القوافي، تركها عشرات الشعراء أو مئاتهم طوال أكثر من أربعة قرون، وحتى إذا قيل إن دواوين أولئك الشعراء لم تكن كلّها مكتوبة ونُسخها متداولة، فإن شعراء هذه الفترة كانوا كمن سبقهم يعتمدون على (الحفظ)، وكان الرواة لا يزالون هم الذين يُعتَمَِد عليهم في تداول المحفوظ من الشعر القديم والحديث على السواء. |
| والثعالبي (أبو منصور عبد الملك بن محمد)، قدّم لشعراء المائة الرابعة وصدر المائة الخامسة ما قد يؤكد أن الشعر والشعراء في هذه الفترة التي حددها الثعالبي بدقة فيما جمع بين دفتي كتابه (يتيمة الدهر) من أخبار الشعراء وشعرهم ومنهم، أو في الصدر منهم (أبو الطيب المتنبي) قد تجاوزوا، أو كادوا، عقدة القافية، ولم يجدوا ما يضطرهم إلى (التحكيك) والمراجعة والتريث فترة تبلغ ((الحول))، لأن الرصيد من هذه القوافي كبير ميسور يسهل عليهم السحب منه دون عناء. ومن هذا الواقع كان الإبداع هو الظاهرة الواضحة التي إن كانت لا تنافس إبداع من سبقهم من الفحول، فإنها لا تهبط عنهم إلا بخصيصة السبق التي سجلت بواقع القوة والتفوق، ولعلّ مسيرة الفنون في مجملها قد تميّزت بهذه الخصيصة، كما هو المشهود في الأعمال الفنية، سواء في الفنون التشكيلية، أو في الموسيقى.. وحسبنا أن نذكر روائع الفن ((لمايكل أنجلو))، وروائع الأعمال الموسيقية لبيتهوفن ومُوزارت وشوبان، لندرك أثر خصيصة السبق في المراحل التالية من تطور هذه الفنون. |
| في الجزء الأول من (اليتيمة) نجد شاعراً هو المعروف بـ (الواساني) - أبو القاسم الحسين بن الحسين بن واسانة
(1)
- يكتب قصيدة يصف فيها (ما جرى عليه، في الدعوة التي عملها في قرية ((حمرايا)) من أعمال دمشق.. قصيدة مطلعها: |
| من لعين تجود بالهملان |
| وقلب مدلّه حيران |
|
| قد بلغ عدد أبياتها مائة وتسعة وتسعين بيتاً، بنفس القافية مع ندرة تردد أو مجيء القافية نفسها في القصيدة رغم طولها، ومع عدم اهتزاز الوزن من بحر (الخفيف).. وليس هو الوحيد على هذا المستوى من القدرة على التغلب على عقدة القافية، فهناك مثلاً ذلك الشعر الهجَّاء أو (الذي لا يبني جلَّ قوله إلاّ على سُخف) و (لولا أن جِدَّ الأدب جد، وهزله هزل كما قال إبراهيم بن المهدي لصنت كتابي هذا عن كثير من كلام من يَمُد يدَ المجون فيعرك بها أذْنَ الحُرَمْ ويفتح جراب السخف فيصفع بها قفا العقل)
(2)
. وهو المشهور بـ (ابن الحجاج).. تجد له القصائد المطوّلة، وفي كل بحر من بحور الشعر، وتجد القوافي تتراكض في أبيات قصائده، وقد خلصت من حالة أو عاهة الإسفاف في المعنى تسببه القافية في (الإعجاز). |
| صحيح أن المعاني، في هذه المطوّلات، التي تنثال فيها القوافي طيّعة سهلة، تهبط كثيراً عن تلك التي تسمق وتشمخ وتسمو، في شعر شعراء العصور الإسلامية والأموية والعصر العباسي الأول، ولكن، لا شك أن تحكم القافية وسلطانها كان أظهر وأقوى وأشد شموساً عند أولئك، ثم خف وتنازل عن عنفوانه، في العصر العباسي الثاني إلى المائة الرابعة وصدر الخامسة، لأن رصيد المتداول والمحفوظ منها أصبح يتيح للشاعر أن يسحب منه دون عناء. |
| والحفظ، ورواية المحفوظ من الشعر، كان أهم مدخور الشاعر، بل ربما كان سلاحه الذي يضمن له، ليس الوصول إلى القافية فحسب، وإنما توخّي المعاني التي يحرص على أن لا يكون قد سبقه إليها القدامى.. ومع ذلك فما أكثر من الشعراء مَنْ تكررت معانٍ لشعراء قدامى، أو معاصرين للشاعر نفسه في شعرهم وقد ترصّدهم النقاد، واعتبروا الكثير من ذلك نوعاً من السرقة التي تعيب الشاعر، وتفسح المجال للقدح في مكانته.. |
| فإذا انتهينا إلى الشعراء منذ عصر النهضة الذي ابتدأ بالبارودي ثم شوقي وحافظ، وخليل مطران، ومن بعدهم أفواج الشعراء الكثيرين، ومدارس الشعر التي ظهرت وانتمى إليها هذا الفريق أو ذاك من الشعراء، وأخذت تَنْبتُ دعوة التجديد، وتمتد لها الفروع وتتعمّق الجذور، وترتفع نداءات التجديد، مركِِّزة على عقدة القافية، فيما يشبه ثورة عليها، فإن علينا أن لا ننسى أن ما أسميه (مدرسة الحفظ والحفاظ) قد أخذت تتراجع أمام المطبعة، والنشر، اللذين رفعا عن كاهل معظم المثقفين ومنهم عشاق الشعر، عبء الحفظ.. لم تعد هناك حاجة لحفظ مئات أو ألوف الأبيات كما كانت الحال في بداية عصر النهضة الذي كان متابعة لما سبقه من العصور في هذه الظاهرة.. أصبح معظم الشعر الذي كانت تعيه ذاكرة الشاعر مطبوعاً بين دفتي الكتاب أو الكتب.. والكتاب، بدوره، لم يعد في متناول أيدي الجميع.. موجود في المكتبات والأسواق، ولكن الوصول إليه، إن لم يعوزه المال فإن البحث عنه ((حركة)) لم يعد يتسع لها الوقت، ولم يعد مما تسمح به المشاغل. ومن هنا أخذت القافية تسترجع شيئاً من سلطانها القديم ولكن بأسلوب جديد. يمكن أن يوصف بأنه (متعب ومكلّف).. وأبناء العصر، ومنذ أكثر من جيلين، استوعبتهم السرعة أو استوعبوا هم مقتضاها وطبيعة معايشتها.. وعندما انفتح باب الشعر غير الملتزم بالقافية، كذلك الذي كتب به شكسبير شعره ومسرحياته، وشاع نشر مقطوعات الكثير من الشعر المترجم عن اللغتين الإنجليزية والفرنسية بلا قافية ولا وزن ثم عندما انطلقت الدعوة إلى الشعر الحر أو الشعر الجديد، ومن أوائل زعمائها الدكتور أحمد زكي أبو شادي
(3)
،ثم جماعة أبولو، وتكاثَر التذكير بما ابتكره شعراء الأندلس، مما سمّي الموشحات، وفيها تتغيّر القافية، وتتغير التفعيلة مع احتفاظها بالوزن أو البحر مجزوءاً، هنا وكاملاً هناك، مع التفنّن في اختيار الأوزان الخفيفة وفي كل ذلك نوع من المثال والقُدوة.. كل ذلك، إذا أضفنا إليه ما دعا إليه شاعر كبير كجميل صدقي الزهاوي في العراق، وما حملته موجة شعر شعراء المهجر، وفي الطليعة منهم، حتى قبل جبران، أمين الريحاني، فإننا نستطيع أن نضع أصابعنا على بذور ونوامي الشعر الحر أو شعر الحداثة، في آخر صيحاته التي لم تتمرد على القافية فقط، بل أخذت تتمرد على التفعيلة بأنواعها.. قد تُلتزم اتفاقاً، أو نوعاً من محاولة الزخرفة الإيقاعية التي تضيف - ولو القليل - إلى مطلب التجميل، الذي يخفف إلى حدٍّ من (وحشة) المتلقي وحالة ضياعه بين ما ألّف من قصائد الشعر التي ازدحمت بها العشرات أو المئات من دواوين الشعراء، وبين هذا العمل الذي يجد شرائحَ من المثقفين - مثلِه - يسمُّونه شعراً. |
| والمعركة مستعرة جداً - وسوف تظل كذلك إلى ما لا نهاية - بين أنصار شعر الحداثة وأنصار الشعر المحكوم للقافية والوزن، فإذا بدا للقارئ أن يتساءل لمن أو لأي النوعين من هذا الشعر سيكون البقاء، فإني أجد أمامي عامل (السرعة) الذي أصبح يحكم ظروف الحياة كلّها.. أجد عامل السرعة الذي نقلنا من عهد الارتحال على (عوجاء مرقال تروح وتغتدي)، إلى عهد (الكونكورد) ولا أدري ما بعدها، ولعلّه الصواريخ، التي تنقلنا إلى أقصى الأرض في دقائق أو ثوان. ومن عهد الرسالة لا تصلنا من المدينة المنورة مثلاً، قبل مرور أيام، إلى عهد الفاكسيميلي، تنقل الرسالة من مكتبي في جدة إلى الصحيفة في نيويورك (مثلاً) في التو واللحظة، ومن عهد الأخبار عن تطورات الحرب (أي حرب) لا تصلنا إلا بعد أن تكون قد وضعت أوزارها، إلى عهد سماعها ومشاهدة أحداثها صوتاً وصورة وحركة وفجائع، في نفس اللحظة أو في نفس اليوم.. الخ الخ.. |
| عامل السرعة هذا هو الذي لن يترك للشاعر وقتاً للبحث عن القافية والرَّوي، أو توخي الوزن وتفعيلاته، بعقدها التي وضعها الخليل، فهو محكوم لهذه السرعة.. تجيش نفسه بالمشاعر والرؤى، وبالموقف، وتترامى في ذهنه المعاني، فيضعها على الورق، كما تجيء متدفقة منثالة، أو متحيّرة متعثرة متخلِّصاً من جميع القيود، شاعراً أنه قد قال ما جاشت به نفسه وكفى.. تاركاً للمتلقي أن يرى رواءه، وأن يتعمّق معانيه، وأن يهتز لموقفه، فإذا ضاع هذا المتلقي، واستغرقته أو أحاطت به دوّامة التبعثر والغموض، فليس ذلك مما يعني الشاعر في شيء، إذ ليست مسؤوليته أن (يشرح، ويفصّل)، يكفيه أنه (قال) ما يريد أن يقول مؤمناً بن هذا الذي قاله لا بد أن يجد من يفهمه، وأن في هذا الذي قاله الكفاية من الضوء لمن يلتمس الأضواء بين الأنفاق أو الآفاق. |
| وأجد الآن من يقول لي: (كأنّك تؤمن بأن المستقبل لهذا الشعر..).. وإجابتي الجاهزة هي أن عامل السرعة هذا الذي حكم ظروف الحياة كلّها هو الذي يجعلني أذهب إلى أبعد كثيراً مما يظن أنصار الشعر التقليدي، ومعهم أنصار الحداثة.. إني أرى ذلك اليوم الذي يجلس فيه الشاعر أمام (الكمبيوتر)، ويضع أصابعه على مفاتيحه، وفي ذهنه شحنة المشاعر والمعاني والمواقف، فلا يكاد يحرّك هذه المفاتيح لحظات، حتى يعطيه (الجهاز) شعراً، يعالجه المتلقي بجهاز كمبيوتر آخر، فيفهم منه، ليس ما أراد الشاعر أن يقوله فقط، وإنما ما تختزنه المعاني من أجناس القول وفنونه، التي لم تكن تخطر على البال. |
| وهذا يعني باختصار شديد، أن الشعر سوف لن يندحر ولن يتلاشى من حياة الإنسان لأنه فن.. والفن ضرورة حياة، لا تختلف في التصاقها بحياة الإنسان عن أي من ضرورياته الأخرى، والفن، كما هو معلوم، ليس الشعر وحده، وإنما معه الموسيقى التي أصبح الكمبيوتر قادراً على أن يضع المبتكر من ألحانها وإيقاعاتها وأداء كل آلة من آلاتها.. ومعه أيضاً الفن التشكيلي، الذي لم يعد مستبعداً أن يبتكر الكمبيوتر ما يتفق مع انطلاقة العصر إلى المستقبل البعيد البعيد. |
| الفن، سوف يظل عنصر المجد والشموخ في حياة البشر، ولكنّه الشموخ الذي يتطوّر ليحقق حلم الإنسان في حياة لا حدَّ لتكاملها المنشود كما أراده الله عزّ وجل. |
| * * * |
| رغم أن مشاعر الأبوّة في وجداني تتزايد توهّجاً واشتعالاً، كلّما تزايد رصيدي من سنوات العمر، بحيث ترسّخ في نفسي ما يصل إلى درجة اليقين أن كل شاب وشابّة يعتمر في نفسي مكانَ الابن والابنة حُبًّا وإعزازاً، والتماساً لكل ما يحقّق لهم من جانبي - وفي حدود الطاقة - ما يتطلعون إليه من توفيق ونجاح في مسيرتهم نحو مستقبل أفضل تتوافر فيه عناصر النصر في معركتهم مع الطموح الذي يبدو لي أحياناً أنه الملحمة الضارية التي أصبحوا يعيشونها مع عصر تحدياتٍ عاصفة تهبّ، ولن تهدأ، إلى ما شاء الله.. رغم هذا الواقع، مع وجداني، والمشاعر المشتعلة أبداً فيه نحو الشباب، فإني لا أجد تفسيراً لموقفي من حركة إبداعهم، وما يتألق في هذا الإبداع من براعم ونوامي فنٍّ ٍتبشّر بأن مسيرة الفكر، وحركة الفن عندنا، قد دخلت مضمار السباق مع الأقطار العربية التي لم يعد من المحتمل أن نتخلّف عنها، كما كانت الحال منذ عقود قليلة من السنين. |
| وعلى أرفف مكتبتي المتواضعة مجموعة لي أن أعدّها أو أعتبرها كبيرة، من عطاء هذا الشباب لابد أن أعترف بأني ألقي نظرات عابرة على عنوان الكتاب أو الديوان ثم قد أقرأ صفحاتٍ هنا، وأخرى هناك، ثم بيان (المحتويات)، ثم أضعه على الرف الذي يستوعب أمثاله في موضوعه.. ثم تمر الأيام.. بل الشهور، وربما السنون، وفي نفسي إحساس بالذنب من جهة، وفي ذهني أو ذاكرتي أن أقل ما يجب عليّ - والكتاب هدية كريمة من المؤلف أو الكاتب أو المبدع - أن أفرغ لقراءته، والكتابة عنه من جهة أخرى. ولا أفي بالتزامي أمام نفسي، مع أني أكاد لا أنقطع عن الكتابة، مما ينشر، ومما لا أدفعه للنشر. |
| قلت، إني لا أجد تفسيراً لهذه السلبية أو لهذا التجاهل، أو التناسي والنسيان مع ما يشتعل به الوجدان من مشاعر الأبوة الحانية، والمتطلّعة إلى التعبير عن هذه المشاعر. ولكن اليوم يفاجئني التفسير أو التعليل - على سخفه - وهو ما لا يزال يحتفظ به التراث من قدرة على احتواء معظم ساعاتِ النهار والليل، من وقتي.. اكتشفت أني أغرق في متيهة لا سبيل إلى الخروج منها، إلاّ عندما أشعر أو أقتنع بالاكتفاء، وهذا ما يعتبر من المستحيلات، لأن هذا التراث قطع إلى حياتنا اليوم أكثر من خمسة عشر قرناً من الزمان، وللقارئ أن يتصوّر - مجرد تصور - كيف يمكن أن نتجاوز كل هذه القرون، وقد ملأها أعلام الفكر ومنهم الشعراء، والنقاد، وأكابر علماء اللغة، والبلاغة، والبيان، وفقه هذه اللغة ونحوها وصرفها، الخ.. ملأوها بما قد يسعك أن تغفله وتسقطه من حسابك وتضن عليه بوقتك الثمين، وعلى الأخص في هذه المرحلة من القرن العشرين، ولكن، لا يسعك أبداً - عندئذٍ - أن تدّعي أو تزعم صادقاً أنك مُنتَمٍ إلى أمّتك، أرضاً، وعقيدة، وتاريخاً، ولغة وفكراً له مناهله وينابيعه في هذا التراث الضخم والعريق. |
| ولأدع التفسير الآن، ثم أطوي دفّتي هذا الكتاب من كتب التراث، الذي أكاد لا أفارقه منذ أكثر من ثلاثة أسابيع.. لألتقط كتاباً من الرف الذي أضع فيه مؤلفات أبنائي من الشباب في المملكة.. وقد لا تكون صدفة عشوائية أن أجد بين يدي (الخبز والصمت) وهو كتاب أغراني بحجمه الرشيق، إذ لا يزيد عدد صفحاته على سبعٍٍ وثمانين صفحة من القطع المعقول والمقبول، قياساً إلى الكتب التي تبدو (رهيبة) الحجم، عدد صفحاتٍ، وانطلاقاً في الطول والعرض، إلى حد كثيراً ما يجعلني أزهد في قراءته.. والمؤلف أو ((المبدع)) كما يجب أن أسميه منذ اللحظة، هو الأستاذ (محمد علوان). وعلى الصفحة بعد الغلاف، عبارة إهداء، فيها المألوف من التواضع بالنسبة له.. والإسراف في الثناء والسخاء في ألقاب (الأستاذية) بالنسبة لي. ولم أُضِع وقتاً لأدرك أن الكتاب مجموعة قصص قصيرة، في عناوينها ما يغري بالقراءة والاكتشاف، منها مثلاً: (المرأة المشروخة.. ونعيق الغراب الأبيض.. والمطلوب رأس الشاعر).. ولعلّ مما يستنكره عليّ كثير من الشباب أني أنسى أسماءهم، وما أكثر ما أُحرج وأرتبك حين أجد شاباً يصافحني بحرارة، وأعرف أني ربما اجتمعت به، وتحدثت إليه، ولكن اسمه الكريم (تائه) في الذاكرة التي يصفها الابن الأستاذ محمد سعيد طيّب، بأنها تعاني عملية (مسح)، وبمسَّاحةً أو ما يسمّونه في مصر (أستيكة)، تكاد تأتي على كل ما في الذاكرة من أسماء، بل ومن الشوارع والطرقات، إذ ما أزال أعجز عن معرفة موقع منزلي.. ولهذه الحالة حكايات، تضحكني على نفسي والحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه. |
| ولعلّ من حسن حظ الابن الأستاذ محمد علوان، أني تذكرت بسهولة عجيبة، أنّه شرّفني بزيارة في منزلي، مع الدكتور عبد الله منَّاع، منذ بضع سنوات.. وأني أقرأ له في مجلة اليمامة أحياناً، مقالات قصيرة، كان آخرها مقال في الصفحة الأخيرة، بعنوان (أبو الهول ينطق أخيراً).. استوقفتني فيه عبارات أعتبرها شعراً وإبداعاً، منها (هي حجارة الوطن السليب تثمر في الأصابع التي ترتفع بعلامةِ النصر).. ثم هذه الالتفاتة الشاعرة إلى (أبو الهول).. (الذي أزاح عن كتفه الأيمن كتلة من الصخر، كأني به يهديها مشاركة من مصر التي تعي دورها الضارب في أعماق التاريخ.. نطق أبو الهول ليمنح الأطفال وساماً تاريخياً).. ثم هذا التعليق الحرّيف اللاذع الذي يقول: (روما تحرّكت متظاهرة ضد الظلام، وباريس ولندن و.. و.. أمّا على مساحة الوطن العربي الكبير، فلم ينبس أحد ببنت شفة). |
| ومع إغراء الرشاقة في حجم الكتاب، ثم إغراء عناوين القصص، كان المفروض أن أشرع في قراءتها واحدة تلو الأخرى.. ولكن، ما أسرع ما صادر رغبتي ولهفتي على قراءة القصص (تقديم يحيى حقي).. ولعمري، كيف يستطيع مثلي أن يتجاوز يحيى حقي ليقرأ هذه القصص التي يقدم لها.. إني في حضرة واحد من بقية العمالقة في الفكر العربي.. ولقد انقضى زمن طويل منذ فرغت لقراءته في (قنديل أم هاشم) وفي القنديل لمحات من سيرته الذاتية التي نكتشف فيها أنّه بقراءة إعلان لوزارة الخارجية في مصر، عن عقد مسابقة لتعيين الفائزين فيها بوظائف أمناء المحفوظات في القنصليات والمفوضيات ويقول: (تقدمت للمسابقة ونجحت وإن جاء أسمي في ذيل قائمة الفائزين، فصدر الأمر بتعييني أميناً لمحفوظات القنصلية المصرية في جدة - باعتباره أسوأ المناصب وقتذاك.. ويضيف: (ما أبلغ هذا الانقلاب في حياتي) ثم يقول: (في جدة ما بين عامي 1929 و 1930 حدثت في حياتي ثلاثة أحداث هامة.. ويفصّل هذه الأحداث أو هو يعددها، فإذا منها أنه رأى المسلمين يأتون للحج من جميع أرجاء العالم فيكوِّنون لوحة شاسعة كان لها أقوى الأثر في نفسي.. وهناك درست المذهب الوهّابي.. والتقيت في جدة بالعقلية الغربية المنظمة، ممثلة في بعض رجال السلك الديبلوماسي من أهمهم (سان جون فيلبي) المستشرق البريطاني الذي قام بدور هام لحساب مخابرات بلاده واجتاز الربع الخالي، وألَّف عنه كتاباً.. و (فاندر مولن) قنصل هولندة في جدة، وكان هو الآخر مستشرقاً تخصص في وضع الخرائط عن الجزيرة العربية). |
| ومع أن الأستاذ يحيى حقي من جيل العمالقة أو هو بقيتهم فإنه بعيد عن ذلك المستوى الذي بلغه عمالقة من أمثال الدكتور طه حسين والأستاذ عباس محمود العقّاد. ويمكن أن يكون السبب، هو انغماسه إلى (العنق) في الحياة الوظيفية أو الحكومية، حيث فتح الله عليه بعد وظيفته في قنصلية مصر في جدة، بوظيفة لعلّها مماثلة في قنصلية مصر في أنقرة حيث أتيح له كما يقول أن يرقب تلك التجربة الخطيرة التي قام بها مصطفى كمال في تركيا ومن استامبول في تركيا إلى غيرها، في هذه العاصمة أو تلك من عواصم العالم، ولا يجهل كثير من القراء أن يحيى حقي كاتب قصة.. وأن له كتاباً بعنوان (فجر القصة المصرية) وهو يقدم لهذا الفجر بمذكرات أو ذكريات عن الحياة في مصر، أيام سطع هذا الفجر، بقصة (زينب) لمحمد حسين هيكل، وقد كتبها في فرنسا، بعد أن قرأ الكثير من أجناس الأدب الفرنسي، ومنه الرواية أو القصة، ولا شك أن مما يسجّل لهيكل، أنه لم ينجرف مع تيار الحياة الفرنسية، ليقدم في (زينب) ملامح من المجتمع الفرنسي، ومنه المرأة الفرنسية التي فتن بها الدكتور طه حسين، كما فتن باللغة الفرنسية، فكانا (المرأة الزوجة واللغة) مصدر ذلك الثراء العريض في ثقافة ذلك العملاق، وقد كان سخياً، ففتح الباب على مصراعيه إعجاباً بفرنسا، وبالحضارة الفرنسية.. أو بالغرب كله وجميع أقطاره. وأجمل ما في (زينب) أنها كانت الفتاة أو المرأة المصرية. بكل موروثها الحضاري العريق الذي تشم فيه عبق الخضرة في الريف وتسمع اصطفاق الأمواج الناعمة الرقيقة في الترعة من مياه النيل. |
| وعكفت على قراءة تقديم الأستاذ يحيى حقي لقصص المبدع الشاب محمد علوان، ولم أعد ذلك القارئ الذي يلتهم الصفحات التهاماً.. إني أقرأ لأتذوّق، ولأملأ النفس من (طعم) ومذاق هذا الذي يطيب لي أن أقرأه.. ولذلك فقد وجدت نفسي مع مقدمة يحيى حقّي، أقرأ ما كتب في تمهل وتأنٍّ، متوخّياً أن أرى أثر هذا المبدع في هذا العملاق.. المبدع الشاب، والعملاق العجوز، الذي طوى من أحداث الحياة، ومن نبض الفكر وعطائه، ما ينبغي أن يعطي تقديمه أو هي مقدمته نكهة وجبة ليس من السهل أن تُجهّز، دون أن تلمس فيها جهارة صوت (الأستاذ) مع التلميذ. |
| ولكن ليس هكذا كانت مقدمة يحيى حقي لقصص محمد علوان.. ولم يكن متواضعاً أو متوخياً الرفق وتجنّب الوحشة، وإنما هي النظرة الفاحصة التي أعطتنا - وأعني نفسي والقراء - إحساساً بأن مسيرة الإبداع عندنا قد انطلقت، وأنها لن تتوقّف، وأن العقد القادم من السنين، سوف يجعلنا نعتز بأمثال كاتبنا الشاب، بين كتّاب مصر وغير مصر من بلدان العالم العربي. |
| وبعد، |
| فقد كان للأستاذ محمد علوان فضل أجد نفسي ملزماً بتقديره.. وهو أنه قد أغراني بأن أعود إلى رف المؤلفات لأبنائنا من الشباب.. أقرأ منها ما يعطيني الفرصة للوفاء بما أشعر أنه (ديون) كبيرة لا يصح أن لا أفيَ بها إلاّ جاحداً متعالياً، وهو ما لا أحبه لنفسي، وعلى الأخص في هذه المرحلة من العمر. |
| فإلى الخميس القادم مع قصص محمد علوان.. ومع رعيله من الشبان. |
| * * * |
| وأكاد أقول إن الأستاذ يحيى حقّي، في مقدمته لقصص المبدع الشاب (محمد علوان)، قد قال ما لا أتجاوز الحقيقة إذا قلت إنّه قد غطّى كل منافد القول، بحيث أشعر أني لن آتي بأي جديد في محاولة نقد وتحليل هذه القصص التي حملت عنوان (الخبز والصمت). ومن المفروغ منه أن عملاقاً كالأستاذ يحيى حقّي، يقول إنه قد كتب الكثير من المقدمات إلى الحد الذي أصبح معه موضع تندر: (فيقال كما يجلس العرضحالي مأجوراً أمام باب المحكمة يتصيّد كل داخل.. وكان جزائي اتهاماً لي بأنني مالأت الجميع، أحياناً بالكلام وأحياناً بالصمت.. وأود أن أنتهز لحظتي هذه - فلعلّها الأخيرة - لأبرّئ نفسي من التهمتين، علم الله إني ما قلت إلا ما اعتقدت أنه الحق).. أقول: من المفروغ منه أنه مع (الخبز والصمت) لمحمد علوان، قد عُني إلى الحدِ الذي يتفق مع مكانته المرموقة، بأن يقدم لهذه القصص، بالرأي والوقفة أو الوقفات، التي رأى وأحسَّ أنها (الحق). |
| ولا أدري كيف لم يخطر للابن محمد علوان أن ينشر هذه المقدمة استلالاً من الكتاب قبل أو بعد طبعه، إذ فيها ما يستحق أن يقرأه الكثيرون من رصفائه، ليس ليتعلّموا شيئاً لم يكونوا يعرفونه، وإنما ليُلمّوا بوجهة نظر أستاذ عايش مراحل من تطور الفن بأجناسه المختلفة، ومنها المسرح، والقصة، والشعر والرواية والرسم بل والعمارة، ولآثاره في تلك البلدان والعواصم التي تواجد فيها، في علمه الديبلوماسي الذي يبدو أنه التزمه طوال حياته. |
| على سبيل المثال، نقرأ مدخلَه إلى هذه القصص، حيث يقول: (أما - اليوم، فها أنذا - وهذه هي التجربة الجيدة - أكتب عن مؤلِِّف لا أعرفه.. لم أقابله من سابق.. لا أعرف أي شيء عن حياته وإنتاجه) ثم يضيف: (ولكني بعد أن قرأت مجموعته مرتين أصبحت أعرف الإنسان، وإن جهلتُ شخصه وشكله). ويتساءل: (كيف حدث هذا؟) ويجيب (لأن نغمة الصدق في هذه القصص بيّنة لا مراء فيها.. الصدق من أجل الصدق وحده.. لم يصل إلى الصدق عن طريق الصنعة احتذاءً بقواعدِ الشكل المقررة، بل وصل إلى الصدق عن طريق الصدق) ويعطينا الأستاذ يحيى حقي ما يعتبرُ قاعدةً أو قانوناً حين يقول: (الصنعةُ لا بد منها في الفن، ولكن لا يزال الصدق هو السبيل الوحيد إليها). |
| وبعد أن يقول: (قرأت هذه المجموعة بشعور مزيج من الاستعبار والغبطة) يطيل وقفته مع الاستعبار، إذ يعود بالذاكرة إلى عهود بداية (المدرسة الحديثة) في مصر، ثم يقف عند إحساسه بالغبطة فيقول (لأنني أحس مع هذه القصة القصيرة أني أعيش عصري.. ومتحرك معه.. وهذا شأني مع كل المدارس الحديثة في مختلف الفنون، وإن كسَرتْ مظاهر القواعد المعروفة.. في هذه القصة الحديثة تضاءلت مكانة ((الحدوتة)).. تركَّزَ الاهتمام على الشعور.. النظرة في أغلب الأحوال إلى الداخل لا إلى الخارج.. قلَّ فيها التشبيه.. كَسَرتْ ترتيب الزمن.. أصبحت أكثر جرأة على معالجة ((الجنس)).. مأساتها الأولى اغتراب الإنسان.. الجموع لا الفرد هي البطل أحياناً).. ويضرب المثل لهذه الشحنة من الآراء المتلاحقة بقصة ((السور ليوسف إدريس)) وقصة ((السلخانة لإسماعيل ولي الدين)). |
| ويبدو لي أن الأستاذ يحيى حقّي ينتهز فرصة كتابة هذه المقدمة لمجموعة الأستاذ محمد علوان ليبدي رأياً ظل يختزنه أمداً طويلاً عن القصة الحديثة، فيتساءل: (ما هو الحجم الأمثل لهذه القصة الحديثة؟.. ولأن صفتها - القصة الحديثة - الغالبة هي ((التركيز)) فلا بد أن يكون الحجمُ صغيراً.. فما أسهل أن يشابَ التركيزُ ((بالغموض)).. والغموض يُسقى بالكستبتان لا بالأكواب). ويلتفت هنا التفاتة حادة إلى الشعر الحديث إذ يقول: (وتتمثل هذه المشكلة بصورة أكثر حدة في الشعر الحديث.. إذا طالت القصيدة مالت إلى النثر، ضاع أدنى أمل أن يبقى منها في الأذن بعد القراءة شطرةٌ واحدة). وأجدني أقف منه محاوراً.. حول قصيدة الشعر الحديث إذا طالت وأنها تميل إلى النثر. فلا يبقى منها في الأذن شطرة واحدة.. لأقول إن بقاء شطرة واحدة.. أو أكثر أو أقل، من الذي يقرأ من الشعر الحديث، لم يعد متاحاً، أو مرغوباً فيه بأية حال.. لأن قصيدة الشعر الحديث، (تقرأ.. ولا تُلقى..)، قراءتها هي سبيل الرحيل في أجوائها تحليقاً في الآفاق أو زحفاً وتسلّلاً في الخنادق والأنفاق. وقد مررت بتجربة الإصغاء إلى القصائد التي ألقاها في نادي جدة الأدبي، ثلاثة من شعراء القصيدة الحديثة.. فكانت الضجة التي ثارت واحتدمت، وكادت تكون معركة حامية الوطيس، نتيجة لضياع بعض الحضور، واختلاط الدروب عليهم وهم يُصغون إلى ما بدا لهم ((كلاماً غير مفهوم)). وإن كان في الواقع مفهوماً وفيه القدرة على أن يهزّ الوجدان، ويحرك المشاعر لو أن النادي عُني بتوزيع نسخة من كل قصيدة يقرأها الحضور وهم يُصغون.. ولعلّها فرصة لأقول: إن القصيدة التي تُلقى من منابر الخطابات أو مايكروفونات الإذاعة، ويترقرق لها ما يشبه النغم، يتردَّد تطريباً، في طريقها إلى الزوال.. وقد لا يبقى لها وجود بعد عشر سنوات.. وهي في ذلك لا تختلف عن تطريب أم كلثوم، ومحمد عبد المطلب، اللذين لم نعد نطيق البقاء معهما ذلك الوقت الطويل، الذي كنا نقضيه في الإصغاء إليهما، ومعهما بالطبع عبد الحليم حافظ.. ومن هنا أجد أن ((الرحبانية)) وتحفتهم (فيروز) قد أدركوا قبل غيرهم، في العالم العربي، أن (الزمن) قد أصبح أغلى أو أثمن من أن يتبدد في الإصغاء إلى جملة موسيقية واحدة بكلماتها يرددها المطرب ذلك العدد الضخم من المرّات. لا بأس أبداً في أن أصغي إلى سبع أغنيات، في أقل من ساعة.. ولكن لا أطيق أن أصغي إلى أغنية واحدة لمطرب أو صوت واحد، ثلاث ساعات، إلاّ ربما في حالة واحدة، هي أن تفرغ الحياة حولها من حوافزها ومشاغلها، ومنها قضايا الفكر والفن، أو قضايا التعامل مع الحياة والأحياء. |
| وأعود إلى الأستاذ يحيى حقّي، بعد هذا الاستطراد الذي استلزمه رأيه في قضية نعايشها، فأجده يهاجم القصة الحديثة - ومنها قصص الأستاذ محمد علوان - فيقول: (القصة تيار متدفق حتى ولو على شكل أمواج مستقلة متتابعة.. ما نجده فيها الآن هو تقطيع التتابع.. فأسلوبها الآن، كالطريق المملوء بالمطبات يتعثر فيه الرجل قبل الطفل.. النفس الممدود من رئتيه الذي يحمل إلينا همسها أصبح سلسلة من الشهقات).. ثم يضيف ما أجده سبباً كثيراً ما جعلني أعزف عن متابعة القراءة وهو حاجة القصة الحديثة إلى علامات الترقيم (الشولة.. الشولة فوقها نقطة.. النقطة.. النقطتان.. الاستفهام والتعجب). وينبهنا الأستاذ هنا إلى (أن هذه المجموعة ستطالبك بالمزيد من التأني ومن الصبر على قراءتها، كي تستطيع أن تتفهّم معانيها وتتذوق جمالها).. مما يعني حاجة قصص المجموعة - وأمثالها كثير فيما تنشره الصحف والمجلات عندنا، على الأخص، إلى هذا الترقيم.. وإلى التخلص من المطبات التي يتعثر فيها الرجل قبل الطفل.. ويلخص الأستاذ حقي الموضوع كله في قوله: (إنني أؤمن أشد الإيمان أن لا وسيلة للنهوض بجملة فنوننا - الموسيقية والتشكيلية والأدبية - إلا بتحّول اللحن من (التخت) إلى هارمونية (السيمفونية).. وهذا ما أتطلبه للقصة الحديثة بعد أن قلّت حجماً، وزادت تركيزاً). ولعلّ من أهم ما يعتبر تقريظاً وثناء يناله الأستاذ محمد علوان من الأستاذ الكبير يحيى حقي قوله: (ملك المؤلف أسلوبه الذاتي الذي يدل عليه ويميّزه عن غيره.. وهذا هو أعزّ مطامح الفنّان..) ثم يضيف: (إن هذه المجموعة لا تريد إخبارك، وإعلامك، بل رجَّ شعورك إلى حد الإيلام) ولكنه لا يترك هذا الثناء عائماً، يتسلق إلى محاولة (تطييب الخاطر والإرضاء) وإنما يقف الوقفة التي كنت أتمنى أنا لو أني وقفتها، لو كان من حظي أن أكتب هذه المقدمة، وهي قوله: (كنت أتمنى للبيئة الجغرافية نصيباً أكبر من اهتمام المؤلف.. كانت أمامه فرصة ضيّعها للالتفات إلى عبقرية المكان.. إن بروز البيئة المحلّية المتباينة هو الذي يبني للقصة ((العربية)) رقعتها الفسيحة. |
| ولم يبخل الأستاذ يحيى حقي على الكاتب بالتأني وسعة البال في قراءة المجموعة بحيث تجد له أكثر من وقفة هنا وهناك، مما أتمنى أن يقرأه رصفاء الكاتب الأستاذ علوان، ليكتشفوا الكثير مما أستوقف الأستاذ حقي.. ومن ذلك على سبيل المثال قوله: (ونرى هذا الفنان في صورة أخرى، وهو يؤمن ((أن لا فن بلا حريّة)) وأن أبسط مظهر لهذه الحرية يتمنى أن يجده في مجتمعه، هو قدرة الإنسان أن يقول، ولو مرة واحدة: ((لا!)) حتى في وجه أبيه.. بجانبه ((أم)) لم تستطع طول حياتها أن تقول ((لا))).. ثم يقول الأستاذ حقي ما يضع الكاتب تحت مسقط ضوء، لا يكشف المنظور، ولكنّه يوحي بوجوده.. حين يقول: (ورأيت هذا الصوت الذي يحدثنا عبر السطور، يؤمن أن الإنسان لن يقدر النُّور حق قدره ويعشقه إلا إذا دفعته يد ليسقط في أعمق الآبار المظلمة.. إلا إذا قيدته بالسلاسل التي تدمي معصميه ليدرك بعد حلها معنى الحرية.. ليس التبشير مقصوراً على إعلاء شأن الفضائل بل على ذم الرذائل وإبرازها في أشنع صورة.. إن نسيم الجنة يتراءى لنا في أتم بهائه إذا قرأنا وصف الجحيم وهول عذابه.. ولا عجب فإن هذا الصوت يأتي من بلاد تؤمن بأن آخر الدواء هو الكي). |
| وأخيراً، يختم الأستاذ حقي مقدمته لمجموعة قصص الأستاذ محمد علوان بكلمة فيها الكثير الذي ربما لا يُتوقع من مثله وهو الذي كتب مئات أو عشرات المقدمات لأمثال هذه المجموعة لكثير من الكتاب، إذ ليس قليلاً أن يقول: (لا أدري كيف أشكر الصديق على تعريفي بهذه المجموعة التي ((رجَّتني)) رجًّا عنيفاً أخرجني من ركود واعتكاف.. إنني أستخسر حقاً أن تمر هذه المجموعة دون أن تحظى بما هي جديرة به من اهتمام). |
| وأنا من جانبي، أضيف إني قد ظللت مع هذه المجموعة، ومع غيرها من أعمال شبابنا في شبه إغفاءة، يمكن أن أسميها غفلة حمقاء، ولذلك فقد انتزعت من الرف ((إياه)) مجموعة من هذه الأعمال، أضعها الآن أمامي، وفي نفسي أن أفرغ لها، وأن أكتشف الآفاق، أو الأنفاق فيها.. مؤمناً بأن من حق الشباب علينا أن نعايش أفكارَهم وأحلامهم، وقضاياهم، وأن نقول ما ينبغي، أو ما ينتظرون هم، أن يقال عنهم، وليس ثناء وتقريظاً، هما السمة التي ألفناها أو ألِفَها بعضهم، فيما ينشر عن أعمالهم عند ظهورها وصدورها، وإنما نقداً وتحليلاً ووقوفاً عند المنعطفات، إذا وجدت، وأنا أتوقّعها على أية حال. |
|
|
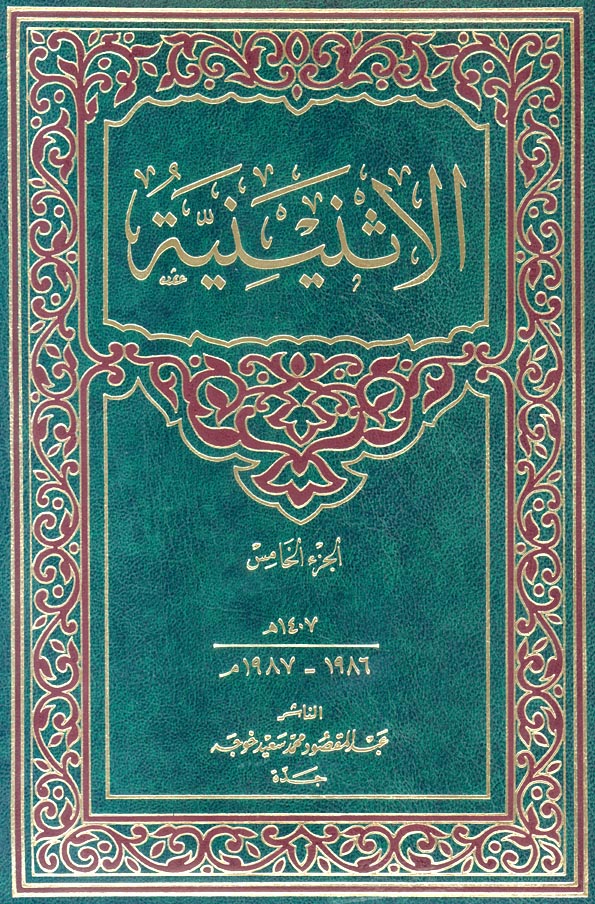
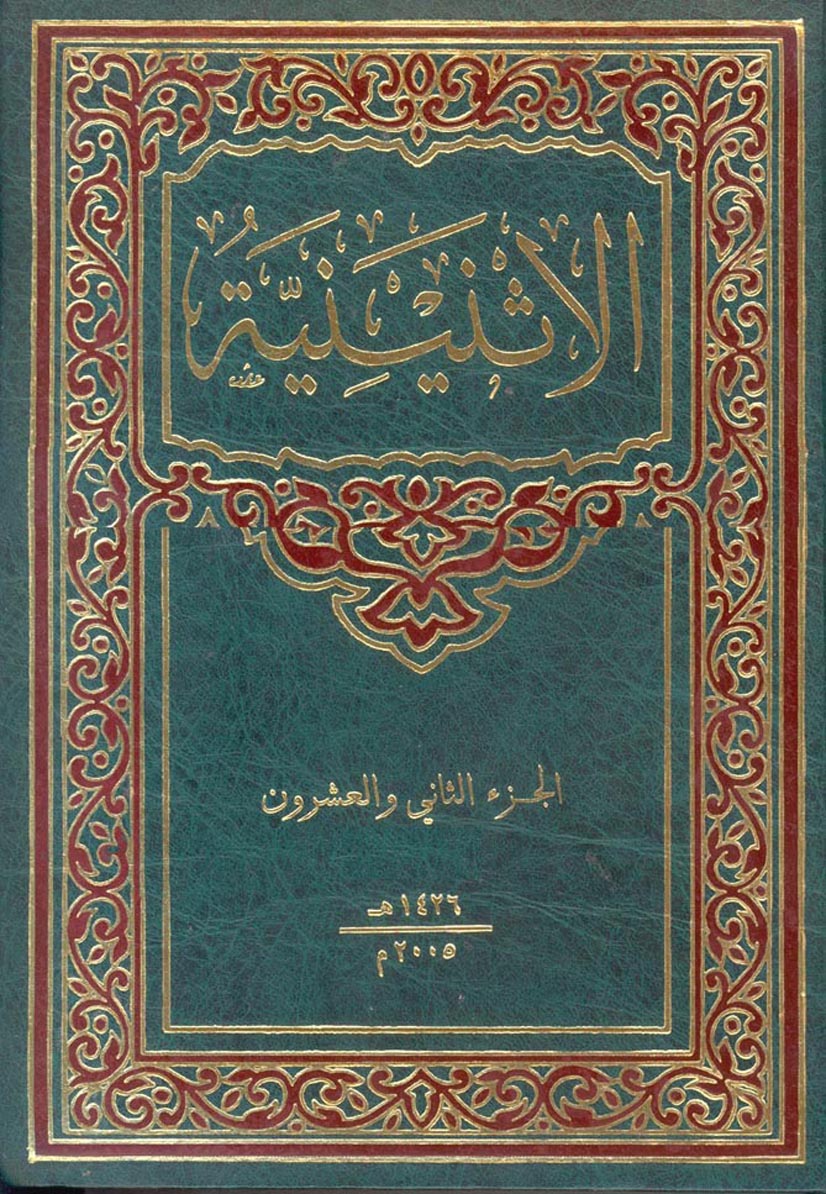
 شارع عبد المقصود خوجة
شارع عبد المقصود خوجة 00966-12-6982222 - تحويلة 250
00966-12-6982222 - تحويلة 250




