| المحاضرة (4) |
| أردت بهذا التمهيد، الذي تناول أطرافاً من الفروض والأقوال، وأساليب من التمثيل، والاستدلالات، والأقيسة، أن تقوم الفكرة التجريدية عن نشأة الفضائل واضحة كل الوضوح في أذهاننا، ويسرني أن أشعر بأني وفقت في هذا ولو قليلاً. |
| وأعترف لكم بأنه لا يؤذيني، أن يعد كثيراً من هذه الفروض والأمثلة المزجاة خيطاً، وخلطاً، فإن الذي يحاول الإقناع عادة، لا يستقيم له ما يريد بالحجة والمنطق وحدهما. ففي الإنسان شيء غير العقل المكين، والعلم الراسخ، والعقائد الثابتة. فيه الوجدان، وفيه مشابه الإنسان القديم، واستجاباته الخاطفة، وفيه الضمير الفطري الذي يؤمن بأحكام العقل ومنطقه قليلاً، ويكفر بهما كثيراً. |
| فيه هذا الحس الداخلي الذي يكونه تاريخ طفولته القائم في دمه، وتاريخ وراثاته الذي يعد عاملاً له قوته. هذا الحس الذي يتسع فيه أفق الشعورات المبهمة حتى ما تحده الحدود، ويضيق حتى ما يرى سبيلاً غير سبيله. |
| وعساني -إن فشلت في اكتساب العقول- لا أفشل في اكتساب عطف الضمائر والنفوس، وإقناعها، وأي شيء من الفضائل والرذائل. يمكن أن تكون صلته بالعقل، أوثق من صلاته بالعواطف والنفوس والخيالات والضمائر؟ بل أي شيء منها يمكن أن يكون أقدم علاقة بالعقل، أو أدنى قرابة إليه، من الفطرة الأصيلة..؟ |
| * * * |
| ينبغي الآن أن نستنتج، أن الفضائل أنانية مهذبة، وأن الرذائل أنانية عارية. |
| وأن الفضائل أدل على القوة وانطلاقها، والرذائل أدل على فتورها وضيقها، وقد كان الجسد في ما مثلنا، مصدر القوة، أو مظهرها، ومعيار الحكم عليها، في بداءة الحياة. |
| أما في الأطوار الأكثر حضارة فيكون مظهر القوة مدى الاستطاعة والمقدرة على ضمان الرغائب. |
| فالثروة أقدر على تحقيق المطالب والرغبات، وبسط النفوذ، من قوة الجسد، وقوة الفكر، ومعيار الفضائل والأخلاق في هذا العصر وفي عصور قبله، القوة بمعناها الجديد (الثروة -النفوذ). |
| فإيمان الناس بالقوة (في معناها الجديد) إيمان معرفة وتقدير. أما إيمانهم بالفضائل مجردة، فإيمان خيالي أو شعري. |
| وليس أدل على ذلك، من أن أية فضيلة لا تكون مظهر قوة، لا يكون الإيمان بها إلا شبيهاً بالكفر والإنكار. |
| وأعتقد أنه لا يسع أحداً أن ينكر أن كل فضيلة لا يكون المتصف بها قوياً، لا تكتسب في نظر الناس معنى الفضيلة ونفوذها. |
| فأنا إذا عطفت على مريض ملقى في الطريق، وواسيته، لا أنال التقدير يناله رجل بارز في المجتمع يفعل فعلي. |
| بل إنا نرى أن بعض المعائب والرذائل يوسع لها العرف العام صدره، متى كان المتصف بها قوياً ذا نفوذ. |
| ولو شئنا أن نذهب هذا المذهب في الاستقراء والمقارنة والتجريد، لألفينا أن الصراحة في رجل ممتاز، تعد نبلاً وعظمة وقوة طبع. وأنها في رجل ضعيف الأثر في تقدير الناس تعد تفاهة وغثاثة وثرثرة، وضعفاً عن ضبط النفس. |
| والأثرة في عظيم قوي، دلالة على امتياز شعوره بنفسه، واعتداده بها فهي حق معترف به، ولكنها في إنسان وسط، باطل، وخروج على سنن الحياة المعروفة، ومألوفاتها المتبعة. |
| ورقة الجانب والبشاشة، والدعة، وصدق الشعور، والأريحية، ونبل الاتجاه والإيثار في رجل فقير، لا تساوي كلها في ميزان الفهم والإعجاب، ابتسامة فاترة، أو إيماءة مكرهة، من رجل ذي نفوذ، ولتكن بعد ذلك بارقة كاذبة، لا أمل فيها. |
| والناس ما يزالون يترنمون بالصدق، ويحضون عليه، ولكنا لا نجد له أثراً بينهم. |
| وقد أصبح الكذب، وما ولد من رذائل المكر والخداع والمداهنة، والتصنع، والمداورة، والرياء، قانون الحياة الاجتماعية. |
| ونحن نمتدح بصدق الوعد في الرجل المرجو، ولكنا نكره ألا يعدنا بتحقيق مطالبنا، حتى إن كان تحقيقها غير ممكن. |
| والرجل إذا قال هذا غير ممكن كنا له أشد كرهاً.. نحب أن يعد ولو لم يفِ لأن الصدق في هذا الموقف تخييب قاطع للأمل، والوعد الكاذب عزاء، ولو باطل.. إذاً فالكذب يلقى تشجيعاً. |
| تفطن الناجحون لهذا الضعف، فلا تلقى (للا) أثراً في صلاتهم بالناس، فلا جرم أن استحالت حياتهم كذباً مألوفاً ترضاه النفوس، وما يصدق على الكذب، يصدق على رذائل أخرى. |
| فإذا قال قائل، إن حظ الفضائل أخذ في الإدبار، لم يقل إلا بعض الحقيقة.. الحقيقة كلها، أن حظ الفضائل قد أدبر أو زال. |
| فنظرتنا إلى الفضائل بعد قياسها بهذه الأقيسة الصريحة، التي مهدنا لها بعدة أمثلة، خليقة بأن تفقد حماسها وحرارتها، وأوشك أن أقول أملها. |
| وقد بينّا أن بعض الفضائل كانت تقاليد بهيجة، تحولت بالمزاولة والتشجيع إلى مشاعر وأخلاق ثابتة، يوم كانت الحياة أقل تعقداً، ويوم كانت الجماعة أسرة مكبرة، تتوحد فيها المشاعر والمقاصد، وتقوى بينها الروابط الطبيعية، أو يوم كان الاتصاف بها ضرورة لتوسيع مدى النفوذ، وبسط سلطان القوة، بين الجماعات المناورة. |
| وهذه كرة الزمان تفقدها سحرها ونفوذها.. شاخت وضعفت، كما يشيخ ويضعف، كل شيء في الوجود. |
| كانت شيئاً جديداً في حياة الجماعات، وشيئاً لامعاً يزيد روابط التماسك الجماعي، وقانوناً فاتناً يتضمن حماية الضعيف، ومعنى الاعتراف بقرابته من الجماعة القوية، ويتضمن معنى السمو بالقوة والرجولة. |
| وكان القانون الأدبي معنى لذيذاً تسرب في روح الجموع فساد وظهر كما يسود كل مبدأ شريف القصد، تستمد منه الجموع روح الأمل والعزاء والتفاؤل، وتستروح منه نسمات التساوي مع القوى. |
| وما زالت الجموع هكذا، تستمد من فهمها الفضائل، ومن الإيمان العميق بها، روح الأمل والعزاء.. ولو كانت وهماً خلاباً. |
| ومن السهل أن نحدد وقع هذه الألفاظ الساحرة في نفوس الجماعات الأولى: الشفقة، العدالة، الخير، الثبات، التضحية، الإيثار، العفة، الصدق، متى عرفنا أن كلمات: المساواة، الحرية، الاشتراكية، الحق، المبدأ، حماية الضعيف، الديمقراطية، تفعل فعل السحر، في نفوس الملايين وتقودهم إلى التضحية في القرن العشرين، وتنزل من نفوسهم وأفكارهم منزلة الأحلام البهيجة، وتخدر أعصابهم بصورة ذلك الفردوس الأرضي الذي تزوره القوة أو الفلسفة. |
| وبالرغم من أن العقل لا يؤمن بإمكان المساواة والحرية، المطلقتين، وبالرغم من أن منطق الحياة يجعل الحق دائماً في جانب القوة، وبالرغم من أن حماية الضعيف، وضمان حقوقه الإنسانية، ليست أكثر من وهم فعال تسخر به الجموع، وبالرغم من أن الاشتراكية حلم لم تحققه سلسلة الجهاد الطويلة في آلاف السنين، فإن النفوس، ما تزال ترتاح إلى هذه الأوهام الباطلة، وتحرص على أن تبقى لها. |
| فهل الفضائل ألفاظ اخترعها القوي ووشاها بالأحلام والتهاويل لاستغلال الضعفاء؟. أما تيارات الحياة المتدافعة فإنها تندفع في سيرها تكتسح الضعفاء ومبادئهم وآمالهم وأوهامهم وتكتسح الفضائل والأخلاق لا قانون لها إلا القوة؟؟ |
| وارحمتاه للضعفاء، لماذا لا يتعلمون فن القوة إذاً ليكونوا أقوياء أو ليتقوا شر القوة..؟ |
| صحيح أن الإيمان بالفضائل في المعتقدات العامة لا يمكن أن يموت أثره في النفوس. |
| وصحيح أن المشاعر والمعتقدات الثابتة في الفضائل تكون أقوى نواحي القوة في روح الأمة، والجماعة، والفرد. لكن هذا الإيمان، وهذه المشاعر والمعتقدات أصبحت في نفوس بعض الأفراد والجماعات نقطة ضعف تستغلها القوة. |
| كم من المجازر البشرية انقادت الجماعات إليها مأخوذة بوهم الحق والعدالة، والدفاع عن الفضائل المستباحة؟ والقوة من ورائها لاهية عابثة، تعد الأغلال والأكفان لهذه الجماعات بعد الانتهاء من جهادها؟ |
| وكم استغلت أطماع القوة، مشاعر الجماعات ومعتقداتها، باسم إقامة موازين الفضيلة والحق، حتى إذا بلغت غايتها بهم، أقامت موازين العسف والجور والرذيلة، عارية، مكشوفة...؟ |
| ما ننكر أن تاريخ كل أمة حية لا يخلو من محاولات إصلاح يقوم بأعبائها فرد، أو أفراد تصح نزعاتهم إلى الخير، وتصدق جهودهم في الدعوة إليه.. ولكن سرعان ما يبتلعها الزمن، وتطويها القوة. |
| ويستحيل أن تتحول تيارات الحياة الجارفة عن مجراها الطبيعي ليقوم ميزان الفضائل بحقه في قيادة الحياة، وتسيير دفتها. |
| ويستحيل أن تصاغ الحياة في قوالبها الأولى، وأن تعود إلى قوانين الفطرة القديمة، وأن يتقلص ظل التمدن الاجتماعي إلى حدود هذه الفطرة، ليعاد ترتيب الفضائل والرذائل على ما يضمن للحياة استقرارها وسموها، وفقاً لما يقننه منطق العقل الإنساني البصير! |
| وها نحن نزن الفضائل -كما هي في واقع الحياة- ونحللها ونسبر غورها فما نراها إلا ألفاظاً براقة، وخيالاً ساحراً، ومبادئ لامعة، لا يمكن أن يتكون منها روح عام لجماعة من الجماعات أو لأمة من الأمم؛ بعد أن تقدمت الحضارات واندفعت في سبيل القوة والطغيان؟ |
| ولا نرى الفضائل -في ما تمارس- إلا أنانية راسخة تقوم على النفع يرتجى، أو على اللذة تبتغى، أو على الأمل يطلب، هي وسيلة تحقيقه. |
| وهنا قد يسأل سائل عن سر إعجابنا بالفضائل؟ والجواب أنه ما من فضيلة تمارس إلا وفي أطوارها دلالة على قهر النفس، وكبح غرائزها، وجهاد لمطالب هواها، فلا جرم أن يكون إعجابنا بها، إعجاباً يؤدي معنى الاعتراف بقيمة شيء نجد صعوبة في اكتسابه، أو نحس هذه الصعوبة في اكتسابه، وما تغلو قيم الأشياء عادة إلا بمقدار الصعوبة في الحصول عليها، وإلا بمقدار الحاجة إليها. |
| والفضائل صعبة ولكن لمن يكون إيمانه بها إيمان تضحية لا تنظر إلى جزاء وبيت المتنبي: |
| لولا المشقة، ساد الناس كلهم |
| الجود يفقر، والإقدام قتال |
|
| تعليل دقيق لهذا الإعجاب، وإن كان تعليلاً ظاهراً للعجز الشائع عن السيادة والإقدام. |
| فالإيمان بالقوة ونفوذها، هو، حقيقة الحياة، وهو قانونها في القرن العشرين، وفي القرون الأولى، وفي أطوار الحياة القديمة البعيدة! |
| والدعوة إلى الفضائل حلم جميل بالحياة، كما يجب أن تكون، لا كما هي كائنة، حلم ما تحققه إلا القوة. |
| فمن يسعه أن يتكهن بأن الاتحاد مصير القوة والفضائل، والعالم مندفع في سبيل الطغيان والجحود..؟؟ |
| * * * |
| نتقدم الآن إلى تحليل بعض الفضائل وتجريدها، والمقابلة بينها وبين نقائضها، لنرى صحة قولنا أن الفضائل أنانية مهذبة، وأن الرذائل أنانية عارية. |
| فالكرم لا شك، صفة فاضلة، تنطوي فيها صفات تتعدد مسالكها ودلائلها، وهي ككل صفة، لم تنشأ هكذا كاملة السمات، بل تدرجت في سلم التطور حتى بلغت غايتها المعروفة. |
| وقد قلنا إن الإنسان في حياته الأولى، كان يمتحن بعواد من الجهاد ومفاجآته الطارئة، تتطلب المعونة والنجدة. |
| في هذا الطور قد يزيد من نشاط الإنسان الكادح، فضل يتخذه يداً على الجماعة، ولا تزيد من طعامه فضلة. |
| فالطعام يدخر، وفي عدم ادخاره استهداف لمضرة الجوع والفقدان، ولكن النشاط يبذل، وفي بذله منفعة، تعين على تمرين القوى وحفزها، وتعين على اتساع وجوه الحيلة، واستمراء لذة الظفر والاكتشاف، ونشوة انتشار الصيت، وهو بعد قرض واجب الأداء على الجماعة، في الغد الغامض، وضرورة من ضرورات التكتل لدفع المخاطر، والاستئناس والسلوة، وتقليل هيبة المخاطر المترصدة له. |
| فالنجدة إذاً أولى معاني الكرم. |
| والكرم لم يكن في أول نشأته تضحية وإيثاراً، وغراماً بالبذل، إنما كان -ولا يزال- دلالة افتخارية على اتساع نفوذ القوي، ومقدرته على مواصلة الجهد والإنتاج، على أنه لا يتناول إلا الزيادة، وسبيل تعويضها مجهودة هينة، بعد اتساع رقعة التجربة والسعي، وامتداد مذاهب الحيلة، وحنكة المزاولة، واتساع الثراء. |
| ثم هو بعد صفة لازمة لمن تحلهم قوتهم من الجماعة محل الأبطال والقواد، فالكريم أكثر أعواناً، وأبعد صوتاً، وأعمق أثراً في النفوس، وأرفع منزلة في العيون، ولا يزال في الناس من ينزلهم كرمهم منزلة الزعماء المسيطرين. |
| والكرم فضيلة متعدية، لذلك كان الثناء والإقبال على تمجيدها، أكثر من الثناء والإقبال على تمجيد العفة، مع أن العفة قهر صارم للنفس، ورمز للقوة، أكثر مما يكون الكرم الذي هو في معناه، وطبيعة دوافعه، انتفاء للخوف من الفاقة، أو توكيد للمقدرة، أو استغراق في لذة نفسه، أو سعي وراء مطلب أدبي، يكون أغلى من المادة المبذولة في نفس الباذل. |
| والبخل فطرة وشدة، تأخذ بحساب دقيق، وتعطي بحساب أدق، وهو رمز للخوف، وما يعيب الإنسان أن يخاف بل يعيبه أن يكون آدمياً. |
| والبخل إن كان رذيلة، فهو رذيلة لازمة إن كانت شراً في ذاتها فليست شراً على غيرها. |
| وهو إن دل على قصر الذهن، وفتور حيوية الفكر الطامح وضيق مدى النفس والخيال، في مجال المعنويات المنطلقة، دل على فهم عميق لطبيعة الحياة، وحقيقة الناس، ودخائل سرائره المطوية. |
| فإن كان الكرم شعراً وحماساً، وخيالاً جميلاً، كان البخل حكمة وفلسفة وفهماً عميقاً. |
| والكرم يعطي ليأخذ، والبخل اكتفاء.. وما عاب الناس البخل، إلا لما فيه من أثر الأنانية الواضحة، والاعتكاف في حدود الذات، ونحن نراه أنانية محدودة قانعة، ونرى الكرم أنانية واسعة جشعة، هما استرقاق النفوس والألسنة، وذيوع الفخار، وتحقيق المطامع، والاستمتاع باللذة الخفية. |
| * * * |
| والشجاعة ليست خلقاً طبيعياً في الإنسان فما يتصف بها الناس إلا اضطراراً، أو فراراً من عار، أو طمعاً في تحقيق غاية، أو منافسة لندّ، أو دفعاً لسبة، أو خطأ في تقدير نتائج المخاطر.. فبماذا من هذه الأسباب تستحق أن تدعى فضيلة؟ |
| والجبن في منطق العقل السديد، وليد الخوف، والخوف ليس منافاة للعقل، ولا للطبيعة الإنسانية، فهو أقوى غرائز الإنسان، وأداة شعوره بالأخطار، وسبيل تجنبها. |
| فإذا خاف الجبان مجهولاً، فشأن النفس البصيرة أن تخاف المجهول، وإذا خاف المجازفة، فإنما يرجح السلامة والهدوء. |
| إنما كان الجبن سبة أو عيباً، يوم كانت الدنيا قائمة على المجازفة، ويوم كانت حرباً شعواء بين الإنسان، ومطالبه الصارخة، وبين الطبيعة بأهوالها المتراكبة، ومخاوفها المطبقة، ويوم كان اقتحام المجهول، ولقاء المخاطر، ضرورة الفرد، وضرورة الجماعة، لضمان العيش والأمن. |
| ومن يستطيع أن يزعم إن ضنَّ الحي بروحه، وحرصه على صيانتها رذيلة إلا في منطق هذا العرف الآبد؟ |
| إن الإنسان إذا تغلب على وحي غريزته، فاستهان بالمخاطر واستمرأ لذة المجازفة، كان خارجاً من حدود غريزته وفطرته، داخلاً في حدود مطلب من مطالب الضرورة، أو مطالب العواطف واندفاعاتها، ولهذا حدوده الخاصة، فإذا لم تلد هذه الحدود، وإذا لم تلد عواطف الشجاعة واندفاعاتها، حجة يستقيم بها الإقناع في منطق الجبان، كان ذلك حقاً، وحقاً كله. |
| نعم إنه ليس من الرشد في عرف نفس اتسع مدى فهمها للحياة وشعورها بامتداد آفاقها، أن تفقد في سبيل صيانة النفس، أعز أعلاقها.. ولكن هذا مطلب من مطالب طور خاص، في حياة الإنسان، ونضوج ذهنه، فذاك حيث عد الجبن رذيلة، حتى بعد أن أدبرت الحياة البدائية أدبارها، واتسعت حدود الإنسانية بمعنوياتها الحافلة النازلة من الإنسان منزلة لحمه ودمه وأنفس أعلاقه. والشك في أن الجبن رذيلة، ما يزال قائماً في النفوس، وإلا لماذا جنح الناس إلى توليد فضائل نصفية منه، دعيت وزناً وتقديراً، وتبصراً واعتدالاً؟ وإلى توليد رذائل نصفية من الشجاعة، دعيت تهوراً وتطرفاً واندفاعاً؟ أليس لأن القرابة بينهما واضحة؟ |
| والحق إنا نرى القرابة بين معظم الفضائل ونقائضها وشيجة، والتداخل واضحاً. |
| وما نعتقد التفرد بهذه النظرة، أو السبق إليها، فقد قاد الشعور بهذا التداخل -في ما نرجح- بعض الفلاسفة قديماً وحديثاً إلى اعتبار الفضيلة، وسطاً بين رذيلتين، فالكرم عندهم وسط بين رذيلتين، البخل والسرف، والشجاعة وسط بين رذيلتين، الجبن والتهور. |
| ولكن ثمة فضائل لا تقبل هذا التقسيم، فبقيت على الشذوذ وسط ذاتها، فالأمانة، والصدق، والعفة، وأمثالها، لا تنزل فضيلة منها منزلة وسطاً بين رذيلتين. |
| فالأمين يكون أميناً كلما بالغ في أمانته، والخائن يكون خائناً مهما قصر به مدى خيانته، ويكون صادقاً أو كاذباً، ولا وسط، وللمبالغة بعد، حدودها وصيغها الفكرية واللغوية. |
| فهل نلام على الشعور بأن العدالة المنطقية، لم تعط الرذائل والفضائل حقها من التقدير والفهم الدقيق؟ |
| هذه رذيلة الحقد، لماذا عدَّت رذيلة؟ |
| أينقص بالنفس أو ينحدر بها، أن تحقد على من أساء إليها، أو اغتصب حقاً من حقوقها، حتى ينصرف بغيظها الانتقام والاسترداد؟ أو ينصرف به العفو بعد الظفر؟ |
| وهذه فضيلة العفو القادر! أليست أبلغ الانتقام وأدهاه، والانتقام الذي يتضمن الشماتة البليغة والتقريع اللاذع، للضعف المنكر بعد اعترافه بالهزيمة؟ أليست عدول الكبرياء عن تشديد التنكير على الجسد، إلى تشديد التنكير على الروح؟ أليست الانتقام الذي يفثأ غليان النفس، ويطفىء أوارها ثم يستلّ في دهاء سخيمة قلب الضد المندحر ويكسر سَورة الشر فيه..؟؟ |
| في ما بين معظم الفضائل والرذائل إذاً من الفروق، ما بين الظلم والعدل، والحسد والغبطة وأمثالها. |
| هذه أضداد ونقائض، وتلك قرابة ومجاورة، وما على هذا الظن غبار، ما دامت النفس الإنسانية، وطبائعها الأصيلة، المنبع الذي استمدت منه الفضائل والرذائل خصائصها وسماتها وإنباضها. |
| * * * |
| والقناعة كانت فضيلة -ولا تزال فضيلة الصابر المحروم- لأنها رمز الاكتفاء القوي عن الناس، والتحكم في مطالب النفس، وحد طماحها، ترفعاً عن التدلي لالتماسها منهم. |
| ولكنها اليوم فضيلة خاملة، توشك أن تنقلب رذيلة، في عرف الحياة الراهنة، ومصطلحات طورها الحديث، فهي معدودة في الفقير تسليماً بالعجز عن إدراك الرغائب، وفي الغنى دلالة الاستكفاء. |
| ولو قلنا إنها في الغني والفقير، دليل سمو النفس وترفعها، لم نقل حقاً. |
| ولا يسعنا أن ننكر أن قناعة الفقير والضعيف والعاجز، عزاء يلتمس لتخفيف وطأة الشعور بالحرمان، عن النفس. |
| وهذا المتنبي يقول: |
| كل عفو أتى، بغير اقتدار |
| حجة لاجىء إليها اللئام |
|
| فالعفو عنده لا يكون إلا من قادر، وهذا مطابق للاصطلاح. فلماذا لا تكون القناعة فضيلة -إن كانت- إلا ممن تتوفر فيه المقدرة على تحقيق الأطماع. |
| والتواضع توكيد للذات، وإيمان عميق بها، ويخطىء من يظنه إنكاراً للنفس، واعترافاً صادقاً بضعفها، وهو لهذا لا يكون في أروع صوره، وأكثرها فتنة، إلا إذا جاء دلالة على قوة ممتازة. |
| والكبرياء أنانية واضحة لا تعرف الدهاء والحذق، فهي رذيلة ظاهرة. |
| ولو قابلنا بين الإيثار والأثرة ألقينا الإيثار أكثر جشعاً، وأوضع طمعاً، فالإيثار نظر حاذق إلى ضمان فائدة الحب والإعجاب في الحاضر، وما يفيد بهما في المستقبل، والأثرة نظر ضيق إلى ضمان فائدة في الحاضر، تقتصر على المادة، فهي عارية لا تتستر، فتتيح بوضوحها الفرصة للمقاومة والفهم والحكم الدقيق. |
| فالمتكبر، والأناني الأثر، أقصر نظراً إلى مصلحتهما، وتوسيع حدودها. |
| * * * |
| والاعتراف بالنقائص فضيلة دون شك. ولكنها أيضاً فضيلة ذات مغزى نفعي كالتواضع، فما يعترف إنسان بنقيصة فيه، إلا وهدفه أن يتصف بالكمال في ناحية أخرى، هي أكبر عنده وأغلى. |
| والعفة لم تكن رياضة عسيرة للنفس وجهاداً مستمراً لغرائزها، وقمع شهواتها الملحة، إنما كانت مطلباً من مطالب الحياة الاكتفائية الحريصة على أن تبقي لها ذخيرتها من النشاط والقوة، حيث كانا سلاح الحياة، وأداة صيانتها وإنما كانت دليل الزهد في مناورة الجماعة، لضرورة الحاجة إلى حمايتها، والاستقرار فيها. |
| فهي في هذا القياس صفة لا أثر فيها للترفع الأدبي المختار عن انتهاك الحرمات. |
| على أنها قد تكون عجزاً وفتور حيوية! |
| ومن يرى أن عفة الشيخ في طور كلامه واسترخائه فضيلة، إنما هي فضيلة السن، وقانون الفتور، وليست فضيلة القوة والصبر والمغالبة، كما هي في الرجل المشبوب القادر على تأمين مطالبه. |
| * * * |
| والكذب يقل حيث يقل التزاحم على أسباب العيش، فهو في القرية، أقل منه في المدينة. |
| ففي القرية يعيش الناس على الزراعة مثلاً، وعلى العمل فيها، أو على أسباب محدودة للعيش، فلا مجال للتنازع، ولا للشعور بالحاجة إلى الرياء والملق. لوضوح استقلال الحياة واكتفائها، فما يكرم الإنسان فيها طمعاً في ماله، ولا يكذب عليه للاحتيال على الزلفى إليه، ولكن يحب لسجايا الخير فيه، أو يخشى جانبه لقوته البدنية مثلاً، وهذا يدعو إلى تحاشي سبيله أكثر مما يدعو إلى تملقه والكذب عليه. |
| لكن الكذب في المدينة العامرة، ضرورة اجتماعية واقتصادية، تعين على الرواج، وانتعاش حركة التبادل، والإقناع، فلو ساد الصدق فيها، أصيبت مجالات الحركة والنشاط، بركدة، يتضاعف معها الشعور بأعباء الحياة وهمومها. |
| والكذب دليل فقدان الثقة بنفع الصدق، وهو أكثر الرذائل نسلاً، وأرشقها دخولاً على النفوس، وأوسعها حذقاً. |
| فالرياء، والتصنع، والغيبة، والخداع، والمكر، والمداهنة، والمداورة، والمصانعة، والنفاق، والغدر، والدهاء... من مواليد الكذب ومركباته. |
| وقد ضمن له هذه الكثرة، الشيوع والسيطرة، وضيقت مجال الصدق حتى اعتبر خشونة، وجهامة، وقلة بصر بالحياة والسذاجة. |
| * * * |
| والصبر والثبات -على أنهما من الصفات الفاضلة، كانا ضرورة من ضرورات الجهاد للعيش، فما يلجأ الإنسان إليهما إلا وهما ضرورتان، لا رجاء في درك مراده إلا بهما. |
| وقد يكون معقولاً أن يزهد الإنسان في بث فكرة أو مبدأ أو إقامة حقيقة، متى أضنكه الجهد، وناء به في هذه السبيل. |
| لكن الإنسان الساعي لقوت يومه، أو إقامة مأواه، أو مطاردة فريسته أو دفع خطر داهم عن نفسه، ما يجد بداً من الصبر والثبات، لأن خيبته هنا لا تقطع عليه لذة فكرية، لا يستحيل العيش بفقدانها، بل تقطع عليه أمل نشاطه، وقوام حياته، ومادة بقائها. |
| هذا في الأطوار القديمة.. |
| وفي أطوار الارتقاء، يكون الصبر والثبات، ضرورة يمليها قانون التجارب وقانون الرغبة في سداد السعي، والحرص على ألا تفقد النفس مطالبها، وألا تألف الاندحار والخيبة، فتفسد بهما عقيدتها في قوتها ومضانها، أو عقائد الناس فيها. |
| والأمانة شأنها هذا الشأن أو ما يقاربه. |
| فقد كانت -على الأرجح- دليل سيطرة القوي، وندرة مثاله، ودليل الثقة باستغنائه عن الطمع في أعراض يكثر مثلها في ما يحرز أو في ما يستطيع. |
| ولا شك أنها كانت مقصورة على من هيأت لهم قوتهم من امتداد النفوذ بين الجماعة سبيل السلطان عليها، فهي سمة القوي الذي لا تحد حريته وشهواته، إلا قيود قوته وحدودها. |
| وهي اليوم ضرورة لصيانة السمعة، واستجلاب الثقة والفرق من اختراق حدود القوانين، والاستهداف للمضرة والانهيار، وجرح العزة والشرف. |
| ونحسب أنه لو حلت الإباحة والإطلاق محل التحريم، والتقييد في قوانين الحياة الوضعية، لكانت الخيانة، واستباحة الحقوق، واحتجان الودائع، أول زلزلة تصاب بها البشرية عامة، إلا من عصم الله، وعصم الإيمان به. |
| * * * |
| قسنا الفضائل والرذائل -أو بعضها على الأصح- بهذا المقياس الذي لا تقاس به الأشياء إلا مجردة عارية، مما أضفت عليها خيالات القرون، والأفكار الذهنية والمدرسية.. ونعتقد أنه لم يعد لنا معدى عن الاعتراف بأن الفضائل في مراميها الخفية، أنانية مهذبة، ميزان الربح والخسارة فيها قائم منصوب. |
| وجملة القول إن معظم الفضائل لا تنتسب إلى أشرف عواطف الإنسان أو غرائزه؛ بل تنتسب إلى أنانيته، وشعوره الخفي بالمصلحة. |
| ولم يكن حكمنا على الفضائل وتجريدها إلا تقديراً دقيقاً، لأثرها الحقيقي في الحياة، وعلاقاتها بالنفوس. |
| وقد رأينا أن بعض الرذائل، ألصق بالحياة، وأقرب إلى طبائع النفوس من الفضائل... ويؤلمنا أن تكون المماراة في هذا ضرباً من العبث. |
| ونحن لا ننكر أن الفضائل في حقيقة معانيها ومطالبها جهاد صادق للسمو بالنفوس إلى آفاق من الحرية والخير، تخرج بها من حدود المادية الجامدة، وترتفع بها عن قوانينها الترابية ولا ندعي أن الإنسان قدير على أن يأتي بأشرف ما فيه من خارج نفسه وطبائعه، ولكنه مطالب بأن يحول ما فيه من نزعات الشر والأنانية إلى أسمى مطالب إدراكه العقلي والوجداني، كما تحول الرياضة العنيفة، لحمه المترهل إلى عضلات قوية. |
| * * * |
|
|
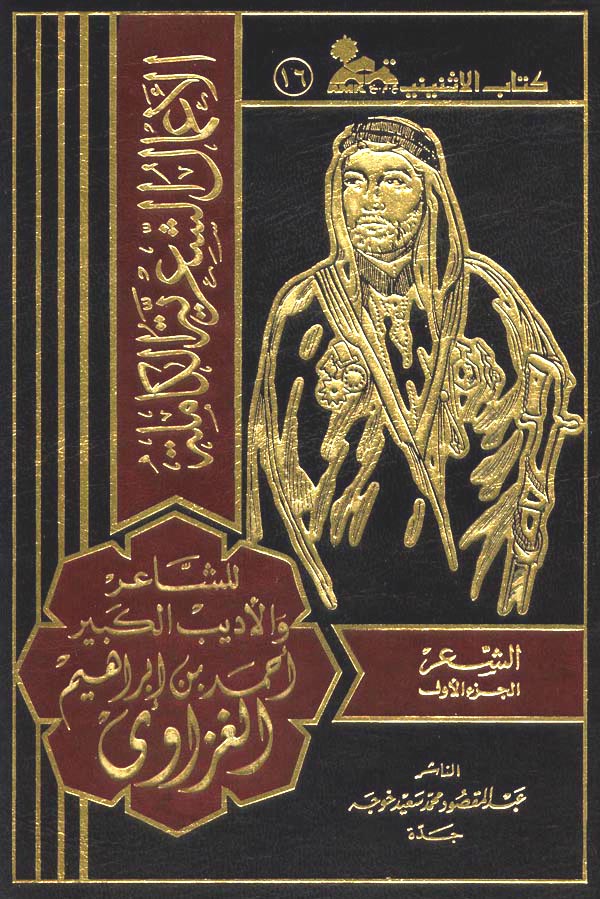
 شارع عبد المقصود خوجة
شارع عبد المقصود خوجة 00966-12-6982222 - تحويلة 250
00966-12-6982222 - تحويلة 250




