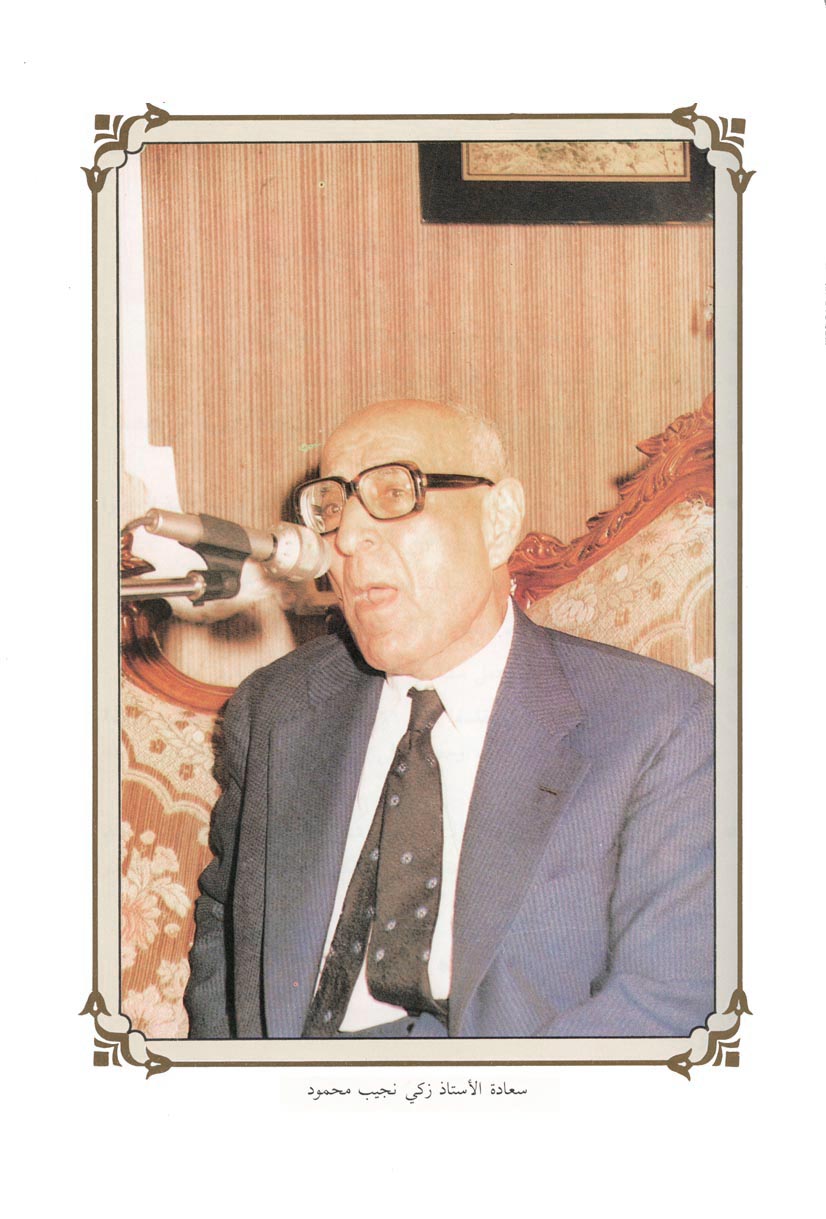| الأيَّـام الأخيرة وَيوم الودَاع |
| وتلاحقت الأيام وتتابعت، وأخذت أخبار عبد العزيز الرفاعي الواردة إلى أحبته في السعودية تأخذ حيزاً كبيراً من اهتمامهم وأصبح هاتفه في منزله في "آخن" مشغولاً، فما إن يضع السماعة بعد أن أجاب على مكالمة أحد أصدقائه الذين يريدون أن يطمئنوا على صحته حتى يرن الهاتف من جديد فيرفع السماعة ليجيب مستفسراً آخر يسأل عنه وكيف أصبح؟ وفي نهاية كل مكالمة هاتفية من صديقه المهاتف، يذكّره أن لا ينساه من الدعاء، ويبدو من نبرات إجاباته على أسئلة السائلين، كأنه يقترب من العافية، وان الداء يجمع حقائبه ليرحل، بعد أن فقد قوة الاحتمال على الاستمرار تحت وطأة استعمال الأدوية الكيماوية والأشعة فوق البنفسجية وما صاحب ذلك من العقاقير الطبية. |
| ولم يدرك السامعون وهم يصغون إليه وهو يحدثهم بصوته الواضح، وكلماته البينة، أنه هو الذي يشد الركاب ليرحل ولكنه لا يريد أن يبدو ضعيفاً، رغم أنه يقاسي أشد أنواع الألم، لأنه نشأ قوياً يصارع الفقر ويقاوم الضعف، ولم يرض بالخضوع، بل عاش أنفِاً كريماً غيرَ شرس يأخذ الحق بلا تجاوز، ويحلم عن المسيء في غير لين ولا ضَعف. وهكذا عاش وعرف بين أهله وأنداده. |
| وكنت أحدَ الذين هاتفوه في غربته في ألمانيا عدةَ مرات لأطمئن في كل مرة على صحته، وعلمت منه ذات مرة أنه لم يعتق قلمه من قبضة يده فهو سجين سبابة يده اليمنى ووسطاها وثالثة الأثافي إبهامها، وهذا دليل قوة الاحتمال عند عبد العزيز الرفاعي - رحمه الله - أن ينشغل بالقراءة والكتابة والمراجعة والبحث، وهو في تلك الحالة التي يشق على المرء أن يفكر في مثل هذه الأشياء، بل ربما يكره أن يُحَدِّثَه أحد عنها لكن عبد العزيز الرفاعي شبّ قوياً لا يعرف الكَلَلَ، وجاهد نفسه جهاداً كبيراً، لا يقوى عليه إلا من رحم الله، ومنحه القوة والقدرة على النهوض بالمسؤولية، وإنه لمن المعروف أن أشدَّ جهاد في حياة البشر هو جهاد النفس الأمارة بالسوء، ولقد استطاع عبد العزيز أن يروضها ويخضعها فانقادت له يسيِّرها كما يشاء، فلا غرابة أن ظل عبد العزيز الرفاعي يحادث الناس ويهاتفهم، ويتلقى مكالماتهم، دون أن يلمِسُوا أو يحسوا في حديثه وكلماته ضعفاً، أليس من قوة احتمال الرفاعي وصلابة عوده أن يكتب شعراً هز به مشاعر القراء في فترة تَعبِثُ فيها مشارط الداء في جسده، وكأن فراش نومه حُشيَ بجمر الغضا، فلا على جنبه يستريحُ، ولا وسادة ظهره تريح، وفي صدره تلتهب التباريح، عيناه مشنوقتان بقضبان السهر، ولسانه رطب بذكر الله، وكأني به يردد في كل لحظة: اللهم إني لا أسألكَ رد القضاء، ولكني أسألك اللطف والرفق فيه. |
| وفي الأسبوع الأول من شهر ذي الحجة عام 1413هـ تلقيت مكالمة هاتفية منه من مسكنه بآخن بألمانيا عزاني فيها بوفاة أم زوجتي، فأكبرتُ فيه هذا الخلق النبيل أيعزّيني رجل يقاسي صرعاتِ الألم في ألمانيا ويمتنع عن تعزيتي مَنْ هم إلى جواري؟ ولكن لا غرابة، فالرجل كان لي نعم الأب، ونعم الأخ، ونعم الصديق، ونعم الراشد، وكان في نظري بقيةََ الرجال حقاً. |
| إذا قيل: إن الرجال معادِن، فقد كان الرفاعي أغلاها وأنفسَها، ما وُضِعَ في كِفَّتيْ ميزانٍ أيّاً كان هذا الميزان إلا رجح بالكِفِة التي هو فيها. |
| وتعاقبت الليالي والأيام، وتوالت الأخبار عن تدهور صحة عبد العزيز الرفاعي، واشتداد وطأة الألم، وقرر عبد العزيز العودة إلى الرياض لتلقي العلاج بالمستشفى التخصصي، طالما أن العلاج الذي يتلقاه بمستشفى آخن له نظير في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، ولم يضنَّ ولاة الأمر بالمملكة العربية السعودية والمسؤولون وهم يعرفون إخلاصه ووفاءه وولاءه وصدق انتمائه لهذه المملكة ولحماتها فأرسلوا إلى ألمانيا طائرة خاصة لنقله إلى الرياض ومعالجته بالمستشفى التخصصي وتم ذلك. |
| وخلال إقامته بالمستشفى التخصصي، زاره الكثير من أحبابه ورواد ندوته وعشاق قلمه ومتابعي سيرته الأدبية والثقافية، وقد لمَس الجميع فيه قدرته على جذبهم إلى أحاديث الأدب كلما شعر أنهم أخذوا يفكرون في حالته الصحية المتدهورة، وكان يبتسم لهم بين فينة وأخرى ليشعرَهمْ أنه يتماثل للشفاء. |
| واتصلت به هاتفياً من جدة مرتين أو ثلاثاً، وفي المرة الأخيرة كانت كلماته متقطعة، فأحسست أنه يمر بمرحلة حرجة وان عليَّ أن أزوره وألقي نظرة عليه قبل أن يودِّعَ الدنيا ويرحل دون أن أراه، خشية أن تنالني عقب رحيله دون أن أراه مرارة وحسرة شديدتان. فهيأت نفسي للسفر وتوجهت إلى المطار وقطعت تذكرة إركاب إلى الرياض كان ذلك صباح يوم الأربعاء الثاني والعشرين من شهر ربيع الأول عام 1414هـ وفور وصولي إلى مطار الرياض أسرعت إلى استئجار سيارة أجرة وانطلقت بها إلى المستشفى التخصصي ولم أجعل للتفكير فرصة لتأخيري عن المهمة التي جئت من أجلها فدلفت إلى داخل المستشفى وما شعرت إلا وأنا أمام باب الغرفة التي علمت من جدة أنه كان يرقد فيها. قرعت بابها حتى كلّ متني فلم يجبني أحد. بدأ الدوار يقلب رأسي في كل اتجاه وأنا واقف أمام الباب لم أستطع أن أفوه ببنتِ شفة. استرجعت قواي ولمحت أحد الممرضين يقف بجواري ويسألني قائلاً: عمن تسأل؟ فقلت له أليست هذه الغرفة التي يرقد بها معالي الشيخ عبد العزيز الرفاعي؟ فأجاب: بلى لقد كان، فاضطربت وسألته: وأين هو الآن؟ |
| فأجاب: لقد نقل إلى جدة، فقلت له : أنا لا أحب الإيجاز، أوضحْ لي أكثر فإن مداركي الآن لم تعد قادرة على الاستيعاب، والإجابات المختصرة تحرمني الكثير مما تعني، فتلطف مشكوراً وقال: لقد نقلته طائرة خاصة إلى جدة ولكن لا علمَ لي بشيء بعد ذلك. |
| صرعتني الإجابة، أوثقتني، قطعتُ ممرات المستشفى أمشي على مهل، كأنني سجين موثَق الرجلين. غادرت المستشفى وركبت السيارة وأنا أضرب أخماساً بأسداس، وأطوف بخيالي شوارع الرياض، وأستذكر أسماءها وأسترجع أسماء رواد ندوة الرفاعي المقيمين بها لأهاتفهم لعلني اظفر بمن يَهديني إلى الجهة التي نقل إليها. |
| وفي طرفة عين برقت ومضة سريعة في ذاكرتي من تلك الومضات التي توقظ الذاكرة وليست من التي تذهب بالإبصار وأظهرت على شاشة الذكريات الأخ أحمد باجنيد وهو الشخص الذي تعهد بإحياء خميسية الرفاعي خلال فترة غيابه. توجهت إليه وسألته عن مصير عبد العزيز الرفاعي فقال لي: ما المسؤول بأعلم من السائل. فقلت: إذن فهناك شخصية محبَّبة إلى عبد العزيز هي شخصية عبد الله علي بامقدم فبين الاثنين صلات قوية وحميمة ولا بد أن يكون على علم به، دعني اتصل به، فهاتفته فأخبرني بأن الرفاعي ساءت حالته ودخل في غيبوبة ورغبت زوجته أن ينقل إلى جدة حتَّى إذا أدركته منيته، دفن بمقابر المعلاة بمكة، وقد حقق المسؤولون لها رغبتها فنقل فجر هذا اليوم إلى مسكنه بجدة. |
| طلبت من الأخ أحمد باجنيد أن يأذن لي كي أعود إلى جدة فأصرَّ على بقائي حتى المساء، طالما أنني لا أحمل في جعبتي حجزاً مؤكداً، وألحَّ عليَّ أن أتناولَ معه طعامَ الغداءِ في منزله، وهو طلب من رجل كريم، والكريمُ لا يُردُّ طلبُه، فأجبتُه إلى ما سأل. |
| في المساء توجهت إلى المطار وخلال المسافة التي قطعتها من حي الروضة إلى المطار، وأنا أسبح في خضم أفكار قاتمة، كان لحديثي مع الأخ أحمد باجنيد شأن كبير فيها. فقد تجاذبنا أطراف الحديث بل قتلناه بحثاً وذكرى واستعرضنا خلاله كثيراً من الجوانب الإنسانية والأخلاقية والاجتماعية والعلمية التي كان يتحلى بها عبد العزيز الرفاعي والتي ولَّدت في أنفسنا له الحب والاحترام والتقدير، والتي علمت ألسنَتنا كيف تتحدث عنه. |
| لم أدرِ كمْ من الوقت صرفت في قطع هذه المسافة حتى وصلت مطار الرياض - لم أجد مقعداً لركوبي إلى جدة إلا على الرحلة التي تُقلعُ إلى جدة بعد العاشرة والنصف فما وجدت حيلة إلا أن أقر بالواقع فوافقتُ. فتحت باب شقتي بعد منتصف الليل بنصف ساعة، كان الوقتُ متأخراً لا داعيَ لإزعاج عائلة الرفاعي بالسؤالِ عنه في هذا الوقت. إن الصبحَ لناظره قريبُ، فلننتظر الصباح. |
| أشرقت شمس صباح يوم الخميس 23 ربيع الأول عام 1413هـ واستيقظت وهيأت نفسي للذهاب إلى مسكنه بمشروع الأمير فواز السكني ولكني تمهلتُ اعتقاداً مني أن الوقت ما زال مبكراً فأخذت نفسي لأقضي بعض المآرب المنزلية، وحين عدت إلى البيت حوالي الساعة الحادية عشرة، نبئت أن أحدَ الأخوة نعى بالهاتف عبد العزيز الرفاعي الذي انتقل إلى جوار ربه، فجر هذا اليوم الخميس وأنه سيصلى عليه بالمسجد الحرام بعد صلاة الظهر وسيدفن بمقابر المعلاة بمكة. |
| نزل عليّ الخبرُ كالصاعقة، تركتُ كل شيء وهرولتُ إلى السيارة، وانطلقت مسرعاً إلى مسكنه، كي أشاركَ أهله في الصلاة والدفن. |
| وجدت الدار هادئة، وليس أمامَها أية سيارة، فخالجني شك كبيرٌ، لكنه سُرعانَ ما تبدَّد حينما أبصرت الأخ عبد الله علي بامقدم وقد قدِم من الرياض لحضور مراسم الدفن، وبجواره الأخ سعود سجيني وكانا يعتزمان على الذهاب إلى مكة بعد أن تيقنا أن الجنازة قد سبقتهما فرافقتهما إلى مكة. |
| لم أتمكن من رؤيته قبل وفاته، وكانت رغبة في نفسي أكيدة، لكني حظيتُ بالصلاة عليه، والمشاركة في مراسم دفنه، وعزَّيتُ أهله وذويه بمقابر المعلاة، وكان مشهداً عظيماً. |
| وطُويتْ بذلك الصفحة الأخيرة من رحلته الأخيرة، بل الحقيقة لم تُطْوَ وإنما تزاحمت الكلماتُ على السطور، وبلّلتْها الدموعُ، وأضاءتها الشموعُ، ووقفت في السطر الأخير الجموع، تُردِّدُ: رحم الله عبد العزيز الرفاعي رحمةً واسعةً وأسكنه فسيحَ جناته. |
|
|
 شارع عبد المقصود خوجة
شارع عبد المقصود خوجة 00966-12-6982222 - تحويلة 250
00966-12-6982222 - تحويلة 250