| المحاضرة (3) |
| لم يكن في حياة الإنسان القديم فقر، ولا غناء، ولم تكن هناك طبقات وفوارق، كانت الثروة جسداً قوياً، والسلاح قوة. (هذا أقل قوة، هذا قوي، هذا أقوى) وكانت المشاعر واحدة، والغاية واحدة والسبيل واحدة. |
| لذلك يكون الشذوذ على المطلب الجماعي الأدبي، ضعيفاً، ومتقطعاً وخافتاً. |
| فإذا كان العهد الجديد أكثر رخاء، وأكثر أمناً، وهو هكذا قطعاً، كان الاستغناء المفروض عن هذه القلة الشاذة، وعما تؤديه ممكناً جداً. |
| فمتى ساهم الفرد في رد الغارة عن جماعته، وفي أداء نصيبه من الجهد إزاء الأخطار التي تهدد طمأنينتها، ومتى عال نفسه وأسرته وشارك الجماعة في حمالاتها، وتبعاتها المادية، كان قيامه بالفرائض في شريعتها الجديدة شيئاً اختيارياً، له قيمته، وله جزاؤه في العرف والاعتبار الأدبي فإذا شح بما يقتضيه العرف على الضعفاء والشيوخ، كان جافياً على نفسه، وعلى درجة اعتباره المعنوي بين الجماعة. |
| هكذا تشعر القوة الممثلة للشريعة الجديدة، والقوة الخارجة عليها في الابتداء... |
| ولكن الحوادث تلعب دورها بينهما، بعد... |
| تبدأ الخصومة بين الضعف الذي كان مصدر قوة التشريع، وسبب وضعه والذي نازل القوة فهزمها، وحبب إليها الهزيمة، فأصبح مصدر السلطة الروحية في قانونها الجديد وبين القوة التي رجحت اعتزال الجماعة، والخروج على قانونها. |
| يبدأ التنكر والعراك بينهما، هادئين ثم مخيفين. |
| وسواء أشرع الضعف (المتسلط) قانونية هذا العراك الشعري أو شرعه الأقوياء الفضلاء باسمه فإنه المصدر. هكذا انشطر تقديس القوة -التي مظهرها كفاية الجسد- إلى شطرين. كما انشطرت القوة إلى شطرين، تحول أحدهما إلى قوة ذات سجايا نافعة لجماعة الضعفاء فاتسع أمامه مجال التطور، والظهور والتأثير، لأنه قوة نبيلة معقولة، والآخر قوة لا تخرج من حدود ذاتها الضيقة. |
| الأول قوة متعدية أو منصرفة. |
| والثاني قوة لازمة، أو جامدة. |
| ما زالت الفضائل المتعدية في القرن العشرين، وفي جاهلية الجماعات أكثر أعواناً، وأكبر نصيباً من تقدير الناس وإقبالهم. |
| والعراك دائماً يخلق ميادين النشاط والتزيد ويوسعها، وهذا عراك السجايا بين قوتين.. عراك جديد، لأنه نمط جديد. |
| فالفضائل الناشئة في هذا التطور تكون مظهراً للاختيار والقصد أولاً، أو مظهراً لضرورات أدبية، ثم تستحيل ممارستها، والحرص على الإنصاف بها إلى نوع من اللذة الخفية، وتداعي الشعور بحلاوة ما تلقاه من إعجاب وتشجيع ومناصرة. |
| والعزلة تتخذ مظهر الحرد والعناد والإصرار لما تلقاه من مقاومة وزراية واستغناء عنها فتمعن في ما يزيد حنق الجماعة ويسيء إليها.. هذا مفترق الطريق للقوتين. |
| وليس في تغلب قوة على قوة تماثلها في ميادين التطاحن، شر ولا نذالة كلتاهما تعمل للبقاء والسيادة، وكلتاهما تدافع عن حق تراه حقاً، فالنزاع بينهما مشروع، كما كان النزاع بين الإنسان والحيوان مشروعاً. |
| لكن قوة الخارجين على الشريعة الأدبية للجماعة هنا، لا تنازل قوة تماثلها، بل تنازل ضعفاً.. تحميه قوة.. فالانتصار عليه نذالة ولؤم. |
| هكذا يتولد الشعور بالرذيلة، وفهمها واضحين. |
| بدأت الفضيلة قوية مؤزرة، وبدأت الرذيلة ضعيفة متكورة. |
| ما تزال صرخة الفضيلة أقوى، في نفوس الجماعة. |
| ألمانيا تقول الحق، العدالة، المنطق. |
| انجلترا تقول الديمقراطية، نصرة الضعيف، حماية المبادئ الفاضلة. |
| لا يوجد من يقول الاغتصاب، العدوان، سحق الضعيف، الطمع لأن الرذيلة لا تنتصر إلا متى كان صوتها قوياً، وصوتها لا يكون قوياً إلا إذا نفخت في بوق الفضيلة. |
| هذا في حياة الأمم مثله في حياة الأفراد، وهو في القرن العشرين مثله في القرن العاشر، ولكنه لم يكن هكذا في حياة الإنسان القديم. |
| كانت الفضيلة حينئذٍ حقاً، أو شبيهة بالحق، وكانت صفات لازمة أو محبوبة ترتاح إلى ممارستها النفوس ولا تستغلها. |
| القوي الذي يعطف على الشيوخ، والنساء، والأطفال: أقوى، أحسن، أفضل (حب). |
| القوي الذي لا يعطف على هؤلاء رديء، قاسٍ (بغض). |
| القوي الذي لا يحب الجماعة، ويعتزلها، يحب نفسه، أناني (ازدراء). |
| اتسع دستور القوة قليلاً واتسع إدراك الجماعة قليلاً. |
| كان الإنسان يرى ويدرك بغرائزه، وضرورات حياته، فأصبح يدرك، بقلبه، بوجدانه بشيء من الشريعة الأدبية. |
| كان يرى قوة، وقوة، فيقيس بينهما ويفاضل (قوي، أقوى). |
| صار يرى قوة، وقوة وسجية، فيقيس بينهما، ويعلل، ويستنتج (حسن أحسن). |
| كان يكره الأقوى ويخافه، ويحسده، ويطيعه. |
| الآن يعظمه، ويحبه، ويتَّبعه. |
| صار مختاراً بعد أن كان مضطراً. |
| هذه خطوات الجماعة. |
| خطوات الفرد الخاصة غير هذه، تختلف كثيراً عندما ينفرد. |
| يرى الأنانية حقاً إذا كان قوياً.. |
| ويراها باطلاً إذا كان ضعيفاً. |
| ما تزال الجماعة أقل دقة، وأسرع إيماناً.. وأعمق استجابة، من الفرد. |
| * * * |
| تضيق حرية الفرد كلما تقدمت أطوار الجماعة اجتماعياً، وكلما تكاثرت الروابط الاجتماعية واتسعت الحدود لحرية الجماعة فيها. |
| لا يعود من مصلحة الجماعة، إطلاق الحرية للفرد، أو للأقليات، فتنشأ شرائع وضعية، يضعها الأقوياء، المسيطرون على الجماعة، تكون خلاصة لشرائعه الأدبية، التي تصبح بالتدريج معتقداً عاماً. |
| فالشريعة التي تكون فرائضها الأدبية، فرائض كفاية، أو فرائض اختيارية، تنقلب قانوناً لا معدى عن طاعته. |
| والمحاسن التي كان مصدرها الجسد والقوة، وجاء طور أصبحت فيه أساساً لشريعة أدبية يجيء عليها طور آخر، هو طور التلقي والمزاولة، لا بد أن تكتسب فيه صفة التقاليد الواجبة، ولا بد فيه من ممارستها، ومحاولة تحويلها إلى خصائص نفسية، وفكرية ثابتة (أخلاق ومعتقدات). |
| ولسنا نعني طبعاً في كل ما تقدم أن الإنسان في هذه الأطوار كان يضع الأسماء لمسمياتها على وفاق ما تشعر به إزاء إدراك معانيها، وشيوع الإحساس التام بها في نفوسنا، إنما نعني أن إعجابه بالقوة وبمحاسنها، وشعوره الأدبي بمعنويات الحياة والنفس، كان يقوم مقام هذه التسميات، ويرمز إلى مسمياتها أو إلى ما يشبهها. |
| ومن المؤكد أن تطور اللغة في الحياة الأولى لهذا الإنسان، كان أبطأ كثيراً من تطوراته الاجتماعية والفكرية، فالشعور والإدراك يسبقان عادة التسميات وألفاظها، تشعر أولاً أو ترى، أو تعرف، أو تسمى! |
| ومن المحزن حقاً انقراض الأصول الأولى للغات، فقد كان وجودها حرياً بأن يوسع آفاق حياتنا الفكرية، وبأن يحدثنا ألذ الحديث وأشهاه عن تواريخ تلك التطورات القديمة التي رافقت كفاح الإنسان في أطوار انتقالاته الاجتماعية والنفسية، والفكرية. |
| كيف حارب الإنسان؟ كيف كانت همومه؟ كيف فهم السجايا التي صارت أساس شرائعه الأدبية؟ وكيف سماها؟ كيف نشأت الآداب؟ كيف نشأ الشعر؟ كيف كانت أساليبه وموضوعاته؟ كيف غنى الإنسان؟ كيف تحمس وفاخر؟ كيف تعبد؟ كيف أحب؟ |
| هذه الحلقات المفقودة، جزء من تقدم شرائعه الأدبية، بل هي أهم أجزاء هذا التقدم ودلائله وهي سبيل الفهم اليقيني أو ما يقاربه. |
| * * * |
| قبل أن ننتقل إلى تحليل الفضائل نتحدث إليكم قليلاً عن طور التلقي والمزاولة، وهو الطور الذي يتحول فيه الشعور بالسجايا والأفكار والشرائع إلى معتقدات لا شعورية أو إلى خصائص نفسية وفكرية ثابتة. |
| الإنسان الصغير الجديد في الطور الثاني أو الثالث، يتعلم بسهولة، ما كان يتعلمه جده القديم بصعوبة، ويعرف ما عرف أبوه وأمه وأجداده، فهو يعرف أكثر. |
| كان الجد القديم يتلقى عن الضرورات، وعن الطبيعة، وعن التجارب، فأصبح الثاني يتلقى عن هذه، ويتلقى عن الجماعة، ذخائر تجاربها، ومحاسن حياتها، وغرائب اكتشافاتها ومعتقداتها، وفرائضها وأوهامها. |
| الحياة رخاء، وأمن، فهي متسعة، متعددة السبل. |
| كان الطفل القديم في الأطوار الأولى يخاف ويساهم بنصيبه في احتمال قسوة العيش وأعبائه، وهو اليوم يمرح ويلعب، ولا يحمل عبئاً، إلا ما كان من قبيل التمرين والمحاكاة حتى يشتد. |
| عرف الفكاهة والعبث، كما يفعل الكبار حين يلعبون حول النار. |
| الكبار ذوو سجايا، وخبرة، ورحابة فهم، فهو يقلدهم. |
| يراهم يمثلون الحوادث التي تقع بعيداً، حيث الصيد والمغامرات، ويقلدون الحيوانات، حركاتها وأصواتها، فيحاكيهم. |
| التمثيل قديم في حياة الإنسان، الأرجح أنه عرفه بعد أن عرف النار، وتجمع حولها للدفء واللعب والحديث. |
| والرقص فرع من فروع التمثيل، هذا معقول. |
| رجل لذعته النار، فقفز، وتوثب على رجل واحدة، وأمسك موضع اللذعة بيده. |
| هذه مفاجأة، يضحك لها الناس، لأن فيها شيئاً غير الجد المحض. |
| إذا قلده أحدهم ضحكوا أكثر. |
| هذا تمثيل، ثم رقص. |
| هكذا اتسعت الحياة رويداً. |
| الناس يمثلون، ويقلدون بعضهم في الجد وفي الهزل، تحبهم الجماعة. |
| الإنسان الصغير، يفعل فعلهم بسهولة، لأنه أذكى، طفولته أوسع مدى من طفولة جده، كذلك الطفل في المدينة الحافلة، أذكى من نِدّهِ في القرية وفي الريف، وأوسع أفقاً لكثرة ما يتوارد عليه من الصور. |
| يزاول الطفل الشجاعة، العطف، احترام الشيوخ.. الإحسان إلى الضعفاء، أعمال البطولة، بوحي من نفسه، وبإيحاء من أبويه، وأسرته، ومن الجماعة. |
| يزاولها على أنها فضائل يتحتم الإيمان بها، وعلى أنها محاسن وسجايا يتصف بها الأقوياء الممتازون. |
| فالفضائل أو بعضها في هذا الطور مزاولة وتقليد، يستحيلان إلى أخلاق ثابتة، ومشاعر، بعد قليل أو كثير. |
| والمزاولة أقدر على ترسيخ الفضائل، وتحويلها إلى مشاعر ثابتة، وأخلاق مغلغلة في النفس من أحكام الضرورات الطارئة والمتكررة. |
| * * * |
| أعتقد أني أسرفت كثيراً في سوق الأمثلة وحشدها، وأظن أنه لم يعد صعباً أن تساير جميعاً هذه الطريقة إلى حدود أبعد. |
| هذه الحلقات الأولى من السلسلة، أو الدرجات الأولى من السلم، فلم يبق ما يمنعنا من التصور.. والتخيل.. والمسايرة. |
| في وسعنا الآن أن نتصور ما يفعله التقليد، وما تفعله المحاكاة، وما تفعله ضرورات الطور الجديد، ومطالبه، في استكمال معاني الفضائل وإقامة حدودها، وفي ترسيخها، وتوليد المحاسن منها. |
| * * * |
| قلنا إن الغرائز هي مادة التكوين الباطن في الإنسان والحيوان. |
| وقلنا إن الضرورات المتصلة بالعيش، وبنداء الحياة الملح، دفعت الإنسان إلى أن يخرج من أفقه الضيق، إلى آفاق أكثر رحابة، خفتت معها أصوات غرائزه، وخفيت، أو تلطفت، على قدر عرافته في الاكتساب الاجتماعي من مراحل التطور التي يقطعها. |
| وقلنا أخيراً إن المزاولة والتقليد أقدر على ترسيخ السجايا، وتحويلها إلى مشاعر وأخلاق ثابتة، من أحكام الضرورات. |
| ونود هنا أن نجري التجربة على الحيوان، لتختبر صحة افتراضاتنا التي بنيت عليها هذه النتائج، ونصيبها من القوة. |
| فالحيوانات مزودة بإلهام غرائزها إلى حد الجمود، ولكنها قد تكتسب بالتجارب المكررة، ما يضعف عمل هذه الغرائز، ويحولها، فيهذبها، أو يزيدها قوة وضراوة. |
| ومفهوم أن مجال التطور الطبيعي أمام الإنسان، غيره أمام الحيوان، فنشأة العواطف في الإنسان، أو ذوبان غرائزه الأصيلة، وأنانيته الآبدة، لم يكن نتيجة عوامل شعورية، ووليد عوامل ضرورات حيوية، ثم معنوية، ثم أدبية، لا تخرج في شتى صورها وامتزاجاتها عن أنها ضرورات، متحولة عن ضرورات. |
| والحيوانات التي اتصلت أسباب حياتها بحياة الإنسان الاجتماعي، فقدت بعض غرائزها، أو خفتت أصوات هذه الغرائز فيها بعامل التدريب والتجربة. |
| فالكلب والقط يحبان الوطن كالإنسان، ويشعران بقانون أدبي محدود، لأنهما أكثر علاقة بالإنسان في محيط حياته الخاصة. |
| القط يألم للزجر، ويحزن لفقد سيده، ويعلن الحنين إليه، ويتأدب بدافع شعوره بالعطف عليه، ويفسد بانقطاع هذا العطف عنه، ويغار من قط يزاحمه على مكانته عند صاحبه. |
| والكلب يتعلم الأمانة والصبر والحب واليقظة والشعور بقوانين العشرة الأدبية، ويتأثر بالإحسان، والواجب، ويقلد الإنسان في شعوره بالحماية والفخار والزهو لأن صلته بالإنسان كانت ولا تزال أوسع نطاقاً، وأقدم عهداً. |
| وقد ينحط الكلب أو يتشرد، فيستحيل تأثير سجاياه القديمة، على ما يشبه الأسى العميق والجفوة الكئيبة. |
| والحمار -وعلاقتي الأدبية به قديمة جداً -وعفواً-، تضيق دائرة اتصاله بالإنسان، ولا تتخطى حدودها الضيقة، لذلك كان تطوره التخلقي، أقل مرتبة من تطور الكلب. |
| فهل كان هذا هكذا، لأن الحمار أضيق مدى في إدراكه الحيواني، وأصلب غرائز من الكلب؟ أو لأن هناك استعداداً غريزياً هيَّأ الكلب لأن يكون حارساً ورفيقاً، وللحمار أن يبقى كادحاً؟؟ |
| كلا!! |
| ولكن خفة جسم الكلب، وقوة صوته المتزنة، ودقة شمه، ومقدرته على تصوير مؤثراته، وتشكيلها بهذا الصوت، وقلة مُؤنته، وسرعة عَدوه، ساعدته على الدُّنو من الإنسان كرفيق وحارس، وطبعته التجارب المكرورة، وشعوره بضرورة إدراكها، بطابعها الخاص. |
| فيتضح مما تقدم، أن التقدم بغرائز الحيوان وتحويلها إلى طور الإدراك، والتعقل، ممكن، متى تعلقت وسائل هذه المحاولة بضرورات عيشه أيضاً، ولكن هذا التقدم لا يتم إلا بعمل التجارب، وبأن تجيء على يد الإنسان. |
| فالكلب في الحضارة الراهنة، ينقذ الغرقى، ويتعقب المجرمين ويُدعَى للشهادة في المحاكم، ويعاون الجنود، ويترصّد الأشقياء، ويخدم العدالة.. والمجال أمامه ما يزال واسعاً جداً للتطور. |
| وبعض الخيول ترقص على نغمات الموسيقى، رقصاً مدرسياً موزوناً، عفواً إخواني المدرسين وبعض القدرة العليا في أمريكا وأوروبا تعزف على آلات موسيقية عزفاً دقيقاً. |
| ولبرنارد شو -الفيلسوف الانكليزي- حمارة ما أشك في أن لها نصيباً وافراً من الإدراك تخطت به حدود بنات جنسها وأبنائه كثيراً إن اطرد القياس، وما له لا يطرد. |
| وكثير من الحيوانات تطرب طرباً هادئاً أو عميقاً، للحداء، والغناء، والموسيقى فهذا يشير إلى علاقتها القديمة بالفن؟ وإلى أن لها حساً غير حسها الحيواني. |
| حساً وجدانياً مثلاً.. |
| فهذه نتائج التدريب والتهذيب والمزاولة، ووحي ضرورات العيش، وتأثير المشاركة الطويلة في الحيوان. |
| يقابلها في الإنسان ضعف غرائزه الأولى، وما اقتضاه هذا الضعف من التكتل الجماعي، وما أدى إليه هذا التكتل من نشاط القوة التعقلية فيه، وما مهد له هذا التعقل من ضيق حدود أنانيته، وتحولها إلى غيرية أولية، حتى عرف القانون الأدبي بعامل شعوره العاطفي، وحتى أخذ توسيع مدى هذا القانون، متابعة لمقتضيات تطوره المستمر. |
| * * * |
| انتهى بنا الكلام إلى العهد الذي قامت به بعض الفضائل، التي صارت الجماعة إلى الشعور بها، والاستجابة لأحكامها، وكيف تتولى المزاولة والمحاكاة تحويلها، إلى أخلاق ومشاعر، أو ملكات نفسية، وفكرية. |
| أما كيف تتناسل الفضائل بعد ذلك وتتزايد، فجوابه عند حياة الإنسان الاجتماعية، واطراد جزرها ومدها، وعند تقدمه الفكري، واتساع أفقه. |
| ونظن أن القوة التي يمثلها الأبطال والزعماء، هي التي كانت ترتجل بعض الصفات التي تغري الجماعات بالحب والتقديس، وتحبب إليها الطاعة والانقياد والالتفاف، حول مرتجليها، فتحب وتدعي محاسن أو فضائل، وتدعي أضدادها ونقائضها، معائب أو رذائل. |
| فالقوة أقدر على الارتجال والوضع، لأنها أوسع مجالاً، وأوضح غنى، وأقدر على الاضطلاع بمسؤوليات ما ترتجل، وأعمق ميلاً إلى توسيع دائرة النفوذ، وإطلاقها. |
| ولا شك أن الطور الذي حارب فيه الإنسان، أخاه الإنسان (طور احتكاك الجماعات) هو الطور الذي كان يلد كثيراً من المعائب والمحاسن، والذي اتسع فيه منطق المقارنة والوزن والمقابلة، والمبالغة والتهويل. |
| فالجماعة القاهرة، تلجأ بعد إصابة غرضها الذي ساقها إلى الحرب إلى أساليب من المعاملة، تكفل الدوام والرسوخ لانتصارها، كإطلاق الأسرى، والعفو عن الجناة والمبالغة في إكرام النساء والشيوخ، والاضطلاع بحماية الضعفاء لاجتذابهم، واتخاذهم مثالاً مغرياً للمناهضين الأقوياء، وبسط اليد بالعطاء، وفرض قانون العفة. |
| وما يزال هذا مشاهداً في كثير من أحوال الفتح والاستعمار. |
| والجماعة المقهورة تعاب بالضعف، وتلفق ضد أفرادها المتسلطين حكايات يصنعها الوهم، أو يبالغ فيها. |
| في جاهلية العرب كانت الجماعات المنتشرة، تتنافس للاستهتار بالقوة، فما يتهيأ له هذا بالغزو، وقوة الشكيمة فيه، كما يتهيأ بانتشار القالة الحسنة عنها، وبذيوع المحمدة، فكانت شارة القوة والمتعة للجماعة، أن يكون أفرادها البارزون، وزعماؤها المسيطرون، كرماء وهابين، وذوي غيرة على الجار، وعطف على الغريب، وإكرام للطارق والقاصد، وحماية للاجئ المستجير. |
| وكان هذا التنافس نفسه، أسلوباً من أساليب الغارة والحرب، ودلالة على اتساع نفوذ المقدرة على الكسب والإنتاج. |
| وكانت لكل جماعة صحيفة أو أكثر، تنافح عن سمعتها، وتبالغ في نسبة الكمال والفضائل إليها، والشاعر هذه الصحيفة. |
| وكان هذا كله مظهراً لمذهب الفروسية الذي ساد في ذلك الطور الهمجي. |
| * * * |
|
|

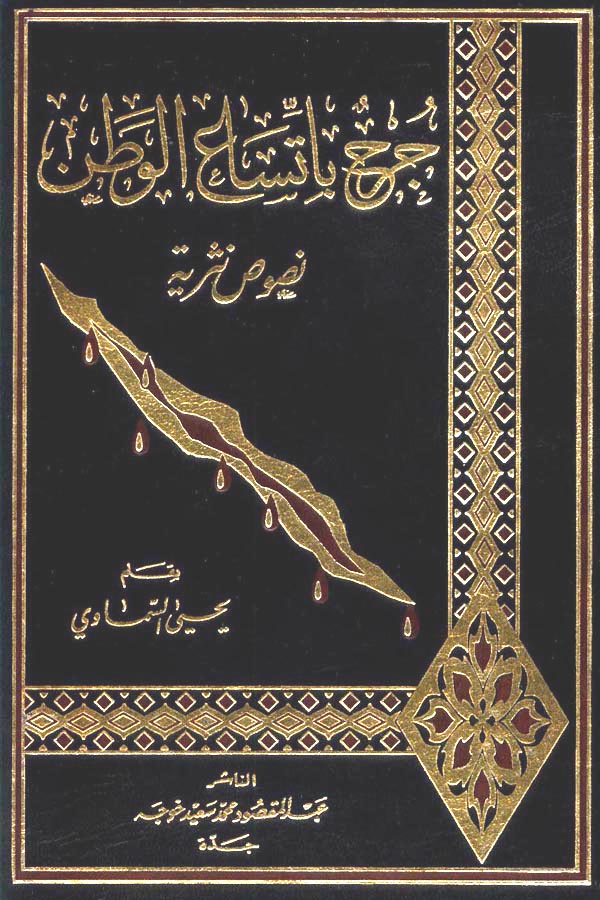
 شارع عبد المقصود خوجة
شارع عبد المقصود خوجة 00966-12-6982222 - تحويلة 250
00966-12-6982222 - تحويلة 250




