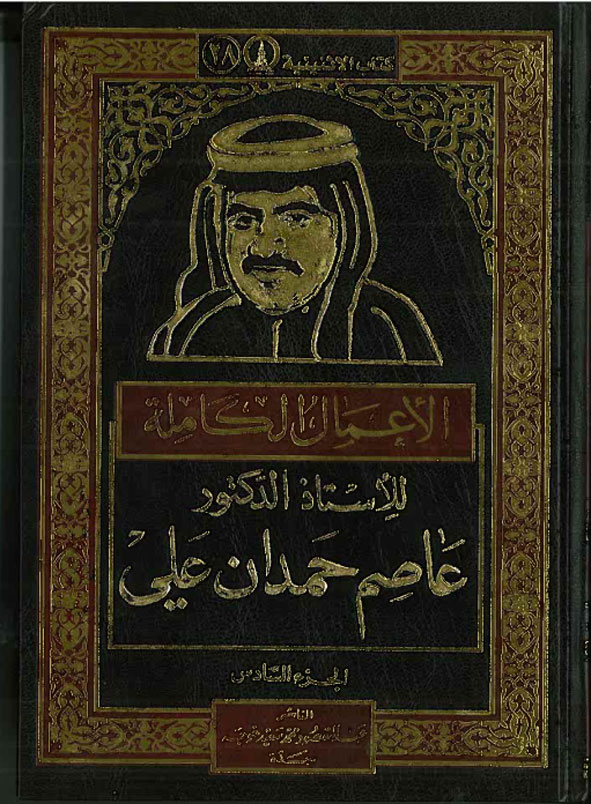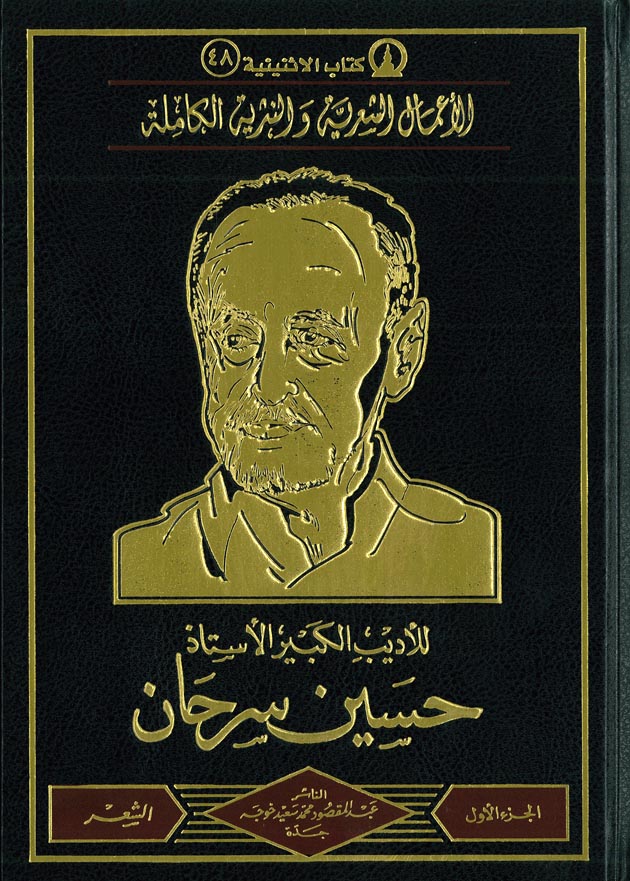| تولي أمي المسئولية |
| وبدء الكفاح من أجل تأمين الحياة |
| أستطيع اليوم، بعد هذا التسيار الطويل في مسالك الحياة، على تنوعها، سهولا وحزونا وتوالي تناقضاتها، أفراحاه وأحزانا، أن أفسر خمود، أو تبلد مشاعري في اللحظات التي رأيت فيها وفاة جدّي، ذلك الشيخ الذي فتحت عيني عليه، دفقا من الحدب والحنان والرعاية، تموج في قلبه الكبير، فلا تكتفي بمجرد النظرة الحانية، أو الكلمة الاسيه، أو العطاء السخي، وانما تمتد، إلى حد الحرص على أن أكون إلى جانبه أو في حضنه، سواء في ذلك (البابور) الذي انتقلنا به من المدينة إلى دمشق، حيث اجلسني إلى جانبه، على تلك الصناديق، نرتفع فوقها إلى مستوى النافذة، فنرى عبرها ما تقع عليه العين من معالم الطريق... تعودت أن أراها وهي الأمكنة التي تواجدنا فيها منذ خرجنا من المدينة المنورة في ذلك الصباح... لم أبك... رغم ما عصر قلبي في صدري من الخوف أو الرعب، وعلى الأخص حين تهالكت أمي عليه، وهي تبكي، ووجهها على صدره، وكفاها تحيطان بوجهه.. لم أدرك في تلك اللحظة، أنه لم يبق لي، غيرها، كما لم يبق لها هي الا شخصي، بكل ركام الضعف والعجز والافتقار إلى الرعاية والعون تفتقدهما الطفولة، في مرحلة تفتحها للحياة. |
| وأكاد لا أذكر، كيف وجدت نفسي في بيت جيراننا: (بيت أبو داود)... استيقظت من نوم عميق ثقيل لأرى نفسي، في مكان لم آلفه أو أعرفه من قبل، وكلن ما لبثت أن أدركت أني في بيت (أبو داود) حين لمحت الفتاة الصبية (لطفية) جالسة هناك، تعالج عملا بالخيط والابرة في يدها... نهضت، وليس في ذهني إلا اللحاق بأمي التي لا أدري أين هي، وقبل أن أمشي خطوات، تذكرت أن جدي قد مات... ولكن ماذا بعد ذلك؟؟؟ لم تكن المسألة لغزا بالنسبة لي إذ أصبحت لا أجهل أن الذين يموتون، يؤخذون إلى المقبرة، التي سبق أن أخذ جدي إليها، أولئك الذين ماتوا من أهلي: عبد الغفور.. عبد المعين.. خالتي خديجة... والذين يذهبون إلى المقبرة يدفنون ولكن من ياترى الذي أخذ جدي أيضا إلى المقبرة...؟؟؟ ليس هناك من يقوم بذلك سوى أمي... كيف؟؟؟ |
| وتطول التفاصيل التي كانت تخبرني بها أمي، في حكاياتها الكثيرة، عن الفترة التي عشناها بعد وفاة جدي... قد أذكر بعضها، ولكن ما أكثر ما غاب عن ذاكرتي، في زحمة الأحداث المتلاحقة والمزدحمة بأهوال، اعتقد اليوم، ان الذاكرة قد عالجتها بعمليات (أسقاط)، إذ هناك مقولة في علم النفس، تزعم، ان النفس الانسانية، أو هو الذهن، يلجأ إلى اسقاط أو محو الكثير من الذكريات الأليمة، كنوع من الهروب من آلامها... ومن حكاياتها عن فاجعتها بموت جدّي، انها حين افاقت من حالة الاغماء التي داهمتها وهي تبكي عليه وجدتني نائما، أو ربما مغمى عليّ مثلها، فأسرعت تحملني إلى بيت الجيران... وإذ كانت لا تدري كيف تتصرف في جثمان الفقيد الغالي، فقد اكتفت، بأن تلتمس عون الجيران، وهم (بيت أبو داود) وتمتلىء عيونها بالدموع، حتى بعد سنوات من هذه الذكرى، وهي تقول: |
| :ـ. جزاهم الله خير... لقد تكفل زوج شفيقة بكل شيء تقريبا... استعان هو بمن يعرف من الجيران في تلك (الحارة) فهرعوا إلى أداء الواجب كما قالوا... ما عدا الكفن... |
| هنا يختنق صوتها بعبراتها لتقول.. |
| :ـ. كأني كنت أعلم أني سأحتاج إلى ذلك الشرشف الأبيض الكبير، والنظيف، الذي لم نستعمله ابدا... اخرجته من الصندوق، ومعه زجاجة ماء (ورد المدينة)... رششتها عليه... وكم كانت فرحتي كبيرة، في ساعة الحزن تلك، حين وجدت مع مجموعة من الأشياء التافهة المنسية في هذا الصندوق، زجاجة صغيرة، تذكرت أن فيها (عطر ورد) كان شيخ الحرم في المدينة، قد أهداها إلى أبيك، ليلة قرأ ((الختمة)) كلها في صلاة التراويح، وهي ليلة 27 رمضان... وهي ـ من نفس العطر الذي يهديه السلطان للحجرة النبوية. لم أترك في الزجاجة قطرة واحدة... كلها عطرت بها ذلك الشرشف... ظلت رائحة الورد، تملأ فناء البيت الذي كنا نسكنه عدة أيام... وأهل الحارة ظلوا يذكرون تلك الرائحة، وهم يترحمون على جدّك... |
| وتتوقف عن الكلام لحظات طويلة، وفي نظراتها رحلة طويلة إلى الماضي البعيد لتقول بعد ذلك: |
| :ـ. الحمد لله يا عزيز... انت تذكر أن الكثيرين الذين كانوا في تلك الأيام كانوا يحملون في عربات نقل الموتى الذين يلتقطونهم من الشوارع، ويدفنونهم في حفرة كبيرة، كل عشرة أو عشرين مع بعض... أمّا جدك، الحمد لله، لقد سّخر الله له، أهل الخير، من الجيران، وغير الجيران،... كانت جنازته مشهدا عزاني في فقده،،، وقد دفن في قبر، ظللت أزوره، كل يوم خميس، إلى أن سافرنا من حلب... |
| وهنا تلتفت إليّ وهي تقول: |
| :ـ. أرجو الله أن يكتب لنا السفر إلى حلب، لنذهب معا لزيارة قبره وقراءة الفاتحة على روحه... حاولْ أن نقوم برحلة إلى الشام، وحلب... حلب، يا عزيز ترقد في ترابها خديجة... وجدّك... وعبد المعين... والمئات من أهل المدينة... اقرأ الفاتحة على أرواحهم، بعد كل صلاة رحمة الله عليهم... ماتوا غرباء... ومن يموت من المسلمين غريبا، يموت شهيدا... |
| ولا أدري، أو لا أذكر، كم من الأسابيع أو الشهور، انقضت، ونحن ـ أمي وأنا ـ في حلب ولكن لا أنسى أننا انتقلنا إلى بيت (أبو داود)، حيث ارتفقنا غرفة صغيرة في الدور العلوي أو لعلها في السطح، لا ينقصها حمّام صغير نظيف، وأمامها سطح واسع عريض يحيط به سور فيه نوافذ صغيرة، كانت أمي ترفعني لأرى عبرها الشارع، والقلعة العتيدة هناك تزدحم ساحتها أحيانا بالجنود الأتراك، وعربات النقل، والسيارات، يشحنونها بصناديق رمادية اللون، قالت أمي أنها صناديق (الجبخانة)... وفهمت فيما بعد، ان (الجبخانة) هذه هي الذخيرة ـ رصاص، وقنابل، والغام ـ وربّما مسدسات ومدافع رشاشة وبنادق... |
| وفي تلك الغرفة، عشنا ـ أمي وأنا وأحيانا أم شفيقة وابنتها الصبية لطفية ـ ليالي البركان الذي يقذف حممه، كلما اشتد هجوم القوات البريطانية ومعها ـ كما أصبحنا نسمع ـ قوات شريف مكة، يقودها أحد الأشراف الذي عرفنا بعد انسحاب الأتراك نهائيا أن اسمه (ناصر ابن علي)... واسميها اليوم (ليالي البركان)، لأننا كنا نرى من مكمننا في تلك الغرفة، عبر نافذتها الخشبية المهترئة، القذائف، تنطلق مشتعلة في اتجاهين متضادين، كانت تملأ السماء كأنها نهر من النار، ومع أن السيدة أم شفيقة، كانت تلح علينا أن نهبط إلى الدور الأرضي لئلا نتعرض لخطر هذه النيران، فقد كانت أمي تعتذر، وتصر على البقاء في غرفتنا تلك، لأن زوج شفيقة، لم يكن قد غادر بيت (أبو داود) إلى منزله مع زوجته كما فعل فيما بعد. |
| والعجيب، في هذا الواقع الرهيب، اننا قد (أخذنا عليه)... ربما لانه يتكرر كل ليلة وأحيانا في النهار، منذ الفجر، أو بعد الظهر قبيل الغروب... ولعل ما خفف من مخاوفنا وجعلنا لا نبالي كثيرا حتى بالزلزال الذي نشعر به، أثناء انطلاق القذائف، انها موجهة إلى الجنود أو القوات في ساحة المعركة، التي لا يدري أحد أين هي، ولكنها خارج حلب دون شك، فلم يكن هناك احتمال لسقوط أي قذيفة أو رصاصة على السكان في الشوارع أو في البيوت. |
| ومن أشد تصرفاتي طرافة ونحن في هذه الاجواء المتوترة، اني لم اعد أخشى الخروج إلى الشارع، وان ألعب مع الأطفال في سني، بل ومع من يكبرونني سنا... احرص على أن لا أبتعد عن العطفة أو الزقاق الذي يقع في منزلنا، ولكن أمنح نفسي، حرية، أن أجري في هذه العطفة إلى آخرها، وإلى ما بعد مخرجها من الاتجاه المقابل لمدخلها... فإذا لعلع الرصاص وأصوات الانفجارات، كما كان يحدث أحيانا، فما أسرع ما نهرع جميعا إلى البيت، ولا أكاد أخطو خطوتين أو ثلاث في مدخل بيت (أبو داود)، حتى أجد أمي، وقد ارتدت ملاءتها، واحتقن وجهها، في طريقها للبحث عني... وأصبحت أعرف أن خفقاتها على كتفي وظهري، لابد أن تتواصل إلى أن نصعد إلى غرفتنا في ذلك البيت. |
| وحتى الجوع، لابد أن أقول أننا قد الفناه وتعايشنا معه... ومن حكايات أمي عن تلك الأيام أنها وجدت في جيب جدي رحمه الله وفي محفظته أكثر من عشرين مجيديا..... من أنصاف وأرباع هذا المجيدي، إلى جانب كمية أخرى من قطع النقد النحاسية، منها ما يسمى (المتليك) وأظنه يقابل الهللة، و (البيشليك) وربما كان يساوي عددا من (المتليك)... تعتقد أنه ادخرها من عمله في (حفر الأختام) لأنه بعد أن سطا اللصوص علينا في حماة، لم يعد يملك شيئا، فكل ما ظل ينفقه، علينا قبل وفاته، ما وجدته بعد وفاته في جيبه ومحفظته، هو مما ادخره من دخله المحدود... وتعلق على ذلك قائلة: |
| :ـ. ياترى كيف كنا رايحين نعيش، لو اني ما التقيت هادي الفلوس؟ واللي باستغرب له يا عزيز، أنو الله يرحمه، كان حريص على اني ما ادري عن شيء... والسبب هو انو يبغانا ما نخاف، وما ننام بالجوع.. |
| وتضيف، بعد أن تسرح بذاكرتها قليلا: |
| :ـ. الفلوس اللي التقيتها، يمكن تظنها قليلة... لكن الحقيقة انها كانت شيء كثير في هاديك الأيام... قعدنا نصرف منها اكتر من تلاتِه أربعه أشهر. وكمان دفعت أجرة الغرفة، في بيت (أبو داود)... كل شهر تلاته أرباع مجيدي. ولما رجلك كبرت، على (الكندرة)، وبدأت تتعلم المشي حفيان... قدرت من الفلوس اشتري لك كندرة جديدة وشراب صوف... واشتريت لنفسي انا كمان فنيلة صوف نص عمر لكنها نضيفة وهنا يزحمها الضحك، والعبرات حين تقول: |
| :ـ. وتدري... يمكن ما تدري... اني فصلت جبة سيدك رحمة الله عليه... فصلتها بالطو لنفسي، وصديرية لك انت... هادي اللي كنت بتلبسها أيام وليالي وتدفيك من البرد في هاديك الأيام، هادي من قماش جبة سيدك... ومن الفلوس، ودفعت أجرة الخياطة... أكثر من تلاته مجيدي... |
| ومع أنها ـ رحمها الله ـ قد وجدت هذه النقود، التي تقول أنها كثيرة بحساب تلك الأيام، وأنها ظلت تنفق منها أكثر من ثلاثة أو أربعة شهور، فأن ما كان يتيسر شراؤه من الأغذية، لم يكن أفضل من تلك التي كان يجيئنا بها جدي... ظل الخبز، هو الخبز الأسود من الشعير والكرسنة، ومنذ وفاة جدي، لم نعد نرى علب اللحم المفروم، أما اللحم الطازج فقد نسيناه تماما... ومن أغرب الأكلات التي كانت أم شفيقة تتفنن في ابتكارها، أكلة ماازال أذكرها ـ ولعلي لا أكره أن أجدها وآكلها... اسمها (زنَّانة)... وهي عبارة عن عصير الرمان الجامض يضاف إليه الملح والفلفل الأسود، نغمس فيه الخبز ونأكله، في وجبتي الغداء والعشاء، وتعلل أمي الحرص على هذا النوع من الأغذية التافهة، بأن الأسواق نفسها لم يكن فيها شيء يمكن أن يشتريه الفقراء... وكان الناس، جميعهم، وعلى الأخص المهاجرين، ونحن منهم.. جميعهم فقراء... والذين، كانوا يموتون جياعا أو من الجوع في الشوارع، وفي المساجد، وفي الطرقات، جميعهم من هؤلاء الفقراء. |
| ثم... جاء اليوم الذي أوشك أن ينفد ما بيدها من تلك النقود... وسمعتها تتحدث مع أم شفيقة، عن شيء قالت أمي أنهم يسمونه في المدينة (مِنْسَجْ) وأنها تعرف التطريز عليه وسمعت أم شفيقة، تتهلل مسرورة، وهي تقول لها: |
| :ـ. إذا كنتي بتعرفي تطرزي، مثل ما عمتقولي... عندنا الذاوات كلهن بيشتروا. وفي اليوم التالي، خرجت أمي مع أم شفيقة، وعادت، وهي تحمل (المنسج)، و (شلل) الحرير الملون، وقالت أم شفيقة، ان عندها قطع الاقمشة التي تحتفظ بها من أيام زمان ـ قبل (السفر برلك)... اقترحت أن تطرزها أمي... وهي تقوم ببيعها لبيوت (الذوات) ومنذ ذلك اليوم، بدأت أرى أمي عاكفة على هذا المنسج، تشد عليه قطع القماش وتطرزها بعد أن ترسم الأشكال التي تريد تطريزها، بالقلم الرصاص... أزهار.. وورود... وفروع أغصان صغيرة. |
| وقد لا أنسى ذلك اليوم الذي عادت فيه أم شفيقة، وهي تكاد تزغود فرحا... وتضع بينها وبين أمي، ـ وهما جالستان على الأرض ـ حفنة من أنصاف وأرباع المجيدي وقطع النقد النحاسية وتقول لها. |
| :ـ. خدي اليك، اللي بدك أياه... وأنا راضية باللي يهون عليكي.. وكان ذلك اليوم، هو آخر يوم انفقت فيه أمي آخر ما كانت تدخر... إلا (مجيدي) واحدا تصره، في طرف غطاء الرأس... كانت فرحتها كبيرة.. واعطت (لطفية) حفنة من النقود النحاسية ذهبت بها، وعادت بارغفة الخبز... وقطعة جبن، وكمية من الخس والخيار... |
| اعتقد أن من حقها اليوم رحمها الله أن أقول، أنها بذلك المنسج، وشلل الحرير الملون استطاعت، أن تؤمن لقمة العيش لنفسها ولي... |
| تقول رحمها الله وهي تقص على ذكرياتها. |
| :ـ. ولكن، إذا كنت قد أمنت ما انفقه على الغذاء، وحتى أجرة البيت، فقد كنت لا أدري شيئا عن المصير... بعد أن بدأ الناس يقولون، ان الجيش التركي انسحب، وأن جيش الانجليز، والشريف، سيستلم حلب... لم يعد هناك أمل ف يالرحيل إلى تركيا كما كنت أفكر بعض الأحيان. أو. والعودة إلى المدينة... من الذي يعيدنا إليها كيف؟؟؟ |
| وفي ذات صباح... طرق باب البيت، زوج شفيقة... وما كاد يدخل حتى أخذ يرقص فرحا ويغني أهازيج الفرحة، وفهمنا أن حلب قد سلمت.. وأن جيش الشريف، أصبح الآن في السرايا ويضيف: |
| خلاص... ما عاد فيه ضرب رصاص.. ولا مدافع... ولا شي.. والسوق.. مليان اكل.. لحم وحنطة وكل شيء... الحمد لله.. الحمد لله. |
|
|
 شارع عبد المقصود خوجة
شارع عبد المقصود خوجة 00966-12-6982222 - تحويلة 250
00966-12-6982222 - تحويلة 250