|
(( كلمة سعادة الضيف الكريم الشاعر الكبير |
| الدكتور محيى الدين اللاذقاني ))
|
| بسم الله الرحمن الرحيم، بين النخيل والماء وهذه القلوب المحبة أكتشف فجأة أن للكلمة قبيلة وأن لك إخوة لم تلدهم أمك وأن ذلك الحرف يسافر عبر الأصقاع ويعبر القارات ويجمع القلوب على كثير من المحبة والوئام مع ذلك القبول بالاختلاف الذي لا يفسد للود قضية لكنه يعمق فينا الوعي ويدفعنا للمزيد من تأمل ذواتنا فما نحن مع الكتابة إلا رحلة سؤال كل من يعتقد أنه وصل إلى الجواب فوراً يعود إلى بدارة الدائرة ليعيد السؤال من جديد، حين خاطبني أخي الشيخ عبد المقصود خوجة بشأن لقاء هذه الوجوه الطيبة أحببت الفكرة منذ البداية وأثنيت على وجود فئة ما تزال تعتقد أن للكلمة دورها في هذه الحياة، تعرفون جميعاً أننا نمر في أوقات يأس وأوقات تفاؤل، في أوقات اليأس نقول كل هذا الكلام يذهب هباء، وفي أوقات التفاؤل ومع أمثال هذه المبادرات والرسائل الكثيرة التي أتلقاها من صحب كرام تعرفت على وجوههم هذه الليلة فقط.. يراودني الإحساس بأن هذه القبيلة التي تتشكل تحتاج إلى أن تلتقي وجهاً لوجه، أن تتحاور وتحاول أن تبلور وجهة نظر ما يمكن الاتفاق حولها ولكننا ورغم هذه المسافات نحاول أن نزيح حاجزاً بعد آخر فتنبت مئات الحواجز وهذه الحواجز لا يقيمها الآخرون لكننا نقيمها نحن، مجرد أن تخف الرغبة في اللقاء وفي تبادل الأفكار والحوار ننعزل داخل جزر صغيرة وينتهي ذلك العالم الفسيح من المحبة، فليأذن لي أخي الشيخ عبد المقصود خوجة، أن لا أثني من الأعماق فقط على ترتيب هذه اللقاءات ولكن أؤكد بأنها ضرورة للقارئ والكاتب معاً، ضرورة للمتلقي والمرسل، وضرورة لمجد الكلمة، فمن لا يعرف القارئ الذي يتوجه إليه يلقي كلمة في صحراء، وحينما يلتقي بهذا القارئ وجهاً لوجه تنبت مئات الأسئلة وعشرات الأجوبة وتمتلك البوصلة أن تتجه للوجهة الصحيحة بدل ذلك التوهان والإخوة النحاة يفضلون التيه ولكن الآن بدأنا نترخص ونتبسط كثيراً في ذلك فالمعذرة، كانوا سابقاً يقولون من عاشر بعض الأعجام في بغداد والبصرة، خالطت لسانه العجمة، نحن الآن نعيش مع الأعجام ومع الروم والفرنجة ومع خليط من لغات وأشكال ونحاول قدر الإمكان أن نحافظ على هذا اللسان العربي وهذا التراث العربي وهذه الفصاحة والبيان العربيين. ونحن دائماً في كل هذه المحاولات نتجه إلى هذه البلاد، نتجه إلى هذه الأمكنة، كان عندي ولع بهذا المكان، والولع بالمكان قادني إلى مشروع كتاب اسمه الشعر وروح المكان، أثناء البحث والتقصي أردت أن أعرف ماذا تبقى من أزمنة شعراء كثر في الجاهلية والإسلام، أتيت إلى هذه البلاد، ذهبت إلى الطائف، ذهبت إلى وادي نعمان، ذهبت إلى وادي فاطمة، وأنا أتقصى أثر عمر بن أبي ربيعة، أتقصى ما تبقى من العرجي، أتقصى ما تبقى من ذلك الشعر الجميل، الذي حفظناه صغاراً، وماذا بقي من روح تلك الأمكنة التي عاش فيها أولئك الشعراء الكبار، هذه الرحلة حملتني أيضاً إلى الأندلس لأرى ماذا بقي من المعتمد بن عباد، ماذا بقي من ولادة وابن زيدون، وبالحدس المباشر حاولت أن أحدد عندما كنت في قرطبة، قلت هذا البيت لعل ولادة كانت تعيش فيه، وبعد مراجعة مجموعة من الوثائق تبين لي فعلاً أن آل الخليفة الأموي كانوا يقيمون في الشارع نفسه في ذلك المكان، قصدت من ذكر هذا الحادث بالذات، وهذا الكتاب بالذات، أن أشير إلى أننا دائماً نتبع تلك البوصلة الروحية التي تهدينا في كافة خطواتنا، بعض الأمور لا تجد وثائقها لكن الحدس يكفي، والحدس في أغلب المواقع بالنسبة للكاتب هو الشيء الأساسي لبلورة أي فكرة، ربما البعض يعلم إني من الذين ضاعوا بين الصحافة والعالم الأكاديمي، أقصد إلى جمع الأكاديميين فيقولون هذا صحافي أصابه التسطح، أعود إلى جماعة الصحافة يقولون هذا أكاديمي متقعر، وأنا بين عمق الأكاديميين وبين بساطة الصحافة ورشاقة أسلوبها أعجبتني هذه المفارقة، كنت أستاء منها في البداية ثم أحببتها، لأنك لو نظرت إلى كل ما يجمع الآن في النقد الأدبي مثلاً ستجد أنه لم ينضج ولم يوزع جيداً ولم ينتشر بين القراء لأنه افتقد إلى هذين العنصرين: افتقد إلى رشاقة الأسلوب الصحافي وافتقد إلى تعمق الأكاديميين ونظرتهم العميقة التي تحدد كل شيء وتقننه وتحاول أن تجعله مفهوماً ومحبوباً عند قاعدة عريضة من القراء، إذا كان لي تجربة وكان المطلوب أن أتحدث عن هذه التجربة فآمل ألا يقول البعض في سره "آن لأبي حنيفة أن يمد رجله" لأني سأتبع ما أحببت، سأطرح الأسئلة على نفسي أولاً، وأشارك معكم أهم المراحل التي اعتقد أثرت بي تأثراً حقيقياً وكبيراً وجعلتني من أنا إن كنت شيئاً حتى الآن. فأنا حتى الآن أمام نفسي أصحو على عشرات المشاريع والأحلام المجهضة وأنام على عشرات المشاريع التي لم تنفذ، وأفتح أدراجي على عشرات الكتب التي لم تكتمل وبي كل ما بكم من قلق وحيرة، ومحاولة للفهم لكن أحياناً تصيبني نوبات من الإحساس بالذات، حسناً أيها الفتى لقد أنجزت كذا وكذا وكذا، ثم أنظر إلى ما لم ينجز فأجد أني لم أنجز إلا القليل وهذا ما يضعني في ورطة دائمة. |
| من الأسئلة الكبرى في حياتي هذا السؤال الاغترابي الذي يواجهني في كل مكان، مرة كنت في الجزائر وبعد أن ألقيت محاضرة في جامعة تيزيوز وهذا قبل الأحداث طبعاً، في بداية التسعينات، أتى لي مذيع من التلفزيون متحمس لتسجيل على الهواء ليذاع البرنامج مباشرة، أتاني بسؤال والآن أيها الشاعر المغترب متى تعود إلى أرض الوطن؟ أنا نظرت في المذيع ورأيت حماس الشباب، وكان يتوقع جواباً واحداً أن أقول له إني مللت من الغربة ومن برودة الاغتراب وإني أتطلع إلى يوم قريب أعود فيه إلى الوطن، لكنني لم أقل ذلك، لأن هذه القناعة لم تعد تتوفر داخلي، ولقد تعودت أن أقول ما أحس أنه الصدق، قلت ببساطة آنذاك: لا أعتقد أن الطقس إن كنت تعتقد أن الطقس الإنجليزي هو شديد البرودة، فالبرودة عادة تكون في القلوب، ولا أظن أن الاغتراب مسألة لها نهاية، هناك نوع من البشر كالبدو أنا أعتقد أننا أصحاب الصحافة هذه الأيام مثل البدو المعاصرين، عندنا توق للرحلة، عندنا توق للاكتشاف، عندنا توق للبحث، ولا نستطيع أن نستقر في مكان ولكن ليس الجواب هنا، الجواب الأكبر أن داخلي الآن يتشكل موضوع كائن كوني، لا أستطيع الآن أن أقول إني أحب هذا المكان بالذات، يعني مثلاً أنا مسقط رأسي سرمدا من الأماكن التي أتعلق بها حتى الولع، لكنني أستطيع أن أتعصب إلى مدن كثيرة حضرت بها وأحببتها، فالمدن كالبشر لها أرواح تحب وتناغى وتشتهي ويُحن إليها، اكتشفت في لحظة من اللحظات أني لا أستطيع أن أقول إني أحب مكاناً وأحداً، أنا الآن فعلاً أحب أكثر من مكان، يعني إذا كانت سوريا هي الأم التي ولدت، فإن النضج الحقيقي لي - لا أريد أن أقول بكل أسف - قد حصل في المهجر وتحديداً في المهجر البريطاني، ولا أجد غضاضة الآن من القول أن هناك أم أرضعت وأن هناك أم ربت وأستطيع الآن أن أحب أكثر من مكان، إذا طلبت مني التوازن أيهما أكثر؟ لا أستطيع الإجابة لأني أعتقد في لحظة من اللحظات حينما نكون لوحدنا أمام مرايانا فإن أكبر نسبة من الصراحة نحتاجها أن نقول هل هذا الإنسان الذي توصل إلى جواب ولم يعد يفرق بين وطن ومنفى يستحق الاحترام؟ إذا قلت لنفسك نعم هذا الرجل يستحق الاحترام معنى ذلك أنه سؤال جدلي وحقيقي وإنساني وكوني ويستحق أن تواصل البحث لنوع من هذه الأسئلة. |
| الانصهار الحقيقي لتجربتي فعلاً كان في المهجر البريطاني كما قلت، وهناك تبدأ بالتعرف على عالم جديد تكتشف إن مجموعة المستشرقين الذين كان لهم ذلك النفوذ - تكتشف أن أيام رينان ودوساس ودوزى - الاستشراق كان هو الذي يحرك الجيوش، والثقافة كانت هي التي تحرك السياسة، لكن الآن في تلك البلاد مجموعة من المستشرقين المساكين، لم يعد ذلك الشرق الذي يدور بالأذهان هو ما يدور في أذهانهم، ولم تعد السياسة خاضعة للثقافة كما كان الأمر في القرن الثامن عشر، ولم يعد لهؤلاء تلك الاهتمامات الأكاديمية الفقهية اللغوية الموسعة، تجد أن الصور قد اختلفت كلياً وأنك تواجه عالماً جديداً فيه نقيض ما كنت تتصور عن تلك العوالم، وأنا أتعصب لعبارة لقرامشي يقول فيها إن نقطة الإتقان النقدي تبدأ بالتطور حين يعي الإنسان حجمه الحقيقي ومسؤولياته عن العالم المحيط. |
| أمام هذه الأجوبة التي لا يقدمها لك الغرب الجديد تكتشف صورة جديدة وتكتشف أن أكثر من غرب وأكثر من شرق هناك وأن هذا الشرق وهذا الغرب يحتاج منك إلى فهم جديد، تكتشف أن كبلنج يختفي ويظهر فلوبير مثلاً الذي كان يتوقع ذات يوم أن يلتحم جناحا الإنسانية في رواية شهيرة له هي بيفارو بيكوشيه، تكتشف أيضاً أن ذلك العالم الوهمي الساحر الذي كنا نظن أن الغرب أقامه عن شرقنا لم يكن يقصد به الشرق العربي بالتحديد، فمجموعة هذه - دعوني أقول - الصدمات تجعلك أمام سؤال أخطر من السؤال الذي سبقه وهو هل نحن باتجاه مرحلة جديدة تذوب فيها الفوارق فعلاً بين الثقافات وتذوب فيها كل هذه الحدود والأسوار التي كنا نعتقد أنها موجودة في مكان ما؟ أيضاً هذا من الأسئلة التي تشغل البال ولا أعتقد أن الإجابة عنها بسيطة، فمن السهل أن تقول نحن أمام ثقافة كونية، لكن هذه الثقافة الكونية هل ستزيد من كثافة الهوية المحلية أم ستلغيها؟ بعضنا يتسرع في الجواب ويقول الثقافة الكونية ستلغي الهوية المحلية، ولكني أعتقد أنها ستزيد، عفواً لكلمة أنا، أنا من الذين يعتقدون أن الثقافة الكونية ستزيد من الشعور بالهوية المحلية وسيكون لكل الثقافات الإقليمية انتعاشة أخرى في ظل ثقافة إنسانية تستطيع أن توحد وأن تقبل لأنها تضع التعددية في قمة الأولويات.. حينما يكون هناك تعددية، حينما يكون هناك اعتراف بالآخر لن يكون هناك خطر من الإلغاء، لن يكون هناك خطر من المحو، لن يكون هناك خطر من قوة غاشمة تقول لك أنت لست موجوداً، حينما يكون هناك مناخ تعددية تعرف أن كل شيء يمكن أن يبقى. |
| الثقافة، الأقليات، العقائد، مجموعة النوازع البشرية، مجموعة الطبائع، كل شيء يمكن أن يكون محمياً وبصورة فعلية في إطار تعددي، إنما الإطار الواحدي هو الذي يرعب، لذلك دائماً واحدية في السماء وتعددية على الأرض هو من الأجوبة التي بدأت تقنعني إلى حد كبير، لأنك مع اكتشاف الآخر، مع التعرف عليه من قرب، مع المعايشة، تتعلم عادات جديدة، تحس أن كل ما نشأت عليه من عادات فيها تسلط وفيها فردية وفيها نزعة عنيفة تختفي بالتدريج وتبدأ تدرك أن هذا الآخر الذي يختلف معي هو في الواقع يزيد من رصيدي ويعرفني بنفسي بشكل أفضل، إذا بدأنا بالمجاملات لن نتوقف حتى الصباح ولكن بمجرد أن يبدأ النقد سوف أكتشف الآخر بشكل أفضل وسوف أكتشف نفسي بشكل أفضل أيضاً. |
| من الأسئلة التي وردت في طريقي في هذه التجارب سؤال المثقف والسلطة.. في بلادنا دائماً تجارب مهملة مثلاً، أهملنا فكرة المثقف المستقل، منذ ابن خلدون وإلى الآن المثقف آلة السلطة وآلة السلطان حسب تعبير ابن خلدون، لكننا أهملنا قبل ابن خلدون تجربة رائعة مثل تجربة الجاحظ، الجاحظ أتى به كما تدرون جميعاً وجميعكم أساتذة في التراث، أتى به المأمون إلى الديوان، سلمه ديوان الكتاب، مكث في ذلك الديوان ثلاثة أيام فقط ثم غادر إلى غير رجعة ليؤسس مشروعه الفكري المستقل، يحتفظ بمساحة بينه وبين المأمون، بينه وبين الدولة، هناك مواقف للمعارضة وهناك مواقف للموافقة، لم يستسلم بالكامل ولم يعارض بالكامل وهذا المشروع الفكري العربي المستقل نستطيع أن نستوحي منه الكثير فلم تكن هذه التجربة من فراغ إنما أتت في سياق تطور الفكر العربي وفي إطار تطور الفكر النقدي لكننا دائماً نهمل الرجوع إلى هذه القضايا ونقفز إلى الاستيراد لعلي داخلي منذ زمن كنت أتعامل خارج إطار كل معرفي سياسي لأني من الذين يعتقدون استقلال الثقافة استقلالية كاملة.. مجرد أن لوح لك أحد بسيف المعز أو بذهب المعز تختلط عليك الأمور، تختلط في رأسك الأفكار، يفقد الحياد المعرفي ذلك الزخم الذي يجعل منك كاتباً متألقاً يحلق في آفاق أخرى، هذه الاستقلالية بدأت كما نقول أعض عليها بالنواجذ، أعرف تماماً أنك لا تستطيع أن تحصل عليها كاملة في عالم عربي معقد الظروف معقد الحدود، أعرف أنك صحيح تكتب في منطقة بعيدة عن الوطن العربي لكن لا تستطيع أن ترضي كل الأذواق ولا كل الرقباء، إنما بقدر الإمكان ومع مرور الوقت تبدأ بإنتاج خطاب معرفي يداعب هؤلاء الرقباء، يقفز من فوق هؤلاء الرقباء، حتى الأسلوب يبدأ بالتغير، وتكتشف أن الذي يكتب بشكل مباشر وصريح ليس له ذلك الوهج كذاك الذي يكتب بطريقة رمزية، بطريقة متقنة، بطريقة تجيد زرع الأفكار وتجيد اللمح ولكنها لا توغل في الكثير من التوضيح وتترك المساحة للقارئ، بكل أسف الصحافة العربية في فترة من الفترات تعاملت مع القارئ العربي وكأن كل شيء يجب أن يقدم إليه جاهزاً، وكأنه ينتظر الحل لتقول له هذه المشكلة وهذا الحل وما عليك إلا التنفيذ، هذه عقلية تخرب الكتابة، تخرب التلقي، تخرب الود الذي أصلاً ينشأ بين قارئ وكاتب ويحتاج بين فترة وأخرى إلى من يخرج تلك النار التي هي تحت الرماد، لأن كل أسئلة تنام هي نار نائمة يجب أن يوجد من يوقظها ومن يحركها ومن يدفعها في مسارات صحيحة. |
| من الأسئلة أيضاً التي أرقتني سؤال الحداثة، هذا السؤال والذي خصصت له كتابي الأخير "آباء الحداثة العربية" أغاظني كثيراً، كنت بالغرب وعلى إطلاع على التيارات الفكرية بالغرب وأدري أن المشروع الغربي للحداثة لا يتعلق بالشعر وحده، هو كالمشروع الحداثي العربي الذي تحقق أثناء الدولة العباسية، أثناء أيام المأمون، وإلى القرن السادس الهجري، هو حداثة مجتمع، حداثة تطور فكري، مؤسسة كاملة تتحرك على كافة الأصعدة، لكننا كنا نقصرها على الشعر فقط، ومن ذلك الموقع إذا كنت تراقب وترى وتشهد جناية حقيقية تحتاج إلى من يصححها، تحتاج إلى من يبلور محتواها الجديد تحتاج إلى من يقول إنه ما من نظرية نقدية يمكن أن تولد خارج الرحم التراثي، تحتاج أن تقول إنه ما من حداثة أدبية يمكن أن تولد بعيداً عن حداثة اجتماعية، هذه الأسئلة طرحت في أيام محمد عبده والأفغاني وطه حسين لكن حداثة المجتمع في ذلك الوقت لم تكن كحداثة أيامنا فضاعت أسئلة كثيرة وأجوبة أكثر، وحين وقَّتُ إصدار هذا الكتاب عام 1998م كنت أرمي بالحقيقة إلى غرض لا يخفى على اللبيب، أول بيان للحداثة العربية انطلق في بيروت 1947م، الآن وبعد انقضاء نصف قرن على ذلك البيان نجد أنفسنا أن فهمنا للحداثة يقل كثيراً عما كان يفهمه الآباء في العصر العباسي، لذا أردت إن أقول ببساطة أن الجيل العربي الجديد يفهم الأمور من منظور مختلف وباتجاه مختلف ويريد أن يعيد لهذه الحداثة العربية آباء التراث الذين فعلاً هم أسسوها وغرسوها إلى أن أينعت، أعدتها إلى الجاحظ، أعدتها إلى أبي حيان التوحيدي، أعدتها إلى الحلاج، وإلى مجموعة من كبار الذين أسهموا في وضع بنية حقيقية فكرية متطورة أهملنا الاستفادة منها لذا وصل حالنا إلى ما وصل إليه، وإن شاء الله هذا المشروع سوف يكمل بمقاربة أسطورية للشعر الجاهلي تقدم له قراءة مختلفة من خلال الفهم الأسطوري للمنطقة وما كان فيها من أساطير. |
| لا أريد أن أطيل عليكم فالأسئلة كثيرة، والأجوبة أقل، إنما خلال هذه الرحلة الطويلة والمتشعبة بين السياسة والصحافة والأدب تذكرت ذات مرة أن اليابان أرسلت إلى البلاد العربية، إلى مصر تحديداً، في القرن الثامن عشر، أرسلت وفداً لتستفيد من التنوير العربي الذي كان موجوداً آنذاك، عاد الوفد وعادت البعثة اليابانية وأخذت ما استطاعت أن تأخذه، وانظروا أين هي اليابان الآن وأين نحن؟! هذه المقارنة أردت من خلالها أن أقول إنما نفتقر إليه هو التراكم، دائماً الحضارات لا تبنى بطوب جاهز، هناك حالة من التراكم، جيل يبني وجيل آخر يكمل البناء، نحن كلما جاءت أمة لعنت الأمة التي سبقتها وبدأت من جديد لذا لا يكتمل عندنا أي مشروع ولا يكتمل عندنا أي كتاب ولا يكتمل عندنا أي تيار فكري، نجد مجموعة من التهابيش، فكرة من هنا، كلمة من هناك، قضية من ذلك الاتجاه.. فلا يقوم ذلك البنيان الحضاري، ولا يُخلق ذلك التراكم الذي لا يمكن أن تقوم حضارة بدونه على الإطلاق. |
| يبقى السؤال الذي يطرح عليَّ دائماً وأنا أحياناً أريد أن أستبق الأمور وأطرحه على نفسي.. ذلك الضياع بين الشعر والنثر، الكتابة في الصحافة والكتابة اليومية تحديداً والكتابة لفترات طويلة تجعل الناثر يطغى على الشاعر، الشعر عزيز وقليل الزيارات ويأتي في العام مرة واحدة، ومرات لا يأتي، أنا فعلاً من المقلين، لا أكتب كثيراً، إذا كان زهير صاحب حوليات فربما أقول عن نفسي أحياناً أنا صاحب كبيسيات.. كل أربع سنوات أصدر مجموعة أو أقل من مجموعة وبقصائد قليلة، فعلاً تطغى شخصية الناثر على شخصية الشاعر لكن لا أستطيع أن أقل بأن هذا الوضع يزعجني لكني أرى أيضاً أهمية النثر، أرى زهو الجملة النثرية وأرى أيضاً أن فنون العصر القادم سوف يترسخ من خلالها فن العمود الصحفي كواحد من أبرز الفنون، الناس لن يكون عندها وقت للكتب الكبيرة ولا للموسوعات ولا لهذه الروايات المطولة، ومن هذا المنطلق حاولت بقدر الإمكان أن أجعل من كتابة العمود الصحفي فناً يتعب أحياناً لكنه ممتع في كل الأحوال، أحياناً قراءة ثلاثة أشهر تنزلها في ثلاث جمل، عملية صعبة، إنما لمن اعتاد عليها ولمن اعتاد التعامل بهذه الطريقة يعرف أن هناك قارئاً يستحق الجهد وأن هناك عقلاً يجب أن تحترمه وأن هناك مجموعة من الخواطر والأحاسيس المرهفة التي تحتاج منك إلى جهد مضاعف، يطلقون علينا حالياً خصوصاً في بريطانيا وفرنسا، تيار أدب المهجر الجديد، وأنا أسأل نفسي فعلاً هل هناك الآن تيار أدب مهجر، هل هناك أدب مهجري جديد يذكر بجبران وبالمهاجرين الأوائل إلى أمريكا الشمالية والجنوبية؟ وغالباً أقول لا.. لأن هذا الأدب الذي يكتب حالياً هناك لا يختلف كثيراً عما يكتب في الوطن العربي إلا من حيث مساحة الحرية التي يمارسها من يقيم هناك، هذه الفواصل لم تعد موجودة، معاناة جبران وميخائيل نعيمة قبل العودة إلى الوطن لا نجدها نحن، نحن في قلب الوطن العربي، نأتي إلى الوطن العربي كثيراً الفضائيات العربية تسهر معنا في حجر نومنا، تذهب إلى اجوان رود فتحاول البحث عن إنجليزي وليس عن عربي لأنهم كلهم عرب، هذه الأجواء لا تجعل من فكرة الحديث عن أدب مهجري جديد فكرة جادة إلى حد كبير، فهو أدب يجب أن يصنف في إطار الأدب العربي دون حاجة إلى هذه التسميات الجديدة لأنه لا يختلف عما يكتب هنا ويقال هنا فعلاً. |
| اسمحوا لي أن أختم بالشكر الجزيل لمن أتاح لي هذه الفرصة لآتي إلى هذه الأرض الطيبة وأصارحكم بما يدور في ذهني من أسئلة لا أجد جواباً لها، وأعتقد أن ما يدور في أذهانكم أكثر وأكثر وعلى دروب المعرفة لا يوجد أساتذة ولا يوجد مريدين، كلنا تلاميذ على دروب المعرفة، وشكراً لأخي الشيخ عبد المقصود خوجة، الذي جعلنا نشارك هذا النسيم العليل الذي يهب بيننا اليوم محملاً بمحبة سأقدرها كثيراً وأحملها معي وحين أحتاج في ديار الاغتراب إلى دفء ويأتي من يسألني عن برودة الاغتراب سأجد هذا الدفء بين ضلوعي.. فشكراً لكم هذا المساء، وكل مساء. |
|
|
|
|
|
|
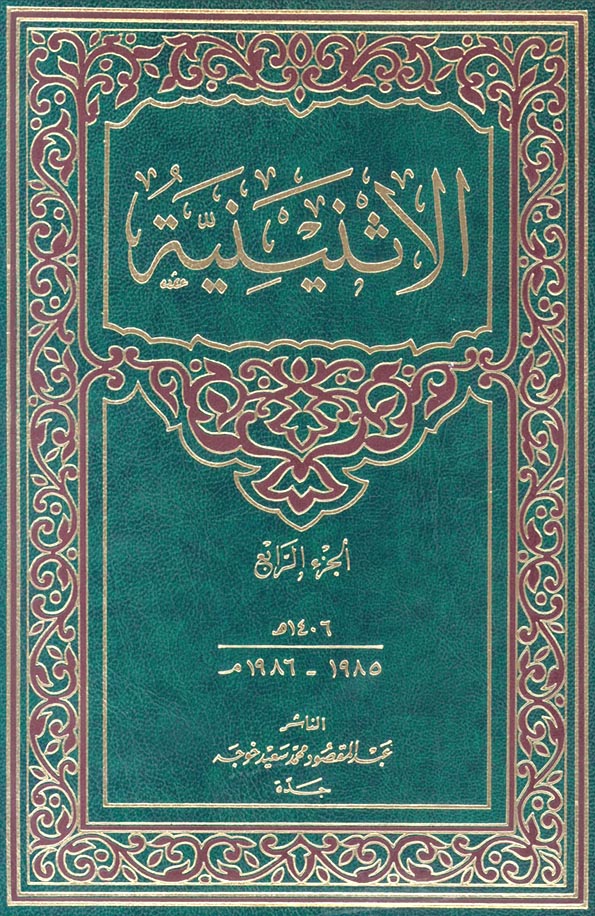
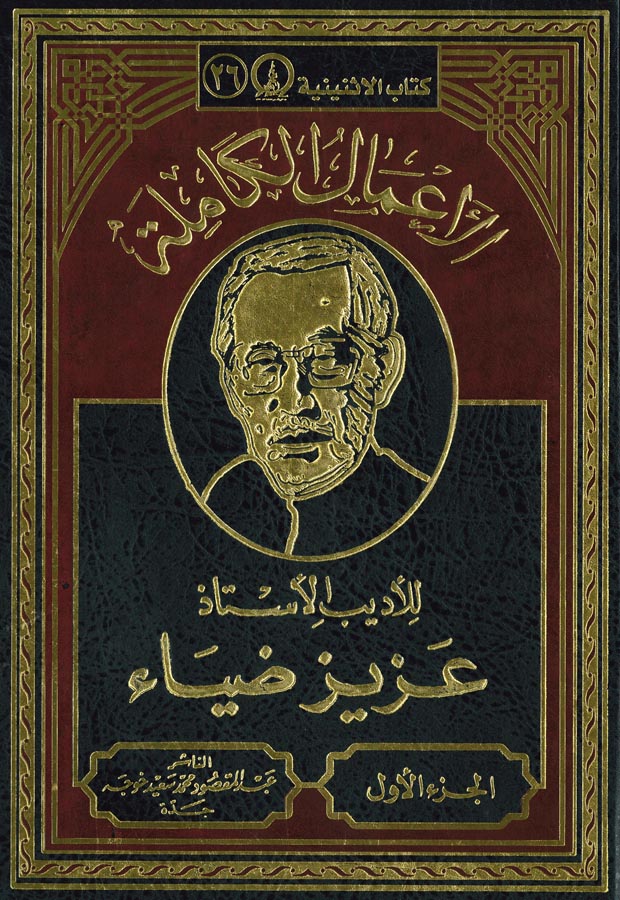
 شارع عبد المقصود خوجة
شارع عبد المقصود خوجة 00966-12-6982222 - تحويلة 250
00966-12-6982222 - تحويلة 250




