|
|
|
|
هذه صور ولوحات/بعضها زيتي، وأخرى كاريكاتير، التقطتها لكم من طريق طويل تخطى الستين عاماً.. سميتها: "مشواري على البلاط"، وأقصد: بلاط صاحبة الجلالة/الصحافة... لعلي في هذه الصور واللوحات أنقل إليكم مواقف، وأكسب تأملكم لأبعادها!! |
|
| * * * |
| قبل البدء |
| مدخل: |
| عندما أراد أن يكتب قصة حياته للناس، قبل أن يموت، أخذ يفكر طويلاً، ويتساءل: |
| - ما هو مبلغ الصدق فيما نرويه للناس؟! |
| - هل الحياة التي نعيشها تارة، ونحس بها تارة أخرى: تصلح لأن تكون خيمة، أو عبرة، أو تجربة... أم تراها سخرية مريرة جداً؟!! |
| ولكنه حينما بدأ يكتب... اكتشف أنه أفرد فصلاً طويلاً من قصة حياته، كان يتحدث فيه عن الليل! |
| لقد عرفه الناس في النهار، وعرف هو الناس في الليل... رأوه ورآهم، كشفهم واكتشفوه... وكثيراً ما كان يشهد انقطاع التيار عن الإضاءة الداخلية في نفوس الناس! |
| لكنه كان يقهقه، ويجعل الناس يفعلون ذلك... ابتداءً من الأفلام الصامتة، وانتهاء بالمسرح! |
| * * * |
| كان يضحك الناس، ويذهب إلى بيته في نهاية الظلام أو الليل.. وهناك: يجد ابنته تعاني من آلام المعدة الحادة، وإدارة المسرح لم تعطه أجره... فيضع الوسادة على وجهه وأذنه، و..... ينام! |
| وكان يمشي في الشوارع: مفلساً.. وكل الأيدي تشير إليه بإعجاب وحب، وهو يتطلع إليها.. فيزهو، ويحس بالغنى وبالسخرية معاً.. ويقول لنفسه: "طز"!! |
| وأحب فتاة مليحة.. كانت بارعة -أيضاً- في أشياء عديدة! |
| ويراها تحضر مسرحياته.. وفي حفلة العرض الأولى، سأل: من هذه الفتاة الجميلة؟! |
| وتابعها، وجرى إليها... وأخيراً كتبت ورقة، قالت له فيها: |
| - إنني أحب حركاتك المضحكة وتمثيلك البارع، أما أنت فلا أعرفك، وأما أنا فإني لا أحب الممثلين!! |
| * * * |
| تلك إحدى حكاياته... رواها بأسلوب السخرية والألم، والمرح والذكريات! |
| ثم..... يفر "شارلي شابلن" إلى الليل بعد ذلك من جديد، وهو يتمتع بتقاعده... لكنه كان يسهر الليل وينام والوسادة على وجهه وأذنه، لأنه -كما قال- قد تعود على ذلك، منذ ليلة أمعاء ابنته! |
| وفي النهاية.. يرسل للناس الذين أحبوه ذات يوم: صوتاً له صدى... فيقول لهم: |
| - أيها الناس.. جميعكم ممثلين، فاخرجوا من وراء الكواليس، وقفوا على خشبة المسرح بدون أقنعة!! |
| وها أنذا الآن، قبل البدء في رواية مشواري لكم، أصدقكم أن القمر لم يسطع منذ ليال، فهو "غائب"، والنجوم "حرَّانة".. وأحسست أن بعض النائمين في ليل هذه الدنيا: يتحدث في نومه بكلام لا نقاط فوق حروفه... وعرفت أن نباح الكلاب: حركة ليست مسرحية وإنما عادية جداً، ولا أكثر من أنه دلالة على السهر أو الأرق، أو.... وحشة الوحدة!! |
| ويهرع المرء إلى أعماقه.. يحاول أن يضيء فيها زاوية ليرتاح قليلاً أو يبتسم، لكن التيار ينقطع أحياناً! |
| وفي غربة الروح: فرار وأبعاد منهدة... أو كأن المرء يفر من نفسه وهو شبه مطلق عار من الأفكار والمعاني... إنه يخبط رأسه في قطعة الظلام أو في زاوية كثيفة الظلال، والبارع: من يستطيع أن يضحك، مثلما كان يفعل "شارلي"!! |
| * * * |
| في البدء: |
| في البدء أستأذنكم في طرح هذا السؤال (الأنوي)، ربما على نفسي أولاً، ثم على مسامعكم أو قراءتكم: |
| - من أنا... وما هوية ركضي ومشواري على بلاط الصحافة التي استنزفت أكثر مراحل العمر؟! |
| لقد أردت أن أمزج الصحافة/العمل بالأدب والثقافة/الهواية ثم الطريق الطويل؟! |
| وأستعيد سؤالاً قديماً طرحه على مسامعي ذات صباح: صحافي كان يبدو متفائلاً بصباحاتنا العربية قبل أكثر من ثلاثين عاماً.. فسألني أيضاً: |
| - من أنت باختصار؟! |
| - أجبته: أنا إنسان.. هذا الكاتب المتفاعل العاشق في الغضب العادل، المشاكس في زمن الانكسار.. مجروح أنا بخلفية الاتجاه والظمأ: عقاب بعد أن ماتت النداءات الصادرة من التفاؤل! |
| أرى الكلمة: ناراً، ونوراً؟! |
| - أراها "ناراً": في الغضبة للدفاع عن الحق والحقيقة.. عن القيم والمبادئ، ولكشف الذين يزوِّرونهما، ولإسقاط الذين يدعسون الجمال... سواء كان جمالاً محسوساً أو ملموساً. |
| وأراها "نوراً".. في تحويلها إلى نبض، وإلى صوت قوي لإجلاء الحقيقة، وإلى ريشة جميلة تمنح أبعاد لوحة الحياة! |
| وفي انطلاقتي نحو الحياة الأولى، بكل تلَفُّتي واشتعال وعيي، يومها ذاك الذي لم يدم: |
| - غازلتني الأحلام الجميلة التي أشرق بعضها بلا موعد، والتي تكسر أغلبها قبل أي موعد! |
| وسلبت مني الحياة: الاشتياق إلى قرية صغيرة، تسمق فيها النخلة الموغلة بجذورها في الأرض... إنها: نخلة الزمان، وحضارة الروح! |
| لم أخف من الزمن ولا من العمر في نهدة صباي ثم شبابي.. وأعرف أن: الخوف لا يستقيم مع الإيمان، وإيماني راسخ إن شاء الله.. وأن الزمن قد لا يكون هو العمر، والعمر الجميل الحافل بالإنجاز وبالإبداع وبالحب: هو الذي يصنع الزمان الأجمل! |
| فقط.. تركت الجمال يقف على شباة قلمي... الجمال/جمال الكلمة وجمال التعبير، وجمال الحلم وجمال الحق والحرية! |
| * * * |
| وبعد كل هذا المشوار أتساءل: هل تعبت؟! |
| - التعب: نسبي... أفضِّل أن أعيد تشكيل سؤالي بهذه الصيغة: بعد كل هذا التعب.. هل أكملت المشوار؟! |
| - أقول: في كل يوم يبدأ مشوار جديد بتعب جديد آخر... وكلاهما -المشوار والتعب- يرتبطان بالعمر! |
| أما أحزاني فلا تخجلني حتى أطويها في أعماقي، فهي أحزان إنسان طموح انتصر لحلمه الجميل في هذا العصر، وهذه المعاناة، وهذه الطموحات والأحلام.. وتجدني البوَّاح بها من خلال كلماتي، وفي ظلالها وأبعادها.. فالأحزان صارت هي: مقلتاي ونبضي! |
| وعندما أسمع ضحكة من القلب، وعندما يستكن طفل في دفء الأمومة والأبوة المتحدة، وعندما تنطلق كلمة حق بلا خوف، وعندما ينتصر العدل على الظلم، وعندما تطرد الحقيقة: الزيف: لا بد أن تورق أفراحي. |
| وهناك من يقول: إن ورقة الحظ لا غنى عنها في دفتر العمر. |
| كلنا صرنا نعاني الآن من آلامنا المحسوسة أكثر من آلامنا المجسدة.. وهي آلام تبدو مستعصية... لذلك، فإن الحديث عن "الحظ" يبدو: ضرباً من الترف الذي يغيظ! |
| أما أحلامي: فلم تكن لها حدود. |
| لقد رأيت بمقدار ما عرفت، ولقد عشقت فوق طاقة القلب ووعاء الوجدان، ولقد ركضت إلى أبعد من حدود الممكن في زمن المستحيل الأبله. |
| ولكن... استمرت أحلامي بلا حدود، وبقيت حتى هذه الثمالة من العمر: أقف مع الشجر نصغي معاً للفرح الذي لا يسقط منا أبداً!! |
| * * * |
| فلسفة الطفولة: |
| فوق سطح البيت.. كنا نجد الأطفال يلعبون! |
| كنا في طفولتنا -أيضاً- نصعد الدور الأعلى، وأسمه "السطح" لنلعب، فلم يكن أهلنا يسمحون لنا بالخروج إلى الشوارع.. يتساوى في ذلك: الولد والبنت، وكانت حجة الآباء تكمن في خوفهم على الطفل من الانحراف عن التربية السليمة، دون أن يبحث الآباء نتائج حبس الطفل في سطح البيت. |
| وعندما ارتفعت العمارات الشاهقة، لم يعد هناك سطح، بل أصبح للعمارة: رأس! |
| وفي الدول المتقدمة جداً: تطاولت ناطحات السحاب، وتحول السطح إلى مهبط لطائرات "الهليكوبتر"، وفقد الأطفال مكاناً آخر يلعبون فيه.. ليلعب الكبار! |
| وفوق سطح البيت: في إمكانك أن تقف، وأن تحفظ توازنك عندما تضع قدميك على حافة حائط السطح، وتطل من ذلك العلو، وكنا نسمع أصوات أمهاتنا تصعد من تحت السطح، محذرة: |
| - لا تطلع يا ولد فوق الجدار! |
| كن يخفن علينا أن نقع، وكانت الحياة يومها بسيطة... تخلو من التعقيد، ومن زحام، ومن ضجيج... الليل يبدأ مع صوت المؤذن حين يرفع أذان المغرب، والعمل يبدأ مع طلوع النهار وارتفاع أذان الفجر. |
| لقد فقدنا سطح البيت، وفقدنا معه البساطة، وفقدنا الجوار، والحارة، والجيران الذين تشعر بهم وكأنهم أهلك. |
| اختفى سطح البيت، وتحول السكن بعد ذلك إلى "شقق"، ولا تعرف من الذي يفتح الباب الذي يواجه باب "شقتك"... فتحوَّل الجيران إلى: غرباء! |
| وهكذا تحولت الحياة جميعها إلى: مدن كبيرة، وإلى "أسطح" اختفى منها الأطفال والسكان، وتم استبدالهم بـ "أريل" التلفاز.. عشرات الأعمدة الحديدية، و "الإريلات" الموجهة إلى عدة اتجاهات! |
| كنا في طفولتنا نطل من "السطح" على الشارع، فنرى الناس يمشون بأحجامهم الحقيقية. |
| وعندما فقدنا "السطح": أصبحنا نرى الناس بأحجام مختلفة.. ما بين أقزام، ومتوسطي الحجم، ومن لهم رقاب طويلة مثل رقبة "عوج بن عنق"! |
| وفي هذه الرؤية.. أصبح الذي يرى الآخرين أقزاماً، يظن أنه لا أطول منه، وكأنه هرقل أو "جيلفر".. فالماديات تسلطت على رؤية الكثير من الناس، وعلى أحجامهم، وعلى أفكارهم وعواطفهم أيضاً! |
| كنا في طفولتنا وصبانا: نرى الناس يمشون جميعاً.. فأصبحنا نرى الكثير يحاول، بل يصر أن يركب! |
| كنا نرى كراسي المقاهي ممتلئة، وأصداء ضحكاتهم تشيع في الأرجاء، ثم اختفى الناس داخل البيوت الزجاجية، والسيارات المنطلقة.. لكنك تعثر عليهم بعد ذلك على الشاطئ، وعند حفافي البحر، وفي داخل الطائرات! |
| صديق قديم جداً.. باعدت الأيام بيننا، كنا نلعب معاً فوق سطح البيت، وفي الحارة.. فلما كبرنا، وكبرت مشاغلنا: لم نعد نلتقي... رأيته أخيراً في جوف طائرة، وسألته جاداً: |
| - أين أنت؟! |
| - قال مازحاً: مازلت فوق السطح، هل تذكر أيام طفولتنا حين كنا نلعب فوق سطح منزلنا، أو منزلكم؟! |
| - قلت: يرحم الله تلك الأيام، ولكنك -كما قلت- ما تزال فوق السطح.. فكيف؟! |
| - قال: كنت من صغري أهوى السطح.. ألعب فوق السطح، أستلقي فوق سطح بيتنا تحت السماء والنجوم وأحلم بالبقاء فوقه! |
| ونجحت... بقيت فوق السطح، فأنا اليوم رجل أعمال كبير، أي فوق السطح وفي ألأعالي، وحياتي تحولت إلى سفر دائم لمتابعة أعمالي.. أي أنني -أيضاً- فوق السطح، ألسنا الآن داخل طائرة تمشي وتطير فوق سطح العالم كله؟! |
| - قلت: صدقت، ولكن.. ألا تحن للأرض، "البسيطة"، لدهليز البيت، لكرسي في مقهى مثلما كنت تفعل في أيام شبابك الأولى؟! |
| - قال: الحنين موجود بلا شك، ولكن.. ليس عندي الوقت، ولا راحة البال! |
| - قلت: صدقت، وإذن.. فإن الوقت وراحة البال يتوفران فوق الأرض، لا فوق السطح؟! |
| - قال ضاحكاً: أنت ما زلت رومانسياً، كما عهدتك منذ زمن طويل! |
| - قلت ساخراً: ولكني أركب الطائرة.. ألا تكفي "سطحاً" لي؟! |
| - قال بحزن: أعترف لك أنك وأنت فوق السطح لا أحد يراك، في حين تستطيع أن ترى ما تريده، ومن تريده... ولكن الإنسان يتوق أحياناً إلى أحد أن يراه بجانبه، لا تحته ولا فوقه!! |
|
|
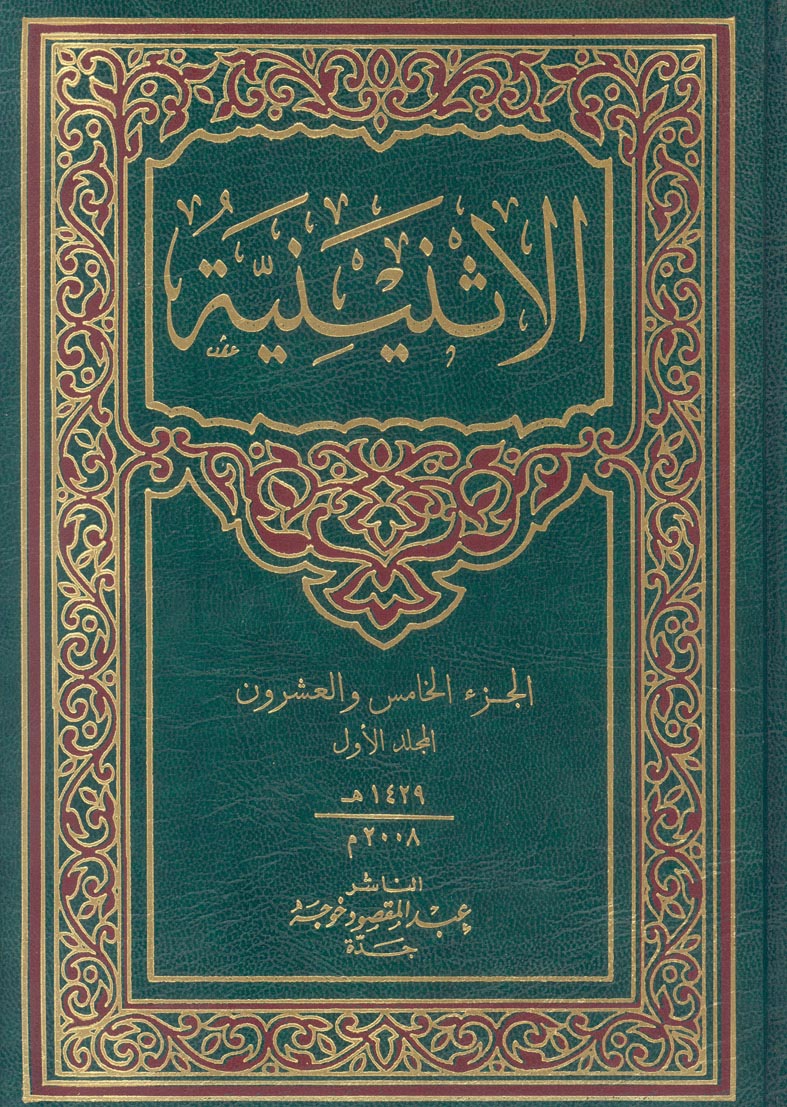
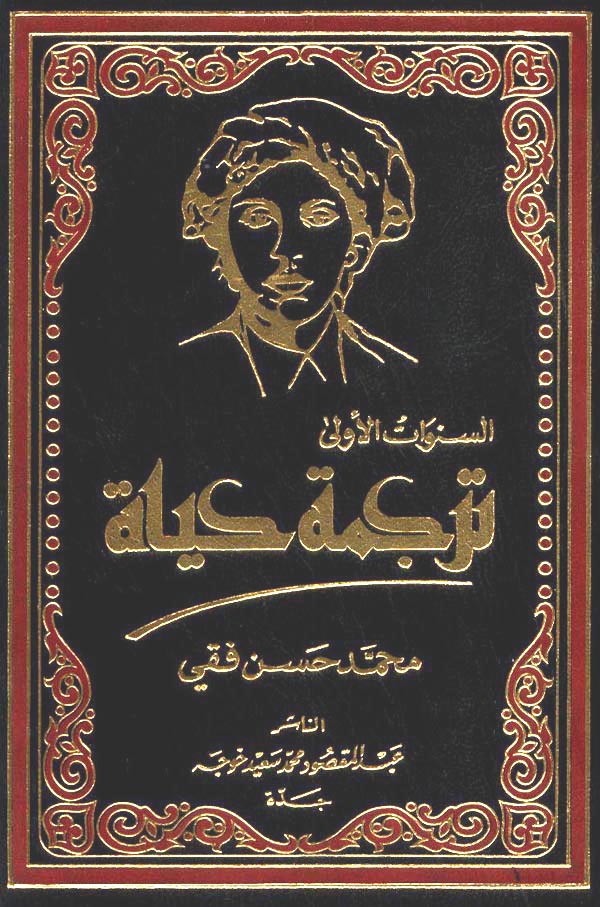
 شارع عبد المقصود خوجة
شارع عبد المقصود خوجة 00966-12-6982222 - تحويلة 250
00966-12-6982222 - تحويلة 250




