| قضية الكاتب اليوم! |
| ونوافذ جيراني.. أطفأها الحزن، وأني |
| أخشى أن أوقظها.. |
| وأخاف عليها مني.. |
| وأخاف على نفسي منهم |
| وأخاف إذا سألت أعينهم أي سؤال |
| أن أبكي رغماً عني.. |
| سأعانق ظلي!! |
|
|
|
| (1) |
| سيدي الكاتب.. السائل، المناقش، المحاور: |
| سيدي الفنان المبدع.. المتألم، المسكوب شجى، والساكب معاناة: |
| ترى.. ما هو الواقع العربي اليوم؟! |
| ترى... إلى أي مدى، وبأية مقدرة يستطيع الإنسان العربي أن يعرف نفسه؟!! |
| أمام الليل.. ينتصب "انتظاراً" لبزوغ الفجر، أو ينسفح النوم والخدر! |
| أمام الفواصل.. تكثر العثرات، فأي تاريخ مثل تاريخ الإنسان العربي قادر على اليقظة، ومطلق سراحه من قيود العثرات؟!! |
| الجميع يتحدث عن: "الغربة الثقافية"! |
| هي غربة روحية، وغربة وطن، وغربة حق وعدل، وغربة عشق، وغربة حرية! |
| أما غربة الروح.. فنحن لا نطلب من كل كاتب أو مبدع أو فنان، أن يصير شاعراً ليصور روحه، أو يُجسِّد شفافية الروح.. بل لا بد أن نجلس بعض الوقت! |
| لعلنا نطلب الآن من كل كاتب عربي.. أن يجلس بعض الوقت! |
| وتطلب من كل قارئ عربي - أيضاً - أن يطالب "الكاتب" بالحقيقة! |
| إن الذي نراه الآن: عجيب، وساخر، و "قاعيّ"! |
| إن الكاتب في صحيفة، أو مجلة، أو حتى للإذاعة والتلفاز، والكاتب الذي يصدر الكتب.. تحس بهم جميعاً كأنهم يكتبون وهم "وقوفاً".. يسابقون الوقت، ويضيِّعون الزمان.. يركضون في كل المسافات، ويخسرون نقطة وقوفهم الأصلية! |
| لا وقت لدى هذه "الطبعة الجديدة" من الكُتَّاب والمؤلفين.. المهم أن يكتبوا، ربما للتنفيس - إذا بحثنا عن عذر أو سبب - وربما لأننا بلغنا العصر الذي ألمح إليه نبي هذه الأمة وبشيرها: "عصر فشُوِّ القلم"! |
| وسؤال آخر.. أكثر جدية، ومحاولة للرؤية وللالتحام.. يقول: |
| • ما هي قضية الكاتب اليوم؟!! |
| ـ حرية الوطن.. في عصر تفشِّي الاستعمار، والظلم، والقوة الغاشمة؟! |
| فكيف تُعاد حرية الوطن.. في ضياع حرية العدل، وحرية الحق، وحرية المنطق في العالم، وفي مفهوم كبار العالم وسفَّاحيه؟!! |
| ألم يقرأ كبار العالم لـ "توم بين"، و "جيفرسون"، و "زرادشت"، و "غاندي"، و "نهرو"، و "برنارد شو"، و "برتراند راسل"؟! |
| أم أن الزعامات السياسية العالمية قادمة من محطات الأتوبيس، و "الأوتوستوب" و "قاع" العالم؟!! |
| هل يتحكم في مصائر الشعوب: قادة العالم "الكبار" من المرضى نفسياً، ومن الذين يعانون من عُقَد نفسية؟! |
| ألم يجلس كبار العالم - في لحظة إصغاء - لسماع سيمفونية، أو كونشرتو، أو معزوفة جميلة، وينامون على العشب الأخضر، ويمشون تحت المطر؟! |
| من يرى العالم اليوم.. يظن أنه قد خلا من الشجر، وشح فيه المطر، وضاع منه النغم وسخروا فيه من "الكتاب"، وانحصر عبق "أنوثة" المرأة في لحظة الشهرة؟! |
| كأنَّ العالم: لا يسمع، لا يقرأ، لا يرى.. ولكنه يثرثر، بينما كل الدلالات الجمالية في الحياة تصمت وتصاب بالبُكْم! |
| وتبقى أصوات: المدافع، والرشاشات، والقنابل، والأحقاد، والأمراض الخبيثة... هي الأصوات التي تسود مناخ الإنسان! |
| أليس من المطلوب - إذن - أن يجلس الكاتب، ويتأمل، ويستوعب، ثم يكتب بعد ذلك بصدق، وبتجربة، وبرؤية أشمل؟! |
| نحن في عصر ازدهار "المذكرات" وكتابتها، وادعائها، والكذب فيها! |
| أصبحت "الكتابات": واقفة، قلقة، متوترة.. فقدت ملكية المعنى الذي تريد أن تصل إليه! |
| أليس من المطلوب - أيضاً - أن يفتش القارئ عن "الحقيقة"، وعن التفاصيل؟!! |
| أكثر القراء لا وقت لديهم، أو أنهم أسارى ما يأخذونه من الوقت.. والوقت لا يمنح القارئ سوى لحظات يطالع فيها العناوين الكبيرة. والخبر المثير، والصورة الملونة الفاتنة والفضائح، والمعارك بين أسرة الثقافة فيما بينهم(!!). |
| • • • |
| * الفكر.. والانقلاب العسكري!! |
| • كأن الفكر، والإبداع، وترجمة المشاعر والأحاسيس الإنسانية.. تتساوى تماماً مع خبر انقلاب عسكري في أفريقيا السوداء، أو في أميركا اللاتينية، أو مع طعنة الانقلاب الضميري في نفسية زعيم عربي تشدَّق بالثورية، وبالديموقراطية!! |
| ولكنَّ القارئ العربي - أيضاً - مأخوذ إلى صفات العصر الجديدة.. فكيف له أن يقرأ رواية عاطفية، أو حتى اجتماعية، ويقرأ ديوان شعر.. ووطنه مهدد، وإنسانيته مهددة، وعصره يعاني من التلوث والتجلط؟! لذلك فليس غريباً أن "يتصوَّف" الفكر العربي خلال السنوات القادمة.. لأن الكاتب العربي يكاد يسقط في الانفصام.. فهو مرة كاتب يمنح من أعماق حزن العربي، وينزف الألم الكامن في كل تاريخ الأمة.. وعندما يبدع، لا يجد القارئ الهاضم والمستوعب، بل يصطدم بقارئ يجري، وبقارئ "ساندوتش"! |
| وهو مرة: كاتب السطح.. يلتقط ما يتدحرج أو يسقط على سطح العالم العربي، كما الأحداث الطارئة، ويسمي ذلك: "رواية" أحياناً، وقصة قصيرة، وقصيدة شعر تعيسة أو غامضة! |
| فالتصوف الفكري.. لن يأتي إبداعاً، ولكنه "وعد" خَطِر للوعي، العربي، أو وعيد أخطر للوجدان العربي!! |
| وهناك حقيقة صوّرها، وكتب عنها المفكرون والأدباء العرب عن تاريخهم، ومطالب أرضهم، وعدالتها وطموحاتهم.. لكنها حقيقةً فشل أن يواكبها هؤلاء، فذابت في الرغائب، وتحولت إلى تمثال متلفع بالانبهار الأخرس.. ، وإلى ساعة سقط عقربها! وتأتي إلى إصدار الكتب، وهي - في محتوى الكثير منها - غارقة في تعذيب النفس، وفي استرجاع الأخطاء، وفي شتم الموتى، وفي استعادة المعاناة وأصداء الهزائم، وفي تجريد التاريخ العربي من دوره ليقيّم ويُصَفّي! |
| إنها هذه الكتب التي تحوَّل فيها مؤلفوها إلى: مخبرين صحافيين.. يجمعون الأحداث التاريخية، المتوارية خجلاً، ورواية تلك الأحداث كالفضائح.. كأنَّ ذلك يعني ما ردده "توينبي" قبل وفاته بعامين، فقال: |
| • "الانطلاقة العربية المقبلة.. لن تأتي من أذهان مفكري العرب وأدبائهم، ولكنها تأتي من معاناة الذين تهدّمت فوق رؤوسهم البيوت، وهدمت إسرائيل قراهم، وقتلت |
| أطفالهم ورجالهم.. أولئك هم فلاسفة الحياة في العدم، وظهور الحياة من العدم"!! |
| ولكن هذه العبارة التاريخية.. لا بد أن تكون لها تكملة، لبناء المعنى الشامل لها. |
| والتكملة.. قالها "برتراند راسل" من زمن بعيد، قبل استفحال شراسة العدوان وقبل كلمة "توينبي".. ونصها: |
| "لقد انتهى عصر إبداع الكلمة.. لأنه جاء عصر غلوُّ العقل، وسيطلع القرن الواحد والعشرون على البشر، وهم أكثر أميِّة مما قبل الحضارة والإنجاز العلمي.. لأنه سيكون عصر القوة المدمرة بالتهديد"!! |
| ولكنَّ دور المفكر والأديب.. من الضروري أن ينبعث من تحت الركام، وإذا كانت المنطقة العربية قد عانت، وما زالت تعاني من تسلط القوة، وشراسة العدوان، وغياب العدالة عنها.. فهناك أمم سبقتها، ولاقت أكثر، بل ودمرت كل مدنها وحضارتها.. ولكنها انبعثت، وأنجبت المبدعين والملهمين. |
| • • • |
| فصل الروح عن العقل: |
| إن أخطر ما في هذه الغربة الثقافية، ليس: "المنتج" أو "المستهلك".. لكنه (المنظِّر) والمتسقِّط، والذي يطالبك بفصل الروح عن العقل، أو اعتبار العقل وحده هو النموذج، والروح هي "السلوك السري" في حياة الإنسان! وهذا هو الانفصام.. نجده في واقع الوجدان العربي! |
| الغربة: أن لا يستطيع كاتب عربي، في بلد "ثوري!" أن يكتب عن الحرية، فيصيغ قصيدة شعر.. يغازل ويلعن فيها امرأة! |
| أصبحت الأنثى - بالرمز - هي الوطن.. لأن الأنثى محرَّمة عند التعبير عنها، أو بتصوير أحاسيسها.. إما أن تكون "أماً" فقط، وإما أن لا تكون.. والمرأة العربية قد تخلت عن هذه القناعة، لأنها تحاول أن تحارب.. لكثرة ما أشعرها الرجل العربي أنه "الفارس" دوماً، وهي "المهرة" أبداً.. ولكثرة ما عاملها على أنها: "هِجْرته" إلى نفسه، وهي تريد أن تكون: عودته إلى نفسه ووطنه!! |
| الغربة: أننا نحاول العودة إلى طفولتنا.. ونعجز! |
| الغربة: أن نكتب ما نشعر بأنه صوت الداخل في كل إنسان، ويرفض الإنسان صوته! |
| إننا نحتاج إلى "تنمية" المشاعر.. قبل تنمية الدخل! |
| (2) |
| • في متابعتنا لأفكار، ولآراء (المثقفين) العرب، التي يطرحونها عبر وسائل الإعلام، ومن خلال مهرجانات الفكر، والإبداع.. لا بد أن نتوقف قليلاً، لنتساءل: |
| ـ إلى أين وصل (المثقفون العرب) بما طرحوه، وكتبوا عنه، ونادوا به.. هل تحقق شيء من ذلك، أم اكتشفوا أن صوت (المثقف العربي): يزداد وهناً وخفوتاً في زحام الإعلام السياسي والاقتصادي؟! |
| وهل التفتت الأجهزة الرسمية المسؤولة عن الثقافة والإعلام في الوطن العربي إلى "بعض" ما طرحه هؤلاء المثقفين، وناقشته، وحققته؟! |
| • • • |
| • أذكر موضوعاً ضخماً، وصعباً، ومثيراً، طرحه بعض المثقفين العرب من خلال ندوة تبنتها "هيئة الكتاب المصرية" ضمن فعاليات معرض الكتاب لعام 93، وكان محور النقاش يقوم على هذه القاعدة: (وضع ميثاق للمثقفين العرب).. وقد كنت مشاركاً - في حدود - وتفاعلت خواطري وأفكاري حينذاك في أجواء النقاش، وركضاً وراء تلك المداخلات التي يسهل على المثقف العربي كتابتها والمناداة بها، ويصعب جداً أن يجد من يبلورها: فكرة، ثم ميثاقاً للمثقفين العرب.. ومن سيعترف بهذا الميثاق من أجهزة الثقافة العربية، ويمنحه شهادة الميلاد؟! |
| حتى "مصر" التي تبنَّت إحدى مؤسساتها الثقافية الهامة والفاعلة ترتيب هذه الندوة بحماس شديد: لم تعد تذكر شيئاً عن ذلك الميثاق المقترح الذي (قد) يحمي المثقف العربي من الإهانة، والظلم، وتفسير أفكاره بهوى بعض السلطة العربية التي تضيق بحرية، وتطور الثقافة! |
| في عمق أزمة الشرخ الذي أحدثه "صدام حسين"، لم يستطع المثقفون العرب أن يقولوا الحقيقة بكل أبعادها... بل إن هؤلاء المثقفين اعملوا في بعضهم البعض: تجريحاً، واتهامات... فلم نعد ندري مَنْ العربي الخالص، ومَنْ العميل، أو المسترزق!! |
| • • • |
| • جميل أن يتجمع المثقفون العرب على أرض عربية، ليتصافحوا، وليتعانقوا، و... ليتبادلوا النكات، ولكنهم - حتى إشعار آخر - لم يتوصلوا إلى وفاق نفسي في أعماقهم، وفي ما بينهم! |
| أية وحدة عربية يُراد لها أن تنبثق من ميثاق ثقافي عربي، بعد فشل المواثيق السياسية.. وبين العرب مَنْ طعن مفهوم وأبعاد الوحدة، وتوحدُّ كلمة أصحابها؟! (وهذا المثال الآخر بعد العراق والكويت: اليمن واليمن)!! |
| هل تراها: وحدة القسر، والتمزق، والقتل، وسرقة الوطن؟! |
| لقد تسبب هؤلاء الطاعنون للوحدة وللتضامن في إدخال العرب ضمن دائرة التناحر الإقليمي، ليتشققوا بانتماءات تدور في معاني: التقدمي، والرجعي... والغني بالنفط، والفقير.. حتى يوغروا الصدور، ويوسعوا الخلاف.. ويقوم التناحر الإقليمي بإسقاط القدرة العربية على مواجهة التحديات التي تحوطها! |
| • إنه السؤال الموجع بأحداث الوقت الراهن.. في الوقت الذي يبحث فيه المثقفون عن "ميثاق" لهم، يعرفون أن لا أحد سيعترف به: |
| ـ ما هي "وحدة" الفكر العربي المطلوبة أولاً، ليبلور منها ميثاق للمثقفين.. وأي منهج، أو شعار، أو حتى رؤية، يقوم عليها ميثاق المثقفين؟! |
| • • • |
| إن الكلام لن يكون أقسى ولا أوجع من ألم هذا (المِلْح) الذي نثره مَنْ حسبناهم يوماً: رموزاً، أو مصلحين في مسيرة (العقل) العربي، والحكمة العربية.. فزاد الجرح العربي بملوحته: وجعاً! |
| (3) |
| حلّقت في المدى.. ورقصت في السفر! |
| وخلف أجنحة الحمام الزاجل من الزمن القديم، انطلقت نظراتي وأفكاري، أو كأنّ حدقتيّ تترددان على المدى الأرحب.. تسترجع الزمان، وتطوف على الأمكنة، وتلملم الرؤى المتكسِّرة في الشروخ! |
| حدقتاي: ملآنة بالتعلق.. فائضة بالتجمُّع الروحي حينما يلتئم بكلمة من الصدق، وبنغمة من تلك الروابط التي أينعت بسبب خصوبة الأرض بالحب! |
| حدقتاي: مأخوذة إلى مئات وآلاف الأميال في تاريخ الإنسان.. في موجاته الحسية والعقلية.. في كل قدراته، وتعاطفاته، ووشائجه المجسدة في وحدة الأرض، والدم، والمصير. |
| وانتهى دور الحمام الزاجل، إلا دور رغّد أرواحنا بتأمل عطائه وقدراته! |
| وتبلور دور "الكتاب" وقد أصبح يمثل في عصرنا قدرة أكبر من دور الحمام الزاجل آنذاك! |
| كان الحمام الزاجل: "مرسال الهوى"، وكانت خطواته لا تخطئ.. حمل كلمات الوجد، والاطمئنان، ونقل الأخبار والأسرار، وشارك في الانتصارات والهزائم، وكان ذلك في الزمن الراحل.. يوم اهتدى الإنسان إلى مقدرة "الحمامة" على قطع المسافات، ومعرفة الأمكنة وتحديد التوقيت، وكان العلم بكراً، وفعل الإنسان بواسطة هذا الطائر الأليف الذي عبَّر بإطلاقه عن عطاء الحرية، وأثبت بحسّه تعطل القدرات. |
| فهل أصبحت الحمامة اليوم مصدر حيرة الإنسان وتساؤله؟! |
| ـ قالوا بتظرف ثقيل: لقد تغابى الحمام اليوم فلم يعد يوصل الرسائل.. لماذا؟! |
| لأن نسبة الحمام المنطلق قد تضاءلت.. ولأن وسائل العلم الحديث قد استغنت بلا شك عن دور الحمام الزاجل.. ولأن "الحمامة": شعار السلام.. أصبحت اليوم مورّطة في ادعاءات لا تطيقها! |
| وربما كانت مصادفة أنني حين كنت أفكر في هذه الصورة.. كنت قد حدقت بتأملاتي في نقيضين صاحبا الحقبة الفكرية التي كتب وظهر فيها "أنيس منصور".. فقبل الترويج الإعلامي المصري لمعاهدة الصلح المنفرد، بل وقبل أن يصبح أنيس منصور رئيساً لتحرير مجلة أكتوبر.. كان قد كتب، وأصدر بعض كتبه التي أثبت بها: "تعليق عضوية إسرائيل في العالم الحر أو العالم الإنساني!".. لأنه كان يعتقد أن إسرائيل عدو لن يترك حقده على العرب ومحاربته للإسلام، فكان هذا هو الوجه العربي لأنيس منصور، ولقد كان أكثر إلحاحاً في العنوان الذي ردده وهو: اعرف عدوك!! |
| وبعد "أكتوبر" ثم معاهدة الصلح.. استطاع بقدرة عجيبة أن ينقلب على تلك الحقائق وأن يوظفها لغسل دماغ الشعب المصري والعربي، وأن يجد الشجاعة عنده ليقول: إن "الوجع في قلب إسرائيل" قد شُفي تماماً، فلا أحقاد فيه ضد العرب، ولا أطماع توسعية، وليقول: إن "الحائط والدموع" حقبة قد تم القضاء عليها، فالحائط سيسقط والدموع ستجف، وفي المقابل رد عليه "بيغن" قائلاً: الحائط سيبقى وسيكبر، لأن القدس ستبقى عاصمة إسرائيل!.. أما الدموع فسنكثِّفها في عيون العرب! |
| وليقول أنيس أيضاً: إن "جيل الصابرا" هو جيل الغد.. أو سيكون هو الجيل الذي نحاول أن نوحد بينه وبين جيل 15 مايو!! |
| وبذلك.. أصبح الاحتياج إلى الحمام الزاجل غير ضروري أبداً، لأن التعبير عن الحب ليس هذا زمنه في واقع روابط ووشائج الأخوَّة.. ولأن الرغبة في التجسس على العدو ولو بواسطة الحمام الزاجل لا داعي لها، فنحن قد أقمنا سلاماً مع العدو، ولا دخل لنا لو أراد العدو أن يتجسس علينا، فلديه أرحب الوسائل لتحقيق أغراضه(!!) أما "الحمامة" فإن أنيس منصور نفسه قد أثبت عجزها التام عن مواصلة دورها القديم.. حينما أخبر في واحد من كتبه فقال: |
| • "إن إحصائيات رسمية صدرت عام 61 تؤكد أن إحدى الهيئات أطلقت ثمانية آلاف حمامة زاجلة، ومن العجيب أن (7950) حمامة ضلت طريقها إلى العودة، والمسافة لم تتجاوز 400 كم، وقالوا إن تفسير ذلك يعود إلى الموجات الكهربائية والمجالات المغناطيسية اللانهائية التي تطلقها موتورات المصانع والآلات، ومحطات الإذاعة والتلفزيون وشبكات الرادار، كلها سببت تشويشاً على هذا الطائر"!! |
| وهكذا.. فقد انتقل الإنسان من عصر الحمام الزاجل.. إلى عصر الإنسان الآلي، ولكن.. هل تنجح هذه "الآلية" في تعطيل جوهر الإنسان، ومميزاته كعاطفة، وكفعل.. كروح، وكإرادة وطموح؟! |
| • • • |
| * كيف تطور العلم؟! |
| • لقد تأكد لنا - إذن - أن القضاء على الحمام الزاجل، أو إنهاء دوره.. كان بسبب تطور العلم الحديث، أو تطور العقل الإنساني، ولكن.. كيف تطور العلم، وكيف انتشر، وكيف بلغ العقل الإنساني إلى هذا المستوى من الشيوع والفعل؟! |
| ليست الآلة هي السبب، وإنما "الآلة" هي ثمرة العلم المتطور، وعطاء العقل المتعلم. |
| وليست هي الوسائل الحديثة للمواصلات، وإن كانت تلك الوسائل قد ساعدت على اختصار الزمن، لأن المواصلات الحديثة كالطائرات، والإذاعة، والتلفاز، هي نتيجة العلم المتطور، وعطاء العقل المتعلم.. وإنما كل هذه الوسائل، قد توافرت وتحققت بعاملين اثنين: |
| • العامل الأول: الروابط الإنسانية بين شعوب الأرض، وهي التي نستخدم لها تعبيرات خاصة.. مثل: السلام، الوفاق، المصالح المشتركة، وهذه الروابط هي التي دفعت العلم ليبتكر ويستحدث الوسائل المتطورة لتقليص رقعة العالم الواسعة، ولتقريب الأصوات، وربط الأفكار والآراء.. وهي التي أضاءت العقل المتعلم لتلمس اتصالاته الإنسانية، فالروابط الإنسانية قد مكنت الإنسان من اختصار الوقت وتقريب المسافات، وأحسب أنه لو كانت إسرائيل قد وجدت الفترة العظيمة من تاريخ الإنسان - فترة الاختراع والاهتداء إلى الوسائل المتطورة - لما استطاع العلم أن يفعل شيئاً لسلام الإنسان وحضارته وتفوقه العلمي.. لأن إسرائيل ستبادر إلى استغلال ذلك الاهتداء العلمي لمصلحة الدمار والحروب والتوسع، وستعمل على إبقاء شعوب الأرض في فاقة وضنك لتسودهم هي، وهذا يدلل: على أن إسرائيل لم تكن حضارية قط، أو ليس لها حضارة بمعنى التراث، والقيم، والآداب، والفنون، والعمارة، والتطور العلمي.. وبدليل: أن إسرائيل في حاضرها اليومي لا تهتم فيما تدَّعيه من بناء حضاري، إلا ببناء المفاعلات الذرية، وتكديس الأسلحة، وصناعة تلك الأسلحة.. أي إنها كيان يقوم على التدمير، ويتخلى عن عطاء الكلمة وأفعالها نحو استتباب الأمن والسلام لحياة الإنسان! |
| ولابد أن يشهد العالم في وقت غير بعيد - وبفعل إسرائيل - تقويضاً بشعاً مهولاً لشواهد هذه الحضارة الهائلة التي تحاول بها الشعوب أن تحقق الرخاء والرفاهية لواقعها.. فإسرائيل كيان تجمَّع من أطراف الأرض، لا تربطه وحدة أرض، ولا وحدة دم، ولا وحدة تراث، وإنما كل ما يربطه هدف التوسع والاستيطان فوق أرض عربية لا يملكها، وهو بهذا الهدف يحلم بإنشاء (ولايات متحدة إسرائيلية) يكونها من التوسع والاستيلاء على الدول العربية!! |
| فالروابط الإنسانية: هي التي تمكننا من المحافظة على تطور العلم، والمحافظة على العقل المتعلم، بحراسة الأرض، والمقدسات، والتراث، والتاريخ الطويل... وبغير الروابط الإنسانية لن نستطيع أن نبني عصر الرخاء والرفاهية، وإنما بتحديات ومجابهة إسرائيل لنا سوف ننشغل في عملية انتشال الزمن من الغرق في محيطات هادرة من أحقاد الصهيونية، ومن مؤامرات الاستعمار، ومن مخططات الشيوعية.. وهي حراب مسمومة تتحد اليوم لتطعن هذا البناء الإنساني الذي أقمناه بالروابط الإنسانية!! |
| العامل الآخر: إن الآداب والفنون لا بد أن يكونا هما العلاج لكل هذه لكل هذه الصدمات والشروخ والإنفصامات التي أحدثتها الآلام والخوف والتهديد في الروح.. فعندما تهدمت ألمانيا تحت وابل القنابل، لم تجد شيئاً بعد الحرب والذل والانتهاك إلا أن تلجأ للفكر، وأن تتعزى بالفنون.. فالكتاب كان عاملاً مهماً في معالجة الروح في الشعب الألماني، وفي إفاقة العقل من الصدمة، وكان النغم هو المنظف السريع لوجدان الإنساني الألماني من الحزن، والآلام.. لئلا يستغرق الشعب الألماني في ذلك الحزن فيعجز أن يبني من جديد.. لأن قتل الروح في شعب ما هو قتل للطموح، وللإرادة، وللقدرة على الوقوف من جديد. |
| (4) |
| • لماذا حاولوا قتل: الروائي، المثقف، المبدع النوبلي (نجيب محفوظ)؟! |
| لا أكثر من إحداث: الرعب، والخلخلة في نفسية "المثقف" لتكريس "الخوف" في داخله.. فلا يجأر بكلمة الحق، ولا يدين الإرهاب الذي استهدف - قبل كل شيء - قتل الأبرياء، والأطفال.. تحت شعار: العودة إلى الدين! |
| والعودة إلى الدين من تعاليم الإسلام: وجادلهم في الأمر، والأمر بالمعروف.. ولم يحضّ الإسلام على قتل الأبرياء! |
| حتى لو اختلفنا مع كاتب كبير، جدّد في البناء الروائي، مثل "نجيب محفوظ".. فالاختلاف لا يمنع إلى محاولة "ذبح" رمز فكري وإبداعي كالشاة! |
| وإذا كان هؤلاء الذين يمارسون الإرهاب: قصدوا بجرائمهم هذه، إلفات انتباه الناس (لدعوتهم الدينية!) كما يقولون... فإن الناس لا تقتنع، ولا تتبع مَنْ أقام دعوته على: الدماء، وترويع الآمنين، وتخريب اقتصاد الوطن. |
| وإذا كانوا يقصدون: إحراج النظام السياسي في بلدهم... فالنظام لا تخلخله "حوادث" تكاد تكون فردية، وتستهدف رموز الوطن: سواء في الفكر، أو في الفن، أو حتى في السياسة! |
| إن النظام يبقى قائماً، بل ويزداد رسوخاً بدعم المواطنين له، في تعاطفهم ضد الإرهاب، وزعزعة الأمن والاستقرار، وتقويض الاقتصاد! |
| وأديب مبدع كبير مثل "نجيب محفوظ"، إذا تمَّت تصفيته جسدياً، فإن الناس سوف يتدافعون إلى كتبه، وقراءة أفكاره التي قيل: إنها دوافع الإرهابيين هؤلاء لقتله.. وقد قال ناشر مصري بعد حادث الاعتداء على "نجيب محفوظ": |
| ـ لقد بدأنا في إعادة طبع روايات "نجيب محفوظ" بكميات كبيرة.. نظراً لإقبال الناس على شرائها، وسؤالهم عنها! |
| • • • |
| وجود "البطل": |
| • لقد كان هاجس "نجيب محفوظ": التركيز بإصرار على وجود "البطل" في رواياته، وذلك بسبب شعوره بانعدام "البطل" في الواقع العربي الذي يشكّل سمات هذا العصر! |
| • ففي رواية "ثرثرة فوق النيل": كان البطل المرموز إليه، هو: "النيل"، الذي يستقبل المراحل والعصور، والمتغيرات، ويصغي، ويفيض، ويشاهد تلك المخاضات، والعبور من فوقه وحوله! |
| • وفي رواية "القاهرة الجديدة": كان البطل هو: "التغيير"، أو الانقلاب الاجتماعي السطحي.. بما يشبه الطفو، ولا يتشبث بالأصول!! |
| وقد أرجع ذلك لأسباب عديدة.. أسهم الاستعمار بنصيب الأسد فيها، وأسهمت "الزمرة" بنصيب المنتفع فيها! |
| حتى دخل إلى عمق المجتمع، ونبش في تربته وجذوره، وجذبته التجمعات الشعبية في "زقاق المدق"، و"خان الخليلي"، و"القاهرة القديمة"، و"بداية ونهاية"، "أولاد حارتنا"، ثم "الثلاثية"... فكان البطل هو: الإنسان المصري، أو المجتمع المصري.. بوحدته، وبتراثه، وبتقاليده، وبمعاناته! |
| وحين اتجه إلى الروايات ذات المعالجات السياسية مثل: الكرنك، وثرثرة فوق النيل، واللص والكلاب، والحرافيش... فقد بلور شخصية (البطل) من منظومة "التجريب الشعبي" لحكم الطبقة الاستعمارية، والطبقة العسكرية، والطبقة الحزبية، والطبقة المنتفعة، وليس أدلّ من ذلك التجسيد المؤلم - كارتطام! - في رواية "السراب" لشخصيات تطورت أساليبها فيما بعد في الكرنك، واللص والكلاب، على سبيل المثال! |
| ونعني بذلك كله: أن "نجيب محفوظ" قد اهتم بالناحية السلوكية المؤثرة في عمق المجتمع، وهي التي تُنضج شخصية ومقومات (البطل) أو تنسفهما!! |
| وقد ركّز على هذه الناحية، حتى كاد أن يكون "السلوك" ذاته هو (البطل) أيضاً في أغلب رواياته، وبالذات في رواية "ثرثرة فوق النيل"! |
| ويُرجع الدكتور "عبد المحسن طه بدر" في كتابه "الرؤية والأداة" ذلك كله في أعمال "نجيب محفوظ" إلى ما وجده هذا الروائي في فلسفة "برجسون" القائلة:" |
| • "أن الشعور والمادة.. صورتان من الوجود، مختلفان اختلافاً أساسياً، ومتعارضان.. وهما يتعايشان"!! |
| • • • |
| المثقف.. والحقيقة: |
| • من أقوال الروائي العربي النوبلي "نجيب محفوظ": |
| ـ "إن المثقف هو أقدر إنسان على معرفة الحقائق، أو الحقيقة"! |
| ومع ذلك.. لم يتوصّل إنسان على هذه الأرض، وعلى امتدادها أو تكويرها إلى: معرفة كل الحقائق.. مفصّلة، صريحة، عادية، مباشرة.. برغم أننا في عصر "ذري"، تكنولوجي، يسرع بنا إلى مزيد من مناهل العلم، وتحقيق الانتصارات العلمية والفكرية، ومحو الأمية التي لدينا حتى الآن، وتخفيض البطالة.. حتى البطالة العقلية! |
| إن إنسان هذا العصر، بثقافته.. بعلمه.. بإدراكه المتفتِّح.. بغروره: لم يزل كثير من الحقائق الهامة غائباً عن رؤيته، وفهمه... وذلك لأن الإنسان يعيش عصره ينصف الحقائق!! |
| إن هذا "الإنسان" في حقيقته الأولى: جبار، وضعيف.. متسلط، وخائف. |
| إنه إذا ملك كل الحقائق، أو حتى توهم ذلك الامتلاك، فإنه يهدر زمنه وهو يملك نصف الحقائق، أو نصف الحقيقة، ويمارس إضاعة كل نفسه! |
| • • • |
| • إن "المثقف" - بكل ذخره، وكنوزه الفكرية، ومواهبه - لم يتوصل بعد إلى حقائقه كلها... وهو: أكثر الناس الذي يعانون من القلق، والتبعثر، والحيرة، وكثافة الأسئلة! |
| لكننا أمام إنجازات العلم، لا بأس أن نغتبط... لأن العالم - كله تقريباً - قد وصل إلى هذه المرحلة من "التفهُّم" لكيفية الاستمرارية في الحياة على علاّتها، وأثمانها، وصروفها. |
| ولعلنا نتمنى: أن يسود "الفهم" بعد التعليم، أو بعد هذا الزحام في ارتفاع نسبة الجامعات، والمؤسسات العلمية، والأدبية، والإنسانية... فإذا بلغنا مرحلة الإدراك الجيدة، إستطعنا أن نطور مفاهيمنا للحياة! |
| • • • |
| فنان.. لا مكانيّ: |
| • "نجيب محفوظ" فنان تؤلمه حياة الرتابة، أو، رتابة الصمت الذي يخاف الكلام.. لذلك تراه يخرج من بيته في هذه السن متثاقلاً ليكسر حدة الرتابة والصمت... وهو في رواياته يتحرك دائماً.. يتكلم باستمرار.. يضطرب! |
| إنه: لا مكانيّ.. بل هو مجموعة أمكنة لا أزمنة.. يتطلع إلى عيون الناس من خلف نظارته، ويرثي الحب في حدقاتها... ويتطلع إلى حدقاتهم ويصفها بـ "نبيذ الكذب"... وينظر إلى شفاههم الحاكية، ويتساءل: لماذا الحب إذن؟! |
| في أغلب رواياته.. تحدث عن الحب، وصوره، ووصفه.. وعن (الأماني الغالية التي تصير بلا قيمة!)!! |
| • وجاءه يوماً صحافي يطرح عليه هذا السؤال: |
| ـ ألا يكفي الإنسان ما يناله من حب أهله؟! |
| وكأنه أراد أن يردف سؤاله بعبارة: هذا إن وجد الآن!! |
| • ولكنه رفع رأسه وأجاب الصحافي: |
| ـ أبداً لا يكفي... إنه حب بلا مناقشة.. حب غبي.. حب مستقر أو مقرر.. حب منهجي لا ينقطع ولا يمتنع، لا اجتهاد فيه، وليس حباً للشخص ذاته، وإنما هو حب لوضع معين! |
| ونحن نبحث حقاً - عن: حب ذكي.. حب بمناقشة، واعتصار، واختبار، واختيار.. حب غير مضمون لأي نجاح ما لم يكن احتمال الفشل راسياً على أحد راحتي الميزان!! |
| الجمال: نقطة غير محددة: |
| "نجيب محفوظ": فنان يكتب عن الجمال، ويصوره، ويصفه.. وهو لا يستر نفسه.. إنه يقف في العراء، وينادي على كل المختبئين: |
| إن الجمال: نقطة غير محددة.. |
| إن الجمال: يذوب، ويتمدد، ويتفاعل، ويتأكسد، ويخاطب الناس. |
| إن الجمال: يمنع حدوث الانهيارات في النفس.. وذلك بإحداث الانهيارات في كل حواجز الغباء، والقبح، والمنهج الرتيب، والتقرير البليد!! |
| • ولم يزل "نجيب محفوظ" يمسح عن نظارته الطل، وعن نظراته الزحام... ويتأمل الناس اليوم من بعيد، بعد أن كان يخوض لجّة زحامهم، وأمواجهم، وتدافعهم، ويختلط برائحة حواريهم، وأزقتهم، ويستطعم الكلمات الشعبية المميزة... حتى صار الروائي العربي الذي ارتبطت إبداعاته بالحارة المصرية، وبالكفاح الشعبي! |
| لكن الحاسة التصويرية عنده قد تباطأت في أعماله الأخيرة.. كأنه يعلن عن التعب. |
| وربما أراد نجيب محفوظ أن يعلن عن الوصول إلى القناعة القائلة: |
| ـ ليس في الإمكان أبدع مما كان!! |
| والإنسان/ الفارس: لا تتوقف به شيخوخة العمر.. بل تصقله أكثر، وتجعله لامعاً تحت وقدة الشموس اللاهبة، وفي ظلال الزوايا المعتمة. |
| وقد عبر نجيب محفوظ مراحل سياسية عدة، وكان أعظم ما كتبه: قد تمثل في "الشرائح" التي صورها في هذا الإطار... بعد ثلاثيته المشهورة: كتاباً: وتلفازاً، وسينما، و... ربما مسرحاً! |
| • • • |
| التجربة حين تواكب الثقافة: |
| • بعض العصاميين.. تكتشف فيهم: ما يأخذ بإعجابك إلى الذروة، وربما الذهول! |
| لا تصدق أن هذا "العصامي": علّم نفسه، ورعى ذهنه حتى وصل إلى معرفة (جزء) من أبعاد الحياة بإدراك متفوق... ولكنها التجربة حين تواكب الثقافة غالباً! |
| وهناك من يستظرف، فيقول: |
| ـ ليس من المنطق، ولا من المعقول: أن تجعل كل فرد في الأمة مثقفاً، وإلا فقدنا هذا الإنسان العادي، أو العفوي، أو البسيط جداً: (الثقافة مدعاة لتعقيد الحياة، والموت في سبيل الحقيقة)!! |
| والناس في بعضهم: يحرصون على وجود مثل هذا النوع بينهم.. حتى تقوم الحياة في جانبها الآخر بما يعتبره الآخرون: ضرباً من الحظ الأعمى، أو الفرص التي ضلّت طريقها الصحيح... فيعيش: التسابق، والعراك.. إلى درجة الحسد! |
| • • • |
| • فإذا كان كل الناس: (مثقفون).. لم تستفد الحياة شيئاً ولكنها تفقد بساطتها ربما! |
| وإذا كان كل الناس: (أغبيون) - على وزن مثقفون، أي أغبياء - فلا ضرورة للحياة، أو.... لا ضرورة للإحساس بالحياة، وبالتالي: للدفاع عن هذه الحياة... مثل ذلك الذي أتعبه (فهمه)، وعذبته أفكاره، وتأذى من اعتراضه على الحال المايل، فقال غير مبتسم: (اللهم اجعلني حماراً لا أفهم... حتى أستمتع بالحياة)!! |
| وإذن... فإن طبيعة الحياة تتطلب: وجود المستويات العقلية والفكرية... ونحن لا نطلب أن تكون الأمة - كلها - من المثقفين والعباقرة، بل نطمح إلى بلوغ المستوى الذي يمور فيه العلم، حتى قفز بالإنسان إلى سطح القمر!! |
| (5) |
| • لم يكن "حواراً" عن عطاء الكلمة ودورها، وعن مسؤولية الكاتب والمناخ الذي يتطلَّبه ذلك العطاء، وحجم المسؤولية.. بقدر ما كانت "مشاكسة" ابتدأها شخص عُرِف في هذا الوسط بإشعال الحريق.. بالكلمة الاستفزازية، أو بالرأي العنيف، أو المخالف...... وربما: الجارح! |
| إنه هجر الكتابة منذ زمن، وقال مبتسماً.. كأنه يتشفّى من كل واحد: |
| ـ الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به كثيراً من خَلْقه!! |
| ولكنه يقرأ، ويتابع، ويحلو له في بعض الأحيان أن يُشكِّل من "الكُتَّاب" حجار شطرنج، يصنفهم على رقعة لعبته كما يستمزج... فهناك الكاتب: الحصان، والكاتب القلعة، والكاتب العسكري، والكاتب الوزير... لكنه يؤكد من خلال ما يقرأ في صحف العالم العربي كله: أنه ليس هنالك الكاتب/ المَلِك... أو الكاتب الأعلى والمتفوق والباهر!! |
| وفي ذلك المساء... تحدث هذا المشاكس عن انطباعاته نحو ما يقرؤه في الصحف، وإذا به يرغي ويزيد، وينفعل، ولعله يتحامق... فيقول: |
| • اسمعوا... أنتم يا من تكتبون في الصحف الآن، وتُصدِّعوننا بكلام مكرور... لكي تظهر صوركم مع مقالاتكم، أو "رَغْيَكم"، لقد سئمناكم، ومللنا من عباراتكم... لأنكم تدورون في حلقة مفرغة... لأنكم كففتم عن كتابة الكلمة الجيدة، والفكرة الجيدة، والرأي الصريح، كأنكم تُروِّجون للكلمة العانس! |
| سأله بعض الذين يكتبون: ما الذي تريده بالضبط، وتبحث عنه؟! |
| • قال: أن ينظف الكاتب العربي عموماً قلمه من الكلمات التي تلوَّثت بالخوف، وبقرع طبول الحرب، وبالإثارة المكشوفة بلا ذكاء! |
| لابد أن تُغيِّروا جلود كلماتكم، وتطوروا أفكاركم، وتقدموا للقارئ غذاء روحياً وعقلياً: طازجاً، وصادقاً، وفياضاً بالإحساس! |
| • • • |
| • أصغيت - مع من أصغى - إلى هذا المشاكس الذي يستفز بسلبية عجيبة، فقد كان يكتب وانسحب.. ولم يعد أحد يعجبه، ويَصِف الكثير من الكلمات التي يقرؤها بأنها: ملوّثة.. تثير اهتمامات بعض الناس، وتستقطب التعليقات المباشرة، ولكنها لا تقوى على الحياة والاستمرار في أذهان الناس! |
| وكنت أرغب أن أطوّر الحوار معه... فنحن لا نختلف معه في بعض الإشارات التي طرحها، وأيضاً لا نتفق معه في الطريقة التي احتد بها، وأسقط معاناة الكاتب، والطقس العربي، والمتغيرات! |
| وإذا كان ذلك المشاكس قد وصف الكلمات بالتلوُّث... فلا بد أن يجد ما قصد ووصف، دون أن يجعل الحُكْم مطلقاً! |
| إن هناك بعض الكلمات المرتبطة بما يسميها السلوك: ظواهر... مثلما أنها تعني في التعامل، عيباً، أو ذماً، أو نقصاً، أو، مرضاً في النفس... والكاتب - في كل الأحوال - إنسان من هؤلاء البشر! |
| ولكنَّ إطلاق الأحكام جزافاً، أو احتداداً، أو تنفُّجاً، أو استعلاء على الآخرين... لابد أن يعبِّر - أيضاً - عن تلوث نفسية، أو انطباعات مُطْلِقها أو مروجها... لأنه عجز عن شيء، أو فشل في شيء، أو "تعقَّد" من شيء! |
| ويبدو أن مشكلة العالم الثالث عموماً.. صارت تنحصر في أدواء المثقفين، أو في الخلخلة النفسية التي تهزمهم من الداخل! |
| فإذا كان "المثقفون" في العالم الثالث يشكون من الشعور بالتلوث، ويُضخِّمون هذا الشعور في الآخرين، ثم يمقتونه... فإنهم يعانون - بلا شك - من التعبير الصحيح الغائب، ومن الحوار النقي فيما بينهم... لأنهم يتوقون إلى ممارسة "التعدِّي" على كل شيء بشعار يرفعونه، ويرددون: |
| ـ أحلامنا فسدت، وقدراتنا مشلولة... فأين قيمة الثقافة ودورها؟! |
| ذلك هو مرتكز، أو محور "الفرجار" الذي يريد أن يحمله كل مثقف في العالم الثالث، ليرسم به دائرة واسعة، يحبس في داخلها قناعاته، وأفكاره، ورؤيته.. ويدور حولهم!! |
| وبرغم أن التربويِّين، والمعلمين، والموجهين، والمفكرين، ووسائل الإعلام... يحاولون جميعاً أن يهتموا بالمعالجة - عبر الكلمة والترشيد والتثقيف - من داخل الإنسان: حضارياً، ومعرفياً، وتمديناً... لكنَّ هؤلاء أيضاً يُهملون العناية المطلوبة، بل والضرورية لقيمة الإنسان، ولأحلامه! |
| إن قيمة الإنسان في هذا العصر.. لا تحميها قواعد ثابتة، ولا حدود سلوكية... بل هناك تسبب في مدى (التعدِّي).. مثلما هناك أيضاً معركة إفسادية ضد فعاليات الإنسان.. يتمّ استخدام الكلمة فيها، واستخدام "الحلم"، واستخدام الثقافة!! |
| وهنا... أسترجع أصداء صوت "أراجون"... الذي كان يردد: |
| • "إن معركة حياتي تتلخص في التعبير عن أشياء خارج كياني.. سبقتني إلى هذا العالم، وستظل بعد أن أتوارى عنه"! |
| وإذا كانت الكلمة مهددة بالتلوث... فذلك لأن أحلام الإنسان هي الأخرى مهددة بذلك التلوث! |
| وإن أبسط فعالية لتفشي ذلك التلوث، تتمثل في: اختلاط الألوان، وفي اختلاط السلوك والممارسات!! |
| وتتمثل كذلك في: التلون النفسي، وأخطره: اختلاط الألوان في أفكار الناس، وفي مناهج فكر المثقفين أنفسهم، وحتى في عواطفهم(!!). |
| ولقد قيل: إن الأشياء الملونة تتضح أكثر... فالألوان المتعددة ليست للزهو فقط، وإنما هي - بالنظرة الفنية - لرؤية كل لون على حدة، ثم رؤية اللون الواحد متجانساً مع عدة ألوان! |
| وفي القديم، وقبل أن يصبح اختلاط الألوان دلالة على اضطراب النفس... كانوا يقولون: |
| ـ إن السماء تبدو أجمل بعد نزول المطر! |
| ولا بد أن عطاء الكلمة، ودور المثقفين، بعد التعبير، والحوار، والإبداع.. يمثلان نزول المطر، وهو ما يفتقده القارئ في هذا الصخب! |
| لكن "الألوان" الآن... تتحكم، وتؤثر حتى على أحلام الإنسان! |
| ولابد أن هذه "الألوان" في ما يطرحه المثقفون... قد أثَّرت على أحلام الإنسان، وفي تلقِّيه لهذه الألوان التي تبدو متصارعة ومصطرعة! |
| • • • |
| • لقد تذكرت: كيف أن "الكاتب" "المرجوم بالالتزام اليومي"... إنما يشبه "المثل الذي لا يملك إلا قطعة صلصال واحدة.. ولابد أن يعطيها في كل يوم شكلاً جديداً، أو يحاول أن يُشكِّل منها ملامح ربما جاءت جديدة... ثم يتعرض للذم، وللقدح، وللتقريع! |
| لكن قطعة الصلصال هذه لم تتغير، ولم تتعدد فتصبح عدة قطع... إنها واحدة فقط!! |
| ولعل الجانب الآخر من المشكلة... يكمن في هذا (الواغش) الذي ازدادت كثافته.. فأنت لم تعد تقدر على إحصاء عدد الذين يكتبون، ولكن المجال مفتوح لكل "كلام" يقال... "ومن علامات الساعة: فُشوُّ القلم"!! |
| إننا نطالب بتشجيع المواهب، وإفساح المجالات لظهور الشباب: في أفكارهم، وفي طرحهم، وفي ثقافتهم، وفي أدبهم وإبداعهم... ولكنْ لابد أن نختار، ونكتشف، وتشدنا الموهبة التي تعلن عن نفسها! |
| إن البعض يحاول أن يحطم البعض الآخر... برغم اتساع الساحة، وضجيجها، وغثائها!! |
| • • • |
| • ذات يوم... تلقيت رسالة مطولة من "قارئة" طرحت سؤالاً، وألحت على إجابته: |
| ـ هل تكتب من واقع تجارب تمرُّ بها، وتعايشها، وتقاسي منها، وتعاني أحياناً... أم أنك تمتلك خيالاً خصباً، تدعه يمتزج بتجارب الناس والحياة عموماُ؟! |
| وخلت أن الإجابة لا بد أن تكون بديهية.. يعرفها القارئ المطلع، والمتابع، والناضج. |
| وهذا السؤال واجهني كثيراً، خاصة بعد الرواية القصيرة التي أصدرتها بعنوان: (جزء من حلم)! |
| ولكنَّ الكاتب، وهو يتوق للنجاح من خلال صدق العمل الإبداعي، ولابد أن يلتحم بالناس، وأن يسبر أغوارهم، ويصغي إليهم، ويبلور همساتهم وصرخاتهم وشجونهم! |
| والكاتب إنسان.. شريحة من ملايين الشرائح الإنسانية، له نفس العواطف، والصغائر، والقِيَم، والمثل، والرغائب، والأحلام... لكنَّ الفارق يتضح في نسبة الوعي، والثقافة، والنضوج، والقراءات... وفي صحة النفس! |
| الكاتب إنسان... يجرب ويعاني، ويحلم، ويستطيع بذلك كله أن يجسِّد الناس من داخله وبصوته... وأن يجسّد داخله من خلال حكايات الناس! |
| لكن المشكلة لا تتوقف هنا أبداً!! |
| عندما ينحرف إنسان عادي... فإنه هو هذه الشريحة التي تتشابه مع آلاف الشرائح الإنسانية.. له ظروفه التي تهزمه، وله أشياؤه الصغرى... وهذه خسارة إنسانية!! |
| لكن المثقف يعني: الفكر، والوعي، والنضوج، وقيادة الرأي العام، وتوجيهه، وترشيده... فإذا أصيب فكره بداء، أو انحراف، أتخلخل نفسياً... فهذه خسارة قومية، وحضارية، وثقافية! |
| وليس ذنب "المثقف" في كثير من الأسباب التي تؤدي بالبعض إلى الإحباط، أو الخلخلة... بل يندسُّ الذنب في دوافع تلوث الكلمة، وفساد الحلم، وممارسة (التعدِّي) باسم الثقافة على كل شيء!! |
| لقد شدَّني - أخيراً - عبارة لم تكن عابرة... بل تجذب إلى معانيها وأبعادها، وتستأهل التأمل: |
| • "أكثر ما يخيفنا في - الفاهمين - المعاصرين، هو: عجزهم عن إدراك ضرورة استناد المجتمع الإنساني إلى قواعد عامة في السلوك، والنزاهة، والضمير، والعمل، والاستقامة، والتفوق، والتجرُّد... مهما كان الأساس السياسي، والإقتصادي للمجتمعات"!! |
|
|
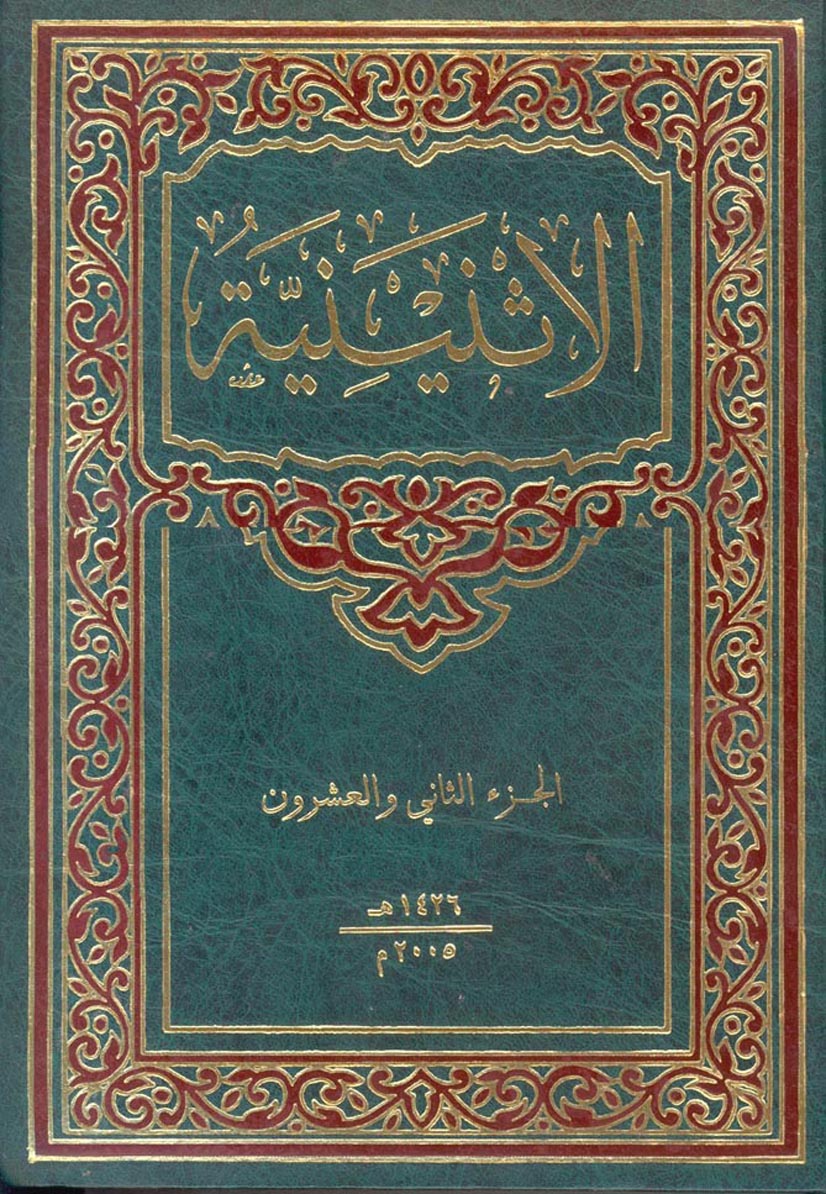
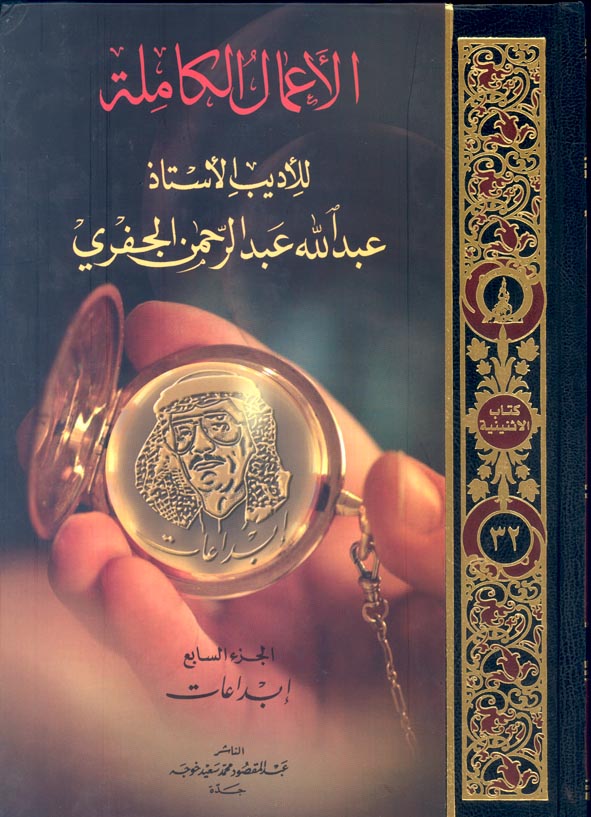
 شارع عبد المقصود خوجة
شارع عبد المقصود خوجة 00966-12-6982222 - تحويلة 250
00966-12-6982222 - تحويلة 250




