| الفصل السادس عشر: التأمل جُوَّانياً! |
| القديم، وأصداء تلويعها الجديد له - تدفعه ليردد أغنية من زمن صوتها القديم لعبد الحليم: |
| (رميت نفسك في حضن.. سقاك الحضن: حزن.. حتى في أحضان الحبايب: شوك يا قلبي)؟! |
| هل يحلم بغيرها... هي المرأة الخرافية؟! |
| هل يحلم: أن لا تحلم به امرأة غيرها؟! |
| يريدها - وحدها - في كل هذا الزحام... أحبها هو، لم يستعبدها... استعبدت هي قلبه، لم تحبه! |
| بقي يحلم، يحلم، يحلم... حتى صار يحلم بالحلم، و..... غرق، حتى استقر في قاع بحرها! |
| كان أشد حُبّاً لها في قسوتها هذه.. وهي كانت: أشد قسوة عليه في حبه الطاغي لها. |
| * يقول لها في فواصل حواراتهما القديمة المتجددة: |
| ـ حين يقسو الحب، يتحول إلى جرح.. وحين ينزف الجرح، تُهدر الأشياء الغالية.. فأكفكف جرحي، أدرأه بحب أعمق حتى لا يواصل نزفه، وحتى تبقى أصداؤك في سرى: صبابة العمر! |
| وها هو - في وحدته وجفائها - يشعر أنه يتعلم بعدها: زيف الحديث، ونزيف المشاعر... تساوت في العين كل الوجوه، وكل العيون، وكل الضمائر! |
| مَنْ الذي تبدّل وتغيَّر حتى في تعامله مع الآخر.. هو، أم هي؟! |
| اتصالاتها بالهاتف صارت قليلة، مختصرة.. نبرة صوتها: افتقد منها الدفء، وفي حواره الذي تبتسره: يحاول أن يجذبها إلى كلماته التي يعبر بها عن حبه لها... لكنها صارت تربط مواعيدها وحتى حوارها ((بالفُرْصة)) لتحادثه.. وقد أبقت على هذا الخيط الرفيع الذي يوصل بينهما! |
| وما زال هذا ((الخيط الرفيع)) الممتد من جانب ((سارة))... لا هي تريد أن يتواصل ((فارس)) بحبه لها، ولا هي ترغب في المبادرة من جانبها نحو هذا العاشق لها لتمنحه صبابة من حبها له.. فأبقته معلقاً بين سمائه وأرضها!! |
| يتذكَّر صوت ((فيروز)) بها، وقد ترنما بأغنياتها معاً زمناً طويلاً... حتى بلغ إعجاب ((سارة)) بفيروز: أنها قلَّدت في يوم ما قَصَّة أو تسريحة شعرها في بدء صباها وصبوتها وولعها بأغاني فيروز. |
| وتبقَّى لـ ((فارس)) في واقعه اليوم: هذا الليل الذي يتجسد فيه صوت فيروز، في معنى كلمات أغنياتها العتيقة: (رحتوا م الليل.. صار الليل: ليلين).. وهذا هو أرق ((فارس)) الذي صار ينادي فيه على كل من ((راحوا مع الليل)): الحبيبة، والقيم، والأهداف، والحب، والأمان... وتبقَّت مشاعر الناس جائعة في زمن طوّحوا فيه بالحنان... لأنهم صاروا ينبشون في فواصل الكلمات الزئبقية.. ولأن رؤوسهم ساخنة جداً، لكنَّ صدورهم أضحت باردة في هذا الشوق الغربالي بخرومه التي تتسع مع استغوال الحياة في الماديات! |
| * * * |
| * يتأمل ((فارس)) الحياة من حوله.. وكيف صار الكثير من الناس: يهرب من نفسه.. كأنه يهرب من الحب والحبيب، ومن المواقف ذات القيمة، ومن المعايير التي ادّعوا تجديدها. |
| يستغرق ((فارس)) في هذا التأمل جوانباً لملامح المجتمع الجديدة، أو للمتغيرات التي حدثت لتكوينات هذا المجتمع، والتعريفات التي أضيفت لفئات أطلق عليها المجتمع: المتدينون.. ممن لهم (أشكال) في اللبس القصير، والوجه، واللحية، ويحصرون الحياة في التجرد من الدنيا والاعتكاف على التقرب للآخرة... والبعض منهم يقوم بتوصيل دعوته هذه بأسلوب يتسم بالقسوة، أو بالفرض بعيداً عن الحوار، وتحريم كل شيء ينتمي إلى الدنيا بلا تفريق! |
| أما الفئة الثانية: فتأتي على النقيض.. تمارس التمرد، وربما تصل بتمردها إلى كسر العُرف، والعبث بالقيم الأساسية، وتذبذب المواقف، وهدم المعايير... وذلك من واقع نظرتها إلى الحياة التي تقوم ركائزها على مضمون بيت شعر الخيام الشهير: |
| ـ ((واغنم من الحاضر لذَّاته فليس في طبع الليالي الأمان))! |
| وتجد هذه الفئة مجالات عديدة لتفريغ ألوان الغوايات، بعد نسف كل قواعد السلوكيات المنضبطة، أو القيم التي تبلور أهدافاً للاستمتاع الهادئ بالحياة ومباهجها. |
| وتبقى الفئة الثالثة المطحونة في الوسط بين الأولى والثانية.. وهي التي: تحلم ويُفسد الآخرون أحلامها، وتكافح لتصعد بضع درجات وكأنها تدور حول نفسها: لا تصل، ولا تتوقف عن الدوران.. وتسب الحياة، وتلعن الأماني.. ويستمر صراخها حتى لحظة خروج الرمق الأخير! |
| وهذه الفئات.. لو تلفتت إلى الحياة حولها، فلن تعثر على ما تسمع عنه أو تقرأه، أو حتى تشاهده عبر التلفاز بمسمى: الحضارة، والمتعة، والأمان.. ولكنها تحملق في المشاهد التي تضخم: الإرهاب، وحوادث دهس الضمير، واغتيال الحب، وطعن الطيبة، وتفشي الأمراض الخطيرة المستعصية، وتزايد السجون في العالم، وظاهرة ((الانتحار))، والتلوث، والمخدرات، وكساد ((دور الإنسان)) في استتباب السلام المزعوم! |
| * * * |
| * في هجعة هذا الليل.. صرخ ((فارس)) وهو يفيق من تأملاته.. كأنه كان مرميّاً على قضبان قطار بطيء صدئ العجلات.. يهرس جسمه، وأفكاره، وخفقاته.. فما أسخف أن يضاجع في هذه اللحظة: ابتسامة بلهاء بكلمة فرح تتسرب وهي لا تقوى على النهوض ولا على البقاء فوق شفتيه. |
| وفي هذا الهجوع... صرخ وراء صرخته رنين الهاتف، فقام متثاقلاً كأنه خارج من جولة مصارعة انهزم فيها بالضربة القاضية.. رفع سماعة الهاتف بإرهاق يحسه في عظامه: |
| ـ آلو... أهلاً بتنقيبي! |
| * ماذا تقصد بتنقيبك؟! |
| ـ أقصد أنك بئر بترولي الوحيد الذي أنقب عنه دائماً، وكلما اكتشفته.. بادرتِ إلى ردم نفسك في داخلي! |
| * هل أنت مريض.. حرارتك مرتفعة؟! |
| ـ نعم.. مريض بالتلفت إلى أصدائك، ولكني أسألك: ألم يحن بعد حديثنا؟! |
| * أيّ حديث تقصد، أو تتطلبه بيننا؟! |
| ـ أريد أن أخترق حاجز صمتك. |
| * لم أعد صامتة... صرت أتكلم كثيراً حتى تضايقت من نفسي. |
| ـ ولكني أريدك أن تسامحيني. |
| * ولكن... على ماذا أسامحك؟! |
| ـ سامحيني على دخولك إلى قلبي... صحيح، أنت لم تعدينني بشيء، ولم تنفِّذي إلاّ قرارات قطيعتك لي في كل مرة.. لم تقولي لي: انتظرني.. يوماً، دهراً، لقد انتظرتك بتفاؤلي وبأملي في عودتك من جديد دائماً... لم تقولي: أريد زمناً وعنواناً منك لنفرح بخصوصيتهما لنا... أنا الذي قلت ذلك كله لك، وطلبته منك. |
| هل تعلمين يا سارة: لماذا لم أفرح بعودتك الجديدة المشروطة؟! |
| أنتِ عوَّدْتِني: أن فرحي لا يتم... دائماً كنت تمنحينني الأمل مغلفاً بالمستحيل! |
| * لماذا أنت دائماً تهاجمني؟! |
| ـ ليس هجوماً عليك.. بل هو الفضح لأحلامي التي فسدت في واقع يحيِّرني معك، فأنت تتقدمين معي خطوة بكلمة دافئة تطلقينها في لحظة رقة مزاجيتك.. وفجأة تتقهقرين بي عشرات الخطوات، لأبقى واقفاً وحدي: أنتظرك من جديد! |
| وهذا المدّ والجزر من موجك، ومن عمق بحرك إلى شاطئي: يكسر أحلامي ويلقي بها وشلاً وأصدافاً فارغة. |
| * ((أوكي))... تصبح على خير! |
| * * * |
| * أعاد سماعة الهاتف إلى موضعها ببرود. |
| كجزء من هذا العالم، وبوحدته وفَقْده.. يشعر أنه: يشيخ ويعتل، وكان في فراغ أيامه الأجوف: لم يتمنَّ غيرها - سارة - تملأه وتنقذه من كذبة العمر... لكنه بهذا المدّ والجزر منها، وبسلبياتها التي تطغى أكثر الأوقات.. تدفعه بعنف ليكون جزءاً بذوب في نفسية هذا العصر، وفي جنون هذا العصر.. والكثير من البشر المعاصرين: لم يعد يعرف ما الذي يريده بالضبط.. هناك مجرد ((غوائل)) تسرق من الإنسان عمقه، وأحلامه، حتى تصل إلى قدراته! |
| لقد أطفأته ((سارة))... وقد جعلها في عمره: الحلم الأجمل، والرواسي التي لا تميد أبداً، والمدى الرائع البعيد الذي يتبلور سماءً لوطن قلبه... حتى دفعته أن يرفع الآن في وجهها لوحة من كلمات قرأها بهذا النص: (سرّحيني من النفي والانكسار)! |
| فما أبعد الأرض التي أبعدَتْه ((سارة)) إليها... وما أقسى هذا الانكسار الذي صار ينغل في وريده: جرحاً! |
| لا يعتقد أنه أضاعها بمعنى: التفريط فيها.. بل هي التي كانت تواصل دفعه بقوة وإصرار بعيداً عنها إلى أقصى بُعْد الأمكنة والمشاعر، وفجأة.... تندفع نحوه - كالشهقة المفاجئة - لتغرقه عاطفة وجنوناً، ثم تتلاشى كألعاب الليل الملوَّنة الفلاشية التي تُحدث دوياً في السماء، وتختفي في الظلمة! |
| ربما أضاعتهما معاً: أشياء من قهر هذا الزمان... ولكنه في قهر الزمان وقهر ((سارة)) لمشاعره نحوها، كان يخرج من ذلك التأمل الجوّانيّ إلى ما يشبه ((الاستفتاء)) لنفسه ولعواطفه. |
| ـ وهمس في أصداء صوتها الليلة: لا بد أن يكون لنا خيار!! |
| ولكن..... كيف وهما يدلجان في أسئلة مستنفرة من واقع حياتهما الاجتماعي والنفسي.. لا تسبح بهما، بل تجرحهما؟! |
| لم يبرد حبه لسارة، إنها تبقى في منطقة ((الحلم)) دائماً في حياته. |
| لكنَّ قلبها حوّله من ذهب إلى نحاس.. رغم أنهما يشكلان بأفكارهما، وبرؤيتهما الفكرية: نضج مسيرة جيل.. صنع من القلق: حُبّاً، وبلور الحب مرآة لنفس تتوق إلى عواطف غير متربة! |
| * * * |
| * في الصباح الفجري، بعد أن مضى ليلته: سُهداً... قفز ((فارس)) فوق قامته، وركض إلى ورق وقلم... كأنه في لحظة مخاض، ميلاد جديد.. أو كأنه في بهاء لحظة موت ترتفع فيها الصلوات مع شروق شمس يوم جديد! |
| لقد تكاملت شجاعته في هذه اللحظة المشبَّعة بامتزاج الميلاد والموت.. امتلك قراره الحاسم، فأمسك بالقلم، وكتب: |
| * يا عمر العمر/ سارة: |
| في هذا الصبح البكر... استيقظَتْ قدرتي، ووجدت كتاباً كنت أحتمي بقراءته البارحة بعد محادثتك الهاتفية، وقد قلبته في نعاسي على الصفحات، واعتسفت النوم حتى حشوت به عينيَّ.. فإذا بعبارة تضج بهذا المعنى (هل تظن أنك أحببت يوماً من يجب أن تحب)؟!! |
| وفي غبش الصباح.. التحمت مع هذه العبارة: صورة من أغنية لمحمد عبده نحبها، وهي: (ما حد يحب اللي يَبي.... أبعتذر)، وكان مكانك في قلبي: عشقاً، وصداقةً، وخفقاً، ودفئاً.. وأنت سري المعلن، ولغة نفسي، ومستقر أمانها. |
| وحتى لا أستطرد في ما حسبت أنه كان يضايقك طوال إعلان عشقي لك... فقد تحزمت صفحة الكتاب الذي كنت أقرأه بعبارة أخرى، سدّدها الكاتب وأغفى بعد أن قال: (هناك من يموت على أمل أن يحظى بعد الموت بمن يشتاق إليه)... فهل تعتقدين: أني سأحظى بك بعد أن أموت؟! |
| لقد وُلد حبي لك شعوراً لا ضد فيه، وكبر عشقاً مولهاً بك.. رائع الرمز. |
| واليوم... حتى هذا السؤال: (من يجب أن تحب) لم يعد يعنيني، فلم أعد ذلك العاشق الغريب الذي تسجنينه، ثم تحصدينه!! |
| ها أنذا - يا معذّبتي الرقيقة - قد تحررتُ منكِ... أخيراً، وإلى الأبد! |
| تحررت... وربما هو: ميلاد جديد لهذا القلب الذي استَعْبَدتِ أزهى سنوات عمره... وربما هو: الموت الذي يحملني إلى برزخ.. ينجو فيه القلب من ساديتك معه!! |
|
انتهت
|
|
|
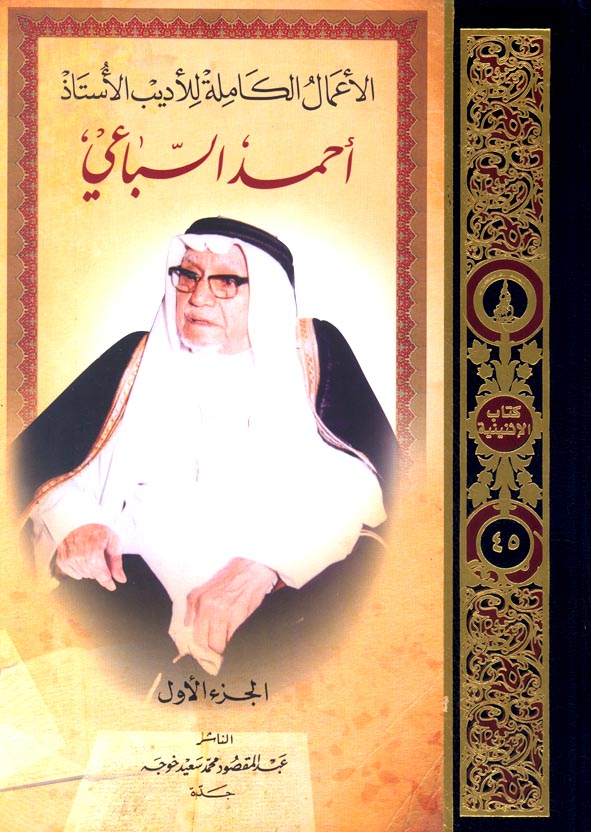
 شارع عبد المقصود خوجة
شارع عبد المقصود خوجة 00966-12-6982222 - تحويلة 250
00966-12-6982222 - تحويلة 250




