|
((العَلْقَةَ)) في ((الفلكة)).. |
| وكما كان كتّاب ((الشيخ العريف محمد بن سالم)) مدرسة لحفظ القرآن الكريم، وتعلُّم مبادىء القراءة والكتابة على اللوح الذي تعلمت بعد بضعة أيام، كيف أحفظ عن ظهر قلب ما يكتبه ((محمد)) وهو مساعد الشيخ ولعله من أقاربه، كما تعلمت، كيف يمُسح بعد الحفظ ثم يُطلي أو يدهن بما يسمّى ((المضَر)) وهو نوع من مكعّبات مستطيلة الشكل من ((الطفلة)) التي تغمس في الماء، ثم يدهن بها سطح اللوح، ويترك دقائق ليجف، ويبدو أبيض ناصعاً يكتب عليه بالقلم ((البوص)) الذي يغمس في ((الدواية)) المعالجة بما يُسمى الليقة التي تشبّع بالحبر الأسود، الذي يتميز بأنه سهل الزوال عن اللوح عند مسحه أو غسله، كما كان الكتّاب كما ذكرت، فقد كان بالنسبة لي مدرسة تعلمت فيها الكثير من التصرفات والسلوكيات التي يجب أن تتم في الخفاء لا يفتضح أمرها، عند الشيخ، الذي يعالجها في غالب الأحيان ((بالفلكة)) والفرش، بالخيزرانة التي لا أدري إن كانت مبلولة بالماء كما قال يحيى، أم جافة.. ولكنها على كل حال من النوع ((الرفيع الممصوص))، التي تظل ((لسْعتُها)) في كف القدم، بحيث تضطر الطفل إلى أن يتعثر في مشيته ربما ليومين. |
| وطاب لي هذا الكتّاب، وتعشقت الحياة فيه إلى حد أني كنت أستعد للذهاب إليه منذ الليل، وبجانبي اللوح الذي كانت تجلس أُمي تلاحق قدرتي على حفظه.. وكان يدهشها ويفرحها أني كنت لا أستغرق وقتاً طويلاً في الحفظ.. ولم يكن السبب في الواقع حدة ذكائي أو قدرتها ـ رحمها الله ـ على إجلاسي أمامها وتحفيظي النصوص المكتوبة في اللوح.. كان السبب هو أنني أسمع نفس النصوص يقرؤها بأصوات عالية الجالسون حولي ومعي ممن نسميهم ((البزورة)) وهم بطبيعة الحال ((زملائي)). |
| أما الأسباب التي جعلتني أستطيب الحياة في الكتّاب، وأتعشقها، فهي أولئك الزملاء الذين تعلمت منهم، كيف يرفعون أصواتهم متظاهرين بالقراءة، عندما يجلجل صوت الشيخ وفي يده الجريدة الخضراء الطويلة ((جدّاً))، بينما هم لا يقرأون، وإنما يرددون بعض الشائع من أغاني الحارة التي آسف على أني قد نسيتها على ما فيها من صور شعبية أغلب الظن أنها قد اندثرت اليوم.. ثم تلك الحيلة التي يلجأ اليها، للخروج من الكتّاب إلى ((الميضة)) وهي ما نسميه الآن ((دورة المياه)).. ما على الزميل الذي يريد أن يخرج ((ليتفسح)) إلاَّ أن يقف رافعاً يمناه مقبوضة الأصابع منفردة الخنصر، بينما يسراه تحت سرَّته، وبحركة تململ تفسيرها أنه ((محصور جدّاًًً)). ولا يجهل الشيخ أنهما حيلة للخروج فقط، فيتركه واقفاً هكذا لحظات، ثم يأذن له بالخروج، فلا يكاد، حتى يقف آخر.. وثالث.. وكلهم بنفس الحركة ((محصورون جدّاً))، ولا يجد الشيخ بداً من الاذن لهم. واتضح لي ـ بعد فترة ـ أن الاثنين أو الثلاثة يتصنعون هذه الحركة باتفاق مسبق. فلا يكادون يخرجون من الباب، حتى ينطلقوا إلى باب الحرم الواسع العريض.. وهناك يجدون الحاجّات التكرونيات. يبعن ((البليلة)) وهي الحمص المغلي الناضج تكيله في فنجان، وكل فنجان بهللتين... ثم الفول السوداني ((المقشور)) الذي كنا نسميه ((لوز العبيد)).. ويبدأ التهام البليلة، واللوز.. ثم ((اللبن الرايب)) في إناء مصنوع من القرع ((المجفف)) تسبح على سطحه اقراص ((الزبد))، تضعها التكرونية للمشتري في شريحة صغيرة من الخبز.. نلتهمها، ونجدها أشهى أكلة. |
| وليس هذا فقط ما كنا نحتال به للخروج.. كانت هناك أعمال تخريبية خطيرة تمارس في الميضة.. وهي تكسير أباريق الوضوء المصنوعة من الفخّار.. والتي كانت تُملأ بمغراف كبير من الحوض الطويل الممتد على الجدار... والغرض هو ادعاء عدم وجود هذه الأباريق للوضوء عند أذان الظهر.. ولا أدري كم من عشرات أباريق الفخار هذه كان يشتريها الكتّاب كل اسبوع. |
| ولم يكن ((العريف محمد)) مساعد الشيخ يجهل أننا نحن الذين نكسر هذه الأباريق، ولكن لا سبيل إلى معرفة الفاعل.. ولذلك فقد كان الحل هو ((الفلكة))، ليس لواحد أو مجموعة بل للجميع بدون استثناء... يحدث هذا يوم الخميس قبل ((الصرفة)).. وكان هذا هو سبيل قدميّ إلى ((الفلكة)) لأول مرة... والشيخ محمد بن سالم هو الذي يتولّى الضرب.. ولم أنسَ حتى اليوم، أنه ما كاد يراني، وهم يقدموني إليه، وقدماي في ((الفلكة)) حتى هتف قائلا: ((حتى أنت؟؟)) وأنه اراد أن يرسخ عملية ((الردع)) فاشتد في الضرب من جهة، وزاد عدد مراته من جهة أُخرى، ثم قبل أن أنهض، لسعني بضربتين أُخريين على كتفي.. صرخت متألماً، وبكيت طويلاً بالطبع.. والمضحك أن الزملاء الأشقياء بجواري، كانوا يكاتمون ضحكات خافتة.. وقال أحدهم: |
| :ـ. من يوم ما دخلت، ونحن نقول: ليه ما يدوق العلقة؟؟ هيّا اليوم دُقتها. ورايح تدوقها كل يوم. |
| لم أجبه بشيء فقد كنت أعاني من اللهب في كفي قدمي، وأمسحهما أو افركهما بيدي دون جدوى وذهبت أفكاري إلى البيت.. إلى أمي، متسائلاً بيني وبين نفسي: ((هل أقول لها أني أكلت علقة أم أخفي عنها؟؟ واذا سألتني: عن سبب العلقة، فماذا أقول لها؟؟ إذ الواقع أني في ذلك اليوم لم أكسر من أباريق الوضوء شيئاً، وان كنت قد فعلتها من قبل.. وجاء وقت الصرفة. فبعد صلاة العصر وحيث نهضت أمشي للصلاة، كنت أتعثر أو أعرج.. كانت الضربات بالغة الشدة من جهة وكانت هي المرة الأولى في حياتي أوضع فيها في ((الفلكة)) وأجلد بالخيزرانة الرفيعة الممصوصة.. وعندما ارتفقت اللوح، والدواية والقلم، واتجهت للذهاب إلى البيت، كان حولي أكثر من زميل بيوتهم في منطقة الساحة..وفي الوقت الذي كنت أتألم، وماتزال عيناي ممتلئتين بالدموع، كانوا هم يتضاحكون ويسخرون مني. ويرددون كلمة استهولتهُا اذ كنت لا أعرف معناها وهي ((خِرِنْتَه)).. وقد عرفت فيما بعد أن معناها ((الولد أو المخلوق المايع الدلوعة)). |
| ولا أدري، كيف خطر لي وأنا أمشي معهم أن لا أذهب إلى البيت.. وأنا أهرب إلى ((البلدان)) وهي ((المزارع التي حدثني عنها ((يحيى)).. ولكن كيف ؟؟ وما هو الطريق إليها. تمنيت لو أني أجد يحيى، فأرافقه إليها. |
| ولكني، بعد أن ظللت أمشي فترة، وأسمع تعليقات الزملاء الساخرة، اكتشفت ما هو أهول وأفظع حتى من ((العلقة والفلكة))... اكتشفت أني أمشي بلاحذاء ولا جورب.. حافياً تماماً.. وتلك هي المخالفة السلوكية التي لابد أن لا تغفرها أُمي بأية حال.. ثم أين الحذاء الآن؟؟ أخذت أعود إلى الكتّاب بخطى سريعة رغم ألم ((الفرش)) في كفيْ قدمي.. فوامصيبتاه.. لقد كان الكتّاب مغلقاً، إذ انصرف كل من فيه.. وسألني البواب الأسود على باب الحرم، بلحيته البيضاء المبعثرة على صفحتي وجهه: |
| :ـ. راجع ليه؟؟ في الكتّاب ما في أحد.. خلاص. |
| :ـ. نسيت ((الكندرة)) والشراب... أنا ماشي حفيان.. ودحّين أُمي.. وضحك العجوز، وهو يقول: |
| :ـ. هادول العفاريت... البزورة الشياطين، هم اللي دسّوها... يا ما دسّوا ((المُدُسْ)) والكنادر.. في الميضة حقّت الكتاب التاني.. |
| :ـ. طيب.. وفي هادي الميضة؟! |
| :ـ. على يسارك.. روح شوف يمكن تلتقيها.. |
| ولكن. لم أجد شيئاً... وحين دخلت البيت في زقاق الطوال، كان أول من لاحظ أني أمشي حافياً هو ـ محمد علي ـ ثم زميله ـ اسماعيل ـ فوقفا وأخذا يتحدثان معاً بالتركية.. ولم أكن أحتاج إلى ذكاء لأفهم أنهما يستهولان الظاهرة... وما ستجره عليّ من مشكلة مع أُمي بل ومع ((عمي)) أيضاً. |
| * * * |
| كما سبق أن قلت.. كان يوم الخميس هو ذلك اليوم المنحوس، الذي عرفت فيه أو ذقت العلقة في ((الفلكة))، ورجعت فيه من المدرسة حافياً متوقعاً العقاب من أُمي، وربما كذلك من زوجها ((عمي)). |
| ولذلك، بعد أن تسللت دون أن تراني أُمي إلى غرفتي، وغسلت رجليّ من أتربه الشارع اضطجعت على السرير، ملقياً اللوح إلى جانبي.. وأخذت أفكر في شيء واحد بدا لي أنه أهم ما ينبغي أن أفكر فيه.. |
| العثور على ((يحيى)).. والهرب معه إلى المزارع.. والعمل على سياقة حمير السواني، فذلك ـ في تقديري ـ أفضل ألف ألف مرة من هذه الكتّاب اللعين.. وأنا أعرف بيت ((يحيى)).. وأستطيع الذهاب إليه في نهاية ((زقاق الحبس)).. ولكن كيف أحتال للخروج من البيت... وحافياً... والوقت يقترب من صلاة المغرب. |
| كان مما سهّل لي تنفيذ فكرة الذهاب إلى بيت يحيى في ((زقاق الحبس))، أن أُمي كانت تستقبل زائرات من ((الهوانم)) التركيات... وأن ((الباجي)) مشغولة باعداد الشاي لهن وربما العشاء أيضاً اذ كن مدعوات لتناوله، كما حدث أكثر من مرة.. فالطريق ممهود أو خال من العقبات.. باستثناء الجنديين في ((الدّكة)) عند باب الزقاق... أمّا عمي فهو لا يعود بحصانه قبل صلاة العشاء. |
| ولم اتردد.. تسللت من غرفتي على رؤوس أصابع قدمي.. إلى أن وصلت الدهليز و ((الدكة))... ويا للغرابة !؟ كانت خالية من الجنديين.. وإن كانت أسلحتهما معلقة في مكان على الجدار، لم أعن بأن أتساءل أين أختفيا أو ذهبا.. أسرعت أفتح الباب، وما كدت حتى انطلقت أسابق الريح من زقاق الطوال إلى ((زقاق الحبس)).. إلى بيت ((يحيى)) المعروف باسم ((بيت العم عبدالنبي)).. |
| وجدت الباب مغلقاً.. طرقته بحجر من الأرض... فأسرع من فتحه لي فاذا به ((حسين)) أو ((سيدي حسين)) كما يسميه ((يحيى)) ربما غاض الدم من وجهي رعباً.. ولكني تجلدت... تلجلجت وأنا أسأل ((سيدي حسين)) عن ((يحيى)).. وقبل أن أسمع اجابة.. رأيت يحيى بلحمه وشحمه قادماً من الداخل وفي يديه ((المِسْرجةَ))، التي توضع لتنير الدهليز في العادة.. ما كاد يراني حتى أسرع إليّ وهو يقول: |
| :ـ. أُمك أرسلتك تبغا شيء من أمي.. من أستيتة ((ملكة))؟؟ |
| :ـ. لا... لا.. ما أحد أرسلني.. أنا اللي جيت أبغاك.. أبغا أقول لك سيء ولا أدري كيف غمزْتُه بعيني.. ووضعت سبابة يدي اليسرى على فمي تنبهاً إلى أن الكلام ((سر)) لا ينبغي أن يسمعه أحد. |
| وكان ((سيدي حسين)) قد ذهب عنا، مكتفياً بأن من طرق الباب، طفل هو صاحب يحيى. |
| واقترب مني يحيى مستفسراً.. فهمست في أُذنه أني أُريد أن نذهب معاً إلى ((البلاد)) ـ المزرعة ـ التي حدثني عنها. |
| فاذا به يحملق عينيه، ويرفع كفَّه الصغير إلى فمه ثم يقول: |
| :ـ. اصحا أحد يسمعنا.. أنا يا عزيز دخلوني كتّاب الشيخ حامد.. كتاب ((القُبّة)) وما عاد أقدر أروح ((البلاد)) ولا أشتغل عند التجار.. وكمان سيدي وجعان كتير.. بيقولوا خلاص يعني رايح يموت.. |
| :ـ. طيب.. كيف اسوّي دحّين.. أنا جيت من البيت بدون ما أحد يدري. |
| :ـ. بدون ما أحد يدري ؟؟ يا ويلك.. يا ويلك. |
| ثم بعد أن رمش بعينيه رمشات سريعة، هي من عادته حين يلتمس فكرة أو مخرجاً قال: |
| :ـ. اسمع.. ما عندك غير تروح لدادتك منكْشة في بيتكم في زقاق القفل. |
| :ـ. يمكن تكون عندنا في زقاق الطوال. |
| :ـ. خلاص عبِّي نفسك للعلقة. |
| ثم حين أحس بخطوات قادمة من الدهليز الطويل أسرع يقول: |
| :ـ. هيّا.. هيّا روح يا عزيز، وخليني في ساعة بركة. |
| وأسرع يغلق الباب خلفي لأجد نفسي في الزقاق، وقد أخذ يظلم إلا من ضوء فانوس البلدية الخافت هناك. |
| * * * |
| وحين كنت أمشي في هذا الزقاق المظلم، لم يكن في ذهني أن أعود إلى البيت. كان كل تفكيري متجهاً إلى الذهاب إلى واحد من هذه ((البلدان)) ـ المزارع)) ـ التي تحدث عنها يحيى.. ولم يكن السبب هو الخوف من ((العلقة)) وانما هو الحياة التي بدت لي جميلة مع الحمير وأحواض البرسيم الخضراء كالزمرد.. والنخلات الطويلة التي نتسلقها، ونأخذ ((النغاري)) الصغيرة من اعشاشها.. ولكن كيف؟؟ لا أعرف حتى اليوم كيف يذهبون اليها.. ثم الوقت ليل.. ولم أكن أخاف الليل. فقد عشت في حلب ليالي بطولها في الظلام، وأنا في حضن أُمي، نرتعد كلما هدرت أصوات قصف المدافع وزخات الرصاص.. ولكن المهم أين الطريق ؟؟. |
| في مشيتي البطيئة تلك، بعد أن أغلق يحيى الباب في وجهي، وعلى امتداد ((زقاق الحبس)) إلى شارع الساحة، لا أدري كيف أخذت ذاكرتي تستعيد تلك الأيام التي قضيتها مع أُمي في حلب بعد موت جدي وقبله كل أقاربي.. كانت أياماً ملؤها الرعب والجوع، ولا آكل إلا خبز الشعير وعصير الرمان الحامض مع الملح. كان غريباً أن أشعر بالحنين إلى تلك الأيام، بكل الليالي المظلمة والبرد الذي يهشم ويقضقض العظام حتى النخاع، وكل ما أتدفأ به هو صدر أُمي وذراعها تضمني بهما وكأنها تحاول أن تستعيدني إلى داخلها.. أحشائها.. ويبرق في ذهني سؤال لم يسبق أن خطر في بالي قط، وهو: ما الذي جعلنا نعود من هناك.. وما دام جدي وأهلي كلهم قد دفنوا هناك فلماذا لم نمت نحن أيضاً معهم... حتى ولو في الشوارع، تلتقطنا عربات نقل الموتى، كما كانت تلتقط الأموات من الأرصفة؟؟ وأقول في نفسي: لماذا عدنا إلى المدينة على ذلك الجمل ((النطّاطي)) من ينبع.. ولحست أُمي تراب الأرض في باب العنبرية.. وعشنا في زقاق القفل.. |
| وكنت قد انتهيت في مشواري عند مدخل زقاق القفل فعلاً.. هناك في نهاية الزقاق بيتنا وأمامه بيت الخالة فاطمة جادة.. وإلى جوارنا بيت ((خاتون الهندية)). مشيت في الزقاق المظلم إلاَّ من بعض الأنوار التي تضييء المجالس.. وعند باب بيت الخالة فاطمة جادة وقفت وتذكرت والعبرات تنذرف من عيني، أنه في هذا البيت تزوجها.. ومن هذا الباب، كان الرجال يخرجون وهو معهم، وكلهم يرددون ((مبارك.. مبارك.. مبارك يا دكتور)).. |
| قبل أن أطرق الباب وقد عزمت أن أبيت عند الخالة فاطمة، وقد تكون عندها ((بدرية)) سمعت خطوات مسرعة تدخل الزقاق. وما هي إلا لحظات حتى رأيت أُمي في ملاءتها السوداء وقد رفعت ((البيشة)) عن وجهها وخلفها الجندي ((اسماعيل)).. وما كادت تراني حتى ارتفع صوتها تقول له بالتركية ما معناه.. هذا هو.. |
| تسمّرت في موقفي.. مدركاً تماماً، أن أول ما ستبادرني به هو ((الكف)) أو الخفقة على صدري أو ظهري... ظللت واقفاً إلى أن وقفت أمامي... فاذا بها تحتضنني وتضمني إلى ذلك الصدر الذي قلّ أن ضمتني إليه بعد زواجها. |
| :ـ. أنت فين يا عزيز؟؟ ليش جيت عند خالتك فاطمة؟؟ قل لي فين كنت من بعدما خرجت من الكتّاب الين دحّين؟؟ |
| التزمت الصمت.. ولكني انتشيت واستروحت تلك الضمة التي أنعمت بها على صدرها.. كانت لصدرها رائحة اعرفها.. ألفْتها طوال السنوات التي لم تفارقني خلالها إلى أن تزوجت. |
| :ـ. سألتني: أنت جيت تشوف خالتك بدرية؟ |
| لم أجب.. لم أنبس بكلمة واحدة... وكان الجندي اسماعيل واقفاً.. فالتفتت إليه وكلمته بالتركية أننا سنعود إلى البيت... وأخذت تكرر ((الحمد لله... الحمد لله)) وكان هو يردد معها ((الهمدو لله)). |
| * * * |
| وعند باب البيت، كان يقف محمد علي و ((الباجي)).. كان بادياً عليهم القلق والارتباك.. وفهمت بعد أن احتوانا الديوان.. أنهم كانوا يخافون أن يعود ((عمي))، ويكتشف ((ضياعي)) بعد خروجي من الكتاب. |
| ولم أخف على أُمي شيئاً من تفاصيل القصة كلها.. من اللحظة التي أكلت فيها ((العلقة وبالفلكة)).. إلى أن وجدتني عند باب الخالة فاطمة جادة.. وبكيت عندما كنت أخبرها عن ضياع ((الكندرة)). |
| التفت إلى ((الباجي)) وانهمكت في حديث بالتركية.. لم أفهم منه إلا القليل الذي بدا لي كأنه سخط على العلقة التي أكلتها بلا سبب... وعلى أولئك ((البزورة)) الذين أخفوا أو سرقوا ((الكندرة)).. |
| * * * |
| وحين اضطجعت على سريري في تلك الغرفة التي أصبحت غرفتي. جاءت أُمي، ومرة أُخرى انحنت عليّ.. وضمتني إلى صدرها. طوقتها بذراعي.. ووجدتني أقول: |
| .ـ. ففَّم... أبغا أنام جنبك الليلة.. |
| أحسست بدموعها تبلل وجهي.. واستغرقت في النوم.. وفي موج الأحلام. |
|
|
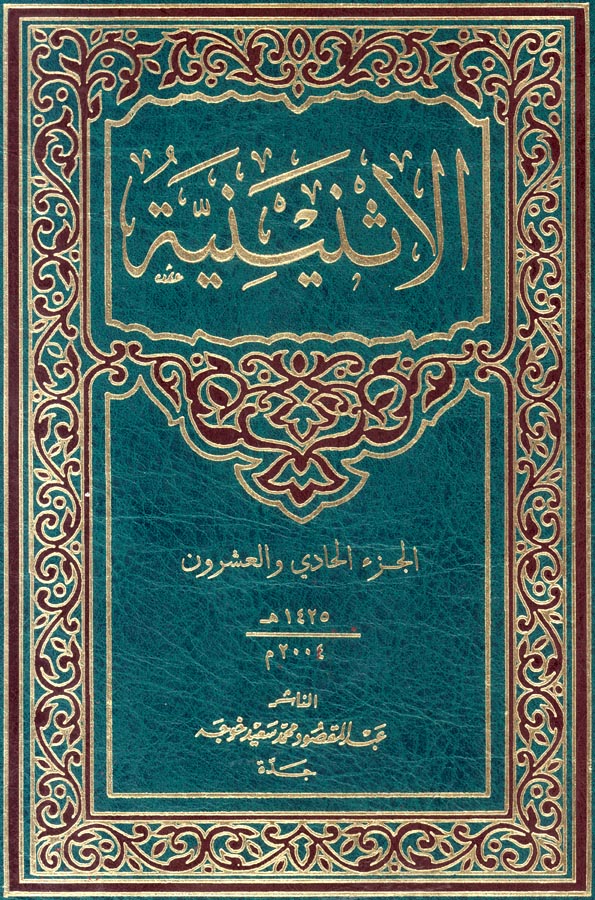
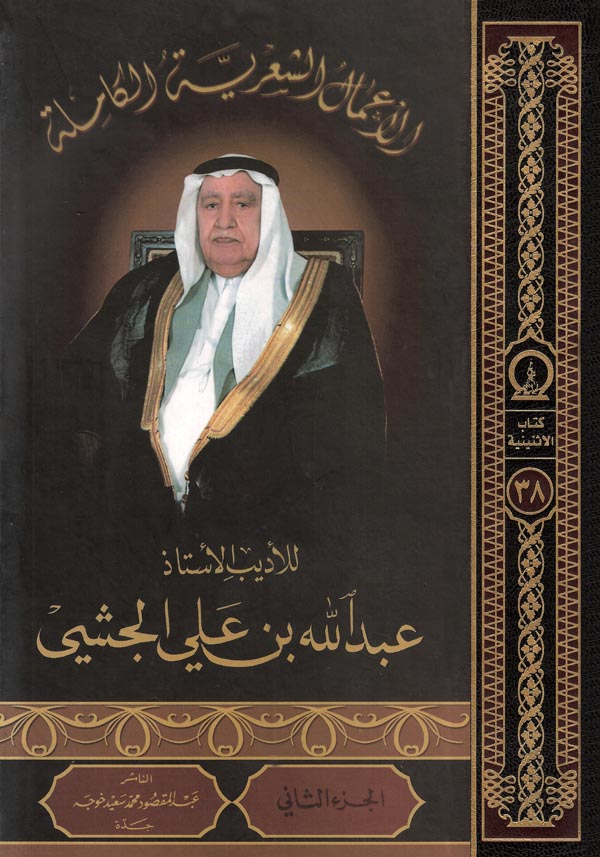
 شارع عبد المقصود خوجة
شارع عبد المقصود خوجة 00966-12-6982222 - تحويلة 250
00966-12-6982222 - تحويلة 250




