| الطيب صالح.. وجارسيا ماركيز.. |
| إذا استطاع الباقي من نشاط الذاكرة أن يحدد الفترة التي أخذ أدب أمريكا اللاتينية من شعر وقصص، يتسلّل إلى وعي واهتمام المثقفين من شباب العالم العربي، وهم الذين تصدّوا ولا يزالون، لعملية تحريك السطوح الراكدة في مسيرة الأدب، بإصرارهم المثابر على تجاوز الاتباعية ومحاولة التخلص من هيمنة القديم، إذ لم يعودوا يطيقون تسلّطه المتعنّت وسلطانه الراسخ، فإنها - أعني هذه الفترة - تعود إلى ما قبل خمسة عشر عاماً تقريباً، وربما تحديداً، إلى ذلك اليوم من عام 1973،الذي لقي فيه الرئيس الشيلي اليساري (سلفادور اللِّيندي) مصرعه في انقلاب قاده طاغية اليوم الرئيس الشيلي (أوجستوبينوشيه)، وبتدبير من الولايات المتحدة الأمريكية دعماً لليمن الذي كان الليندي قد استطاع أن يكتسحه في انتخابات الرياسة عام 1970، ليشكل في شيلي أول جمهورية يسارية. |
| واليسار والأنظمة اليسارية في أي جزء من أمريكا اللاتينية (وتشمل أمريكا الجنوبية والوسطى)، هي الخصم التقليدي، الذي لا تغفل عنه عين الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك ما تعتبره حقها الطبيعي، لأن وجوده - وأعني اليسار - في هذه المنطقة، وبأي حجم أو وزن، لا يعني أقل من خطوة، في طريق زحف شيوعي، يظل متوقعاً، ويظل التحسب له مطلباً استراتيجياً لا سبيل إلى التغافل عنه بأية حال. |
| ولكن إذا كانت حركة اليمين التي قادها (أوجيستو بينو شيه) وقد كان رئيس الأركان في جيش الحكومة التي شكلها (الليندي)، قد انتصرت بمصرع (الليندي) الذي قيل إنه انتحر كما قيل إنّه قتل على يد قوات (بينوشيه)، فإن اليسار قد حقق انتصاراً من نوع آخر، وليس على مستوى اليسار في أميركا اللاتينية فقط، وإنما عن مستوى اليسار في العالم، إذ سرعان ما أصبح (اللِّيندي)، ومصرعه في نضاله ضد البورجوازية والقطاع والطغيان، كما كان (جيفارا) قبله، هاجس اليسار واليساريين، وواحداً من الرموز، شديدة التوهّج، التي ترفعها الشعارات في تحديها المتواصل لليمين.. ولم يكن عالمنا العربي بمعزل عن انتفاضات اليسار وشعاراته ورموزه، لأنّه التجسيد الطبيعي، والتنفيس الميسور للسخط المتفجّر على الأمبريالية بكل تراكمات سوابقها من العدوان المتلاحق على الإنسان العربي في أرضه، وعلى مصيره في حاضره المطحون، ومستقبله الضائع، بداية بالاستعمار بكل تاريخه الأسود، وانتهاء عند جريمته الكبرى التي لا يزال هذا الإنسان مسحولاً دامي الكيان، بمآسيها الدموية.. وهي - كما هو معلوم - (الوجود الإسرائيلي) المضمون أبداً.. على رفات وأشلاء (الوجود الفلسطيني) المرفوض أبداً. |
| ويتاح أن نرى التحول الحاد في اتجاه مسيرة الأدب العربي، وما يكاد يعتبر انتفاضاً يظهر أحياناً، ويتخّفى في غالب الأحيان، إذا واجهنا حقيقة أن المثقف عندنا كان طوال ما يقرب من قرن مبهوراً، بل ومشدوداً إلى إشعاع الثقافة الأوروبية، وعلى الأخص منها الفرنسية والإنجليزية، وكان المظنون - إن لم يكن المفروض - أن لا تحقق ثقافة أخرى، كالأمريكية اللاتينية تواصلاً واسع النطاق مع هذا المثقف، ولكن حركة اليسار ببواعثها وركائز ردود فعلها المتواصلة منذ زرع الاستعمار إسفينه في حياة الإنسان العربي، استطاعت أن تفتح قنوات تواصل حميم بأدب أميركا اللاتينية، بلغ من قوة الدفع فيها أن خلقت عند شرائح من المثقفين العرب، شعوراً سلبياً، إن لم يكن جفوة متنامية، ضد الثقافة الأوروبية، إلا ما كان منها يتدفق من ينابيع اليسار، في مفاهيمه التي قد تتعدد مواقعَ، وتتنوع اتجاهاتٍ ولكنها تظل في النهاية يساراً يواجه تحديات اليمين. |
| وما لا بد أن يستوقف النظر، في ظاهرة اهتمام شرائح من مثقفينا في الساحة العربية كلّها بأدب أمريكا اللاتينية، أن اللغتين الأسبانية أو البرتغالية، وهما اللتان يكتب بهما هذا الأدب، لم تكونا قط من اللغات التي يكثر قراؤها فضلاً عن القادرين على استيعاب أدبها.. ومع ذلك فقد أصبح من المألوف تقريباً أن يستقبل القارئ العربي ما ينقل إلى العربية من الأعمال الأدبية، في الشعر والقصة والرواية عن هاتين اللغتين، لأدباء تتكاثر أسماؤهم كما تتكاثر أسماء الذين يحفظون عدداً من هذه الأسماء.. ومنهم (جارسيا ماركيز)، الذي قد لا أبالغ إذا زعمت أنه قد أصبحت له شعبية في العالم العربي - وعلى الأخص بعد منحه جائزة (نوبل) - تنافس شعبية وشهرة أكابر أدبائنا.. ومع اعترافي بالعجز عن فهم الكثير مما نقل إلى العربية من قصصه، وأستبعد قدرة أبناء جيلي على هذا الفهم، فإن المألوف هذه الأيّام أن لا تخلو صفحة الأدب، أو زاويته في الصحف والمجلات، من كلام يقال إنه ترجمة لقصيدة، أو قصة لواحد من تلك الأسماء التي يكاد يعتبر حفظها وترديدها فيما يكتب مؤشراً لسعة الاطلاع، وغزارة النهل الثقافي من اللغتين الأسبانية والبرتغالية، لأدباء أميركا اللاتينية. وقد يكون مَنْ يُعنى بنقل هذا الشعر، أو القصة من إحدى اللغتين إلى العربية، من الذين أوتوا حظاً من العلم بهما، ثم قد تكون الصفحة الأدبية في الجريدة أو المجلة، أو هو محررها لا يكره أن يبحر في مجاهل بحار أمريكا اللاتينية على هذه الموجة التي كثر الذين يبحرون عليها، ولكن المسألة التي آن فيما يبدو لي أن تعالج، أو أن تطرح كإحدى قضايا التواصل الثقافي أو الفكري بين شبابنا وبين الفكر العالمي، ومنه فكر وأدب أميركا اللاتينية هي: هل بلغ من إفلاس وخواء الفكر العربي المعاصر، بكل ما اختزن، وتعايش، وتعامل من التفاعل مع أحداث المنطقة وهو كثير وحيوي، ولم يفقد بعدُ نبضه القوي بكل معيار، هل بلغ هذا الخواء الحد الذي يجعله يتسوّل مشاعره، وتطلعه وطموح رؤياه، من أدب أميركا اللاتينية؟ حتى هذا الانحياز العاطفي أو فلنسمه الأيديولوجي، إلى اليسار باعتباره المتنفس لمخزون السخط على الأمبريالية والصهيونية والاستعمار.. حتى هذا، أليس الأدب العربي قادراً، على أن يروي ظمأ القارئ فيزوّده بجرعات تطفئ هذا الظمأ إلى منهل الكلمة المعبّرة عن المكنون في نفوس أرهقها الصبر انتظاراً لما كاد يصبح (جودو) فعلاً؟. |
| وقد لا يجانبني الصواب إذا التمست للظاهرة تعليلاً يمكن أن يصل إلى حد الأعذار، وهو تلك الاستمرارية المتعنّتة التي لم يتخلّ عنها اليمين.. وهو يمين لا يزال يتهاون أو يغض النظر عن انفلاق ساحة الصراع، بظهور طغاة، من أمثال (أوجيستو بينوشيه)، الذي تتناقل وكالات الأنباء منذ بضعة أسابيع، أخبار الألوف من أبناء شيلي الذين امتلأت بهم السجون، إلى جانب صنوف من حوادث (القتل) السري.. الذي كان الصحفي (خوزيه كاراسكو تابيا) نموذجاً لأمثاله الكثيرين الذين قتلوا، ولا يدري أحد من الذي يقتلهم، ويلقي بجثثهم في عرض الطريق.. فإن ظهور أمثال هذا الطاغية في أي جزء من العالم، ومحسوباً على اليمين الذي لم يعد يتردد في إعلان دعمه له، وحتى في مواجهة الكونجرس، باستعمال حق الرفض، كما حدث في إجماع النواب والشيوخ، على فرض العقوبات الاقتصادية، على طاغية جنوب إفريقيا.. كل ذلك، يبرر إلى حد، موقف التسوّل من أي أدب، يعبّر عن ذلك المخزون من السخط.. ولكن مع ذلك، فإن موقف التسوّل هذا أصبح يطالب شرائح المثقفين بأن يحاولوا، هم، أن يعبّروا عن مشاعرهم.. أن يكونوا صادقين، مع أنفسهم، ومع قرائهم، ومع قضاياهم الأيديولوجية، فيعطونا، ويطرحوا في الساحة طموحاتهم، ومشاعرهم، وأفكارهم. |
| قد يكون الرد الجاهز، على هذا الرأي، هو: كيف؟ وأين السبيل إلى شيء من ذلك ولا تزال الساحة العربية.. وساحة الفكر منها على الأخص تشهد ظلال بعض رموز اليمين القادر على أن يمارس تصرفات، لها نماذجها، وذكرياتها في الحاضر المشهود، وفي الماضي القريب. |
| وذلك صحيح بكل معيار.. ولكن ما الفرق؟ ما الفرق بين أن نتنفّس عبر أدب أميركا اللاتينية، أو أدب غيرها، وبين أن نستغني عن هذه الوسائل، وأن نجرّب التنفس بأصالة وصدق؟ |
| وبعد.. |
| فإن عنوان هذا المقال، يبدأ بـ (الطيب صالح)، الذي اكتشفت منذ أيام أنّه من القليلين جداً بين أدباء العربية المبحرين في خلجان وأدغال أمريكا اللاتينية، الذين لم يركبوا الموجة.. فقد أعجبني أنه اقتحم الحصار المضروب على الفكر العربي، بصرعة اللهفة على أدب أمريكا اللاتينية، فقال يجيب من طرح عليه مقولة: (إن الرواية الأمريكية اللاتينية بلورت اتجاهات لها بحيث سبقتنا) بقوله: (الحقيقة أننا نظلم أنفسنا، وعندنا حالة غريبة تتمثل في أن البضاعة إذا لم تأتنا من الخارج، لا نحترمها).. ثم يضيف الطيب صالح: (يعني لو أخذنا ماركيز.. فقد عرف (بالصدفة) لأن مترجماً أعجب به وظل يقدِّم أعماله ويصرّ عليه، ثم فجأة يحصل ماركيز على الجائزة.. مع أن في أمريكا اللاتينية من هو أفضل منه).. ويصل الطيب صالح إلى الذروة في رؤية الواقع الأدبي العربي حين يقول: (أرى أن ماركيز لم يصنع أكثر مما صنع محفوظ، إذا أخذنا نجيب محفوظ ككل.. فالإطار الكامل الذي صنعه لمجتمعه ليس هيّناً.. أما كون ماركيز قدَّم أسلوباً جديداً ((لا عقلانياً)) فهو أسلوبنا من القديم في ألف ليلة وليلة.. حتى أنا كتبته في ((عرس الزين))). |
| إننا نتحدث عن الأصالة.. والحداثة ونملأ أنهر الصحف عنهما.. أفليس عجيباً أن لا نجد هذه الأصالة.. ولا الحداثة، إلاّ في أدب أمريكا اللاتينية؟؟ والحقيقة تظل كما قال الطيب صالح: (إننا نظلم أنفسنا).. |
| ويبدو أننا لن نتراجع عن هذا الموقف.. فالتسوّل مرض كما يقول العلماء. |
| * * * |
| رصفائي من الشيوخ عاشوا يحصدون الكثير. وفي أذهانهم - أو هي جماجمهم - صوامع غلال تكدّست فيها أصناف مما حصدوا طول العمر. وهم يعيشون مشكلة شديدة التعقيد.. وهي أنهم لا يكفون عن الحصاد.. ولا يشبعون من التخزين في الصوامع. |
| وعن المخزون في هذه الصوامع دار بيني وبين من رفض أن يذكر اسمه، حوار طريف، لم يخل من شراسة ساخنة، إذ سخر من عملية الحصاد كلّها، ونسف، بكلمة واحدة، كل المخزون في الصوامع، لأنه في رأيه (مهترئ) لم يكن يصلح للتخزين أصلاً، فما فائدته أو جدواه بعد تخزينه هذا الدهر الطويل.. وأضاف في لهجة ضاحكة: يقول: (ولا تنسَ أن الصوامع التي ذكرت أنها قابعة في (ثمار جوز الهند)، ليست من النوع الذي عالجته التكنولوجيا بالتطوير، فقدرتها على الاحتفاظ بقيمة المخزون وأصالته ونضرته، تعتبر منتهية، بطبيعة انتهاء عمرها الافتراضي.. ولذلك، فبدلاً من أن تعرضوها علينا، حاولوا أن تتخلّصوا منها.. وإن كان لا بد من الاحتفاظ بشيء منها، فبما ذكرت من الحوريات والصبايا وروّاد ورائدات الفنون، إذ لا يبعد أن تكونوا قد عايشتم عهوداً حفلت بالكثيرين والكثيرات ممّن لا نكره أن يزاح عنهم ستار الخفاء الذي درجتم على إسداله عملاً بتقاليد (الفروسية). التي لم تكن في الحقيقة إلاّ من نوع فروسية طيّب الذكر (الدون كيشوت)). وأضاف يضرب لهذا المخزون من الحصاد في أذهاننا مثلاً بالعشرات أو المئات - مئات الألوف - من المؤلفات التي تملأ مخازن دور الكتب الكبرى، ويطلع علينا من ينبشون عنها، وعن نسخها الخطية، في هذه الدور، ثم يعكفون على تحقيقها، واصطياد الأخطاء، في هذه النسخة مقارنة بأخرى وثالثة، والمراجعة بين الأصح منها، ثم التقدم بثمرة الجهد الذي يستغرق عمراً طويلاً، لنيل درجة الدكتوراه التي لن ينالها المتقدم لها إلاّ بعد مراجعة المشرف، ثم تلك المناقشة الحامية التي يتصدى لها العلماء الأجلاء.. ويصدر الكتاب، أخيراً، فإذا أخذنا نتصفّحه، في محاولة الاستفادة منه لا نجد إلا نفس المواضيع التي سبق أن عالجها سابق عن سابق عن الأسبق منذ قرون.. وكل الجديد مزيد من الشرح.. أو مزيد من التلخيص، ولا إضافة إلاّ إضافة المحقق، التي لا تزيد على التنبيه أو التنويه بما راجع من النسخ، وما وجد من أخطاء، وما رجّح أنه الأصح.. الخ.. |
| وقال صاحبي: ((الموجود في صوامعكم من الحصاد لا يختلف عن هذا.. وكلّه، باستثناء القليل الذي لا يتجاوز نسبة الواحد في المليون، لا يضيف إلى ثقافتنا شيئاً ذا بال.. بل قد يكون الأصح أن أقول إنّه مضيعة للوقت والجهد.. وقت المحقق، ومعه وقت العلماء الذين يناقشون ثم وقت القارئ إذا وجد من يعنى بالقراءة من شباب المثقفين. |
| ثم تساءل صاحبي، في لهجة ساخرة: ((كم في تقديرك عدد الذين منحتهم الجامعات في العالم العربي درجة الدكتوراه، تقديراً لجهدهم في تحقيق مؤلفات من هذا النوع؟ ثم ما الذي أفادته دوائر الثقافة والعلم، بل ومسيرة العلم والثقافة من تحقيق هذه الكتب))؟ |
| ولا أخفي على القارئ أني قد استصعبت أن أستهين بالمحاور وموضوع الحوار، إذ الكثير مما أرسله على سجيته كان مما يستحق أن يناقش، بل وأن يطول حوله النقاش، وعلى الأخص هذا الذي عالجه عن كتب التراث التي تحقق، ويمنح المحققون عليها درجة الدكتوراه.. لقد وجدتني ألقي نظرة عاجلة على الكتب في أرفف مكتبتي المتواضعة لأجد الكثير من هذه المؤلفات التي يكاد ما تضيفه إلى الموضوع يدخل في باب المكرور المسبوق إلى أمثاله، فتقل أو تنعدم الحاجة إليه. وهنا وجدت نفسي أتساءل بدوري: كيف ينبغي أن يكون موقف الفكر العربي والثقافة العربية، من كتب التراث؟. هل يصح أن نتجاهلها، ونتركها حيث تركها أصحابها مخطوطات في كبريات دور الكتب، باعتبارها مجرّد (آثار)، أم أن واجبنا، كورثة لهذا التراث، أن نكتشف أعماقه ودخائله؟. فإذا اكتشفنا هذه الأعماق والدخائل، فما الذي نستفيده لدعم مسيرتنا الثقافية، ونحن نعايش ظروف عصر يلح علينا أن ننطلق إلى المستقبل فندرك ما ينطوي عليه من مجاهيل تنتظر الحلول. ولا حلول في المكرور الذي تقل أو تنعدم الحاجة إليه. |
| * * * |
| وكان لا بد أن أجد ما أخرج به من دوّامة هذا الحوار، بكل ما جعل يتراكم في الذهن من أفكار، عن الحصاد، وعن التراث، وهما في تقديري قضية شريحة من المثقفين أصبحت تواجه تحدياً يصعب أن تتجاهله أو تتغافل عنه. ولم يطل الانتظار، فقد سطع في الأسبوع واحد من أعظم الأحداث في تاريخنا.. تاريخ هذه الدولة وهذه الأرض.. والإحساس بأهمية وعظمة الحدث قد يكون مسألة نسبية تتفاوت درجته بين الناس، ولكن ما لا يختلف فيه جميع المواطنين على اختلاف نظرتهم، ودرجة تقديرهم، هو أن عاهل هذه المملكة العظيم، فهد بن عبد العزيز قد أضاف إلى مبادراته التي ظلّت تتلاحق، منذ تسنّم سدة الحكم، واستهدف بها كلّها بناء معمار صروح تاريخ حافل بحبه وتفانيه وسهره على مصلحة الوطن والمواطنين وحرصه البالغ على كل ما فيه خير ورفعة وعزة الإسلام والمسلمين.. قد أضاف ما لم يسبقه إليه ملك أو سلطان في تاريخ هذه الأرض، وهو التخلّي عن لقب (صاحب الجلالة) مفضّلاً عليه ومختاراً لقب (خادم الحرمين الشريفين).. وما يصفق له تاريخ الحكم، ويختزنه جوهرة نادرة المثال، هو أن يتم ذلك بمرسوم، أعلنه بنفسه، وبصوته الكريم على جماهير المواطنين، في طول البلاد وعرضها وهو يواجههم، في مجلسه معهم، بمناسبة افتتاح تلفزيون المدينة المنورة. |
| ولقب (خادم الحرمين الشريفين) الذي اختاره الفهد العظيم، وفضَّله على لقب (صاحب الجلالة) وأمر بأن يكون هو المعتمد في كل ما يوجّه إليه، أو عنه، في الخطاب أو الكتابة منذ اللحظة التي أعلن فيه المرسوم الكريم.. هذا اللقب كان مألوفاً متداولاً في الواقع منذ تسنم سدة الحكم، ولكن الفرق كبير جداً بين أن يُتداول اللقب، إضافة إلى لقب (صاحب الجلالة)، وبين أن يستبعد رسمياً لقب (صاحب الجلالة) ليحل محله لقب (خادم الحرمين الشريفين).. إذ في التخلي والاختيار إدراك متعمّق ونظر بعيد لمضمون اللقبين يؤكّدان أن العاهل العظيم فهد بن عبد العزيز، يرى ويشعر بما في (صاحب الجلالة) من تجاوز لمستوى المواطنين من أبناء شعبه، إضافة إلى أن لفظ (الجلالة) نفسه من الألفاظ التي تصرف الذهن إلى ذات الله سبحانه، بينما لقب (خادم الحرمين الشريفين) فيه التواضع وصدق الإحساس بشرف النعمة التي منّ الله بها على الملك العظيم، وهي أن يضطلع بمهام العمل والسهر على ما فيه عزّة العقيدة الإسلامية السمحة، بخدمة أقدس بقعتين من بقاع الأرض هما مهوى أفئدة المسلمين، ومشرق الهداية والهدى، ومأرز الإيمان في فجره الأول، وإلى الأبد في المستقبل الممتد. ومع أن فهد بن عبد العزيز كان دائماً في موقع الأب، والأخ لكل مواطن ولا حصر للمواقف التي تجلّت فيها مشاعر المواطنة بينه وبين أبناء شعبه، فإن هذا القرار الذي يتخذه وهو في أحضان الرحاب الطاهرة في المدينة المنورة يلغي كل حاجز، بل كل بعد بينه وبين المواطنين، وفي ذلك تقنين لقاعدة أن الحكم مواطنة لا سيادة، وخدمة للأمة ومصالحها وأهدافها، وليس سيطرة وتحكماً وتسلّطاً للعنفوان. |
| وبعد، فلقد كانت كثيرة ومتعددة مداخل الفهد العظيم إلى تاريخنا الحديث، وها نحن نشهد هذا المدخل الجديد، يرحّب فيه هذا التاريخ بنموذج فريد للملك الصالح الذي يجد في خدمة الحرمين الشريفين معنى الرفعة والعزة، والشرف الأسمى كأغلى جوهرة يدّخرها التاريخ للعاهل العظيم. |
| * * * |
| ومن حصاد الأيام الذي تختزنه الصوامع، ولم يهترئ بعد، ملف نادي أبها الأدبي الذي اختار النادي له اسماً يشير إلى ما تجمّع فيه من الشعر والنثر حصاداً فيه تشبيه رقيق ولطيف، بما يتجمّع في البيدر من حصاد القمح مثلاً. أتحفني بهذا الملف مع مجموعة طيّبة من إصدارات النادي، رئيسه الأستاذ محمد عبد الله الحميد، حين دعاني لزيارة أبها وإلقاء محاضرة ترك لي اختيار موضوعها.. وهي مناسبة اليوم أن أذكر كَمْ سعدت بزيارة المدينة الجميلة الهادئة الوادعة، وبزيارة النادي الذي أحسست أن ما يبذل فيه من الجهد لإفساح مجال العطاء الأدبي، بل والفني أيضاً، يؤكد أن المنطقة التي تمثل أبها مركزها وحاضرتها الكبرى تستفيد الكثير الذي يبشر بأن الحركة الأدبية والفنّية في المنطقة، إن كانت قد أثمرت القليل الذي رأيته خلال الأيام القليلة التي قضيتها هناك، فلسوف تثمر الأكثر والأفضل، وليس ذلك مما يستبعد، ونحن نعلم أن صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، أمير المنطقة، يعيش هموم الشعر والفن، إذ هو شاعر أتطلع إلى أن أقرأ له شعراً بالفصحى إلى جانب الكثير الذي تتسابق إلى نشره الصحف من شعره النبطي.. ثم هو فنّان تشكيلي، حدّثني ابني ضياء عن أعماله التي قال إنها - من وجهة نظر ضياء - تعتبر في الطليعة من الأعمال الفنّية التي تواجه موجة السيريالية، والتأثيرية، وغيرهما، بصدق فنّي يترفّع عن الاتباعية الحديثة التي تستوعب الكثير من الأعمال الفنية، هذه الأيام. |
| قلت إن من حصاد الأيام، هذه البيادر التي جمعت نماذج من أعمال الشباب، وليس في المنطقة وحدها وإنما في المملكة، استوقفني فيها، هذا العمل أو هذه اللوحة التي تتألق في باطن الغلاف الأول، للفنّان عبد الله الشلتي.. وكونها تستوقفني لا يعني أني أفهمها، ولكنّه يعني أنها تملك القدرة على أن تحملك على التأمل والتفكير من جهة، وتبعث في النفس خدر الارتياح من جهة أخرى. ثم كان إخراج الملف طباعياً.. ورقاً، وحروفاً، وتنسيقاً، وصوراً ترمز إلى الموضوعات التي تضمنّها الملف.. كل ذلك يغري أمثالي من الذين امتلأت في رؤوسهم الصوامع بالحصاد، بأن يقرأ هذه القطعة أو تلك، وهذا الذي يدور في الندوات التي عقدها النادي، ولكن كانت المسألة بالنسبة لي مسألة وقت، لا يزال يضيق، ولا يزال بخيلاً بأن يفسح لي مجال العكوف على ما يتجمّع في مكتبي من أعمال الشباب والشيوخ على السواء. |
| ومع ذلك، فإني لا أنسى ذلك الحوار الساخن جداً الذي دار في الليلة التي قضيناها في منزل الشيخ سعيد أبو ملحة، حول شعر الحداثة، أو حول قصيدة من هذا الشعر أخذ يقرأها عضو النادي، من الملف، ويقف ساخراً محتدماً عند كلمة هنا أو تعبير هناك.. وقد فضلت أن ألتزم الحياد أو الصمت، تحسباً للنتائج التي خشيت أن تفسد الليلة الجميلة التي أعدّها مضيفنا الكريم. وقد تصدى للحملة سكرتير النادي الشاب الأستاذ علي عمر عسيري الذي رأيت كيف تذرّع بالصبر الجميل في مواجهة الصخب الحاد الذي عبّر عن حدّة النفور من الحداثة والحداثيين، أو الثورة عليها وعليهم، ممّا يدل على أن هذه الحداثة قد استطاعت رغم كل ما تواجهه من رفض، وتحدّيات واستهجان، أن تتواجد في الساحة الأدبية، وأن تجمع حولها جيشاً لَجِباً من الأنصار، لا أستبعد أبداً أنّه سيريح الجولة، ومن أسلحته هذا الاحْتدام والتوتّر، بل والسيل المتدفق من التهم، ومنها المروق، والضلال، إذ كلّما ارتفعت حرارة الرفض، ومعها حرارة التوتر، كلّما انفسح المجال لكسب المزيد من المواقع والأنصار. |
| وإن كانت لي وقفة من ملف نادي أبها، وما حفل به من شعر، أغلبه بأقلام الحداثيين فهي مع رئيس النادي الأستاذ محمد عبد الله الحميد الذي ما زلت أذكر الحديث الذي دار بيني وبينه ونحن في سيارته إلى منطقة السودة.. ولا أخفي دهشتي، مع إعجابي البالغ بانفتاح ذهنه وقلبه ومشاعره، ليس للشعر الحديث فقط، وإنما لكل جهد فكري يستهدف التجديد والتطوير، إذ ليس في ذلك كله ما يتناقض مع حرصنا في نفس الوقت وترحيبنا بكل عطاء يلتزم الأصالة بروح منطلقة نحو آفاق العصر، ترتادها، وتحلّق فيها، وتعطينا ما يستطيع أن يتقبله الفكر المعاصر وأن يعايشه ذوق العصر. |
| * * * |
| ومن حصاد الأيام، في أعقاب زيارة خادم الحرمين الشريفين، الملك فهد بن عبد العزيز للمدينة المنورة، هذه الخريطة التي أجدها في مكتبي، من إعداد ونشر المهندس زكي محمد علي فارسي أمام عيني وبين يدي.. وأغوص وراء الخطوط والأرقام، بل والمواقع التي أعرفها بحكم أني من أبناء المدينة المنورة، ولكني بعد كل الذي طرأ من عمران، وانشق من الشوارع والطرق، وضاع من الحواري والأزقة القديمة، ومنها (زقاق القفل) الذي فيه البيت الذي ولدت فيه.. بعد كل هذا الذي يمثل بالنسبة لي فوضى لا أول لها ولا آخر، فإني أطوي الخارطة الجميلة متقنة الصنع والطباعة والألوان، وأقول بيني وبين نفسي: في أي زيارة قادمة أقوم بها إلى البلدة الطاهرة، سوف أعتمد على دليل (من أبناء آدم).. وأعني من أبناء المدينة المنورة أو المقيمين فيها. وسأكتفي بتعليق خريطة المهندس زكي محمد علي فارسي، على أحد حوائط المكتب، أتأملها بين وقت وآخر.. وأستعين بها على استعادة ذكرى أيام الطفولة والشباب التي قضيت الكثير منها، في تلك الربوع، مع نخبة من الأصدقاء والأقران كم يحزنني أن لا أجد اليوم إلاّ أبناءهم وأحفادهم الذين لا ألوم جهلهم بأن هذا الذي يرونه مصلياً في الروضة الشريفة أو واقفاً تحت نخلة في بستان، هو صديق الأب أو الجد فيما مضى من الزمان. |
| * * * |
| وما يحصد لا بد أن يكون مما يصلح، إن لم يكن للحاصد، فلمن يلتمسه، طلباً لنفع.. وهذا إذا كان الحصاد غلالاً أو ثماراً، فإذا كان ((كلاماً))، كهذا الذي نضعه بين أيدي القراء في هذه الصحيفة منذ اليوم، فإن الأرجح، أن يكون نصيبه الكساد، وقد لا يجد من يلتمسه لا طلباً للنفع، ولا حتى رغبة في التقليب. ولا حاجة لشرح الأسباب، فالقارئ هذه الأيام - إن وجد - مشغول بالأهم والأكثر إلحاحاً من مصالحه ومشاكل يومه، ثم هذه الزحمة فيما تقذفه به المطابع صباح مساء، وما يتراكم في الأسواق مما يتسابق إلى استيراده المشتغلون بتجارة المطبوعات، وهو كثير جداً يتعذّر معه حتى الاختيار ويتسابق إليه المشترون ليضعوا على صدورهم، وربما على شفاههم (حُلوة الغلاف). |
| فإذا كان هذا هو الأرجح، فلا بد أن يسألنا سائل، ما الذي يُلزمنا أن نطرح بضاعة لا رواج لها؟.. أليس الأفضل، والأكرم للكاتب، أن يصون ماء وجهه عن النظرة الساخرة، بل العابرة التي تكاد لا تستقر؟ ولا يطول التفكير في الإجابة، إذ نجدها جاهزة تكاد تمارس نوعاً من حركات النشاط الرياضي. وهي أنواع كثيرة إذا كنتُ أجهلها، فلا يوجد بين القراء من لم يمارسها أو لا يزال يمارسها صباح مساء، عملاً بنصائح أطباء القلب من جهة، وحوافز ومؤسسات رعاية الشباب من جهة أخرى.. هذه الإجابة تتلخّص في أن رصفائي من الشيوخ عاشوا يحصدون الكثير وفي أذهانهم أو هي جماجمهم، صوامع غلال تكدّست فيها أصناف من الحصاد.. غلال، وثمار، وبحار، ولآلئ. بل، والأعجب من ذلك أن من هذا الحصاد في الصوامع حوريّات، وصبايا، وروّاد فنون، ورائدات أدب وعلم، وهذا، كما يجب أن أنبّه، إلى جانب الرمال، والحصى والأسماك الميتة، أو التي كان لا بد أن تموت، بعد أن جفّت مياه المحيط التي كانت تموج بها الجماجم، ثم ابتلعها قاع في الأعماق.. ثم هؤلاء الرصفاء يعيشون مشكلة شديدة التعقيد، وهي أنهم لا يكفون عن الحصاد.. ولا يشبعون عن التخزين في الصوامع.. أقصد في هذه الجماجم. التي قد تبدو كثمرة جوز الهند الجافة، ولكن ما بنته الأيام من الصوامع فيها يبلغ من اتساعه أنّه لا يقل بحال عن هذه الخزانات بالغة الضخامة، التي علّلوا لهبوط وانخفاض أسعار النفط بأن القوم من الذين اكتووا بنار الأسعار، وقبلها بنار وقف التصدير في حرب عام 1973،وجدوا أن خير ما يرد الكيد إلى النحر هو أن يشتروا الكميات الهائلة التي تنتجها آبارنا بالسعر الذي أغرانا بالاندفاع في الإنتاج، إلى أن ملأوا خزاناتهم، بل وملأوا مدناً عائمة في البحار، مشحونة بملايين الملايين من الأطنان.. فكان هذا الفائض الذي أتاح لهم أن ينظروا إلى المعروض نفس النظرة الساخرة التي قلنا إنها نصيب بضاعتنا الكاسدة.. وأعني هذا الحصاد. |
| ومع هذه المشكلة - أعني مشكلة الحصاد، والمخزون المتنوع منه في جماجم الشيوخ - لا حل إلاّ (التفريغ) أو هو (العرض)، ولا إكراه في الإقبال على القراءة أو في الأعراض عنها، وهو شأن كل بضاعة مزجاة.. ولكن من حقنا أن نقول إن المخزون من هذا الحصاد، لم يخزن عبثاً.. كانت النظرة إليه أنّه يمكن أن يستفيد منه الأبناء أو الأحفاد، وكانت المشكلة معه أنّه كما قلت، متنوع، لا ندري نحن أنفسنا كيف حصدناه، ولماذا اخترناه. |
| ثم.. قلت.. إننا لا نكف عن الحصاد.. ربما في كل لحظة نفرغ فيها إلى أنفسنا من الليل أو النهار. وهذا يطمئن القارئ - إن وجد - إلى أن الكثير مما يعرض، جديد.. ومنه على سبيل المثال، حصاد الأسبوع الماضي، فهو ثمار، من أعجب الثمار التي أعرف أن القراء التمسوها وهضموها، وقت حصادها. وهي رحلة جلالة الملك فهد بن عبد العزيز إلى المدينة المنوّرة، وتكريسه ربما جلَّ وقته الثمين لمتابعة تنفيذ هذه المشاريع العملاقة في عاصمة الإسلام الأولى التي سجّل التاريخ لجلالته قوله إنه ((يتطلع إلى أن تصبح مدينة خير الخلق وسيد الرسل، سيدة المدائن وأعظمها في ديار الإسلام)). وحصادنا الذي لا بد أن يستغرق وقتاً لتهضمه المعدة الفكرية في الداخل والخارج على السواء، ليس فقط أخبار الرحلة الميمونة وهي الثالثة في تاريخ فهد بن عبد العزيز، منذ اقتعد سدة الحكم، وليس هذا الحجم بالغ الضخامة، لتوسعة المسجد النبوي الشريف، ومع التوسعة القائمة على قدم وساق، الكثير الكثير من المشاريع المرافقة في المسجد، وفي المدينة كلها، بل وفي الطرق والمداخل إليها والمخارج منها، وإنما فيما يفتر عنه ثغر المستقبل مع هذه الوثبة التي يثبها الفهد العظيم، للنهوض بالمدينة، والانطلاق في مسار التطوير.. وثغر المستقبل يفترّ عن التاريخ الكامن في ضمير الغيب المنظور.. إننا نرى اليوم ما تمّ، وما سوف يتم، خلال فترة من الزمن لن تطول بإذن الله، ولكننا نحتاج إلى خيال طموح، لنرى المدينة، بعد أن يتم كل هذا الذي تلمسه أنامل الفهد، اليوم.. لنرى مئات الألوف من حجاج بيت الله الحرام وزوّار المسجد النبوي الشريف، يعودون إلى بلادهم في مختلف أصقاع الأرض وعلى ألسنتهم ذكريات ما شهدوا من تطوير، تحتضنه أجواء القداسة والطهر، ويفوح من جنباته أريج (الحب) و (الإيمان) الذي ضمّخ كل خطوات التطوير، فاض بها قلب هذا الملك العربي، الذي عرف العالم، وسجل التاريخ أنّه يعتزّ ويفخر، ويشمخ على الدنيا وما فيها بأنّه (خادم الحرمين الشريفين). |
| * * * |
| ومن حصاد الأسبوع، هذه الرحلة التي قام بها حضرة صاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن عبد العزيز ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الحرس الوطني إلى كل من سوريا والعراق.. ولقد كان تفسير المعلّقين في صحفنا المحلية، وفي مختلف وسائل وأجهزة الإعلام من الداخل والخارج، أنها رحلة (للتوفيق).. والكلمة في حد ذاتها تضيء مساحة واسعة من الواقع العربي الذي لا يحتاج فعلاً إلى شيء كما أصبح يحتاج إلى هذا التوفيق. ومن المفروغ منه أن ركائز التوفيق موجودة، بل منظمة في عقد، كانت ولا تزال المملكة العربية السعودية تحمله، وتلوّح به، وتدعو إلى الاستفادة من لآلئه الغالية.. لأنها وحدها التي تشع الضوء الذي يمكن أن تخرج به قضايانا كلها من ظلامها الدامس إلى النور.. وليس النور الذي تلتمسه هذه القضايا تصريحات، تبشّر، ثم تندثر، وتلعلع بها أجهزة الإعلام ثم تخرس، ولا يبقى منها في ضمير الجماهير إلاّ المألوف من الحوقلة والحسبلة مع المزيد المتنامي من شحنات اليأس لا تجد متنفسّها إلاّ في سيل اللعنات يتدفق هادراً على (الظروف) ومَنْ (وراء الظروف). |
| التوفيق، أو الرغبة في الوصول إلى هذا التوفيق بين الأشقاء، مطلب عاشته قيادات المملكة في جميع مراحل تاريخها.. وعاشه جلالة الملك فهد بن عبد العزيز، وولي عهده الأمين، طوال الفترة منذ حالة الانشطار أو الانفلاق التي أفرزتها اتفاقيات كامب ديفيد. واستعراض عدد المحاولات التي قام بها سمو ولي العهد، بتوجيه عاهلنا العظيم، يملأ مجلدات لمن يريد الحصر والشرح والتعليق.. والعجيب في جميع مرات هذه المحاولات، أنها كانت مشحونة بالأمل من جهة، وبما يربط بين المملكة، وبين هؤلاء الأشقاء من وشائج الود والثقة يدعمها دائماً وعلى المدى الطويل، كل ما تملكه الدولة من القدرة على العون والوقفة الصامدة التي لم تهتز قط من جهة أخرى.. |
| ومع ذلك.. بل مع كل ذلك، وهو كثير بكل معيار.. يظل هذا التوفيق أو الوفاق، أو الرغبة في التضامن، لغزاً يتستر وراء هذا الذي نسميه (الظروف) ثم مَنْ (وراء الظروف). |
| ولكن إلى متى؟ |
| وبأي منطق يرتضي هذا الطرف أو ذاك، من أطراف الجفوة والجفاء، والتباعد، والانزواء أن تعيش الأمة في الظلام.. في مواجهة تلك الأضواء الساطعة التي يعيشها العدو ويمارس جهاراً نهاراً ما يمارس من تبجح، بالإصرار الوقح على المضي في مخططاته، عدواناً على مخيمات اللاجئين الفلسطينيين، وعلى سكان الجنوب اللبناني، بل على أي بقعة في هذا البلد الذي لم يعد يشعر أبناؤه بعار الواقع وهوانه وخزيه. |
| * * * |
| وأخيراً من حصاد هذا الأسبوع، هذا الذي ينبض به قلم الأستاذ عابد خزندار، عن قضية الإبداع.. وأنا واحد - ربما من قليلين جداً - أدمنت الإعجاب بعابد خزندار منذ سنين.. ورغم ندرة اللقاء بيني وبينه، فإن كل مرة يتاح لي أن أقضي معه ساعة أو بعض ساعة، أعدّها فرصة للفرحة بنوع من المثقفين في بلادي يختلف عن كثيرين غيره من أقرانه سناً على الأقل.. يتجنّب دائماً أنْ يتنفّج، وفي عينيه، حين يصغي إليك، لهفة الراغب في أن يكتشف ما عندك، وليس ليستقلّه، أو يستبعد جدواه، وإنما ليضيف إليه بعض ما عنده وهو كثير، ومفيد لا يسعك إلاَّ أن تتساءل وأنت تسمعه يفضي به في هدوء، كيف أتيح له أن يختزن ما كنت تظن أنه مما لا يعنى به. |
| في مقالاته، عن الإبداع، نقرأ أسماء يسند إليها آراء معيّنة يدعم وجهة نظره أو يناقش الرأي مناقشة أستاذ متمكن.. وهو مع هذه الأسماء ليس من نوع المتحذلقين بذكر أسماء لا يعرفون لغة أصحابها، بل ولا يعرفون الحروف التي تكتب بها هذه الأسماء.. وإنما يذكرها أو يستشهد بأقوالها لأنّه قرأها في لغتها، ووقف عند آرائها في الموضوع الذي يعالجه. |
| قلت له في آخر لقاء عابر، عند ثلوثية الابن محمد سعيد طيّب، إني أقرأ لك هذه المقالات عن الإبداع.. ولكني لا أستطيع أن أربط بينها.. وليس لدي الوقت لأقتطع قصاصة اليوم وأخرى غداً أو في الأسبوع القادم.. ولذلك فإذا قلت إني لم أستوعب شيئاً مما كتبت فإني أصدق مع نفسي ومعك. |
| ولذلك.. فإني أهيب به أن يجمع الكثير مما كتب عن الإبداع، وعن غيره من الكثير الذي سبق أن نشر أو لم ينشر، وأن يصدره في كتاب.. وأعلم سلفاً أن الرواج لمثل هذا النوع من الكتب، وبهذا المستوى الرفيع، قلَّ أن يتحقق.. ولكن فليكن! ذلك مصير محتوم لكل كتاب قيّم في هذه الأيّام، وربما في المقبل من الأيام أيضاً.. والمضحك بعد ذلك أن مما يشرّف الكتاب القيّم أن لا يجد نصيبه من الرواج. |
|
|
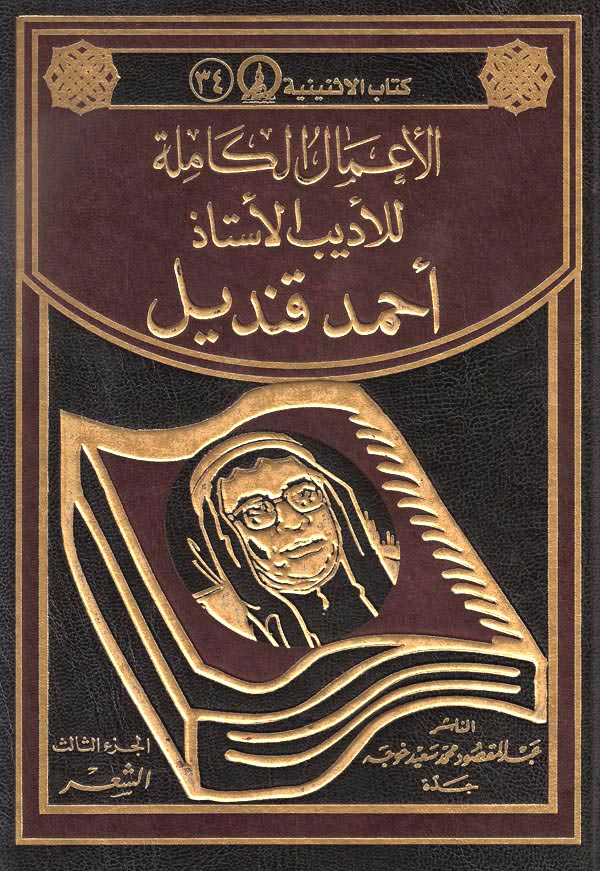
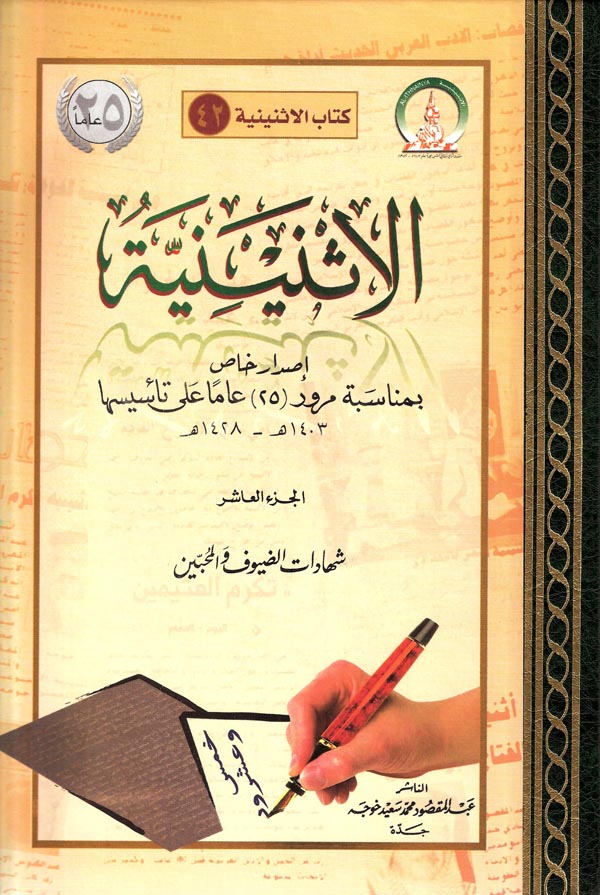
 شارع عبد المقصود خوجة
شارع عبد المقصود خوجة 00966-12-6982222 - تحويلة 250
00966-12-6982222 - تحويلة 250




