| مُشكِلَة تبحثُ عن حلٍ |
| انتهت صلة الشاب بالصحيفة لتتصل بوظيفة حكومية لأول مرة في حياته.. كانت الوظيفة محترمة ذات راتب جيد.. سعت إليه ولم يسع إليها.. وغبطه من حوله لهذا التوفيق المواتي وعدُّوه حظاً سعيداً وكانوا فيما يرون أحق منه بما نال.. |
| أما هو فلم يشعر بما دار حوله من غبطة ولا حرد.. ولم يستشعر في نفسه فرحة غير فرحة النقلة والتجديد.. فهو لا يطيق المداومة على عمل واحد مهما كان ذلك العمل مرموقاً مجدياً.. ويعتقد أنها ركود يقعد بالهمة، ويخمد النشاط ويبدد الحوافز.. ولذلك اغتبط ومَنَّى نفسه بالطرافة والانبعاث والجدوى ولم يبال بما يقول عنه حاسدوه فهو اعرف الناس بدخائلهم وما يُكِنُّون له من شر وبغضاء لا دافع إليها إلا الغيرة والحسد.. وهو –بعد- من طينة غير الطينة التي جبلوا منها.. لا يحمل ضغينة ولا يطيق دبيبها في صدره.. وقد حاول أن يضطغن على أناس كادوا له وهجروه بعداء فلم تقو نفسه على حمل الضغينة ولم يسعه إلا الصفح والغفران.. |
| واتقد الحقد عليه في صدور كثيرة فلم يجد وقوداً من حقد مقابل يجيش بصدره بل وجد طيبة وتجاوزاً أخمدا وأطفآ لهيبه وانقلب في بعض الحالات إلى مودة ووئام.. |
| وهنا يجب أن نقف قليلاً لنشير إلى حادثة خطيرة كان لها أكبر الأثر في حياة هذا الشاب الجياشة بالحوادث المثيرة.. لقد كان يومها في السابعة عشرة من سني حياته.. تموج نفسه الرقيقة بالأخيلة والأحلام، وتتلون أيامه بلون الورود وشذاها الفاغم.. ولولا كآبة كانت تلوح في محياه الوسيم، وحزن دفين يلعج فؤاده وتتراءى ملامح منه على وجهه الكظيم لكان صورة ناطقة للنضارة الجاذبة.. |
| ولقد كانت هذه الوسامة الحزينة أو الحزن الوسيم مبعث إشفاق لداته وقلقهم. وكانوا يزجون إليه اللوم المترفق ليفسح للمرح والاستمتاع مكاناً من نفسه المنطوية المتبتلة كما يفعل الشباب في باكورته فيجيبهم بابتسامة ووعد مكذوب. ويحاول –صادقاً- أن يحرر نفسه من ربقة الكآبة والحزن فما تجديه المحاولة إلا إمعاناً فيما يهرب منه.. كالرمال اللينة كلما حاول السائر خلاصاً منها ازداد غوصاً فيها.. |
| إنه أسير طبعه فلا فكاك من الأسر إلا أن يأذن الله.. |
| ومرت الأيام عصيبة كان يستشري فيها داؤه فيتجرع صامتاً الآلام ويعاني ضروباً من المحن وألواناً من الشقاء يشيب لهولها الوليد فما يزيد على الخلوة والبكاء حتى إذا أراحه الدمع مسح آثاره الواقذة من عينه وقابل الناس بوجه باسم وقلب كليم فما يقص على خلصائه بل ولا على كل من يراه ما يفرى أحشاءه من هم مبرح وألم مكظوم. |
| فأما عامة الناس فما يعنى بعضهم همَّ بعض.. وأما خلصاؤه فكانوا يألمون ولا يملكون إلا الرثاء ومحاولة التسرية وأنهم ليعلمون فشل ما يحاولون.. إن بلوى صاحبهم تجثم داخل أضلاعه وتتغلغل إلى مسارب وجدانه فعليهم أن يتقبلوا صاحبهم كما هو وأن لا يضايقوه فيما يبدو عليه من توجع وأسى إلا إذا أنِسوا منه ميلاً إلى التسرية والمشاركة في النجوى. |
| هكذا كانوا.. ولعل من الحظ السعيد أن تتاح للشاب هذه الصداقات الكريمة التي يبحث عن مثلها الناس فما يوفقون إلا في النادر.. |
| وهم آخر كان يعانيه الشاب فما يجرؤ على البوح به لإنسان.. ذلك هو الكبت الجنسي والحرمان.. فقد نشا في بيت محافظ ما يقارف الإثم ويربأ أفراده بأنفسهم أن يتمرغوا في حمئة المهين.. ويزعهم عن ذلك وازعٌ من دين وخلق وتقاليد.. وفي مثل سنه تصرخ مطالب الجسد وتلح إلحاحاً مقلقاً لا محيد من إجابته.. وإلا تضعضع الجسم والتاث العقل وتزلزلت الحواس والجوارح.. |
| والأغلبية الساحقة من الناس تلبي هذا النداء الطبعي راغمة أو راضية.. أما الأقلية المتمردة التي لا تستجيب لهذا النداء وتستعصي عليه فتظل عرضة للزلازل النفسية والكوارث البدنية حتى ترضخ أو تخرج من الميدان وهي تترنح بجراح تسيل وعقد نفسية نكراء لا يشفيها إلا مثل العزيمة التي تثبت لتلك التجربة المريرة في عنفوانها.. |
| وهذه الأقلية التي يعصمها الله من التردي في مهاوي الرذيلة والارتكاس في حماتها هي التي تجنى -بعد زمن طويل- ثمرة جهادها الدامي فتلتذ بالفضيلة أضعاف التذاذ الآثمين بالإثم.. |
| ولعل هذا الكبت الجنسي قد ضاعف من شقوة الشاب وأساه فقد كان يعانيه صابراً منطوياً على نفسه لا يفضي لمخلوق بما يعاني.. فإذا جن عليه الليل واحتواه الفراش تقلب على أحر من الجمر ثم يهب كالملسوع فيدور في أرجاء غرفته الضيقة وهو يستنشق الهواء كما لو أن رئتيه قد خلتا منه.. ويعمد أحياناً إلى القراءة أو الكتابة يُرَوِّحُ بهما عن نفسه بعض ما يجد حتى ينام بعد إعياء مميت ومكابدة وشقاء.. كان لا بد من عملية تنفيس وإلا انفجر.. |
| ولقى ضالته المبتغاة بعد لأي في "العادة السرية" يلجأ إليها إذا حز به الكبت فتكسر من حدة الشهوة العارمة وتعيد إلى نفسه السكينة والقرار.. ولكنه كان يقارف هذه العادة المنكرة على تخوف واستحياء. يدافع القوة الشهوانية دفاعاً مجيداً فلا يرفع راية التسليم إلا بعد أن يستنفد الدفاع قواه ويصرعه.. وبذلك جانب الإفراط المؤذي وصان أعصابه من التلف وواجه الأزمة ولم يستدبرها.. |
| قال الشاب.. هذه مشكلة اجتماعية قلَّبتها على وجوهها فلم اهتد إلى وجه الصواب فيها لعل "السيكولوجيين" والأطباء أقدر على معالجتها لإنقاذ الشباب المعذب منها.. ولعل عقدة الإشكال فيها راجعة – أكثر ما ترجع إلى اختلاط النفع بالضرر وامتزاج الأوهام بالحقائق فيها.. |
| فحين يكون الشاب في أوج الثورة الجنسية المحقونة. يكون يومئذ في حاجة إلى التعليم واستكمال الأهبة للحياة.. ويكون هو – في الغالب عالة على ذويه في نفقات المعيشة والتعليم، فمن الخطأ تكليفه بالإنفاق على عائلة وهو لو كُلِّف لما استطاع.. |
| فأما الغريزة الجنسية في تلك السن فان جبروتها لا ينكر.. وهو جبروت لا يثبت له اليافعون الذين ما زال عودهم هشاً ينقصف بالالتواء والمصاولة.. فماذا يصنعون؟ لأنهم إن اندفعوا مع أحكام الغريزة القاهرة وقف الدين والأخلاق والتقاليد لهم بالمرصاد.. وإن هم عارضوا فتكت بأعصابهم ومشاعرهم وأبدانهم فتكاً ذريعاً وقد تفضي بهم إلى الجنون.. ولئن همْ بكروا بالزواج – أو بكَّر بهم أهلهم به على الأصح – صرفتهم شواغله وأعباؤه وملاهيه عن الدراسة وألقت على كواهلهم الضاوية بمسئوليات جسام لا قبل لهم بها... |
| ولا بد من دراسة المشكلة المعقدة دراسة مستوفاة وحلِّها بما يحافظ على شبابنا.. عُدَّة المستقبل وأمله المرتجى.. |
| واسترسل الشاب وهو مغمض عينيه نصف إغماضه يقول لصديقه الذي يكشف له من نفسه ما يصونه عن سواه.. وفي هذه الفترة الحرجة من ربيع حياتي الذي يشبه الخريف الذاوي التقيت بـ ص.. كنت أعرفه من قبل، ولعائلتنا تجاور وتجاوب.. ولكني لم أبه له من قبل ولم يسترع بصري وفكري.. ولعل حداثة السن لها أثر كبير في تجاهلنا لبعض.. فقد كنت يوم التقيت به وعصفت بنفسي رؤيته المفاجئة في السابعة عشرة وكان هو في الخامسة عشرة.. فكان لقاء عجيباً.. تبادلنا نظرتين كانتا رسولى قلبين، وشعرت أنه شقيق روحي وشعر هو بنفس الشعور كما قال لي بعدُ حينما اتصل حبلى بحبله واستمر بيننا الوداد.. وافترقنا بعد حديث قصير وقر في أعماق نفسي بنبرات حبيبة لن أنساها ما حييت. |
| كانت البراءة تطبع وجهه بطابع ملائكي فيتراءى لك أن نوراًً يشع من عينيه – المغناطيسيتين ومعارف وجهه الجميل.. وتحسُّ أن نفسه الطهور تطالعك كالكتاب المفتوح فما تخشى من مكنون السرِّية لأنك تقرؤه فما تقرأ إلا ما يُعجب ويسرُّ.. |
| وقلت لنفسي. ويحك يا نفسي هل هذا يوم سعدك وخاتمة أحزانك وفواجعك.. لقد استرحت إلى آلامي فما أبغي بها بديلاً من حبور ومباهج.. ألم أقل من قصيدة طويلة أصف حالي بأني (كالعليل الذي استراح إلى العلة يأبى لألفها أن تزولا) فما بال قلبي اليوم يشتد خفوقه وتدق فيه البشائر مؤذنة بانقشاع الكرب والأحزان؟ |
| أكل هذا من أجل تجدد صداقة وتوقع إخاء؟ |
| وقالت لي نفسي -وهي تكاد ترقص بين الجوانح- هذا يوم نعيمي بعد البؤس المخيم فلا تفسد بكآبتك فرحى وبتشاؤمك تفاؤلي إن فراستي لا تخيب لأنها فراسة الفطرة البصيرة لا العقل المتكلف فاغتنم فرصتي وفرصتك فهي لن تعود إذا لم تبادر إلى اقتناصها واخرُج بنا من مفاوز اليأس إلى رياض الأمل والبسمة. |
| قلت يا نفسي.. أواثقة أنت أنك لا تخدعين بسراب كذوب.. أنك ظامئة إلى المغابط. وهذا الأمل المفاجئ يشبُّ من وقدة الظمأ ويدفع بك إلى العجلة وعدم التمييز، فهل اطمأننت اطمئنان اليقين المتبصر إلى ما أنت قادمة عليه؟ |
| قالت. نعم إنني لمطمئنة واثقة فخذ بيدي من هذا الغيهب المتراكب إلى – السنا المتلألئ فقد كدت أتحطم وأنا أتخبط في مجاهل عمياوات لا أول لها ولا آخر. |
| وهكذا أوقعت في الفخ والتقمت الطعم الشهي الذي كان يترنح في إغراء لا يقاوم.. |
| فهل أصبت أم أخطأت؟ |
| هل سعدت أم شقيت؟ |
| هذا ما سترينيه الأيام. |
|
|
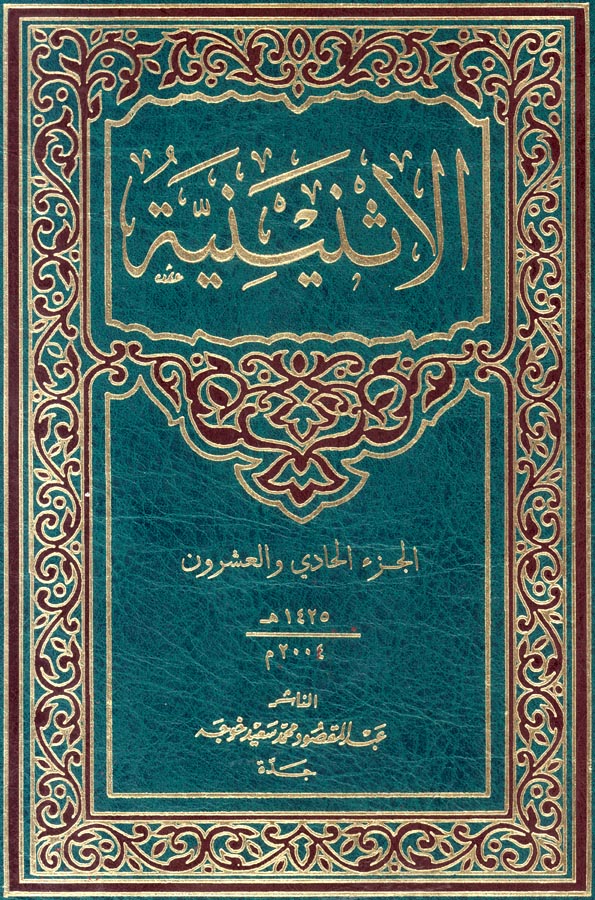
 شارع عبد المقصود خوجة
شارع عبد المقصود خوجة 00966-12-6982222 - تحويلة 250
00966-12-6982222 - تحويلة 250




