| الخوف على الجيل |
| • نحن نخاف على "الجيل الجديد" من كل الأسباب التي أدت إلى اكتساح المجتمعات في الغرب... وهي نفسها: الأسباب التي أخذ الجيل الجديد يترسَّمها، وليس شرطاً أن يكون الترسُّم كربونياً.. ولكنه يرتبط بطبيعة المجتمع الصناعي، والمجتمع الذي أوغل في الماديات... فتغرَّب بعيداً عن الروح، والقيم، والثوابت الاجتماعية الأخلاقية. |
| اليوم... صار الكثير من شباب العالم يصرخ: باحثاً عن نفسه، وعن ركائز الشخصية المنتمية إلى أعراف وقيم مجتمع يقوم على الدين، والروح.. وتحول من جيل مستقل رافض إلى جيل احتجاج ومن احتجاج إلى تمرد، ومن تمرد إلى ضياع، ومن ضياع إلى عنف... فَقَد بهم الشباب ما تبقَّى من المُثل الإنسانية، وتاه عن الطريق الصحيح. |
| العالم - وأكثره صار مادياً - يشبه الآن: بحيرة صمغ... والشباب في هذه البحيرة فقدوا نظرتهم الصافية إلى الحياة.. الانفعال يركبهم، والقلق يسوطهم، والحقيقة المُّرة: تقتلهم! |
| لقد انشلَّت خطواتهم، فباتوا يتخبطون من داخل بحيرة الصمغ.. ينزعون إلى الوصول على حافة البحيرة فلا يقدرون، ويحاولون تذويب الصمغ فيزيدون كثافته ولزوجته بدون دراية منهم.. وأخذت بحيرة الصمغ تطفو على الحفافي وتتسرب إلى أنحاء العالم في الغرب والشرق... وكل شاب وشابة: يرفع عقيرته هذه الأيام مردداً عبارة صالحة للفرجة، هي: (أريد أن أكون أنا)!! |
| والعبارة قديمة تتجدَّد.. كانت قد تبلورت قبل سنوات وصارت الركيزة التي نهضت عليها فكرة فيلم - عمره أكثر من ثلاثين عاماً - قام ببطولته "كيرك دوغلاس، وفاي دوناوي، وايدي أندرسون"، وعنوانه: قلوب في دوامة.. من تأليف وإخراج "الياكازان" الذي قدم قبل ذلك الفيلم أفلاماً تصور زيف هذه الحياة التي يعيشونها هناك... حتى بلغت حدود جيلنا الجديد... وهو فلسفة مستطيلة لسؤال يقول: |
| ـ هل يؤدي اكتشاف الحقيقة إلى الدمار والقتل؟! |
| إن الحقائق لا تتشابه، وليست كلها تحمل الدمار.. لكن الحقيقة - كحياة، وكيقظة - هي ارتكاز (إنساني) لا يتغيَّر: إما أن تدمر، وإما أن تنظف وتنقذ! |
| إن العلاج لعبارة: (أريد أن أكون أنا) بين الشباب.. سيكلفهم كثيراً، وستكون اليقظة على الحقيقة مرعبة وأكبر من الاحتمال.. لكنها - أيضاً - ستفتح درباً لجيل جديد نظيف قادم! |
| والدخول إلى: مادية العصر، أو حقيقة الجيل الذي تلوث بماديات العصر.. نبدؤه بهذه العبارة القائلة: "كل شيء.. تزوّجوه عرفياً"!! |
| أو أن هذا الجيل: يتعامل مع نفسه، ومع الآخرين بسلوكيات ماديات العصر.. حتى باتت العلاقة بين الإنسان وأشيائه: محكومة بالزواج العرفي... الكثير منها في السر، والبعض منها يمارسونه في الوقت الضائع. |
| وهذه العبارة (أعلاه).. من الممكن أن نقولها اليوم كمحصلة لأشياء كثيرة تابعناها بقلق وخوف، و..... عن بعض الناس ممن ركبوا الموجة حتى نهايتها، فاكتشفوا: أن البحر عميق، وأن المسافة إلى الشاطئ الآخر تحتاج إلى زمن طويل من التجديف والسباحة في الطمي! |
| فهل هو عصر: الكراهية، والشقاق.... لا يقف عند حد المفارقة الطبيعية بين اختلاف الأجيال؟! |
| هل من الممكن أن يكره الابن أباه.. والبنت أمها؟! |
| • قال فيلسوف قديم: إن الكراهية لا تتفق مع الحب أبداً.. إنهما ضرَّتان شرستان، وإن الأهداف لا تخضع للأغراض الأنانية، وإن الحواس تتألم من الأفعال البغيضة وترفضها.. وكل شيء من هذا يناقض الآخر إذابته فيه!! |
| • • • |
| • البحث عن التربية: |
| • هنا.. لابد أن نفتش عن (التربية) التي صارت تفتقدها مدارسنا... فالتعليم حين يُصبُّ في عقل الطفل بدون تربية، لا يُنتج شخصاً فعالاً ناضجاً سوياً! |
| ونجد حكاية نستشهد بها عن دور التربية، وقد نستروح بها من ضغط الحوار الجاد: |
| • ذات يوم.. ذات شهر: اكتشفوا طفلاً في أسرة من "القوقاز" لا يحب الحلوى أبداً، وكلما قدموا له حبة حلوى قذفها وصرخ محتداً... وكان هذا التصرف غريباً على طفل من المفروض أن "يتفانى" في حبه للحلوى! |
| ولم يعرفوا ما الذي يريده الطفل بالتحديد، ولكنهم تركوه يمشي وهم خلفه يتبعون خطواته.. لعله يدلُّهم بالإشارة إلى مطلبه! |
| وتجول الطفل في أنحاء البيت، وكان كل عمره لا يزيد على سنة، استطاع في خلالها أن يتقن المشي، وبلغ الطفل منتصف المطبخ وأسرته كلها خلفه، وجال بعينيه ناظراً إلى أشياء كثيرة، وأشار إلى زجاجة مليئة، واقترب منها، تركوه يحاول فتح غطائها، فعجز، ورفع عقيرته بالبكاء، فسارعوا إلى فتح غطائها وقد ارتسمت الدهشة على وجوههم... وتناول الطفل شيئاً من داخلها على شكل إصبع، وابتهجت أساريره، ووضع الزجاجة بين فخذيه الصغيرتين الممتلئتين خوفاً من أن يفقدها، واستمر يتناول مما بداخلها وعلى وجهه إمارات الابتهاج والغبطة! |
| فما الذي كان يملأ الزجاجة؟! |
| كان بداخلها "طرشي" معتق لاذع(!!) وهكذا أبدل الطفل الحلوى بالطرشي... فلماذا؟! |
| البعض يفسِّر هذا التحول: بأنه يرجع إلى نفسية الإنسان اليوم.. ما يقلقها، وما تصطدم به، وما تتوق إليه، والحلوى لا تعبر عن حقيقة ما يشعر به المرء.. إذا كنا نعيش عصر "الطرشي" بالفعل في أشياء كثيرة!! |
| ولكن "الطرشي" حاد لاذع ويثير الشهية.. بينما الحلوى منزلقة وناعمة وحلوة وتقفل الشهية، ومن القديم - حينما كنا أطفالاً - كانوا يعطوننا الحلوى بمقدار لئلا تؤثر على الشهية فتصُدَّ النفس.. ولكنَّ الحلوى الآن أرخص الأشياء الجميلة في أكثر من معنى وصورة ورمز!! |
| وربما فكروا في المستقبل أن يصنعوا بدل الحلوى: "كافياراً" أو سجقاً، أو الجمبري، أو "الرنجة"... على شكل قطع الحلوى المتداولة الآن، وقد فعلوا ذلك في أنواع البسكويت الحاد أو المالح "أبو خَلْ"! |
| وإذا استطاعوا الخلط بين المعاني وبين الماديات، كالخلط بين جمال النفس، أو جمال الشكل، أو جمال الصوت، وبين جمال الأكل، أو جمال الطَّعْم، أو جمال اللبس... فإن ذلك معناه: قدوم الإنسان إلى ظواهر لا يعرفها، وسوف تُغرقه وتغرق معه أنبل الصفات، وأكثر الأشكال وسامة وفتنة، وأكثر المعاني أصالة ونقاء!! |
| ولكن...... ربما كان المعنى الذي رمزت إليه حكاية طفل القوقاز.. هو معنى يشير إلى مادية هذا العصر، وربما يكون المعنى محدوداً وضيقاً في إطار يقول: إن أسرة هذا الطفل من "مدمني" أكل الطرشي، فلا غرابة إذن من كل ما كان(!!) فنحن الذين نعلم الطفل كل عادة، وبعد أن يعي الإنسان ويشبّ عن الطوق، وينتقل من التقليد إلى الاستقلال بما يرغبه.. قد لا يستطيع التخلص مما تعوَّد عليه وهو طفل، فالمادية تبدأ منذ الصغر! |
| وهناك طفل آخر: اكتشف أن الحياة فلوس، فهو كل طفل، وأول ما يتعلم المشي المدرك للخطوة... يطلب مالاً ليشتري حلوى أو ليشتري طرشي! |
| إن مادياتنا لم تعد عادة.. بل أصبحت مطلباً، وإلحاحاً، وأصبح من الصعب علينا الآن أن نفرق بين الماديات والروحانيات... بين المطلب والتمنِّي أو الحلم، لقد تشابكت كلها معاً... وأنت بائس إذا حلمت وغرفتك جرداء أو فراشك خشن... فالأحلام مرتبطة بما كنت تفكر فيه قبل أن تنام! |
| إنه عصر سقط فيه القلب تحت حزام الخصر، وفي هذا "التحت" نحن نحمل الفلوس، ونحمل أيضاً أحلام ما تأتي به الفلوس!! |
| • • • |
| • لكنَّ هناك رأياً آخر.. يقول: |
| ـ ليس شرطاً أن تكون (التربية) في البيت هي التي تُشكِّل سلوكيات وأخلاقيات الشاب، أو هذا الجيل كله.. ففي البيت الواحد نجد أخوين: يختلف كل واحد منهما عن الآخر في سلوكياته، وطباعه، وتوجهاته، وأفكاره.. مع أن تربيتهما واحدة: أب واحد للاثنين، وأم واحدة... غير أن (التأثير) يأتي من البيئة التي يعيش أكثر وقته معها.. يتكلم معها، ويقلِّدها، ويستمع إليها.. وهي بيئة: الصداقة، أو الأصدقاء، أو الزملاء في المدرسة ثم في الجامعة... فهذه البيئة تؤثر أيضاً حتى على ما تزرعه تربية الأسرة في عقل ووجدان الطفل ثم الشاب! |
| وهذه البيئة - أيضاً - هي: الأخطر على سلوكيات، وتوجهات، وأفكار الشاب... بالإضافة إلى الواقع المادي، إذا كان: فقراً مدعقاً، أو كان ممثلاً في تدنِّي الدخل المادي... أو إذا كان: غِنًى فاحشاً يؤدي إلى السفه أو البذخ في الصرف! |
| ومهما حاول "الأب" أن يحرص على اختيار (رفاق) ابنه، أو حتى إلزام الابن برفقتهم... فهذه المحاولات تفشل في الغالب، طالما أن "الأب" مشغول عن متابعة نمو هذه الصداقات! |
| وهناك "أب" قال: إنه منح ابنه كل ثقته في اختيار الرفاق، أو الزملاء، أو الأصدقاء... وأنه كان يمحّض ابنه كل الرضا على حسن اختياره لأصدقائه الذين كانوا يحضرون إلى المنزل، ويسلِّمون على الأب، ويعرف آباءهم وتماسك أسرهم. |
| لكنه اكتشف بعد توسط ابنه مرحلة الجامعة - ربما لشعور الابن أنه أصبح رجلاً - بتخلي الابن عن كل أولئك الأصدقاء/ أولاد الناس كما يسميهم/ والركون إلى شاب واحد، حرص أن لا يخبر عنه أسرته، ولا يُعرِّف والده عليه. |
| وعندما علم الأب بهذا التغير، سأل ابنه: |
| ـ وأين ذهب أصدقاؤك الذين كانوا أقرب إليك من أبيك وأمك وأخوتك.. وكنا - أسرتك - نبارك صداقتكم؟! |
| غمغم الابن ولم يعط سبباً وجيهاً للتفريط في أصدقائه/ أبناء الناس، ورفض في نفس الوقت أن يبتعد عن هذا الشخص الذي صار بالنسبة إليه: أهم من أسرته.. بعد أن صار يقضي عنده في منزله أكثر وقته، والوقت القصير الذي يمضيه في المنزل: يعتزل في غرفته عن أهله.. وصار كثير السهر، ويخرج بعد الظهر ولا يعود إلا مع حلول منتصف الليل! |
| وعندما ثار والده وطلب منه: تعريف صديقه الأوحد.. أصر الابن على التمسك بهذا الرفيق الذي سرق الابن من كل أصدقائه الطيبين، بل ومن أسرته... وقال الابن لأخيه: |
| ـ هذا الرجل (يقصد والده): لماذا يفرض وصاية علينا حتى بعد أن كبرنا وأصبحنا رجالاً؟!! |
| • وقال الأب في قمة عجزه: أتوقع أن يسقط ابني في مصيبة لا أحسبني سأكون قادراً على احتمالها!! |
| • • • |
| • ظاهرة العنف: |
| تبقى نقطة خطيرة جداً... في هذه الظاهرة التي أخذت في الإعلان عن نفسها... وصرنا نقرؤها أخباراً في الصحف، وهي تشير إلى: |
| ـ سلوك العنف لدى بعض هذا الجيل... وقد تمثل في: طعن تلميذ لزميله بالسكين.. وفي: ضرب بعض الطلبة لأستاذ مُعلِّم لهم، ترصَّدوا له في الشارع وأوسعوه ضرباً!! |
| ونحسب أن من أهم أسباب هذه الظاهرة: |
| • أولاً: الفراغ العاطفي والنفسي الذي يشعر به الطالب، في مقابل شحنة جسمية هائلة يكتنزها ولابد أن يفرغها في: مجهود، أو عمل عنيف... بمفاهيم ضيقة ومحدودة، وفي غياب التربية السليمة. |
| • ثانياً: الواقع المادي الذي شغل الأب عن تربية ابنه وملاحظته.. مع تصاعد الاحتياج المادي لدى الشاب كلما كبر به العمر، خاصة مع بدء مرحلة المراهقة لديه وشعوره بأنه يقتحم ميدان الرجولة! |
| • ثالثاً: احتياجه الشديد إلى (القدوة) التي يُعجب بها أولاً، ثم يقلدها ويترسَّم أسلوبها! |
| وكل هذه الأسباب: هامة جداً.. تتطلب دراسات، وإعلاماً ينجح في شد انتباه الشباب إلى التوجيه والترشيد فيه... فنحن نقرأ على شاشة التلفاز - مثلاً - لوحات تدعو الناس إلى: ترشيد استهلاك الكهرباء والماء... وحتى هذه اللوحات لا تبدو مجدية في إقناع الناس لأنها طريقة بدائية في مخاطبة (وعي) الناس... فعلينا أن نفكر في أساليب جذابة ولافتة: نرشّد بها - أولاً - سلوكيات هذا الجيل المتمرد، والرافض إلى درجة الكراهية أحياناً، وإلى درجة العقوق للأب والأم، وإلى درجة التطاول على القيم الأخلاقية... بينما نقف في صفوف المتفرجين ولا نعرف سوى الشكوى!! |
|
|
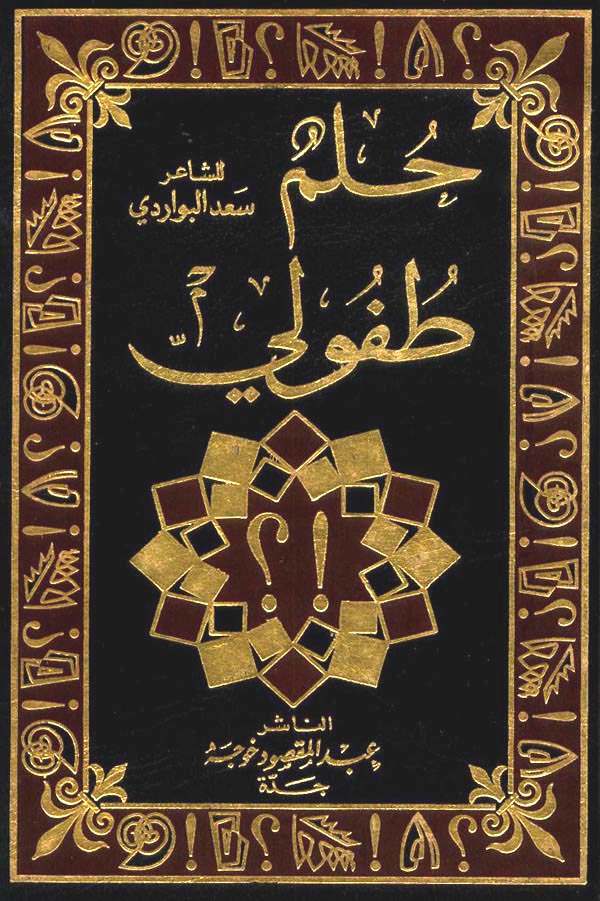
 شارع عبد المقصود خوجة
شارع عبد المقصود خوجة 00966-12-6982222 - تحويلة 250
00966-12-6982222 - تحويلة 250




