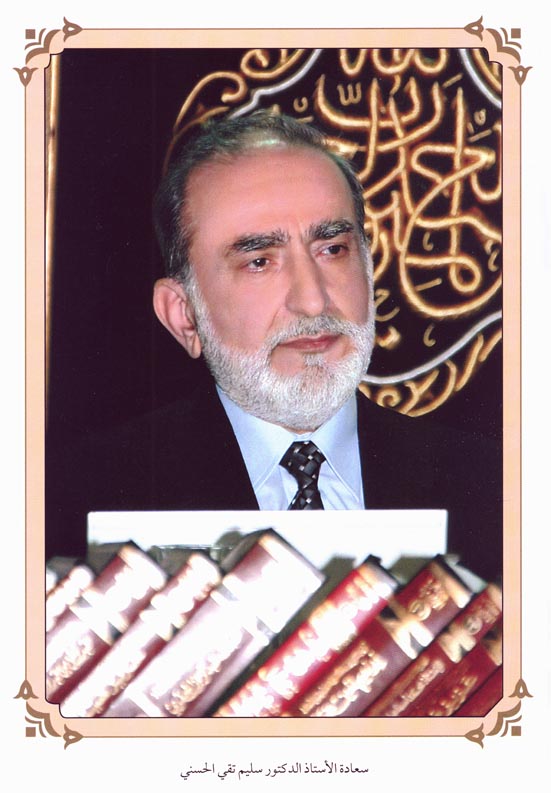| الفصل الرابع: قمة المعاناة |
| هذه الليلة.. لم تكن ((سارة)) تنتظر أحداً.. لا رجلاً.. لا همسة حب.. لا نداء من قريب بعيد، ولا حتى معاكسة هاتفية مما استشرى في سلوكيات مجتمع أهلها الجديد! |
| فقط... كانت تشعر أنها تبحر فوق مياه هادئة الموج.. تُجدّف ببطء، والليل من حولها صامت لا يعيد إليها أصداء تجديفها. |
| ـ تساءلت: هل حقاً عندما تموت قضايا الإنسان.. تموت معها خفقة الحب؟! |
| ولكن... من قال إن قضاياها ماتت، ربما بدأت قضاياها الأكبر! |
| كانت رسالة ((فارس)) تتنقل من يدها اليمنى إلى يدها اليسرى، وتعيد قراءتها، وتشرد بعيداً... إلى فارس، وبعيداً عنه. |
| ـ سألت نفسها: لماذا تذكرته الآن، ولماذا تحرضها رغبة ضوئية لأن تكتب إليه.... وحده؟! |
| ربما لأنها عايشت الهدوء مع نفسها بعد لحظة طلاقها من زوجها الأول. |
| الآن - بعد أكثر من عامين - لم تجد في نفسها ذلك الزلزال الذي (نخعها) من عمقها وأضرم في قلبها: نيران العشق أو جنون الحب. |
| ربما - ثانية - لأنها وهي توشك على وداع الثلاثينات من عمرها.. صارت تكثر أسئلتها وتتفرع دروب خوفها، لأن التجربة في أبعادها ستكون ذات دلالات إنسانية تتوفر فيها القناعات أكثر مما هي عاطفية/ غرامية! |
| لكنّ ((فارس)): طرأ على خاطرها... ومن زمن كان هو قد انتشر في البال وترك فيها بقايا منه حتى الآن. |
| ـ ولكن... كيف ستراني الآن؟! |
| كأنّ ((فارس)) أمامها وهي توجه له هذا السؤال عبر تحديقها في سطور رسالته. |
| ولو رآها: فجأة، صدفة، غفلة... ما هي حركته الأولى؟! |
| هل تراه يتفحصها مستعرضاً جسدها الممشوق الفارع الذي ما زال ميعسباً - كما كان يصفه أمامها دائماً - ويندهش قائلاً بضحكته: |
| ـ كيف تحافظين على رشاقتك؟! |
| هل يسألها مثل كل مرة: أين تسريحة شعرك القديمة... لماذا تقصين شعرك، ألمْ أنْهك عن ذلك؟! |
| ولو رأته هي... بدون صدفة، ولا غفلة، ولا فجأة، لأنها أرادت وسعت إليه... فكيف ستسقط نظرته الأولى عليها، وكيف ستعاملها عيناه بالنظرة الأولى؟! |
| هل ترُشُّ نظراتها بعبق الذكريات وتلك الأيام الخوالي.. يوم بذرا جنون الحب معاً في برودة الأيام فأشعلاها، وركضا ليلاً، وحلَما نهاراً؟! أيام الخوالي. |
| هل تتحسن ((بقايا)) من حبه ذاك، هي التي لم تحافظ على نعمة حبه لها.. أم لا يهمها في هذه اللحظة، بل هي تهتم بما آلت إليه سحنته، ونفسيته؟! |
| ذات يوم - قبل أكثر من عام - سمعَتْ أنه كاد يموت بعد أن تعرض لحادث. |
| ـ همست كأنها تحادثه: يا الله.. إنني لا أكرهك، بل أعبر عن شدة حبي لك.. فلو أنك انتقلت إلى رحمة الله، لأصبحت جزءاً هاماً في ما تبقى من عمري.. لا تبرحني أبداً، وأسترجع أمسياتنا الأجمل والأكثر جنوناً وحلماً وسفراً. |
| يوم علمت بما تعرضت أبدا له.. لم أشعر بذلك القلق الذي أصاب أهلك وأصدقاءك في عصر ندرتهم، ولكني أردت أن أقول لك وتمنيت أن تسمعني: كان من المفروض أن تتعرض لمثل هذا.. فأنت لا تتوقف ولا تتلفت حولك، كأن الحياة لديك: موعد هام، ومحدد، وقصيرجداً! |
| ياه.. إنها ما زالت تذكر: كانت تطلب منه في لحظات امتلائها العاطفي أو الغرامي به.. أن يؤجل موته، لأنها تحبه! |
| تشعلها لحظات معه.. فتتبلور أمامه: صادقة وشفافة وبلورية المشاعر، رغم أنها تعرف رأيه عنها في هذه النقطة بالذات... ومما كان يقوله لها: |
| ـ (أنت لا تحبين رجلاً لذاته أو لصفاته.. بل تحبين ذاتك أنت فيه، بكل ما يتعمَّقك من أنانية ونرجسية فيك). |
| واليوم - بعد قطيعة دامت بينهما أربع سنوات - اكتشفت أنها: لا تكرهه، لكنها أرادت أن تلغيه من ذاكرتها.. أن تقلع غرسته من تربة أيامها.. أن تجعل شجرته تجف في حديقة عمرها وتشيخ وتسقط حتى تموت جذورها. |
| كم هي قاسية في هذا الجانب الذي كان يزعجه من جنونها.. وكان يطلق عليه: قسوة متناهية! |
| لم تعد تريده في حياتها أبداً. |
| إنه لم يحطم حياتها.. هي المسؤولة عن كل ما حدث مما اعتبرته أمها وأخواتها: تحطيم لحياتها حين قررت أن تنهي الرباط الزوجي بعد معاناتها في عشرتها مع زوجها.. من إهمال لها، وغرور، وانشغاله بصفقاته ورحلاته الدائمة والمتلاحقة! |
| حاولت عدة مرات ان تسترد زوجها إلى ما يسمّيه الرومانسيون في العصر الماضي: ((عش الزوجية أو الحب)).. لكنها اكتشفت: أن زوجها ذاك.. كان يقيم عشاً مؤقتاً في كل مكان يسافر إليه، وقد كثرت أعشاشه. |
| كانت أمها تصرخ في وجهها، حينما علمت بدخول ((فارس)) إلى ليالي ولهفة ابنتها: |
| ـ هذه خيانة منك يا سارة... فكيف تطيقين ذلك؟! |
| لذلك كانت تطيل التحديق في وجه ((فارس))، ثم... يرتفع صوتها مقهقهاً، وتمتد إليه يدها متوددة في قمة شراسة أنوثتها معه، وتناديه: |
| ـ تعال إلى صدري.. يا نقطتي السوداء، اللامعة بالضوء جداً! |
| * * * |
| كانت فكرة مجنونة.. لكنها ارتكبتها كجريمة، حبكت خيوطها، وعرفت ماذا سيحل بها، وربما توقعت، ماذا سيلاقيه/ فارس؟! |
| لم تشعر بالخوف عليه حين خطّطت.. لم تفكر في مصيره، وماذا سيحدث له لو افتضحت قصتهما؟! |
| كل ما ركزّت تفكيرها عليه وفيه، كان ينحصر في هذا السؤال: |
| ـ كيف تقتل هذا الرجل/ زوجها، الذي قبرها بالحياة، فتجعله يمشي ويتحرك ويعيش حياته: مقتولاً؟! |
| لا يخطر بالبال أنه الانتقام.. بالعكس، ليست ميّالة إلى الشر كما هي طبيعتها ونفسيتها.. لكنه التمرد ومحاولة كسر الطوق الذي سجنها في إطاره عدة أعوام، أثمرت طفلاً كبر اليوم وفي عيونه ما يرعبها حيناً، وما تتحاشاه أكثر الأحيان. |
| فهل هي سافلة.. أمْ زوجة جريحة بالإهمال من زوجها.. لعقت دماءها التي تنزف، وقامت بعمل أقسى من الاغتيال، أو القتل الجسدي؟!! |
| هكذا تعاملت مع وجود ((فارس)) في حياتها:أحبته وقتاً قصيراً، وسريعاً، ومكثفاً، وعاجلاً... كأنها تخاف أن يموت فجأة، أو أنه لن يعمّر كثيراً.. حتى إذا عرفت خبر الحادثة له.. احتارت لحظتها في تعاملها المتباطئ مع الخبر: هل تبكي، أم تضحك.. هل تصفق لتوقعاتها عنه، أم تزجرها وتكرهها، لأنها تريده أن يعيش ويحيا.. لا تريده أن يموت الآن، رغم ما حدث من فراق بينهما. |
| تريده أن يواصل حياته بإصراره الذي تعرفه فيه. |
| كانت في زمن صفائهما، أو ((غيهما)).. تطلب منه برجاء تُسمِّيه سخرية، أو ترفاً في المشاعر والتعبير، فتقول له: |
| من فضلك.. دع موتك يتأجل قليلاً، حتى أسأم منك، وبعد ذلك لا يهمني إن ودَّعت الحياة، أو بقيت... لكنك ستكون في حكم الميت في مشاعري! |
| الآن... هل يسألها بمبادرته التي تعرفها فيه: ((هل تعتبرينني ميتاً في وجودك، أم حيَّاً))؟! |
| ـ تهمس: لا أدري صدقني... أشعر بك بعيداً جداً جداً، كأنك خارج حدود عالمي، أو كأنني في كوكب آخر لا يتلائم مع كوكبك... لكنني - فجأة - اشتقت إليك، أو إلى الكتابة لك: عني وعنك!! |
| لا تتهمني بأني كبرت، شخت.. لم أزل في شموخ أنوثتي وكبريائها. |
| كنت أطلب منك في الزمن الذي أحبك فيه، برجاء حار: أن لا تموت... وإذا أردت ذلك فيكون بعد أن أكرهك!! |
| ستسألني بالضرورة، أو بتوقّعي لأسئلتك التي خبرت محورها: والآن... هل تكرهينني؟!! |
| هي لا تعرف الكراهية، وأيضاً... لم تعد تعرف قلق الحب، لعلها تقتنص فرص الضحك، والمرح، والانطلاق، والسفر بعيداً بعيداً.. لكن قلبها: وادع، راكد كالبحيرة النائمة! |
| حتى زمان التسلية الذي كانت تقول له عنه: إنها تخافه.. لم يعد هو الزمان المثير، ولا المخيف.. ربما كان هو الزمان التافه، أو الذي يضخم تفاهة ممارساتنا، حتى العاطفية! |
| * * * |
| أمسكت القلم.. وبدأت تكتب له رداً على رسالته: |
| ـ عزيزي فارس: |
| ما معنى التسلية الآن؟! |
| أنت... هل عندك نَفْس؟! |
| لحظة من فضلك... لا تظن أنني محبطة. |
| لكنّ أسئلتي تراكمت، وفاضت... ولقد تركت الأسئلة بدون أجوبة، وحتى بدون حرص على إيجاد أجوبتها... لماذا؟! |
| ألسنا نعيش، ونمشي، ونتكلم، ونسهر، ونمرح؟! |
| إذن... لماذا نُقيِّد الحياة بمثل هذه الأسئلة التي صرنا نجرجرها خلفنا كالأصفاد والسلاسل؟ |
| ذهبت إلى البلد التي تكرهها أنت/ في أقصى الأرض. |
| طرأْتَ أنت على خاطري هنا - في بداية مساء، وأنا أشاهد لقطة من برنامج في التلفاز - فقلت: ترى.. لماذا أنت تكره هذا البلد/ القارة؟! |
| ألا زلت متمسكاً بالمبادئ والقيم والمثل، والمواقف، والوطنية؟! |
| ياه... هل تذكر يوم قرأت عليك أبياتاً من قصيدة، سميتها أنت (تقدمية) قبل أكثر من عشرين عاماً، فقلت لي: |
| ـ لو كنت أمامي لأخذتك في أحضاني.. لكنّ الهاتف يعيقني، مثلما الخوف يعيق الكثير عن كلمة الحق، والحقيقة! |
| هل ما زلت مجنوناً بالمبادئ يا صغيري الشايب؟! |
| أحاول أن أبلور كلمة ((أحبها)) منك لي.. وكنت تقولها دائماً في سمعي وأمامي... (في الفاضي والمليان).. وكانت تسعدني، أشعر بصدقك فيها، وأتردد أن أقولها لك الآن بنفس نبرة صوتك، ودفء الكلمة: |
| ـ وحشتني؟! |
| صحيح... هل وحشتني حقاً؟! |
| مضى وقت طويل لم نلتقِ فيه، بل... لم يُصادفني وجهك في أي مكان، فهل تغير وجهك منذ أن عرفته؟! |
| كم أتمنى أن أراك الآن أمامي، فقط... لأرضي فضولي لا أكثر! |
| أضحك... ستقول عني: ما زلت كما أنا.. لم أتغير، كلماتي اللاذعة، وتعليقاتي الاستفزازية، و.... قلبي الأبيض!! |
| حقاً... أنت الوحيد الذي تعرفني جيداً من داخلي، وكثيراً ما خفت من تحليلاتك، واستنباطاتك عن خطواتي، ولكن هذه الميزة عندك، تدل على حميميَّتي فيك، وحميميتك في نفسي، وتمازُج روحينا. |
| تصور... حتى السخرية افتقدتها في تعليقاتي، ربما لأنه لم يعد لها طعم. |
| صديقاتي: صرن يتَّهمنني بالشرود، وبالبرود. |
| قلت لواحدة من اللواتي يحرصن على تسقّط أخباري ذات يوم: |
| إنني أحب رجلاً رائعاً جداً، وتعتبرينه من عامة الناس، وسأتزوجه يوماً ما. |
| نظرت إلى ملامح وجهها، فوجدتها تغيرت.. كل ألوان الطيف انتشرت على قسمات ذلك الوجه: غيرة، أو حقداً... وقد عرفت أنها أمضت أكثر من عام وهي تحاول إقناع أهلها بالموافقة على اقترانها بشاب يصغرها كثيراً، ومن عائلة أقل بكثير من مستوى عائلتها الاجتماعي والمالي... دون أن تفلح! |
| حتى عندما تزوج ذلك الشاب بامرأة أخرى في سنه.. استمرت في حلمها تنتظر أن يعود إليها! |
| ضحكت سخرية من الحياة، لا من صديقتي... وتذكَّرت أننا حلمنا معاً - أنت وأنا - ذات ليلة، ربما أسميها (يتيمة)، لأنها ما تكررت في روعتها.. قلت لي فيها: |
| ـ حلمي أن يضمنا بيت واحد!! |
| وسرحتُ مع حلمك، وطاردني صوتك حتى استرجعني... فقلت لك: |
| ـ أنت رجل مجتمع، مجالاتك متسعة في الركض، لكنّ الفوارق الاجتماعية ما زالت تقهر التغيير، ومثل القرن العشرين! |
| كنت شغوفة جداً بأعمال البر... أزور الجمعيات الخيرية في بلدنا، وأفتش عن الأسر المحتاجة والفقيرة في مجتمعنا، خاصة تلك التي لا تسأل الناس إلحافاً.. لأساعدها في حدود طاقتي. |
| مرة بكيت أمام سيدة في الخمسين، كانت تقف أمامي وتشرح لي حكايتها مع أطفالها وزوجها المريض الذي يفتش عن عمل من حوالي نصف عام، ولا مورد لديهم! |
| كانت يدي - بعفوية - تدخل إلى الحقيبة المعلقة على كتفي، وتخرج دفتر شيكاتي، فأنا لا أحمل نقداً كما تعلم عني، ثم... ما لبثت أن تنبهت: هذه المرأة لا تعرف طريق أي بنك... فما بالي ببوابة البنك، وطريقة صرف الشيك؟! |
| - قلت لها: عودي إليَّ غداً في هذا الموعد وأنا أنتظر أمام بوابة هذه الجمعية في سيارة... وعادت وفرحت بل طفرت من عينيَّ وأنا أسمع صوتها يلاحقني بدعواتها من خلال بكائها أو صوتها المخضّل بالدموع. |
| هل رأيت؟!... لقد فررت في اليوم التالي من البلد كلها؟! |
| قد تتهمني بنعوت عديدة، لا بأس... طرت إلى أوروبا لأنسى منظر تلك المرأة! |
| رد فعل عكسي، أو... جبان! |
| أو... مجتمعنا صار يعاني اليوم من الإنفصام في الشخصية!! |
| لا عليك... فالناس يموتون بأتفه الأسباب، بحوادث السيارات التي صارت جنوناً.. بأسباب ليس من بينها: الفقر، وانظر حولك!!!... وهم يموتون الآن بالجوع، أو بالتجويع العالمي المتحد (!!) والجوع ليس سببه: شح الطبيعة |
| بل شح الرحمة من القلوب، وتفشِّي الطغاة في العالم.. حتى صرنا نسمع وصفهم بالمصلحين!! |
| حتى الطغاة يا حبيب الأمس - يتحدثون اليوم عن: الحرية، والديمقراطية، والعدل، والحق!! |
| أرأيت... لا مفر من الجنون أبداً!! |
| أشتاق أن أقول في هذه اللحظة: أحبك (!!) ليس لأنني أحبك بالفعل بل لأنني ظمأى للحب بذاته! |
| مرة قلت لي أيضاً في قراءتك النفسية لذاتي: أنت لا تحبين رجلاً لذاته بل للحب فقط!! |
| بعدك.. عرفت من هو أصغر منك سناً، بل حاولت أن أغازل (طليقي) في سري، لأقتنع به، وأسمح له أن يعيدني.... ففشلت. |
| هل رأيت ترفاً أكثر قهراً، وضنكاً، وضغطا ًعصبياً من ترفنا الذي نعيشه كل يوم في هذا العصر التجليطي: عصر تفشي الكذابين، والمنافقين، والمدلِّسين؟!! |
| دعك من اشتياقي، أو من رغبتي الآنية في التصريح بكلمة: أحبك.. لك وحدك! أرغب أن أحكي لك.. أن أبوح - كما هي عبارتك دائماً - أن أفضفض.. فأنت الوحيد الذي استحوذت على هذا الحق (فيني) من سنوات طويلة. |
| غيرك.. لا أقدر أن أمنحه هذه الخصوصية ورغم ذلك فأنا لا أجدك أمامي الآن.. وهذه مشكلتي معك منذ أول يوم عرفتك فيه، فأنت مرتهن بمناخ اجتماعي... وصرتُ مثلك بعد ذلك، ولكننا نحتاج إلى بعضنا البعض في لحظات هامة، فلا يجد أحدنا الآخر! |
| كم هي قاسية هذه البروتوكولات؟! |
| لا تضحك... من يقرأ كلمتي هذه - البروتوكولات - سيتهمني بخروجي عن العادات والتقاليد العربية وربما يرميني بالإباحية في عصر الإرهاب حتى ضد الفكر والرأي.. وهي التهمة السهلة في عصر الإتهامات السائلة والمسددة برصاصة! |
| حقاً أريد أن أحب!! |
| أن يُسمعني "رجل": كلمة حب من بين أضلعه تخرج، وليست من لسانه، أو حنجرته! |
| فهل بلغت كلمتي/ النداء - أحبك - حشاشتك، وعمق روحك؟! |
| منذ متى لم تسمعها؟! |
| لعلك - كرجل - تسوّقها، كلما التقيت بأنثى حلوة! |
| نعم.. أعرف أن هذه هي التهمة الدائمة، الثابتة التي تحاول كل امرأة أن تلصقها بجميع الرجال (!!) ولكن... قل لي: ألا تفعلون ذلك أيها الرجال/ السادة؟! |
| آهٍ... كم أتوق الآن لسؤال منك، كنت تردده بين الفينة والأخرى على مسامعي، فتقول: ما أخبار ((مزاجيتك))؟! |
| صدّقني... أنت كنت على حق، لقد أتعبتني مزاجيتي كثيراً، خاصة بعد اختفائي من حياتك، وإصراري على مقاطعتك للأبد، بل على قطعك من ذاكرتي، ومشاعري! |
| لكن... نعم ((حيل الله أقوى))...وقد كان من كان، حتى لم يعد عندي مزاج لإنعاش مزاجيتي! |
| إنها فكرة مجنونة أن أكتب إليك الآن... لقد أفرغت هذه الشحنة التي كادت تهوي بي إلى قاع النفس، وربما ترميني في الإكتئاب. |
| لا أريد منك رداً... بل أنت لا تستطيع أن ترد، لأنني قصدت أن لا أكتب لك عنواني اليوم ولعلك ستقرأ الرسالة على أجزاء، أو ترمي بها على سطح مكتبك عدة أيام، ليس خوفاً من نفخ رماد نيران حبك القديم لي... بل لأننا - أنت وأنا - قد تغيرنا كثيراً كثيراً، وكأننا قد جئنا إلى عصر لا نعرفه، أو من كوكب آخر! |
| وأنا.. إن لم تكن كارثة الطلاق في بدئها، وراحة الطلاق في تمدده بعد ذلك.. قد نالا من عمق نفسيتي ورؤيتي للحياة والأحياء.. فإنني لست أكثر من إمرأة صارت تروق لها الفرجة، والإسترخاء البليد. |
| أرجوك.. عدني أن لا تفكر في كلمة واحدة من كلمات هذه الرسالة بعد أن تطويها... حتى التفكير لوّثه العصر الجديد!! |
| * * * |
|
|
 شارع عبد المقصود خوجة
شارع عبد المقصود خوجة 00966-12-6982222 - تحويلة 250
00966-12-6982222 - تحويلة 250