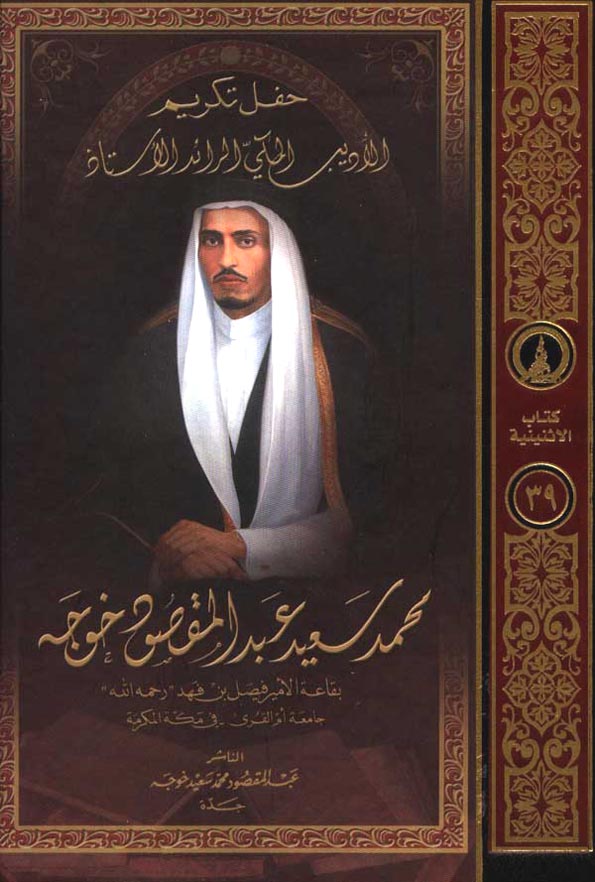| نظرية الشعر عند العقاد |
| خلف العقاد فيما خلف من نتاج موهبته الشعرية تراثا حافلا طبع منه عشرة دواوين
(1)
.. ويختلف شعره في هذه الدواوين العشرة بين القصائد الطوال والقصائد المتوسطة والمقطعات القصيرة التي ضمنها بعض خواطره وأفكاره وثمرات تأمله في الحياة والأحياء، ويتفاوت عدد الأبيات في هذه المقطعات حتى يهبط إلى بيتين يركز فيهما الشاعر معانيه، ويصلحان أن يكونا حكمة أو مثلا سائراً.. |
| ولا يعنينا هذا بقدر ما يعنينا أن هذا الشعر في جملته يصور المذهب الشعري للعقاد، أو هـو التطبيق العملي لاتجاهه في تأليف الشعر، وهو اتجاه جديد، أو اتجاه خاص به من حيث المعاني والمضمونات، ومن حيث الأخيلة والصور، بل ومن حيث الموضوعات التي يعرض لها، وكلها تعبير عن ذات الشاعر، وما يحوك في صدره من المشاعر والعواطف والانفعالات. ولا يصل هذا الشعر بالشعر العربي المعروف إلا الأداء الشعري الذي يتمثل في اللغة العربية الممتازة في ألفاظها وتراكيبها، والمناسبة للذوق الأدبي أو لذوق العصر، وفي النسق الموسيقي الذي قامت عليه أعاريضه وأوزانه. |
| وفي هذا الشعر - كما يقول المازني - ما في الحياة والطبيعة، وليس كل ما في الحياة معجباً موفقاً، ولا كل ما في الطبيعة أزهار ورياحين، فثم إلى جانبها الشوك والجبال الجرداء، والبراكين الفائرة الثائرة بالخراب والدمار والنقمة.. |
| ثم يقول المازني إن شعر العقاد صورة من حياته تمثل أطوار نفسه، وحالاتها، وتنقل خوالجها.. |
| ويصف العقاد شعره في أبيات صدر بها ديوانه الأول "يقظة الصباح" بأنه "بحر بلا انتهاء" وأنه جمع المتناقضات، ففيه حكمة الحكماء، وغباوة الأغبياء، وفيه الحب والبغضاء، وفيه اليأس والأمل، وفيه السكون والضوضاء، وكلها كما يقول صورة حياته التي يريد أن يطلع عليها الناس، فليقلها هؤلاء الناس بما يشاءون من رضا وقبول، أو إعراض ورفض، فإنها كتابه، أو صفحة حياته: |
| هذا كتابي في يد القرّاءِ |
| ينزلُ في بحرٍ بلا انتهاءِ |
| فيه من الحكمة والغباءِ |
| وفيه مـن يـأسٍ ومن رجاءِ |
| وفيه من حبٍّ ومن بغضاءِ |
| وفيه من صَمْتٍ ومن ضوضاءِ |
| صورةُ مَحْياي لعين الرائي |
| فلْيلْقِ بين القدْح والثناءِ |
| ما شاءَت الدنيـا مـن الجـزاءِ |
|
| وليس من همنا في هذه السطور تقويم شعر العقاد أو دراسته، ولكن الذي يعنينا هنا محاولة الوقوف على معالم شخصيته النقدية، وإنما عرضنا لشعره هذا العرض في هذه الكلمات لسببين: |
| أولهما أن شعر العقاد كان، كما قلنا يمثل مذهبه في تأليف الشعر، أي أنه كان مبينا على الأسس النقدية التي نادى بها ودعا إليها، وبسطها في عدد من مقالاته وكتبه ومؤلفاته. |
| والسبب الآخر هو أن العقاد عمد في المقدمات التي كتبها لبعض دواوينه إلى شرح آرائه النقدية التي تختص بفن الشعر. |
| ومن تلك المقدمات ما كتب في ديوانه الثاني "وهج الظهيرة" في موضوع "الشعر والمدنية". |
| ونلحظ في تلك المقدمة التي كتبها العقاد قبل سبع وسبعين سنة وكان عمر العقاد إذ ذاك ثمانية وعشرين عاماً
(2)
آثار النضج المبكر في الوعي وتفتح الذهن، وسعة الاطلاع الذي تجاوز ما اطلع عليه من آثار المعرفة العربية إلى آفاق أخرى للثقافة الإنسانية قرأها وفقهها، وكان له من رأي فيها، يؤيد ما يرضي بأدلته التي يقتنع بها، ويرفض مالا يرضي ويفنده بفكره الواعي، ومنطقه المستقيم. |
| وذلك درس ينبغي أن يعيه أولئك الذين يلمون بأطراف من ثقافة أجنبية يأخذونها على علاتها، ويرجون لها في بيئاتهم العربية من غير وعي، ومن غير تمحيص، ويفضلونها دائما على المأثور الصالح من ثمرات التفكير الأصيل في أمتهم، ثم تكون فوضى فكرية، وصراع لا يجدي، ولكنه يزعزع الثقة بالفكرة الطبيعية الأصيلة الملائمة لعقلية الأمة وشخصيتها التاريخية المستقلة في مجالات الأدب والفنون على الأخص، ولا تستطيع الفكرة الوافدة الغريبة أن تحل محلها، لاختلاف العقليات وتباين الأذواق. وذلك سبب كبير من أسباب ما تعاني الأمة من انفصام الشخصية، وتفتت الجوهر، وفقدها الثقة بنفسها ومقدرتها. وذلك أقسى ما تمتحن به الأمم والشعوب. |
| ونعود إلى مقدمة العقاد، التي أوحي بها ما قرأه للكاتب الإنجليزي "توماس بيكوك" في رسالته عن "أدوار الشعر" وما ذهب إليه فيها من أن الشاعر في عصرنا هذا هو نصف همجي يعيش في عصر المدنية، لأنه يقيم في الزمن الخالي، ويرجع بخواطره وأفكاره وخوالجه وسوانحه إلى الأطوار الهمجية والعادات المهجورة والأساطير الأولي، ويسير بذهنه كالسرطان إلى الوراء.. ويرى بيكـوك أن الشعر يمثل طفولة الهيئة الاجتماعية.. ثم يقول.. كما نقل العقاد: "من المضحك في عصر النضج العلمي أن نعني بألاعيب طفولتنا. ونفسح لها موضعا من شواغلنا، فإن هذا سخف يشبه سخف الرجل الذي يشتغل بألاعيب الصبيان، ويبكي لينام على رنة الأجراس الفضية" ! |
| هذا هو الأساس الذي أقام عليه الكاتب ما دّون في رسالته. ويرى العقاد أن هذا الرأي ليس بالرأي الحديث، ولكنه رأي قديم أورده أفلاطون في جمهوريته
(3)
ولهج به بعض الكتاب في إبان النهضة الفرنسية، مع أنها كانت في مراميها السياسية والاجتماعية أشبه برواية شعرية تمثل على مسرح الفن منها بالحقيقة العملية التي تجري في عالم الحياة. |
| ويطالعنا العقاد في هذه المقدمة التي جعل عنوانها (الشعر والمدنية) بوجهه الثقافي المشرق، وبحصيلته من المعرفة، التي جمعت خلاصة التفكير الأدبي في بيئاته المختلفة، فيستظهر بها فيما فند به فيكتور هوجو مثل هذا الرأي الذي صرح به بيكوك، حيث يقول هوجو في كتابه "وليام شكسبير: "ينادي كثير من الناس في أيامنا هذه بأن الشعر قد أدبر زمانه. فما أغرب هذا القول ! |
| الشعر أدبر من زمانه !؟ لكأن هؤلاء القوم يقولون إن الورد لن ينبت بعد، وأن الربيع قد صّعد آخر أنفاسه، وإن الشمس كفّت عن الشروق، وأن القمر لا ينتظر له ضياء بعد اليوم، والبلبل لا يغرد، والأسد لا يزمجر، والنسر لا يحوم في الفضاء، وإن تلال الألب والبرانيس قد اندكّت، وخلا وجه الأرض من الكواعب الفتان والأيفاع الحسان… كأنهم يقولون إنه لا أحد اليوم يبكي على قبر، ولا أم تحب وليدها، وإن أنوار السماء قد خمدت، وإن قلب الإنسان قد مات". |
| وذلك هو رأي العقاد، والمنطلق الذي سار فيه في تفنيد قول الذاهبين إلى أن فن الشعر قد مضي زمانه لأننا صرنا إلى عصر العلم أو عصر المدنية والحضارة، وقولهم إن الشعر أشبه بحياة البداوة والهمجية، وإنه لا يناسب حياة المدنية التي يعيشها الإنسان في هذا الزمن، لأن مثيرات العاطفة والانفعال التي كانت تثير القدماء ما تزال موجودة، وما تزال تفعل فعلها في نفوس البشر ما دام الإنسان يحس ويشعر ويتذوق ويتخيل وينفعل بمظاهر الجمال التي يراها في الطبيعة والموجودات. |
| ولقد انجلت اليوم عصابة الجهل عن حواسنا، ودرجنا من الهمجية إلى المدنية كما يقول العقاد الذي يستطرد فيقول: لكن الكون لم يصغر والدنيا لم تنقص، ونواميس الطبيعة لم تضعف. ولم يصبح هذا الكون اليوم أقل استحقاقا لإعجابنا ودهشنا مما كان في أعين الهمج الجاهلين ! |
| فهل من فضل المدنية على أبنائها ألا يشعروا ببهجة الأزهار، وروعة البحار، أو ببهاء النجوم، ووحشة الغيوم، وألا تتفتح نفوسهم لنضرة الوجوه المشرقة، ولا تطرب آذانهم الجـداول المترقرقـة، وعجيج الأواذي المتدفقة، وألا يأسفوا، ولا يحزنوا، ولا يحبوا، ولا يبغضوا، ولا يتمنوا، ولا يتذكروا، تنزها عن الهمجية وصونا لكرامة المدنية ؟! |
| أم من فضلها عليهم أن يشعروا بهذه الأشياء ثم يسكتوا عن شعورهم بها مباهين بهذا البكم المبني على ذلك المنطق الهمجي ؟ |
| أم ينطقون بها همساً لئلا يعترضوا مطارق المعامل ومقارع الآلات، ولئلا يحجبوا صفير القاطرات وأزيز المركبات التي لا ينبغي للمدني أن يطرب لغيرها، أو يتصنت لصوت غير صوتها ؟ |
| وبهذا الحجاج العقلي يصل العقاد إلى أن المدنية لا تصل إلى النفس الإنسانية، وأن المنافع المادية التي يعبدها كارهو الشعر لن تكون الغاية القصوى في الحياة . يقول: ولو أن مطالب الجسم كانت هي وجهة الحياة الإنسانية لكان العالم قد بلغ حده منذ آلاف السنين، ولكانت الأجيال المقبلة أجيالاً فضولية لا تزيد العالم، ولا العالم يزيدها؛ لأن الإنسان قد عرف حاجات جسمه، وبصر بوسائلها. فماذا بقي عليه منها، وفيم تتعاقب الأجيال بعد الأجيال لتكرير حالة واحدة لا تفاوت فيها ؟. لو كانت وجهته ما يسمونه بالمنافع المادية لكان حسبه ما بلغه منها وكفى ! |
| ولكن الإنسان مسوق إلى وجهة بعيدة بميول نفسه وحوافزها، وإنما منافعه المادية زاده إلى هذه الوجهة. وكل هاتيك المنافع تنتهي إلى معنى من المعاني الشعرية التي يعدها البلداء لغواً، وهي هي جوهر الحياة، ومتاع النفوس. |
| وحريّ بالعقاد الذي حلق في أجواء الشعر والأدب، ونهل من فيض المعرفة الإنسانية أن ينتصر لفن الشعر، وأن يتصدى للدفاع عنه بمثل هذا الدفاع ضد الحملات التي يشنها أعداؤه عليه بسيل من الحجج الواهية والدعاوي التي لا يسلم بها منطق، ولا يعترف بها واقع الحياة. وإن يكن هذا الدفاع كما رأينا لا يصور دفاع فنان عن فنه الأثير بقدر ما يمثل دفاع مفكر عن فكرة يؤمن بها، ويعرف أبعادها وأغوارها، ويقدر مراميها وآثارها في حياة البشر. |
| * * * |
| وكتب العقاد مقدمة لديوانه الخامس "وحي الأربعين" جعل عنوان هذه المقدمة "الشعر العصري"، وموضوعها "التقليد في إنكار التقليد". ذلك أن بعض النقاد أرادوا أن يعدهم الناس في المجددين فزعموا أن التجديد يعني مجافاة كل ما يمت إلى القديم بسبب من الأسباب، ولو كان هذا السبب عرضيا لا يتعلق بجوهر الشعر في مبانيه أو مضموناته أو مراميه، ولذلك يحكمون على الشعر بالتقليد، وعلى صاحبه بالمتابعة والاحتذاء وإن اختلف المذهب وتباين الاتجاه. |
| وهؤلاء لا يفرقون بين الجديد إن كان له أصل أو شبه في القديم وإن أبدع الشاعر أو جدد فـي تناوله وتأليفه، والقديم الذي كان هم صاحبه محاكاة الأقدمين. |
| وقد ضرب العقاد مثلين لما سماه "التقليد في إنكار التقليد": |
| أولهما: أن بعض أولئك النقاد تناول ديوانا من الشعر فقال " هذا شعر عصري هذا ديوان خلا من باب المدح وباب الهجاء، فهو شعر جديد، وليس بشعر قديم ! |
| والآخر: أن بعضهم قرأ قصيدة في وصف الصحراء والإبل، فأنكر أن تكون من المذهب الجديد، وعدها بابا من الشعر لا يجوز أن يطرقه العصريون ! |
| يرى العقاد أن الشعر لا يكون عصرياً مبتكراً لأنه خلا من المدح، ولا يكون قديماً محكياً لأنه يشتمل عليه. وإنما يخرج "المدح" من الشعر لأنه كلام يضطر الناظم إليه اضطراراً، ولا يعبر فيه عن عقيدة صادقة أو عاطفة صحيحة، ولولا الحاجة إلى نوال الممدوح لما نظمه ولا أجاله في خاطره، فمن هنا كان المدح كلاماً لا شعر فيه ولا دلالة على شعور. |
| أما المادح الذي يقول ما يعتقد أو يحس أو يتمثل أو يتخيل فلا فرق بينه وبين شاعر الوصف والغزل والحماسة من حيث القدرة الشاعرة، ولا سيما إذا هو أثنى بما يوجب الثناء في رأيه وضميره. |
| ويضرب العقاد لذلك مثلا التصوير بالريشة، وهو كالشعر أحد الفنون الجميلة التي يقع فيها الابتكار والتقليد، فيقول: لا نعرف ناقداً يزعم أن المصور، الذي يرسم رجلا من أجل ثمن مقدور لا يعد من المصورين "العصريين" إذ كل ما يطلب منه هنا أن يجيد نقل الشبه، والدلالة على الملامح والأطوار النفسية. |
| فإن هو أجاد في عمله هذا فهو مصور كأحسن المصورين، وإن لم يجد فليس هو بمصور وإن كان يرسم الأشخاص متبرعاً غير مأجور. |
| وكذلك المدح في دلالته على المشاعر أو في انتظامه بين أبواب الشعر الصحيحة فإنما يعاب بيع الثناء من وجهة الخلق والعرف، لا من وجهة الفن والتعبير. |
| أما الذين "يقلدون" في إنكار القديم فقد اختلط عليهم الأمر، فحسبوا المدح منفيا من عالم الشعر لذاته لا لما قدمناه. |
| ذلك هو رأي العقاد في شعر المديح كما سجله في مقدمة "وحي الأربعين". وهو يزيده توكيداً وتوضيحاً في معرض آخر يدافع فيه عن فن المديح، وينبه على ما هو جدير منه بالعيب والاطراح. وذلك في دراسته التحليلية لشاعرية حافظ إبراهيم شاعر النيل الذي شغلت المدائح في شعره مكاناً ملحوظاً حيث يقول إن المديح "من أفضل المقاييس لقياس حال الأمة والشاعر والأديب في وقت واحد، فيخطئ من يظن أن الأمم المترقية لا تمدح أو لا تقبل المدح من شعرائها، إذ المديح جائز في كل أمة ومن كل شاعر. |
| فلا ضير على أعظم الشعراء أن يصوغ القصيد في مدح عظيم يعجب به ويؤمن بمناقبه. ولا ضير على الأدب أن يشتمل على باب المديح بين أبوابه الكثيرة التي يعرفها الغربيون أو الشرقيون. |
| وإنما الخلاف في نوع المديح لا في موضعه على إطلاقه، فمديح الأمم المتعلمة غير مديح الأمم الجاهلة، والشاعر الذي يملك أمره يتبع في مدحه أسلوبا غير الذي يتبعه شاعر مغلوب على أمره. |
| ومكانة الأديب في الأمة تظهر أتم الظهور من أساليب الشعراء في هاتين الحالتين: فلن يقال أن للأدب مكانا في الأمة والشاعر مضطر فيها إلى إذلال عقله وتسخير كرامته في مديح لا تسيغه العقول، ولا يليق بالرجل الحر لما يقول. ولن يقال إن الأمة متعلمة والمبالغات الشعرية فيها تؤخذ مأخذ الجد والوقار، وهي أقرب إلى الهزل والهجاء المستور، أو لن يقال إن الأمة حرة تشعر بوجودها وأنت تقرأ مدائح شعرائها فلا ترى فيها ذكراً لغير الرؤساء، ولا ترى في الصفات التي يمدحون بها صفة ترجع إلى الأمة وتعتمد على تقديرها، أو تستفاد من خدمتها والعمل بمشيئتها. فحافظ يمثل أمته في مديحه، كما يمثلها في قصائده الاجتماعية، فهو مديح يدل على مراحل الأدب والحرية القومية في الأمة المصرية مرحلة بعد مرحلة. |
| وبهذه الخصلة أيضاً كان حافظ متفرداً بين شعراء جيله قليل النظير. |
| * * * |
| أما وصف الصحراء والإبل فإنه يحسب تقليداً لا ابتكار فيه إذا نظمه الناظم مجاراة للأقدمين، واقتباسا من الدواوين. أما الرجل الذي يعيش في الصحراء أو على مقربة منها، ويركب الإبل وتجيش نفسه بالشعر والتخيل عند ركوبها ورؤيتها فليس بشاعر إن لم ينظم في هذا المعنى مخافة الاتهام بالتقليد، أو جرياً على رأي الآخرين. إذ هذا هو التقليد بعينه في التصور واختيار الموضوعات ! |
| وما المقلد إلا من ينسي شعوره، ويأخذ برأي الآخرين على غير بصيرة، أو بغير نظر إلى دليل ! |
| فهناك إذن "مقلدون" في كراهة التقليد، لا يدركون لماذا يستحسنون ولماذا يستهجنون. وربما كان هؤلاء أضر بالمذاهب الجديدة من معشر الجامدين على المذهب القديم. |
| وقد كثرت محاولات العلماء والنقاد لتعريف الشعر وتحديد مفهومه، أو وضع حد جامع مانع لهذا الفن العريق. ويرى العقاد أن من أراد أن يحصر الشعر في تعربف محدود كمن يريد أن يحصر الحياة نفسها في تعريف محدود. |
| ولا ينبغي للشاعر أن يتقيد إلا بمطلب واحد يطوي فيه جميع المطالب. وهذا المطلب هو "التعبير الجميل عن الشعور الصادق". |
| وكل ما دخل في هذا الباب. باب التعبير عن الشعور الصادق - فهو شعـر، وإن كان مديحـاً أو هجاءً أو وصفاً للإبل والأطلال. وكل ما خـرج من هذا البـاب فليس بشعـر، وإن كان قصـة أو وصف طبيعة أو مخترع حديث. |
| وإذا كان العقاد يحصر الشعر في هذا المطلب "روعة التعبير عن صادق الشعور" ويراه يتسع لجميع المقاصد، ولا يضيق بمقصد منها، فإن أحداً لا يستطيع أن ينازع في سلامة هذا المقياس الذي يحتفي بأصالة المعاني وجودة الأداء في المحاكاة الشعرية. |
| وفي الوقت نفسه ينفر العقاد من النمطية، ويرفض التبعية التي تحدد للشاعر المسار الذي يسلكه لتحقيق مقصده من الشعر، حتى لو كان هذا النمط أو المثال من النماذج الرفيعة التي حظيت بإعجاب عامة الأدباء، وتقدير عامة النقاد. |
| ويصف العقاد بضيق الوعي وركود النفس أولئك النقاد الذين يحصرون كل باب من أبواب الشعر في نمط لا يعدوه، ولا يتخيلون غيره، ويحددون المعاني والصفات المطلوبة في كل غرض من أغراضه
(4)
، ويحسبون أن النفوس لا تحس إلا على وتيرة واحدة، ولا تعبر إلا على أسلوب واحد ! |
| وقد يعجب أولئك النقاد بصنيع شاعر من الشعراء وإبداعه في فن من فنون الشعر، فلا يرضيهم شعر في هذا الفن إلا أن يكون صورة لما أعجبهم من صنيع الشاعر القديم. |
| فهم قد أعجبوا مثلاً بإبداع البحتري في وصفياته، فأصبحوا لا يرضون من الوصف إلا ما كان على غرار وصف البحتري، وأعجبوا بحكمة المتنبي وتأملاته فلا يعجبهم من الشعر إلا ما اشتمل على الحكمة وثمرات التأمل، ومنهم من هام بشعر الملاحم فأراد أن يكون الشعر كله ملحمياً… |
| كل ذلك من المحاكاة التي يضرب لها العقاد الأمثال، ثم يرفضها جميعاً، لأنه لا يريد للشاعر المحدث أن يكون صورة لغيره، وإنما يكون شعره صورة نفسه، يعبر ببيانه المطبوع الجميل عن شعوره الذي ينبع من وجدانه، ومن ذات نفسه. |
| ويختم العقاد مقدمة "وحي الأربعين" بتلخيص ما فصل فيها النقاد من آرائـه في الشعر الحديث أو في الشعر العصري، وما يأخذه على النقاد المحدثين، فيقول: |
| "لقد رأينا دواوين لبعض الشعراء يستغرق فيها فضاء محدود، يقاس بعشرات الأشبار، فأين بقية آفاق الوجود ؟ أين غرائب الإحساس التي تختلف إلى غير نهاية في كل طور من أطوار النفوس ؟ |
| إنك لن تستطيع أن تفرضها فرضاً إذا أنت قنعت من الدنيا بما تمثله لنا أشعار الناظمين المحدودين، فلنفهم شأن الخيال في توسيع الدنيا والسيطرة عليها نفهم شأن الشعر الصحيح، ولنفهم شأن الشعر الصحيح نحطم تلك السدود التي يحبسنا فيها أصحاب التعريفات من الجامدين أو المقلدين في كراهة التقليد. |
| ولنذكر أبداً أن "التعبير الجميل عن الشعور الصادق" عالم لا ينحصر في قالب، ولا يتقيد بمثال". |
| إن أهم ما تضمنته هذه المقدمة من التفكير النقدي عند العقاد هو تحديد المفهوم الذي ارتضاه للشعر وهو أنه "تعبير جميل عن شعور صادق". وهذا المفهوم يتسع لكل غرض أو لكل مقصد من مقاصد الشعر، لأن موضوع الشعر هو الحياة كلها، والحياة لا تحدها حدود، وكذلك الشعر الذي يعبر عن عالم بلا نهاية. وقلنا إن أحداً لا يستطيع أن ينازع في صواب هذا المفهوم الذي اصطفاه العقاد، وعبر عنه في تلك الألفاظ القليلة. |
| كما تضمنت هذه المقدمة إشارة إلى إسراف بعض النقاد في أحكام يصدرونها تحت شعار التجديد، وهم في الحقيقة يقلدون المجددين، ولكنه تجديد لا يصدر عن وعي ولا بصيرة بفن الشعر ووسائله وأهدافه. |
| ولقد كان العقاد واحداً من زعماء الشعر في العصر الحديث، وداعية من أكبر الدعة إلى تجديده، وإلى العدول به عن مذاهب الجامدين، وأسرف بعض مقلدي العقاد، فانحرفوا عن الجادة، وأخذوا ما ينتقصون كل شعر له أصل أو شبه في القديم، فعابوا الشعراء الذين عرضوا لوصف الإبل وحياة الصحراء ففند العقاد مذهب أولئك المقلدين في إنكار التقليد كما رأينا. وفي معرض آخر يزيد رأيه بياناً
(5)
ويعد من الآراء "الخاطفة" نقد الناقدين "الخاطفين" لوصف الناقة أو وصف الصحراء في عصرنا الحديث، فقد عز عليهم أن يفهموا لماذا عيب على الشعراء المتقدمين، فحسبوا أنه منقود على الإطلاق، وأن آية التحريم قد نزلت على وصف النوق والصحراوات إلى أبد الأبيد ! |
| وليس الأمر كذلك، فإنما يعاب وصف الناقة على المحاكاة، كما تعاب المحاكاة في وصف الطيارة من أحدث طراز، وكما تعاب المحاكاة في وصف القنبلة الذرية وكل مخترع يأتي بعد القنبلة الذرية، ولو أتى بعدها بعدة قرون! |
| ويبدو أن أولئك الناقمين على الشعراء المحدثين وصفهم النوق والصحراوات من الذين يروقهم وصف مشاهد الطبيعة مع أن في هذه المشاهد ما هو أقدم بكثير مما عابوا وصفه، إذا كان المقياس عندهم هو القدم والحداثة، لأن العقاد يقول لهم: |
| إن الجبال أقدم من الناقة، فهل يحرم وصفها على الشعراء والكتاب؟ |
| والبحار أقدم من الجبال، فهل يحرم وصفها على الشعراء والكتاب؟ |
| والكواكب والشموس أقدم من الجبال ومن البحار ومن الأرض نفسها، فهل يحرم وصفها على الشعراء والكتاب؟ |
| والعجب أن تخفى هذه الحقيقة البينة على أحد ممن يفقهون الشعر أو لا يفقهونه ! فكيف خفيت على أولئك النقاد ؟ |
| يقول العقاد: ما نخالها خفيت عليهم إلا لأنهم حسبوا الناقة "أداة مواصلات"، وصفها الشعراء الأقدمون لأنها أداة مواصلات، فلا يحسن بالشعراء المحدثين أن يتركوا أدوات مواصلاتهم، ليصفوا النوق في الصحراء! |
| والناقة ليست بأداة مواصلات وكفى، إلا إذا كان راكبها جمَّالاً وكفى ! ولكنها حيوان وراكبها إنسان، وشأن الحيوان والإنسان باق في الشعر وفي الإحساس والتعبير عن الإحساس إلى آخر الزمان. وهي بهذه المثابة أحدث من طيارة اليوم، وطيارة القرن الثلاثين، أو ما بعد القرن الثلاثين ! |
| وكذلك الصحراء وأهل الصحراء، وكذلك كل بقعة من بقاع الأرض، وكل مطلع من مطالع السماء. |
| ويدع العقاد أمثال أولئك النقاد ليتحدث الشعراء الذين يتوجسون من نقد أولئك النقاد، فيقول إن الشاعر الذي تروعه الصحراء ولا ينظم فيها أعرق المحاكاة والتقليد من الشعراء المتقدمين، والأديب الذي يحسب أن الطيارة قد نسخت الناقة والجواد وسائر المطايا الحية لا يحس الحياة ولا الأحياء ! |
| * * * |
| وفي مقدمة ديوانه السادس "هدية الكروان" يذكر العقاد علة هذه التسمية التي اختارها، وهي ما كان يحس به من طرب إذا سمع هتاف هذا الطائر العجيب، وهو أكثر ما يسمع السامع في حوافي مصر الجديدة حيث يسكن العقاد، وحيث يكثر الكروان الذي يألف أطراف الصحاري على مقربة من الزرع والماء.. |
| ويبدي العقاد عجبه لأنه لا يقرأ صدى للكروان فيما ينظم الشعراء المصريون على كثرة ما يسمع الكروان في أجوائنا المصرية من شمال وجنوب، وأعجب من ذلك أنك لا تقرأ فيما ينظمـون؛ إلا مناجاة البلابل وأشباهها مع قلة ما تسمع في هذه الأجواء المصرية. |
| وفي هذه المقدمة من مسائل النقد مسألتان: |
| الأولى: إنحاء العقاد باللوم والتقريع على أولئك الناظمين المعجبين بالبلابل ومناجاتها في أشعارهم، وهم لا يسمعون أصواتها ولا يرونها، ويصف العقاد صنيعهم بأنه محاكاة منقولة من الورق البالي، وتؤذي النفس كما يؤذيها كل تصنع لا حقيقة فيه، ويقول إن أخف موقع لذلك في نفوسنا أن يضحكها ويغريها بالسخرية، كذلك الأصم الذي أراد أن يخفي صممه في مجلس الغناء، فأوصى صاحبه أن يغمزه كلما وجب الصياح والاستحسان، فلما نام وراحوا يوقظونه آخر الليل قام يصيح ويستحسن، ولا سماع هناك ولا سامعين ! |
| وخلاصة هذا الكلام أن الشاعر لا ينبغـي له أن يصف من الأشيـاء إلا شيئـا رآه أو سمعه أو أحس به، ثم تأثر بهذا الإحساس أو انفعل به، وإلا كان من المقلدين الذين لا يعبرون عن أنفسهم. |
| وسواء أكان الكروان قد أوحي إلى العقاد هذا الشعر الذي انتظمه الديوان أم كان العقاد هو الذي أهدى هذه الطاقة من شعره إلى الكروان الذي كان من بواعث إلهامه والتسرية عنه، فإن العقاد يتساءل: إذا لم يشعر الشاعر بتغريد الطير على اختلافه فبماذا عساه يشعر ؟ ثم يقول: إن الطير المغرد هو الشعر كله، لأنه هو الطلاقة والربيع والطرب والعلو والتعبير والموسيقية. فمن لم يأنس به لم يأنس بما في هذه الدنيا من طبيعة شاعرة، ولم يختلج له ضمير بما في الحياة من فرح وجيشان وتعبير ! |
| والمسألة الأخرى أن الطبيعة هي معلم الإنسان، وهي التي ألهمته تلك الفنون التي شغف بها، ومنها الرسم والموسيقى والشعر والغناء، ولكنها من أعمال المحاكاة التي أحس الإنسان بقدرته عليها، وحاجته إليها. |
| وقد رأينا كيف فند العقاد في مقدمة ديوانه "وهج الظهيرة" مقالة أعداء الشعر، ومنهم الكاتب الإنجليزي توماس بيكوك، الذي زعم أن زمن الشعر قد ولى، وأنه أجدر بحياة البداوة في عصور الهمجية والفوضى، وأنه لا محل له في حياة التحضر والمدنية، ورأينا كيف دافع العقاد عن فن الشعر، وأثبت أن الحياة لا تستغني عن هذا الفن الإنساني العريق، وأن الإنسان مجبول على التشبُّث بهذا الفن ما دام هنالك حس وشعور، وما دام في الحياة ما يثير العواطف ويؤثر في النفوس. |
| ويسوق العقاد إلى إعادة هذا الرأي حديثه عن الكروان وشدو الطيور الذي هو شاهد صدق على أن الشعر والغناء تدفع إليهما طبيعة الإنسان كما تدفع الفطرة الطيور إلى الشدو، وترديد الأنغام والألحان على غصون الشجر، وفي فضاء الله الرحيب. |
| يقول العقاد في ختام مقدمة "هدية الكروان": والطير هو حجة الطبيعة لشعر الإنسان وغناء الإنسان، فهو عند الشاعر وثيقة لا يعرض عنها، ولا يفلتها من يديه. فإذا قال الجفاة الجامدون إن الشعر لغو في الحياة قال الشاعر أن التعبير الموسيقي عنصر من عناصر الطبيعة، وإن الطير يغني ويهتف. وإن الطير يفرغ للغناء وحده إذا شبع وأمن، كأن الغناء والتعبير عن الشعور هما غاية الحياة القصوى، لا ينساها الحق إلا لعائق يشغله، ويغض من حياته. |
| والجفاة الجامدون يقولون كثيراً عن الشعر في الزمن الأخير، يقولونه على الرغم من هذا الشعر الذي تفيض به الطبائع الحية ولا سيما الأحياء المغردة الطائرة، ويقولونه على الرغم من ملازمة الشعر لكل أمة ولكل قبيلة، ولكل لغة. |
| فلو كان الشعر شيئا عارضاً في الحياة الإنسانية لما وجد حيث توجد الحياة الإنسانية، ولو كانت الموسيقى نافلة في الدنيا لما وجدت في أمة الطير. وإذا وجدت في لسان الطائر فلماذا تحرم على لسان الإنسان؟ ولماذا يكون الكلام الإنساني وحده بمعزل عن الأوزان والأشجان ؟ . |
| * * * |
| أما الديوان السابع للعقاد "عابر سبيل " فقد اختار مقدمته حديثا عن "الموضوعات الشعرية". وقد تحدث فيها عن المجالات التي يستطيع الشاعر الإلمام بها وتجليتها كما تتفاعل في أعماقه. |
| وعند العقاد أن كل ما في الحياة صالح أن يكون موضوعاً للشعر، بشرط أن يخلع عليه من إحساسه، ويفيض عليه من خياله، ويتخلله بوعيه، ويبث فيه من هواجسه وأحلامه ومخاوفه، كل ذلك مجال للشعر وموضوع له، لأنه حياة وموضوع للحيـاة. وكل شيء فيه شعـر إذا كانت فينـا حياة، أو كان فينا نحوه شعور. |
| ومعنى ذلك أن الشعر في نظر العقاد لا يصف الأشياء وصفاً مجرداً كما هي، وإنما يصفها مختلطة بمشاعر الشاعر، متفاعلة مع عواطفه وذكرياته. وذلك أصل من أصول المحاكاة الشعرية التي عرفها الحكماء الأقدمون، وأكدها علماء الأدب ونقاد الشعر، لأن الوصف المجرد من خصائص العلوم. |
| ويقرر العقاد أن الإحساس بالشيء هو الذي يولد الشعور نحو ذلك الشيء، ويخلق فيه اللذة، ويبعث فيه الروح فيحيله إلى معنى شعري تهتز له النفس، أو بمعنى زريّ تصدف عنه الأنظار، وتعرض عنه الأسماع. ويستشير العقاد في تقريره هذا بحث علماء النفس في الحياة العقلية، إذ أن الحواس هي منافذ المعرفة التي يتحقق بها الإدراك الذي ينشأ عنه الشعور أو الوجدان، والإحساس الداخلي باللذة أو الألم، والرضا أو السخط، ثم تكون المرحلة الأخيرة من مراحل العقل، أو مراحل الوعي، وهي مرحلة الإرادة أو النزوع. |
| ويقول العقاد إن التصور هو خير معوان للإحساس وشاحذ للرغبة أو النفور، ويضرب المثل بالأم التي تنظر إلى وليدها، ثم تقضي عشرين سنة وهي تتصوره عريساً سعيداً، لا تفرح به يوم عرسه كما تفرح بتصوره والرجاء في بقائه طوال تلك السنين. ونحن من نسج التصور نخلق أنفس الحلل التي نضفيها على آمال الغيب ومشاهد العيان. |
| وأحسب أن العقاد يعني الرغبة التي يذكرها في هذا المقام ما يسمى "الملكة" وهي الاستعداد الفطري لمزاولة فن من الفنون، لأن هذا النزوع الفطري هو الذي يغري صاحبه بالاستجابة لدواعيه. |
| أما التصور فهو التخييل الذي يجسد الأماني أو الأحاسيس لتبرز في إطارها الفني المتكامل بعد أن تمت معالم الصورة واكتملت أجزاؤها في نفس الفنان. |
| وإذا اجتمع لدى الشاعر الرغبة والتصور تجمع إليه زاد من الشعر لا ينفد، وموضوعات للشعر تشتمل على كل ما تراه العيون وتمسه الأذواق، وليتوجه بالحواس الراغبة إلى ما تشاء يستمرئ الشعور به، والتعبير عنه كما يستمرئ المحاسن المشهورة والمناظر المأثورة، لأن المحاسن نفسها لن تهزه إليها، ولن تحل عقدة لسانه حتى يزينها له الحسن الناشط والخيال المتوفز.. |
| كتب العقاد هذه الكلمات في العقد الرابع من هذا القرن (1937م) وهو في وقت ازداد فيه الاتصال بالغرب، والوقوف على حركاته الفكرية وتياراته الاجتماعية والأدبية، وكانت "الرومانسية" من أهم ملامح الآداب والفنون في تلك الفترة، وقد هامت بها طائفة من أدبائنا وشعرائنا بعد أن قرءوا آداب الرومانسيين وأشعارهم، وعرفوا هيامهم بالطبيعة، وإطلاقهم الخيال في وصف مشاهد الطبيعة ومفاتن الرياض والبحار والسحاب والنجوم، فأصبحوا لا يرون الشعر إلا فيما تلهمه تلك المشاهد الطبيعية التي يصورها الشعراء المبدعون، فاقتفوا آثارهم في تمجيدها ووصف مشاهدها. |
| والعقاد الذي يبغض التقليد ويمقت المقلدين ويدعو إلى الأصالة والتجديد لابد أن يتصدى لأولئك المفتونين، فيرى أن الرياض والبحار والكواكب والنجوم والمطر والسحاب ليست وحدها الصالحة لتنبيه القرائح واستجاشة الخيال، وأن النفس التي لا تستخرج الشعر إلا من هذه الموضوعات كالجسم الذي لا يستخرج الغذاء إلا من الطعام المتخير المستحضر، أو كالمعدم الذي يظن أن المترفين لا يأكلون إلا العسل والباقلاء ! |
| وعلى هذا الوجه يرى الشاعر شعراً في كل مكان إذا أراد، يراه في البيت الذي يسكنه، وفي الطريق الذي يعبره كل يوم، وفي الدكاكين المعروضة، وفي السيارة التي تحسب من أدوات المعيشة اليومية، ولا تحسب من دواعي الفن والتخيل، لأنها كلها تمتزج بالحياة الإنسانية، وكل ما يمتزج بالحياة الإنسانية فهو ممتزج بالشعور، صالح للتعبير، وأجد عن التعبير عنه صدى مجيباً في خواطر الناس. |
| ويرى العقاد أن أبناء العصر الحاضر في حاجة إلى هذا التوجيه لإنقاذ النفس الإنسانية، لا لإنقاذ الملكة الفنية وحدها، فإننا إذا تعودنا العناية بالأشياء وجدنا فيها ما استحق العناية، وينفض عن النفس تلك التفاهة التي غلبت على الحياة وعلى الشعر في هذه الأيام الحديثة. |
| * * * |
| أما مقدمة ديوانه الثامن "أعاصير مغرب" فإن العقاد يقصر حديثه فيها على حديث الغزل والحب. |
| وقد ألف العقاد ديوانه هذا وهو في الثالثة والخمسين من عمره (1942م) والعالم يصلي نار الحب العالمية الثانية، وجيوش الألمان والطليان تدق أبواب مصر الغربية، والعقاد يمر بفترة قاسية في حياته، فقد عصفت بالعالم أعاصير الحرب، وعصفت في أعماقه أعاصير القلق والاضطراب، وهو يحس بقرب انصرام حبل الأجل، فكان ذلك التشاؤم الذي دعاه إلى اختيار اسم الديـوان لأن المغرب أو الغروب رمز لقرب الرحيل عند العقاد وعند شعراء اليونان القدماء. |
| ومحور القضية الذي تدور حوله المقدمة هو: هل يتمكن الحب من قلب الشيخ الذي تقدمت به السنون، وهل يكون صادقا في حبه إذا تغزل بعد أن يجاوز من عمره السبعين ؟ |
| قرأ العقاد، وهو في تلك السن أبياتاً للشاعر الإنجليزي "توماس هاردي" يقول فيها: |
| "انظر إلى المرآة، فأرى هذه البشرة الذابلة تتغضن، فأتوجه إلى الله مبتهلاً إليه: أسألك يا رب إلا ما جعلت لي قلبا يذبل مثل هذا الذبول ! |
| إنني إذن لأحس برد القلوب من حولي فلا آلم ولا أحزن، وإنني إذن لأظل في ارتقاب راحتي السرمدية بجأش ساكن وصمت وقور.. |
| غير أن الزمن الذي يأبى لي إلا الأسى قد شاء أن يختلس فلا يختلس كل شيء، ويترك فلا يترك لي كل شيء، ولا يزال يرجف هذه البنية الهزيلة في مسائها بأقوى ما في الظهيرة من خلجة واضطراب"! |
| فما أتم قراءة الأبيات حتى خطر له الاسم الذي اختاره لهذا الديوان، وهو "أعاصير مغرب" وإن لم يرد في الأبيات ذكر للأعاصير. |
| وأعجب العقاد بالغزل الذي ألّفه هاردي وهو بين السبعين والثمانين لأنه كان يرى في زمن الفتوة أن الشعور والتعبير لا ينتهيان بانتهاء الشباب، ومتى بقي الشعور والتعبير فما الذي فني في مادة الغزل والغناء. |
| والمسألة ليست في نظر العقاد مسألة نظريات. وإنما هي حقيقة لا ريب فيها إذ كل ما يجب علينا لنقول إن الشيخوخة تجيد الغزل أحيانا هو أن نعلم أن توماس هاردي نظم شعر الغزل بعد السبعين، وأن ما نظمه بعد تلك السن كان جيداً مقبولاً، رضي عنه قراء الشعر واستزادوه، وأنه كان من أسباب تلك الشهرة التي أحرزها في عالم الشعر بين قراء الأدب الرفيع بعد اشتهاره بالرواية وحدها في سن الشباب.. |
| ويتحدث العقاد عن "الحب" وهو عاطفة شائعة بين الناس، ولسنا نعني الصلة الجسدية التي تنقضي بانقضاء دوافع الفطرة، فإن هذه لا تسمى حبا، ولا هي من العلاقات القائمة بين فرد وفرد، لأنها فوضى مشتركة بين جميع الذكور وجميع الإناث من فصيلة واحدة. |
| ولكننا نعني الصلة النفسية التي تجمع الفردين معاً بعلاقة لا يغني فيها أي فرد آخر من الفصيلة. |
| وليس في استطاعتنا أن نقول إن كل محب شاعر، ولا إن كل متغزل نصيبه من الحب مثل نصيبه من الغزل على السواء، فإن الناس من غير الشعراء الغزليين يقتلون أنفسهم حباً أكثر جدا من الذين يبلغون في الحب هذا المبلغ بين أولئك الشعراء، ولا ريب أن الشاعر لا يحسن الغزل بغير حب، وقد يعلو الحب حين يهبط الغزل، وقد يعلو الغزل وتهبط درجة الحب. |
| وقد يقضي الفتى أوائل شبابه ولا معنى للحب عنده إلا أنه "وظيفة فيزيولوجية" مبهمة يساق إليها بغير هداية ولا تمييز، لأن الحب عنده جوعة جسدية أو نفسية يشبعها أي شريك يصادفه ويلفيه على مثل حاله من الرغبة والاشتياق. |
| والحب الذي يكون على أتمه وأعمه وأقواه هو تفاهم بين نفسين، وامتزاج بين قلبين. |
| ويخلص العقاد من ذلك إلى أن للشباب حبه، وللرجولة حبها، وللكهولة بعد ذلك حب لا يشبه الحبين ! |
| إن مئونة الغزل لا تنفد ودواعيه حاضرة في كل حين، فهناك الحنين والتذكار بعد فوات الشباب، وانقضاء عهد الرجولة. ولو سألنا الشعراء الذين نظموا في خوالج النفوس شيوخاً وشباناً لعلمناهم أن خير ما نظموه في شوق أو حزن أو ألم أو خالجة ثائرة أيا كان فحواها إنما كان كله من قبيل الحنين والتذكار، لأنهم ينظمون بعد فوات الثورة الداهمة، واطمئنان اللوعة العارضة، حين يصفو الشعور من كدر الدخان والضرام. |
| ويجب أن نعلم أن العاطفة ألزم للحياة الإنسانية وألصق بها وأعمق فيها من أن تحصرها فترة واحدة، أو تحتويها صورة، أو يختمها عهد واحد. فهي - كأي شيء في الحياة - تزداد فهماً على طول المصاحبة، وطول المراس والمساجلة. |
| وعلى حسب الفهم يزداد التعبير، ويزداد الاستكناه والتصوير؛ وبخاصة بين الذين يقضون حياتهم في عالم الشعور والخيال، وهم الشعراء والموسيقيون والمصورون والممثلون. |
| * * * |
| وانطفأت نار الحرب العالمية الثانية التي روعت الإنسان في بقاع كثيرة من الدنيا، وهدأت ثورة العقاد بعد أن انجابت عنه دواعي القلق والاضطراب، فقرت بلابله، واستقرت حياته، واطمأنت نفسه بعد سكون الأعاصير التي حسبها الأعاصير المؤذنة بقرب الغروب أو قرب الرحيل، فأطلق على المجموعة التاسعة من شعره اسم "بعد الأعاصير". |
| ونقرأ تلك المقدمة التي كتبها العقاد لما بعد الأعاصير وجعل عنوانها "في ذمة النقد" فنراها أطول المقدمات التي كتبها لدواوينه، وأحفلها بآرائه في الأدب والفن ودراسة اتجاهات النقاد في هذا العصر.. |
| وقد أراد العقاد لهذه المقدمة أن تكون مراجعة وتقويماً لتلك الاتجاهات النقدية، ولمقاييس الأدب والفن، التي سادت في هذا الزمن، لأننا كما يقول في زمن المراجعة والتقويم، نراجع كل شيء، ونعيد تقويم كل شيء، وننقد ونعيد النظر في مقاييس النقد نفسه. |
| ولا محيص من "نقد النقد" نفسه قبل تقدير قيمته في عالم الأدب والفن، وقبل الاعتماد عليه في تقرير ما نقبله من آثار الأديب والفنانين. |
| ونستطيع أن نلخص تلك المراجعات النقدية في عدد من الأمور أهمها: |
| (1) أن أول ما ينقد به النقد أنه لم يكن خالصاً لوجه الأدب في أي زمان، فما من نقد خلص من نفس الناقد، مما حال دون النفاذ إلى قيمة الأدب في صميمه، والنقد الصحيح هو الذي يستخرج القيمة التي تدل على المنقود، وتعطيه حقه في الإعجاب أو استحقاقه للرفض والزراية. |
| و"نقد النقد" بهذا المعنى هو تخليصه من كل أثر فيه لهوى الناقد أو هوى البيئة، أو هوى الشيعة، أو وساوس النفس الإنسانية. |
| (2) والتعصب داء قديم، فقد عرف الناس التعصب للأديب أو الشاعـر لأنه من جنس المعجبين به، أو من أبناء نحلهم في الدين، أو شيعتهم في السياسة. |
| ولكن الجديد في هذا العصر أن التعصب قد أصبح خطة مقررة في دعوة مدبرة تدين بها طائفة كبيرة من أصحاب المذاهب والنحل، ويصدرون عنها في تقريعهم ونقدهم، وفي ثنائهم وتشهيرهم، ويتخذونها سبيلاً إلى ترويج دعواتهم السياسية وآرائهم الاجتماعية بمعزل عن الفن والأدب، وعلى علم بالتلفيق، والعوج في القياس، إذا لزم التلفيق أو العوج في خدمة الغرض الأصيل. |
| يقول العقاد: إن الذين يستخدمون "النقد الأدبي" لمحاربة خصومهم المذهبيين والانتقام منهم قوم لهم سيماهم التي لا يختلطون فيها بغيرهم، فهم جميعا من "غير الأدباء" وهم جميعا لا ينتجون أدباً، ولا يقرءون أدبا لأنه أدب، ولكنهم دعاة يقحمون عالم الأدب والشعر لخدمة الأغراض التي تعنيهم باسم "النقد الأبي"، وما هو من النقد الأدبي في شيء ! |
| (3) ظهور المقلدين في حركة التجديد، وهم أولئك الذين سمعوا بمبادئ التجديد، وراحوا يطبقونها تطبيق الآلة التي لا تميز بين حقائق الأسباب. |
| ولا يقل هؤلاء المقلدين في النقد عن ضرر أولئك المتعصبين من الدعاة لمذهب من المذاهب السياسية أو الاجتماعية، فإنهم لا يصلحون لقديم ولا جديد في الأدب، ولا يعرفون لماذا يقرظون، ولا لماذا ينتقدون. |
| سمعوا مثلا أن وصف النوق والأطلال بعض سمات الأدب القديم، فحسبوا أن وصف الناقة والطلل حرام على المعاصرين، ونكسة من الجديد إلى القديم حيث كان. |
| وسمعوا كذلك أن المديح تقليد لشعر الصنعة الذي ننعاه على الأقدمين فخيل إليهم أن المديح كله باب قديم لا يطرقه الشعراء المعاصرون. |
| وسمعوا أن الأقدمين أبدعوا في وصف الخيل بمئات القصائد فخيل إليهم أن الخيل لم توصف في شعر الأقدمين إلا لأنها أداة "مواصلات" أو أداة قتال، وأن الشعراء المعاصرين مسئولون أن يصفوا ما يقابلها من أدوات المواصلات والقتال عندهم، ومنها السيارات والطيارات والقذائف والصواريخ ! |
| وهذا جميعه ضلال عن معنى النقد في الأدب الحديث. |
| فالشاعر العصري يعاب على تغنيه بالناقة والطلل إذا كان غرامه بهما حكاية للأقدمين لا تتصل بشعوره وتجارب حياته. أما إن كان يغشي الصحراء ويركب الإبل ويقف على أطلال الهياكل فالتجديد العصري يدعوه إلى النظم في هذه الأغراض ولا يحرمها عليه. |
| والشاعر العصري يعاب على مديحه إذا كان يثني على الممدوح بما ليس فيه، وبما يعلم أنه ليس فيه، مستجديا رفده، مغالطا نفسه وقومه. ولكنه إذا أحس الإعجاب برجل عظيم فصدق في الإعراب عن إحساسه بعظمته فهو أجدُّ المجددين. |
| والخيل لم توصف قديما لأنها وسيلة سفر أو قتال بل وصفت لما بين حياتها وحياة الفرسان من التجاوب والتلازم في السفر والمقام والسلم والحرب، وهي عصرية في زماننا هذا كما كانت عصرية في زمان امرئ القيس. وقد يكون وصفها أولى بالشاعر المعاصر من وصف الطيارة على أحدث طراز. |
| وقد تعدد نعي العقاد على أولئك النقاد الذين يقلدون المجددين في مواضع أخرى من كتاباته، وعدَّ صنيعهم من باب "التقليد في نقد التقليد". |
| (4) عرض العقاد في هذه المقدمة لقضية من أهم القضايا التي شغل بها النقد الحديث، فقد ذهب بعض الناقدين إلى أن الشعر تعبير عن العاطفة والشعور والوجدان، وأن الكلم المنظوم لا يكون شعراً إلا إذا عبر صاحبه عن مشاعره وأحاسيسه، وأنه يكون أبعد عن الشعر بمقدار ما يكون فيه من المعاني العقلية التي هي من آثار التدبر وإعمال الفكر. |
| ونجد لهذا القول أصلا في القديم، نجده في كلمة أبي العلاء المشهورة التي فصل فيها بين الشعر وعمل العقل، وقصر فيها الشعر على أبي عبادة البحتري ووصف بالحكمة أبا تمام وأبا الطيب في قوله "المتنبي وأبو تمام حكيمان وإنما الشاعر البحتري" ! |
| وقد قلنا إن التسليم المطلق بتلك النظرية يفضي بنا إلى الحكم على أكثر شعر أبي العلاء نفسه بأنه ليس شعراً، لأن الحكمة التي هي أثر العقل ونتاج الحس وثمرة التجربة أبرز صفات شعر المعري
(6)
.. |
| ومن الطبيعي أن يتصدى العقاد لهذا الرأي، فقد عرف في عالم الأدب بأنه من رجال الفكرة، وأن أسلوبه في الكتابة ونظم الشعر أسلوب علمي تشيع فيه آثار المنطق والمعرفة حتى زعم بعضهم أن أسلوب العقاد "معقد" ! يقول العقاد: من الكلمات التي لا تلاك ولا تفهم قول القائلين إن الشعر "وجدان" وإن الشاعر لا يتأمل ولا يفكر، وإلا قيل في شعره إنه كلام لا يوحيه الوجدان ! |
| إن الإنسان الهمجي له وجدان وله شعور، ولكن وجدانه كوجدان الحيوان وشعوره لا يرتقي إلى طبقة التعبير الجميل أو غير الجميل. |
| والإنسان الصوفي له وجدان وشعور، ولكنه إذا عبر عن وجدانه وشعوره دق تعبيره على عقول الكثير أو الأكثرين. |
| فليس شرط الوجدان أن يكون مقصوراً على أجهل الناس وأعجزهم عن التفكير، لأننا لا نرادف بين معنى الجهل ومعنى الوجدان في اللغة، ولا في مصطلحات الفنون والعلوم. |
| والحقيقة أن الأدب الرفيع لم يخل قط من عنصر التفكير، وأن الشاهد على ذلك أدب الفحول من شعراء الأمم العالميين، ومنهم أمثال شكسبير وجيتي والخيام وأبي الطيب.. ونخص الشعراء بالذكر لأن صدق هذه الملاحظة عليهم يجعلها أقمن بالصدق على الأدباء الناثرين. |
| ومن الحقائق أن نقص التفكير ليس بزيادة في الحسّ والوجدان، وأن زيادة الفكر لا تمنع الإنسان أن يحس وأن يتسع وجدانه لأوسع آفاق الحياة.. |
| فقد ينقص فكر الإنسان حسه على السواء. ومزية الإنسان دائماً أن يحس حين يفكر، وأن يفكر حين يحس، وأن يكون نصيبه من الإنسانية على قدر نصيبه من الفكر والإحساس، فليس هو بإنسان كامل إذا خلا من التفكير ولا يكون الأدب كاملاً حين يعبر عن إنسان ناقص في ألزم مزاياه. |
| قول واحد يجمل جميع الأقوال في الفن والأدب، وهو أن الفن والأدب وجدان، ولكنه وجدان إنسان، ولن يكمل الإنسان بغير ارتفاع في طبقة الحس، وارتفاع طبقة التفكير، ولن يخلو الأدب المعبر عنه من هذا وذاك، ولا يقاس نصيبه من الحس بمقدار نقصه في التفكير، ولا يقال إنه أحس تماماً لأنه لم يفكر تماماً، بل يقال إن التمام في مزاياه الإنسانية أن يتم له الحس ويتم له التفكير. |
| * * * |
| بين القديم والجديد |
|
|
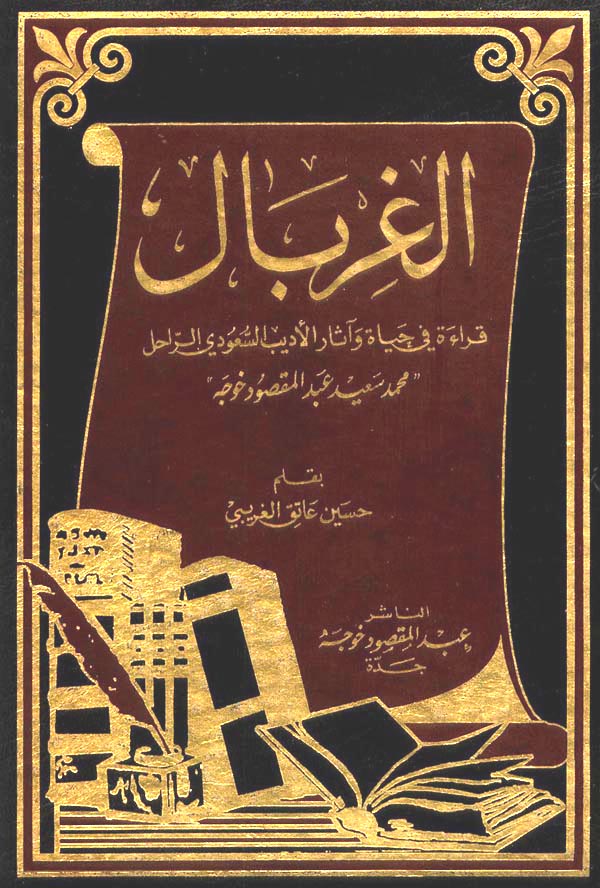
 شارع عبد المقصود خوجة
شارع عبد المقصود خوجة 00966-12-6982222 - تحويلة 250
00966-12-6982222 - تحويلة 250