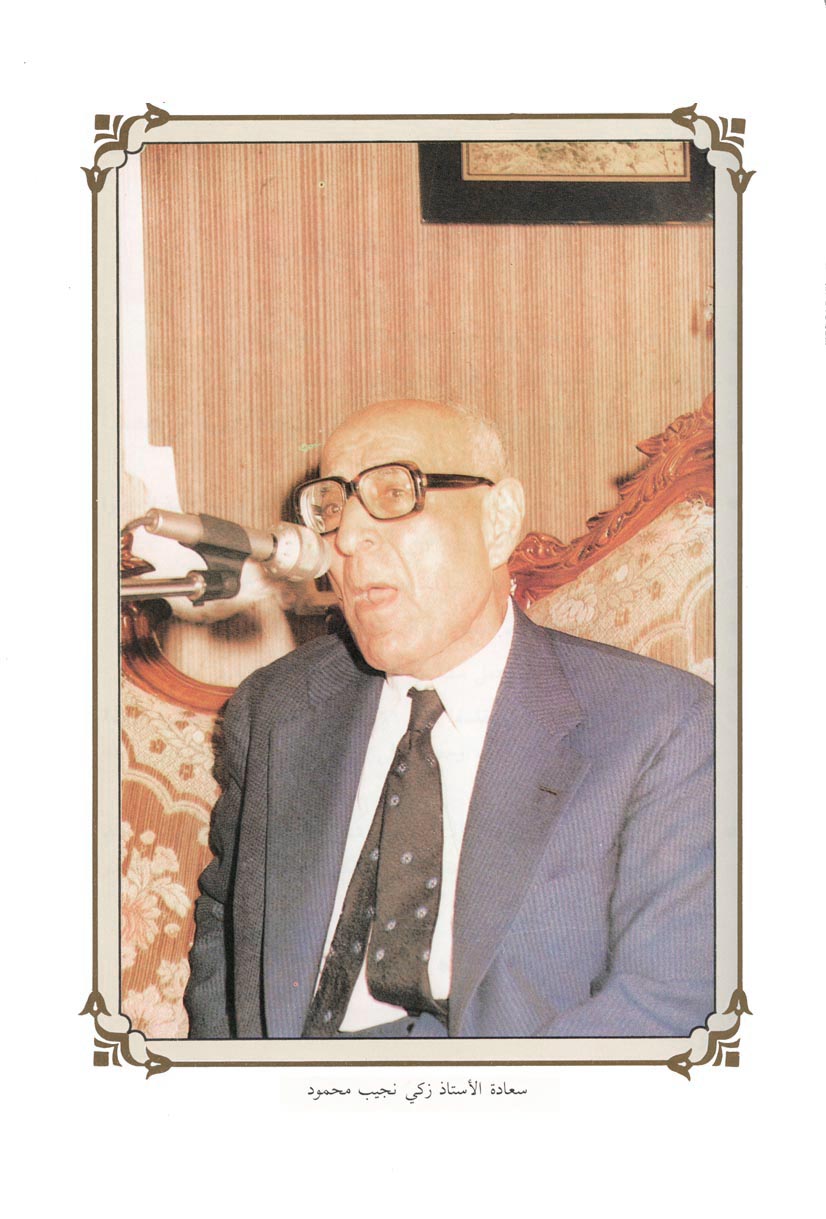|
بمناسبة اختيار مكة المكرمة العاصمة الثقافية الإسلامية.
|
| اثنينية عبد المقصود خوجه تصدر مجموعة الأعمال الكاملة للرواد
(1)
|
|
متابعة: تركي إبراهيم الماضي |
|
| أصدرت اثنينية
عبد المقصود خوجه الأعمال الكاملة للرواد في مجال الفكر والثقافة والأدب، ويأتي هذا الإصدار تزامناً مع مناسبة اختيار مكة المكرمة العاصمة الثقافية الإسلامية لعام 1426 ـ 2005م وذلك لكل من الأديب الأستاذ إبراهيم أمين فودة والأديب الأستاذ محمد حسين زيدان والأديب الأستاذ عزيز ضياء والدكتور عاصم حمدان علي والأديب الأستاذ عبد الله عبد الرحمن الجفري، وتحدث الأستاذ عبد المقصود خوجه عن هذه الإصدارات وقال: مجموعة من إصدارات (كتاب الاثنينية) هي حصاد ثلاث سنوات من الجهود المتواصلة لجمع مواد هذه الكتب، بدءاً بإعلان في معظم الصحف عن المشروع الذي واكب اختيار مكة المكرمة عاصمة للثقافة الإسلامية، فكان للاثنينية ما يجب عليها تجاه جانب من تراثنا الثقافي المعاصر الذي كان من إرهاصاته الأولى كتاب (وحي الصحراء) الذي صدر عام 1355هـ للوالد الأستاذ محمد سعيد خوجه ومعالي الشيخ عبد الله بلخير رحمهما الله.. وانطلاقاً من تلك المبادرة نمت فكرة هذه الإصدارات بهدف جمع الأعمال الكاملة. |
| الأعمال الكاملة للأديب الأستاذ إبراهيم أمين فودة |
| الأعمال الكاملة للأديب الأستاذ إبراهيم أمين فودة ـ رحمه الله ـ والتي يأتي معظمها في رياض الشعر، فقد تتلمذ على يدي والده فضيلة الشيخ أمين فودة، قاضي قضاة مكة المكرمة، كما تتلمذ لاحقاً على المستوى العملي والإداري على معالي الشيخ محمد سرور الصبان، وأحسب أن هذه التربية الصارمة قد جعلت الفودة ينظر إلى الشعر بشيء من الحذر رغم أنه بدأ قرضه في بواكير شبابه، إلا أنه لم يسع بشكل من الأشكال إلى تبوؤ مكانة مرموقة في عالم الشعر، بل ترك الأمور على أعنتها، ونشر دواوينه الخمسة تباعاً بعد أن حذف منها ما أعتقد أنه لا يناسب منهجه في الحياة، وذلك في إطار نقد ذاتي قبل أن يدفع بها إلى المطبعة حيث تصير ملكاً للقارئ وليست في يد المبدع. |
| وقبل التوغل في مسيرة الشاعر الكبير ـ رحمه الله ـ لا بد من الإشارة بكثير من التقدير إلى القراءات النقدية التي قدمها الأساتذة الأفاضل محمد حسن عواد، وضياء الدين رجب، وحسن عبد الله القرشي ـ رحمهم الله ـ في سياق هذه الأعمال الكاملة، فهي تشكل جزءاً لا يتجزأ من المرحلة والبيئة الثقافية السائدة في ذلك الوقت، وترسم المعايير المرتبطة بالكلمة وفنون إبداعها بعيداً عن التحيز لجهة ما غير الأصالة وحب الإبداع وتكريس الجهود لتقديم ما يبقى ثابتاً ويواجه عوامل الزمن وإرهاصات التجديد على دعائم راسخة من القوة والتمكين. |
| الرؤية النقدية |
| إن هذه الرؤية النقدية لم تكن تجاوز عقلية المبدع، كما أنها لم تنل من مقدرته على الانطلاق نحو آفاق أرحب في رسم الصور والأخيلة الفريدة والأنماط المبتكرة للتعبير عن الذات من خلال تجارب حية تنداح دوائرها وتتكشف أستارها ضمن أغراض الشعر المختلفة من وطنيات، ومديح، ورثاء، وغزل، ووجدانيات وإخوانيات، كان الشاعر يتنقَّل بينها بكل سلاسة وبلغة ميسرة بعيدة عن الغريب والمبتذل، مع محاولاته المستمرة لشرح ما يعتقد أنه يفوق فهم وأدارك القارئ العادي.. واضعاً نصب عينيه أن المبدع ينبغي أن يقود المجتمع نحو الرقي في استخدام اللغة بدلاً من الهبوط إلى مستوى العامة والسوقة في التداول اليومي للغة.. وبما أن تربيته وبيئته حتمت عليه التعامل باللغة العربية الفصحى بصورة يومية في معاملاته داخل أسرته ونطاق عمله، فلم يجد صعوبة في التعبير عن مكنون ذاته شعراً أو نثراً وكأنه ينجز خطاباً طبيعياً بين ذويه ومعارفه وأصدقائه. |
| الطبيعة |
| ومن ناحية أخرى قد يرى البعض أن الشاعر الكبير ـ رحمه الله ـ كان صاحب شطحات فيما يتعلق بوصف الطبيعة والميل نحو مدارس بعينها ـ مدرسة المهجر ـ على وجه الخصوص، في الوقت الذي تنأى فيه طبيعة مكة المكرمة التي ورد فيها قول الحق سبحانه وتعالى: بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ (سورة إبراهيم: 37)، عن كل ما يمت بصلة إلى المروج الخضر، والروابي السندسية، والخمائل وخرير المياه. وغيرها من سمات الجغرافيا التي اخترعها الشاعر وصورها بعيداً عن بيئته الحقيقية.. فالشاعر إنسان عاطفي، رقيق الشعور، جامح الخيال بطبعه، وعليه فإن مقدرته على تصوير الأمر وفق انفعالاته الخاصة لا ينبغي أن تثير الاستغراب لأنه ليس محققاً للتراث أو مصوراً فوتوغرافياً يتوخى الاحتراف بعدم تجاوز الواقع بحال من الأحوال. |
| كما تضم هذه الأعمال الكاملة جانباً مهماً يتعلق بصدى علاقات الشاعر بمحيطه الاجتماعي، وتعلقه بأفراد أسرته وصداقاته العميقة، لذلك كانت المناسبات ذات إطلالة مميزة في كثير من قصائده، واستطاع أن يسجل لنا شعراً للكثير من الأحداث الخاصة أو العامة التي لها علاقة بتاريخ هذا الكيان الحبيب، ومما لا شك فيه أن ثقافته الواسعة وعمله كأول مدير للمديرية العامة للإذاعة والصحافة والنشر منحه موقعاً مميزاً لمتابعة الأحداث الجسام التي مرت بالأمة، خاصة قضاياها المصيرية ممثلة في قضية فلسطين، ومحاربة الاستعمار في كثير من الدول العربية والإسلامية ومن أهمها ثورة الجزائر، وحال الأمة الإسلامية بصفة عامة، مبدياً تعاطفه الطبيعي لما يجيش في صدور المواطنين والقادة في كل مكان. |
| الأحداث |
| ومع أن الشاعر لم يترك الكثير من الأحداث التي مرت به في حياته اليومية تمر مرور الكرام، حرص على تسجيلها شعراً ولو ببيت أو بيتين، إلا أن زفراته الحرى تسامت أيضاً مع مطولات معروفة مثل قصيدة (البردة) لإمام البوصيري، فجاراها على ذات الروي والقافية، وأضاف الكثير من الشعر الوجداني أثناء زياراته المتعددة إلى المدينة المنورة، على ساكنها أفضل الصلاة وأزكى التسليم، فكانت وقفات مترعة بالمشاعر التي تهز الوجدان وتسطر تلك الرحلات الخالدات في صحائف النور. |
| العلاقات الإنسانية |
| وقد تجلت أقوى أواصر العلاقات الإنسانية في قصائد الرثاء التي سكب من خلالها أروع معاني الوفاء لمن فارقهم بقلب تملؤه اللوعة، وتجاذبه العواطف، ونوازع الخوف والرجاء، فكانت قطعاً من فلذات الكبد الحرى تتقلب على الورق وكأنها تتنفس الحزن رغم مرور السنوات، ذلك أن العاطفة المترعة التي غذتها كانت صادقة كل الصدق، بعيدة عن دنس الدنيا ومطايا النفوس الضيقة.. إنها الوداع الأبدي، الذي يطوي في طريقه كل شيء، ولا يبقى إلا العمل الحسن والذكرى العطرة بين الجوانح. |
| الحب الخالد |
| ثم يأتي الحب الخالد الذي نشره على الملأ، ذلك الحب الذي جعله مظلته في الورى، وسار به بين الناس، حب بعيد عن سفاسف الأمور وصغائر النفوس، فكان الشاعر كبيراً بعاطفته الجياشة، مليئاً بأغلى ما يملكه كل إنسان تجاه الآخر، وهو الحب أيضاً سواء على نطاق العاطفة التي تربط المحب بمن أحب، أو على نطاق الحب السرمدي الذي يمد الإنسان بفلسفة الكون ووشائج العلاقة غير المحدودة مع كل الكائنات والمخلوقات في كل زمان ومكان. |
| النثر |
| ويجد القارئ الكريم (النثر) الذي سجله الأديب الكبير الأستاذ إبراهيم أمين فودة في الجزء الرابع، وهو أصغر جزء في المجموعة، إلا أنه يحتوي الكثير من الرؤى المتقدمة التي تناولها بكثير من الشفافية والتفصيل.. في وقت كانت هوامش البحث والتحليل محوطة بما لا يخفى على أحد من المحاذير والخطوط الحمراء، ومن جملة ما تحدث عنه التعليم والرياضة، فقد كان مولعاً بكليهما.. ووهبهما الكثير من وقته وجهده ورعايته، فغرس طيباً، وجنى خيراً في حياته وغنم ذكرى باقية بعد مماته. |
| هنالك ثلة من المفكرين والكتاب والشعراء لا تكتمل (بانوراما) الكتابة عندهم إلا من خلال النسيج الاجتماعي، والثقافي، وربما السياسي والاقتصادي، الذي عاشوا فيه مما شكل خلفيتهم الثقافية ودفعهم إلى الإبداع متأثرين ومؤثرين في الوسط الذي درجوا على أرضه، واستظلوا بسمائه، وتنفسوا أريج هوائه، وامتزجت أرواحهم بعبق تاريخه. |
| من هؤلاء الرواد الأستاذ الكبير عزيز ضياء زاهد مراد، الذي اشتهر أدبياً واجتماعياً باسم عزيز ضياء ـ رحمه الله ـ وقد ولد في المدينة المنورة عام 1332هـ فهو من جيل عمالقة المبدعين الذين شكلوا الرعيل الأول من رجالات النهضة الأدبية في المملكة العربية السعودية مثل: عبد الله بلخير، محمد حسن عواد، حمزة شحاتة، أحمد السباعي، محمد سعيد عبد المقصود خوجه، طاهر زمخشري، حسين سرحان، عبد العزيز الرفاعي، ضياء الدين رجب، محمد سعيد العامودي، عبد القدوس الأنصاري، محمد حسين زيدان، أحمد عبد الغفور عطار، أحمد قنديل، أحمد إبراهيم الغزاوي، الحافظان ـ علي وعثمان حافظ ـ وعبيد مدني، ومحمد العربي، حمد الجاسر، عبد السلام الساسي، الجمالان ـ أحمد ومحمد صالح جمال ـ وحسين عرب، وأبو تراب الظاهري، وعبد العزيز الربيع، وغيرهم من الأسماء التي لمعت في سماء الأدب والثقافة خلال مرحلة التأسيس التي قيض الله لها عدداً من النجوم الزواهر الذين شيدوا الخطاب الثقافي والفكري بكثير من الصبر والجلد في وقت كانت الإمكانات شحيحة، والتواصل مع العالم الخارجي يعتمد على البريد السطحي والبحري، والطرق معدومة أو في أحسن الأحوال في حالة مزرية، ونوافذ الإعلام تقتصر على الإذاعة بالإضافة إلى بعض الصحف التي تصل لماماً عبر الحدود، كانت تحيط بهؤلاء الأساتذة الكبار بيئة نمطية طاردة في معطياتها الاقتصادية والأدبية، إلا أنها كانت في ذات الوقت ذات روافد أراها المولى عز وجل ترياقاً لكل السلبيات التي أشرت إليها، فكان الحج يمثل الإكسير الذي شد أزر حركة التنوير أثناء تكوينها وجعلها مشروعاً قابلاً للنمو والتطور وفق آليات ابتكرها بعض هؤلاء الرواد. |
| عشق الحرف |
| عاش عزيز ضياء في هذه الأجواء مع زملائه ومحبيه متطلعين دائماً نحو الأفضل.. فعشق الحرف منذ بواكير حياته، وأصبح ميالاً للعمل في مجال الإعلام فكان يكتب في الإذاعة معلقاً سياسياً يومياً لأكثر من عشر سنوات، كما كان عضواً في المجلس الأعلى لرعاية العلوم والآداب، التابع لوزارة المعارف ـ آنذاك ـ وقد كان برئاسة الأستاذ الكبير عبد الله بن إدريس، غير أن المجلس برمته لم يستمر طويلاً وطويت صفحته إلى يومنا هذا.. وضمن تحيزه للحرف وحبه للكلمة تولى الأستاذ عزيز ضياء رئاسة تحرير جريدة (عكاظ) خلال الفترة من 18/1/1381هـ ـ 21/10/1381هـ وهذا أول عدد صدر منها بالتعاون مع صاحب امتيازها الأستاذ أحمد عبد الغفور عطار ـ رحمه الله ـ وعمل رئيساً لتحرير جريدة (المدينة المنورة) لفترة قصيرة.. كما ترجم عدداً من القصص والروايات بالإضافة إلى مؤلفاته الخاصة وأحسب من أهمها (حمزة شحاتة قمة عرفت ولم تكتشف) وكتابه الشهير (حياتي مع الجوع والحب والحرب) الذي صاغ من خلالها سيرته الذاتية المنطوية على كثير من معاني الكفاح وبناء الذات، ولم تأت هذه القصة من فراغ بل ارتكزت على محاور أكسبتها صلابة من قوة شكيمة كاتبها الكبير.. فقد تلقى تعليمه الأولي في المدرسة الراقية الهاشمية بعد الكتَّاب، ثم التحق بمدرسة الصحة التي درس بها بعض علوم التمريض عام 1345هـ لكنه لم يكمل المشوار، كما تقطعت به سبل الاستمرار في التعليم بكل من مصر ولبنان.. ثم عمل ـ رحمه الله ـ في عدة مواقع منذ شبابه المبكر حيث عمل مقيد أوراق في مديرية الصحة العامة، ثم في قلم مدير الأمن العام متدرجاً إلى رئاسة قسم التنفيذ.. ثم التحق بوزارة الدفاع مساعداً للسكرتير الأول، ثم مديراً عاماً للخطوط الجوية العربية السعودية، ثم انتقل للعمل في مجال الكلمة مذيعاً في بعض إذاعات الهند لمدة عامين، وبعد عودته إلى المملكة عمل مديراً لمكتب مراقبة الأجانب بمكة المكرمة، ثم أصبح وكيلاً للأمن العام للمباحث ومديراً عاماً للجوازات والجنسية، ثم اتجه للعمل في مجال الأعمال الحرة فأنشأ مؤسسة الشرق الأوسط للإعلان والثقافة والنشر. |
| الأعمال الكاملة للأديب الأستاذ محمد حسين زيدان |
| مهما عصفت رياح الصمت فإنها لن تتمكن من إطفاء جذوة كلماته المتفردة، فللأستاذ أسلوبه الخاص الذي دمغ به الأيام، تناقلته الألسن، ودارت به المطابع، إنه من الرجال الذين يضن بهم الزمان حتى تحسبهم ممن قال فيهم عبد الرحمن الكواكبي (ما بال هذا الزمان يضن علينا برجال يعلمون الناس، ويزيلون الالتباس).. إنه الشيخ والأديب الكبير، الغائب الحاضر، الأستاذ محمد حسين زيدان ـ رحمه الله ـ أستاذ الأجيال الذي تخرج على يديه من نعدهم بكل إعزاز واعتزاز أساتذة ورواداً نفخر بعطائهم، ومنهم على سبيل المثال الأستاذ الأديب عبد الله الجفري، الذي يضع الزيدان في قمة لا تدانيها قمم بتسميته (والده الروحي)، وبطبيعة الحال فإن مكانة الأستاذ، الذي هو بمثابة الوالد والمربي والموجه لبعض تلاميذه، تحلق عالياً فوق ذرى الإبداع التي أنسناها من الأستاذ الجفري، وهو الذي أثرى ساحتنا الثقافية والأدبية بعطائه الكبير وإسهامه المشكور في النهضة الأدبية والصحافية التي تجاوزت حدود الوطن لتمتد عن جدارة إلى كثير من الدول العربية فتكون له الصدارة على مستوى الخليج العربي ومنارات الإشعاع في بعض العواصم العربية.. ومن تلامذته الذين يشار إليهم بالبنان الأديب والكاتب المعروف الأستاذ عبد الله الماجد الذي يصف الأستاذ الكبير بـ(شيخي وشيخ الكتاب في عصرنا)، وبهذه الخصوصية في العلاقة بين الأستاذ ومحبيه التي يفخر كثير منهم بأنها تصل إلى مصاف الألق التربوي والعاطفي الذي يربط بين الوالد وأبنائه، فعندما قال الأستاذ عبد الله الماجد من خلال حوار دار بينهما (يا ولدي) لم تمر العبارة مرور الكرام عند تلميذه النجيب، بل حفرت أخدوداً عميقاً في ذاته فتمترس خلفها ليشير إلى (هذا النحو النادر المتأطر بهذه الخصوصية العذبة، كنت محظوظاً بهذه البنوّة، حيث كنت أبحر في أعماق هذا البحر ألامس صدفاته، وأفتحها وأحتوي داناته المتلالئة، وأعود إلى شاطئه فأستريح على ثرائه). |
| الزيدان زوربا القرن العشرين |
| ثم نظر الأستاذ الجفري إلى مكونات شخصية أستاذه، ووالده الروحي، فصنف عنه كتاباً بعنوان (الزيدان.. زوربا القرن العشرين) من إصدارات مؤسسة عكاظ للصحافة والنشر محرم 1413هـ يوليو 1992م.. إن هذا الانتقاء الحصيف لعنوان الكتاب لم يأت من فراغ.. فقد نبع من عمق إدراك الكاتب الفذ لشخصية الأستاذ المعلم الذي تتماهى شخصيته مع (زوربا) (العجوز، العميق، الفياض بالحيوية.. ما أجمل الصورة القلمية التي لا تحفل باللحظات بل تمتد حزمة ضوء أبدية نحو اللانهاية فتعبر المدى ليعزف التلميذ الوفي لحن أستاذه.. ذلك هو الزيدان الذي (كانت مودته للكلمة.. هي: وله يسمو بالمعاني في نفسه.. فلا يجعل الملل ينتصر على وقته.. ولا يجعل الغرض يهزم معانيه. إن ولهه بالكلمة: عطاء جزل لحياته على امتدادها.. لتطلعاته، فقد بقي ـ في شيخوخته ـ شاباً بروحه، وبعزيمته، وبفكرته، وبرؤيته للغد.. يكتسح خريف العمر بالحب). |
| لم يكن الأستاذ زيدان ـ رحمه الله ـ أديباً فحسب، بل كان أقرب إلى الفيلسوف والحكيم والمفكر الذي يعمل فكره الثاقب في كل فكرة يصوغ منها موضوعاً ذا دلالات تمس صميم الحياة، وتتفاعل مع واقع الحال سواء داخل أو خارج الوطن، فهو مثقف أصيل يسعى باستمرار إلى تقليب كل خبر والقراءة بين السطور وفوقها وتحتها وربط الأحداث وتجارب الماضي واستشراف المستقبل ليقول في النهاية كلمته مدعمة بكثير من الحجج والبراهين مما يجعل خطابه وكتاباته نوعاً من التاريخ الأمين والتحليل المنطقي العميق، ويصوغ كل ذلك في قالب أدبي مميز ولغة رصينة يتخير مفرداتها ومعانيها بدقة متناهية، حتى تحسبه يزن الحروف والكلمات بميزان يعدل إن لم يفق معيارياً ميزان الذهب والأحجار الكريمة. |
| لقد كان الأديب الكبير موسوعياً في علمه وسعة أفقه وتنوع مصادره، فهو ضليع في الأنساب ومعرفة القبائل ومضاربها قديماً وحديثاً ـ وإن كان لا يميل إلى التوسع في هذا الجانب ـ كما أنه خبير في علم الفلك، راسخ القدم في دراسات الشعر العربي قديمه وحديثه، عالم ببواطن التاريخ الإسلامي والغربي، مطلع على كل ما يستجد من أحداث سياسية في كل أصقاع العالم، وله موهبة نادرة في تحليلها وربطها بمختلف القضايا التي تثار في أكثر من نقطة ساخنة حول العالم، ويبدي رأيه بكل جرأة في كثير من القضايا الخلافية، ولكن بعد أن يدعمه بأفكار لماحة، وذكاء حاد، وقالب لغوي أنيق. |
| وهو في كل ألقه ومكانته السامقة في قلب محبيه ذو تواضع جم، سئل ذات لقاء صحفي أن يعرِّف نفسه فقال: (طالب معرفة يحب كل الناس، ولا يكره أحداً.. وما نام ليلة وهو حاقد على أحد).. بهذه الروح الشفافة شق أستاذنا الكبير ـ رحمه الله ـ طريقه بين الناس، كان الحب ديدنه وبوصلته التي يتواصل من خلالها مع من حوله، سعى لخدمة من يعرف ومن لا يعرف، وضن بخطه الجميل حتى على كتابة مقالاته الممتلئة بمقومات الإبداع، ولكن لم يضن به قط عن كتابة توصية إثر أخرى لمساعدة من يتوسمون فيه الخير، وكثيراً ما تكبد المشاق حتى أثناء توعكه ليتابع بنفسه مصالح بعض من يلقون بثقل همومهم على ساحته، فغرس من الحب ما أزهر وأينع وحصده إبان مسيرة حياته، وعند وداعه في مثواه الأخير. |
| الأعمال الكاملة للأديب الدكتور عاصم حمدان علي |
| يتحدث الأستاذ عبد المقصود محمد سعيد خوجه عن الأعمال الكاملة للأديب الدكتور عاصم حمدان علي ويقول: إذا كان حب المكان بالمكين، فإن مكة المكرمة والمدينة المنورة تحظيان بحب ملايين القلوب التي تهفو إليهما من كل حدب وصوب.. غير أن هناك فئة من الناس اختصها الحق سبحانه وتعالى بقوة التعبير عن مكنون أنفسها، شعراً أو نثراً، دون عناء البحث عن الشوارد ووعثاء تكلف الخواطر، ومن الناس من لا يرضى بغير (المجاورة) تعبيراً حسياً عن حبه للالتصاق بالأرض التي يسري عشقها في عروقه.. وقد خبرت أصنافاً من البشر ممن هاموا حباً بالحرمين الشريفين، إلا أن معرفتي بالأستاذ الدكتور عاصم حمدان جعلتني أقف على أنموذج فريد في حب (المدينة المنورة) على ساكنها أفضل الصلاة وأتم التسليم. |
| إن تفصيل ما أجملت عن ذلك الحب الكبير يستدعي الغوص في الأعمال الكاملة للأستاذ الدكتور عاصم حمدان علي التي أشرف بنشرها في المجموعة التي بين أيديكم، ضمن سلسلة (كتاب الاثنينية).. فكاتبنا المعروف، عاشق تراث المدينة المنورة، أكاديمي جاد (أستاذ النقد الأدبي بجامعة الملك عبد العزيز بجدة) وأديب ذائع الصيت، وصحفي مطبوع، وظف مواهبه المتعددة لخدمة مدينة رسول الله ـ (صلى الله عليه وسلم) ـ.. والمتتبع لأعماله يجد أنها نابعة من قلب مفعم بذلك الحب الخالد الذي يعمر فؤاده ويفيض على جوارحه، فهو صاحب عبارة مشرقة، وأسلوب سلس في التعبير عن ذاته مما يمكنه من الوصول إلى المتلقي عبر أقرب نقطتين، إذ ليس بين القلب والقلب رسول كما يقال، وهل منا إلا ذلك المشوق الذي يقبل أرضاً وطأتها أقدام الحبيب ـ صلى الله عليه وسلم ـ. |
| الأسلوب التحليلي |
| ولا يقف كاتبنا الكبير عند حدود العرض الفكري والتناول الأكاديمي لكثير من الظواهر الأدبية والاجتماعية، بل نجده دائماً يسعى لإعمال الأسلوب التحليلي والمنطقي لسبر غور أي ظاهرة، والخروج بجواهر الفكر من لجج العواطف التي قد لا تحمل أكثر من رسم لواقع الحال، غير أن التحليل العميق وفق معايير أكاديمية صارمة يمثل عبقرية الأداء التي تستقرئ كل حالة، وتشخص المرض، لتسهم في العبور نحو بر الأمان، وتسعى لتشكيل قاعدة بيانات قد تساعد صانع القرار أو من بيده الحل والعقد على ترتيب الأمور بموجب قراءة هادئة توضح أبعاد أي ظاهرة أو أزمة اجتماعية تمس الاستقرار والأمن والأمان. |
| بالإضافة إلى ذلك شارك أستاذنا الكبير بعدد من المؤلفات القيمة التي أرخت للمجتمع المدني ورسمت من تاريخ المدينة المنورة لوحات ذات ألق وعبق نادرين، حتى يخيل للقارئ أنه يسعى بين أزقة وحواري تلك الأحياء التي تتنفس الحب، وينظر إلى أسطح المنازل المتقاربة في سكون الليل وهدأة السحر، ويجالس سكانها ويسمع حواراتهم الهادئة.. إنها أنفاس مقتبسة من عمق أصالة وطيب الناس الذين طيبتهم طيبة الطيبة، فكانوا وما زالوا عنواناً للآداب الإسلامية السامية. |
| إن الأستاذ الدكتور عاصم حمدان يتمتع بمقدرة فائقة على توصيل فكره للمتلقي سواء عن طرق مخاطبته مباشرة، أو بمقال صحفي، أو من خلال أجهزة الإعلام المختلفة، فهو في كل الأحوال متفرد ومميز بقوة المنطق، وحضور البديهة، وثراء المعلومة.. وهو مستمع جيد يستوعب بمقدرة فائقة كل المتغيرات ويحلل بهدوء ما يثار من شبهات، ثم يرسل الرد الشافي معتمداً على كنوز المعارف التي يختزنها في ذاكرته القوية أو بين محتويات مكتبته الخاصة، أو مصادر المعلومات التي يستطيع الوصول إليها في وقت وجيز. |
| هذا الحب الكبير الذي يحمله كاتبنا الأنيق بين جوانحه للأدب والثقافة دفعه لتعلم اللغة الإنجليزية في معقلها.. فنهل من معين الأدب المقارن، وتمثل ما درس وعلم، ثم أنجز بعض المؤلفات باللغة الإنجليزية إسهاماً مشكوراً في توسيع آفاق المعرفة الإنسانية وتطوير أساليب البحث العلمي. |
| الأعمال الكاملة للأديب الأستاذ عبد الله عبد الرحمن الجفري |
| يشير الأستاذ عبد المقصود خوجه في كلمته التي صدَّر بها مجموعة الأعمال الكاملة للأديب عبد الله الجفري إلى أن الأستاذ الجفري كبير في أدبه وخلقه ومعاناته وقال: يعلم الكثيرون أن الأستاذ عبد الله الجفري كبير في أدبه، وخلقه، ومعاناته.. حمل دهشة الكلمة وبهاءها وركض بهما في عرصات الحياة، اختلط عرقه النابض بوجدانه مع حبر قلمه فكانت هناك وشيجة قوية بين العرق الناتج والحبر النازف.. كلماته لا تنفك عن(معاناته) لذلك عندما توعك قلبه خلال فترات، وألزمه مراجعة المشافي، كنت أقول دائماً: إن القلب الكبير لم يتحمل زخات الألم التي يفرضها صدق العاطفة والتفاعل مع الكلمات.. غير أن من يطأ جمر الكلمات يجد لها لذة في صميم الوجدان، فيظل ضاغطاً عليها إذ فيه الروح والسلوى.. أو هكذا قدر الجفري.. وما زال (الوجار) ملاذه في كل حين. |
| لقد أبدع الجفري الكلمة بمختلف محاورها وطرق تناولها.. تعامل معها بمهنية الصحفي وإمكاناته الكبيرة وعلاقاته الواسعة.. وتناولها من منظور الأديب القاص، فكتب القصة وكأنه لم يفرغ لشأن سواها في حدقة الحرف.. ثم تناول الرواية فسكب فيها خلاصة فنه فخرج بها من المحلية إلى الإقليمية، بل شارفت تخوم العالمية.. وكل ذلك تحت مظلة الأدب الرفيع، والكلمة التي لا تخدش الحياء، ولا تلامس الخطوط الحمراء ذلك أن العمل الأدبي عند الجفري فن لا يجوز التعدي على جمالياته بتشويهها عمداً أو سهواً.. ظلت الكلمة تمثل بالنسبة إليه أرجوحة تهدهد كيانه قبل أن يطلقها حمامات محبة وسلام وأمن وطمأنينة. |
| عُرف الجفري بأسلوبه الخاص الذي يميل إلى (الرومانسية) ووجد تجاوباً لدى شريحة كبيرة من المتلقين.. ولا سيما أن كاتبنا الكبير قد أطل على محبيه من خلال بعض أشهر الصحف العربية، فأتاح له مقعده في مقدمة (الآلة الإعلامية) مكاناً مميزاً استطاع من خلاله أن يرسخ معالم مدرسته ويرسم ملامحها بتؤدة وهدوء شديدين.. فكان له ما أراد من شفافية لامست قلوب معظم القراء في وقت ظن الكثيرون أن (الرومانسية) كأسلوب كتابي قد انقرضت منذ منتصف القرن الميلادي المنصرم..وربما بقي منها هامش ضعيف يرتاده شداة الأدب وطلاب المدارس.. إلا أن الأيام أثبتت غير ذلك، وبدا واضحاً النهم الشديد والحرص الكبير الذي يتابع به المتلقون كتابات الجفري.. فالمادة التي سيطرت على هذا العصر (الطباشيري) لم تقتل بعد كل الزهور البرية التي يمكن أن يضوع أريجها إذا وجدت اليد الحانية التي تتعامل معها من منطلق (الحب) وتعرف كيف تنتشلها من وهدة (الأنا) إلى قمة الإبداع الذي يتلاشى في الآخر.. ويسطر معه أروع أناشيد الحياة. |
| لقد عمل الجفري طويلاً.. طويلاً.. وبجهود مضنية لكي يصل صوته وصهيل كلماته وصدى حنجرته الخاصة إلى كل الناس.. إن الصباح لم يدرك الجفري ليسكت عن الكلام المباح.. فأرخى عنان (وجده) لتتحد كلماته مع آمال وتطلعات المرأة على امتداد حرف الضاد.. كانت المرأة ولم تزل: أما وشقيقة، وزوجة، وابنة، وملهمة، محور الكثير من كتاباته وروائعه التي شكلت جانباً مهماً من قاعدته العريضة وسط مجتمع القراء والمثقفين.. وقد استطاع أن يحرك بحيرة الإبداع حاملاً في إحدى يديه قوس قزح، وفي الأخرى قلماً يستطيع أن يردع به بعض الأفكار الهلامية والظلامية التي تحاول بين الفينة والأخرى النيل من مشروعه الثقافي والأدبي.. وإن كنت أحسبه لا يأبه كثيراً لمن يغمزون في الظلام، أو الراقصين على السلالم. |
| لقد حازت الأعمال الأدبية للأستاذ الجفري على إعجاب المتلقين في وقت صدورها وتلقفوها من بين صفحات الجرائد والمجلات، واحتفظ البعض منهم بأعداد مما تضمن نشره في حلقات.. وفي ذلك عبء واضح على كاهل المتلقي الذي تتنافس على وقته كثير من القنوات الإعلامية والفضائية ذات الوهج والوميض الذي قد يخلب اللب بغض النظر عن فحواه ومحتواه، ثم أتت هذه الأعمال الكاملة بتعاون مشكور من أديبنا الكبير لتجعل التواصل مع هذا الفن الأصيل ميسوراً بغير انقطاع.. كما يمنح الدارس والناقد مضماراً فسيحاً لتناولها بالبحث والتحليل والتشريح وفق منظور كل مهتم بالشأن الثقافي والفكري من خلال قراءة هذه الأعمال. |
| النهر |
| إن الوشل لا يغني عن النهر.. فنحن إزاء أديب كبير لم تهزه الرياح ولم يغيره المديح والثناء أو الجحود والنكران.. ظل صامداً في وجه تغيرات الزمان، رفيقه كتاب، وأهزوجة حب يترنم بها مع ابتسامة صافية في كل مكان وزمان.. ومهما قيل عنه يبقى أعمق وأقوى وأصلب من صرير الأقلام وحفيف الكلمات.. إنه يحمل بين جوانحه عظمة الكاتب وعبقرية الفنان.. كسر طوق المحلية بتلمس أجمل ما فيها. ثم الإضافة إليه من إبداعاته المبهرة، وأعاد طرحه على العالم العربي، فكان التجاوب الكبير ـ من داخل المملكة أولاً ـ بما تشتمل عليه من لهجات وتعابير خاصة بكل منطقة بحيث يمكن الحكم على شخص بمجرد تناوله طرفاً من الحديث.. ثم دخل قوياً معتداً بنفسه وبانتمائه الوطني إلى معترك الساحة العربية الكبرى، فعرف الأستاذ عبد الله الجفري أديباً متمكناً في كثير من الدول العربية وغيرها من مواطن الاغتراب في أوروبا وأمريكا.. لقد ظل كاتبنا المبدع أميناً في أسلوبه المميز، لم يقلد أحداً، وأحسب أن أحداً لم يستطع مجاراته بذات الدقة والمهارة.. فكان فريداً في عطائه، غنياً بقاموسه، متفرداً بأفكاره، عفوياً في تناوله للقالب القصصي مما جعل (الجفري الصحفي) يكاد يختفي في إهاب (الجفري الأديب) أو القاص الروائي على وجه التحديد. |
| الكتاب |
| ثمة منعطف لا بد من التوقف عنده، ولا سيما في هذا العصر (الفضائي). فحب الأستاذ السيد عبد الله الجفري للكتاب طغى على كل ما سواه.. ظل يركض خلف الكتاب في كل مكان، لم يترك معرضاً للكتاب أو ملتقى يليق بقامته وقيمته إلا وكان السباق إليه مهما بعدت الشقة وشط المزار، ومن هذا الولع الكبير بالقراءة استمد موسوعته الثقافية التي لا تضاهى، وأصبحت الكتابة بالنسبة إليه نوعاً من المشاركة التفاعلية مع مخزونه الفكري الثقافي، كما أنه كثيراً ما يرفد القارئ بمعارف جيدة تضيف إلى حصيلته معلومة إن لم تكن بالجديدة فإنها لا تخلو من طرافة أو تذكير بما لا تحتفظ به الذاكرة، فهو دائم الرجوع إلى مكتبته ومصادره الخاصة. |
| والجدير بالذكر أن مدرسة (الرومانسية) التي أثرت بشكل أو آخر على إبداعات كاتبنا الكبير لم تحتكر تفكيره على الإطلاق.. بل مارس وبشفافية كبيرة التعامل مع مشكلات مجتمعه بصورة يومية من خلال أعمدة الصحف التي لم تضن عليه بنوافذها نحو القراء، كما لم يبخل عليها بقناديل النور ولحظات الإشراق الماتعة. |
| إن الجانب الحضاري الذي مثله كاتبنا المبدع كإضافة حقيقية لمنجزنا الثقافي والأدبي يستحق كل تقدير واحترام، فإذا اختلف الناس حول الأستاذ الجفري ما بين مؤيد ومعارض، فإن ذلك يمنحه بطاقة العبور إلى مصاف الكبار الذين يمثلون دائماً رقماً لا يمكن تجاوزه تجاهلاً أو استهانة.. ويبقى الفيصل في نهاية المطاف بأيدي جمهرة القراء من الجنسين على امتداد ربوع الضاد، باعتبارهم أصحاب المصلحة الحقيقية في الناتج الأدبي والفكري الذي يجد مكاناً في أوقاتهم المزدحمة. |
|
|
 شارع عبد المقصود خوجة
شارع عبد المقصود خوجة 00966-12-6982222 - تحويلة 250
00966-12-6982222 - تحويلة 250