| مرحلة الطفولة |
| لا أحسب أن مرحلة طفولة جسمي وكياني، وحتى عقلي: قد استغرقت وقتاً طويلاً.. بعد أن اختصر متعة طفولتي، وسلب عمري منها: فقدي لأمي في عامي الأول على انضمامي لقوافل أطفال البشر في تلك المرحلة، دون أن أعرف ملامح وجه أمي ولا شكلها... فلم يكن هناك (مصورون)، وإن وجدوا فإن التقاليد لم تكن تسمح للمرأة أن (تتصور)، وهكذا: حرمت أيضاً حتى من هذا الحق. |
| وبعد سنوات.. افتتح "مصور" استديو تصوير في محلة (القشاشية)، وكان من أصل تركي ينادونه: (عم شفيق الفنان المصوراتي)، ولكني بقيت أتعرف أو أتخيل ملامح وجه أمي من عمتي الصغرى التي تماثل أمي في العمر، رحمهما الله، وكانت تصف لي أمي وتسهب في تفاصيل قسمات وجهها، وشعرها الأسود الطويل، وقامتها الشامخة.. فكان ذلك الوصف هو: مبلغ تخيلي... وتمنيت لو منحني الله موهبة الرسم لأنقل وصف عمتي لوجه أمي وأجسدها (لوحة) تقرب لي الملامح (!!) فتصوروا طفلاً لا يعرف حتى وجه أمه؟! |
| إنه (الحرمان) الفظ من حنان الأمومة، والعطش إلى دفء الأمومة، والشعور بالوحدة إلى الآن كلما سمعت النداء الندي: يا أمي، ولا أطيق أن أكمل الاستماع إلى الأغنية الشهيرة: "ست الحبايب يا حبيبة"!! |
| وهكذا استقبلتني الحياة في عامي الأول: يتيم الأم، يتيم حنانها ودفئها وحمايتها... وتولّي (عماتي) واحدة وراء أخرى: تربيتي بإشراف والدي الذي بقي عازباً عدة سنوات كبرت فيها قليلاً دون أن أتخطى طفولتي بعد. |
| ولعل من أهم الكلمات التي ناجيت بها (أمي)، حين بلغت ذات ليلة ذروة الوحشة النفسية، فانسابت دمعة كففتها بهذه الكلمات: |
| يا أمي: |
| نداء واحد/متحدٍّ.. يضيء الكون.. يشكل هذه الروح/النعيم. |
| نداء.. يروي هذا الحب الذي يتفجر عيداً للفرح، ويكبر: خفقة قدسية في القلب، ويمحو الفاصل بين الأمل والرجاء. |
| يا أمي: |
| يصغر هذا العالم كله في غيابك، فيملأني إحساس اليتم من بعدك، حتى اليتم من الأمن النفسي... وتزغرد الشرايين في وجود (الأم).. هي دماء هذه الشرايين. |
| يا أمي: |
| نهاية العالم... يوم يفقد ابن أمه، فتجف أنهار الحنان، ويغيب الدفء في زمهرير الوحدة. |
| بداية العالم: مخاض ألم. |
| حين تلد... تفتح النوافذ على شمس الفرح... تشرع الأبواب لإنسان يملأ الدرب خطوات. |
| يا أمي: |
| أناديك من وراء سياج الأشواق، ومن خلف سجف الوحشة... وأنت في دار الحق. |
| أناديك من عمق وهاد الوحدة، ومن ضيق النفق... وأنا في دنيا الباطل. |
| ومن كل هذه الأبعاد لمأساوية الضجر... صارت الحياة: اعتيادية، فيا لهذا الصمت! |
| يا أمي: |
| روحك الطاهرة: تدفئ أعماقي... فأقوى بها على اختناق أنفاق الحياة. |
| في هواك الأول: أكبر يا أمي... معصوماً من الكراهية والبغضاء.. مبثوثاً -كالعطر يا أمي- في تهذيب النفوس الخيرة، كنفسك يا أمي. |
| لم أذرف على فراقك دمعة، حين جاء موتك وأنا أحبو، ولا أفقه... فكأن دموعي تأجلت لتصاحبني طوال عمر الوقوف، والمشي، والركض، والطموح.. حتى هدوء الشيخوخة. |
| يا أمي: |
| ما أجملك... جوهراً للحنان. |
| بك يا أمي... أقترب من الله عز وجل أكثر.. فالجنة تحت أقدام الأمهات! |
| بك يا أمي... يتبلور عندي إحساس التوهج كلما خطوت نحو الغد، حتى لو كان الموت بعد لحظة... ذلك أن أصداء دعائك: دفوف تزفني إلى الأمان والنجاح. |
| بك يا أمي... أسترجع حميمية النشوة بالحياة.. أرجع طفلاً أتقافز في مجانية الفرح، حتى يحتويني حضنك من جديد! |
| * * * |
| هكذا شعرت بمرارة (اليتم) مرتين: عندما كنت طفلاً أنمو، وعندما كبرت وداهمتني شئون الحياة وهمومها، ولكنها لم تكن طفولة منعمة مترفة، فوالدي (موظف) كان يعمل أميناً لصندوق شركة كبرى للسيارات، فنحن -حسب تعريف اليوم- من ذوي الدخل المحدود، وكل زملائي الذين شاركوني خوض بحار الحياة في المستوى الاجتماعي نفسه، ومن زاد فلا يشعرنا بذلك! |
| وهكذا مضيت إلى الحياة: أنقب عن البراءة، والحنان، والحب، والصدق! |
| ولعلني توقفت ذات يوم بعد خروجي من الطفولة إلى الوعي، عند سطور من رواية كتبها "شارلز جارفس" بطلها شاب فنان رفيع المكانة، يفتش عن الملامح التي تلهمه "اللوحة الخالدة".. فقال عبارة ضمن حوار البطل: |
| - "تعالَيْ.. لا أستطيع الانتظار.. إن كل شيء يتوقف بعدك"!! |
| ولعل العبارة صنعت ذلك النداء على رمز الحنان لكل إنسان، وعايشت طفولتي حتى طفولة روحي الآن! |
| إنها الحياة حينما تبدأ.. والموت حينما ننتهي! |
| تلك طفولتي.. ولكنني أرى البعض من الناس يعاني اليوم من "يتم" الفهم، ومن أجوبة كثيرة حائرة لم يضع الناس أسئلتها بعد! |
| فإذا كان "يتم" الطفولة: ظمأ، وجفافاً من الحنان.. فقد صرنا في عصر يعاني فيه الناس من فقدان "أمومة" أشياء مهمة، ومن "يتم" أيضاً! |
| وقد رددت هذه العبارة: |
| - (الطفولة بغير الأمومة: يتم مؤلم، والفرح بغير من نحبهم ويحبوننا: أيضاً يتم مؤلم)!! |
| الحب: هو أمومة متطورة وناضجة شاملة لا تتنازل أبداً. |
| فهل أكتب لكم عن (الحزن) شيئاً في ركض الناس؟! |
| إنه لم يعد يجرح.. البعض حوَّله إلى مناسبة، والبعض الآخر جعله "رومانسية" في المضمون الإنساني.. وهي رومانسية تتعرض كثيراً للسخرية، وللقدح، ولذم مشاعر الناس!! |
| وإذن... فقد تبلورت "غايتي" في النضوج لتكون هي: الرؤية بوضوح في زمن صاروا يبيعون فيه إبر الذاكرة!! |
| * * * |
| وفي عامي الـ (19): اختصرت طفولتي، وما زلت حتى اليوم، في هذا العصر أرعى وأدلِّه طفولة روحي ووجداني/كإنسان وليس كمراهقة متأخرة (!!) وسعيد جداً بهذا الرابط الحميم بين شخصي وطفولة روحي ووجداني! |
| وفي زماننا البسيط بإمكانياته، وحتى بطموحات أهله: لم نرغد بألعاب، ولا متنزّهات، ولا تلفاز.. كان هناك الراديو فقط: يثقف عقولنا، ويرقق وجداننا... وكان هناك (المعلم) في المدرسة الذي يحسن أداء دوره ورسالة المعلم في تفتيح وعي الطالب وتوجيهه إلى القراءة.. وكان هناك (سباقنا) نحو مكتبة الثقافة الكائنة آنذاك عند مدخل "باب السلام" إلى الحرم المكي الشريف، وأكثر ما كان يصلها: الصحف والمجلات المصرية الأسبوعية والشهرية، فنهلنا منها منذ عرفنا طريقنا إلى بوابة المدرسة. |
| وبدأ مشوار العلم والنضج داخل المدرسة الرحمانية بمكة المكرمة من: أولى ابتدائي، وانتهى في المدرسة الرحمانية/ثانوية عامة... وكان أجمل ما في هذا "العمر" الذي اعتبره/خاصاً: تلك الباقة من زملاء الدراسة المميزين وقد تبلورت علاقتي ببعضهم فصارت: صداقة ارتقت فوق كل مشكلات ومتغيرات الحياة المادية، وما زلنا نعض على هذه الصداقة بالنواجذ. |
| * * * |
| قاعة الشفا: |
| كنا نسكن محلة (قاعة الشفا) المؤدية إلى بوابة الحرم، وقالوا: أنها تتبع لحي أو حارة (الشامية)... وكان بيتنا كبيراً من عدة طوابق نجلو عنها كلما حانت شهور الحج، لنستقبل في جميع أدوارها الشيخ/إسماعيل بن مبيريك، أمير رابغ وعائلته، ونكتفي بما كان يسمّى: (المبيت) أي الدور العلوي! |
| والشيخ "ابن مبيريك": كان رجلاً فارساً من رجال الملك عبدالعزيز، يرحمهما الله، وكان جواداً كريماً محباً لآل بيت النبي الكريم/صلى الله عليه وآله وسلم.. فيأتي كل حج بعائلاته وأبنائه وأقربائه والأصدقاء ليحجوا على حسابه، وبلغ كرمه: أنه أصر على التكفل بقيمة إيجار البيت طوال العام.. وقد ربطته وشائج الصداقة والاحترام بوالدي/رحمهما الله. |
| وفي "قاعة الشفا": كان هناك "عم أمين"/شخصية شعبية حميمية جداً لأهل الحارة، وكان والده عمدة لحارتنا: قاعة الشفا.. إذا صعد سلالم منزلهم المكون من خمسة طوابق (أكثر البيوت في ذلك العهد: ذات طوابق متعددة، تضم كل أفراد الأسرة حتى بعد زواج الأبناء)!! |
| وكان لصوت حذاء "أبو أمين": إنذار في أسماع كل من في البيت، من الزوجة وحتى أصغر أطفاله، وكانت (هيبته) تسود أرجاء البيت وأفراد الأسرة، لكنه لم يكن أباً قاسياً ولا عنيفاً ولا جباراً. |
| وفي مكة المكرمة: لم يعرفوا شخصية (سي السيد) التي ابتدعها وأبدع في تشخيصها الروائي النوبلي/نجيب محفوظ.. فقد كانت النوافذ: ممنوعة على النساء.. والجرائد يقرأها: (جماعة المدارس)!! |
| وتجرأت ذات يوم، وجلست أصغي إلى "عم أمين"/ابن العمدة، في بقالته الصغيرة.. وهو يتذكر ويفيض بالشجون، فتأخذه الذكريات، وصورة أبيه العمدة وصوته الأجش، ومركازه، وبساطة الفرح، وحتى الصرامة كانت -أيضاً- لا تخلو من بساطة! |
| وكان العم "أمين" يجلس في دكانه ليحسب الحسبة أو الغلة اليومية، وكأنه يقارن بين حسبة والده/العمدة، وحسبته... وهل هناك حسبة أهم وأثقل على النفس من الالتزام بمصروف البيت اليومي؟! |
| هكذا كانت الحياة، ببساطتها ومحدودية طموح الإنسان فيها: تحتاج أيضاً إلى تنظيم، وربح وخسارة.. لكن نفوس أصحابها لم تكن مثقلة بماديات كهذه التي تفتك بأحلام الإنسان، وببساطة الحياة اليوم. |
| وبقيت (قاعة الشفا) في وجداني: وطناً أصغر في وطني الأكبر، وفي مدينتي المقدسة/مكة المكرمة التي احتضنتني: طفلاً يتيماً، وفتى ينهد إلى العلم، وشاباً يتطلع إلى المستقبل بتفاؤل ما فتئ يراودني. |
| واضطرتني ظروف العمل، ولقمة العيش، وهاجس تحسين الدخل بعد زواجي وتكوين أسرتي الصغيرة إلى (النزوح) من مكة المكرمة إلى "جدة".. لكن حنيني إلى (قاعة الشفا) لم يبرد ولم يترمد، أطوف أرجاءها كلما جئت إلى مكة المكرمة لزيارة بيت أهلي وإخوتي... حتى فوجئنا ذات يوم بذلك الحريق الشهير الذي اندلع في أنحاء "قاعة الشفا" من أقصاها إلى أقصاها، وتأكل النار بيوتها، وبعض سكانها، وتاريخها، وموقعها اللصيق بالحرم المكي!! |
| وكنت في متابعتي للهب الحريق أسترجع أجمل الذكريات، وتتساقط دموعي على اندثار آثار "قاعة الشفا" حتى الثمالة، فلم يتبق منها شيء إلا: رائحة الحريق/ما زالت في حواس الأنف كأنها هذه اللحظة.. رغم أن أبعاد هذه الحادثة وأسبابها قد انطوت مع الزمن منذ عام الحريق: 1377 هـ. |
| * * * |
| وكان لا بد أن يعبر شريط طويل مما عشقنا الانتماء إليه في هذا المجتمع (المكي) من عادات، وتقاليد، وأخلاق... لو عرف أبناؤنا وأحفادنا من بعدهم حضاريتها وقدرتها على لحمة المجتمع لعضوا عليها بالنواجذ، وتمسكوا بها كأنها: الحق، والعدل، والحب! |
| لقد غرست -تلك التربية في جيل آبائنا- أفضل السلوكيات في أخلاقياتنا، وأثمن القيم في مبادئنا ومواقفنا، وأجل اليقين في إيماننا وقناعاتنا واقتناعنا. |
| نعترف -نحن هذا الجيل الذي تسنم الأبوة وذاق حلاوة الأحفاد- أننا جانبنا بعض الصواب وارتكبنا الكثير من الأخطاء في ما سمحنا له أن (يتدفق) إلى مجتمعنا من الخارج دون رقابة وبدون تصفية له من الشوائب! |
| نحن جيل: لسنا ضد التقدم والتطور والتحديث.. بل نحن من تحول إلى "تروس" في مكنة التحديث: أدخلنا (الكلام) في البدء، وأعلمنا عن الجديد والمتغيرات، وطالبنا بالانفتاح على الكثير منها.. لكننا -أيضاً- أردنا ذلك كله بالعقل، وبالوعي، وبنضج العاطفة مع نضج العقل! |
| ولا أعلن -هنا- عن الندم.. بمقدار ما ينبغي أن نعلن عن الأخطاء التي ارتكبناها بواسطة هذا (التفريط) في: ملامحنا، وعاداتنا، والتزاماتنا السلوكية بدعوى: أننا ننهل من الحضارة والعلوم!! |
| * * * |
| ولعلنا نتساءل اليوم بحزن شديد: كيف نصف ملامحنا.. ومنذ متى لم نعد نحدق فيها؟! |
| من كثرة ما تعودنا على إلصاق وجوهنا بالمرآة.. صار التعود لدينا يحتاج إلى مرآة عاكسة من الخلف! |
| لقد فقدنا الكثير من (علاماتنا) التي تدل على خصوصية مجتمعنا... وكلما دخلت مدينتي/المقدسة/مكة المكرمة، الدافئة بالدعاء، المغمورة بنور الطواف حول الكعبة: تتملكني قشعريرة، وتنزلق من عيني دمعة، ويطوف في أرجاء نفسي سؤال عصيب: |
| أين هو مجتمع مكة المكرمة.. بكل (اجتماعياته) وروحه المرحة، وحبه للوشائج؟! |
| حتى دخلت المسجد الحرام.. ومع تعدد التفاتاتي في أرجائه: صدع في رأسي سؤال آخر: |
| أين هي "حلقات" الدرس التي كانت تضج بها زوايا المسجد الحرام.. وأين هذه الأيام من ذلك الماضي: يوم كان علماء الحجاز يهبون علمهم لمئات من طلاب العلم؟!! |
|
|
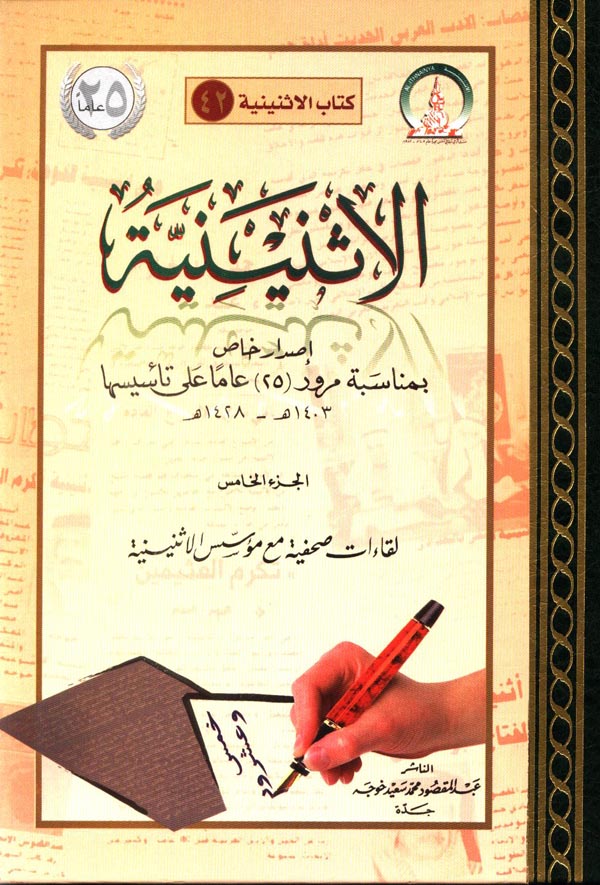
 شارع عبد المقصود خوجة
شارع عبد المقصود خوجة 00966-12-6982222 - تحويلة 250
00966-12-6982222 - تحويلة 250




